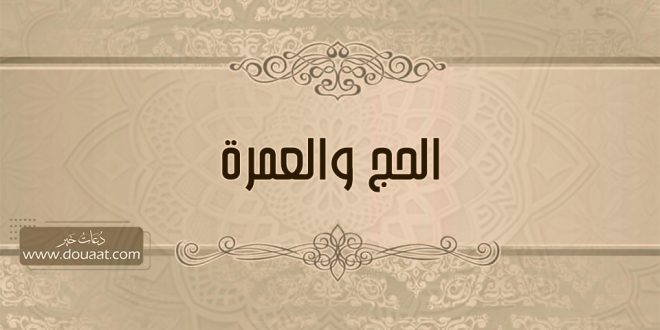موجبات الحج:
يجبُ الحَجُّ والعمرةُ فِى العمرِ مرةً.
الشرح: أنَّ الحجَّ هو قصدُ الكعبةِ لأفعالٍ معهودة، والعمرةُ قصدُ الكعبة لأفعالٍ معلومة. والحجُّ فرضٌ مع الاستطاعةِ بالإجماع، فمن أنكر وجوبَهُ على المستطيعِ فهو كافر. وأما العُمْرَةُ فقد اختُلِفَ فيها. فالشافعِىُّ رضِى الله عنه يقولُ: هى واجبةٌ فى العمرِ مرةً على المستطيع كالحج، وذهب بعضٌ غيرُه من الأئمةِ كمالك إلى أنها سُنَّة. وأما الحجُ فلم يختلفوا فى وجوبِهِ على المستطيع، وإن كانوا اختلفوا هل وجوبُهُ على الفور أم على التراخِى. فقال مالك: هو على الفورِ، وقال الشافعىُّ رضى الله عنه: يجوزُ له تأخيرُهُ طالما أنه يؤدِيهِ قبلَ الموتِ.
وهو أحدُ الأمورِ الخمسةِ التى ذكر رسول الله r أنَّ الإسلامَ بُنِىَ عليها. ومَزِيَّةُ الحجّ أنه إذا كان مقبولاً مبروراً خرجَ الإنسانُ به من ذنوبِهِ كيومَ ولدتْهُ أُمُّهُ، كما روى ذلك البخارىُّ وغيرُه.
على المسلمِ الحرِّ المكلَّفِ المستطيعِ بما يوصلُه ويرُدُّه إلى وطنِهِ فاضلاً عن دَيْنِهِ ومَسكنه وكِسوتِهِ اللائِقَينِ بهِ ومُؤْنَةِ مَنْ عليه مُؤْنَتُهُ مدَّةَ ذهابِهِ وإيابِهِ.
الشرح: أن الحجَّ له شروطُ وجوبٍ وشروطُ صِحَّةٍ. أما شروطُ الوجوبِ فمنها: الإسلامُ، فلا يجبُ علَى الكافِرِ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ فِى الدنيا، وإن كان يُعَاقَبُ على تركِهِ فِى الآخرة. والشرطُ الثانى: البلوغُ، فلا يجبُ على غيرِ البالغ ولو كان غنياً. والشرطُ الثالثُ: العقلُ، فلا يجبُ على المجنونِ. والشرط الرابع: الاستطاعةُ، وذلك بأن يجدَ الشخصُ ما يُوصِلُهُ إلى مكةَ ويرُدُّهُ إلى وطنِهِ من زادٍ وما يتبَعُ ذلك زائداً عن دَينه ومسكنِهِ وكسوتِهِ اللائقَين به ونفقة من عليه مؤنَتُهُ مدةَ ذهابِهِ وإيابِهِ. هذا مع الأمنِ على نفسِهِ ومالِهِ. أما إذا كان يعلم أنه إذا ذهبَ إلى الحج سيُقْتَلُ فى الطريق أو يُسلبُ منه مالُه أو جُزءٌ منه فهنا لا يجبُ عليه. وهناك نوعٌ ءاخر من الاستطاعة وهو استطاعةٌ معنوية وليست حسية، وهى أن تجدَ المرأةُ مَحْرَمَاً يذهب معها. فإن لَم تجدْ مَحْرَماً يذهبُ معها ولو بأجرة إن كانت قادرة عليها فلا يجبُ عليها الحج. والشرطُ الخامسُ: الحُريّـة، فلا يجبُ الحجُّ على العبدِ.
وأما وقوعُ الحجِ عن فرضِ الإسلامِ بحيثُ لا يجبُ إعادتُهُ مرةً ثانية فى العُمُر فله شرطان: التكليف والحريةُ التامة.
أركان الحج:
وأركانُ الحجِّ ستةٌ.
الشرح: أن الحجَّ يتضمنُ أركاناً ويتضمنُ واجباتٍ ويتضمنُ سُـنَـنـاً.
فأما الأركانُ فهى أجزاءُ الحجِ التى إذا تَرَكَ المرءُ واحداً منها لا يَنْجَبِرُ ذلك بالدمِ بل لا يصحُّ حجُّهُ إلا بالإتيانِ بها.
أما الواجبات فهى الأجزاءُ التى إذا تركَهَا المرء أَثِمَ وعليه دم لكن لا يفسُدُ حجُّهُ.
وأما السُّنَنُ فهى الأجزاءُ التى إذا فَعَلَهَا المرء كان مُثاباً وإذا تركَها فليس عليه إثمٌ ولا عليه دم. ففى الحج هناك فرقٌ بين الركنِ وبينَ الواجب، ولا يُوجَدُ هذا الفرقُ فى أبواب الفقه الأخرى غير الحج، إذ الركن والواجبُ والفرض بمعنى واحد فيها. فأركانُ الحجِ أى أجزاؤه التى لا يصحُّ الحجُّ بدونِهَا ولا تُجْبَرُ بالدم هى ستَةٌّ فقط.
الأولُ: الإحرامُ، وهوَ أنْ يقولَ بقلبِهِ: “دخلتُ فى عملِ الحجِّ أو العمرةِ”.
الشرح: أن أولَ أركانِ الحج الإحرام. ومعنى الإحرام: الإتيانُ بالنية، ليس معناهُ لُبسَ الثياب الخاصة بالحج أو نحو ذلك بل معناه الإتيانُ بالنيةِ الصحيحة. ومثالُ النيةِ المُجْزِئَةِ: نَويتُ الحجَّ وأحرمتُ به للهِ تعالى. وبالنسبَةِ للعُمْرَةِ يقولُ: نَويتُ العمرةَ وأَحْرَمْتُ بها للهِ تعالى. ولا بد أن تكون هذه النيةُ فِى أشهُرِ الحجِّ، وهى: شوَّال وذو القَعدة وذو الحِجة، يعنى العشرَ الأوائلَ من ذِى الحِجة.
الثانى: الوقوفُ بعرفَةَ بين زوالِ شمسِ يومِ عرفةَ إلى فجرِ ليلةِ العيدِ.
الشرح: أن الركن الثانىَ من أركان الحج هو الوقوفُ بعرفة، ووقتُهُ ضيقٌ. قال عليه الصلاة والسلام: “الحجُّ عَرَفَة”، فمن فاتَهُ الوقوفُ بعرفة فقد فاتَهُ الحج. ووقتُ الوقُوفِ بعرفة من زوالِ شمسِ يوم عرفة أى يوم التاسع إلى الفجر من يومِ العيد. فلا بد للحاجِّ أن يكون فى ضمنِ حدود أرض عرفة لحظة فى ذلك الوقت، فى النهار أو فى الليل. لكنَّ الأفضلَ له أن يجمعَ بين النهارِ والليل، يعنى أن يكون هناك من قبلِ غروبِ شمسِ يوم عرفة إلى ما بعد الغروب.
الثالث: الطوافُ بالبيتِ.
الشرح: أنَّ الركنَ الثالثَ من أركانِ الحجِ هو الطوافُ بالكعبةِ. ولا يصحُ إلا منْ بعدِ منتصَفِ ليلةِ العيد أى الليلة التى تسبقُ يومَ العيد. والليلُ يبدأ بالمغرب وينتهى بالفجر، فوسطُ ذلك الوقت هو منتصف الليل. ويدورُ الحاجُّ حول الكعبة سبعَ مرات، جاعلاً الكعبةَ عن يسارِهِ، مُبتدئًا بالحَجَرِ، متوجهاً إلى ناحية الحِجْرِ، طائفاً خارجَ الكعبةِ، يعنِى أنَّ كُلَّ بدَنِهِ لا بد أن يكون خارجَ الكعبَةِ، فلا يُحَاذِى بشىءٍ من بَدَنِهِ الحِجْرَ أو الشَاذَرْوَان.
الرابعُ: السعىُ بين الصفا والمروةِ سبعَ مراتٍ من العَقْدِ إلى العَقْدِ.
الشرح: أن السعىَ بين الصفا والمروةِ ركنٌ من أركانِ الحج. والصفا جبلٌ والمروة جبل، وبينهما فى الأصلِ وادٍ، لكنه الآن طُمَّ لتسهيلِ السعىِ على الحُجَّاج. فلا بد أنْ يَسعَى سبْعَةَ أشواط، مبتدئًا بالصفا ومنتهياً بالمروة، لأنَّ الذهابَ يُعَدُّ شوطاً والرجوعَ يُعَدُّ شوطاً ءاخر. وهناك علامةٌ عند الصفا وأخرى عند المروة فلا بد أن يكون السعىُ بين هاتين العلامتين على الأقل. وليست الطهارةُ شرطاً لصحة السعى، ولا هى شرطٌ فى الوقوفِ بعرفة، لكنها شرطٌ فى الطواف بالبيت.
والخامسُ: الحلْقُ أو التقصيرُ.
الشرح: أن من أركانِ الحج أن يَحْلِقَ الحاجُّ شعرَ رأسِهِ أو يُقَصّـِرَهُ. وهذا يحصلُ بحلقِ ثلاثِ شعرات على الأقل، أو قَصّـِهَا، أو حرقِهَا، أو نحوِ ذلك. ويدخل وقته كالطواف بمنتصف ليلة العيد. والأفضلُ أن يَحْلِقَ الرجُلُ شعرَ رأسِهِ، وأما المرأةُ فحَرامٌ عليها الحلقُ بالموسَى لغيرِ ضرورة، وإنما تُقَصّرُ، والأفضلُ أن تُقَصّـِرَ من كلِّ شعرِهَا.
السادسُ: الترتيبُ فِى مُعظَمِ الأركانِ.
الشرح: أن الترتيب ركن من أركان الحج. فلا بد من تقديم الإحرام على كلِّ باقِى الأركان، ولا بد من تأخير الطواف والحلقِ أو التقصير عن الوقوفِ بعرفة. وأما السعىُ بينَ الصفا والمروة فلا بد لصحته من أن يكون بعد طوافٍ بالكعبة سواء كان طواف الفرض أو غيره.
وهى إلا الوقوفَ أركانٌ للعُمرَةِ.
الشرح: أنَّ هذه الستةَ باستثناءِ الوقوفِ بعرفة هى أركانٌ للعُمرة. يعنى أن أركانَ العمرةِ خمسةٌ: الإحرامُ، والطوافُ، والسعىُ، والحلقُ أو التقصيرُ، والترتيبُ. والترتيبُ هنا واجبٌ فى كُلِّ الأركانِ، فلا بد من الابتداءِ بالإحرامِ، ثم الطوافِ بعد ذلك، ثم السعىِ بعد ذلك، ثم الحلقِ أو التقصيرِ.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة