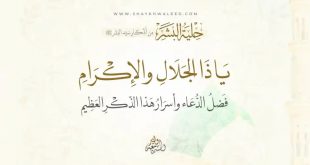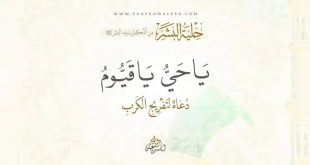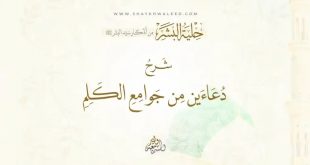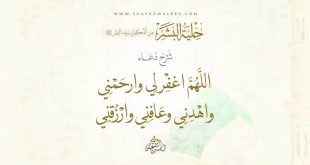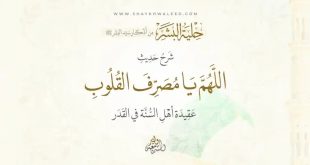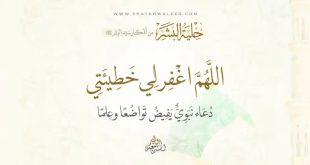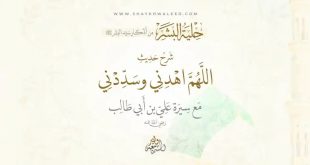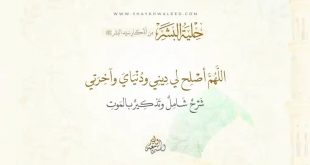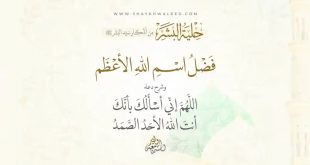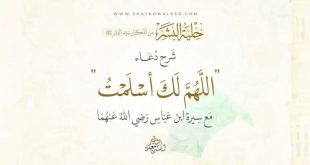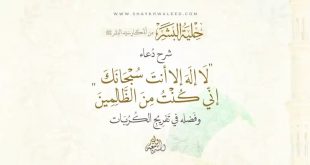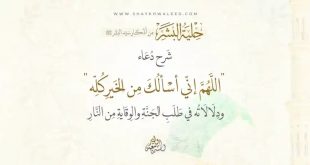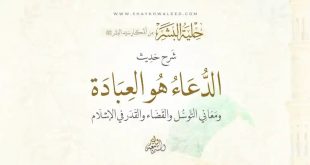بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للَّه الواحدِ القهَّار، العزيزِ الغفَّار، مقدِّرِ الأقدار، مصرِّفِ الأمور، مُكوِّرِ الليل على النهار، تبصرةً لأُولي القلوبِ والأبصار، الذي أيقظَ مِن خلقِه مَن اصطفاه فأدخلَه في جملةِ الأخيار، ووفَّقَ مَنِ اجتباهُ مِنْ عبيدِه فجعلَه مِن المقرَّبينَ الأبرار، وبصَّرَ مَن أحبَّه فزهَّدهم في هذه الدار، فاجتهدوا في مرضاتِه والتأهُّبِ لدارِ القرار، واجتنابِ ما يُسخطُه والحذرِ مِن عذابِ النار، وأخذوا أنفسَهم بالجدِّ فِي طاعتِه وملازمةِ ذكرِه بالعشيِّ والإِبكار، وعندَ تغايرِ الأحوالِ وجميعِ آناءِ الليلِ والنهار، فاستنارَتْ قلوبُهم بلوامِعِ الأنوار،
أحمدُه أبلغَ الحمدِ علَى جميعِ نِعَمِهِ، وأسألُه المزيدَ مِنْ فضلِهِ وكَرَمِهِ. وأشهدُ أنْ لَا إله إلَّا اللهُ العظيمُ، الواحدُ الصمدُ العزيزُ الحكيم؛ وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيُّه وحبيبُه وخليلُه، أفضلُ المخلوقين، وأكرمُ السابقينَ واللاحقينَ، صلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى سائرِ النبيين، وآلِ كلٍّ وسائرِ الصالحين، أما بعد:
فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [سورة البقرة، الآية 152]، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات، الآية 56] فعُلِم بهذا أن من أفضل أحوال العبد المسلم وأشرفِها هو حالَ ذكره لله رب العالمين، واشتغالَه بالأذكار الواردة عن رسول الله ﷺ سيد المرسلين، وكيف لا يكون كذلك وقد وصف الله المؤمنين الذاكرين المتبتلين بوصف عظيم وأثنى عليهم في كتابه العزيز فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [سورة الأنفال، الآية 2]، وقال سبحانه: ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [سورة الحج، الآيتان 34-35]، والمُخبِتونَهم المطمئنون بذكر الله.
ومَدَحَ الله تعالى البيوتَ التي يُذكَرُ فيها سبحانه صباحا ومساء ومَدح الذاكرين له فيها ووعدهم الأجرَ العظيمَ فقال: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38)﴾ [سورة النور، الآيات 36-38]، وقال سبحانه: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [سورة الأعراف، الآية 205]، وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [سورة الكهف، الآية 24]، وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [سورة آل عمران، الآية 41].
وَذَمَّ الذين قست قلوبهم عن ذكر الله فقال: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سورة الزمر، الآية 22]، وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [سورة الزمر، الآية 45].
ورغَّب سبحانه بالذكر فقال: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [سورة الحديد، الآية 16]، ومدح قلوب الذاكرين وبين أن الذكرَ راحةٌ لقلوبِهم فقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [سورة الرعد، الآية 28].
وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول ﷺ كان يذكر الله تعالى في كل أحيانه وأحواله، وحَضَّ عليه الصلاة والسلام أمته حضًّا بليغًا في أحاديثَ كثيرةٍ على ذكر الله تعالى، ومن ذلك قوله ﷺ عندما سئل: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ “أي من أحبها” قَالَ: ((أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)) رواه ابن حبان في صحيحه.
وَرَوَى مسلم عنْ أَبي سعيدٍ الخدري رضِي اللَّه عنْهُ قال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حفَّتْهُمُ الملائِكة، وغشِيتهُمُ الرَّحْمةُ ونَزَلَتْ علَيْهِمْ السَّكِينَة، وذكَرَهُم اللَّه فِيمن عِنْدَهُ))، غَشِيَتهم أي غَطَّتهم، وَالسَّكِينَةُ هِيَ الْوَقَارُ، والمراد بلفظ ((عِنْدَهُ)) عندية التشريف وليس المكان والجهة فَرَبُّنا عزَّ وجلَّ لا يحتاج إلى المكان ولا يجري عليه زمان.
وفي حديث أبي ذر الغفاري قال له النبي ﷺ: ((أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ تَعالَى، فَإِنَّهُ رَأْسُ الأَمْرِ كُلِّهِ، وَعَلَيْكَ بِتِلاوَةِ القُرءَانِ، وذِكْرِ اللهِ تَعالَى، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ في السَّمَاءِ، وَنُورٌ لَكَ في الأَرْضِ)) رواه البيهقي في شعب الإيمان.
وقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ((لا تُكْثِرُوا الكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فإنَّ كَثْرَةَ الكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعالى قَسْوَةٌ للْقَلْبِ، وَإنَّ أبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعالى القَلْبُ القَاسِي))رواه الترمذي في سننه،
وعن أبي هريرةَ رضيَ اللّه عنه، قالَ: وقال رسول الله ﷺ: ((الدُّنيا مَلْعونَةٌ مَلعونٌ ما فِيها إلّا ذِكرَ الله وَما والاهُ، أوَ عالِمًا أوَ مُتَعلِّما)) رواه ابن ماجه في السنن، فَبَيَّنَ لَنا الرّسُول أَنَّ الدُّنيا ((مَلْعُونَة))؛ أَيْ تُبْعِدُ الإِنْسانَ عَنْ ءاخِرَتِهِ غالِبًا، إِلّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ أُمُورِ الدُّنيا أَشياء مِمّا فِيهِ خَير، فقال: ((إِلّا ذِكرَ الله))؛ مَعناهُ ذِكْرُ اللهِ فِى الدُّنيا خَيرٌ يُقَرِّبُ الإِنْسانَ إِلَى ءاخِرَتِهِ وَيَجعَلُ لَهُ فِى الجَنَّةِ نُزُلًا حَسَنة، ((وَما والاهُ))؛ أَي ما هُوَ فِى حُكمِ ذِكْرِ الله مِمّا يُقَرِّبُ إِلَى الله، ((أوَعالِمًا أو مُتَعلِّما))، عالِمًا تَعَلَّمَ دِينَ الله ثُمَّ طَبَّقَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَبَثَّ ما عَلِمَهُ بينَ الناس، ومُتَعلِّما عَلَى سَبيلِ نجاةٍ، يَرْجُو عِنْدَ اللهِ السلامةَ فِى الآخِرَة.
وقارنَ رسولُ اللهِ ﷺ بين الذاكر لربه وغير الذاكر فقال: ((مَثَلُ الذي يَذكُرُ ربَّهُ وَالذي لا يذكُرُهُ، مَثَل الحيِّ والمَيِّتِ)) رواهُ البخاري، وفي لفظ لمسلم قال ﷺ: ((مَثَلُ البَيْتِ الَّذي يُذْكَرُ اللَّه فِيهِ وَالبَيتِ الذي لا يُذْكَرُ اللَّه فِيهِ، مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ))، وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ((سبقَ المُفَرِّدُونَ)) قالوا: ومَا المُفَرِّدُونَ يا رسُول اللَّهِ؟ قال: ((الذَّاكِرُونَ اللَّه كَثيرًا والذَّاكِراتُ)) رواه مسلم.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [سورة الأحزاب، الآية 35]، واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتمَّ بمعرفتها من يدرس هذا الكتاب. وقد اختُلِفَ في معنى ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾، فقال الإِمامُ أبو الحسن الواحديّ في كتابه التَّفْسِيرُ البَسِيْط: “قال ابن عباس: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات، وغدوًّا وعشيًّا، وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكرَ الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكونُ من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا. وقال عطاء: من صلَّى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخلٌ في قول الله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾”.
وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: ((إذا أيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا ـ أَوْ صَلَّى ـ رَكعَتينِ جَمِيعًا، كُتِبَا في الذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ)) هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم.
وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصَّلاح رحمه الله عن القدر الذي يصيرُ به من الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكرات، فقال: إذا واظبَ على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلًا ونهارًا، وهي مُبيّنة في كتاب عمل اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات، والله أعلم.
وعنْ عبد اللَّه بن بُسْرٍ رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رَجُلًا قال: يا رسُولَ اللَّهِ إنَّ شَرائِع الإسْلامِ قَدْ كَثُرتْ علَيَّ فَأخبرْني بِشيءٍ أتشَبَّثُ بهِ قال: ((لا يَزالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ)) رواهُ الترمذي، وروى الطبراني في المعجم الكبير عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: ((كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يطيلُ الصمتَ)) أيِ السكوتَ؛ أي إلا عنْ ذكرِ اللهِ وما هو منَ الدينِ وما ينفعُهُ في معيشتِهِ.
وكان الصحابة رضوان الله عليهم على الاقتداء بالنبي ﷺ في أقواله وأحواله في ليله ونهاره، يتتبعون حركاته وسكناته وتصرفاته وكلامه، ويهتمون باقتفاء آثاره وما يرد عنه من أخبار، فإذا غاب الواحد منهم عن مجلس النبي ﷺ – لأمر شُغِلَ به – سأل غيره عمّا كان في ذلك المجلس، وما هذا إلا لامتلاء قلوبهم بمحبته ﷺ ولحرصهم على أخذ الشريعة منه ﷺ، فكان منهم ما كان، مِن فتحٍ للبلاد ولقلوب العباد فإن الاقتداء بالنبي ﷺ وتتبعَ أحواله علامة خير وفلاح في الدنيا والآخرة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا من النبي ﷺ الحثَّ على ذكر معين التزموه وداوموا عليه، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلّي مع رسول الله إذ قال رجل مِن القوم: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فقال رسول الله: ((عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ)). قال ابن عمر: ما تركتهن منذ سمعتهنّ مِن رسول الله ﷺ رواه مسلم في صحيحه.
ويشترط لقبول الذكر من الذاكر أن يكون مؤمنا بالله، فإن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [سورة إبراهيم، الآية 18]. وقال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا)) رواه الإمام أحمد.
فمن لم يكن مؤمنا بأن كفر بالله فقد خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين، والكُفْرُ نَقِيضُ الإيمانِ كَمَا أنَّ الظَلامَ نَقِيضُ النُّورِ، وَهُوَ ثَلاثَةُ أبْوَابٍ التَّشْبِيهُ وَالتَّكْذِيبُ وَالتَّعْطِيلُ.
التَّشْبِيهُ: أي تَشْبِيهُ اللهِ بِخَلْقِهِ، كالذي يَصِفُ اللهَ بأنّهُ جالسٌ أو أنَّ له شكلاً وهيئةً أو يصِفه بأنّ له مكانًا أو جهَةً.
والتَّكْذِيبُ: أي تَكْذِيبُ مَا وَرَدَ في القرآن الكَرِيمِ أو ما جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهٍ ثابتٍ؛ كَإنْكَارِ بَعْثِ الأجْسَادِ وَالأرْوَاحِ معًا، وَإنكارِ وُجُوبِ الصَّلاةِ والصّيامِ والزَّكَاةِ.
والتَّعْطِيلُ: وَهُوَ نَفْيُ وُجُودِ اللهِ تَعَالَى وَهُو أشَدُّ الكُفْرِ.
والكافر: إمّا كَافِرٌ أصْلِيٌّ أوْ مُرْتَدٌّ عَنِ الإسْلامِ.
فَالَكَافِرُ الأصْلِيُّ: هُوَ مَنْ نَشَأ على الكفر مِنْ أبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ، وَبَلَغَ على الكُفْرِ.
أمَّا المُرتَدُّ: فَهُوَ الشّخْصُ الذي كَان مُسْلِمًا وَوَقَعَ في أحدِ أنْوَاعِ الرّدَّةِ. قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [سورة التوبة، الآية 65-66]، وَالرّدّةُ: هيَ الخُرُوجُ عَنِ الإسْلام، فيَجِبُ على كلّ مُسْلِمٍ أنْ يَحْفَظَ إسْلامَهُ وَيَصُونَهُ عَنْ هذِهِ الرّدّةِ التي تُفْسِدُهُ وَتُبْطِلُهُ وتَقْطَعُهُ والعِيَاذُ باللهِ تَعالى.
وَالرّدَّةُ ثَلاثةُ أقْسَامٍ كَما قَسَّمها العلماءُ: كُفْرٌ اعْتِقَادِيٌّ، وكُفْرٌ فِعْليٌّ، وكُفْرٌ قَوْلِيٌّ.
وكُلُّ قِسْمٍ مِنْ أقْسَامِ الرّدّةِ يَدْخُلُ تَحْتَهُ شُعَبٌ كَثِيرَةٌ.
الكُفْرُ الاعْتِقَاديٌّ: كَنَفْيِ وجودِ اللهِ تَعَالَى، أو اعْتِقَادِ أن الله عَاجِزٌ أو جَاهِلٌ، أو اعتِقَادِ أنَّ اللهَ جِسْمٌ أوْ ضَوْءٌ أو رُوحٌ أو أنّه يَتَّصفُ بصفةٍ من صِفاتِ الخَلْقِ والعِيَاذُ بِاللهِ تَعالى، أو اعتِقَادِ أن شُرْبَ الخَمْرِ حَلالٌ أو أن السَّرِقَةَ حَلالٌ، أو اعْتقَادِ أنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِض الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ أو صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، أو الزَّكَاةَ أو الحَجَّ.
الكُفْرُ الفِعْلِيُّ: كإلْقَاءِ المصْحَفِ أوْ أوْرَاقِ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عَمْدًا فِي القَاذُورَاتِ، أو السُّجُودِ لِصَنَمٍ أوْ لِشَمْسٍ أوْ مَخْلُوقٍ آخَرَ على وَجْهِ العِبَادَةِ لَهُ، وَكَكِتَابَةِ الآيَاتِ القُرآنِيَّةِ بِالبَوْلِ.
الكُفْرُ القَوْليٌّ: كَسَبّ اللهِ تَعَالى أوْ سَبّ نَبِيّ مِنَ الأنْبِيَاءِ أو مَلَكٍ مِنَ الملائِكَةِ أوْ سَبّ الإسْلامِ أو القُرْآنِ أو الاسْتِهْزاء بالصَّلاةِ أو الصّيَامِ، أو الاعتراض على اللهِ.
وقد قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لا يَرىَ بِهَا بَأْساً يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)) رواهُ الترمذيُّ. أيْ مَسَافَةَ سَبْعِينَ عَامًا في النُّزُولِ وَذَلِكَ مُنْتَهَى قَعْرِ جَهَنَّمَ وَهُوَ خَاصٌّ بالكُفَّارِ، وَهَذَا الحَدِيثُ دَلِيلٌ على أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ في الوُقُوعِ في الكُفْرِ مَعْرِفَةُ الحُكْمِ ولا انْشِرَاحُ الصَّدْرِ ولا اعْتِقَادُ مَعْنَى اللَّفْظِ ولا نية الكفر.
وَقَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: ((أكثرُ خطايا ابنِ آدَمَ مِنْ لِسَانِهِ)) رواهُ الطبراني في المعجم الكبير.
وَالقَاعِدَةُ: أنَّ كُلَّ اعتقادٍ أوْ فِعْلٍ أوْ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى اسْتِخْفَافٍ بِاللهِ أوْ كُتُبِهِ أوْ رُسُلِهِ أوْ مَلائِكَتِهِ أوْ شَعَائِرِهِ أوْ مَعَالِمِ دِينِهِ أوْ أحْكَامِهِ أوْ وَعْدِهِ أوْ وَعِيدِهِ كُفْرٌ فَلْيَحْذَرِ الإنْسانُ من ذلكَ جَهْدَهُ.
وليُعلَم أنَّ مَنْ كَفَرَ لا يَرجِعُ إلى الإسلامِ إلا بالنُّطقِ بالشهادتين بعد رجوعه عن الكفر، فلا يرجع الكافر إلى الإسلام بقول (أستغفِرُ اللهَ)، بل يَزيده ذلك كفرًا، ولا تنفعه الشَّهادتان ما دام على كفرِه لم يرجِع عنه.
ويشترط كذلك أن يكون ذكرُه لربه عز وجل ذكرًا صحيحا؛ فلا يجوز تحريف ذِكر الله تعالى، كمن يأتي ليذكر الله ويذكر لفظ الجلالة بطريقة خطأ، كثيرا من الناس بدل أن يقول: (الله)، يقول: (اللا)، قال الفيومي في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: “قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَبَعْضُ الْعَامَّةِ يَقُولُ (لَا وَاَللَّهِ) فَيَحْذِفُ الْأَلِفَ، وَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهَا فِي اللَّفْظِ، وَهَذَا كَمَا كَتَبُوا (الرَّحْمَنَ) بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهَا فِي اللَّفْظِ، وَاسْمُ (اللَّهِ) تَعَالَى يَجِلُّ أَنْ يُنْطَقَ بِهِ إلَّا عَلَى أَجْمَلِ الْوُجُوهِ. قَالَ: وَقَدْ وَضَعَ بَعْضُ النَّاسِ بَيْتًا حَذَفَ فِيهِ الْأَلِفَ فَلَا جُزِيَ خَيْرًا وَهُوَ خَطَأٌ وَلَا يَعْرِفُ أَئِمَّةُ اللِّسَانِ هَذَا الْحَذْفَ”.اهـ
والبعض يزيد في الفساد فيقول: (آه)، ويعتبر نفسه يذكر الله والعياذ بالله تعالى، لِيُعْلَمْ أَنَّ الصَّوَابَ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ ذِكْرُ اللهِ بِلَفْظِ (ءَاهٍ) وَلَا بِنَحْوِهِ مِنْ أَلْفَاظِ الأَنِيْنِ وَالتَّوَجُّعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى فَلْيَذْكُرْهُ بِمَا هُوَ ثَابِتٌ فِي القُرْءَانِ الكَرِيْمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيْفَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [سورة الأعراف، الآية 180].
وَكَيْفَ يَصِحُّ كَوْنُ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الشِّكَايَةِ وَالعَجْزِ وَالتَّوَجُّعِ اسْمًا للهِ، حَاشَا، فَمَا كَانَ كَذَلِكَ مِنَ الأَسْمَاءِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِيْلُ أَنْ يَكْوُنْ اسْمًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ يَرُدُّ زَعْمَ مَنْ يَقُوْلُ بِأَنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى مُخَالَفَةُ ذَلِكَ القُرْءَانَ الكَرِيْمَ وَالسُّنَّةَ الشَّرِيْفَةَ وَأَقْوَالَ الفُقَهَاءِ وَأَقْوَالَ أَهْلِ اللُّغَةِ، فَضْلًا عَنْ أَنَّ الحَدِيْثَ الَّذِي يَسْتَنِدُوْنَ إِلَيْهِ مَرْدُوْدٌ مَوْضُوْعٌ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ، وَهَا نَحْنُ نُبْطِلُ مَقَالَةَ هَؤُلَاءِ فِي أَنَّ (ءَاهٍ) مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى:
أَوَّلًا: مُخَالَفَةُ دَعْوَاهُمُ القُرْءَانَ الكَرِيْمَ
أَمَّا مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِم مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّ لَهُ الأَسْمَاءَ الدَّالَّةَ عَلَى الكَمَالِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [سورة الأعراف، الآية 180]. وَمَعْنَى ﴿الحُسنَى﴾ الدَّالَّةُ عَلَى الكَمَالِ، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى دَالًّا عَلَى خِلَافِ الكَمَالِ.
قَالَ الإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الخَطَّابِيُّ البُسْتِيُّ: “وَدَلِيْلُ هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ الغَلَطَ فِي أَسْمَائِهِ وَالزَّيْغَ عَنْهَا إِلْحَادٌ” اهـ. نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ الحَافِظُ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي زَادِ الْمَسِيْرِ،
وَقَالَ أَبُو البَرَكَاتِ النَّسَفِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ: “وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ أَيِ اتْرُكُوا تَسْمِيَةَ الَّذِيْنَ يَمِيْلُوْنَ عَنِ الحَقِّ وَالصَّوَابِ فِيْهَا فَيُسَمُّوْنَهُ بِغَيْرِ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى وَذَلِكَ أَنَّ يُسَمُّوْهُ بِمَا لَا يَجُوْزُ عَلَيْهِ نَحْوُ أَنْ يَقُوْلُوا: (يَا سَخِيُّ، يَا رَفِيْقُ) لِأَنَّهُ لَم يُسَمِّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ، وَمِنَ الإِلْحَادِ تَسْمِيَتُهُ بِالجِسمِ وَالجَوْهَرِ وَالعَقْلِ وَالعِلَّةِ” اهـ.
فَتَبَيَّنَ أَنَّ الإِلْحَادَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى هُوَ تَسْمِيَتُهُ بِمَا لَم يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ وَلَم يَرِدْ فِيْهِ نَصٌّ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُلَّهَا تَوْقِيْفِيَّةٌ أَيْ يَتَوَقَّفُ إِطْلَاقُهَا عَلَيْهِ تَعَالَى عَلَى وُرُوْدِهَا فِي كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ أَوْ إِجْمَاعِ الأُمَّةِ، وَمنْ الإِلْحَادِ فِي الأَسْمَاءِ مَا يَصِلُ بِهِ الشَّخْصُ إِلَى حَدِّ الكُفْرِ كَمَنْ سَمَّى اللهَ تَعَالَى جِسْمًا أَوْ جَوْهَرًا أَوْ عَقْلًا أَوْ عِلَّةً أَوْ رُوْحًا أَوْ مُسْتَحْيِيًا أَوْ مُضِلًّا، وَتَسْمِيَةُ اللهِ بِالعِلَّةِ أَشَدُّ مِنْ تَسْمِيَتِهِ بِالسَّبَبِ لِأَنَّ العِلَّةَ فِي اللُّغَةِ التَّغَيُّرُ، وَأَمَّا مَا لَا يُكَفَّرُ بِتَسْمِيَتِهِ لَكِنَّهُ لَا يَجُوْزُ هُوَ كَمَنْ قَالَ عَنِ اللهِ (يَا كَامِلُ، يَا قَاضِي) فَهَذَا لَا يَكْفُرُ مُطْلِقُهُ عَلَى اللهِ، لَكِنَّ إِطْلَاقَهُ هَذَا عَلَى اللهِ مِنْ بَابِ الاسْمِ لَا يَجُوْزُ لِأَنَّهُ لَم يَرِدْ.
ثانيًا: مُخَالَفَتُهُ السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ الشَّرِيْفَةَ
وَأَمَّا مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِم مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّه قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُم فَلَا يَقُلْ: ءَاهٍ ءَاهٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ)) أَوْ قَالَ: ((يَلْعَبُ مِنْهُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَافِظُ الْمُجْتَهِدُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ.
فَلَوْ كَانَ لَفْظُ (ءَاهٍ) مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى كَمَا يَزْعَمُوْنُ لَم يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ)). ثُمَّ إِنَّهُ لَم يَرِدْ فِي حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ وَلَا حَسَنٍ أَنَّ (ءَاهٍ) اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا الَّذِي وَرَدَ مَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ وَالرَّافِعِيُّ فِي تَارِيْخِ قَزْوِيْنَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا مَرِيْضٌ يَئِنُّ فَقُلْنَا لَهُ: اسْكُتْ فَقَدْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “دَعُوْهُ يَئِنُّ فَإِنَّ الأَنِيْنَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى يَسْتَرِيْحُ إِلَيْهِ العَلِيْلُ“، وَهُوَ حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ جَزْمًا أَيْ مَكْذُوْبٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَحَاشَا أَنْ يَقُوْلَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ، وَقَدْ عَزَاهُ لَهُ السُّيُوْطِيُّ فِي الجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ، فَتَعَقَّبَهُ الحَافِظُ أَحْمَدُ بنُ الصِّدِّيْقِ الغُمَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُغِيْرِ عَلَى الجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَحَكَمَ بِوَضْعِهِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ: “أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيْقِ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيْهِ مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوْبَ بنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الحَدِيْثِ، وَلِي فِي بَيَانِ وَضْعِهِ جُزْءٌ مُسْتَقِلٌّ” اهـ.
وَمِمَّنْ رَدَّهُ أَيْضًا الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الجَامِعِ الصَّغِيْرِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ: “لَكِنْ هَذَا لَم يَرِدْ فِيْهِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَلَا حَسَنٌ، وَأَسْمَاؤُهُ تَعَالَى تَوْقِيْفِيَّةٌ” اهـ.
وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُ الأَزْهَرِ الشَّيْخُ سَلِيْمٌ البِشْرِيُّ الْمَالِكِيُّ فَتْوَتَيْنِ بِتَحْرِيْمِ الذِّكْرِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِلَفْظِ (أَحْ أَحْ) وَكَذَا بِلَفْظِ (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) بِمَدِّ هَاءِ كَلِمَةِ (إِلهَ)، أَوْ بِلَفْظِ مَنْ يُشْبِعُ هَمْزَةَ (إِله) مَعَ مَدِّهَا فَيَتَوَلَّدُ عَنْهَا يَاءٌ، أَوْ بِلَفْظِ إِثْبَاتِ وَمَدِّ هَمْزَةِ لَفْظِ الجَلَالَةِ فَتَصِيْرُ كَالاسْتِفْهَامِ، حَتَّى إِنَّهُ أَفْتَى بِتَحْرِيْمِ حُضُوْرِ مَجَالِسِهِم وَيَجِبُ تَغْيِيْرُ ذَلِكَ بِاليَدِ لِمَنْ قَدَرَ، فَإِنْ لَم يَقْدِرْ بِاليَدِ فَبِالِّلسَانِ فَإِنْ لَم يَقْدِرْ فَبِالقَلْبِ، فَقَالَ فِي الفَتْوَى الأُوْلَى: “لَا يَكُوْنُ الذِّكْرِ إِلَّا كَمَا وَرَدَ فِي القُرْءَانِ الْمَجِيْدِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّرِيْعَةِ وَالحَقِيْقَةِ لِأَنَّ الحَقِيْقَةَ مَا جَاءَتْ إِلَّا مِنَ الشَّرْعِ، وَأَمَّا (ءَاهٍ) فَلَمْ تَثْبُتْ مِنْ طَرِيْقٍ صَحِيْحٍ أَنَهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى، وَلَم تَضِقْ أَسْمَاءُ اللهِ عَنِ الذِّكْرِ بِهَا حَتَّى يُذْكَرَ بِغَيْرِهَا”.
وَجَاءَ فِي الفَتْوَى الثَّانِيَةِ: “وَكُلُّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَطَقَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَتَارَةً يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُم انْجَذَبُوا فَيَأْكُلُوْنَ بَعْضَ حُرُوْفِ هَذِهِ الكَلِمَةِ وَيُحَرِّفُوْنَهَا، وَرُبَّمَا لَم تَسْمَعْ إِلَّا أَصْوَاتـًا سَاذِجَةً أَوْ شَيْئـًا يُشْبِهُ نَهِيْقَ الحِمَارِ أَوْ هَدِيْرَ الطَّائِرِ، وَيَرْحَمُ اللهُ الأَخْضَرِيَّ حَيْثُ قَالَ فِي مَنْظُوْمَتِهِ فِيْهِم:
وَيَنْبَحُوْنَ النَّبْــحَ كَالكِــــلَابِ
طَرِيْقُـهُم لَيْسَتْ عَلَى الصَّوَابِ
وَلَيْسَ فِيْهِم مِن فَتًى مُطِيْـــعِ
فَلَعْنَـــــــةُ اللهِ عَلَى الجَمِيْـــــعِ
نَعَم، الْمَأْخُوْذُ عَنْ حِسِّهِ الغَائِبُ عَنْ نَفْسِهِ كُلَّ مَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا كَلَامُنَا فِي الَّذِيْنَ يَتَعَمَّدُوْنَ ذَلِكَ وَهُم بِاخْتِيَارِهِم وَلَم يَخْرُجُوا عَنْ حَدِّ التَّكْلِيْفِ، فَهَؤُلَاءِ يُخْشَى عَلَيْهِم مِنْ تَقْطِيْعِ أَسْمَاءِ اللهِ وَتَحْرِيْفِ أَذْكَارِهِ إِنَّهُم يَذْكُرُوْنَهُ وَهِيَ تَلْعَنُهُم عَلَى حَدِّ مَا وَرَدَ: ((رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْءَانِ وَالقُرْءَانُ يَلْعَنُهُ)) أَوْرَدَهُ السُّيُوْطِيُّ فِي الجَامِعِ مَرْفُوْعًا، وَوَقَفَهُ الغَزَالِيُّ عَلَى أَنَسِ بنِ مَالِكٍ فِي الإِحْيَاءِ“ اهـ
ثالِثًا: مخَالَفَتُهُ لِأَقْوَالِ الفُقَهَاءِ
وَأَمَّا مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِم مِنْ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ الفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الأَوْسَطِ أَنَّ الأَنِيْنَ – وَهُوَ قَوْلُ (ءَاهٍ) وَ(أُوْهٍ) وَفِيْهَا لُغَاتٌ كَثِيْرَةٌ – يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمُغِيْرَةَ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.
ثُمَّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا: إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ أَفْسَدَ وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَ العِمْرَانِيُّ فِي البَيَانِ: “فَإِنْ تَنَحْنَحَ أَوْ أَنَّ أَوْ تَنَفَّسَ أَوْ نَفَخَ فَإِنْ تَبَيَّنَ مِنْهُ حَرْفَانِ مِثْلُ أَنْ يَقُوْلَ: (ءَاهٍ) أَوْ (وَاهٍ) أَوْ (أُف) بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ كَلَامًا“، وَقَالَ الْمَقْدِسِيُّ الحَنْبَلِيُّ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الكَبِيْرِ مَا نَصُّهُ: “وَلَم أَرَ عَنْ أَحْمَدَ فِي التَّأَوُّهِ شَيْئًا وَلَا فِي الأَنِيْنِ، وَالأَشْبَهُ بِأُصُوْلِنَا أَنَّهُ مَتَى فَعَلَهُ مُخْتَارًا أَفْسَدَ صَلَاتَهُ“، لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَالحَنَفِيَّةَ قَالُوا: الأَنِيْنُ وَالتَّأَوُّهُ إِنْ كَانَ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ أَوْ خَوْفِ النَّارِ أَوِ العَذَابِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَإِلَّا فَسَدَتْ، كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ بَعْضُ شُرَّاحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ كَالخَرْشِيِّ وَمُحَمَّدٍ عِليش، وَبَعْضُ الحَنَفِيَّةِ كَالشُرُنبُلَالِيِّ وَالطَّحْطَاوِيِّ.
ثُمَّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهَا اليَمِيْنُ وَكَذَا لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ بَعْضِ الجُهَّالِ: (وَاللَّا) بِدُوْنِ هَاءٍ بَلْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ حَرَّفَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى. فَبَعْدَ هَذَا كَيْفَ يَكُوْنُ (ءَاه) اسْمًا للهِ تَعَالَى وَهُوَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ؟! فَإِنَّهُ لَم يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنَ الفُقَهَاءِ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ أَلْفَاظِ الأَنِيْنِ هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، بَلْ قَالَ جَمْعٌ مِنَ السَّلَفِ وَمِنْ فُضَلَاِء أَهْلِ التَّصَوُّفِ الحَقِيْقِيّ، كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ، وَمِنْهُم طَاوُوسٌ وَالفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ وَذُو النُّوْنِ الْمِصْرِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُم أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ: “إنَّ أَنِيْنَ الْمَرِيْضِ وَتَأَوُّهَهُ مَكْرُوْهٌ”، وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُهُم كَالنَّوَوِيِّ بِقَوْلِهِ: اشْتِغَالُهُ بِالذِّكْرِ أَوْلَى، وَهِيَ مَسْئَلَةٌ مَشْهُوْرَةٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَم يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُم إِنَّ (ءَاهٍ) مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى.
رابِعًا: مُخَالَفَتُهُ لِأَقْوَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ
وَمِمَّا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِم مِنْ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ، إِيْرَادُ الحَافِظِ اللُّغَوِيِّ الفَقِيْهِ مُحَمَّدٍ مُرْتَضَى الزَّبِيْدِيِّ فِي شَرْحِ القَامُوْسِ جُمْلَةً مِنْ أَلْفَاظِ الأَنِيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ: “فَهُنَّ اثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ لُغَةً، كُلُّ ذَلِكَ كَلِمَةٌ تُقَالُ عِنْدَ الشِّكَايَةِ أَوِ التَّوَجُّعِ وَالتَّحَزُّنِ” اهـ. وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ لِسَانِ العَرَبِ، وَبِنَحْوِهِ قَالَ الفَيُّوْمِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ.
فهذا يبين لنا أن ذِكر الله يتطلب علمًا، فالجاهل لا يُحسن أن يعبد الله عز وجل، ولذلك أمر الشرع الحنيف المكلفين والمكلفات أن يتعلموا قدرًا من علم الدين قال عنه الفقهاء إنه الفرض العيني من علم الدين، أَيْ عِلْم الدِّينِ الَّذِى يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فِى الْحَالِ. فقد نص الفقهاء من علماء المذاهب الأربعة أنه يوجد قَدْرٌ مِنْ عِلْمِ الدِّينِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مَعْرِفَتُهُ. وَمَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْهُ لاَ يَضْمَنُ صِحَّةَ صَلاَتِهِ وَلاَ صِحَّةَ طَهَارَتِهِ وَلاَ صِحَّةَ صِيَامِهِ وَلاَ صِحَّةَ زَكَاتِهِ. لاَ يَضْمَنُ أَنَّهُ مُتَجَنّـِبٌ بِيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَعَيْنِهِ وَأُذُنِهِ وَلِسَانِهِ وَبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ الْمَعَاصِىَ الَّتِى نَهَى اللهُ عَنْهَا. الإِنْسَـانُ إِذَا أَرَادَ حَقِيقَةً أَنْ يَتَّبِع رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَ بُدَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ عِلْمِ الدِّينِ وَأَنْ يَعْمَلَ بِه.
قال البيهقي: وَالْعِلْمُ إِذَا أُطْلِقَ عِلْمُ الدِّينِ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ أَقْسَامًا: فَمِنْهَا عِلْمُ الْأَصْلِ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْبَارِئِ جَلَّ ثَنَاءهُ، وَمِنْهَا مَعْرِفَةُ مَا جَاءَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَدَخَلَ فِيها عِلْمُ النُّبُوَّةِ، وَمَا تَمَيَّزَ بِهِ النَّبِيُّ عَنِ المتنبي، وَمِنْهَا مَعْرِفَةُ مَا يُطْلَبُ عِلْمُ الْأَحْكَامِ فِيهِ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ نُصُوصُهَا وَمَعَانِيهَا. ونقل عن الشافعي قولَه: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمُ عَامَّةٍ لَا يَسَعُ بَالِغًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ جَهْلُهُ، مِثْلُ أَنَّ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ، وَأَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وَزَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمِ الزِّنَا، وَالْقَتْلَ، وَالسَّرِقَةَ، وَالْخَمْرَ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى هَذَا مِمَّا كُلِّفَ الْعِبَادُ أَنْ يَفْعَلُوهُ وَيَعْلَمُوهُ وَيُعْطُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَأَنْ يَكُفُّوا عَنْهُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، وَهَذَا صِنْفٌ مِنْ عِلْمٍ مَوْجُودٍ نَصًّا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ومَوْجُودٍ عَامًّا عِنْدَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، يَنْقُلُهُ عَوَامُّهُمْ عَمَّنْ مَضَى مِنْ عَوَامِّهِمِ، يَحْكُونَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا يُنَازِعُونَ فِي حِكَايَاتِهِ وَلَا وُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ، فهَذَا الْعِلْمُ الْعَامُّ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْغَلَطُ مِنَ الْخَبَرِ وَلَا التَّأْوِيلُ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ التَّنَازُعُ. اهـ
قال الغزالي في الإحياء: “بَيَانُ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ))“.اهـ
وقال النووي: بَابُ أَقْسَامِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ: هِيَ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ فرض العين وهو تعلم المكلف مالا يَتَأَدَّى الْوَاجِبُ الَّذِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ [فلو أن شخصا لم تجب عليه الزكاة بأن لم يملك المال الذي يجب فيه الزكاة مثلا فلا يأثم إذا لم يتعلم أحكامها، ولو أن شخصا لم يجب عليه الحج بأن كان غير مستطيع فلا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج] فِعْلُهُ إلَّا به ككيفية الوضوء وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهِمَا وَعَلَيْهِ حَمَلَ جَمَاعَاتٌ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: ((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)).
نقل ابن عبد البر عن ابْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ: مَا الَّذِي لَا يَسَعُ الْمُؤْمِنَ مِنْ تَعْلِيمِ الْعِلْمِ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ؟ وَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ؟ قَالَ: “لَا يَسَعُهُ أَنْ يَقْدَمَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بِعِلْمٍ وَلَا يَسَعُهُ حَتَّى يَسْأَلَ”.
ويشترط للثواب في ذكر الله عز وجل كذلك الإِخلاص وحسن النيّات فهي تشترط في جميع الأعمال الظاهرات والخفيَّات لتحصيل الثواب والأجر، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [سورة البينة، الآية 5]، وقال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [سورة الحج، الآية 37] قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه ولكن يناله النيّات. وقد قال رسول الله ﷺ: ((إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلّ امرىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها أَوِ امْرأةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَتُه إلى ما هَاجَرَ إلَيْهِ)). هذا حديث متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدارُ الإِسلام؛ وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يَستحبُّون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، تنبيهًا للمُطالع على حسن النيّة، واهتمامه بذلك والاعتناء به.
روي عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: من أراد أن يُصنِّفَ كتابًا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان الخَطَّابي رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبُّون تقديم حديث الأعمال بالنيّة أمامَ كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يُحْفَظ الرجلُ على قدر نيّته. وقال غيرُه: إنما يُعطى الناسُ على قدر نيّاتهم.
وروي عن السيد الجليل أبي عليّ الفُضيل بن عِياض رضي الله عنه قال: تركُ العمل لأجل الناس رياءٌ، والعمل لأجل الناس رياء، والإِخلاصُ أن يعافيَك الله منهما. وقال الإمام الحارث المحاسبيُّ رحمه الله: الصادق هو الذي لا يُبالي لو خرج كلُّ قَدْرٍ له في قلوب الخلق من أجل صَلاح قلبه، ولا يحبُّ اطّلاع الناس على مثاقيل الذرِّ من حسن عمله ولا يكرهُ أن يطَّلعَ الناسُ على السيء من عمله.
وعن حُذيفة المَرْعشيِّ رحمه الله قال: الإِخلاصُ أن تستوي أفعالُ العبد في الظاهر والباطن.
وروي عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القُشَيريّ رحمه الله قال: الإِخلاصُ إفرادُ الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يُريد بطاعته التقرّب إلى الله تعالى دون شيء آخر: من تَصنعٍ لمخلوق، أو اكتساب محمَدةٍ عند الناس، أو محبّة مدحٍ من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرّب إلى الله تعالى.
وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التُستَريُّ رضي الله عنه: نظر الأكياسُ في تفسير الإِخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن يكون حركتُه وسكونه في سرِّه وعلانيته لله تعالى، ولا يُمازجه نَفسٌ ولا هوىً ولا دنيا.
وروي عن الأستاذ أبي علي الدقاق رضي الله عنه قال: الإِخلاصُ: التوقِّي عن ملاحظة الخلق، والصدق: التنقِّي عن مطاوعة النفس. فالمخلصُ لا رياء له، والصادقُ لا إعجابَ له.
وعن ذي النون المصري رحمه الله قال: ثلاثٌ من علامات الإِخلاص: استواءُ المدح والذمّ من العامَّة، ونسيانُ رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاءُ ثواب العمل في الآخرة.
وروي عن القُشَيريِّ رحمه الله قال: أقلُّ الصدق استواءُ السرّ والعلانية. وعن سهل التستري: لا يشمّ رائحة الصدق عبدٌ داهن نفسه أو غيره.اهـ
فالنية الصالحة لها اعتبار في الشرع ولها منزلة في دين الله فإذا فسدت بأن كان صاحبها مرائيا حبط ثواب عمله وكان عليه ذنب من الكبائر والعياذ بالله تعالى.
فقدْ أمركَ ربُّكَ بإخلاصِ العبادةِ لهُ فِي كلِّ أحوالِكَ فقدْ قالَ تعالَى فِي سورةِ البينةِ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [سورة البينة، الآية 5]، أخلصْ نيَّتَكَ دائمًا للهِ تعالَى ولَا تُراءِ، واسمعْ معيَ الحديثَ الذي رواهُ الترمذيُّ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ قالَ: ((إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يومَ القيامةِ ليومٍ لا رَيْبَ فيهِ نادَى منادٍ: مَنْ كانَ أشركَ في عملٍ عَمِلَهُ للهِ أحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عندِ غيرِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكاءِ عَنِ الشِّرْكِ))، والمرادُ بالشركِ هنَا الرياءُ؛ وهوَ أنْ يعملَ العملَ الصالحَ طلبًا لمحمدةِ الناسِ فهذَا لَا يكونُ لهُ ثوابٌ وعليهِ ذنبٌ كبيرٌ هوَ الرياءُ الذِي سمَّاهُ النبيُّ ﷺ لِعِظَمِهِ الشِركَ الأصغرَ مَعَ كونِهِ لَا يُخرجُ مِنَ الإسلامِ، وهوَ المرادُ بقولِهِ تعالَى فِي سورةِ الكهفِ: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [سورة الكهف، الآية 110] والإخلاصُ يحصلُ بأنْ ينويَ العبدُ بعملِهِ الصالحِ الثوابَ مِنَ اللهِ، لَا يفعلُهُ حتَّى يُقالَ عنهُ فلانٌ كذَا، وليُعْلَمْ أنَّ الإخلاصَ فِي العملِ شىءٌ لَا يَحصلُ لكثيرٍ مِنَ الناسِ وذلكَ لأنَّ هذَا شىءٌ مُتعلِقٌ بالقلبِ والقلبُ سريعُ التَّقَلُّبِ، فلذَلكَ يَجْدُرُ للواحِدِ مِنَّا أنْ يُراقِبَ تقلُبَ قلبِهُ حتَّى يُخْلِصَ فِي أعمالِهِ الصالحةِ كُلِّها حتَّى يكونَ ناجيًا فِي الآخرةِ وإلَّا إِنْ لَمْ يفعلْ ذلكَ فَتَرَكَ نَفْسَهُ عَلَى هواهَا فإنَّ النفسَ تُورِدُهُ المهالِكَ، الله يُنجِّينَا مِنْ ذلكَ.
وقد جاء في التحذير من شؤمِ الرياءِ ما قالَ رسولُ اللهِﷺ فيمَا رواهُ مسلمٌ: ((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بهِ، ومَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ)) ومعنَى قولِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ((سَمَّعَ)) أيْ فَعَلَ الفعلَ رِياءً وَطلبًا للثناءِ والمدحِ، ((سَمَّعَ اللهُ بهِ)) معناهُ فَضَحَهُ يومَ القيامةِ، وهذَا ِمنْ جملةِ العذابِ يومَ القيامةِ وهوَ الفضيحةُ أمامَ الخلائقِ نسألُ اللهَ السلامةَ، وقولُه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((مَنْ رَاءَى)) معناهُ مَنْ أَظْهَرَ للنَّاسِ العَمَلَ الصَّالِحَ الذِي يَعْمَلُهُ ليَعْظُمَ عندَهم ولِيَنَالَ مَدْحَهُمْ، ((رَاءَى اللهُ بِهِ)) معناهُ فَضَحَهُ وهذَا مِنْ شؤمِ الرياءِ والعياذُ باللهِ تعالى.
وقد جاءَ عنْ بعضِ التابعيَن أنَّهُ قالَ: ((كلُّ مَا لَا يُبْتَغَى بهِ وجهُ اللهِ يَضْمَحِلُّ))، أيْ أنَّ المخلصَ هوَ الذِي يباركُ اللهُ لهُ أعمالَهُ ويحصلُ لهُ نِتَاجٌ حسنٌ فِي فعلِ الخيرِ كمَا يُرْوَى عنِ الإمامِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قالَ لهُ أحدُهُمْ وقدْ صَنَّفَ الموطأَ مَا الفائدةُ مِنْ تَصْنِيْفِكَ وقدْ صَنَّفَ غيرُكَ مَا هوَ أكبرُ منهُ فقالَ: مَا كَانَ للهِ بَقِيَ.اهـ
وهَا هوَ بعضُ تلامِذَةِ الإمامِ الشافعيِّ يدخلُ عليهِ وهوَ مريضٌ فيقولُ لهُ الشافعيُّ: بِوُدِّيْ أنَّ جميعَ الخلقِ تَعَلَّمُوا هذَا الكتابَ يعني كِتابَهُ عَلَى أنْ لَا يُنْسَبَ إِلَيَّ منهُ شيءٌ.اهـ
والمعنَى أنَا أهتمُّ أنْ يصلَ هذَا العلمُ للناسِ وليسَ شرطًا أنْ يعلمُوا أنَّنِي أنَا الذِي أَلَّفْتُهُ ونَقَلْتُهُ لَهُمْ، ومَا هذَا إلَّا مِنْ شدةِ إخلاصِهِ رضيَ اللهُ عنهُ فقدْ قالَ بعضُ السلفِ: مَا أخلصَ العبدُ للهِ إلَّا أحبَّ أنْ يكونَ فِي جُبٍّ لَا يُعْرَفُ.اهـ معناهُ أنَّ المخلصَ لَا يحبُّ أنْ يُعْرَفَ بينَ الناسِ بلْ أنْ يعملَ بخفاءٍ كالذِي يكونُ فِي الجُبِّ أيِ البئرِ، ولَا يَظْهَرَ، ولَا يَهُمُّهُ أنْ مَدَحَهُ الناسُ أوْ ذَمُّوهُ، وهنَا تَرَى بَرَكَةَ العملِ فقدْ قالَ الإمامُ أحمدُ الرفاعيُّ رحمَهُ اللهُ: خُذُوْا نَتَائِجَ الأعمَالِ بخالِصِ النِّيَّاتِ.اهـ
فلذلكَ نَرَى أنَّ مذاهِبَ الأئمةِ الأربعةِ رضيَ اللهُ عنهُمُ انتَشَرَتْ أكثرَ مِنْ غيرِهِمْ ونَفَعَ اللهُ بِهِمُ المسلمينَ إلَى يومِنَا هذَا.
وينبغي العمل بالأحاديث التي وردت في الأذكار ولو لم تكن من درجة الصحيح في الحديث، قال النووي: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرّة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقًا بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي ﷺ في الحديث المتفق على صحته: ((إذَا أَمَرْتُكُمْ بَشَيءٍ فأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطعْتُمْ)). فإن العلماء يأخذون بالحديث الضعيف إذا جاء في السيرة وفضائل الأعمال، لأنها مواضيعُ لا تتعلق بالحلال والحرام.
ويقبل العلماء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإنه لا يضر. وقد ذكر النووي في كتابه الأذكار أن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال بالإجماع، ونصّ كلامه:
قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا وردَ حديثٌ ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحبَّ أن يتنزّه عنه ولكن لا يجب.اهـ
وليعلم أن علماء السيرة كانوا يتساهلون في الرواية عندما يكون الكلام عن السير والمغازي والأيام وفضائل الأعمال، فلا يُطلب هنا هل هذا صحيح أم غير صحيح؛ لأن موضوع السيرة ليس موضوعا لاستنباط الأحكام وما كان يستنبط منه الأحكام مما مرده إلى السيرة فإنه يروى في كتب السنة، فإننا نجد في الصحيحين والسنن كتاب المغازي والسير والمناقب وبدء الخلق وغيرها، وهذه كلها من السيرة لكنها لما كانت موضعا لاستنباط الأحكام رويت عند أهل الحديث فذلك موضع لاستنباط الأحكام، ولم يكن العلماء يجلسون فيبسطون أمامهم كتاب الله وسنن الرسول وكتب السيرة ليستنبطوا منها الأحكام، وهذا كان دأبَ الناس في التعامل مع المرويات في السير، الإمام أحمد رضي الله عنه ينقل عنه السخاوي في شرحه لألفية العراقي قولَه: ابن إسحاق (وهو كان من أشهر من روى السيرة النبوية) رجل تؤخذ عنه هذه الأحاديث (أي في السيرة مع ضعفها) ـ ومعلوم عندهم أن ابن إسحاق رجل مدلس والمدلس لا تقبل روايته إذا لم يصرح بالتحديث ـ ، لكن الإمام أحمد لم يكن يتشدد في ابن إسحاق إذا كان الكلام عن المغازي والسير، يقول أحمد: ابن إسحاق رجل تؤخذ عنه هذه الأحاديث فإذا أخذنا في الحلال والحرام طلبنا رجالا هكذا وقبض أصابع يديه.اهـ
قال الحافظ زين الدين العراقي عندما جاء ينظم في السيرة:
وليعلمِ الطالــــــــبُ أنَّ السيرا
تَجمعُ ما صحَّ وما قد أُنكرا
والقصدُ ذكرُ ما أتى أهلُ السيرْ
بـــهِ وإنْ إسنـــــادهُ لمْ يُعتبرْ
ولا يجوز العمل بالحديث الموضوع ولو في فضائل الأعمال، فالكلام في تسهيل الرواية هي في الحديث الضعيف أما الحديث الموضوع فلا يقبل في أي محل ولا يروى إلا مع بيان حاله، أما الضعيف له تعامل غير تعامل الموضوع. هذا المنقول عن أحمد وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وغيرهم من رؤوس السلف الصالح.
فلا يُعْتَرَضُ على من يروي في السير وفضائل الأعمال ويقال لهم هذا إسناده ضعيف وهذا ضعّفه فلان وفلان لأن الكلام هنا في السير وفضائل الأعمال كما ثبت عن الأئمة. وهذا طريقهم في رواية السيرة والفضائل فمما يروى فيها منه ما هو صحيح وما يروى فيها منه ما هو ضعيف ولكنه يروى ويقبل عندهم، وهم الذين بلغوا رتبة في الورع والفهم مما لم يبلغه أكثر أهل عصرنا هذا.
نسأل الله حسن الاقتداء بهم رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا كل خير.
وكذلك يُستحبُّ الذكر ويُستحبُّ الجلوس في حِلَق أهله، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، ويكفي في ذلك حديث النووي في الأذكارابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا مَرَرْتُمْ بِرِياضِ الجَنَّةِ فارْتَعُوا)). قالُوا: وَمَا رِياضُ الجَنَّةِ يا رَسُولَ الله؟! قالَ: ((حِلَقُ الذّكْرِ، فإنَّ لله تعالى سَيَّارَاتٍ مِنَ المَلائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذّكْرِ، فإذَا أَتَوْا عَليْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ)).
وروي في صحيح مسلم عن معاوية أنه قال: خرج رسول الله ﷺ على حلقة من أصحابه فقال: ((ما أجْلَسَكُم))؟ قالوا: جلسنا نذكُر الله تعالى ونحمَدُه على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا، قال: ((آلله ما أجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ))؟ قالوا: واللَّهِ، ما أجلسنا إلاّ ذاك، قال: ((أما إني لَمْ أستحلِفكُمْ تُهمةً لكُمْ، ولَكنَّهُ أتاني جبْرِيلُ فأخْبَرَنِي أنَّ الله تعالى يُباهي بكُمُ المَلائكَةَ)).
وروي في صحيح مسلم أيضًا، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: أنهما شهدا على رسول الله ﷺ أنه قال: ((لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُون الله تَعالى إلا حَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَليهِمْ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعالى فِيمَنْ عِنْدَهُ)).
وكذلك من المسائل التي نتناولها قبل الشروع في شرح هذا الكتاب المبارك، ما قاله بعض الفقهاء من أنّ: الذكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، والأفضلُ منه ما كانَ بالقلب واللسان جميعًا، فإن اقتصرَ على أحدهما فالقلبُ أفضل، ثم لا ينبغي أن يُتركَ الذكرُ باللسان مع القلب خوفًا من أن يُظنَّ به الرياء، بل يذكرُ بهما جميعًا ويُقصدُ به وجهُ الله تعالى، وقد قال الفُضَيل رحمه الله: أن ترك العمل لأجل الناس رياء. ولو فتح الإنسانُ عليه بابَ ملاحظة الناس، والاحتراز من تطرّق ظنونهم الباطلة لانسدَّ عليه أكثرُ أبواب الخير، وضيَّع على نفسه شيئًا عظيمًا من مهمَّات الدين، وليس هذا طريق العارفين. وروي في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [سورة الإسراء، الآية 110] أي في الدعاء.
وقال بعض الفقهاء كذلك: اعلم أن فضيلة الذكر غيرُ منحصرةٍ في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كلُّ عاملٍ لله تعالى بطاعةٍ فهو ذاكرٌ لله تعالى، كذا قاله سعيدُ بن جُبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: مجالسُ الذِّكر هي مجالسُ الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيعُ وتصلّي وتصومُ وتنكحُ وتطلّق وتحجّ، وأشباه هذا.
قال النووي: أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله ﷺ والدعاء وغير ذلك. ولكنَّ قراءة القرآن حرامٌ على الجُنب والحائض والنفساء، سواءٌ قرأ قليلًا أو كثيرًا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراءُ القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النَّظَرُ في المصحف، وإمرارُه على القلب. قال أصحابُنا: ويجوز للجُنب والحائض أن يقولا عند المصيبة: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [سورة البقرة، الآية 156]، وعند ركوب الدابة: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [سورة الزخرف، الآية 13]، وعند الدعاء: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [سورة البقرة، الآية 201]، إذا لم يقصدا به القرآن، ولهما أن يقولا: بسم الله، والحمد لله، إذا لم يقصدا القرآن، سواءٌ قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن، ويجوزُ لهما قراءةُ ما نُسخت تلاوتُه كـ”الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما”.
وقال بعض الفقهاء: ينبغي أن يكون الذاكرُ على أكمل الصفات، فإن كان جالسًا في موضع استقبل القبلة وجلس مُتذلِّلًا مُتخشعًا بسكينة ووقار، مُطرقًا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركًا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [سورة آل عمران، الآية 190-191].
وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسولُ الله ﷺ يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن)) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ((ورأسه في حجري وأنا حائض)). وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضًا قالت: ((إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعةٌ على السرير)).اهـ
وينبغي أن يكون الموضعُ الذي يذكرُ فيه خاليًا نظيفًا، فإنه أعظمُ في احترام الذكر المذكور، ولهذا مُدح الذكرُ في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يُذكر الله تعالى إلّا في مكان طيّب. وينبغي أيضًا أن يكون فمه نظيفًا، فإن كان فيه تغيُّر أزاله بالسِّواك، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، فلو ذكر ولم يغسلها فلا يَحرمُ.
وقال النووي: اعلم أن الذكر محبوبٌ في جميع الأحوال إلا في أحوال وردَ الشرعُ باستثنائها: فمن ذلك أنه يُكره الذكرُ حالةَ الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجِماع، وفي حالة الخُطبة لمن يسمعُ صوتَ الخطيب، وفي القيام في الصلاة، بل يشتغلُ بالقراءة، وفي حالة النعاس. ولا يُكره في الطريق ولا في الحمَّام، والله أعلم.
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ كان يذكر الله في كل أحيانه، وهذا فيه ردٌّ على من يحرم ذكر الله في الجنائز ويزعم أنه بدعة محرمة والعياذ بالله تعالى. هل تعلم بأن بعض الجماعات التكفيريين يحرمون قول: (وحدوا الله) أي قولوا لا إله إلا الله، خلف الجنائز، الشخص الذي يُذَكِّر الناسَ أن يقولوا لا إله الا الله خلف الجنازة يعتبره هؤلاء أنه وقع في معصية الله وأنه يستحق العذاب والعياذ بالله تعالى، مع أن النبي ﷺ يقول فيما رواه الطبراني: ((أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله الا الله)).
وقال بعض الفقهاء أيضا: المرادُ من الذكر حضورُ القلب، فينبغي أن يكون هو مقصودَ الذاكر فيحرص على تحصيله، ويتدبر ما يذكر، ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوبٌ كما هو مطلوبٌ في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود.
وينبغي كذلك لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ عليه تضييعها في وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شيءٍ مِنْهُ فقرأهُ ما بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصلاة الظُّهْرِ كُتب له كأنما قرأه من اللَّيل)).
وإذا عَرَضَت أحوال للذاكر قطعَ الذكر بسببها ثم يعودُ إليه بعد زوالها: منها إذا سُلِّم عليه أحدٌ ردّ السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطسَ عنده عاطشٌ شمَّته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيبَ، وكذا إذا سمع المؤذّنَ أجابَه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا رأى منكرًا أزاله، أو معروفًا أرشد إليه، أو مسترشدًا أجابه ثم عاد إلى الذكر، كذا إذا غلبه النعاس أو نحوه. وما أشبه هذا كله.
وعند الشافعية يوجد مسألة ذكرها النووي وغيره حيث قال: اعلم أن الأذكار المشروعة الواجبة في الصلاة لا يُحسبُ شيءٌ منها ولا يُعتدّ به حتى يتلفَّظَ به بحيثُ يُسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له.
وكذلك في آخر ما نذكره قبل البدء بشرح الكتاب هو الرد على من منع من المبتدعة التسبيح وسائر الأذكار بالسبحة، قال بعض أهل السنة في باب جواز عقد التسبيح باليد وكذلك عدّه بنوى التمر مثلًا ونحوه أنه عن بسيرة وكانت من المهاجرات رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: ((عَليْكُنَّ بالتَّهْلِيْلِ والتَّسْبِيْحِ والتَّقْدِيْسِ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ وَاعْقُدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ))، رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ((أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِيْ السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِيْ الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إلهَ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ)، رواه أبو داودوالترمذي.
وعن صفية قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها، فقال: ((لقد سبحت بهذا ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به))؟ فقالت: علمني، فقال: ((قولي سبحان الله عدد خلقه)) رواه الترمذي.
وأما الحديث الأول فأخرجه أيضا الحاكم، وقد صحح السيوطي إسناد هذا الحديث. وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وحسنه الترمذي. وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضا الحاكم وصححه السيوطي. والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح، والحديثان الآخران يدلان على جوازعد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره ﷺ للمرأتين على ذلك.
وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز، وقد وردت بذلك آثار ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن أبي صفية مولى النبي ﷺ أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسي.
وأخرجه الإمام أحمد في الزهد قال: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت: ((رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي ﷺ وكان خازنا قالت: فكان يسبح بالحصى)).
وأخرج ابن سعد ((أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى))، وقال ابن سعد في الطبقات: عن جابرعن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ((أنها كانت تسبح بخيط معقود فيه)). وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد ((عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح)).
وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: ((كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن)).
وأخرج ابن سعد عن ((أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع)).
وأخرج الديلمي عن أم الحسن بنت جعفرعن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ((نِعمَ المُذكر السبحة)) أي أنها تذكر بذكر الله تعالى. وقد ساق السيوطي آثاراً في الجزء الذي سماه (المنحة في السبحة) قال في آخره: “ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عدّ الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدّونه بها ولا يرون ذلك مكروهًا”.
والله تعالى أعلم وأحكم
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة