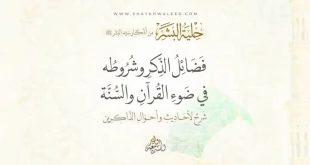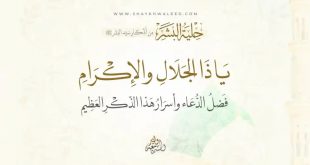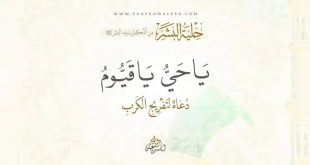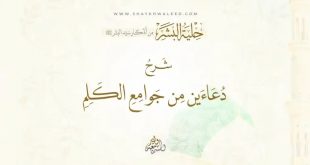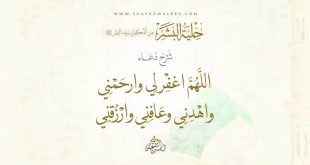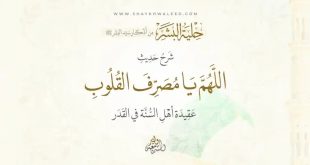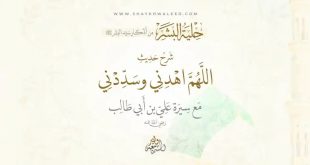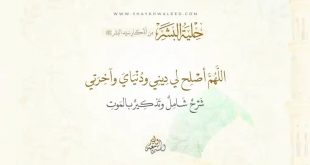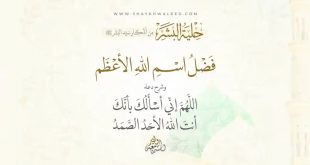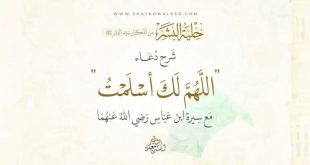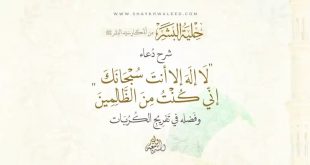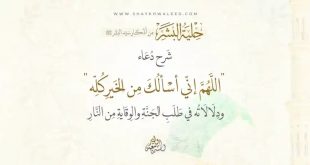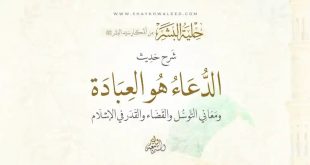المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ للَّهِ الْعَلِيِّ الْقَوِيِّ الْمَتِينِ، الْقَاهِرِ الظَّاهِرِ الْمُبِينِ، لا يَعْزُبُ عَنْ سَمْعِهِ أَقَلُّ الأَنِينِ، وَلا يَخْفَى عَلَى بَصَرِهِ حَرَكَاتُ الْجَنِينِ، ذَلَّ لِكِبْرِيَائِهِ جَبَابِرَةُ السَّلاطِينِ، وَقَلَّ عِنْدَ دِفَاعِهِ كَيْدُ الشَّيَاطِينِ، قَضَى قَضَاءَهُ كَمَا شَاءَ عَلَى الْخَاطِئِينَ، فَهُؤَلاءِ أَهْلُ الشِّمَالِ وَهَؤُلاءِ أَهْلُ الْيَمِينِ، جَرَى الْقَدَرُ بِذَلِكَ قَبْلَ عَمَلِ الْعَامِلِينَ، أَحْمَدُهُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ، وَأَسْأَلُهُ مَعُونَةَ الصَّابِرِينَ،
وَأُصَلِّي على رسوله المُقدّم على النبيين، وَعَلَى صَاحِبِهِ الصِّدِّيقِ أَوَّلِ تَابِعٍ لَهُ عَلَى الدِّينِ، وَعَلَى الْفَارُوقِ عُمَرَ الْقَوِيِّ الأَمِينِ، وَعَلَى عُثْمَانَ زَوْجِ ابْنَتِهِ وَنِعْمَ الْقَرِينُ، وَعَلَى عَلِيٍّ بَحْرِ الْعُلُومِ صهر النّبي وزوج الزهراء وإنّه لمن المتّقين البارِّين، وَعَلَى عَمِّهِ الْعَبَّاسِ ذِي الْفَخْرِ الْقَوِيمِ وَالنَّسَبِ الصَّمِيمِ، أما بعد:
الحديث
وَرَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِى أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ)).
الشرح والتعليق على هذا الحديث
وَرَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ راوي الحديث هو الصحابي الجليل: عَبْدُ اللهِ بنُ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمِ بنِ حَضَّارِ بنِ حَرْبٍ، الإِمَامُ الكَبِيْرُ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَبُو مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ، الفَقِيْهُ، المُقْرِئُ.
أُمُّهُ ظَبْيَةُ بِنْتُ وَهْبٍ، كَانَتْ أَسْلَمَتْ، وَمَاتَتْ بِالمَدِيْنَةِ. وينسب إلى الجُماهر بن الأشعر، والأشعر من أولاد سبأ الذين كانوا باليمن، وسمّي بذلك لأنّه وُلد وعليه الشعر،
وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: أَسْلَمَ أَبُو مُوْسَى بِمَكَّةَ، وَهَاجَرَ إِلَى الحَبَشَةِ، وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ خَيْبَرُ. وَهُوَ مَعْدُوْدٌ فِيْمَنْ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ورافق النَّبِيَّ ﷺ وَحَمَلَ عَنْهُ عِلْمًا كَثِيْرًا. وَوَلِيَ إِمْرَةَ الكُوْفَةِ لِعُمَرَ، وَإِمْرَةَ البَصْرَةِ، وأَقْرَأَ أَهْلَ البَصْرَةِ، وَفَقَّهَهُمْ فِي الدِّيْنِ. وَهُوَ فَتَحَ مدينة تُسْتَرَ – في جنوب إيران -، وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ أَحَدٌ أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ.
وفِي الصَّحِيْحَيْنِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيْمًا)).
وعَنْ أَنَسٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ، هُمْ أَرَقُّ قُلُوْبًا لِلإِسْلاَمِ مِنْكُمْ)). فَقَدِمَ الأَشْعَرِيُّوْنَ، فَلَمَّا دَنَوْا، جَعَلُوا يَرْتَجِزُوْنَ:
غَدًا نَلْقَـــــــى الأَحِبَّهْ
مُحَمَــــــّدًا وَحِـــــزْبَهْ
فَلَمَّا أَنْ قَدِمُوا، تَصَافَحُوا. فَكَانُوا هم أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ المُصَافَحَةَ. رواه الإمام أحمد في مسنده.
وأخرج الحافظ ابن عساكر فى تبيين كذب المفترى والحاكم فى المستدرك لَمَا نَزَلَتْ: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [سورة المائدة/ الآية 54]؛ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((هُمْ قَوْمُكَ يَا أَبَا مُوْسَى))، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
قال القشيري: فأتباع أبي الحسن الأشعري من قومه؛ لأنّ كلّ موضع أُضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع، قاله القرطبي فى تفسيره.
وقال البيهقى: وذلك لما وُجِدَ فيه من الفضيلة الجليلة والمرتبة الشريفة للإمام أبى الحسن الأشعرى رضى الله عنه فهو من قوم أبى موسى وأولاده الذين أوتوا العلم ورزقوا الفهم مخصوصًا من بينهم بتقوية السنة وقمع البدعة بإظهار الحجة ورد الشبهة. ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري.
وفي شرح السنة للبغوي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ قَائِمٌ، وَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَالَ لِي: ((يَا بُرَيْدَةَ، أَتَرَاهُ يُرَائِي))؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ مُنِيْبٌ، لَقَدْ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ)). فَأَتَيْتُهُ، فَإِذَا هُوَ أَبُو مُوْسَى؛ فَأَخْبَرْتُهُ.
وقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)) رواه البخاري في باب حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ.
قال العلماء: المراد بالمزمار هنا: الصَّوت الحسن. وأصل الزَّمر: الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق عَلَى نفسه، وكان داود ﷺ حسن الصَّوت جدًّا.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يُؤْخَذُ العِلْمُ عَنْ سِتَّةٍ: عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ، وَزَيْدٍ، يُشْبِهُ عِلْمُهُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَكَانَ عَلِيٌّ، وَأُبَيٌّ، وَأَبُو مُوْسَى يُشْبِهُ عِلْمُهُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا، يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
رحم الله أبا موسى الأشعري، لقَدْ كَانَ صَوَّامًا، قَوَّامًا، زَاهِدًا، عَابِدًا، مِمَّنْ جَمَعَ العِلْمَ وَالعَمَلَ وَسَلاَمَةَ الصَّدْرِ، لَمْ تُغَيِّرْهُ الإِمَارَةُ، وَلاَ اغْتَرَّ بِالدُّنْيَا. مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ.
روي له عن رسول الله ﷺ ثلاثمائة وستون حديثًا اتفقا منها على تسعة وأربعين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة عشر.
ومن نسل أبي موسى الأشعري كان إمام أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، الذي جمع هو والماتريدي عقائد أهل السنة وأثبتها بالعقل والنقل حتى برعا وصارا إمامين مقدمين ينهل من علمهما كل من جاء بعدهما من علماء المسلمين، حتى صار أهل السنة يقال عنهم أشاعرة وماتريدية كما قال الزبيدي وغيره، وقال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: “واعلم أن أبا الحسن الأشعري لم ينشء مذهبًا، إنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله، فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنّه عقد على طريق السلف نطاقًا وتمسّك به وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدي به في ذلك، السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريًا”. اهـ
وقد أفرد الإمام حافظ الشام ابن عساكر الدمشقي مؤلفا للدفاع عن أبي الحسن الأشعري سماه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري.أما الشيخ محمد العربي التبان شيخ المالكية في الحرم المكي فيقول: “فحول المحدثين من بعد أبي الحسن إلى عصرنا هذا أشاعرة وكتب التاريخ والطبقات ناطقة بذلك”. اهـ
وكان الخُلفاء والسلاطين على مذهبِ أهلِ السنة ومنهُم السلطان صلاح الدين الأيوبي المتوفى سنة تسعين وخمسمائة من تاريخ الهجرة النبوية كان رضي اللهُ عنهُ سُلطانًا عادلًا وكانَ حافظًا للقُرءان و كانَ حافظًا لِكِتاب التنبيه في فقهِ المذهبِ الشّافعي وكان حافظًا كِتاب الحماسة تَلقى العلم من أهلِ المعرفةِ وكانَ يحضُر مَجالس المُحدثين على العادة القديمة عند عُلماء الحديث وكانَ رضي اللهُ عنهُ أشعري العقيدة.
واعلم أيها المطالعُ أنّ الإمام أحمد روى حديث: ((لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ)) وهذا الأمير هو السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه الذي فتح القسطنطينية وكان ماتريديًا فيكونُ معنى الحديث أنّ الرسول يثني على الماتريدية وعلى إمامهم أبي منصور فمن طعن فيهم يكون معارضًا للرسول ومن يعارض الرسول إلا الضّال، واعلم أن الماتريدية والأشاعرة شيء واحد.
ومن جملة اعتقاد الأشعري الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة:
اعلم أرشدَنا الله وإياكَ أنه يجبُ على كلّ مكلَّف أن يعلمَ أن الله عزَّ وجـلَّ واحـدٌ في مُلكِه، خلقَ العالمَ بأسرِهِ العلويَّ والسفليَّ والعرشَ والكرسيَّ، والسَّمواتِ والأرضَ وما فيهما وما بينهما، جميعُ الخلائقِ مقهورونَ بقدرَتِهِ، لا تتحركُ ذرةٌ إلا بإذنِهِ، ليسَ معهُ مُدبّرٌ في الخَلقِ ولا شريكٌ في المُلكِ، حيٌّ قيومٌ لا تأخذُهُ سِنةٌ ولا نومٌ، عالمُ الغيب والشهادةِ، لا يَخفى عليهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ، يعلمُ ما في البرّ والبحرِ وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمُهَا، ولا حبةٍ في ظلماتِ الأرضِ ولا رَطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبين.
ومنها: موجـودٌ قبل الخلقِ، ليس له قبلٌ ولا بعدٌ، ولا فوقٌ ولا تحتٌ، ولا يَمينٌ ولا شمالٌ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ، ولا كلٌّ، ولا بعضٌ، ولا يقالُ متى كانَ ولا أينَ كانَ ولا كيفَ، كان ولا مكان، كوَّنَ الأكوانَ ودبَّر الزمانَ، لا يتقيَّدُ بالزمانِ ولا يتخصَّصُ بالمكان، ولا يشغلُهُ شأنٌ عن شأن، ولا يلحقُهُ وهمٌ، ولا يكتَنِفُهُ عقلٌ، ولا يتخصَّصُ بالذهنِ، ولا يتمثلُ في النفسِ، ولا يتصورُ في الوهمِ، ولا يتكيَّفُ في العقلِ، لا تلحقُهُ الأوهـامُ والأفكارُ، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة الشورى/ الآية 11].اهـ
عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ليعلمنا وليس لأنه يقع فيه، فهو أثبت الناس قلبًا على دين الله عز وجل، وأبعد الناس عن أن يُفتَن، فهو معصوم عن الكفر والكبائر وصغائر الذنوب التي فيها خسة ودناءة نفس قبل النبوة وبعدها: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي أَيْ سَيِّئَتِي وَجَهْلِي أَيْ فِيمَا يَجِبُ عَلَيَّ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ وَإِسْرَافِي أَيْ تَقْصِيرِي وَتَجَاوُزِي عَنْ حَدِّي فِي أَمْرِي قال ملا علي القاري: الْخَطِيئَةُ الذَّنْبُ، وَيَجُوزُ تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ فَيُقَالُ: خَطِّيَّةٌ بِالتَّشْدِيدِ، وَالْجَهْلُ ضِدُّ الْعِلْمِ، وَالْإِسْرَافُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ فِي أَمْرِي أَنْ يَتَعَلَّقَ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ وَاعْتِرَافٌ بِإِحَاطَةِ عِلْمِهِ تَعَالَى وَإِقْرَارُهُ بِعَجْزِهِ عَنْ مَعْرِفَةِ نَفْسِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي هُوَ نَقِيضُ الْهَزْلِ وَهَزْلِي وَهُوَ الْمِزَاحُ أَيْ مَا وَقَعَ مِنِّي فِي الْحَالَيْنِ، أَوْ هُوَ التَّكَلُّمُ بِالسُّخْرِيَةِ وَالْبُطْلَانِ وَخَطَئِي مِمَّا يَقَعُ فِيهِ تَقْصِيرٌ مِنِّي، فِي الصِّحَاحِ الْخَطَأُ نَقِيضُ الصَّوَابِ وَقَدْ يُمَدُّ وَالْخَطَأُ الذَّنْبُ وَعَمْدِي أَيْ وَتَعَمُّدِي فِي ذَنْبِي وَكُلُّ ذَلِكَ أَيْ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْعُيُوبِ عِنْدِي قال القسطلاني: موجود أو ممكن كالتذييل للسابق أي أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها لي، قاله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متواضعًا وهضمًا لنفسه أو عد فوات الكمال وترك الأولى ذنوبًا أو أراد ما كان عن سهو أو ما كان قبل النبوة اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ أَيْ مِنَ الذُّنُوبِ أَوْ مِنْ التَّقْصِيرِ فِي الْعَمَلِ وَمَا أَخَّرْتُ أَيْ وَمَا يَقَعُ مِنِّي بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ، وَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْمَاضِي لِأَنَّ الْمُتَوَقَّعَ كَالْمُتَحَقَّقِ أَوْ مَعْنَاهُ مَا تَرَكْتُ مِنَ الْعَمَلِ، أَوْ قُلْتُ سَأَفْعَلُ أَوْ سَوْفَ أَتْرُكُ وَمَا أَسْرَرْتُ أَيْ أَخْفَيْتُ مِنَ الذُّنُوبِ وَمَا أَعْلَنْتُ أَيْ أَظْهَرْتُ مِنَ الْعُيُوبِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي.
قال العيني: وَإِنَّمَا كَانَ يسْتَغْفر هَذَا الْمِقْدَار مَعَ أَنه مَعْصُوم ومغفور لَهُ لِأَن الاسْتِغْفَار عبَادَة، أَو هُوَ تَعْلِيم لأمته، أَو اسْتِغْفَار من ترك الأولى أَو قَالَه تواضعاً. وَقيل: كَانَ دَائِما فِي الترقي فِي الْأَحْوَال فَإِذا رأى مَا قبلهَا دونه اسْتغْفر مِنْهُ، وَقيل: يَتَجَدَّد للطبع غفلات تفْتَقر إِلَى الاسْتِغْفَار.
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: هفوات الطباع البشرية لَا يسلم مِنْهَا أحد، والأنبياء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام وَإِن عُصموا من الْكَبَائِر فَلم يعصموا من الصَّغَائِر التي ليس فيها خسة ودناءة نفس.
وقال ابن حجر: وَقَدِ اسْتَشْكَلَ وُقُوعُ الِاسْتِغْفَارِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مَعْصُومٌ، وَالِاسْتِغْفَارُ يَسْتَدْعِي وُقُوعَ مَعْصِيَةٍ وَأُجِيبَ بِعِدَّةِ أَجْوِبَةٍ مِنْهَا: قَول ابن بَطَّالٍ الْأَنْبِيَاءُ أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَادًا فِي الْعِبَادَةِ لِمَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمَعْرِفَةِ فَهُمْ دَائِبُونَ فِي شُكْرِهِ مُعْتَرِفُونَ لَهُ بِالتَّقْصِيرِ انْتَهَى. وَمُحَصَّلُ جَوَابِهِ أَنَّ الِاسْتِغْفَارَ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي أَدَاءِ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِاشْتِغَالِهِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ رَاحَةٍ أَوْ لِمُخَاطَبَةِ النَّاسِ وَالنَّظَرِ فِي مَصَالِحِهِمْ وَمُحَارَبَةِ عَدُوِّهِمْ تَارَةً وَمُدَارَاتِهِ أُخْرَى وَتَأْلِيفِ الْمُؤَلَّفَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْجُبُهُ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ وَمُرَاقَبَتِهِ فَيَرَى ذَلِكَ ذَنْبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَقَامِ الْعَلِيِّ وَمِنْهَا أَنَّ اسْتِغْفَارَهُ تَشْرِيعٌ لِأُمَّتِهِ أَوْ مِنْ ذُنُوبِ الْأُمَّةِ فَهُوَ كَالشَّفَاعَةِ لَهُمْ.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: فِي الْإِحْيَاءِ كَانَ ﷺ دَائِمَ التَّرَقِّي فَإِذَا ارْتَقَى إِلَى حَالٍ رَأَى مَا قَبْلَهَا دُونَهَا فَاسْتَغْفَرَ مِنَ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ وَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي اسْتِغْفَارِهِ كَانَ مُفَرَّقًا بِحَسَبِ تَعَدُّدِ الْأَحْوَالِ وَقَالَ الشَّيْخُ السُّهْرَوَرْدِيُّ: لَمَّا كَانَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَزَلْ فِي التَّرَقِّي إِلَى مَقَامَاتِ الْقُرْبِ يَسْتَتْبِعُ الْقَلْبَ وَالْقَلْبُ يَسْتَتْبِعُ النَّفْسَ وَلَا رَيْبَ أَنَّ حَرَكَةَ الرُّوحِ وَالْقَلْبِ أَسْرَعُ مِنْ نَهْضَةِ النَّفْسِ فَكَانَتْ خُطَا النَّفْسِ تَقْصُرُ عَنْ مَدَاهُمَا فِي الْعُرُوجِ فَاقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ إِبْطَاءَ حَرَكَةِ الْقَلْبِ لِئَلَّا تَنْقَطِعَ عَلَاقَةُ النَّفْسِ عَنْهُ فَيَبْقَى الْعِبَادُ مَحْرُومِينَ فَكَانَ ﷺ يَفْزَعُ إِلَى الِاسْتِغْفَارِ لِقُصُورِ النَّفْسِ عَنْ شَأْوِ تَرَقِّي الْقَلْبِ وَاللَّهُ اعْلَم.اهـ
قال الإمام الشافعي: أَنْزَلَ الله تعالى عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ: أَنْ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَبْلَ الْوَحْيِ وَمَا تَأَخَّرَ أَنْ يَعْصِمَهُ فَلَا يُذْنِبُ.
ومثل هذا الحديث ونحوه من الأحاديث والآيات استدل بها العلماء الذين قالوا بجواز المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ودناءة نفس على الأنبياء، فإن لعلماء أهل السنة قولين في جواز صدور المعصية الصغيرة التي لا خسة فيها ولا دناءة من الأنبياء وقد ذهب إلى تجويز ذلك الإمام الأشعري والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما، وبيّن العلماء أن فعل ذنب أو اثنين من الصغائر التي لا دناءة فيها لا يسقط العدالة ولا ينافي الاتصاف بالأمانة ولا يسقط الشخص من أعين الناس لا سيما مع التوبة والإسراع بالإنابة، وهذا إجماع بلا خلاف أنه لا يسقط العدالة،
ومما اختلف فيه المفسرون قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [سورة محمد/ الآية 19] فقال بعضهم ليس المراد بالذنب هنا المعصية التي فيها إثم، وذهب آخرون إلى أنّ الذنب فيها هو صغيرة من الصغائر وهو ظاهر ما ذهب إليه الإمام الطبري فقال: وَسَلْهُ غُفْرَانَ ذَنبَكَ وَعَفْوَهُ لَكَ عَنْهُ. وَذُنُوبَ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِكَ مِنَ رجالٍ وَنِّسَاءِ.
قال النووي في شرح مُسلم: وَاختَلَفُوا فِي وُقُوعِ غَيرِهَا مِنَ الصَّغَائِرِ مِنهُم، فَذَهَبَ مُعظَمُ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ إِلَى جَوَازِ وُقُوعِهَا مِنهُم وَحُجَّتُهُم ظَوَاهِرُ القُرآنِ وَالأَخبَارِ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِن أَهلِ التَّحقِيقِ وَالنَّظَرِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِن أَئِمَّتنَا إِلَى عِصمَتِهِم مِنَ الصَّغَائِرِ كَعِصمَتِهِم مِنَ الكَبَائِرِ وَأَنَّ مَنصِبَ النُّبُوَّةِ يَجِلُّ عَن مُوَاقَعَتِهَا وَعَن مُخَالَفَةِ اللهِ تَعَالَى عَمدًا.
وقال الفيروزأبادي: والعِصْيَان: خلاف الطَّاعة.
وقال القشيري: ﴿وَاستَغفِرهُ﴾ [سورة النصر/ الآية 3] وفي هذا دليل على أنه كانت له ذنوب، ولم يكن جميع استغفاره لأمته لأنّه قال في موضع آخر ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [سورة محمد/ الآية 19] وهنا لم يذكر ذلك.اهـ
قال العارف بالله ابن أبي جمرة في أثناء كلام له على حديث رواه مسلم: ((لن يَدْخُل أحد الجنة بعمله)) ما لفظه: لا يخطر بخاطر أحد أن الذنوب التي أخبر الله تعالى أنه بفضله غفرها للنبي من قبيل ما نقع نحن فيها، معاذ الله، لأنّ الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع، ومن الصغائر التي فيها رذائل. أما الصغائر التي ليس فيها رذائل ففيها خلاف بين العلماء.اهـ
قال النووي في شرحه لمسلم: قَالَهُ تَوَاضُعًا وَعَدَّ عَلَى نَفْسِهِ فَوَاتَ الْكَمَالِ ذُنُوبًا وَقِيلَ أَرَادَ مَا كَانَ عَنْ سَهْوٍ، وَقِيلَ مَا كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ ﷺ مَغْفُورٌ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَدَعَا بِهَذَا وَغَيْرِهِ تَوَاضُعًا لِأَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ.اهـ
وقال ابن حجر: قَالَ الطَّبَرِيُّ بَعْدِ أَنِ اسْتَشْكَلَ صُدُورَ هَذَا الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [سورة الفتح/ الآية 2] مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْتَثَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ وَسُؤَالِهِ الْمَغْفِرَةَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. قَالَ الْمُحَاسِبِيُّ: الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ أَشَدُّ لِلَّهِ خَوْفًا مِمَّنْ دُونَهُمْ وَخَوْفُهُمْ خَوْفُ إِجْلَالٍ وَإِعْظَامٍ وَاسْتِغْفَارُهُمْ مِنَ التَّقْصِيرِ. وَقَالَ عِيَاضٌ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَقَوْلُهُ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُعِ وَالِاسْتِكَانَةِ وَالْخُضُوعِ وَالشُّكْرِ لِرَبِّهِ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَهُ. وَقَالَ قَوْمٌ وُقُوعُ الصَّغِيرَةِ – أي التي ليس فيها خسة ودناءة – جَائِزٌ مِنْهُمْ فَيَكُونُ الِاسْتِغْفَارُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: وُقُوعُ الْخَطِيئَةِ – أي التي ليس فيها خسة ودناءة نفس – مِنَ الْأَنْبِيَاءِ جَائِزٌ لِأَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ فَيَخَافُونَ وُقُوعَ ذَلِكَ وَيَتَعَوَّذُونَ مِنْهُ، وَقِيلَ: قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُعِ وَالْخُضُوعِ لِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ لِيُقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ.اهـ
وقال في معناه: قَوْلُهُ (رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي) الْخَطِيئَةُ الذَّنْبُ يُقَال خطيء يخطؤ وَيَجُوزُ تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ فَيُقَالُ خَطِيَّةٌ بِالتَّشْدِيدِ، قَوْلُهُ (وَجَهْلِي) الْجَهْلُ ضِدُّ الْعِلْمِ، قَوْلُهُ (وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ) الْإِسْرَافُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْخَطَايَا جَمْعُ خَطِيئَةٍ، وَعَطْفُ الْعَمْدِ عَلَيْهَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَإِنَّ الْخَطِيئَةَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ عَنْ خَطَأٍ وَعَنْ عَمْدٍ، أَوْ هُوَ مِنْ عَطْفِ أَحَدِ الْعَامَّيْنِ عَلَى الْآخَرِ، قَوْلُهُ (وَجَهْلِي وَجِدِّي) وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَهُوَ أَنْسَبُ وَالْجِدُّ بِكَسْرِ الْجِيمِ ضِدُّ الْهَزْلِ قَوْلُهُ (وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي9 أَيْ مَوْجُودٌ أَوْ مُمْكِنٌ.اهـ (أَنْتَ الْمُقَدِّمُ) أَيْ أَنْتَ تُقَدِّمُ مَنْ تَشَاءُ بِتَوْفِيقِكَ إِلَى رَحْمَتِكَ (وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ) (وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ) أَيْ أَرَدْتَهُ مِنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَغَيْرِهِمَا (قَدِيرٌ) كَامِلُ الْقُدْرَةِ تَامُّ الْإِرَادَةِ.
أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ هُوَ الْمُنْزِلُ لِلأَشْيَاءِ مَنَازِلَهَا يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ مِنْهَا وَيُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ، فاللهُ تعالى هوَ الذي يُقدِّمُ ما يشاءُ ويُؤخِّرُ ما يشاءُ سبحانَه، فمخلوقاتُ اللهِ تعالى يجوزُ عليها مِنْ حيثُ العقلُ ما يجوزُ على بعضٍ، ولكنَّ اللهَ قَدَّمَ ما شاءَ وأَخَّرَ ما شاءَ سبحانَه فهوَ الذي جعلَ السماءَ فوقَ الأرضِ وجعلَ العرشَ سقفًا للجنةِ وجعلَ محلَّ جهنمَ الآنَ تحتَ الأرضِ السابعةِ، وجعلَ الأنبياءَ مفضلينَ على بعضٍ في الدرجاتِ، فَفَضَّلَ سيدَنا محمَّدًا ﷺ عليهم وخصَّه بالوسيلةِ والفضيلةِ والدرجةِ العاليةِ الرفيعةِ مِنَ الجنةِ ورفعَ لهُ ذكرَه في الأرضِ والسماءِ، حيثُ قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [سورة الشرح/ الآية 4]، فقدَّمَ اللهُ تعالى محمَّدًا ﷺ على أنبيائِه في الحشرِ يومَ الدينِ وفي الدنيا وخصَّهُ بمراتبَ عظيمةٍ فهوَ أوَّلُ مَنْ يخرجُ مِنْ قبرِه وهوَ أوَّلُ مَنْ يدخلُ الجنةَ وهوَ أوَّلُ مَنْ يُكْسَى في الجنةِ مِنْ حُلَلِ أهلِ الجنةِ وهوَ صاحبُ الحوضِ المورودِ والمقامِ المحمودِ وهوَ صاحبُ لواءِ الحمدِ يومَ الدينِ وقائدُ الغرِّ المحجلينَ ﷺ، فسبحانَ اللهِ الْمُقَدِّمِ الْمُؤَخِّرِ.
ثُمَّ إِنَّ النَّبيَّ عليهِ الصَّلاةُ والسّلامُ هوَ أوَّلُ مَنْ يَشفعُ وأوَّلُ مَنْ تُقبَلُ شفاعَتُه، وهوَ يختصَّ بالشّفاعَةِ العُظمَى، وقد سُمِّيتْ بذلكَ لأنَّها لا تختصُّ بأمَّتِهِ فقطْ بلْ ينتفعُ بها غيرُ أمَّتِهِ مِنَ المؤمنينَ، وهيَ لتخليصِهم مِنَ الاستمرارِ في حَرِّ الشّمسِ في الموقِفِ، فَسُبْحَانَ المقَدِّمِ المؤَخِّرِ.
وقدْ فضَّلَ اللهُ تعالى مدينةَ رسولِ اللهِ ﷺ على باقي البلادِ على قولِ بعضِ الفقهاءِ، وبعضُهم فضَّلَ مكةَ المكرمةَ على المدينةِ المنورةِ، أما مدينةُ رسولِ اللهِ الكريمِ ﷺ، فهيَ طيبةُ الطيّبةُ مهبطُ الوحيِ ومُتَنَزَّلُ جبريلَ الأمينِ على الرسولِ الكريمِ ﷺ، وهيَ مأرزُ الإيمانِ وملتقى المهاجرينَ والأنصارِ، وموطنُ الذينَ تبوأوا الدارَ والإيمانَ، وهيَ العاصمةُ الأولى للمسلمينَ، فيها عُقِدَتِ الألويةُ في سبيلِ اللهِ، فانطلقتْ كتائبُ الحقِّ لإخراجِ الناسِ مِنَ الظلماتِ إلى النورِ، ومنها شعَّ النورُ فأشرقتِ الأرضُ بنورِ الهدايَةِ، وهيَ دارُ هجرةِ المصطفى ﷺ، إليهَا هاجرَ وفيها عاشَ ءاخرَ حياتِهِ، وبها ماتَ وفيها دُفِنَ، ومنها يبعثُ ﷺ، وقبرُه أوَّلُ القبورِ انشقاقًا عَنْ صاحبِه، وهذهِ المدينةُ المباركةُ شَرَّفَها اللهُ وفَضَّلَها وجعَلَها خيرَ البقاعِ بعدَ مكة.
فضَّل بعض الفقهاء مكة على المدينة المنورة لكن هذا التفضيل محلُّه دون البقعة التي حوت جسد النبي ﷺ أمَّا إذا ضُمَّت إليها هذه البقعة فهي بالإجماع أفضل بقاع الدنيا ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء. وقد نقل الإجماعَ على تفضيل البقعة التي حوت جسد سيدنا رسول الله ﷺ على كل بقاع الدنيا القاضي عياضٌ من المالكية وابن عقيل الحنبلي والسبكي في فتاويه وغيرهم،
ويدلُّ على تفضيلِ مكةَ على المدينةِ قولُ الرسولِ الكريمِ ﷺ، لما أخرجَه الكفارُ منها واتَّجَهَ إلى المدينةِ مهاجِرًا قالَ مخاطِبًا مكةَ: ((وَالله إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ الله وَأَحَبُّ أَرْضِ الله إِلَى اللهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ)) رواه الترمذي، فَسُبْحَانَ اللهِ المقَدِّمِ المؤَخِّرِ.
فاللهُ تَعَالَى هُوَ الْمُقَدِّمُ وَهُوَ الْمُؤَخِّرُ سُبْحَانَهُ هوَ الذي جعلَ أبا جهلٍ وأبا لهبٍ وفرعونَ وهامانَ وقارونَ في أسفلِ الدركاتِ، وجعلَ أبا بكرٍ الصديقَ أفضلَ البشرِ بعدَ الأنبياءِ، فأبو بكرٍ رضي الله عنه سمعَ دعاءَ محمَّدٍ ﷺ لهُ بالإسلامِ فآمنَ باللهِ ورسولِه فورًا بلَا ترددٍ، فقدَّمَه اللهُ على كلِّ أولياءِ البشرِ، وأبو جهلٍ دعاهُ رسولُ اللهُ كثيرًا فلمْ يَشَإِ اللهُ لهُ الهدايةَ، فبقيَ على كفرِه لآخرِ لحظةٍ مِنْ عمرِه، فكانَ في أسفلِ الدرجاتِ، فَسُبْحَانَ اللهِ الْمُقَدِّمِ الْمُؤَخِّرِ.
وروى ابن حبان في كتابه الثقات: بسنده عن الأوزاعي، عن عبد الله بن محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطًا وكان رابطنا يومئذ عريش مصر. قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا بِبطيحة، وفي البطيحة خيمة، فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وماله من جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: “اللهم أوزعني أن أحمدك حمدًا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها عليَّ، وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا”.
قال الأوزاعي: قال عبد الله، قلت: والله لآتينَّ هذا الرجل، ولأسألنَّه أنَّى له هذا الكلام!!!، فهمٌ أم علمٌ أم إلهامٌ أُلهم؟ فأتيتُ الرجل فسلمت عليه، فقلت: سمعتك وأنت تقول: “اللهم أوزعني أن أحمدك حمدًا، أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها عليَّ، وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا” فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها؟ وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ وهذا السؤال ليس اعتراضا.
قال: وما ترى ما صنع ربي؟ والله لو أرسل السماء علي نارًا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرًا، لما أنعم علي من لساني هذا، ولكن يا عبد الله إذ أتيتني، لي إليك حاجة، قد تراني على أي حالة أنا، أنا لست أقدر لنفسي على ضُرٍّ ولا نفع، ولقد كان معي بنيٌّ لي يتعاهدني في وقت صلاتي، فيوضؤني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام، فتحسَّسه لي رحمك الله.
فقلت: واللهِ ما مشى خَلْقٌ في حاجة خلقٍ، كان أعظم عند الله أجرًا ممن يمشي في حاجةِ مثلك.
فمضيت في طلب الغلام، فما مضيتُ غير بعيد، حتى صرت بين كثبان من الرمل، فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه، فاسترجعت … وقلت: بأي وجه آتي هذا الرجل؟ فبينما أنا مقبل نحوه، إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلمّا أتيته سلمّت عليه، فردّ عليّ السلام، فقال: ألست بصاحبي؟
قلت: بلى.
قال: ما فعلت في حاجتي؟
فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟
قال: بل أيوب النبي.
قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟
قال: بلى.
قلت: فكيف وجده؟
قال: وجده صابرًا شاكرًا حامدًا.
قلت: لم يرضَ منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبابه؟
قال: نعم. قلت: فكيف وجده ربُّه؟
قال: وجده صابرًا شاكرًا حامدًا.
أوجز رحمك الله.
قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كُثبان الرمل، وقد افترسه سبع فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر.
فقال المبتلى: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقًا يعصيه، فيعذبه بالنار. ثم استرجع، وشهق شهقة فمات.
فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عظمت مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدتُ، لم أقدر على ضر ولا نفع. فسجَّيته بشملةٍ كانت عليه، وقعدت عند رأسه باكيًا، فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة رجال، فقالوا: يا عبد الله، ما حالك؟ وما قصتك؟
فقصصت عليهم قصتي وقصته، فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه، فعسى أن نعرفه. فكشفت عن وجهه، فانكبَّ القوم عليه، يقبلون عينيه مرة، ويديه أخرى، ويقولون: بأبي عينٌ طالما غُضّت عن محارم الله، وبأبي جسم طالما كان ساجدًا والناس نيام.
فقلتُ: من هذا يرحمكم الله؟
فقالوا: هذا أبو قِلابة الجَرْمي، عبد الله بن زيد صاحب ابن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم.
فغسَّلناه وكفنَّاه بأثواب كانت معنا، وصلينا عليه ودفنَّاه. فانصرف القوم وانصرفتُ إلى رباطي، فلما أن جَنَّ عليَّ الليل، وضعت رأسي، فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حُلَّتانِ من حُلَلِ الجنة، وهو يتلو الوحي: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [سورة الرعد/ الآية 24]، فقلتُ: ألست بصاحبي؟
قال: بلى… قلت: أنى لك هذا؟
قال: إن للهِ درجاتٍ لا تُنَال إلا بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، مع خشية الله عز وجل في السرِّ والعلانية.
والله تعالى أعلم وأحكم
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة