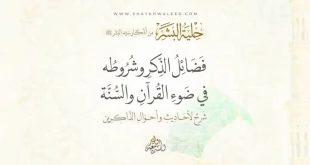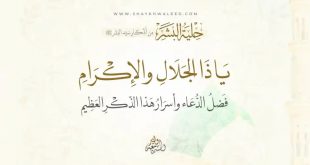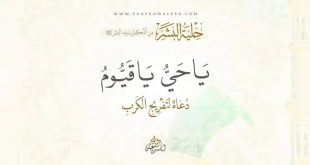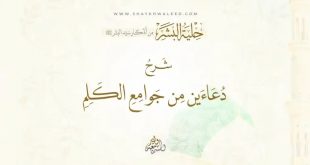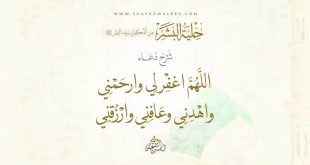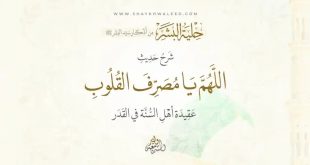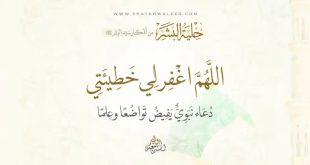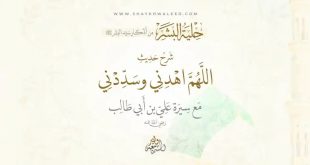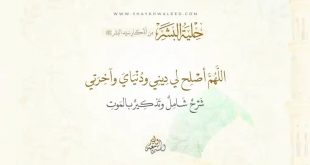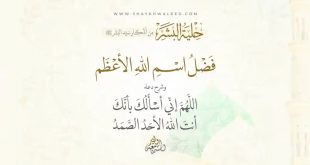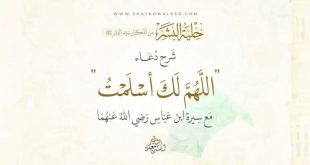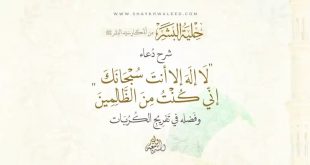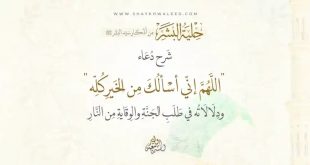المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله الَّذِي أعانَ بفضلِهِ الأقدامَ السَّالِكة، وأنقذ برحمته النُّفوسَ الهالِكة، ويسَّر منْ شاء لليسرى فرغِبَ في الآخِرة، أحمدُه على الأمور اللَّذيذةِ والشَّائكة، وأشهد أن لا إِله إلّا الله وَحدَهُ لا شريكَ له فكلُّ النفوسِ له ذليلةٌ عانِيَة،
وأشهد أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُه القائمُ بأمر ربِّه سِرّا وعلانِية، صلَّى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكْرٍ الَّذِي حَرَّضَتْ عَلَيْه الْفرقَة الآفِكة، وعَلَى عُمَرَ الَّذِي كانَتْ نَفْسُه لنفسه مالِكَة، وعَلَى عُثمانَ مُنْفِقِ الأمْوالِ المتكاثرة، وعَلَى عَليِّ مُفرِّقِ الأبطالِ في الجُموع المُتكاثفَة، وَعَلَى بَقيَّةِ الصَّحابة والتابعين لهم بإحسانٍ ما قَرعتِ الأقدام السالِكَة، وسلَّم تسليما، أما بعد:
الحديث
وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا أُنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ وَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ)).
قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
قبل أن نبدأ بشرح هذا الحديث ننوه إلى أمر ومعنًى مهم وهو:
أنّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ اللهِ هُنَا الصَّلاةُ. فقد جاء لفظ “ذكر الله” في القرآن والحديث على معنى الصلاة وجاء بمعنى الطاعة وجاء بمعنى الذكر اللساني، وجاء بمعانٍ أخرى، فالذكر اللساني ليس أفضل من الزكاة والجهاد وليس هو أفضلَ الأعمال على الإطلاق، بل إن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله ورسوله كما روى البخاري أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: ((إيمان بالله ورسوله))، وفي رواية عند أحمد والبيهقي قال: ((إيمان لا شك فيه)).
فالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات هو أفضل الأعمال، فهو الشرط لقبول الأعمال. وبعده يأتي في الفضل الصلاة، فهي أفضل العبادات العملية؛ فقد روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.
الشرح والتعليق على هذا الحديث
وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو أَبُو الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرُ بنُ زَيْدِ بنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ، الإِمَامُ، القُدْوَةُ، قَاضِي دِمَشْقَ، وَصَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو الدَّرْدَاءِ، الأَنْصَارِيُّ، الخَزْرَجِيُّ، حَكِيْمُ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَسَيِّدُ القُرَّاءِ بِدِمَشْقَ، رَوَى: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَّةَ أَحَادِيْثَ. وَهُوَ مَعْدُوْدٌ فِيْمَنْ جَمَعَ القُرْآنَ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَصَدَّرَ لِلإِقْرَاءِ بِدِمَشْقَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، وَقَبْلَ ذَلِكَ.
رَوَى عَنْهُ: أَنَسُ بنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ، وروى عنه زَوْجَتُهُ؛ أُمُّ الدَّرْدَاءِ العَالِمَةُ، وَابْنُهُ؛ بِلَالُ. وكانت أمّ الدرداء تُجِلُّ زوجها أبا الدرداء كثيرا وتتأدب في الحديث عنه، فقد روى مسلم وغيره فقال: وقالت أُمُّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها: حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ))، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: “قالت: (حدثني سيدي) تعني زوجها أبا الدرداء. ففيه جواز تسمية المرأة زوجها سيدها وتوقيره” انتهى.
وليس الحال كما هو عند أكثر النساء في زماننا لا تجدها تتأدب أبدا في كلامها عن زوجها وهو أكثر النّاس حقًّا عليها، بل إن كثيرا من النساء لا تحفظ زوجها ولا تحفظ بيته ولا ماله ولا أولاده ولا تتقي الله فيه، وتقصّر معه بأمر الزينة واللباس وتجدها عند خروجها من المنزل تتزين زينة كثيرة وأمام زوجها تقصر ولا تتقي الله فيه، المرأة إذا زوجها أمرها بوضع شيء من الزينة وكان جلبه لها لهذا صار واجبا عليها أن تضع، هي عندما تعفّ زوجها يكتب لها ثواب عظيم، هذا مما أمر به الشرع حتى لا يقع الزوج بالنظر المحرم ولا يقع في معصية الله.
ومن حقوق الزوج على زوجته فله أن تطيعه فيما أمر الله، ولا سيما فيما يتعلّق بها من الاستمتاع، وألا تمتنع عنه إذا طلبها لغير ضرورة شرعية كأن تكون في حالة حيض أو كان يلحقها ضررٌ، فإن لم يكن لها عذر شرعي ليس لها أن تمنعه نفسها بل عليها معصية كبيرة إن امتنعت من ذلك، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ((إِذا دَعَا الرَجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا المَلائِكَةُ حَتَى تُصْبِحْ)) رواه البخاري ومسلم، وإنّما أمر الشرع بتلبية رغبة الزوج وإطاعته في الفراش لأنّ الرجل ولا سيما الشاب إن لم يجد ذلك في زوجته قد يحيله ذلك إلى الوقوع بالحرام أو يتعكر صفوه فيكدر سعادتها، لذلك أمرَ الرسول المرأة أن تستجيب لطلب الزوج حتى لو كانت تعمل عملا خشية أن تقع الفتنة وحتى تستمر روابط المحبة بين الزوجين قال عليه الصلاة والسلام: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كانت على التنور)) رواه ابن حبان في صحيحه.
ومن حق الزوج على الزوجة: ألا تصومَ تطوعًا ونفلًا إلا بإذنه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإذْنِهِ وَلَا تَأذَنُ في بَيْتِهِ إِلَّا بِإذْنِهِ)) رواه البخاري ومسلم. وسببُ وحكمة هذا التحريم أنّ للزوج حقّ الاستمتاع بها في أي وقت وحقه واجب على الفور وصومها تطوعًا ليسَ بفرض فلا يُمنع حقٌّ بنفلٍ وكذلك في الحديث المذكور حرمة أن تُدخل إلى بيته من لا يرضى لأن ذلك يسبب العداوة بين الزوج وزوجته ولكن ليس له منعها من صلة الرحم وزيارة الأقارب، ولا يجوز لها طاعته فيما حرّمَ الله أو إعانة على معصية الله لأنّ القاعدة في ذلك أن لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق.
ومن حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا برضاه إلا لضرورة تبيحُ الخروج لها دون إذنه كالخروج لأمر مهم شرعًا لا يتحصل إلا بالخروج، وأمّا إن كان يرضى ويأذن لها فلا مانع أن تخرج المرأة من بيتها ضمن حدود الحشمة والأدب والستر. ومن حقّ الزوج على زوجته أن تتزيّنَ له وتتجمّل له بالثياب ونحوه إذا طلب منها، وذلك حتى لا تمتد عينه إلى غيرها فيقع في الحرام. وسواءٌ كانت الزينة التى طلبها اعتادت عليها أو لم تعتد عليها وجبَ عليها تلبيتهُ في ذلك، وعليها أن تمتنع عن كل شىء يعكر عليه الاستمتاع كالروائح الكريهة وما يؤذيه إذا نظرَ إليه.
وفي الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قِيْلَ للنَبِيّ: أَيُّ النِسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((الَتِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمِرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ في نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ)). وينبغي للمرأة المحافظة على مال زوجها في حضرته وغيبته، وينبغي أن تحترمه ولا تتعالى عليه، وتحفظ قدره؛ فالرجل أولَى الناس بالمرأة من حيث العناية والرعاية فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: ((زَوْجُهَا)). قُلْتُ: مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ ((أُمُّهُ)) رواه الحاكم في المستدرك والنسائي في السنن الكبرى.
وكذلك حذّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من أن تَكْفُرَ العشير أي تُنكر فضلَ الزوج عليها، ففي الحديث الصحيح أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَعظُ النساء فيقول لهنَّ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)). فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)) رواه البخاري. والعشير هو الزوج والمعنى أنَّ أكثرَ ما هو سبب لدخولهنَّ النار كونهن يكثرنَ من اللعن بغير حق ومنهنَّ من يُكثرنَ كُفرانَ عشرةِ الزوج وإحسَانِه، فلو أحسنَ إلى إحداهنَّ الدهر ثم رأتْ منه شيئا قالت: ما رأيتُ منكَ خيرًا قط!.
ووردَ في حثّ المرأة على طاعة زوجها وإرضائه فيما لا معصية فيه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ)) رواه الترمذي، فالمرأة إذا صبرت على زوجها وأحسنت إليه بما يحب كان لها عند الله ثواب عظيم، وطاعة المرأة لزوجها ليست طاعة إذلال بل طاعة مودةٍ وحنان. فكما أنَّ للرجل ءادابًا في حُسنِ معاشرة زوجته كذلك على المرأة ءاداب في حسن معاشرتها لزوجها الذي له الفضلُ الكثير وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)) رواه ابن ماجه، معناه سجود تحية واحترام وليس عبادة ولكن حتى هذا السجود الذي للاحترام حرّمَهُ رسول الله على أمته، ولو كانَ حلالا لكانَ أولى الناس بفعلهِ المرأةُ لزوجها.
وقد قال أحدُ العلماء ناصحًا بعض تلميذاته اللواتي يتلقين العلم الشرعي: كُوْنِيِ لَيِّنَةً بِيَدِ زَوْجِكِ، أَخْفِضِي صَوْتَكِ أَمَامَهُ وَكَأَنَكِ عِنْدَ مَلِكٍ مِنَ المُلُوْكِ، حَقُّ الزَوْجِ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ، خَالِفِي نَفْسَكِ بِالتَواضُعِ مَعَهُ. وإياك أن تكلمي زوجك كمَن يُحاكمُه لمجرَّدِ شكٍّ أو ظنٍّ في أمرٍ لا يُعجِبُكٍ فيؤدي ذلك إلى نفورِهِ منك، لا تبحثي في أغراضِهِ بدونِ إذنِهِ إرضاءً لشهوةِ نفسِكِ التي في غير مَحلّها الأمرُ الذي قد يهدمُ بيتَك وأنت لا تشعرين. فلا تلومي إلا نفسك. لقد هدمَت وخرَّبت الغَيرَةُ كثيرًا مِنَ البيوت ولو عَمِلَ الواحدُ مِنَّا بِحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم – الذي رواه مالك في الموطأ -: ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ)) لارتحنا كثيرًا، لا تقولي نساءُ الرسولِ كُنَّ يغرنَ أنا أيضًا أغارُ، أين أنتِ مِنْ نساءِ رسولِ الله وأينَ زوجُكِ من رسولِ الله، وتذكّري جيدًا أن هذا ليس عذرًا لك للغَيرةِ التي تؤدي بك إلى مخالَفةِ الشرع فقدوتنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وميزاننا شرعُ اللهِ، استغلي محبَّة زوجَكِ لك في طاعةِ الله ولا تبعديهِ عنكِ بِما يكرَه. إياكِ ثم إياكِ أن تطلبي الطلاقَ منه بدونِ عذرٍ شرعي فتقعي في كبائرِ الذنوب، ليس لك عذرٌ أن تطلبي الطلاقَ لأنك تشعرينَ بالنفورِ منه أو لأنه تزوجَ غيركِ أو لأنكِ تغارينَ أو لأنه كثيرُ النومِ كثيرُ الأكلِ قليلُ الحركة. انتبهي وزِنِي أمورَكِ بِميزانِ الشرع لا بِميزانِ الهوى إياكِ ثم إياكِ إن جلبَ لك طعامًا أو ثيابًا أو نَحوَ ذلك أن تتأففي لأنَّ الطعامَ ليسَ كما تريدين والثيابَ ليسَ كما تشتهين والسَّيارة ليس كما تُحبّين، إما أن تأكلي وتشكري أو تسكتي وتَحمدي اللهَ على كلّ حال، احمدي اللهَ على ما أنتِ فيه مِنَ النّعم وتذكري قولَهُ عليهِ السلام – رواه أحمد في مسنده -: ((مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ)). إياكِ أن تكسري قلبَهُ مع أنه أحسنَ إليكِ بِما جلبَ لكِ، قولي له باركَ الله فيك وجزاكَ عني كلَّ خير بدلَ أن تقولي ما هذا الطعام يوجد أجودُ منه، ما هذا اللّباس يوجدُ أحسَنُ منه ما هذه السيارة يوجدُ أحدثُ منها ما هذا المكان الذي جلبتني إليه للنزهة يوجدُ أحلى منه، فإنك إن فعلتِ ذلك كسرتِ قلبَهُ ونفَرَ منكِ وتذكري قولَ اللهِ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [سورة الطلاق/ الآية 2-3] كونِي له خيرَ النساء وهي التي تسرُّهُ إذا نظرَ وتطيعُهُ إذا أمر ولا تخالفُهُ في نفسِها بِما يكره كونِي عونًا له لا عليه، واحفظي نفسَكِ في غَيبتِهِ وحافظي له على ماله. لا تكلمي زوجك بصيغة الآمِرِ وكلّميهِ بصيغَةِ المترجّي المنكسر فإنّ ذلكَ لا يُنقِصُ مِنْ قدرِك بل يرفَعُهُ، قولي له: لو جلبتَ لنا كذا وكذا لو أخذتنا إلى مكانِ كذا مِنْ غيرِ إلزامٍ له وتهديدٍ وتوعّد. وهناكَ نصيحة مهمة ينبغي أن يَعيها كلُّ زوج وزوجة وهي مرعاةُ حكم الشرع والدين في المعاملة بين بعضهم البعض وبأن لا يحمل الغضب أحدهما على التلفظ بألفاظ كفرية كسب الله أو الألفاظ البشعة التى فيها نسبة العجز إلى الله تعالى كالذي يقول لزوجته “الله ما بيحملك” والعياذ بالله أو غير ذلك مما شابه هذا اللفظ فإن هذا يخرج من الإسلام ويجعل العلاقة بين الرجل وزوجته علاقة محرمة وليحذر من التسرع بألفاظ الطلاق والشتم واللعن، ورأس الأمر أن يَتعلم الزوجان علمَ الدين الذي أوجبه الله عليهم وأن يطبقا ذلك وأن يتحاكما إلى حكم الدين فالمرأة التى تسمع من زوجها كفرًا وتسكت عنه وتعاشره بحجة أنه غضبان لا بَركة ولا سعادة في عشرتها على هذه الحال ما لم يرجع إلى الإسلام بالشهادتين وكذلك الرجل إن سَمعَ من زوجته لفظًا كفريًا كَسَبِّ اللهِ ونحوه فعليه أن يأمرها بالشهادتين وإلا فالمعاشرة محرمة، ومن أراد أسرة سعيدة مباركة هنيئة فعليه بتقوى الله فهي رأسُ كل سعادة وعليه بحفظ اللسان عمّا حرمَ الله وترك الغضب وإلا فلن يجد سعادة في غير ذلك.
وَوَلِيَ أبو الدرداء القَضَاءَ بِدِمَشْقَ، فِي دَوْلَةِ عُثْمَانَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ ذُكِرَ لَنَا مِنْ قُضَاتِهَا.
وَيُرْوَى لَهُ: مائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا. وَاتَّفَقَا لَهُ عَلَى حَدِيْثَيْنِ. وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بِثَلَاثَةٍ، وَمُسْلِمٌ بِثَمَانِيَةٍ. مَاتَ: قَبْلَ عُثْمَانَ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ.
وقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كُنْتُ تَاجِرًا قَبْلَ المَبْعَثِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ، جَمَعْتُ التِّجَارَةَ وَالعِبَادَةَ، فَلَمْ يَجْتَمِعَا فَتَرَكْتُ التِّجَارَةَ، وَلَزِمْتُ العِبَادَةَ.
قَالَ سَعِيْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: أَسْلَمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ قَدْ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ شَهِدَ أُحُدًا، وَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ أَنْ يَرُدَّ مَنْ عَلَى الجَبَلِ، فَرَدَّهُمْ وَحْدَهُ.
قَالَ شُرَيْحُ بنُ عُبَيْدٍ الحِمْصِيُّ: لَمَّا تراجع أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ يَوْمَ أُحُدٍ، كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمَئِذٍ فِيْمَنْ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فِي النَّاسِ، فَلَمَّا أَظَلَّهُمُ المُشْرِكُوْنَ مِنْ فَوْقِهِمْ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((اللَّهُمَّ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُوْنَا))، فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ، وَانْتَدَبُوا، وَفِيْهِم عُوَيْمِرُ أَبُو الدَّرْدَاءِ، حَتَّى أَدْحَضُوْهُمْ عَنْ مَكَانِهِمْ، وَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمَئِذٍ حَسَنَ البَلَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نِعْمَ الفَارِسُ عُوَيْمِرٌ)). وَقَالَ: ((حَكِيْمُ أُمَّتِي: عُوَيْمِرٌ)) رواه الطبراني في مسند الشاميين.
جاء عَنِ الشَّعْبِيِّ: جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ سِتَّةٌ، وَهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: مُعَاذٌ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَزَيْدٌ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَأُبَيٌّ، وَسَعْدُ بنُ عُبَيْدٍ.
يروى أنّه كان لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه صنم فجاء يومًا فوجد الثعلب قد بال على رأس الصنم فاحتقره واعتنق الإسلام وقال: أرَبٌّ يبول الثعلبان برأسه؟! لقد ذلّ من بالت عليه الثعالبُ فلو كان ربًّا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأتْه المطالبُ برئتُ من الأصنام يا رب كلها وآمنت بالله الذي هو غالبُ.
وقَالَ أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ آخِرِ الأَنْصَارِ إِسْلَامًا، وَكَانَ يَعْبُدُ صَنَمًا، فَدَخَلَ ابْنُ رَوَاحَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ بَيْتَهُ، فَكَسَرَا صَنَمَهُ، فَرَجَعَ، فَجَعَلَ يَجْمَعُ الصَّنَمَ، وَيَقُوْلُ: وَيْحَكَ! هَلَّا امْتَنَعْتَ، أَلَا دَفَعْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ فَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: لَو كَانَ يَنْفَعُ أَوْ يَدْفَعُ عَنْ أَحَدٍ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ، وَنَفَعَهَا.
فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَعِدِّي لِي مَاءً فِي المُغْتَسَلِ فَاغْتَسَلَ، وَلَبِسَ حُلَّتَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ رَوَاحَةَ مُقْبِلًا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذَا أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمَا أُرَاهُ إِلَاّ جَاءَ فِي طَلَبِنَا فَقَالَ: ((إِنَّمَا جَاءَ لِيُسْلِمَ، إِنَّ رَبِّي وَعَدَنِي بِأَبِي الدَّرْدَاءِ أَنْ يُسْلِمَ)).
وروي عَنْ مَكْحُوْلٍ الدمشقي قال: كَانَتِ الصَّحَابَةُ يَقُوْلُوْنَ: أَرْحَمُنَا بِنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَنْطَقُنَا بِالحَقِّ عُمَرُ، وَأَمِيْنُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، وَأَعْلَمُنَا بِالحَرَامِ وَالحَلَالِ مُعَاذٌ، وَأَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وَرَجُلٌ عِنْدَهُ عِلْمٌ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَتَبِعَهُم عُوَيْمِرُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِالعَقْلِ.
وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ الصَّحَابَةُ يَقُوْلُوْنَ: أَتْبَعُنَا لِلعِلْمِ وَالعَمَلِ أَبُو الدَّرْدَاءِ.
وَرَوَى البخاري: عن عَوْنِ بنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَجَاءهُ سَلْمَانُ يَزُوْرُهُ، فَإِذَا أُمُّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةٌ فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، يَقُوْمُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَرَحَّبَ بِهِ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُفْطِرَنَّ. فَأَكَلَ مَعَهُ، ثُمَّ بَاتَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ، أَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقُوْمَ، فَمَنَعَهُ سَلْمَانُ، وَقَالَ: إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ، وَائْتِ أَهْلَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَلَمَّا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ، قَالَ: قُمِ الآنَ إِنْ شِئْتَ. فَقَامَا، فَتَوَضَّأَا، ثُمَّ رَكَعَا، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَدَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيُخْبِرَ رَسُوْلَ اللهِ بِالَّذِي أَمَرَهُ سَلْمَانُ فَقَالَ لَهُ: ((صَدَقَ سَلْمَانُ)).
وقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَو أُنْسِيْتُ آيَةً لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُذَكِّرُنِيْهَا إِلَاّ رَجُلًا بِبَرْكِ الغِمَادِ، رَحَلْتُ إِلَيْهِ.
فائدة: بَرْك الغِمَادِ جاء ذكرها في التاريخ الإسلامي عندما خرج الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مهاجرًا إلى الحبشة قبل هجرته إلى المدينة، فلما بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة – زعيم قبيلة القارة – فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، فقال بن الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدُّغُنَّةِ، فَرَجَعَ مَعَ أبي بكر، فطاف بن الدُّغُنَّةِ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ، وَقَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يُخْرَجُ مِثْلُهُ، وَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟! فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ بن الدَّغِنَةِ، وَأَمَّنُوا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَتْ لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيَعْبُدْ ربه في داره ما شاء. صحيح ابن حبان
وروي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ متحدثا بنعمة الله عليه: سَلُوْنِي، فَوَاللهِ لَئِنْ فَقَدْتُمُوْنِي لَتَفْقِدُنَّ رَجُلًا عَظِيْمًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
وروي عَنْ يَزِيْدَ بنِ عَمِيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ مُعَاذًا الوَفَاةُ، قَالُوا: أَوْصِنَا، فَقَالَ: العِلْمُ وَالإِيْمَانُ مَكَانَهُمَا، مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا – قَالَهَا ثَلَاثًا – فَالْتَمِسُوا العِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةٍ: عِنْدَ عُوَيْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَسَلْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ.
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: عُلَمَاءُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ بِالعِرَاقِ، وَآخَرُ بِالشَّامِ – يَعْنِي: أَبَا الدَّرْدَاءِ- وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى الَّذِي بِالعِرَاقِ – يَعْنِي: نَفْسَهُ – وَهُمَا يَحْتَاجَانِ إِلَى الَّذِي بِالمَدِيْنَةِ – يَعْنِي: عَلِيًّا رضي الله عنه -.
وقَالَ أَبُو ذَرٍّ لأَبِي الدَّرْدَاءِ: مَا حَمَلَتْ وَرْقَاءُ، وَلَا أَظَلَّتْ خَضْرَاءُ أَعْلَمَ مِنْكَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ.
وروي عَنْ مَسْرُوْقٍ التابعي قَالَ: وَجَدْتُ عِلْمَ الصَّحَابَةِ انْتَهَى إِلَى سِتَّةٍ: عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأُبَيٍّ، وَزَيْدٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ، ثُمَّ انْتَهَى عِلْمُهُمْ إِلَى: عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ.
وَقَالَ خَالِدُ بنُ مَعْدَانَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ: حَدِّثُوْنَا عَنِ العَاقِلَيْنِ. فَيُقَالُ: مَنِ العَاقِلَانِ؟ فَيَقُوْلُ: مُعَاذٌ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ.
وروي عَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ، قَالَ: جَمَعَ القُرْآنَ خَمْسَةٌ: مُعَاذٌ، وَعُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَأُبَيٌّ، وَأَبُو أَيُّوْبَ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَزِيْدُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ إِنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَدْ كَثُرُوا، وَمَلَؤُوا المَدَائِنَ، وَاحْتَاجُوا إِلَى مَنْ يُعَلِّمُهُمُ القُرْآنَ، وَيُفَقِّهُهُمْ، فَأَعِنِّي بِرِجَالٍ يُعَلِّمُوْنَهُمْ فَدَعَا عُمَرُ الخَمْسَةَ، فَقَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُم قَدِ اسْتَعَانُوْنِي مَنْ يُعَلِّمُهُمُ القُرْآنَ، وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّيْنِ، فَأَعِيْنُوْنِي يَرْحَمْكُمُ اللهُ بِثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ إِنْ أَحْبَبْتُمْ، وَإِنِ انْتُدِبَ ثَلَاثَةٌ مِنْكُمْ، فَلْيَخْرُجُوا فَقَالُوا: مَا كُنَّا لِنَتَسَاهَمَ، هَذَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ – لأَبِي أَيُّوْبَ – وَأَمَّا هَذَا فَسَقِيْمٌ – لأُبَيٍّ – فَخَرَجَ: مُعَاذٌ، وَعُبَادَةُ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ عُمَرُ: ابْدَؤُوا بِحِمْصَ، وَلْيَخْرُجْ وَاحِدٌ إِلَى دِمَشْقَ، وَالآخَرُ إِلَى فِلَسْطِينَ قَالَ: فَقَدِمُوا حِمْصَ، فَكَانُوا بِهَا، حَتَّى إِذَا رَضُوا مِنَ النَّاسِ، أَقَامَ بِهَا عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ، وَخَرَجَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى دِمَشْقَ، وَمُعَاذٌ إِلَى فِلَسْطِيْنَ، فَمَاتَ فِي طَاعُوْنِ عَمَوَاسَ ثُمَّ صَارَ عُبَادَةُ بَعْدُ إِلَى فِلَسْطِيْنَ، وَبِهَا مَاتَ، وَلَمْ يَزَلْ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِدِمَشْقَ حَتَّى مَاتَ. وروي أنه بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ابْتَنَى كَنِيْفًا بِحِمْصَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: يَا عُوَيْمِرُ، أَمَا كَانَتْ لَكَ كِفَايَةٌ فِيْمَا بَنَتِ الرُّوْمُ عَنْ تَزْيِيْنِ الدُّنْيَا، وَقَدْ أَذِنَ اللهُ بِخَرَابِهَا، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي، فَانْتَقِلْ إِلَى دِمَشْقَ.
وروي عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ ارْجِعَا إِلَيَّ، أَعِيْدَا عَلَيَّ قَضِيَّتَكُمَا.
وروي عَنْ مُسْلِمِ بنِ مِشْكَمٍ: قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: اعْدُدْ مَنْ فِي مَجْلِسِنَا قَالَ: فَجَاؤُوا أَلْفًا وَسِتَّ مائَةٍ وَنَيِّفًا، فَكَانُوا يَقْرَؤُوْنَ، وَيَتَسَابَقُوْنَ عَشْرَةً عَشْرَةً، فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ انْفَتَلَ، وَقَرَأَ جُزْءًا، فَيُحْدِقُونَ بِهِ، يَسْمَعُوْنَ أَلْفَاظَهُ،
وَقَالَ هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُصَلِّي، ثُمَّ يُقْرِئُ، وَيَقْرَأُ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ القِيَامَ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: هَلْ مِنْ وَلِيْمَةٍ أَوْ عَقِيْقَةٍ نَشْهَدُهَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، وَإِلَّا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي صَائِمٌ، وَهُوَ الَّذِي سَنَّ هَذِهِ الحِلَقَ لِلقِرَاءةِ.
قَالَ القَاسِمُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا العِلْمَ. وَعَنْ يَزِيْدَ بنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ مِنَ العُلَمَاءِ وَالفُقَهَاءِ الَّذِيْنَ يَشْفُوْنَ مِنَ الدَّاءِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آخَرَ رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ دَخَلَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ مِنَ الأَتْبَاعِ مِثْلُ السُّلْطَانِ، فَمِنْ سَائِلٍ عَنْ فَرِيْضَةٍ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنْ حِسَابٍ، وَسَائِلٍ عَنْ حَدِيْثٍ، وَسَائِلٍ عَنْ مُعْضِلَةٍ، وَسَائِلٍ عَنْ شِعْرٍ. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا لِي أَرَى عُلَمَاءكُم يَذْهَبُوْنَ، وَجُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُوْنَ، تَعَلَّمُوا، فَإِنَّ العَالِمَ وَالمُتَعَلِّمَ شَرِيْكَانِ فِي الأَجْرِ. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ وَجْهٍ مُرْسَلٍ: لَنْ تَكُوْنَ عَالِمًا حَتَّى تَكُوْنَ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تُكُوْنُ مُتَعَلِّمًا حَتَّى تَكُوْنَ بِمَا عَلِمْتَ عَامِلًا، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ إِذَا وَقَفْتُ لِلحِسَابِ أَنْ يُقَالَ لِي: مَا عَمِلْتَ فِيْمَا عَلِمْتَ.
وقال ابْنُ عَجْلَانَ: عَنْ عَوْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ: قُلْتُ لأُمِّ الدَّرْدَاءِ: أَيُّ عِبَادَةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ كَانَتْ أَكْثَرَ؟ قَالَتْ: التَّفَكُّرُ وَالاعْتِبَارُ.
وقِيْلَ لأَبِي الدَّرْدَاءِ – وَكَانَ لَا يَفْتُرُ مِنَ الذِّكْرِ -: كَمْ تُسَبِّحُ فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ: مائَةَ أَلْفٍ، إِلَاّ أَنْ تُخْطِئَ الأَصَابِعُ.
رُوِيَ عَنْ: أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: لَوْلَا ثَلَاثٌ مَا أَحْبَبْتُ البَقَاءَ سَاعَةً: ظَمَأُ الهَوَاجِرِ، وَالسُّجُوْدُ فِي اللَّيْلِ، وَمُجَالَسَةُ أَقْوَامٍ يَنْتَقُوْنَ جَيِّدَ الكَلَامِ، كَمَا يُنْتَقَى أَطَايِبُ الثَّمَرِ.
قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ثَلَاثَةٌ أُحِبُّهُنَّ وَيَكْرَهُهُنَّ النَّاسُ: الفَقْرُ، وَالمَرَضُ، وَالمَوْتُ، أُحِبُّ الفَقْرَ تَوَاضُعًا لِرَبِّي، وَالمَوْتَ اشْتِيَاقًا لِرَبِّي، وَالمَرَضَ تَكْفِيْرًا لِخَطِيْئَتِي.
وروى الأَوْزَاعِيُّ: عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَوْجَعَتْ عَيْنُهُ حَتَّى ذَهَبَتْ فَقِيْلَ لَهُ: لَو دَعَوْتَ اللهَ؟ فَقَالَ: مَا فَرَغْتُ بَعْدُ مِنْ دُعَائِهِ لِذُنُوْبِي، فَكَيْفَ أَدْعُو لِعَيْنِي.
وقال رَاشِدُ بنُ سَعْدٍ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: أَوْصِنِي قَالَ: اذْكُرِ اللهَ فِي السَّرَّاءِ، يَذْكُرْكَ فِي الضَّرَّاءِ، وَإِذَا ذَكَرْتَ المَوْتَى، فَاجْعَلْ نَفْسَكَ كَأَحَدِهِمْ، وَإِذَا أَشْرَفَتْ نَفْسُكَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا، فَانْظُرْ إِلَى مَا يَصِيْرُ.
وروي عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي المَوْتَى، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ المَظْلُوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَلِيْلًا يُغْنِيْكَ خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرٍ يُلْهِيْكَ، وَأَنَّ البِرَّ لَا يَبْلَى، وَأَنَّ الإِثْمَ لَا يُنْسَى.
وَرَوَى: لُقْمَانُ بنُ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَهْلُ الأَمْوَالِ يَأْكُلُوْنَ وَنَأْكُلُ، وَيَشْرَبُوْنَ وَنَشْرَبُ، وَيَلْبَسُوْنَ وَنَلْبَسُ، وَيَرْكَبُوْنَ وَنَرْكَبُ، وَلَهُمْ فُضُوْلُ أَمْوَالٍ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهَا، وَنَنْظُرُ إِلَيْهَا مَعَهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَيْهَا، وَنَحْنُ مِنْهَا بُرَآءُ.
وَعَنْهُ قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ الأَغْنِيَاءَ يَتَمَنَّوْنَ أَنَّهُمْ مِثْلُنَا عِنْدَ المَوْتِ، وَلَا نَتَمَنَّى أَنَّنَا مِثْلُهُمْ حِيْنَئِذٍ، مَا أَنْصَفَنَا إِخْوَانُنَا الأَغْنِيَاءُ، يُحِبُّوْنَنَا عَلَى الدِّيْنِ، وَيُعَادُوْنَنَا عَلَى الدُّنْيَا.
وَرَوَى صَفْوَانُ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ قُبْرُسُ، مُرَّ بِالسَّبْيِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَبَكَى فَقُلْتُ لَهُ: تَبْكِي فِي مِثْلِ هَذَا اليَوْمِ الَّذِي أَعَزَّ اللهُ فِيْهِ الإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ قَالَ: يَا جُبَيْرُ! بَيْنَا هَذِهِ الأُمَّةُ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ، إِذْ عَصَوُا اللهَ، فَلَقُوا مَا تَرَى، مَا أَهْوَنَ العِبَادَ عَلَى اللهِ إِذَا هُمْ عَصَوْهُ.
وروي عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: كَانَ لأَبِي الدَّرْدَاءِ سِتُّوْنَ وَثَلَاثُ مائَةِ خَلِيْلٍ فِي اللهِ، يَدْعُو لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ رَجُلٌ يَدْعُو لأَخِيْهِ فِي الغَيْبِ إِلَّا وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَقُوْلَانِ: وَلَكَ بِمِثْلٍ، أَفَلَا أَرْغَبُ أَنْ تَدْعُوَ لِيَ المَلائِكَةُ.
قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: لَمَّا احْتُضِرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، جَعَلَ يَقُوْلُ: مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ يَوْمِي هَذَا، مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ مَضْجَعِي هَذَا؟
وَرَوَى إِسْمَاعِيْلُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: مَاتَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَبْلَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ رضي الله عنهما. وَقِيْلَ: الَّذِيْنَ فِي حَلْقَةِ إِقْرَاءِ أَبِي الدَّرْدَاءِ كَانُوا أَزْيَدَ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ، وَلِكُلِّ عَشْرَةٍ مِنْهُم مُلَقِّنٌ، وَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَطُوْفُ عَلَيْهِم قَائِمًا، فَإِذَا أَحْكَمَ الرَّجُلُ مِنْهُم، تَحَوَّلَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ – يَعْنِي: يَعْرِضُ عَلَيْهِ-.
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ المَوْتِ، قَلَّ فَرَحُهُ، وَقَلَّ حَسَدُهُ.
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا أُنْبِئُكُمْ أَيْ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ أَيْ: أَفْضَلِهَا؛ ينبغي أن يُعلَم أوّلًا أنّ الآيات القرآنية والحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينها أبدًا، وإلا لو كان هناك تعارض – وهذا مستحيل – لأدّى هذا إلى إبطال الشريعة والطعن بالدّين، وهذا لم يتوصل إليه كلّ المشركين والكفّار عبر الزمن لأنَه لا تعارض، بعد هذا أقول: إنّ أفضل الأعمال التي توزن في ميزان العبد يوم القيامة هي الإيمان بالله، فقد جعل الله الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم أساس الشريعة وهو الشرط لقبول الأعمال الصالحة، وهو المُنْجي من الخلود الأبدي في نار جهنم، فأعلى الواجبات وأفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان مُقَدَّم على سائر الأعمال من صلاة وصيام وحج وزكاة، لأنّ الأعمال الصالحة لا تقبل بدون الإيمان بالله ورسوله، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ)) وأما ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا)) فمعناه أن الصّلاة على وقتها أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله وهذا للتوفيق بين الحديثين، وليس معناه أنّ الصلاة أفضل من الإيمان لأنّها لا تصح ولا تقبل من دون الإيمان.
ثم إنّ الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجوه تعالى بلا كمية ولا كيفية ولا مكان، وتنزيهه سبحانه عمّا لا يجوز في حقّه كالحجم والجسم والأعضاء، فلا يحصل الإيمان بمجرّد اعتقاد وجوده سبحانه وتعالى من غير اعتقاد أنّه منزّه عن صفات المخلوقين،
وكذا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه خاتَم الأنبياء والمرسلين وأنّه صادق في كلّ ما أخبر به وبلّغه عن الله، لأنّ من كذّب النّبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به لا يكون على الإيمان ولو اعترف بوجوده صلى الله عليه وسلم، فالمعرفة إذا اقترن بها الإذعان أي رضا النفس بالشئ الذي عرفته هي الإيمان الذي هو مقبول عند الله، وأما المعرفة وحدها لا تكفي، فقد أخبر الله تعالى عن اليهود بأنهم كانوا يعرفون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أنه نبي الله فقال: ﴿يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ [سورة البقرة/ الآية 146]، ولكن لم تُذعن نفوسُهم فلذلك كانوا يكذبونه بألسنتهم مع علمهم بأنّه نبي، لأنّ التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام فيها الإخبار بأنّ محمدًا رسول الله، لكن التوراة والإنجيل حُرِّفا لفظًا بعد أن حرفا معنًى، فلا بد من العلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لحصول الإيمان.
وليُعلم بأنّ نقيض الإيمان الكفر الذي هو ثلاثة أبواب: تعطيل وتشبيه وتكذيب،
فكفر التعطيل: هو نفي وجود الله تعالى وهو أشد أنواع الكفر على الإطلاق كقول الملاحدة الشيوعية: لا إله والحياة مادة، وكذلك كفر أهل الوحدة وأهل الحلول القائلين بأن الله هو العالم والعالم هو الله والعياذ بالله تعالى،
وكفر التشبيه: أي تشبيه الله تعالى بخلقه كمن يصفه بالحدوث أو الفناء أو الجسم أو اللون أو الشكل أو الأعضاء أو السكنى في المكان أو أي صفة من صفات المخلوقين، ومن اعتقد التشبيه لا يكون على الإسلام لأنه لا يعبد الله بل يعبد صورة تخيلها وتوهمها، وقد قال الغزالي رحمه الله: “لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود” أي أن من لم يعرف الله تعالى بأنه منزه عن مشابهة الخلق فاعتقد مثلا أنه ساكن في السماء أو جالس على العرش أو أنه في كل مكان بذاته أو أنه جسم له أعضاء لا تصح منه عبادة لله لأنه ما عرف الله،
وكفر التكذيب: أي تكذيب ما ورد في القرءان الكريم أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت وكان مما علم من الدين بالضرورة كاعتقاد فناء النار أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معا أو إنكار وجوب الصلاة أو اعتقاد تحليل الخمرة ونحو ذلك.
فالمؤمن المسلم هو من تجنب الكفر بأقسامه الثلاثة:
القولي كمسبة الله والفعلي كإلقاء المصحف في القاذورات والاعتقادي كاعتقاد الشبيه والمثيل لله، وكذا تجنب أنواع الكفر وهي التعطيل والتشبيه والتكذيب.
فالإيمان شرط لقَبول الأعمال الصالحة، فمن لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ثواب له في الآخرة والدلائل على ذلك كثيرة منها، قوله تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوۡمٍ عَاصِفٖۖ لَّا يَقۡدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيۡءٖۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ﴾ [سورة إبراهيم/ الآية 18]، أي أنّهم لا يثابون بأعمالهم بل أعمالهم تكون كالرماد الذي اشتدت به الريح في اليوم العاصف،
وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗ﴾ [سورة النساء/ الآية 124]، فبيّن الله تعالى في هذه الآية أنّ الأعمال الصالحة إنّما يقبلها من المؤمن المسلم فقط لقوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، وأمّا الكافر فمهما فعل من الخيرات في الدنيا لا يثيبه الله عليها، بل توضع سيئاته في الآخرة في كفة الميزان وتطيش الكفة الأخرى أي كفة الحسنات إذ لا حسنات له في الآخرة لأنه أضاع أعظم حقوق الله على عباده وهو توحيده تعالى وعدم الإشراك به، وأما في الدنيا فإنه يجزى على ما فعل من الخيرات فيها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُعْطَى عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا))، وقال أيضا فيما رواه مسلم: ((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ)) معناه أنّ المؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرّمة ومكلّف بفعل الطاعات فإذا مات استراح وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من المنغصات، وأما الكافر فإنّما له من ذلك ما حصَّل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم والشقاء المؤبّد.
وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: ((لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)) فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ابن جدعان من صلة الأرحام وإطعام المساكين غير نافع له لأنّه لم يكن على الإيمان، وابن جدعان كان قريب عائشة وكان مفسدا في مكة فطرده أبوه فكره الحياة فصعد على جبل من جبال مكة فوجد شقا فقال: لعلّ في هذا ثعبانا يقتلني فوجد ثعبانا عيناه تلمعان فاقترب منه فإذا هو ثعبان من ذهب إلا عيناه من لؤلؤ فطمع في الحياة وصار من أغنياء مكة وصار يصل الرحم ويطعم المسكين.
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة حين أنزل الله قوله: (وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِي) [سورة الشعراء/ الآية 214]: ((وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا)) معناه أنا لا أستطيع أن أنفعك إن لم تكوني مؤمنة، وأما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي.
وأما قول بعض الناس: (الدين المعاملة) فغير صحيح، وبعض الناس يزعمون أنّه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلام الرسول بل هو يخالف الدين لأنّه كما بيّنا أنّ من لم يكن على الإسلام مهما فعل من الخيرات فإنه لا ينتفع في الآخرة لو كان يحسن معاملة الناس ولا يكذب فيما يقول للناس من أمور الدنيا ويلتزم بالمواعيد ويصل الرحم ويطعم المسكين كل ذلك لا ينفعه إذا لم يكن على الإسلام لأن الإيمان شرط لقَبول الأعمال الصالحة، والصواب أن نقول أن المعاملة الحسنة من الدين، أي أنّ الدين حثّ على المعاملة الحسنة والخلق الحسن، ويدلّ على ذلك أنّ أبا طالب عمّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن محمدا رسول الله ويعرف أن الإسلام حق، وكان يدافع عن النبي ويخاف عليه من أذى المشركين ويحبه محبة كبيرة حتى قال فيه:
وأبيضَ يستسقى الغمامُ بوجهِه ثِمال اليتامى عصمة للأرامــلِ
ولكنه مع كل هذا كان كافرا، ما أسلم خوفا من أن تعيّره العرب فكان يقول للنبي كلما أمره بالإسلام: لولا أن تُعيرني بها قريش لأقررت بها عينك، وجاء في الصحيحين أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ: ((يَا عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)). فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ)). [أي لأطلبن من الله تعالى أن يهديك فتدخل في الإسلام ما لم أُنْهَ عنك؛ أي ما لم يوحَ إليَّ بأنك تموت كافرا، ولكن أبا طالب مات كافرا لأنه لم ينطق بالشهادتين بل كان ءاخر كلامه قبل وفاته أن قال: أنا على ملة عبد المطلب، وقد جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أنّ عليًّا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ))، فَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا. فَقَالَ: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ)) قَالَ: فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: ((اغْتَسِلْ)). ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة عمه ولم يستغفر له بعد وفاته]، فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [سورة التوبة/ الآية 113]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [سورة القصص/ الآية 56]، أي إنك يا محمد لا تخلق الهداية في قلب من أحببت له الهداية ولكن الله تعالى يخلق الهداية في قلب من شاء له الهداية بعلمه ومشيئته الأزلية التي لا تتغير.
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أبا طالب خالد في النار وهو أقل الكفار عذابا من غير أن يخفف عنه عذابه فقد روى البخاري عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: ((هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)) وفي رواية أخرى عند البخاري قال: ((فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ)).
وبعد هذا البيان نرجع للحديث الذي بدأنا به درسنا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا أُنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وفي رواية عند مالك: ((وأزكاها))، والمعنى: أَيْ: أَنْمَاهَا وَأَنْقَاهَا، وَأَرْفَعِهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أي من الصدقات بأنواعها وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ يعني: من جهاد الكفار. أَيْ: خَيْرٍ مِنْ بَذْلِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْ تُجَاهِدُوا الْكُفَّارَ فَيَضْرِبُوا أَيْ: بَعْضُهُمْ أَعْنَاقَكُمْ وَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ)) أَيْ: أَعْنَاقَ بَعْضِهِمْ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
الصلاة هي أفضل الأعمال العملية أفضل العبادات العملية التي يعملها الشخص المؤمن هي الصلاة، هذا هو المعنى الصواب وليس المعنى أن ذكر الله باللسان وهو سنة أفضل من الجهاد والزكاة وغيرها من الأعمال التي هي فرض، فقد تقرر في الشريعة الإسلامية أن الفرض أفضل من السنة لورود الحديث القدسي المعروف الذي رواه البزار في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه، وهو قوله تعالى: ((ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه))، فبعد ذلك كيف يقال إن الذكر اللساني أفضل من هذه الفروض المذكورة في هذا الحديث.
ففي البخاري عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). إذًا فالمعنى لهذا الحديث ذكرُ أعمال هي من أحب الأعمال إلى الله، فالعربُ تقول: هذا العمل أحب الأعمال وتريد من أحب الأعمال وتقول هذا العمل أفضل الأعمال وتريد من أفضل الأعمال.
وقد ثبت في الشرع أنه يَجِبُ أَدَاءُ كُلٍّ مِنَ الصلوات الْخَمْسِ فِي وَقْتِهَا فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [سورة النساء/ الآية 103]، كتابًا أي فرضًا، موقوتًا أي لها وقت محدود، فلا بُدَّ أن يُؤدّيَها المسلم في الوقت الذي فرضهُ الله عليه. وَلا يَجُوزُ تَقْديِمُهَا عَلَى وَقْتِهَا أَيْ فِعْلُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَلا تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِلا عُذْرٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [سورة الماعون/ الآية 4-5] وَالْمُرَادُ بِالسَّهْوِ عَنِ الصَّلاةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ تَأْخِيرُ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى فَتَوَعَّدَ اللهُ مَنْ يُخْرِجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِالْوَيْلِ وَهُوَ الْهَلاكُ الشَّدِيدُ.
وقد روى البيهقي عَنْ سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [سورة الماعون/ الآية 5] قَالَ: ((هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا))،
وروى النسائي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا)).
وذكر الله ممدوح مُرَغَّبٌ فيه، قال تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [سورة الأحزاب/ الآية 41]،
وقال تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ [سورة البقرة/ الآية 198]،
وقال عز وجل: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [سورة البقرة/ الآية 200]،
قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [سورة آل عمران/ الآية 191]،
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [سورة النساء/ الآية 103] قال ابن عباس رضي الله عنهما: “أَيْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ وَالْمَرَضِ وَالصِّحَّةِ وَالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ”.
وَقَالَ تَعَالَى فِي ذَمِّ الْمُنَافِقِينَ: ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [سورة النساء/ الآية 142]،
وقال عز وجل: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [سورة الأعراف/ الآية 205].
ثُمَّ لَا ارْتِيَابَ أَنَّ أَفْضَلَ الذِّكْرِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهِيَ الْقَاعِدَةُ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا أَرْكَانُ الدِّينِ، وَهِيَ الْكَلِمَةُ الْعُلْيَا، وَهِيَ الْقُطْبُ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا رَحَى الْإِسْلَامِ، وَهِيَ الشُّعْبَةُ الَّتِي أَعْلَى شُعَبِ الْإِيمَانِ.
والله تعالى أعلم وأحكم
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة