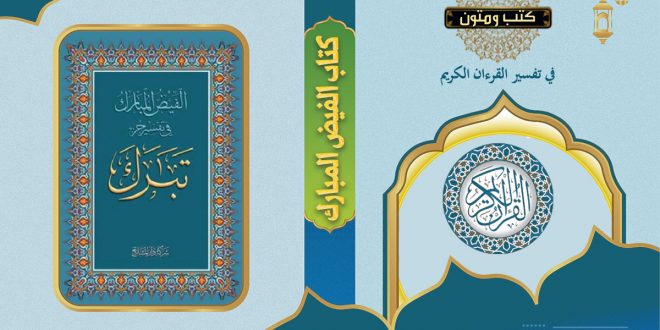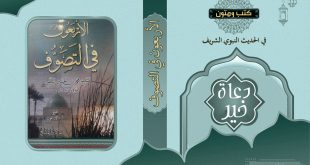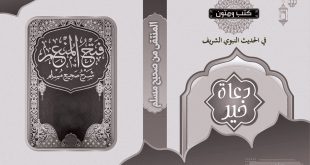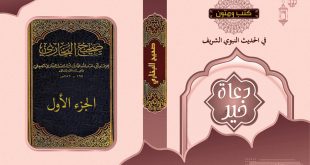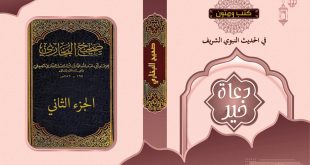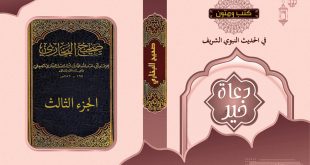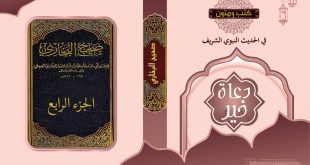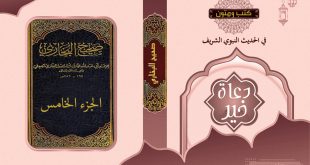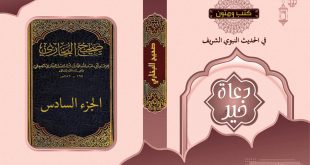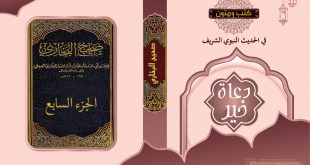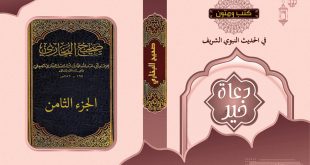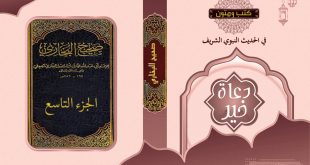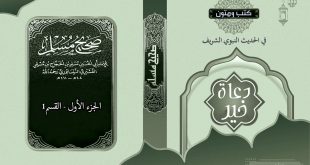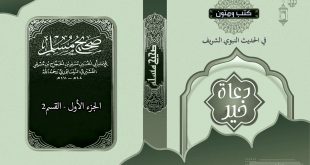المقدمة
الحمد لله الذي شرَّف أمة محمد بالقرءان المجيد، وحفظه من تحريف كل عنيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي بتوفيق الله إلى الأمر الرشيد، وعلى ءاله الأخيار، وصحابته الأطهار.
وبعد: فإن علم التفسير علم جليل يُتوصل به إلى فهم معاني القرءان الكريم، ويُستفاد منه استنباط الأحكام الشرعية والاتعاظ بما فيه من القصص والعبر إلى غير ذلك من الفوائد، إضافة إلى ما يُعرف به من أسباب نزول الآيات مع معرفة مكيّها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ووعدها ووعيدها وغير ذلك.
ولما كان علم التفسير شرفه عظيم، قمنا بإعداد تفسير لجزء تبارك ذكرنا فيه أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والغريب، واختلاف وجوه القراءات، وأسميناه “الفيض المبارك في تفسير جزء تبارك”، ونسأل الله الكريم أن يجعله عملًا خالصًا متقَبَّلًا إنه سميع مجيب.
سورة الملك
سورة الملك
مكية في قول الجميع، وتسمى الواقية والمنجية وهي ثلاثون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنْ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) ءَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ (29) قُلْ ءَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ (30)
روى أبو داود 1 والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سورةٌ في القرءان ثلاثون ءاية شَفعتْ لصاحبها حتى غُفِرَ له ﴿تباركَ الذي بيدِهِ المُلك﴾.
وروى الترمذي عن ابن عباس أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خِباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فسمع من القبر قراءة ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: “هي المانعةُ، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر” وحسّنه الترمذي والسيوطي 2.
————-
1- أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب في عدد الآي، والترمذي في سننه: في ثواب القرءان: باب ما جاء في فضل سورة الملك، والحاكم في المستدرك [1/565] وصححه.
2- أخرجه الترمذي في سننه: كتاب فضائل القرءان: باب ما جاء في فضل سورة الملك، وأورده السيوطي في الجامع الصغير [2/56].
﴿تباركَ﴾ أي تبارك الله أي دام فضلهُ وبره وتعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين ﴿الذي بيدهِ﴾ أي بتصرفه، فاليد هنا كنابة عن الإحاطة والقهر قال ابن عباس: يعني السلطان، يُعِزُّ ويُذِلُّ ﴿المُلك﴾ أي ملك السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، جميع الخلائق مقهورون بقدرته، يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء يُعِزُّ من يشاء ويُذِلُّ من يشاء، وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير ﴿وهوَ﴾ أي الله ﴿على كُلِّ شيءٍ﴾ ممكن يقبل الوجود والعدم ﴿قديرٌ﴾ فلا يمنعه من فعله مانع ولا يحول بينه وبينه عجز، ولا دافع لِما قضى ولا مانع لما أعطى.
﴿الذي خلقَ الموتَ والحياةَ﴾ أي الله الذي خلق الموت والحياة فأمات من شاء وأحيا من شاء إلى أجل معلوم، وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء ﴿ليَبْلُوَكُم﴾ أي ليمتحنكم بأمره ونهيه فيُظهر منكم ما علم أنه يكون منكم فيجازيكم على عملكم ﴿أيُّكُم﴾ أيها الناس ﴿أحسنُ عملاً﴾ أي أطوع وإلى طلب رضاه أسرع، أو أيكم أخلصه وأصوبه فالخالص أن يكون لوجه الله والصواب أن يكون على السُّنة. والمراد أنه أعطاكم الحياة التي تقدرون بها على العمل وسلط عليكم الموت الذي هو داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح من حيث إن وراءه البعث والجزاء الذي لا بد منه ﴿وهوَ العزيزُ﴾ الغالب القوي الشديد انتقامه ممن عصاه وخالف أمره ﴿الغفورُ﴾ لمن تاب من ذنوبه. ”
﴿الذي خلقَ﴾ أي أوجد وأبرز من العدم إلى الوجود ﴿سَبْعَ سمواتٍ طِباقًا﴾ أي سبع سموات بعضها فوق بعض كما ثبت في حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري ومسلم ﴿ما ترى﴾ يا ابن ءادم ﴿في خَلْقِ الرَّحمنِ﴾ العزيز الحكيم ﴿مِن تفاوتٍ﴾ قال البخاري: التفاوت: الاختلاف، والتفاوت والتفوت واحد”، وحقيقة التفاوت عدم التناسب كأنّ بعض الشيء يفوت بعضًا ولا يلائمه، والمعنى: ما ترى يا ابن ءادم في شيء مما خلق الله عز وجل من اعوجاج ولا تناقض ولا عيب ولا خطإ، وليس المراد أن المخلوقات لا يختلف بعضها عن بعض من حيث الشكل والصفة فالاختلاف هنا المراد به ما يناقض الحكمة بالنسبة للخالق، والله عز وجل حكيم لا يجوز عليه العبث والسّفه.
وقرأ حمزة والكسائي: “من تَفَوُّتٍ” بتشديد الواو من غير ألف، وقرأ الباقون بألف.
ثم أمر سبحانه وتعالى بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته فقال: ﴿فارْجِعِ البَصرَ﴾ أي كرر النظر إلى السماء وتأملها ﴿هل ترى﴾ فيها يا ابن ءادم ﴿من فطورٍ﴾ أي من شقوق وصدوع أو عيب أو خلل، والفطور: الشقوق. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام “هل ترى” بإدغام اللام في التاء.
﴿ثُمَّ ارجِعِ البصرَ كرَّتَيْنِ﴾ مرة بعد مرة، وإنما أمر بالنظر مرتين لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة قد لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى، فأخبر تعالى أنه وإن نظر في السماء مرتين لا يرى فيها عيبًا ولا خللاً، وجواب الأمر ﴿يَنْقلِبْ﴾ أي ويرجع ﴿إليكَ البصرُ خاسِئًا﴾ أي صاغرًا ذليلاً متباعدًا عن أن يرى عيبًا أو خللاً، وأبدل أبو جعفر ﴿خاسِئًا﴾ بياء مفتوحة، ﴿وهوَ حسيرٌ﴾ أي كليل منقطع قد بلغ الغاية في الإعياء لم ير خللاً ولا تفاوتًا.
﴿ولقدْ زيَّنَّا السماءَ الدُنيا﴾ وهي السماء القريبة من الأرض والتي نشاهدها ويراها الناس ﴿بِمصابيحَ﴾ أي بنجوم لها نور ﴿وجعلناها﴾ أي جعلنا منها ﴿رُجُومًا للشياطينِ﴾ أي يُرجم الشياطين المسترقون للسمع بشُهب تنفصل عن هذه النجوم ﴿وأعتدنا لهُم﴾ أي هيأنا للشياطين في الآخرة ﴿عذابَ السَّعير﴾ أي النار الموقدة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا.
﴿وللذينَ كفروا بربِّهم﴾ وأعتدنا للذين كفروا بالله من إنس وجن ﴿عذابَ جهنَّمَ﴾ وهي نار عظيمة جدًا، وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أنها أوقِدَ عليها ألف سنة حتى احمرت وألف سنة حتى ابيضّت وألف سنة حتى اسودّت فهي سوداء مظلمة ﴿وبئسَ﴾ وهي كلمة ذم ﴿المصير﴾ أي المرجع أي بئس المآل والمنقلَب الذي ينتظرهم وهو عذاب جهنم، أجارنا الله منها.
﴿إذا أُلقُوا فيها﴾ يعني إذا ألقي الكفار في جهنم وطُرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار العظيمة ﴿سَمِعوا لها﴾ يعني لجهنم ﴿شهيقًا﴾ والشهيق: الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة، والمراد أنهم سمعوا صوتًا منكرًا كصوت الحمار، تصوّت مثل ذلك لشدة توقدها وغليانها ﴿وهيَ تفورُ﴾ أي تغلي بهم كغلي المِرْجَلِ.
﴿تكادُ﴾ جهنم ﴿تميَّزُ﴾ يعني تتقطع وتتفرق، وقرأ البزي “تميز” بتشديد التاء وصلاً، والباقون بالتخفيف ﴿مِنَ الغَيظِ﴾ على الكفار، فجعلت كالمغتاظة عليهم استعارة لشدة غليانها بهم ﴿كُلَّما أُلقِيَ فيها فوجٌ﴾ أي فريق وجماعة من الكفار ﴿سألهُم خَزنتُها﴾ وهم مالك وأعوانه، وسؤالهم على جهة التوبيخ والتقريع وهو مما يزيدهم عذابًا إلى عذابهم ﴿ألمْ يأتِكُم نذيرٌ﴾ أي رسول في الدنيا ينذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه.
﴿قالوا بلى قدْ جاءنا نذيرٌ﴾ أنذرنا وخوَّفنا، كما في قوله تعالى: ﴿وقالَ لهُم خَزَنتُها ألَم يأتِكُم رُسُلٌ منكُم يَتلونَ عَلَيكُمْ ءاياتِ ربِّكم ويُنذِرُونَكُم لقاءَ يومكم هذا قالوا بلى ولكنْ حقَّتْ كلمةُ العذابِ على الكافرين﴾ [سورة الزمر]، فاعترف الكفار بأن الله عز وجل أرسل إليهم رسلاً ينذرونهم لقاء يومهم هذا واعترفوا أيضًا بأنهم كذبوهم كما قال الله تعالى إخبارًا عنهم: ﴿فكذَّبنا وقُلنا﴾ أي قالوا للرسول المرسل إليهم ﴿ما نزَّلَ اللهُ﴾ عليك ﴿مِن شيءٍ﴾ مما تقول من وعد ووعيد وغير ذلك ﴿إنْ أنتُم إلا في ضلالٍ كبيرٍ﴾ وفيه وجهان، قال أبو حيان في تفسيره “البحر المحيط” (البحر المحيط [8/300]). ما نصه: “الظاهر أن قوله: ﴿إنْ انتُم إلا في ضلالٍ كبيرٍ﴾ من قول الكفار للرسل الذين جاءوا نُذرًا إليهم، أنكروا أوَّلاً أن الله نزّل شيئًا واستجهلوا ثانيًا من أخبر بأنه تعالى أرسل إليهم الرسل وأن قائل ذلك في حيرة عظيمة، ويجوز أن يكون من قول الخزنة للكفار إخبارًا لهم وتقريعًا بما كانوا عليه في الدنيا، وأرادوا بالضلال الهلاك الذي هم فيه، أو سَمّوا عقاب الضلال ضلالاً لما كان ناشئًا عن الضلال” ا.هـ.
﴿وقالوا﴾ أي وقال الكفار أيضًا وهم في النار لخزنة جهنم ﴿لوْ كُنَّا﴾ في الدنيا ﴿نسمعُ﴾ من النذر أي الرسل ما جاءوا به من الحق سماع طالب للحق ﴿أو نعقِلُ﴾ عقل متأمل ومفكّر بما جاء به الرسل ﴿ما كُنَّا في أصحابِ السَّعير﴾ يعني ما كنا من أهل النار ولن نستوجب الخلود فيها.
﴿فاعْتَرفوا بذنبهم﴾ أي بكفرهم في تكذيبهم الرسل وهذا الاعتراف لا ينفعهم ولا يخلصهم من عذاب الله ﴿فسُحقًا﴾ أي فبُعدًا، ﴿لأصحابِ السَّعيرِ﴾ وهم أهل النار من رحمة الله، وهو دعاء عليهم. وقرأ أبو جعفر والكسائي بضم الحاء: “فسُحُقًا”.
واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد المؤمنين فقال: ﴿إنَّ الذينَ يَخْشَوْنَ ربَّهُم﴾ أي يخافونه ﴿بالغيبِ﴾ أي الذي أخبروا به من أمر المعاد وأحواله، أو يخافونه وهم في غيبتهم عن أعين الناس في خلواتهم فآمنوا به وأطاعوه سرًا كما أطاعوه علانية ﴿لهُم مغفرةٌ﴾ أي عفو من الله عن ذنوبهم ﴿وأجرٌ كبيرٌ﴾ وهو الجنة.
﴿وأسِرُّوا﴾ أي اخفوا أيها الناس ﴿قولَكُم أوِ اجهَروا بهِ﴾ أي أعلنوه وأظهروه، واللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر يعني إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم به فـ﴿إنَّهُ﴾ تعالى ﴿عليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ﴾ يعني بما في القلوب من الخير والشر فكيف بما نطقتم به، والآية فيها بيان استواء الأمرين أي الإسرار والجهر في علم الله تعالى.
قال ابن الجوزي: “قال ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل بما قالوا، فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد” ا.هـ.
﴿ألا يعلمُ﴾ الخالق جلّ ثناؤه ﴿مَنْ خلقَ﴾ وهو الذي أحاط بخفيات الأمور وجلياتها وعلم ما ظهر من خلقه وما بطن، أو ألا يعلم الخالق سركم وجهركم وهو استفهام معناه الإنكار أي كيف لا يعلم مَن خلق الأشياء وأوجدها من العدم الصرف ﴿وهُوَ اللطيفُ﴾ المحسن إلى عباده في خفاء وسترٍ من حيث لا يحتسبون ﴿الخبيرُ﴾ أي المطّلع على حقيقة الأشياء فلا تخفى على الله خافية.
﴿هوَ الذي جعلَ لكُمُ الأرضَ ذلولاً﴾ أي الله هو الذي جعل لكم أيها الناس الأرض سهلة تستقرون عليها ويمكن المشي فيها والحفر للآبار وشق العيون والأنهار فيها وبناء الأبنية وزرع الحبوب وغرس الأشجار فيها ونحو ذلك ولو كانت صخرة صلبة لما تيسر شيء منها ﴿فامْشوا في مَناكِبِها﴾ أي طرقاتها، وقيل جبالها، وقيل جوانبها، قال البخاري: “مناكبها: جوانبها”، والمعنى: هو الذي سهل لكم السلوك في جبالها وهو أبلغ في التذليل ﴿وكُلوا من رِزقِهِ﴾ مما أحله الله لكم ﴿وإليهِ النُّشورُ﴾ أي المرجع يوم القيامة، فتُبعثون من قبوركم للحساب والجزاء. ثم خوّف كفار مكة فقال:
﴿ءأمِنْتُم﴾ أي أتأمنون، وقرأ قنبل عن ابن كثير: “وإليه النشور وأمنتم”، وقرأ قالون عن نافع، وأبو عمرو وأبو جعفر: “النشور ءامنتم” بهمزة ممدودة وتسهيل الثانية، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ﴿ءَأَمِنتُم﴾ بتحقيق الهمزتين.
﴿مَّن في السَّماءِ﴾ أي المَلَك الموكَّل بالعذاب وهو جبريل ﴿أن يَخْسِفَ بكُمُ الأرضَ﴾ وهو ذهابها سُفلاً كما خُسفت بقارون، وكما خسف جبريل بمدن قوم لوط ﴿فإذا هيَ تَمُورُ﴾ تتحرك بأهلها، والمعنى أن الله تعالى يحرك الأرض بقدرته عند الخسف بهم حتى يقلبهم إلى أسفل وتعلو الأرض عليهم وتمور فوقهم أي تذهب وتجيء.
فائدة مهمة: ذكر أهل التفسير عند بيان معنى هذه الآية أن الله تعالى لا يوصف بالمكان ولا يتحيز في جهة لأن ذلك من صفات الأجسام والله ليس جسمًا كبيرًا ولا جسمًا صغيرًا فلا يسكن السماء ولا يسكن العرش ولا يجلس عليه، فربنا تبارك وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان، وقد قال الحافظ العراقي في أماليه في تفسير حديث: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”: “واستُدلَّ بهذه الرواية: “أهل السماء” على أن المراد بقوله “من في السماء”: الملائكة” ا.هـ.
﴿أمْ أمِنتُم مَّن في السَّماءِ أن يُرسِلَ عليكُم حاصِبًا﴾أي ريحًا ذات حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل ﴿فَسَتعلمونَ﴾ أيها الكفرة ﴿كيفَ نذيرِ﴾ أي كيف عاقبة نذيري لكم إذ كذبتم به ورددتموه على رسولي، والمعنى: وإذا عاينتم العذاب فستعلمون أن إنذاري بالعذاب حق حين لا ينفعكم العلم.
﴿ولقَدْ كَذَّبَ﴾ أي المشركون ﴿الذينَ مِن قبلِهِم﴾ أي من قبل كفار مكة وهم الأمم الخالية كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مَدْيَن وقوم فرعون، فإنهم كذبوا ما جاءت به الرسل ﴿فكيفَ كانَ نكيرِ﴾ أي إنكاري عليهم أليس وجدوا العذاب حقًا؟ بلى.
ولمّا حذرهم ما يمكن إحلاله بهم من الخسف وإرسال الحاصب نبّههم على الاعتبار بالطير وما أحكم من خلقها فقال عز وجل: ﴿أوَلَمْ يرَوا﴾ المشركون ﴿إلى الطيرِ﴾ جمع طائر تطير ﴿فوقهم﴾ في الهواء ﴿صافَّاتٍ﴾ أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها ﴿ويَقْبِضنَ﴾ أي يضممن الأجنحة إلى جوانبهن، قال البخاري: “يضربن بأجنحتهن، وقال مجاهد: صافاتٍ بَسْطُ أجنحتهن” ﴿ما يُمسِكُهُنَّ﴾ عن الوقوع مع ثقلها وضخامة أجسامها ﴿إلا الرحمنُ﴾ سبحانه وتعالى، والمعنى: لم يكن بقاؤها في جو الهواء إلا بقدرة الله وحفظه ﴿إنَّهُ﴾ تعالى ﴿بِكُلِّ شيءٍ بصيرٌ﴾ أي عالم بالأشياء ولا تخفى عليه خافية.
﴿أمَّنْ﴾ أي من ﴿هذا الذي هُوَ جُنْدٌ﴾ أي أعوان ﴿لكُم﴾ أيها الكافرون ﴿يَنْصُرُكُم﴾ يمنع ويدفع عنكم العذاب إذا نزل بكم، والمعنى لا ناصر لكم، وقرأ البصري: “يَنْصُرْكُم” بسكون الراء بخلف عن الدوري، ﴿مِّن دونِ الرَّحمنِ﴾ أي سوى الرحمن، فقوله تعالى: ﴿أمَّن هذا الذي﴾ هو استفهام إنكار أي لا جند لكم يدفع عنكم عذاب الله.
﴿إنِ الكافرونَ﴾ أي ما الكافرون بالله ﴿إلا في غُرُورٍ﴾ من الشياطين تغرُّهم بأن لا عذاب ولا حساب، أو المعنى: ما الكافرون بالله إلا في غرور من ظنهم أنّ ما يعبدونه من دون الله يقربهم إلى الله زُلفى وأنها تنفع أو تضر.
﴿أمَّنْ﴾أي من ﴿هذا الذي يرزُقُكم﴾ أي يطعمكم ويسقيكم ويأتي بأقواتكم وينزل عليهم المطر ﴿إنْ أمسَكَ رزقهُ﴾ أي قطع عنكم رزقه، والمعنى: لا أحد يرزقكم إن حبس الله عنكم أسباب الرزق كالمطر والنبات وغيرهما ﴿بل لجُّوا﴾ أي تمادوا وأصروا مع وضوح الحق ﴿في عُتُوٍّ﴾ أي تكبر وعناد ﴿ونُفُورٍ﴾ أي تباعد عن الحق وإعراض عنه.
ثم ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر فقال: ﴿أفَمَن يمشي مُكِبًّا على وجهِهِ﴾ أي منكسًا رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله فهو لا يأمن من العثار والانكباب على وجهه ولا يدري أين يذهب، وهذا هو الكافر أكب على الكفر والمعاصي في الدنيا فحشره الله على وجهه يوم القيامة، أهذا ﴿أهدى﴾ أي أشد وأرشد استقامة على الطريق وأهدى له ﴿أمَّن﴾ أي أم من ﴿يمشي سَوِيًّا﴾ معتدلاً ناظرًا ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله يبصر الطريق ﴿على صِراطٍ﴾ أي طريق ﴿مُستقيمٍ﴾ أي مستو لا اعوجاج فيه. وقد شبّه الله تعالى المؤمن في تمسكه بالدين الحق ومشيه على منهاجه بمن يمشي في الطريق المعتدل الذي ليس فيه ما يتعثر به، وشبّه الكافر في ركوبه ومشيه على الدين الباطل بمن يمشي في الطريق الذي فيه حفر وارتفاع وانخفاض فيتعثر ويسقط على وجهه كلّما تخلص من عثرة وقع في أخرى، وقرأ قنبل: “صراط” بالسين.
﴿قُلْ﴾ يا محمد للمشركين ﴿هُوَ الذي أنْشَأَكُم﴾ أي الله الذي خلقكم ﴿وجعلَ لكُم السَّمْعَ﴾ تسمعون به ﴿والأبصارَ﴾ تُبصرون بها ﴿والأفئدةَ﴾ أي القلوب تعقلون بها ﴿قليلاً ما تشكرون﴾ أي قليلاً ما تشكرون الله على هذه النعم التي أنعمها عليكم، وشكر نعمة الله هو أن يصرف تلك النعمة إلى وجه رضاه وأنتم لمّا صرفتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاة الله فأنتم ما شكرتم نعمته البتة.
﴿قُلْ﴾ يا محمد: الله ﴿هُوَ الذي ذَرَأكُم﴾ أي بثكم وفرّقكم ﴿في الأرضِ وإليهِ تُحشَرون﴾ أي تبعثون يوم القيامة فتُجمعون من قبوركم للحساب والجزاء، والمعنى أن القادر على خلقكم من العدم قادر على إعادتكم وفي ذلك ردّ على منكري البعث والحشر.
﴿ويقولونَ﴾ أي المشركون المنكرون للبعث ﴿متى هذا الوعدُ﴾ أي متى يوم القيامة ومتى هذا العذاب الذي تعدوننا به ﴿إنْ كُنتُم صادقينَ﴾ في وعدكم إيانا ما تعدوننا، وهذا استهزاء منهم، فاجابهم الله عن ذلك بقوله:
﴿قُلْ﴾ أي يا محمد ﴿إنَّما العلمُ﴾ بوقت قيام الساعة ﴿عندَ اللهِ﴾ لا يعلم ذلك غيره ﴿وإنَّما أناْ نذيرٌ﴾ لكم أنذركم عذاب الله على كفركم به ﴿مُبينٌ﴾ أي أبين لكم الشرائع.
﴿فلمَّا رَأَوْهُ﴾ أي فلما رأى هؤلاء المشركون العذاب الموعود به في الآخرة ﴿زُلفةً﴾ أي قريبُا منهم ﴿سِيئَتْ وجوهُ الذينَ كفروا﴾ ظهر فيها السوء والكآبة وغشيها السواد كمن يُساق إلى القتل ﴿وقيلَ﴾ أي تقول لهم الزبانية ومن يوبخهم ﴿هذا﴾ العذاب ﴿الذي كُنتم بهِ تدعون﴾ أي تفتعلون من الدعاء أي تمنَّون وتسألون تعجيله وتقولون ائتنا بما تعدنا، أو هو من الدعوى أي كنتم بسببه تدّعون أنكم لا تبعثون إذا متم.
فائدة: قرأ يعقوب: “به تدعون” بتخفيف الدال وسكونها، والباقون بتشديد الدال وفتحها، والأول على معنى تطلبون وتستعجلون، والثاني من الدعوى أي تدعون الأباطيل والأكاذيب وأنكم إذا متم لا تُبعثون، قال البخاري: “تدَّعون وتَدْعون واحدٌ مثلُ تذَّكَّرون وتَذْكُرون”.
﴿قُل﴾ أي قل يا محمد للمشركين من قومك الذين كانوا يتمنون موتك ﴿أرَءَيتُم إنْ أهْلَكَنيَ اللهُ﴾ أي أماتني كما تريدون، قرأ حمزة: “أهلكني” بإسكان الياء فتحذف لفظًا في الوصل وترقق لام الجلالة لكسر النون، والباقون بفتحها فتفخم لام الجلالة للفتح.
﴿ومَن مَّعيَ﴾ من المؤمنين، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر، وحفص عن عاصم: “معيَ” بفتح الياء، وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي: “معي” بالإسكان، ﴿أوْ رَحِمَنا﴾ فأبقانا وأخّر في ءاجالنا فلم يعذبنا بعذابه ﴿فمَن يُجيرُ الكافرينَ مِن عذابٍ أليمٍ﴾ أي من يحميكم ويمنع عنكم العذاب الموجع المؤلم الذي سببه كفركم، والمعنى: لا، ليس ينجي الكفار من عذاب الله موتُنا وحياتُنا فلا حاجة بكم إلى أن تستعجلوا قيامَ الساعة ونزول العذاب فإن ذلك غيرُ نافعكم بل ذلك بلاء عليكم عظيم.
﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿هُوَ الرَّحمنُ﴾ أي الذي نعبده ونوحده وأدعوكم إلى عبادته ﴿ءامَنَّا بهِ﴾ أي صدقنا به ولم نشرك به شيئًا ﴿وعليهِ توكَّلنا﴾ أي وعليه اعتمدنا في أمورنا وأن الضار والنافع على الحقيقة هو الله.
﴿فَسَتَعْلَمونَ﴾ أيها المشركون بالله إذا نزل بكم العذاب وعاينتموه، وقرأ الكسائي بالياء من تحتُ، والباقون بالتاء من فوق.
﴿مَن هُوَ في ضلالٍ﴾ أي من هو بعيد عن الحق وعلى غير طريق مستقيم نحن أم أنتم ﴿مُبينٍ﴾ أي بيّن.
﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين ﴿أرَءَيْتُم﴾ أيها القوم أي أخبروني يا معشر قريش ﴿إنْ أصبحَ ماؤُكُمْ غَوْرًا﴾ أي غائرًا ذاهبًا في الأرض إلى أسفل لا تناله الأيدي ولا الدّلاء وهو جمع دلو ﴿فمَنْ﴾ أي الذي ﴿يأتيكُم بماءٍ مَّعين﴾ أي بماء طاهر تراه العيون، أو جارٍ يصل إليه من أراده، أي لا يأتيكم به إلا الله فكيف تنكرون أن يبعثكم.
ويروى أن هذه الآية تُليت عند ملحد فقال: يأتي به الفئوس والمعاول، فذهب ماء عينه في تلك الليلة وعمي، نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى ءاياته، ونسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا ويحسن ختامنا ويدخلنا الجنة مع الأبرار ءامين.
سورة القلم
سورة القلم
مكية، وهي اثنتان وخمسون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيّيِكُمْ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُم أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِن الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (52)
مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه فيما قبلها ذكر الله أشياء من أحوال السعداء والأشقياء، وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع، وأنه تعالى لو شاء لخسف بهم الأرض أو لأرسل عليهم حاصبًا، وكان ما أخبر الله تعالى به هو ما تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وكان الكفار ينسبونه مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر ومرة إلى الجنون، فبدأ سبحانه وتعالى هذه السورة ببراءته صلى الله عليه وسلم مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون، وتعظيم أجره على صبره على أذاهم وبالثناء على خلُقه العظيم، فقال عز وجل:
﴿ن﴾ قرأ ابن كثير ونافع بخلف عن ورش وأبو عمرو وحمزة وحفص بإظهار النون أي بفك الإدغام من واو القسم، وقرأ ابن عامر والكسائي وشعبة وخلف ويعقوب بإدغام النون في الواو، وهو أحد حروف الهجاء، والله أعلم بمراده به ﴿والقلم﴾ الواو واو القسم، أي يُقسم ربنا عز وجل بالقلم، والقلم معروف غير أن الذي أقسم به ربنا من الأقلام القلم الذي خلقه الله تعالى فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة من الآجال والأعمال والأرزاق وغيرها ﴿وما يَسْطُرونَ﴾ أي وما يكتبون، والمعنى ما تكتبه الملائكة الحفظة من أعمال بني ءادم.
﴿ما أنْتَ﴾ يا محمد ﴿بِنِعمةِ ربِّكَ﴾ أي بسبب نعمة ربك عليك بالإيمان والنبوة وغيرهما ﴿بِمَجنونٍ﴾ أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون شيطان، فنزلت: ﴿ما أنتَ بنعمةِ ربكَ بمجنون﴾ أي وما أنت بإنعام ربك عليك بالإيمان والنبوة بمجنون، ونِعَمُ الله ظاهرة عليك من الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية والبراءة من العيوب والأخلاق الحميدة، وفي ذلك رد وتكذيب للمشركين في قولهم إنه مجنون.
﴿وإنَّ لكَ﴾ يا محمد ﴿لأجرًا﴾ أي ثوابًا من الله عظيمًا على صبرك على أذى المشركين إياك فلا يمنعك ما قالوا عن دعاء الخلق إلى الله تعالى ﴿غيرَ ممنونٍ﴾ أي غير منقوص ولا مقطوع.
﴿وإنَّكَ﴾ يا محمد ﴿لعلى خُلُقٍ عظيمٍ﴾ روى مسلم [1] عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: “فإن خُلُق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرءان”، والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرءان.
————-
1- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض.
﴿فسَتُبْصِرُ﴾ أي فستعلم يا محمد ﴿ويُبْصِرونَ﴾ وسيعلم المشركون من أهل مكة يوم القيامة وهذا وعيد لهم.
﴿بِأيِّيكُمُ المَفتونُ﴾ في أي الفريقين المجنون أبالفرقة التي أنت فيها من المؤمنين أم بالفرقة الأخرى، وقيل غير ذلك.
﴿إنَّ ربَّكَ﴾ يا محمد ﴿هُوَ أعلمُ﴾ أي عالم ﴿بِمَنْ ضلَّ عن سبيلِهِ﴾ أي حاد عن دينه ﴿وهُوَ﴾ أي الله ﴿أعلمُ﴾ أي عالم ﴿بالمُهتَدينَ﴾ الذي هم على الهدى فيجازي كُلاً غدًا بعمله.
﴿فلا تُطِعِ﴾ يا محمد وذلك أن رؤساء أهل مكة دعَوه إلى دينهم ﴿المُكَذِّبينَ﴾ الذين كذبوا بما أنزل الله عليك من الوحي وهذا نهي عن طواعيتهم في شيء مما كانوا يدعونه إليه من الكف عنهم ليكفّوا عنه ومن تعظيم ما كانوا يعبدونه من دون الله وغير ذلك.
﴿وَدُّوا﴾ أي تمنوا ﴿لوْ تُدْهِنُ﴾ أي تلين لهم ﴿فيُدهِنونَ﴾ أي يلينون لك، ومعنى الآية أنهم تمنوا أن تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك، ويتركوا بعض ما لا ترضى به فتلين لهم ويلينوا لك.
﴿ولا تُطِعْ﴾ أي يا محمد ﴿كُلَّ حلّافٍ﴾ أي كل ذي إكثار للحلف بالباطل ﴿مَهينٍ﴾ أي حقير في الرأي والتمييز، وقال بعضهم: مهين أي كذاب لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه [2]: “اختُلِفَ في الذي نزلت فيه فقيل: هو الوليد بن المغيرة وذكره
يحيى بن سلام في تفسيره، وقيل: الاسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن داود في تفسيره، وقيل: الأخنس بن شريق وذكره السهيلي عن القتيبي، وحكى هذين القولين الطبري فقال: يقال: هو الأخنس، وزعم قوم أنه الأسود وليس به، وأبعد من قال: إنه عبد الرحمن بن الأسود فإنه يصغر عن ذلك، وقد أسلم، وذكر في الصحابة” ا.هـ.
————-
2- فتح الباري شرح صحيح البخاري [8/662-663].
﴿هَمَّازٍ﴾ قال ابن عباس: “هو المغتاب”، والغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكره مما فيه في خلفه، وقد روى أبو داود في سننه [3] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لما عُرج بي مررتُ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم”.
﴿مَّشَّاءٍ بنَمِيمٍ﴾ أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، والنميمة هي نقل القول للإفساد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يدخُلُ الجنةَ قتَّاتٌ” رواه البخاري [4]، والقتات هو النمام، ومعنى الحديث لا يدخلها مع الأولين.
————-
3- أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في الغيبة.
4- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب ما يكره من النميمة.
﴿مَّنَّاعٍ للخَيْرِ﴾ الظاهر أن الخير هنا يراد به العموم فيما يطلق عليه خير، قاله أبو حيان، وقيل: بخيل المال، وقيل: يمنع ولده وعشيرته عن الإسلام يقول لهم من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدًا.
﴿مُعْتَدٍ﴾ أي على الناس في الظلم متجاوز للحد صاحب باطل ﴿أثِيمٍ﴾ كثير الآثام.
﴿عُتُلٍّ﴾ أي الغليظ الجافي، وقيل: الذي يعتُل الناس أي يحملهم ويجرهم إلى ما يكرهون من حبس وضرب، وقيل: الشديد الخصومة بالباطل، وقيل: الفاحش اللئيم، وقيل: الأكول الشروب الغشوم الظلوم.
﴿بَعْدَ﴾ أي مع ﴿ذَلِكَ﴾ فهو ﴿زَنِيمٍ﴾ والمعنى: مع ما وصفه الله به من الصفات المذمومة فهو زنيم، والزنيم هو الدَّعيُّ في قريش وليس منهم، وقيل: هو الذي يُعرف بالشر كما تُعرف الشاة بزنمتها وهي المتدلية من أذنها ومن الحَلق. وروى البخاري[5] عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ قال: “رجلٌ من قريش له زَنَمَة مثلُ زَنَمَة الشاة” ا.هـ.
وروى البخاري[6] عن حارثة بن وَهْبٍ الخُزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “ألا أخبركم بأهل الجنة، كُلُّ ضعيف مُتَضَعّفٍ لو أقسم على الله لأبرَّه، ألا أخبركم بأهل النار كُلُّ عُتُل جَوَّاظٍ مُستكبر”، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ولا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ* هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ فلم نعرفه –أي للوليد بن المغيرة- حتى نزل عليه بعد ذلك ﴿زَنِيمٍ﴾ فعرفناه له زنمة كزنمة الشاة.
————-
5- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب {عُتُلٍّ بعدَ ذلكَ زنيمٍ}.
6- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب {عُتُلٍّ بعدَ ذلكَ زنيمٍ} من سورة ن.
﴿إذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا﴾ قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، والكسائي، وحفص عن عاصم: “أن كان” على الخبر، أي لأن كان، والمعنى لا تطعه لماله وبنيه، وقرأ ابن عامر بهمزتين: الأولى مخففة والثانية ملينة، وفَصَلَ بينهما بألف أبو جعفر، وقرأ حمزة: “أأن كان” بهمزتين محققتين على الاستفهام، وله وجهان: أحدهما: لأن كان ذا مال تطيعه وهذا تقريع لهذا الحلاف المهين، والثاني: ألأن كان ذا مال وبنين.
﴿إذا تُتْلى عليهِ ءاياتُنا﴾ أي القرءان ﴿قَالَ أَسَاطِيرُ الْأوَّلِينَ﴾ أي قال: أباطيلهم وترهاتهم وخرافاتهم، وهذا الذي قال إنما هو استهزاء بآيات الله وإنكار منه أن يكون ذلك من عند الله.
ولمَّا ذكر قبائح أفعاله وأقواله ذكر ما يُفعل به على سبيل التوعد فقال تعالى:
﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الخُرطُومِ﴾ السِّمة: العلامة، والخرطوم: الأنف، والمعنى: سنبين أمره بيانًا واضحًا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السِّمة على الخرطوم، ويحتمل أن يكون المعنى: سنجعل على أنفه علامة يُعيَّر بها ما عاش، فخُطِم بالسيف، يقال خَطَمَهُ إذا أثَّر في أنفه جراحة، فجمع له مع بيان عيوبه للناس الخطم بالسيف، وقال ءاخرون: لزمه عار لا ينمحي عنه ولا يفارقه.
﴿إنَّا بَلَوْناهُم﴾ يعني أهل مكة امتحناهم واختبرناهم، والمعنى: أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبطَروا فلما بَطِروا وعادَوْا محمدًا صلى الله عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط ﴿كَمَا بَلَوْنَا﴾ أي امتحنا ﴿أَصْحَابَ الجنَّةِ﴾ أي أصحاب البستان ﴿إذْ أَقْسَمُوا﴾ وحلَفوا فيما بينهم ﴿لَيَصْرِمُنَّها﴾ أي ليقطَعُنَّ ثمرها ﴿مُصْبِحِينَ﴾ أي وقت الصباح كي لا يشعر بهم المساكين فلا يُعْطُونَ ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها.
﴿ولا يَسْتَثْنُونَ﴾ أي لا يقولون إن شاء الله بل عزموا على ذلك عزم من يملك أمره.
أما قصة أصحاب الجنة وهي البستان فقد ذكر أهل التفسير أن رجلًا كان بناحية اليمن له بستان وكان مؤمنًا وذلك بعد سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، وكان يجعل عند الحصاد نصيبًا للفقراء والمساكين فكان يجتمع من هذا شيء كثير، فلما مات الأب ورثه ثلاثة بنين له وقالوا: والله إن المال لقليل وإن العيال لكثير وإنما كان أبونا يفعل هذا الأمر إذ كان المال كثيرًا والعيال قليلًا، وأما إذا قلَّ المال وكثر العيال فإنا لا نستطيع أن نفعل هذا، فعزموا على حرمان المساكين وتحالفوا بينهم يومًا ليغدُوَّن غَدوة قبل خروج الناس ليقطعوا ثمر البستان، فلما أصبحوا وجدوه قد احترق وصار كالليل الأسود.
﴿فَطَافَ﴾ أي طرق ﴿عَلَيْهَا﴾ أي الجنة وهي البستان ﴿طَائِفٌ﴾ أي طارق ﴿مِن رَّبِّكَ﴾ أي من أمر الله ﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ ومعنى الآية أن الله بعث على البستان نارًا فاحترق فصار أسود.
﴿فَأَصْبَحَتْ﴾ فصارت جنتهم أي بستانهم ﴿كَالصَّرِيمِ﴾ كالليل الاسود بسبب احتراق البستان، وقيل: صارت كالرماد الأسود.
﴿فَتَنادَوْا﴾ هؤلاء القومُ وهم أصحاب الجنة أي دعا بعضهم بعضًا إلى المضي إلى ميعادهم ﴿مُصْبِحِينَ﴾ يعني لما أصبحوا.
﴿أَنِ اغْدُوا﴾ أي باكروا بالخروج وقت الغداة ﴿عَلَى حَرْثِكُمْ﴾ يعني الثمار والزرع ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ﴾ أي قاطعين ثماركم.
﴿فانْطَلَقُوا﴾ أي مضَوا وذهبوا إلى حرثهم ﴿وهُمْ يَتَخَافَتُونَ﴾ أي يتسارُّون، والمعنى أنهم يُخفون كلامهم ويُسرونه لئلا يعلم بهم أحد.
﴿أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا﴾ أي يتخافتون ويقولون: لا يدخلنها أي الجنةَ ﴿اليَوْمَ عَلَيْكُم مِسكِينٌ﴾ والنهي عن الدخول نهي عن التمكين منه أي لا تمكنوهم من الدخول فيدخلوا.
﴿وغَدَوْا﴾ أي ساروا إلى جنتهم غدوة ﴿عَلَى حَرْدٍ﴾ أي على قدرة، وفُسّر الحرد بالقصد أي غدَوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه واستسرّوه بينهم وهم يظنون في أنفسهم القدرة على صرمها وأنهم تمكنوا من مرادهم، وفُسّر الحرد بالمنع أي منع الفقراء وفي ظنهم القدرةُ على ذلك، وقيل غير ذلك ﴿قَادِرِينَ﴾ أي عند أنفسهم على جنتهم وثمارها لا يحول بينهم وبينها أحد، ويحتمل أن يكون من التقدير بمعنى التضييق لقوله تعالى: ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [سورة الفجر] أي مضيقين على المساكين إذ حرموهم ما كان أبوهم ينيلهم منها، قاله أبو حيان.
﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾ أي فلما صار هؤلاء القومُ إلى بستانهم ورأَوها محترقًا حرثُها أنكروها وشكوا فيها هل هي جنتهم أم لا، فقال بعضهم لبعض ظنًّا منهم أنهم قد ضلّوا الطريق وتاهوا وأن التي رأوا غيرُها ﴿قَالُوا إِنَّا﴾ أيها القوم ﴿لَضَالُّونَ﴾ أي لمخطئون الطريق إلى جنتنا وليست هذه جنتَنا، ثم وضح لهم أنها هي وأنه أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها، وقيل: أي إنا لضالون عن الصواب في غدوّنا على نية منع المساكين فلذلك عوقبنا.
﴿بَلْ نَحْنُ﴾ أيها القوم ﴿مَحْرُومُونَ﴾ أي حُرِمنا خيرها ونفعها بمنعنا الفقراءَ منها.
﴿قَالَ أَوْسَطُهُم﴾ أي قال أفضلهم وأعدلهم قولا وأرجحهم عقلًا ﴿أَلَمْ أقُل لَّكُمْ لَوْلَا﴾ أي هلَّا ﴿تُسَبِّحونَ﴾ أي تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم. فقد أنَّبهم أخوهم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من تسبيح الله أي ذِكره وتنزيهه عن السوء، ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة المساكين واقتفَوا سنة أبيهم في ذلك، فلما غفلوا عن ذكر الله تعالى وعزموا على منع المساكين ابتلاهم الله وهذا يدل على أن أوسطهم كان قد تقدم إليهم وحرضهم على ذِكر الله تعالى، وقيل: “لولا تسبحون” أي تستثنون إذ قلتم ﴿لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ﴾ فتقولوا إن شاء الله، وقيل: لولا تسبحون أي تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم، ولمَّا أنَّبهم رجعوا إلى ذِكر الله تعالى واعترفوا على أنفسهم بالظلم وبادروا إلى تسبيح الله عزَّ وجلَّ.
﴿قَالُوا سُبْحَانَ ربِّنا﴾ أي نزَّهوا الله عن أن يكون ظالمًا فيما فعل، قال ابن عباس: أي نستغفر الله من ذنبنا ﴿إنَّا كُنَّا ظالمينَ﴾ أي لأنفسنا من منعنا المساكين من ثمر جنتنا.
﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ﴾ أي يلوم بعضهم بعضًا، يقول هذا لهذا: أنت أشرت علينا بهذا الرأي، ويقول ذلك لهذا: أنتَ خوفتنا من الفقر، ويقول الثالث لغيره: أنت رغبتنا في جمع المال، ثم نادَوا على أنفسهم بالويل.
﴿قالوا ياويْلَنا﴾ أي هلاكنا ﴿إنَّا كُنَّا طاغينَ﴾ أي مخالفين أمر الله في تركنا الاستثناء ومنعنا حق الفقراء، ثم رجَوا انتظار الفرج في أن يبدلهم خيرًا من تلك الجنة فقالوا:”
﴿عَسَى ربُّنَا أن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا﴾ أي من هذا الجنة ﴿إِنَّا إلى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ أي طالبون من الله تعالى في أن يبدلنا من جنتنا إذ هلكت خيرًا منها، وقرأ المدنيان وأبو عمرو: “يُبَدّلنا” بفتح الباء وتشديد الدال.
﴿كَذَلِكَ العَذَابُ﴾ أي عذاب الدنيا الذي بلونا به أصحاب البستان من إهلاك ما كان عندهم إذ أصبحت جنتهم أي بستانهم كالصريم. ﴿ولَعَذابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ يعني عقوبة الآخرة لمن عصى ربه وكفر به أكبر يوم القيامة من عقوبة الدنيا وعذابها ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنيا لارتدعوا وتابوا وأنابوا.
ثم أخبر الله عزَّ وجلَّ بما أعدَّ للمتقين فقال:
﴿إنَّ للمُتَّقينَ﴾ المؤمنين بالله ورسوله والمجتنبين للشرك وسائر أنواع الكفر، والتقي هو الذي أدَّى ما فرضه الله واجتنب ما حرَّمه، فهؤلاء المتقون لهم ﴿عنْدَ ربِّهِم﴾ في الآخرة ﴿جَنَّاتِ النَّعيمِ﴾ أي النعيم الدائم الذي لا يشوبه ما ينغصه، قال الله تعالى: ﴿إنَّ الذينَ ءامَنُوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ إنَّا لا نُضِيعُ أجرَ مَنْ أحْسَنَ عملاً * أُولئِكَ لهُمْ جنَّاتُ عَدْنٍ تَجري مِن تَحْتِهِمُ الأنهارُ يُحَلَّوْنَ فيها مِن أساوِرَ مِن ذهبٍ ويَلْبَسُونَ ثيابًا خُضْرًا من سُندُسٍ وإستبرقٍ مُتَّكِئينَ فيها على الأرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وحَسُنَتْ مُرتَفَقًا﴾ [سورة الكهف]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفِلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يَتَمَخَّطُون” قالوا: فما بال الطعام؟ قال: “جُشاء ورشْحٌ كرشْح المسك، يُلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهمون النَّفَسَ”، وقال أيضًا: “ينادي منادٍ: إن لكم أن تَصِحُّوا فلا َّتسقَموا أبدًا، وإن لكم أن تحْيَوْا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تشِبوا فلا تهرموا أبدًا، وإن لكم أن تنعَموا فلا تبأسوا أبدًا، فذلك قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ونُودُوا أنْ تِلكُمُ الجَنَّةُ أُورِثتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأعراف] رواهما مسلم.[7]
————-
7- أخرجهما مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًا: وباب في دوام نعيم أهل الجنة.
ولمَّا قال المشركون: إنا لنُعْطى في الآخرة أفضل مما تُعْطون قال تعالى مكذبًا لهم:
﴿أفَنَجْعَلُ المسلمينَ كالمجْرِمِينَ﴾ أي لا يتساوى عند الله الذين ءامنوا بربهم وذلوا له بالعبودية والكافرين، وهو استفهام فيه توقيف على خطإ ما قالوا وتوبيخ وتقريع للكفار.
ثم وبَّخهم فقال: ﴿ما لَكُمْ﴾ أي أيُّ شيء لكم فيما تزعمون، وهو استفهام إنكار عليهم ﴿كَيْفَ تَحكُمُونَ﴾ وهو استفهام ثالث على سبيل الإنكار عليهم، ومعنى الآية: كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد، كأن أمر الجزاء مفوَّض إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم أن لكم من الخير ما للمسلمين، وهذا إشعار بأن هذا الحكم صادر من اختلال فكر واعوجاج رأي.
﴿أمْ لكُمْ﴾ أي ألكم أيها القوم بتسويتكم بين المسلمين والمجرمين في الجزاء والمنزلة ﴿كِتابٌ﴾ أُنزل من عند الله أتاكم به رسول من رسله ﴿فيهِ تَدْرُسُون﴾ أي تقرءون في ذلك الكتاب. ”
﴿إنَّ لكُمْ فيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ﴾ أي إن ما تختارونه وتشتهونه لكم كما زعمتم. وشدد البزي تاء: “تخيرون” وصلاً مع المد المشبع قبله.
﴿أمْ لَكُمْ﴾ أي ألكم ﴿أيْمانٌ عَلينَا بَالِغةٌ﴾ أي أقسام وعهود ومواثيق عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا بالغة أي ﴿بالغةٌ إلى يومِ القيامةِ﴾ مؤكدة تنتهي بكم إلى يوم القيامة لا تنقطع تلك الأيمان والعهود إلى يوم القيامة ﴿إنَّ لكُم﴾ في ذلك العهد ﴿لما تَحكُمونَ﴾ أي حكمكم.
ثم قال الله تعالى لنبيه محمد:
﴿سَلْهُمْ﴾ أي سل يا محمد هؤلاء المشركين وقل لهم ﴿أيُّهُم بذلكَ زعيمٌ﴾ الزعيم: الكفيل، أي أيهم كفيل وضامن بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين من الخير ”
﴿أمْ لهُمْ شُركاءُ﴾ وفي تفسيره وجهان:
الأول: أن المعنى أم لهم أشياء يعتقدون أنها شركاء الله تعالى ويعتقدون أن أولئك الشركاء يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين في الثواب والخلاص من العقاب، وإنما أضاف الشركاء إليهم لأنهم هم جعلوها شركاء لله تعالى.
الثاني: أن المعنى أم لهم ناس يشاركونهم في قولهم هذا وهو التسوية بين المسلم والمجرم وأن لهم ما للمسلمين من الخير في الآخرة. ﴿فَلْيَأتوا﴾ هذا أمرٌ معناه التعجيز أي لا أحد يقول بقولهم كما أنه لا كتاب لهم ولا عهد من الله ولا زعيم لهم يضمن لهم من الله بهذا ﴿بِشُركائِهم﴾ يشهدون على ما زعموا ﴿إن كانوا صادقين﴾ في دعواهم.
ثم إنه تعالى لمَّا أبطل قولهم وبين أنه لا وجه لصحته أصلاً أخبر عن عظمة يوم القيامة فقال:
﴿يومَ﴾ هو يوم القيامة ﴿يُكشفُ عن ساقٍ﴾ هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء، يقال: كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها، وثبت [8] هذا المعنى عن ترجمان القرءان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال في تفسير هذه الآية: “عن شدة من الأمر”، وروى الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: “هو يوم كرب وشدة”. وقال أهل الباطل من المشبهة إن لله ساقًا يكشفها يوم القيامة، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو من رءوس السلف الصالح في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة: “وتعالى –أي الله- عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات” اهـ.
﴿ويُدْعَوْنَ﴾ أي الكفار ﴿إلى السُّجُودِ فلا يَسْتَطِيعُونَ﴾ كأن في ظهورهم سفافيد الحديد، والدعاء إلى السجود ليس على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتوبيخ وعندما يدعون إلى السجود سُلبوا القدرة عليه وحيل بينهم وبين الاستطاعة حتى يزداد حزنهم وندمهم على ما فرطوا فيه حين دعوا إليه وهم سالمو الأطراف والمفاصل.
————-
8- أنظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري [13/428].
﴿خَاشِعَةً أبصَارُهُم﴾ أي ذليلة وخاضعة ﴿ترهَقُهُم ذِلَّةٌ﴾ أي تغشاهم وذلك أن المؤمنين يرفعون رءوسهم ووجوههم أشد بياضًا من الثلج وتسود وجوه الكافرين ﴿وقدْ كانوا يُدعَوْنَ﴾ أي في الدنيا ﴿إلى السُجودِ وهُمْ سَالِمُونَ﴾ أي مُعَافون أصحاء.
﴿فَذَرْني وَمَن يُكَذِّبُ بِهذا الحَدِيثِ﴾ أي القرءان، والمعنى: كِلْ يا محمد أمر هؤلاء المكذبين بالقرءان إليَّ أَكفِكَ أمره أي حسبك في الإيقاع بهم والانتقام منهم أن تكِل أمرهم إليَّ فإني عالم بما يستحقون من العذاب، وهذا وعيد شديد لمن يكذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة وغيره. قال ابن الجوزي: “زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، وإذا قلنا إنه وعيد وتهديد فلا نسخ” اهـ.
﴿سَنَسْتَدْرجُهُم﴾ أي نأخذهم درجة درجة وذلك إدناؤهم من الشيء شيئًا فشيئًا، والمعنى: أن الله تعالى يدنيهم من العذاب درجة درجة حتى يوقعهم فيه ﴿مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ﴾ واستدراج الله تعالى العصاة أن يرزقهم الصحة ويفتح بابًا من النعمة يغتبطون به ويركنون إليه وهم يحسبونه تفضيلاً لهم على المؤمنين وهو في الحقيقة سبب لإهلاكهم فإن العبد إذا كان بحيث كلما ازداد ذنبًا جدَّد الله له نعمة وأنساه التوبة والاستغفار كان ذلك منه استدراجًا بحيث لا يشعر العبد أنه استدراج.
﴿وأُمْلِي لَهُم﴾ أي أمهلهم وأطيل لهم المدة ﴿إنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ أي إن عذابي لقوي شديد.
﴿أمْ تَسْئَلُهُم﴾ أي أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين بالله على ما أتيتَهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق ﴿أَجْرًا﴾ أي ثوابًا وجزاء ﴿فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ﴾ أي من أن يغرموا لك الأجر ﴿مُثْقَلون﴾ قد أثقلهم القيام بأدائه، ومعنى الآية: أتطلب منهم أجرًا فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم ذلك عن الإيمان فلا يؤمنون، وهو استفهام بمعنى النفي أي لست تطلب أجرًا على تبليغ الوحي فيثقل عليهم ذلك فيمتنعوا عن الدخول في الذي دعوتهم إليه من الدين.
﴿أمْ عِنْدَهُمُ الغَيْبُ﴾ أي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب ﴿فهُم يَكْتُبُون﴾ منه ما يقولون، وهو استفهام على سبيل الإنكار.
﴿فاصْبِر﴾ يا محمد ﴿لِحُكْمِِ رَبِّكَ﴾ أي لقضاء ربك الذي هو ءات، وامض لما أمرك به ربك ولا يثنيك عن تبليغ ما أُمرت بتبليغه تكذيبهم إياك وأذاهم لك. قال ابن الجوزي: “قال بعضهم معنى الصبر منسوخ بآية السيف” اهـ ثم رَدَّه أي ابن الجوزي.
﴿ولا تَكُن﴾ يا محمد ﴿كَصَاحِبِ الحُوتِ﴾ وهو سيدنا يونس عليه السلام الذي حبسه الحوت في بطنه، وكان من قصته أنه لما ذهب إلى العراق امتثالا لأمر الله ليبلغ رسالة ربه ودعا هؤلاء المشركين إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، كذَّبوه وتمرَّدوا وأصروا على كفرهم ولم يستجيبوا لدعوته، وبقي يونس عليه الصلاة والسلام بينهم صابرًا على الأذى يدعوهم إلى الإسلام ويذكّرهم ويعظهم، ولكنه مع طول مكثه معهم لم يلق منهم إلا عنادًا وإصرارًا على كفرهم ووجد فيهم ءاذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا ووقفوا معارضين لدعوته عليه السلام فأيس سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام منهم بعدما طال ذلك عليه من أمرهم وخرج من بين أظهرهم وظن أن الله تعالى لن يؤاخذه على هذا الخروج من بينهم ولن يضيق عليه بسبب تركه لأهل هذه القرية وهجره لهم قبل أن يأمره الله تبارك وتعالى بالخروج. ولمَّا أصاب نبيَّ الله يونس ما أصابه من ابتلاع الحوت علم عليه السلام أن ما أصابه حصل له ابتلاء له بسبب استعجاله وخروجه عن قومه الذين أُرسل إليهم بدون إذن من الله تعالى، ثم عاد إليهم فوجدهم مؤمنين بالله تائبين إليه فمكث معهم يعلمهم ويرشدهم.
فائدة: سيدنا يونس عليه السلام ذهب مغاضبًا لقومه لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا بدعوته وأصروا على كفرهم وشركهم، فلا يجوز أن يعتقد أن نبي الله يونس عليه السلام ذهب مُغاضبًا لربه فإن هذا كفر وضلال لا يجوز نسبته لأنبياء الله الذين عصمهم الله وجعلهم هُداة مهتدين عارفين بربهم، فمن نسب إلى يونس عليه السلام أنه ذهب مغاضبًا لله فقد افترى على نبي الله ونسَبَ إليه الجهل بالله والكفر به وهذا يستحيل على الأنبياء لأنهم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها.
﴿إذْ نَادَى﴾ حين دعا ربه وهو في بطن الحوت فقال: “لا إله إلا أنت سبحانك” ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ أي مملوء غيظًا على قومه إذ لم يؤمنوا لما دعاهم إلى الإيمان وأحوجوه إلى استعجال مفارقته إياهم.
﴿لَوْلا أنْ تَدَارَكَهُ﴾ أي أدركه ﴿نِعمةٌ﴾ أي رحمة ﴿مِنْ ربِّهِ﴾ أي لولا أن الله أنعم عليه بإجابة دعائه وقبول عذره ﴿لنُبِذَ﴾ أي لطرح من بطن الحوت ﴿بالعراءِ﴾ أي بالأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا شجر يستر ﴿وهُوَ مَذْمُومٌ﴾ أي مُليم ولكنه رُحم فنبذ غير مذموم لأنه تِيْبَ عليه قبل أن يخرج من بطن الحوت.
﴿فاجْتَباهُ ربُّهُ﴾ أي اصطفاه الله واختاره ﴿فَجَعلهُ مِنَ الصالحينَ﴾ أي من المستكملين لصفات الصلاح، وقيل من النبيين.
﴿وإن يَكادُ الذينَ كَفَروا لَيُزْلِقُونَكَ بأبْصارِهم﴾ وفي معنى الآية للمفسرين قولان: أحدهما: أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين فعصمه الله تعالى وأنزل هذه الآية، وقيل: إن الكفار من شدة إبغاضهم لك وعداوتهم يكادون بنظرهم إليك نظر البغضاء أن يُزلِقه من شدته، يقال نظر فلان إليَّ نظرًا كاد يأكلني وكاد يصرعني. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بمشيئة الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “العين حق” رواه البخاري[9]، أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود.
وأخرج البخاري[10] أيضًا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوِّذ الحسن والحسين ويقول: “إن أباكما كان يعوِّذ بهما إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين ولامَّة”. وقرأ الأكثرون: “لَيُزلقونك” بضم الياء من أَزْلَقَتُهُ، وقرأ أهل المدينة بفتحها من زَلَقتُه أَزْلِقُهُُ، وهما لغتان مشهورتان عند العرب.
————-
9- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب: باب العين حق.
10- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: الباب الثاني من أبواب يزفون: النسلان المشي.
﴿لما سَمِعوا الذِّكرَ﴾ أي لما سمعوا كتاب الله يُتلى وهو القرءان ﴿ويَقولونَ﴾ من شدة كراهيتهم وبغضهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿إنَّهُ لمجنونٌ﴾ أي ينسبونه إلى الجنون إذا رأوه يقرأ القرءان يقولون ذلك تنفيرًا عنه وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم أتمهم فضلاً وأرجحهم عقلاً، قال تعالى ردًّا عليهم ﴿وما هُوَ﴾ يعني القرءان ﴿إلا ذِكرٌ للعالمينَ﴾ أي موعظة للإنس والجن يتعظون به ويستنبطون منه صلاح أحوالهم المتعلقة بالدين والدنيا، فمن كان يظهر مثل هذا الذي فيه الهدى والحق والعدل والسعادة الأخروية ويتلوه ويدعو الناس إلى العمل بما فيه كيف يقال في حقه إنه مجنون والحال أنه من أدل الأمور على كمال عقله وعلوّ شأنه، فمن نسب إليه صلى الله عليه وسلم القصور فإنما هو من جهله وخيبته فإن ذا الفضل لا يعرفه إلا ذووه، ولقد قيل:
إذا لم يكن للمرءِ عينٌ صحيحةٌ *** فلا غَروَ أن يرتابَ والصبح مسفر.
سورة الحاقة
سورة الحاقة
مكية في قول الجميع، وهي اثنتان وخمسون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (12) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتْ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ (15) وَانشَقَّتْ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ (37) فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ (44) لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52)
﴿الْحَاقَّةُ (١)﴾ يعني القيامة، سُميت حاقة من الحق الثابت يعني أنها ثابتة الوقوع لا ريب فيها.
﴿ما الحاقَّةُ (٢)﴾ ما استفهام لا يراد حقيقته بل المقصود منه تعظيم شأنها وتهويله أي ما هي الحاقة، ثم زاد في التهويل بأمرها فقال:
﴿وَمَا أَدْرَاكَ (٣)﴾ أي أعلمَك، أي لم تعاينها ولم تدر ما فيها من الأهوال ﴿مَا الْحَاقَّةُ (٣)﴾ زيادة تعظيم لشأنها ومبالغة في التهويل، والمعنى أن فيها ما لم يُدر ولم يُحط به وصف من أمورها الشاقة وتفصيل أوصافها.
ثم ذكر الله تعالى المكذبين بها فقال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ (٤)﴾ وهم قوم سيدنا صالح عليه السلام ﴿وَعَادٌ (٤)﴾ وهم قوم سيدنا هود عليه السلام ﴿بِالْقَارِعَةِ (٤)﴾ أي بيوم القيامة، والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة.
﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (٥)﴾ أي بطغيانهم وكفرهم، وقيل بالصيحة الشديدة المجاوزة في قوتها وشدتها عن حد الصيحات بحيث لم يتحملها قلب أحد منهم كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (٣١)﴾ [سورة القمر]، والمقصود من ذكر هذه القصص زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهؤلاء الأمم في المعاصي لئلا يحُل بها ما حل بهم.
﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ (٦)﴾ باردة تحرِق ببردها كإحراق النار، وقيل الشديدة الصوت ﴿ عَاتِيَةٍ (٦)﴾ شديدة العصف تجاوزت في الشدة والعصوف مقدارها المعروف في الهبوب والبرد، فهم أي قوم عاد مع قوتهم وشدتهم لم يقدروا على ردّها بحيلة من الاستتار ببنيان أو الاستناد إلى جبل أو اختفاء في حفرة لأنها كانت تنزعهم عن أماكنهم وتهلكهم.
﴿سَخَّرَهَا (٧)﴾ أي سلطها الله وأدامها ﴿ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا (٧)﴾ أي متتابعة دائمة ليس فيها فتور وذلك أن الريح المهلكة تتابعت عليهم في هذه الأيام فلم يكن لها فتور ولا انقطاع حتى أهلكتهم، وقيل: كاملة ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ (٧)﴾ يعني قوم عاد ﴿ فِيهَا (٧)﴾ في تلك الليالي والأيام ﴿ صَرْعَى (٧)﴾ جمع صريع يعني مَوْتى ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ (٧)﴾ أي أصول ﴿ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (٧)﴾ أي ساقطة، وقيل خالية الأجواف، وشبههم بجذوع نخل ساقطة ليس لها رءوس، فإن الريح كانت تحمل الرجل فترفعه في الهواء ثم تلقيه فتشدَخ رأسه فيبقى جثة بلا رأس، وفي تشبيههم بالنخل أيضًا إشارة إلى عِظَمِ أجسامهم.
﴿فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ (٨)﴾ أي من نفس باقية، أو التاء للمبالغة أي هل ترى لها من باق؟ لا.
﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ (٩)ُ﴾ أي من الأمم الكافرة التي كانت قبله كقوم نوح وعاد وثمود ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ (٩)﴾ يعني أهل قرى قوم لوط وكانت أربع أو خمس قريات التي ائتفكت أي انقلبت بأهلها فصار عاليها سافلها ﴿ بِالْخَاطِئَةِ (٩)﴾ أي بالفعلة أو الفعلات الخاطئة وهي المعصية والكفر، وقيل: الخطايا التي كانوا يفعلونها، وقيل: هي ذات الخطإ العظيم. وقرأ أبو عمرو، ويعقوب، والكسائي: “ومنْ قِبَلَهُ” بكسر القاف وفتح الباء، والباقون بفتح القاف وإسكان الباء.
﴿فَعَصَوْا (١٠)﴾ أي عصى هؤلاء الذين ذكرهم الله وهم فرعون ومن قبله والمؤتفكات ﴿ رَسُولَ رَبِّهِمْ (١٠)﴾ أي كذبوا رسلهم ﴿ فَأَخَذَهُمْ (١٠)﴾ ربهم ﴿ أَخْذَةً رَّابِيَةً (١٠)﴾ أي زائدة شديدة نامية زادت على غيرها من الأخذات كالغرق كما حصل لفرعون وجنوده وقلب المدائن كما حصل لقوم لوط.
﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ (١١)ُ﴾ أي زاد وارتفع وعلا على أعلى جبل في الدنيا، والمراد الطوفان الذي حصل زمن سيدنا نوح عليه السلام ﴿ حَمَلْنَاكُمْ (١١)﴾ أي حملنا ءاباءكم وأنتم في أصلابهم ﴿ فِي الْجَارِيَةِ (١١)﴾ أي السفينة الجارية على وجه الماء وهي السفينة التي صنعها سيدنا نوح عليه السلام بأمر الله تعالى وصعد عليها من ءامن به.
فإن قيل: إن المخاطبين لم يدركوا السفينة فكيف يقال ﴿ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (١١)﴾، فالجواب: ان الذين خوطبوا بذلك وهم من ذرية الذين حُملوا في الجارية أي السفينة وهم سيدنا نوح عليه السلام وأولاده فكان حمل الذين حُمِلوا فيها من الأجداد حَمْلاً لذريتهم.
﴿لِنَجْعَلَهَا (١٢)﴾ أي لنجعل تلك الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكفرة ﴿ لَكُمْ تَذْكِرَةً (١٢)﴾ أي عبرة وعظة ودلالة على قدرة الخالق وحكمته وكمال قهره وقدرته ﴿ وَتَعِيَهَا (١٢)﴾ أي تحفظ قصتها ﴿ أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (١٢)﴾ أي حافظة لما تسمع أي من شأنها أن تعي المواعظ وما جاء من عند الله لإشاعة ذلك والتفكر فيه والعمل بموجبه.
﴿فَإِذَا نُفِخَ (١٣)﴾ أي فإذا نفخ إسرافيل وهو الملَك الموكَّل بالنفخ ﴿ فِي الصُّورِ (١٣)﴾ في البوق ﴿ نَفْخَةٌ (١٣)﴾ وهي النفخة الأولى وقيل: النفخة الثانية ﴿ وَاحِدَةٌ (١٣)﴾ تأكيد.
﴿وَحُمِلَتِ (١٤)﴾ أي رفعت من أماكنها ﴿ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ (١٤)﴾ أي حملتها الريح العاصف أو الملائكة أو الله عزَّ وجلَّ بقدرته من غير مماسة ولا مباشرة كما قال الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين بن علي رضي الله عنهم: “سبحانك لا تُمس ولا تُحَسّ ولا تُجَس”.
﴿ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٤)﴾ أي ضرب بعضها ببعض حتى تفتتت، وقيل: تبسط فتصير أرضًا مستوية كالأديم الممدود.
﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١٥)ُ﴾ أي قامت القيامة، والواقعة هي القيامة.
﴿وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ (١٦)ُ﴾ أي انفطرت وتصدعت وتميز بعضها من بعض ﴿ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (١٦)﴾ أي ضعيفة لتشققها بعد أن كانت شديدة.
﴿وَالْمَلَكُ (١٧)﴾ يعني الملائكة ﴿ عَلَى أَرْجَائِهَا (١٧)﴾ أي على جوانب وأطراف السماء ﴿ وَيَحْمِلُ (١٧)﴾ أي الملائكة يحملون ﴿ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ (١٧)﴾ أي فوق رءوسهم، وقيل: إن حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء على أرجائها ﴿ يَوْمَئِذٍ (١٧)﴾ أي يوم القيامة ﴿ ثَمَانِيَةٌ (١٧)﴾ أي من الملائكة واليوم أي في الدنيا يحمله أربعة من الملائكة، وإنما يكونون ثمانية يوم القيامة إظهارًا لعظيم ذلك اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صفة حملة العرش: “أُذِنَ لي أن أُحَدِّث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام” رواه أبو داود[1]، قال الحافظ ابن حجر في “شرح البخاري” ما نصه[2]: “إسناده على شرط الصحيح” اهـ.
————-
1- أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في الجهمية والمعتزلة.
2- انظر فتح الباري [8/665].
﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ (١٨)﴾ على الله للحساب وليس ذلك عرضًا يعلم الله به ما لم يكن عالما به بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة ﴿ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ (١٨)﴾ فهو عالم بكل شيء من أعمالكم، وقرأ حمزة والكسائي وخلف: “لا يخفى” بالياء.
﴿فَأَمَّا (١٩)﴾ أما حرف تفصيل فصَّل بها ما وقع في يوم العرض ﴿مَنْ أُوتِيَ (١٩)﴾ أي أُعطي ﴿كِتَابَهُ (١٩)﴾ أي كتاب أعماله ﴿ بِيَمِينِهِ (١٩)﴾ وإعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة ﴿فَيَقُولُ (١٩)﴾ المؤمن خطابًا لجماعته لما سُرَّ به ﴿هَاؤُمُ (١٩)﴾ أي خذوا، وقيل تعالوا ﴿اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (١٩)﴾ والمعنى أنه لما بلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه أحب أن يُظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له.
﴿إِنِّي ظَنَنتُ (٢٠)﴾ أي علمتُ وأيقنتُ في الدنيا، قال أبو حيان[3]: “﴿ إِنِّي ظَنَنتُ (٢٠)﴾ أي أيقنتُ، ولو كان ظنًّا فيه تجويز لكان كفرًا” اهـ، فُسر الظن هنا بمعنى اليقين لأنه لو أبقي على أصله أي بمعنى الشك والتردد لكان المعنى أنه ظن أي شك هل يحاسب في الآخرة أم لا، والاعتقاد بالبعث والحساب من جملة العقائد الدينية التي يجب الإيمان بها، والشك فيهما كفر، والإيمان لا يحصل بالشك والظن بل لا بد للمؤمن أن يتيقن بحقية البعث والحساب، فيكون معنى الآية: إني علمت وتيقنت في الدنيا أن الله تعالى يبعثني و﴿ أَنِّي مُلَاقٍ (٢٠)﴾ أي ثابت لي ثباتًا لا ينفك أني لاق ﴿ حِسَابِيَهْ (٢٠)﴾ في الآخرة ولم أنكر البعث.
————-
3- انظر البحر المحيط [8/325].
﴿فَهُوَ (٢١)﴾ أي الذي أعطي كتابه بيمينه ﴿فِي عِيشَةٍ (٢١)﴾ أي في حالةٍ من العيش ﴿رَّاضِيَةٍ (٢١)﴾ يعني ذات رضا أي رضي بها صاحبها، وقيل عيشة مرضية وذلك بأنه لقي الثواب وأمِنَ من العقاب.
روى مسلم [4] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إنّ لكم أن تَصِحُّوا فلا تَسْقموا أبدًا، وإنَّ لكم أن تحْيَوا فلا تموتوا أبدًا، وإنَّ لكم أن تَشِبُّوا فلا تَهْرَموا أبدًا، وإنَّ لكم أن تَنْعَموا فلا تَبْأسُوا أبدًا”.
————-
4- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في دوام نعيم أهل الجنة.
﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (٢٢)﴾ مكانًا فهي فوق السموات السبع، وعالية في الدرجة والشرف والأبنية.
روى البخاري[5] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إنَّ في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها”.
وقال أيضًا: “إنَّ للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوَّفة طولها سِتُّون ميلاً” رواه مسلم[6].
وقال أيضًا: “إنَّ في الجنة مائةَ درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتُم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة” رواه البخاري[7].
————-
5- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار.
6- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين.
7- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبيل الله.
﴿قُطُوفُهَا (٢٣)﴾ أي ما يُقطف من ثمار الجنة ﴿ دَانِيَةٌ (٢٣)﴾ أي قريبة لمن يتناولها قائمًا أو قاعدًا أو نائمًا على السرير انقادت له وكذا إن أراد أن تدنو إلى فِيْه أي فمه دنت لا يمنعه من ثمرها بُعْد،
ويقال لهم: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٤)﴾ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا (٢٤)﴾ أمر امتنان لا تكليف أي يقال لهم ذلك إنعامًا وإحسانًا وامتنانًا وتفضيلاً عليهم فإن الآخرة ليست بدار تكليف ﴿ هَنِيئًا (٢٤)﴾ أي لا تكدير فيه ولا تنغيص لا تتأذون بما تأكلون ولا بما تشربون في الجنة أكلاً طيبًا لذيذًا شهيًّا مع البعد عن كل أذى ولا تحتاجون من أكل ذلك إلى غائط ولا بول، ولا بصاق هناك ولا مخاط ولا وهن ولا صداع ﴿ بِمَا أَسْلَفْتُمْ (٢٤)﴾ أي بما قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة ﴿ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٤)﴾ أي في أيام الدنيا التي خلت فمضت واسترحتم من تعبها.
﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ (٢٥)﴾ أي أُعطي كتاب أعماله ﴿بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ (٢٥)﴾ لما يرى من سوء عاقبته التي كُشف له عنها الغطاء ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (٢٥)﴾ أي تمنى أنه لم يؤت كتابه لما يرى فيه من قبائح أفعاله.
روى ابن حبان[8] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يُدعى أحدهم فيُعطى كتابه بيمينه ويمدُّ له في جسمه ستون ذراعًا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ قال: فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم بارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثلَ هذا، وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله مسودًا وجهه ويزاد في جسمه ستون ذراعًا على صورة ءادم ويَلبس تاجًا من نار فيراه أصحابه فيقولون: اللهم اخزه فيقول: أبعدكم الله فإن لكل واحد منكم مثل هذا”.
————-
8- أخرجه ابن حبان في صحيحه، انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان [9/222].
﴿وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (٢٦)﴾ أي وتمنى أنه لم يدر حسابه لأنه لا حاصل له في ذلك الحساب ولا طائل إذ كله عليه لا له.
﴿يَا لَيْتَهَا (٢٧)﴾ أي الموتة التي متها في الدنيا، فإنه تمنى أنه لم يبعث للحساب ﴿كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (٢٧)﴾ أي القاطعة للحياة ولم أَحْيَ بعدها فلم أُبعث ولم أعذب، فقد تمنى الموت ولم يكن شيء عنده أكرهَ منه إليه في الدنيا لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمرّ مما ذاقه من الموت.
قال البخاري: “القاضية” الموتة الأولى التي مُتُّها، لم أحْيَ بعدها”.
روى مسلم[9] في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابًا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنتَ مفتديًا بها؟ فيقول: نعم، فيقول: قد أردتُ منك أهونَ من هذا وأنت في صُلب ءادم أن لا تشرك، فأبيتَ إلا الشرك”.
————-
9- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا .
﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (٢٨)﴾ يعني أنه لم يدفع عنه ماله الذي كان يملكه في الدنيا من عذاب الله شيئًا، ويجوز أن يكون استفهامًا وبَّخ به نفسه وقررها عليه، قاله أبو حيان.
﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (٢٩)﴾ يعني ضلت عني كل بينة فلم تغن عني شيئًا وبطلت حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا، وقيل: زال عني ملكي وقوتي.
﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠)﴾ أي يقول الله تعالى لخزنة جهنم خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيَّدًا بالأغلال ﴿ثُمَّ الْجَحِيمَ (٣١)﴾ أي نار جهنم ﴿صَلُّوهُ (٣١)﴾ أي أدخلوه واغمروه فيها ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ (٣٢)﴾ وهي حَلقٌ منتظمة كل حلقة منها في حلقة، وهذه السلسلة عظيمة جدًّا لأنها إذا طالت كان الإرهابُ أشدَّ ﴿ذَرْعُهَا (٣٢)﴾ أي قياسها ومقدار طولها ﴿سَبْعُونَ ذِرَاعًا (٣٢)﴾ الله أعلم بأي ذراع هي ﴿فَاسْلُكُوهُ (٣٢)﴾ أي أدخلوه، والظاهر أنهم يدخلونه في السلسلة ولطولها تلتوي عليه من جميع جهاته فيبقى داخلاً فيها مضغوطًا حتى تعمه، وقيل: تدخل في دبره وتخرج من منخره، وقيل: تدخل في فِيْه وتخرج من دبرهِ.
أخرج الترمذي[10] في جامعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لو أن رُضَاضةً مثل هذه، وأشار إلى مثل الجُمْجُمة، أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها”.
قال الترمذي: إسناده حسن.
————-
10- أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة جهنم: بعد باب “ما جاء في صفة طعام أهل النار”.
ثم ذكر الله تعالى سبب عذاب الكافر فقال:
﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ الْعَظِيمِ (٣٣)﴾ أي لا يؤمن ولا يصدق بالله الذي أمر عباده بالإيمان به وترك عبادة الأوثان والأصنام، فمن ترك أعظم حقوق الله تعالى على عباده وهو توحيده تعالى وأن لا يشرك به شيء استحق العذاب الأبدي السرمدي الذي لا ينقطع في الآخرة لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما قال الله تعالى في القرءان الكريم: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ (٤٨)﴾ [سورة النساء]، و﴿ الْعَظِيمِ (٣٣)﴾ أي عظيم الشأن منزه عن صفات الأجسام فالله أعظم قدرًا من كل عظيم.
﴿وَلَا يَحُضُّ (٣٤)﴾ أي هذا الشقي الذي أوتي كتابه بشماله كان في الدنيا لا يحث ولا يحرّض نفسه ولا غيرها ﴿عَلَى طَعَامِ (٣٤)﴾ أي إطعام ﴿الْمِسْكِينِ (٣٤)﴾ وفي هذه الآية دليل على تعظيم الجرم في حرمان المساكين.
قال العلماء: دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على معنى أنهم يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة ونحو ذلك وعدم الانتهاء عن الفواحش والمنكرات لا على معنى أنهم يطالبون بأداء العبادات حال كفرهم لأن العبادة لا تصح من كافر.
﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ (٣٥)﴾ أي ليس له يوم القيامة ﴿هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٥)﴾ أي قريب يدفع عنه عذاب الله تعالى ولا من يشفع له ويغيثه مما هو فيه من البلاء.
﴿وَلَا طَعَامٌ (٣٦)﴾ أي وليس له طعام ينتفع به ﴿ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦)﴾ وهو ما يسيل من أبدان الكفار من الدم والصديد وهو الدم المختلط بماء من الجرح ونحوه، وقيل الغسلين شجر يأكله أهل النار ﴿لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (٣٧)﴾ أي الكافرون.
﴿لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (٣٧)﴾ أي الكافرون.
﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩)﴾ أي أقسم بما ترونه وما لا ترونه، وقيل: أقسم بالدنيا والآخرة، وقيل: “لا” رد لكلام المشركين كأنه قال: ليس الأمر كما يقول المشركون ثم قال تعالى: ﴿أُقْسِمُ (٣٨)﴾ وقيل: “لا” هنا نافية للقسم على معنى أنه لا يُحتاج إليه لوضوح الحق فيه كأنه قال: لا أقسم على أن القرءان قول رسول كريم فكأنه لوضوحه استغنى عن القسم.
﴿إِنَّهُ (٤٠)﴾ يعني هذا القرءان ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠)﴾ وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل: جبريل، وليس القرءان من تأليف الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو وحيٌ أوحاه الله إليه.
فائدة: قال أهل الحق: كلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته أزلي أبدي لا يشبه كلام خلقه، فليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة، واللفظ المنزل على سيدنا محمد باللغة العربية هو عبارة عن هذا الكلام الذاتيّ والآية تدل على ذلك، فلو كان اللفظ المنزل على سيدنا محمد هو عين كلام الله تعالى لما قال ربنا تعالى: ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠)﴾.
﴿وَمَا هُوَ (٤١)﴾ يعني هذا القرءان ﴿بِقَوْلِ شَاعِرٍ (٤١)﴾ كما تدعون ولا هو من ضروب الشعر ولا تركيبه، فقد نفى الله تعالى أن يكون القرءان قول رجل شاعر، والشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفَّى موزون بقصد الوزن ﴿قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ (٤١)﴾ قال أبو حيان[11]: “أي تؤمنون إيمانًا قليلاً أو زمانًا قليلاً، وكذا التقدير في ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٢)﴾ والقلة هو إقرارهم إذا سئلوا مَن خلقهم قالوا الله” إهـ، وقيل: أراد بالقليل عدم إيمانهم أصلاً والمعنى أنكم لا تصدقون بأن القرءان من عند الله تعالى. وقرأ ابن كثير وابن عامر بخلف عن ابن ذكوان ويعقوب: “يؤمنون” و”يذّكَّرون” بالياء فيهما مع تشديد الذال.
————-
11- البحر المحيط [8/328].
﴿وَلَا (٤٢)﴾ أي وليس القرءان ﴿بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٢)﴾ أي ليس بقول رجل كاهن كما تدَّعون ولا هو من جنس الكهانة لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم ليس بكاهن، فالكاهن من تأتيه الشياطين ويلقون إليه ما يسمعون من أخبار الملائكة سكان السموات فيخبر الناس بما سمعه منهم، وطريقه عليه الصلاة والسلام منافية لطريق الكاهن من حيث إن ما يتلوه من الكلام مشتمل على ذم الشياطين وشتمهم فكيف يمكن أن يكون ذلك بإلقاء الشياطين إليه فإنهم لا يُلقون فيه ذمهم وشتمهم لا سيما على من يلعنهم ويطعن فيهم، وكذا معاني ما بلَّغه عليه الصلاة والسلام منافية لمعاني أقوال الكهنة فإنهم لا يدعون إلى تهذيب الاخلاق وتصحيح العقائد والأعمال المتعلقة بالمبدإ والمعاد بخلاف معاني أقواله عليه الصلاة والسلام.
﴿تَنزِيلٌ (٤٣)﴾ أي هو تنزيل يعني القرءان ﴿مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣)﴾ وذلك أنه لما قال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠)﴾ أتبعه بقوله ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣)﴾ ليزول هذا الإشكال حتى لا يُظن أن هذا تركيبُ جبريل بل إن القرءان نزل به جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤)﴾ أي الباطلة، والأقاويل جمع الجمع وهو أقوال، وأقوال جمع قول، وسميت الأقوال المتقوّلة أقاويل تصغيرًا لها وتحقيرًا. وقال أبو حيان[12]: “المعنى: ولو تقوَّل متقول ولا يكون الضمير في تقوَّل عائدًا على الرسول صلى الله عليه وسلم لاستحالة وقوع ذلك منه، فنحن نمنع أن يكون ذلك على سبيل الفَرْضِ في حقه عليه الصلاة والسلام” اهـ.
————-
12- البحر المحيط [8/329].
﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥)﴾ أي لأخذنا بيده التي هي اليمين على جهة الإذلال والصَّغار كما يقول السلطان إذا أراد عقوبة رجل: يا غلام خذ بيده وافعل كذا، وقيل: لَنِلنا منه عقابه بقوة منا، وقيل: لَنَزَعنا منه قوته.
﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦)﴾ قال البخاري: “وقال ابن عباس: الوتين نِيَاطُ القلب”، وهو عرق يتعلق به القلب يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه، والمعنى لو تقوّل علينا لأذهبنا حياته معجلاً.
﴿فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧)﴾ أي أنه لا يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناه ثم لم يقدر على دفع عقوبتنا عنه أحد، وقال أبو حيان[13]: “الضمير في ﴿عَنْهُ (٤٧)﴾ الظاهر أنه يعود على الذي تقوَّل ويجوز أن يعود على القتل أي لا يقدر أحد منكم أن يحجُزَه عن ذلك ويدفَعَه عنه” اهـ.
————-
13- البحر المحيط [8/329].
﴿وَإِنَّهُ (٤٨)﴾ يعني القرءان ﴿ لَتَذْكِرَةٌ (٤٨)﴾ يعني عظةً ﴿ لِّلْمُتَّقِينَ (٤٨)﴾ وهم الذين يتقون عقاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.
﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم (٤٩)﴾ أيها الناس ﴿مُّكَذِّبِينَ (٤٩)﴾ بالقرءان، وهذا وعيد لمن كذب بالقرءان. وفي الآية دليل على أن الله عَلِم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون.
﴿وَإِنَّهُ (٥٠)﴾ أي القرءان ﴿لَحَسْرَةٌ (٥٠)﴾ أي ندامة ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠)﴾ أي يوم القيامة، والمعنى أنهم يندمون على ترك الإيمان به لما يَرَوْنَ من ثواب من ءامن به.
﴿وَإِنَّهُ (٥١)﴾ أي القرءان ﴿لَحَقُّ الْيَقِينِ (٥١)﴾ لا شك فيه أنه من عند الله ليس من تأليف محمد ولا جبريل عليهما السلام وفيه الحق والهدى والنور.
﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٥٢)﴾ أي نزّه الله عن النقائص والسوء وكل ما لا يليق به واشكره على أن جعلك أهلاً لإيحائه إليك.
وفي هذه الآية دليل على أن المؤمن مأمور بتنزيه خالقه عن صفات المخلوقين من الجهل والعجز والمكان والجسمية والكميَّة أي الحجم، قال الإمام السلفي أبو جعفر الطحاوي: “وتعالى –أي الله- عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات”، فالله تعالى ليس له حد أي حجم كبير ولا حجم صغير لأن كل ذلك من صفات المخلوقين والله تعالى منزه عن ذلك.
سورة المعارج
سورة المعارج
مكية بالإجماع، وهي أربع وأربعون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَرَاهُ قَرِيباً (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُئْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ (14) كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35) فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنْ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44)
ويقال لها أيضًا: سورة سأل سائل، ويقال لها: سورة الواقع.
﴿سألَ سائِلٌ بِعذابٍ واقعٍ﴾ أي سأل سائل من الكفار عن عذاب الله بمن هو واقع؟ ومتى يكون؟ فقال الله تعالى مجيبًا لذلك السؤال:
﴿للكافرينَ﴾ أي على الكافرين، وقيل معنى الآية: دعا داع وطلب طالب عذابًا واقعًا للكافرين، وأخرج النسائي وغيره[1] عن ابن عباس: ﴿سأل سائلٌ﴾ قال: “هو النضر بن الحارث، قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء”، فنزلت الآية، وقد قتل يوم بدر.
وقرأ أبو جعفر، ونافع، وابن عامر: “سال” بغير همز.
﴿ليسَ لهُ دافعٌ﴾ أي أن العذاب واقع بهم لا محالة سواء طلبوه أو لم يطلبوه إما في الدنيا بالقتل وإما في الآخرة لأن العذاب واقع بهم في الآخرة لا يدفعه عنهم دافع.
وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: نزلت ﴿سألَ سائلٌ بعذابٍ واقع﴾ فقال الناس: على من يقع العذاب؟ فأنزل الله: ﴿للكافرينَ ليسَ لهُ دافعٌ﴾.
————-
1- تفسير النسائي [2/463]، والحاكم في المستدرك [2/502].
﴿مِنَ اللهِ﴾ أي بعذاب من الله، والمعنى ليس لذلك العذاب الصادر من الله للكافرين دافع يدفعه عنهم ﴿ذي المعارِجِ﴾ أي مصاعد الملائكة وهي السموات تعرج فيها الملائكة من سماء إلى سماء، وقيل ذي الفواضل والنّعم.
﴿تَعْرُجُ﴾ أي تصعد ﴿الملائكةُ والرُّوحُ﴾ هو جبريل عليه السلام، وإنما أُخر بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته ﴿إليهِ﴾ أي إلى المكان المشرَّف الذي هو محلهم وهو في السماء لأن السماء مهبط الرحمات والبركات، وقيل: إلى عرشه، وليس معناها كما ذهبت المجسمة إلى أن الله تعالى يسكن العرش والعياذ بالله بل الله عزَّ وجلَّ منزه عن المكان والجهة، ولا يستلزم ورود لفظ إلى أن يكون المعنى مكانًا ينتهي وجود الله إليه فإن الله تعالى أخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ﴿إنِّّي ذاهبٌ إلى ربِّي سَيَهْدينِ﴾ أي إلى حيث أمرني ربي وكان ذهابه من العراق إلى الشام ولم يكن رب العزة قطعًا في الشام لما تقرر بالدلائل القاطعة من تنزه الله عن الجهات والأماكن وإنما دل لفظ إلى ربي على شرف المكان المقصود، وكذلك في قوله [إليه] في الآية المتقدمة.
وقرأ الكسائي: “يَعْرُجُ” بالياء.
﴿في يومٍ﴾ هو يوم القيامة ﴿كانَ مِقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ﴾ أي من سِني الدنيا جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة من وقت البعث إلى أن يفصل بين الخلق، وهذا الطول في حق الكفار دون المؤمنين، وقيل في معنى هذه الآية إن عروج الملائكة من أسفل الأرض إلى العرش في وقت كان مقداره على غيرهم لو صَعِدَ خمسين ألف سنة.
روى أحمد[2] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4)﴾ ما أطولَ هذا اليومَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخفَّ عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا”.
وروى أيضًا[3] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ينصب للكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنمَ ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة”.
واعلم أن من طال انتظاره في الدنيا للموت لشدة مقاساته للصبر عن الشهوات فإنه يقصر انتظاره في ذلك اليوم خاصة، فاحرص أن تكون من أولئك المؤمنين، فما دام يبقى لك نَفَسٌ من عمرك فالأمر إليك والاستعداد بيديك، فاعمل في أيام قصار لأيام طوال تربح ربحًا لا منتهى لسروره، واستحقر عمرك بل عمر الدنيا فإن صبرت عن المعاصي في الدنيا لِتَخلُصَ من عذاب يوم مقداره خمسون ألف سنة يكن ربحك كثيرًا وتعبك يسيرًا.
————-
2- أخرجه أحمد في مسنده [3/75].
3- أخرجه أحمد في مسنده [3/75].
﴿فاصْبِرْ﴾ أي يا محمد ﴿صبرًا جميلاً﴾ أي صبرًا لا جَزَعَ فيه ولا شكوى لغير الله، والمعنى: اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك ولا يثنيك ما تلقى منهم من المكروه عن تبليغ ما أمرك ربك أن تبلغهم من الرسالة.
قال ابن الجوزي: “قال المفسرون صبرًا لا جَزَع فيه، وزعم قوم منهم ابن زيد أن هذا كان قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف” اهـ.
﴿إنَّهُم﴾ أي إن هؤلاء المشركين ﴿يَرَونَهُ﴾ أي يَرَوْن العذاب أو يوم القيامة ﴿بعيدًا﴾ أي غيرَ كائن ولا واقع، وإنما أخبر الله عزَّ وجلَّ أنهم يرونه بعيدًا لأنهم كانوا لا يصدقون به وينكرون البعثَ بعد الممات والثوابَ والعقابَ.
﴿ونراهُ﴾ هذه النون نون المتكلم المعظم نفسه وهو الله سبحانه وتعالى، والمعنى: ونعلمه ﴿قريبًا﴾ وقوعُه أي واقعًا لا محالة، وكل ما هو ءات قريب.
﴿يومَ تكونُ السماءُ كالمُهلِ﴾ أي كعكرِ الزيت، وقيل: ما أُذيب من الرصاص والنحاس والفضة.
﴿وتكونُ الجبالُ كالعِهْنِ﴾ أي كالصوف المصبوغ ألوانًا لأن الجبال مختلفة الألوان فإذا بست وطيرت في الجوّ أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح، شبهها في ضعفها ولينها بالصوف، وقيل: شبهها به في خفتها وسيرها.
﴿ولا يَسْئَلُ حميمٌ حميمًا﴾ أي لا يسأل قريبٌ قريبَه عن شأنه لشغله بشأن نفسه لهول ذلك اليوم وشدته كما في قوله تعالى: ﴿يومَ يَفِرُّ المرءُ من أخيهِ* وأمِّهِ وأبيه* وصاحبتِهِ وبنيهِ* لكُلِّ امرئ منهُم يومئذٍ شأنٌ يُغنيهِ﴾ [سورة عبس].
وقرأ أبو جعفر: “ولا يُسأَلُ” بضم الياء.
﴿يُبصرونهُم﴾ أي يرونهم فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله ولا يكلمه لاشتغالهم بأنفسهم ﴿يَوَدُّ﴾ أي يتمنى ﴿المُجرمُ﴾ أي الكافر ﴿لو يَفتدي من عذابِ يومئذٍ﴾ أي من عذاب يوم القيامة بأعز من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا يقدر.
ثم ذَكَرَهم الله فقال ﴿بِبَنيهِ﴾ أي أولاده ﴿وصاحبتِهِ﴾ أي زوجته ﴿وأخيهِ* وفصيلتِهِ﴾ أي عشيرته ﴿التي تُئويهِ﴾ أي تضمه ويأوي إليها.
﴿ومَنْ في الأرضِ جميعًا﴾ أي من الناس ﴿ثُمَّ يُنجِيهِ﴾ أي يخلّصه ذلك الفداء من عذاب الله، أي ويود الكافر لو فُدي بهم لافتدَى. بدأ الله عزَّ وجلَّ بذكر البنين ثم الصاحبة أي الزوجة ثم الأخ إعلامًا منه عبادَه أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء لو وجد إلى ذلك سبيلاً بأحب الناس إليه كان في الدنيا وأقربِهم إليه نسبًا لفعل.
روى ابن حبان[4] عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العَجُز، ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فِيْه، وأشار بيده فألجم فاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة”.
وروى ابن حبان[5] أيضًا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الكافر ليُلجِمُه العرق يوم القيامة فيقول: أرحني ولو إلى النار”.
فإذا كان هذا هو حال الكافر الذي ينادي ليدخله الله النار من شدة ما يجد من الألم والكرب من طول ذلك اليوم الذي يقف فيه للحساب فكيف به إذا دخل النار. وأما المؤمن التقي فيظله الله في ظل العرش حيث لا ظلَّ إلا ظله، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة.
————-
4- أخرجه ابن حبان في صحيحه، انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان [9/214-215].
5- انظر المصدر السابق [9/216].
﴿كلا﴾ ردع للمجرم ونفي لما يودُّه من الافتداء، وفي الآية دلالة على أن الافتداء لا ينجيه من عذاب الله، ثم ابتدأ الله عزَّ وجلَّ الخبر عما أعده للكافر يوم القيامة فقال: ﴿إنَّها﴾ أي النار ﴿لظى﴾ أي جهنم، سُميت لظى لأنها تتلظى أي تتلهب على الكافر.
﴿نَزَّاعةٌ للشوى﴾ جمع شواة وهي جلدة الرأس أي تنزع جلدة الرأس، وقيل: الشوى أطراف الإنسان كاليدين والرجلين، والمعنى قَلَّاعَةٌ للأعضاء الواقعة في أطراف الجسد ثم تعود كما كانت وهكذا أبدًا.
وقرأ الجمهور: “نَزَّاعَةٌ” بالرفع على معنى: هي نزاعة، وقرأ حفص: “نَزَّاعَةًً” بالنصب.
﴿تَدْعُوا﴾ يعني النار إلى نفسها حقيقة يخلق الله فيها الكلام كما يخلقه في الأعضاء ﴿مَنْ أدبَرَ﴾ في الدنيا عن طاعة الله ﴿وتَوَلَّى﴾ عن الإيمان بالله ورسوله، ودعاؤها أن تقول: إليَّ يا مشرك إليَّ يا كافر، تدعو الكافرين ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب.
﴿وجَمَعَ﴾ أي جمع المال ﴿فأوعى﴾ أي جعله في وعائه ومنع منه حق الله تعالى.
﴿إنَّ الإنسانَ﴾ أريد به الجنس ولذلك استثنى منه بقوله: “إلا المصلين” ﴿خُلِقَ هَلوعًا﴾ الهلع في اللغة: أشد الحرص وأسوأ الجَزَع وأفحشه، وتفسير الآية ما بعدها وهو قوله تعالى: ﴿إذا مسَّهُ﴾ أي أصابه ﴿الشرُّ جزوعًا﴾ أي أظهر شدة الجزع فلم يصبر.
﴿وإذا مسَّهُ الخيرُ مَنُوعًا﴾ أي إذا كَثُر ماله ونال الغنى فهو منوع لما في يديه بخيل به لا ينفقه في طاعة الله ولا يؤدي حق الله منه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “شرُّ ما في رَجلٍ شحٌّ هالعٌ وجبنٌ خالعٌ” رواه أبو داود[6] وغيره.
قال الحافظ الفقيه محمد مرتضى الزبيدي الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الإحياء ممزوجًا بالمتن ما نصه[7]: “[شر ما في الرجل] أي من مساوئ أخلاقه [شح هالع] أي جازع يعني شح يحمل على الحرص على المال والجزع على ذهابه [وجبن خالع] أي شديد كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق. قال العراقي: “رواه أبو داود من حديث أبي هريرة بسند جيد” انتهى قلت: ورواه كذلك البخاري في التاريخ والحكيم في النوادر وابن جرير في التهذيب والبيهقي في الشعب، وقال ابن طاهر: إسناده متصل” انتهى كلام الزبيدي.
————-
6- أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد: باب في الجرأة والجبن.
7- إتحاف السادة المتقين [8/194].
﴿إلا المُصَلِّينَ﴾ وهم أهل الإيمان بالله، وهذا استثناء ولذلك وصفهم بما وصفهم به من الصبر على المكاره والصفات الجميلة والمعنى: إلا الذين يطيعون الله بأداء ما افترض عليهم من الصلاة.
﴿الذينَ هُم على صلاتِهِم﴾ أي الصلاة المفروضة التي فرضها الله على عباده ﴿دائمونَ﴾ أي مواظبون عليها في أوقاتها لا يتركونها.
﴿والذينَ في أموالهِم حقٌّ معلومٌ﴾ يعني الزكاة المفروضة.
﴿للسائِلِ﴾ المحتاج الذي يسأل الناس لفاقته ﴿والمحرومِ﴾ أي المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئًا ولا يُعلِم الناس بحاجته، وقيل غير ذلك.
﴿والذينَ يُصدِّقونَ﴾ أي يؤمنون ويعتقدون اعتقادًا جازمًا ﴿بيومِ الدينِ﴾ وهو يوم القيامة أي يصدقون بالبعث والحشر والجزاء والحساب.
﴿والذينَ هُم من عذابِ ربِّهم مُّشفِقونَ﴾ أي والذين هم في الدنيا من عذاب ربهم خائفون أن يعذبهم الله في الآخرة، فهم من خشية ذلك لا يضيعون له فرضًا ولا يتعدون له حدًّا.
﴿إنَّ عذابَ ربهم غيرُ مأمونٍ﴾ أي لا ينبغي لأحد أن يأمنه بل يكون بين الخوف والرجاء يخاف عذاب ربه ويرجو رحمته.
﴿والذينَ هُم لِفُروجهم حافظون﴾ أي يحفظونها عن المحرمات كالزنى ونحوه.
روى البخاري في صحيحه[8] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من يَضمن لي ما بين لَحيَيْهِ وما بين رجليه أضمَن له الجنة”.
————-
8- اخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان.
﴿إلا على أزواجهم﴾ أي إلا من نسائهم اللاتي أحل الله لهم ﴿أو ما ملَكَتْ أيْمانُهُمْ﴾ يعني الإماء المملوكات ﴿فإنَّهُم غيرُ مَلومينَ﴾ يعني بعدم حفظ فرجه من امرأته وأمته اللتين أحل الله له الاستمتاع بهن بالجماع وغيره فإنه لا يلام على ذلك.
﴿فَمَنِ ابتغى وراءَ ذلكَ﴾ أي من التمس وطلب منكِحًا سوى زوجته أو ملك يمينه وهي الأمة المملوكة ﴿فأولئكَ هُمُ العادونَ﴾ أي الظالمون المجاوزون الحد من الحلال إلى الحرام.
﴿والذينَ هُمْ لأمانتِهم﴾ أي لأمانات الله التي ائتمنهم عليها من قول وفعل واعتقاد فيدخل في ذلك جميع الواجبات من الأفعال والتروك فيجب الوفاء بجميعها، وأمانات عباده التي ائتمنوا عليها بالقيام عليها لحفظها إلى أن تؤدى ﴿وعَهْدِهِمْ﴾ أي عهودِ الله التي أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به ونهاهم، وعهودِ عباده لما عاهدوا عليه غيرهم ﴿راعونَ﴾ أي حافظون، يحفظونه فلا يضيعونه ولكنهم يؤدونها ويتعاهدونها على ما ألزمهم الله وأوجب عليهم حفظها.
وقرأ ابن كثير وحده: “لأمانتهم”.
﴿والذينَ هُم بِشَهاداتِهِم قائِمونَ﴾ أي لا يكتمون ما استُشهدوا عليه ولكنهم يقومون بأدائها غير مغيَّرة ولا مبدَّلة، وهذه الشهادة من جملة الأمانات إلا أنه خصها بالذكر لفضلها لأن بها تحيا الحقوق وتظهر في تركها وتضيع.
وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم: “بشهادتهم”، وقرأ حفص عن عاصم: “بشهاداتهم”.
﴿والذينَ هُم على صلاتِهِم يُحافِظون﴾ أي يؤدون الصلوات الخمسَ المفروضة في وقتها مع الإتيان بشروطها وأركانها.
﴿أولئكَ﴾ يعني من هذا صفته ﴿في جنَّاتٍ مُكرمون﴾ أي يكرمهم الله بكرامته.
﴿فمالِ الذينَ كفروا﴾ أي فما بال الذين كفروا ﴿قِبَلَكَ﴾ أي نحوك يا محمد ﴿مُهْطِعينَ﴾ أي مسرعين في التكذيب لك، وقيل: يُسرعون إلى السماع منك لِيَعيبوك ويستهزءوا بك، وقيل: مسرعين عليك مادّين أعناقهم مدمني النظر إليك وذلك من نظر العدو.
﴿عَنِ اليمينِ وعنِ الشِّمالِ﴾ أي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله ﴿عِزينَ﴾ متفرقين حلقًا ومجالس جماعة جماعة معرضين عنك وعن كتاب الله.
﴿أيَطمعُ كلُّ امرئٍ منهُم أن يُدْخَلَ جَنَّةَ نعيمٍ﴾ أي أيطمع كل رجل من هؤلاء الذين كفروا أن يدخل الجنة كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيها.
﴿كلا﴾ ردٌّ وردع لطماعيتهم والمعنى لا يدخلون الجنة ﴿إنَّا خلقناهُم ممَّا يَعلمونَ﴾ أي أنهم يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما خلق سائر جنسهم، فليس لهم فضل يستوجبون به الجنة وإنما تُستوجَب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالى.
﴿فلا أقسمُ﴾ أي أقسم ﴿بربِّ المشارِقِ﴾ أي مطالع الشمس ﴿والمغاربِ﴾ أي مغاربها والمراد بالمشارق والمغارب: شرقُ كل يوم ومغربُهُ ﴿إنَّا لَقادرونَ* على أن نُّبَدِّلَ خيرًا منهم﴾ أي إنا لقادرون على إهلاكهم وعلى أن نخلق أمثل منهم وأطوع لله ﴿وما نحنُ بِمَسبوقين﴾ أي بمغلوبين عاجزين عن إهلاكهم وإبدالهم بمن هو خير منهم، فلا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر نريده.
﴿فَذَرهُم﴾ أي دع المكذبين واتركهم وهذا اللفظ أمر معناه الوعيد ﴿يخوضوا﴾ في باطلهم ﴿ويلعبوا﴾ أي يلهوا في دنياهم، ﴿حتى يُلاقوا يومَهُم الذي يُوعدونَ﴾ أي حتى يلاقوا عذاب يوم القيامة الذي يوعدونه.
قال ابن الجوزي: “زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، وإذا قلنا إنه وعيد بلقاء القيامة فلا وجه للنسخ” اهـ.
﴿يومَ يَخرجونَ مِنَ الأجداثِ﴾ أي القبور ﴿سِراعًا﴾ أي مسرعين حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي، والمعنى: يخرجون من القبور مسرعين إلى المحشر ﴿كأنَّهُم إلى نُصُبٍ﴾ أي الأصنام التي كانوا يعبدونها ﴿يُوفِضُون﴾ أي يسرعون، ومعنى الآية: أنهم يخرجون من الأجداث وهي القبور مسرعين إلى الداعي مُسْتَبِقِينَ إليه كما كانوا يستبقون إلى نصبهم ليستلموها، والأنصاب هي التي كان أهل الجاهلية يعبدونها ويأتونها ويعظمونها.
وقرأ ابن عامر، وحفص عن عاصم: “نُصُبٍ” بضم النون والصاد، وقرأ الباقون: “نَصْبٍ” بفتح النون وإسكان الصاد، وهي في معنى القراءة الأولى.
﴿خاشعةً أبصارُهُم﴾ أي ذليلة خاضعة لا يرفعونها لما يتوقعونه من عذاب الله ﴿تَرهقُهُم ذِلَّةٌ﴾ أي يغشاهم الهوان ﴿ذلكَ اليومُ﴾ وهو يوم القيامة ﴿الذي كانوا يُوعَدونَ﴾ به في الدنيا أن لهم فيه العذاب.
سورة نوح
سورة نوح
مكية، وهي ثمان وعشرون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (4) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً (12) مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً (16) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الأَرْضِ نَبَاتاً (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ بِسَاطاً (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً (20) قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً (21) وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (22) وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدْ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (24) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً (25) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدْ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً (28)
﴿إنَّا أرسَلنا نوحًا إلى قومِهِ﴾ أي أرسله الله تعالى ليدعو قومه إلى عبادة الله عزَّ وجلَّ وترك عبادة الأوثان، فهو أول نبي أُرسل إلى الكفار وليس هو أول نبي على الإطلاق بل أولهم ءادم عليه السلام ﴿أن أنذِرْ قومَكَ﴾ وخوّفهم وحذّرهم ﴿مِنْ قبلِ أن يأتيَهُم عذابٌ أليمٌ﴾ يعني عذاب النار في الآخرة أو الغرق بالطُوْفان، وقيل: أي أنذرهم العذاب الأليم على الجملة إن لم يؤمنوا.
﴿قالَ﴾ نوح لقومه ﴿يا قومِ إنِّي لكُم نذيرٌ﴾ أنذركم عذاب الله فاحذروه أن ينزل بكم على كفركم به ﴿مبينٌ﴾ أي أثبت لكم إنذاري إياكم، أي إنذاري بَيّن وواضح، وقيل: أبيّن لكم رسالة الله بلغة تعرفونها.
﴿أنِ اعبدوا اللهَ﴾ أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا ﴿واتَّقوهُ﴾ أي امتثلوا أوامره واجتنبوا معاصيه ﴿وأطيعونِ﴾ فيما ءامركم به وأنهاكم عنه فإني رسول الله إليكم.
وقرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، والكسائي: “أن اعبدوا الله” بضم النون، وقرأ عاصم، وحمزة وأبو عمرو بكسر النون.
فائدة: في هذه الآية أمرٌ من الله تعالى لعباده بأن يوحّدوه ويطيعوه، وهذا ردٌّ على الذين يقولون بحرية العقيدة أي يزعمون أن الإنسان إذا أراد أن يعبد كلبًا أو خنزيرًا أو ينكر وجود الله فله ذلك والعياذ بالله، وهو كلام باطل لا يُقرُّه صاحب عقل.
﴿يغفرْ لكُم﴾ جواب الأمر، وجُزم ﴿يغفر﴾ بجواب الأوامر الثلاثة وهي: عبادته عزَّ وجلَّ وتقواه وطاعته ﴿من ذنوبِكم﴾ أي بعض ذنوبكم لأن الإيمان إنما يَجُبُّ ما قبله من الذنوب أي يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان ﴿ويُؤَخِّرْكُم إلى أجَلٍ﴾ وهو وقت موتكم ﴿مُسَمًّى﴾ أي معلوم معيَّن عند الله لا يزيد ولا ينقص، فإن الله تعالى علم بعلمه الأزلي مَن يموت على الإيمان ومَن يموت على الكفر ومتى يكون منتهى ءاجال العباد ﴿إنَّ أجَلَ اللهِ إذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ﴾ أي إذا جاء الموت لا يؤخر بعذاب كان أو بغير عذاب، وأضاف الله الأجل إليه لأنه الذي أثبته، وقد يضاف إلى القوم كقوله تعالى: ﴿فإذا جاءَ أجلُهُم﴾ [سورة النحل] لأنه مضروب لهم.
﴿لو كُنْتُم تعلمونَ﴾ أي لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند انقضاء أجلكم لآمنتم.
﴿قالَ﴾ نوح عليه السلام لما بلَّغ قومه رسالة ربه فعصوه وردوا عليه ما أتاهم به من عند الله ﴿رّبِّ إنِّي دَعَوْتُ قومي﴾ إلى توحيدك وعبادتك وحذرتهم بأسك ﴿ليلاً ونهارًا﴾ أي في كل الأوقات بلا فتور
﴿فلم يَزِدْهُم دُعائي﴾ إياهم إلى ما دعوتهم إليه من الحق الذي أرسلتني به لهم ﴿إلا فِرارًا﴾ أي تباعدًا من الإيمان، ونسب ذلك إلى دعائه وإن لم يكن الدعاء سببًا للفرار من الحقيقة.
﴿وإنِّي كُلَّما دعَوْتُهم﴾ إلى الإقرار بوحدانيتك والعمل بطاعتك والبراءة من عبادة كل ما سواك ﴿لِتَغفرَ لهُم﴾ أي ليتوبوا فتغفر لهم، أي كلما دعوتُهم إلى سبب المغفرة وهي الإيمان بك والطاعة لك ﴿جَعَلوا أصابِعهُم في ءاذانِهِم﴾ أي سدوا مسامعهم بأصابعهم حتى لا يسمعوا دعائي إياهم إلى عبادتك ﴿واسْتَغشَوْا ثِيابَهُم﴾ أي غَطَّوا وجوههم بثيابهم حتى لا ينظروا إلى نبي الله نوح عليه السلام كراهة وبغضًا من سماع النصح ورؤية الناصح ﴿وأصَرُّوا﴾ أي على الكفر فلم يتوبوا ﴿واسْتَكبروا﴾ أي تكبّروا عن قبول الحق ﴿استِكبارًا﴾ ذِكرُ المصدر هنا دليل على فرط استكبارهم أي تكبروا تكبرًا عظيمًا.
﴿ثُمَّ إني دعَوتُهُم﴾ إلى ما أمرتني أن أدعوهم إليه ﴿جِهارًا﴾ أي معلنًا لهم بين الناس ظاهرًا من غير خفاء.
﴿ثمَّ إنِّي أعلنتُ لهم﴾ أي كررت لهم الدعاء معلنًا ﴿وأسْرَرْتُ﴾ الكلام ﴿لهُم إسرارًا﴾ أي فيما بيني وبينهم في خفاء، وكل هذا من نوح مبالغة في الدعاء لهم، فقد نوَّع سيدنا نوح عليه السلام بالدعوة فتارة يدعوهم سرًّا وتارة يجاهر بالدعوة وتارة يجمع بين الإسرار والجهر.
﴿فقلتُ﴾ أي قال سيدنا نوح عليه السلام لقومه يأمرهم بالدخول في الإسلام ﴿استَغْفِروا ربَّكُمْ﴾ أي اطلبوا من ربكم المغفرة بترك الكفر الذي أنتم عليه بالإيمان بالله وحده في استحقاق الألوهية والإيمان بنوح أنه نبي الله ورسوله إليكم بالنطق بالشهادتين، وليس المراد بالاستغفار هنا مجرد القول باللسان: “أستغفر الله” لأن قوم نوح كانوا على الشرك، والكافر لا يصح منه النطق بالاستغفار وهو على كفره.
﴿إنَّهُ كانَ غَفَّارًا﴾ أي غفارًا لذنوب من أناب وتاب إليه من ذنوبه.
﴿يُرسِلِ السَّماءَ عليكُم﴾ أي ماء السماء ﴿مِدرارًا﴾ أي ذا غيث كثير
﴿ويُمْدِدْكُم بأموالٍ وبنينٍ﴾ أي يكثّر أموالكم وأولادكم ﴿ويجعل لكم جنَّاتٍ﴾ أي يرزقكم بساتين ﴿ويجعل لكم أنهارًا﴾ أي أنهارًا جارية تسقون منها مزارعكم وبساتينكم.
﴿ما لكُم لا ترجونَ للهِ وقارًا﴾ أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة، وقيل: ما لكم لا ترجون لله ثوابًا ولا تخافون له عقابًا.
﴿وقد خَلَقَكُم أطوارًا﴾ أي طورًا بعد طور أي طورًا نطفة وطورًا علقة وطورًا مضغة وطورًا عظامًا ثم كسا العظام لحمًا ثم أنشأه خلقًا ءاخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
ثم لما نبههم نوح عليه السلام على الفكر في أنفسهم وكيف انتقلوا من حال إلى حال وكانت الأنفس أقربَ ما يفكرون فيه منهم، أرشدهم إلى الفكر في العالم عُلوِهِ وسُفلِهِ وما أودع الله تعالى فيه، وذكر لهم دليلًا ءاخر يدلُّ على توحيده وسعة قدره، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ أي تنظروا وتتفكروا وتعتبروا ﴿كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً﴾ بعضها فوق بعض.
﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً﴾ أي في السماء الدنيا، وقيل: إن وجه القمر قِبَلَ السماوات وظهرَه قِبَلَ الأرضِ يضيء لأهل السماوات كما يضيء لأهل الأرض ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً﴾ أي مصباحًا مضيئًا لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم، وقد شبّه الشمس بالسراج من حيث أنها تزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض كما يزيلها السراج عما حوله.
﴿واللهُ﴾ القادر على كل شيء هو الذي ﴿أنبَتكُم﴾ أي أنشأكم وخلقكم، والإنبات استعارة في الإنشاء أي أنشأ ءادم عليه السلام ﴿مِنَ الأرضِ﴾ وصارت ذريته منه، فصح نسبتهم كلهم إلى أنهم أُنبتوا منها ﴿نباتًا﴾ أي إنباتًا، أو على معنى فَنَبَتم نباتًا. وقد نبَّه بذلك إلى أن الإنسان هو من وجه نبات من حيث إن بدأه ونشأه من التراب وأنه ينمو نموه وإن كان له وصف زائد على النبات.
﴿ثمَّ يُعيدُكُم فيها﴾ عند موتكم بالدفن يعيدكم إلى الأرض كما كنتم ترابًا.
﴿ويُخرجُكم﴾ من الأرض يوم القيامة بالنشور للبعث ويعيدكم كما كنتم في الدنيا ﴿إخراجًا﴾ أكَّدَه بالمصدر أي ذلك واقع لا محالة.
﴿واللهُ﴾ عزَّ وجلَّ ﴿جعلَ لكُم الأرضَ بِساطًا﴾ أي مبسوطة تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه.
﴿لِتَسْلُكوا منها سُبُلاً﴾ أي طُرُقًا ﴿فِجاجًا﴾ أي واسعة.
ولما أصروا على العصيان وعاملوه بأقبح الأقوال والأفعال ﴿قالَ نوحٌ ربِّ إنَّهُم عَصَوني﴾ فيما أمرتهم به فلم يجيبوا دعوتي لهم بالإيمان بك وأني رسولك ﴿واتَّبَعوا﴾ عامتُهم وسفلتُهم ﴿مَنْ لم يَزِدهُ مالهُ وولدُهُ إلا خَسَارًا﴾ اتبعوا رؤساءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم إلا ضلالاً في الدنيا وهلاكًا في الآخرة.
وقرأ أهل المدينة، وابن عامر، وعاصم: “وَوَلَدُهُ” بفتح اللام والواو، وقرأ الباقون: “وَوُلْدُهُ” بضم الواو وسكون اللام، وهما بمعنى واحد.
﴿وَمَكروا﴾ أي وكان مكرُهم احتيالُهم في الدّين وكيدُهم لنوح عليه السلام وتحريشُ السَّفَلَةِ على أذاه وصدُّ الناس عن الإيمان به والميلِ إليه والاستماعِ منه ﴿مَكْرًا كُبَّارًا﴾ أي مكرًا كبيرًا عظيمًا.
﴿وقالوا﴾ أي قال القادة لأتباعهم، أو قال بعضهم لبعض ﴿لا تَذَرنَّ ءالِهَتكم﴾ أي لا تتركن عبادة أصنامكم ﴿ولا تذرنَّ وَدًّا ولا سُواعًا ولا يغوثَ ويعوقَ ونَسْرًا﴾ وهذه أسماء قوم صالحين كانوا بين ءادم ونوح عليهما السلام فلمَّا ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون بعدهم مأخذهم في العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم: لو صوَّرتم صورهم كان أنشطَ لكم وأشوقَ إلى العبادة ففعلوا ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فكان ابتداء عبادة الأوثان من ذلك الوقت، فكان نوحٌ أولَ رسول أرسله الله إلى الكفار.
روى البخاري[1] في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “صارت الأوثان التي كانت في قوم نوحٍ في العرب بَعْدُ، أما ودٌّ فكانت لكلْبٍ بدُوْمَةِ الجَنْدل، وأما سُواعٌ فكانت لِهُذَيْل، وأما يَغُوثُ فكانت لِمُرادٍ ثم لبني غُطَيْفٍ بالجُرُف عند سبإ، وأما يعوقُ فكانت لِهَمْدَانَ، وأما نسْرٌ فكانت لِحِمْيَرَ لآل ذي الكَلَاعِ، أسماءُ رجال صالحين من قوم نوحٍ، فلما هَلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسَمُّوها بأسمائهم ففعلوا، فلم تُعْبَد حتى إذا هلكَ أولئك وتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَت”.
وقرأ نافع وأبو جعفر: “وُدًّا” بضم الواو، والباقون بفتحها.
————-
1- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب سورة نوح.
﴿وقد أضلُّوا كثيرًا﴾ أي أضل الرؤساء المتبوعون كثيرًا من أتباعهم وعامتهم، وهذا إخبار من نوح عليه السلام عنهم بما جرى على أيديهم من الضلال.
ولما أخبر أنهم ضلوا كثيرًا دعا عليهم بالضلال فقال ﴿ولا تَزِدِ الظالمينَ﴾ أي المشركين بعبادتهم الأصنام ﴿إلا ضَلالاً﴾ أي إلا طبعًا على قلوبهم حتى لا يهتدوا للحق.
فإن قيل: كيف يليق بمنصب النبوة أن يدعو بمزيد الضلال وإنما بُعث لهدايتهم وإرشادهم؟!
فالجواب: أنه إنما دعا عليهم لا رضًا بكفرهم وإنما تشديدًا عليهم ليأسه من إيمانهم بإخبار الله له بذلك أنهم لا يؤمنون كما في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿أنَّهُ لن يؤمنَ من قومكَ إلا من قد ءامنَ﴾ [سورة هود].
﴿مَمَّا خَطِيئاتِهم﴾ أي بسبب ذنوبهم وشركهم ﴿أُغْرِقوا﴾ بالطوفان ﴿فأُدخِلوا نارًا﴾ أي نار جهنم، وعبَّر عن المستقبل بالماضي لتحققه، أو عبَّر بالدخول عن عرضهم على النار غدوًّا وعشيًّا كما قال: ﴿النَّارُ يُعرَضون عليها غُدُوًّا وعشيًا ويومَ تقومُ الساعةُ أدخلوا ءال فرعونَ أشدَّ العذابَ﴾ [سورة غافر]، ﴿فلمْ يَجِدوا لهم من دونِ اللهِ أنصارًا﴾ أي لم يجدوا غير الله أنصارًا تنصرهم وتمنعهم وتدفع عنهم عذاب الله.
وقرأ أبو عمرو: “مما خطاياهم”.
﴿وقالَ نوحٌ ربِّ لا تَذَرْ﴾ أي لا تترك ﴿على الأرضِ مِنَ الكافرينَ دَيَّارًا﴾ أي أحدًا.
﴿إنَّكَ إنْ تَذَرهُم﴾ أي إن تذر الكافرين أحياء على الأرض ولم تهلكهم بعذاب من عندك ﴿يُضِلُّوا عِبادَكَ﴾ أي يدعوهم إلى الضلال ﴿ولا يَلِدوا إلا فاجرًا كَفَّارًا﴾ أي إلا مَن سيكون فاجرًا كفَّارًا إذا بلغ مبلغ التكليف، وإنما قال ذلك لما جرَّبهم واستقرى أحوالهم وعرف طباعهم فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، وكما أنه عليه السلام دعا عليهم بعد أن أوحى الله تعالى إليه: ﴿أنّهُ لن يؤمنَ من قومِكَ إلا مَنْ قد ءامَنَ﴾ [سورة هود].
﴿رَبِّ اغفِرْ لي ولوالِدَيَّ﴾ وكانا مؤمنين ﴿ولمَن دخَلَ بيتي مُؤمنًا وللمؤمنين والمؤمناتِ﴾ أي بيتي مسجدي، وقيل: منزله، وقيل: سفينته ﴿ولا تَزِدِ الظالمينَ﴾ أي الكافرين ﴿إلا تبارًا﴾ أي هلاكًا، فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم.
وقرأ حفص عن عاصم: “بيتيَ” بفتح الياء.
سورة الجن
سورة الجن
مكية، وهي ثمان وعشرون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءاناً عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً (9) وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (15) وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً (17) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (19) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً (20) قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (22) إِلاَّ بَلاغاً مِنْ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً (28)
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: “انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفةٍ من أصحابه عامدين إلى سوق عُكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأُرسلت عليهم الشُّهُب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشُّهب، قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارقَ الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: فانطلق الذين توجَّهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِنَخْلَةَ وهو عامِدٌ إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرءان تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، ﴿إنَّا سَمِعنا قُرءانًا عَجَبًا* يهدي إلى الرُّشْدِ فآمَنَّا بهِ ولن نُشرِكَ بربِّنا أحدًا﴾، وأنزل الله عزَّ وجلَّ على نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ أوحيَ إليَّ أنَّهُ اسْتَمَعَ نفرٌ منَ الجِنِّ﴾ وإنما أوحي إليه قولُ الجن”.
————-
1- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: سورة قل أوحي إلي.
﴿قُلْ﴾ يا محمد للناس ﴿أوحِيَ إليَّ﴾ أي أوحى الله إليَّ ﴿أنهُ استمَعَ﴾ لقراءتي القرءان ﴿نفرٌ﴾ أي جماعة من الثلاثة إلى العشرة ﴿مِنَ الجن﴾ وهم صنف من خلق الله تعالى خلقهم الله من مارج من نار يستترون عن أعين الناس لا يرونهم، وإنكار وجود الجن من نواقض الإيمان مخرجٌ من الدين لأنه تكذيب لما أخبر به رب العالمين ﴿فقالوا﴾ أي الجن لقومهم حين رجعوا إليهم من استماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ﴿إنَّا سَمِعنا قُرءانًا عَجَبًا﴾ أي بليغًا لم يُعهَد مثله لفصاحة كلامه وحسن مبانيه ودقة معانيه وبلاغة مواعظه وكونه مباينًا لسائر الكتب، وفي هذه الآية إشارة إلى أن النبي عليه السلام بُعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس وأنهم مكلفون ويستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا وأن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان.
﴿يَهدي﴾ أي القرءان يدعو ﴿إلى الرُّشْدِ﴾ أي إلى الحق والصواب والتوحيد والإيمان ﴿فآمَنَّا بهِ﴾ أي بالقرءان، ولما كان الإيمان به متضمنًا الإيمان بالله وبوحدانيته وبراءةً من الشرك قالوا ﴿ولن نُشركَ بربنا أحدًا﴾ أي لن نشرك بربنا أحدًا من خلقه.
﴿وأنَّهُ تعالى جدُّ ربِّنا﴾ أي تنزَّه جلاله وعظمته عما نسب إليه من اتخاذ الصاحبة والولد ﴿ما اتَّخَذَ صاحبةً﴾ أي ليس له زوجة ﴿ولا ولدًا﴾ وليس له أولاد لأن الله عزَّ وجلَّ منزه عن ذلك فهو عزَّ وجلَّ واحد لا شريك له لم يلد ولم يولد وليس له شبيه ولا نظير ﴿ليسَ كمثلهِ شيءٌ وهوَ السميعُ البصيرُ﴾ [سورة الشورى].
﴿وأنَّهُ كانَ يقولُ سَفيهُنا﴾ جاهلنا، وقيل هو إبليس، وقيل المشرك من الجن يقول ﴿على اللهِ شطَطًا﴾ أي كذبًا وعدوانًا وظلمًا وهو وصفه تعالى بالشريك والولد.
﴿وأنَّا﴾ أي يقول هؤلاء النفر من الجن الذين سمعوا القرءان وءامنوا به ﴿ظَنَنَّا﴾ أي حسبنا ﴿أن لن تَقُولَ الإنسُ والجنُّ على اللهِ كَذِبًا﴾ أي قولا كذبًا والمعنى: أنا كنا نظن أن أحدًا لن يجترئ على أن يكذب على الله فينسُبَ إليه الصاحبة والولد فاعتقدنا صحة ما أغوانا به إبليس ومردته حتى سمعنا القرءان قتبينا كذبهم.
﴿وأنَّهُ كانَ رجالٌ﴾ أي في الجاهلية ﴿مِنَ الإنسِ يَعُوذونَ﴾ أي يستعيذون ﴿برجالٍ مِنَ الجنِّ﴾ أي أن الرجل كان إذا أراد المبيت أو الحلول في واد نادى بأعلى صوته: يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك فيعتقدُ بذلك أن الجني الذي بالوادي يمنعه ويحميه ﴿فزادوهُم﴾ أي زاد الجنُّ الإنسَ ﴿رَهَقًا﴾ أي خطيئة وإثمًا، وأضيفت الزيادة إلى الجن إذ كانوا سببًا لها.
أخرج ابن المنذر عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حَمَلاً من الغنم فوثب الراعي، فقال: عامرَ الوادي جارَك، فنادى مناد لا نراه: يا سِرحان، فأتى الحمل يشتدّ حتى دخل في الغنم، وأنزل الله على رسوله بمكة: ﴿وأنَّهُ كانَ رجالٌ منَ الإنسِ يعوذونَ برجالٍ من الجن﴾ الآية.
﴿وأنَّهُمْ﴾ أي كفار الإنس ﴿ظَنُّوا كما ظننتم﴾ أيها الجن ﴿أن لن يبعثَ اللهُ أحدًا﴾ أي ظننتم أن الله لن يبعث رسولا إلى خلقه يقيم به الحجة عليهم.
﴿وأنَّا﴾ يعني يقول الجن: وأنا ﴿لَمَسنا السماءَ﴾ أي طلبنا وقصدنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها وهم الملائكة ﴿فوَجدناها﴾ أي فوجدنا السماء قد ﴿مُلِئَتْ حَرَسًا شديدًا﴾ أي ملائكة حافظين من أن تقربها الشياطين ﴿وشُهُبًا﴾ جمع شِهاب وهو ما يرجم به الشياطين إذا استمعوا.
﴿وأنَّا﴾ أي معاشر الجن ﴿كُنَّا﴾ أي قبل هذا ﴿نقْعُدُ مِنها﴾ أي من السماء ﴿مقاعِدَ للسَّمْعِ﴾ أي مواضع يُقْعد في مثلها لاستماع الأخبار من السماء قبل المبعث، يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة وليسترقوا الكلمة حتى يُلقوها إلى الكهنة ويزيدون معها ثم يزيد الكهان في الكلمة مائة كذبة ﴿فمَن يستمِعِ الآنَ﴾ بعد المبعث ﴿يجِدْ لهُ شِهابًا رَصَدًا﴾ يعني شهاب نار قد رصد له ليرجم به ”
﴿وأنَّا لا ندري أشرٌّ أُريدَ بِمَن في الأرضِ﴾ أي لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بإرسال محمد إليهم فإنهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كذَّب من الأمم ﴿أمْ أرادَ بهم ربهم رَشَدًا﴾ أي أراد أن يؤمنوا فيهتدوا، وقيل: وأنا لا ندري أعذابًا أراد الله أن ينزله بأهل الأرض بمنعه إيانا السمع من السماء ورجمه من استمع منا فيها بالشهب أم أراد بهم ربهم الهدي بأن يبعث منهم رسولا مرشدًا يرشدهم إلى الحق.
﴿وأنَّا﴾ هذا إخبار من الجن بما هم عليه من الصلاح وغيره ﴿مِنَّا الصالحون﴾ أي المؤمنون المتقون العاملون بطاعة الله عزَّ وجلَّ ﴿ومِنَّا دونَ ذلكَ﴾ أي ومنا غير المؤمنين، ويجوز أن يريدوا ومنا دون ذلك في الصلاح، أي فيهم أبرار وفيهم من هو غير كامل في الصلاح ﴿كُنَّا طرائِقَ قِدَدًا﴾ أي أهواء مختلفة، وفِرقًا شتى.
﴿وأنَّا ظنَنَّا﴾ أي علمنا وأيقنا ﴿أن لن نُعْجِزَ اللهَ﴾ أي لن نَفُوتَهُ ﴿في الأرض﴾ أينما كنا إذا أراد بنا أمرًا ﴿ولن نُعجِزَهُ هَرَبًا﴾ من الأرض إلى السماء، ومعنى الآية أن الجن قالوا لن نُعجز الله كائنين في الأرض أينما كنا فيها وهاربين منها إلى السماء، ولن نُعجزه عن إمضاء ما أراد بنا سواء كنا ساكنين مستقرين في الأرض أو هاربين فيها من موضع إلى ءاخر، فالفرار وعدمه سيَّان في أن شيئًا منهما لا يمنع ولا يدفع نفاذ إرادة الله عزَّ وجلَّ فينا، فالأرض مع سعتها وانبساطها ليست منجى منه تعالى ولا مهربًا، ألا ترى إلى قوم نوح كيف أغرقهم الله بالطوفان ونجَّى الذين ءامنوا بنوح عليه السلام، فسبحان الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير.
﴿وأنَّا لمَّا سمِعنا الهُدى﴾ أي لمَّا سمع الجن القرءان الذي يهدي إلى الصراط المستقيم قالوا ﴿ءامنَّا بهِ﴾ أي صدقنا به وأقررنا أنه حق من عند الله ﴿فَمَن يُؤمِن بربِّهِ فلا يخافُ بَخسًا﴾ أي لا يخاف أن يُنْقَص من حسناته فلا يجازَى عليها ﴿ولا رَهَقًا﴾ أي ولا يخاف أن يزاد في سيئاته، وقيل ولا ظلمًا ولا مكروهًا يخشاه.
﴿وأنَّا مِنَّا المُسْلمونَ﴾ أي الذين ءامنوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ومِنَّا القاسِطونَ﴾ أي الكافرون الجائرون عن الحق ﴿فَمَنْ أسلَمَ فأولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ أي قصدوا طريق الحق وتوخَّوه.
﴿وأمَّا القاسِطونَ﴾ أي الجائرون على طريق الحق والإيمان وهم كفار الجن ﴿فكانوا لِجَهنَّمَ حَطَبًا﴾ أي حطبًا توقد بهم كما توقد بكفار الإنس، وفي هذه الآية دليل على أن الكفار من الجن يعذبون في النار، فإن قيل: كيف يعذبون بالنار وهم مخلوقون من نار؟ فالجواب أن يقال: الجن تغيَّروا عن صفتهم الأصلية كما أن الإنس خلقوا من تراب وتغيَّروا عن صفتهم الأصلية.
﴿وأَلَّوِ استَقاموا﴾ أي لو استقام هؤلاء القاسطون ﴿على الطريقةِ﴾ أي على طريق الإسلام ﴿لأسقَيْناهُم ماءً غَدَقًا﴾ أي كثيرًا، والمعنى لوسَّعنا عليهم الرزق، وتخصيص الماء الغدق بالذّكر لأنه أصل المعاش والسعة، وقيل: نزلت هذه الآية في كفار قريش حين مُنِعَ المطرُ سبعَ سنين.
﴿لِنَفْتِنَهُم فيهِ﴾ أي لنختبرهم كيف يشكرون ما أنعم به عليهم ﴿ومَن يُعرِضْ عَن ذكرِ ربِّهِ﴾ أي القرءان ﴿يَسلُكْهُ﴾ أي يدخله ﴿عذابًا صَعَدًا﴾ أي شاقًّا شديدًا لا راحة فيه.
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: “نَسْلُكهُ” بالنون، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء.
﴿وأنَّ المساجِدَ﴾ يعني المواضع التي بنيت لعبادة الله وتوحيده وتمجيده ﴿للهِ﴾ إضافة تشريف وتكريم أي هذه المساجد مُشرَّفة عند الله ﴿فلا تَدْعوا معَ اللهِ أحدًا﴾ أي لا تشركوا به شيئًا ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة.
﴿وأنَّهُ لمَّا قامَ عبدُ اللهِ﴾ هو محمد صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي صلاة الفجر ويقرأ القرءان ﴿يدعُوهُ﴾ أي يعبد الله ﴿كادوا﴾ أي الجن أو الإنس ﴿يكونونَ عليهِ لِبدًا﴾ أي جمعًا كثيرًا بعضهم فوق بعض من الازدحام على النبي حرصًا على سماع القرءان، أو لما قام النبي بالدعوة كادت العرب تكون عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به، قال ابن عباس: “لِبَدًا: أعوانًا” رواه البخاري.
وقرأ الأكثرون: “لِبَدًا” بكسر اللام وفتح الباء، وقرأ هشام عن ابن عامر، وابن محيصن: “لُبَدًا” بضم اللام وفتح الباء مع تخفيفها، قال الفراء: ومعنى القراءتين واحد.
﴿قُلْ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المزدحمين عليك وهم إما الجن أو الإنس المشركون منهم على اختلاف القولين في ضمير “كادوا” ﴿إنَّما أدْعُوا ربي ولا أشركُ بهِ أحدًا﴾ أي قل للناس: لم ءاتكم بأمر يُنْكَر إنما أعبد ربي وحده وليس ذلك مما يوجب إطباقكم على عداوتي ومقتي، أو قل للجن عند ازدحامهم متعجبين: ليس ما ترون من عبادة الله بأمر يتعجب منه إنما يتعجب ممن يعبد غيره.
وقرأ عاصم وحمزة: “قل” بغير ألف، وقرأ الباقون: “قال” على الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
﴿قُل إني لا أملِكُ لكُم ضَرًّا ولا رَشَدًا﴾ أي لا أقدر على إيصال خير أو شر إليكم لأن النافع والضار على الحقيقة هو الله تعالى أي أن الله هو خالق الخير والشر فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
﴿قُلْ إنِّي لن يُجيرَني من اللهِ أحدٌ﴾ أي لا يدفع عذابه أحد إن عصيته، وذلك لأن بعض الجن قالوا له: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك ﴿ولنْ أجِدَ مِن دونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ أي لن أجد ملتجأ ألجأ إليه من دون الله.
أخرج ابن جرير[2] عن حضرمي أنه ذُكِرَ له أن جنيًّا من الجن من أشرافهم ذا تَبَع قال: إنما يريد محمد أن يجيرَه الله وأنا أجيرُه فأنزل الله: ﴿قُل إني لن يُجيرني من الله أحدًا﴾.
————-
2- جامع الطبري مجلد 14 [29/120].
﴿إلا بلاغًا مِنَ اللهِ ورِسالاتِهِ﴾ أي إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا إلا أن أبلغكم من الله ما أمرني بتبليغكم إياه، وإلا رسالاته التي أرسلني بها إليكم، وقيل: لن يجيرني من الله أحد إن لم أبلغ رسالاته ﴿ومن يَعْصِ اللهَ ورسولهُ﴾ أي بترك الإيمان ﴿فإنَّ لهُ نارَ جهنَّمَ خالدينَ فيها أبدًا﴾ أي مخلدين في نار جهنم بالعذاب الشديد الذي لا ينقطع أبدًا، وهذه الآية رد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ومَن تبعهما فإنهم كذبوا هذه الآية وقالوا إن نار جهنم تفنى وينتهي عذاب الكفار فيها والعياذ بالله.
﴿حتى إذا رَأوا﴾ يعني الكفار ﴿ما يوعدونَ﴾ من عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا ﴿فسَيَعْلَمونَ﴾ أي حينئذ عند نزول العذاب ﴿مَنْ﴾ هو ﴿أضعفُ ناصرًا﴾ أي أعوانًا ﴿وأقلُّ عَدَدًا﴾ أي سيعلم من هو أضعف ناصرًا وأقل عددًا، المؤمنون أم هم.
﴿قُلْ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك ﴿إنْ أدْري﴾ أي لا أدري ﴿أقريبٌ ما تُوعَدونَ﴾ أي أقريب ما يعدكم ربكم من العذاب وقيام الساعة ﴿أم يَجعلُ لهُ ربي أمَدًا﴾ أي غاية معلومة تطول مدتها، ومعنى الآية: لا يعلم وقتَ نزول العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله، فهو غيب لا أعلم منه إلا ما علمنيه الله.
﴿عالمُ الغيبِ﴾ أي عالم ما غاب عن العباد ﴿فلا يُظْهِرُ﴾ أي فلا يطلع ﴿على غَيبِهِ أحدًا﴾ أي من خلقه.
﴿إلا مَن ارْتَضى مِن رسولٍ﴾ أي لكن من أرسله الله، فإلا هنا بمعنى لكن ﴿فإنَّهُ يسلُكُ﴾ أي يجعل ﴿مِن بينِ يديهِ﴾ أي يدي ذلك الرسول والمراد من أمامه ﴿ومِن خلفِهِ﴾ ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها ﴿رَصَدًا﴾ أي حفظة وهم الملائكة يحفظونه ويحرسونه من الجن.
وليست “إلا” هنا استثنائية بل هي بمعنى “لكن” نص على ذلك الزركشي وغيره.
﴿ليعلَمَ﴾ أي ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم ﴿أن قدْ أبلغوا رسالاتِ ربهم﴾ أي بلَّغ َالرسلُ قبله كما بلَّغ هو الرسالة، وقيل: ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالات ربهم.
﴿وأحاطَ﴾ أي علمُ الله عزَّ وجلَّ ﴿بما لديهم﴾ أي بما عند الرسل وما عند الملائكة ﴿وأحصى كُلَّ شيءٍ عددًا﴾ أي أحاط علمًا بعدد كل شيء فلم يخف عليه شيء منها من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحر وغيرها فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه.
سورة المزمل
سورة المزمل
مكية بإجماعهم، وهي عشرون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمْ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً (7) وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً (9) وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً (10) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً (11) إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً (12) وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيباً مَهِيلاً (14) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً (17) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (18) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (19) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20)
﴿يا أيُّها الْمُزَّمِّلُ﴾ أي المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه أي تلفف بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائمًا بالليل متزملاً في ثيابه فأُمر بالقيام للصلاة.
﴿قُمِ الليلَ﴾ أي قم للصلاة، وحَدُّ الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ﴿إلا قليلاً﴾ أي صلّ الليل كله إلا يسيرًا منه فاستثنى منه القليل لراحة الجسد.
وقد كان قيام الليل فرضًا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ثم نُسخ ذلك فصار تطوعًا كما جاء في صحيح مسلم[1] عن زُرارة: أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله..” الحديث، وفيه أنه قال لأم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها: “أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست تقرأ ﴿يا أيها المزمل﴾ قلت: بلى، قالت: فإن الله عزَّ وجلَّ افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء حتى أنزل الله في ءاخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة”.
وأخرج الحاكم[2] في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت: ﴿يا أيها المزمل* قمِ الليل إلا قليلاً﴾ قاموا سنة حتى ورمت أقدامهم فأنزلت: ﴿فاقرءوا ما تيسَّر منهُ﴾، وأخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس وغيره.
————-
1- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض.
2- أخرجه الحاكم في المستدرك [2/504].
﴿نِصفَهُ أو انقص منه قليلاً﴾ أي قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلث.
﴿أو زِدْ عليه﴾ أي زد على النصف إلى الثلثين، وهذا تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم بين أن يقوم النصف بتمامه وبين الناقص منه وبين قيام الزائد عليه.
﴿ورتِّلِ القرءانَ ترتيلاً﴾ أي لا تعجل بقراءة القرءان بل اقرأه في مَهَلٍ وبيان أي بيّنه تبيينًا مع تدبر المعاني، وروى الترمذي[3] عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يقال لصاحب القرءان اقرأ وارتقِ ورتِّل كما كنت ترتِّلُ في الدنيا فإن منزلتك عند ءاخر ءاية تقرأُ بها”.
————-
3- أخرجه الترمذي في سننه: كتاب فضائل القرءان: باب 18.
﴿إنَّا سنلقي﴾ أي سننزل ﴿عليكَ قولاً﴾ أي القرءان ﴿ثقيلاً﴾ أي بما اشتمل عليه من التكاليف الشاقة كالجهاد ومداومة الأعمال الصالحة وإقامة حدود الشرع واجتناب نواهيه، وقيل: إنه كان يَثقُلُ عليه إذا أوحي إليه وهذا قول عائشة قالت: “ولقد رأيته يَنزلُ عليه في اليوم الشديد البرد فيفصِم عنه وإن جبينَه ليتفصَّد عرقًا، رواه البخاري، وقيل: يَثقُلُ في الميزان يوم القيامة.
﴿إنَّ ناشئةَ الليلِ﴾ أي أوقاته وساعاته لأن أوقاته تنشأ أوَّلا فأوَّلا، واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل فقيل: ما بين المغرب والعشاء، وقيل: الليل كله، وقيل: القيام بالليل بعد النوم ومن قام أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة الليل.
﴿هيَ أشدُّ وَطئًا﴾ أي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار لأن الليل جعل للنوم والراحة فكان قيامه على النفس أشدَّ وأثقلَ.
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: “وِطَاءً” بكسر الواو وفتح الطاء والمد، وقرأ ابن محيصن: “وَطَاءً” بفتح الواو والطاء وبالمد.
﴿وأقومُ قيلاً﴾ أي القراءة بالليل أقومُ منها بالنهار أي أشد استقامة واستمرارًا على الصواب لهدوء الأصوات وانقطاع الحركات فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه.
﴿إنَّ لكَ في النهار سَبْحًا طويلاً﴾ أي فراغًا طويلاً لنومك وراحتك وحوائجك.
﴿واذكر اسم ربك﴾ أي دُم يا محمد على ذكر ربك ليلاً ونهارًا، وذكر الله يتناول كل ما يذكر به من تسبيح وتهليل وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرءان.
﴿وتبتَّل إليه تبتيلاً﴾ أي انقطع بعبادتك إليه فإن التبتل هو الانقطاع إلى عبادة الله عزَّ وجلَّ، وقال مجاهد: “وتبتل: أَخلِص” رواه البخاري في صحيحه[4].
————-
4- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: سورة المزمل.
﴿ربُّ المشرق والمغرب﴾ أي خالق المشرق والمغرب وما بينهما من العالم ﴿لا إلهَ إلا هو﴾ أي لا يستحق أحد أن يُعبد إلا الله عزَّ وجلَّ ﴿فاتَّخِذهُ وكيلاً﴾ أي فوّض جميع أمورك إليه فإنه يكفيكها وتوكل عليه.
وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم: “ربُّ” بالرفع، وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم بالكسر.
﴿واصبر﴾ أي يا محمد ﴿على ما يقولونَ﴾ أي على ما يقوله المشركون من قومك لك وعلى أذاهم ﴿واهجرهم هجرًا جميلاً﴾ أي جانبهم واعتزلهم ولا تتعرض لهم، وكان هذا قبل الأمر بالقتال ثم أُمر بقتالهم فنسخت ءايةُ السيف (ءاية القتال) ما كان قبلها من الترك.
﴿وذرني والمكذبين﴾ أي لا تهتم بهم وكِلْهُمْ إليَّ فأنا أكفيكهم ﴿أولي النعمة﴾ يعني أهل التنعم والأموال والترفه في الدنيا ﴿ومهلهم قليلاً﴾ قالت عائشة: فلم يكن إلا اليسيرُ حتى كانت وقعة بدر.
قال ابن الجوزي: “زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف وليس بصحيح لأن قوله ﴿وذرني﴾ وعيد، وأَمَرَهُ بإمهالهم ليس على الإطلاق بل أمره بإمهالهم إلى حين يؤمر بقتالهم فذهب زمان الإمهال فأين وجه النسخ” اهـ.
﴿إنَّ لدينا﴾ أي عندنا للكافرين في الآخرة ﴿أنكالاً﴾ أي قيودًا عظامًا ثقالا لا تنفك، وقيل أغلالا من حديد ﴿وجحيمًا﴾ أي نارًا شديدة الإيقاد.
﴿وطعامًا ذا غُصَّةٍ﴾ أي غير سائغ يأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خارج وهو الغسلين والزَّقوم والضريع، وقيل: شوك يَدخُل الحلق فلا ينزل ولا يخرج ﴿وعذابًا أليمًا﴾ أي موجعًا مؤلما. وفي هذه الآية دليل وردٌّ على من يقول إن عذاب الكفار معنويٌّ وليس حسيًّا.
﴿يومَ ترجف الأرض والجبال﴾ أي تتحرك وتضطرب بمن عليها وذلك يومَ القيامة ﴿وكانت الجبال﴾ أي وتكون الجبال بعد أن كانت صلبة ﴿كثيبًا﴾ أي رملاً مجتمعًا ﴿مهيلاً﴾ أي رخوًا لينًا بحيث إذا أخذت منه شيئًا تبعك ما بعده وانهال.
ولما هدد الله المكذبين بأهوال القيامة ذكَّرهم بحال فرعون وكيف أخذه الله تعالى إذ كذَّب موسى عليه السلام وأنه إن دام تكذيبهم أهلكهم الله تعالى فقال:
﴿إنَّا أرسلنا إليكم﴾ الخطاب عام للأسود والأحمر، وقيل لأهل مكة ﴿رسولاً﴾ وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿شاهدًا عليكم﴾ بالتبليغ وإيمان من ءامن وكفر من كفر ﴿كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً﴾ وهو سيدنا موسى عليه السلام.
﴿فعصى﴾ أي كذب ﴿فرعون الرسول﴾ أي الذي أرسل إليه ولم يؤمن به ﴿فأخذناه﴾ أي أخذنا فرعون ﴿أخذًا وبيلاً﴾ أي ثقيلاً شديدًا أي أهلكناه ومن معه جميعًا وعاقبناه عقوبة غليظة، وهذا تخويف لكفار مكة أن ينزل بهم العذاب لتكذيبهم كما نزل بفرعون.
﴿فكيف تتقون إن كفرتم﴾ بالله أن بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا برسوله وأنكرتم يوم القيامة، قال قتادة: والله ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء، وقيل بأي شيء تتحصنون من عذابِ يوم من هوله يشيب الصغير من غير كِبَرٍ ﴿يومًا﴾ أي عذاب يوم ﴿يجعلُ الوِلدانَ شيبًا﴾ أي يصير الولدان شيوخًا وهو كناية عن شدة هول ذلك اليوم، ويقال في اليوم الشديد “يوم يشيب نواصي الأطفال”، وقال قوم: ذلك حقيقة تشيب رءوسهم من شدة الهول، وقيل: هذا وقت الفزع قبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق.
﴿السماءُ مُنفَطِرٌ به﴾ أي السماء على عِظَمِهَا وإحكامها تنفطر أي تنشق في ذلك اليوم لشدته وهَوْله ﴿كانَ وعدهُ﴾ أي وكان وعد الله بمجيء يوم القيامة وحصول الحساب والجزاء ﴿مفعُولاً﴾ أي واقعًا وكائنًا لا محالة لأن خبر الله صدق لا يطرأ عليه الكذب.
﴿إنَّ هذهِ﴾ أي الآيات القرءانية ﴿تذكرةٌ﴾ أي تذكير وعبرة وعظة لمن اعتبر بها واتعظ ﴿فمن شاءَ اتَّخَذَ إلى ربِّهِ سبيلاً﴾ أي من أراد اتخذ إلى ربه سبيلاً بالإيمان به والعمل بطاعته، قال أبو حيان رحمه الله تعالى[5]: “وليست المشيئة هنا على معنى الإباحة بل تتضمن معنى الوعد والوعيد” اهـ، وهذا فيه رد على بعض العصريين الذين ينادون بحرية المعتقد ويزعمون أن للإنسان حقًّا أن يؤمن أو أن يكفر وهذا جهل والعياذ بالله وضلال مبين.
قال ابن الجوزي: “زعم بعض من لا فهم له أنها نُسخت بقوله ﴿وما تشاءُونَ إلا أن يشاءَ اللهُ﴾ ﴿سورة الدهر] وليس هذا بكلام من يدري ما يقول لأن الآية الأولى أثبتت للإنسان مشيئة، والآية الثانية أثبتت أنه لا يشاء إلا أن يشاء الله وكيف يتصور النسخ” اهـ.
————-
5- البحر المحيط [8/366].
﴿إنَّ ربَّكَ يعلمُ أنَّكَ﴾ أي يا محمد ﴿تقومُ﴾ أي تصلي، ولما كان أكثر أحوال الصلاة القيامَ عبَّر به عنها. وهذه الآية هي ناسخة لفرضية قيام الليل ﴿أدْنى﴾ أي أقل ﴿من ثُلُثَي الليل﴾ أي زمانًا أقل من الثلثين ﴿ونصفهُ وثُلثهُ﴾ أي وتقوم نصفه وثلثه ﴿وطائفةٌ مِنَ الذينَ معكَ﴾ أي ويقوم بذلك المقدار جماعة من أصحابك المؤمنين بالله حين فرض عليهم قيام الليل ﴿واللهُ يُقَدِّرُ الليلَ والنهارَ﴾ أي أن العالِم بمقادير الليل والنهار وأجزائهما وساعاتهما هو الله تعالى لا يفوته علم ما يفعلون فيعلم القدر الذي يقومون من الليل والذي ينامون منه.
ثم إنهم قاموا حتى انتفخت أقدامهم فنزل ﴿عَلِمَ أن لن تُحْصُوهُ فتابَ عليكم﴾ أي علم ربكم بعلمه الأزلي أن لن تطيقوا قيام الليل لكثرته وشدته فخفف عنكم فضلاً منه ﴿فاقرءوا﴾ أي في الصلاة ﴿ما تيَسَّرَ﴾ عليكم ﴿مِنَ القرءان﴾.
﴿عَلِمَ أن سيكونُ منكم مرضى﴾ أي سيكون منكم أهل مرض قد أضعفه المرض عن قيام الليل، وهذه حكمة ثانية لبيان النسخ، وأما الأولى فهي قوله عزَّ وجلَّ: ﴿علِمَ أن لن تُحصوهُ﴾.
﴿وءاخرونَ يضربونَ في الأرضِ﴾ وهم المسافرون للتجارة وطلب العلم وغير ذلك ﴿يبتَغونَ﴾ أي يطلبون ﴿مِن فضلِ اللهِ﴾ أي من رزقه في تجارة قد سافروا لطلب المعاش فأعجزهم وأضعفهم قيام الليل ﴿وءاخرونَ يُقاتِلونَ في سبيلِ اللهِ﴾ أي وءاخرون أيضًا منكم وهم الغزاة والمجاهدون الذين يجاهدون العدو فيقاتلونهم لنصرة دين الله، فالمجاهد والمسافر مشتغل في النهار بالأعمال الشاقة فلو لم ينم بالليل لتوالت عليه أسباب المشقة، فرحمكم الله فخفف عنكم ووضع عنكم فرض قيام الليل.
﴿فاقرءوا ما تيسَّرَ منهُ﴾ أي فاقرءوا الآن –إذ خفف ذلك عنكم- من الليل في صلاتكم ما تيسرَّ من القرءان، كرر ذلك وأعاده على سبيل التوكيد ﴿وأقيموا الصلاةَ﴾ المفروضة الواجبة عليكم في أوقاتها مع مراعاة أركانها وشروطها، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة ﴿وءاتوا الزكاةَ﴾ أي أعطوا الزكاة المفروضة في أموالكم أهلها ومستحقيها ﴿وأَقْرِضوا اللهَ قرضًا حسنًا﴾ أي وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم مع إخلاص النية وابتغاء الأجر من الله ﴿وما تُقدموا لأنفسكم من خير﴾ أي وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو قراءة أو طلب علم أو تعليم عقيدة أهل السنة أو غير ذلك من أعمال الخير ﴿تَجدوهُ عندَ اللهِ﴾ أي تجدوا ثوابه وأجره يوم القيامة في صحائف أعمالكم ﴿هوَ خيرًا﴾ أي مما خلَّفتم وتركتم وراءكم فإن ما يتركه الإنسان يصير مِلكًا للورثة ﴿وأعظٍمَ أجرًا﴾ أي ثوابه أعظم ﴿واستغفروا اللهَ﴾ أي سلوه المغفرة لذنوبكم ﴿إنَّ الله عفورٌ﴾ أي غفور لذنوب المؤمنين ﴿رحيمٌ﴾ أي رحيم بهم.
سورة المدثر
سورة المدثر
مكية، وهي ست وخمسون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً (12) وَبَنِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيداً (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31) كَلاَّ وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34) إِنَّهَا لإٍحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيراً لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنْ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) فَمَا لَهُمْ عَنْ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (52) كَلاَّ بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ (53) كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (55) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56)
أخرج الشيخان في صحيحيهما [1] عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “جاورتُ بحراء شهرًا، فلما قضيتُ جِوَاري نزلتُ فاستبطنتُ الوادي فَنُوديتُ فلم أر أحدًا فرفعتُ رأسي فإذا الملكُ الذي جاءني بحراء، فرجعتُ فقلت: دثروني، فأنزل الله: ﴿يا أيُّها الْمُدَّثِّرُ* قمْ فأنْذِر﴾.
————-
1- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: سورة المدثر، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
﴿يا أيها المدثر﴾ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم.
﴿قم فأنذر﴾ أي حَذّر قومك من عذاب الله إن لم يؤمنوا.
﴿وربَّكَ فكبِّر﴾ أي عَظّمه، وتعظيم الله تعالى يكون بتوحيده وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، ويؤخذ من هذه الآية أنه أول ما يجب على العبد معرفةُ الله عزَّ وجلَّ أي معرفةُ ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحيلُ عليه من النقائص، فإن من شبَّه الله بخلقه لم يعظمه.
﴿وثيابَكَ فطهِّرْ﴾ أي طهر ثيابك من النجاسات لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة، وقيل غير ذلك.
﴿والرُّجْزَ﴾ أي الأوثان والأصنام ﴿فاهجر﴾ أي اترك، ولا يلزم من ذلك تلبسه صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك.
وقرأ الحسن، وأبو جعفر، وشيبة، وعاصم إلا أبا بكر، ويعقوب، وابن محيصن: “والرُّجزَ” بضم الراء، والباقون بكسرها، قال الزجاج: ومعنى القراءتين واحد.
﴿ولا تَمْنُنْ تستكثِر﴾ أي لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها، قاله ابن عباس، وهذا النهي خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجلّ الأخلاق وأباحه لأمته، وقيل: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير، فإنه مما أنعم الله عليك، وقيل غير ذلك.
﴿ولربكَ فاصبر﴾ أي اصبر على تكاليف النبوة وعلى أداء طاعة الله وعلى أذى الكفار.
﴿فإذا نُقِرَ﴾ أي نفخ ﴿في الناقورِ﴾ أي الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل الملك الموكل بالنفخ.
﴿فذلكَ﴾ أي وقت النفخ في الصور ﴿يومئذٍ يومٌ عسيرٌ﴾ قال ابن عباس: شديد، رواه البخاري.
﴿على الكافرينَ غيرُ يسير﴾ أي غير سهل ولا هيّن.
﴿ذرني﴾ أي دعني وهي كلمة وعيد وتهديد ﴿ومَنْ خلقتُ وحيدًا﴾ المعنى: كِل إلى الله يا محمد أمر الذي خلقه الله وحده لا مال له ولا ولد ثم أعطاه بعد ذلك ما أعطاه وهو الوليد بن المغيرة وكان يسمى الوحيد في قومه، وإنما خُص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه السلام.
قال ابن الجوزي: “هذه نزلت في الوليد بن المغيرة والمعنى: خَلّ بيني وبينه فإني أتولى هلاكه، وقد زعم بعضهم أنها نُسخت بآية السيف وهذا باطل من وجهين:
أحدهما: أنه إذا ثبت أنه وعيد فلا وجه للنسخ.
والثاني: أن هذه السورة مكية وءاية السيف مدنية، والوليد هلك بمكة قبل نزول ءاية السيف” اهـ.
وأخرج الحاكم[2] وصححه عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرءان فكأنه رقَّ له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عمّ، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه فإنك أتيت محمدًا لتتعرَّض لنا قبله، قال: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا، قال: فقل فيه قولا يبلغ قومَك أنك مُنكرٌ له وأنك كارِهٌ له، فقال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا بَرجَزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجنّ، والله ما يُشبه الذي يقول شيئًا من هذا، ووالله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه مشرق أسفله وإنه ليعلو وما يُعلى، وإنه ليحطم ما تحته، قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزلت: ﴿وذرني ومن خلقت وحيدًا﴾، قال الحافظ السيوطي: “إسناده صحيح على شرط البخاري”، وأخرج ابن جرير من طرق أخرى نحوه.
————-
2- المستدرك [2/506-507].
﴿وجعلتُ لهُ مالاً ممدودًا﴾ كثيرًا واسعًا متصلاً من الزروع والضروع والتجارة، وأعطيته مالا ممدودًا وهو كان له ما بين مكة والطائف من البساتين والعبيد والجواري والإبل والحُجُور وهي الأنثى من الخيل.
﴿وبنينَ﴾ وكانوا عشرة أو أكثر منهم ثلاثة ﴿شُهُودًا﴾ أي حضورًا معه بمكة يتمتع بلقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش ولا يحتاج أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه.
﴿ومهَّدتُ لهُ تمهيدًا﴾ أي بسطتُ له في العيش بسطًا، قال ابن عباس: وسعتُ له ما بين اليمن والشام.
﴿ثمَّ يطمعُ أن أزيدَ﴾ أي أن الوليد بن المغيرة يطمع أن أزيده من المال والولد على ما أعطيته.
﴿كلا﴾ أي ليس يكون كذلك مع كفره بالنعم ﴿إنَّهُ﴾ يعني الوليد ﴿كانَ لآياتِنا عنيدًا﴾ أي معاندًا للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به.
﴿سأُرهِقُهُ صَعودًا﴾ أي سَأُكلفه مشقةً من العذاب لا راحة له منها.
﴿إنهُ﴾ يعني الوليد ﴿فكَّرَ﴾ في ما تخيل طعنًا في القرءان ﴿وقدَّرَ﴾ في نفسه ما يقول في محمد والقرءان.
﴿فَقُتِلَ﴾ أي لُعن الوليد بن المغيرة ﴿كيفَ قدَّرَ﴾ ما لا يصح تقديره وما لا يسوغ أن يقدره عاقل.
﴿ثمَّ قُتِلَ كيفَ قدَّرَ﴾ كرر الدعاء عليه للمبالغة وتقبيح ما فكر به.
﴿ثمَّ نظرَ﴾ أي فكر ثانيًا بأي شيء يدفع القرءان ويرده.
﴿ثمَّ عبسَ﴾ أي قطب بين عينيه في وجوه المؤمنين ﴿وبَسرَ﴾ أي كلح وجهه وتغير لونه.
﴿ثم أدبر﴾ عن الإيمان ﴿واستكبرَ﴾ أي تكبر عن قبول الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
﴿فقالَ إنْ هذا﴾ أي قال ما هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ﴿إلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ أي يأثره عن غيره، أي زعم أن هذا سحر يرويه محمد وينقله عن غيره من السحرة قبله، والسحر: الخديعة.
﴿إنْ هذا إلا قولُ البشر﴾ وزعم هذا المعاند أن هذا القرءان ما هو إلا كلام البشر ليس بكلام الله عزَّ وجلَّ.
﴿سأُصليهِ﴾ أي سأدخله ﴿سقرَ﴾ أي جهنم، وسقر اسم من أسماء جهنم.
﴿وما أدراكَ ما سقرُ﴾ هذه مبالغة في وصفها، أي وما أعلمك أي شيء هي؟ وهي كلمة تعظيم لهولها وشدتها.
ثم فسَّر حالها فقال: ﴿لا تُبقي﴾ أي لا تبقي على من ألقي فيها ﴿ولا تذرُ﴾ غاية من العذاب إلا أوصلته إليه. فالكافر لا ينقطع عنه العذاب في النار وهي مع شدتها لا يموت فيها فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة بل عذابه أبدي سرمدي، هذا ما عليه أهل الحق قاطبة بخلاف ما زعمه ابن تيمية وجماعته من أن الكفار ينقطع عنهم العذاب وتفنى النار فإن هذا تكذيب للقرءان.
﴿لوَّاحةٌ للبشر﴾ أي مغيرة للبشرات محرقة للجلود مسودة لها، وقيل: إنهم الإنس من أهل النار.
﴿عليها﴾ أي على سقر ﴿تسعةَ عشر﴾ ملكًا من خزنة النار، مالك ومعه ثمانية عشر.
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في كتاب البعث والنشور عن البراء رضي الله عنه أن رهطًا من اليهود سألوا رجلاً من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه ساعتئذ: ﴿عليها تسعةَ عشر﴾.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: لما نزلت: ﴿عليها تسعةَ عشر﴾ قال رجل من قريش يدعى أبا الأشد: يا معشر قريش، لا يهولنكم التسعة عشر أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي الأيسر التسعة، فأنزل الله: ﴿وما جعلنا أصحابَ النار إلا ملائكة﴾ الآية.
﴿وما جعلنا أصحاب النار﴾ أي خزنتها ﴿إلا ملائكة﴾ أقوياء أشداء ﴿وما جعلنا عِدَّتهم﴾ أي عددهم وهم تسعة عشر ﴿إلا فتنةً للذينَ كفروا﴾ أي سببًا لفتنة الكفار، وفتنتهم هي كونهم أظهروا مقاومتهم في مغالبة الملائكة وذلك على سبيل الاستهزاء، فقد قال أبو جهل: يا معشر قريش ما يستطيع كل عشرة منكم أن يغلبوا واحدًا من خزنة النار؟ ﴿لِيَستيقن﴾ أي ليوقن ﴿الذينَ أوتوا الكتابَ﴾ وهم اليهود والنصارى أن هذا القرءان هو من عند الله إذ هم يجدون هذه العدة في كتبهم المنزلة ويعلمون أن الرسول لم يقرأها ولا قرأها عليه أحد ولكن كتابه يُصدّق كتب الأنبياء إذ كل ذلك حق يتعاضد من عند الله.
﴿ويزداد الذينَ ءامنوا إيمانًا﴾ يعني من ءامن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يزدادون تصديقًا بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن العدد كان موجودًا في كتابهم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما عندهم من غير سابقة دراسة وتعلم علم إنما حصل له ذلك بالوحي فازدادوا بذلك إيمانًا وتصديقًا بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ولا يرتابَ﴾ أي ولا يشك، وهذا توكيد لقوله ﴿ليستيقن﴾ إذ إثبات اليقين ونفي الارتياب أبلغ وءاكد في الوصف لسكون النفس السكون التام ﴿الذينَ أوتوا الكتاب﴾ أي أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى ﴿والمؤمنون﴾ بالله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر ﴿وليقولَ الذين في قلوبهم مرضٌ﴾ أي شك أو نفاق ﴿والكافرون﴾ بالله من مشركي قريش وغيرهم ﴿ماذا أرادَ الله بهذا مثلاً﴾ يعني بعدد خزنة جهنم وما الحكمة في ذكر هذا العدد؟ ﴿كذلكَ﴾ أي كما أضل الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لعدد خزنة جهنم ﴿يُضلُّ الله من يشاءُ﴾ أي يخلق الله الضلالة في قلوب من شاء أن يضلهم ﴿ويهدي من يشاء﴾ أي يخلق الله الاهتداء في قلوب من شاء أن يهديهم ﴿وما يعلم﴾ أي وما يدري ﴿جنود ربك﴾ أي عددهم وهم الملائكة ﴿إلا هو﴾ يعني الله عزَّ وجلَّ. ,
روى مسلم في صحيحه[3] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة: “يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون إليه”.
﴿وما هيَ﴾ أي النار ﴿إلا ذكرى للبشر﴾ أي إلا تذكرة وموعظة للناس ذكَّر بها البشر ليخافوا ويطيعوا.
————-
3- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات.
﴿كلا﴾ أي ليس القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه المشركين خزنة جهنم ﴿والقمر﴾ أقسم الله بالقمر ﴿والليل إذْ أدبرَ﴾ أي ولَّى ﴿والصبح إذا أسفر﴾ أي أضاء وتبين.
وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم: “إذا دبر”.
﴿إنَّها﴾ أي النار ﴿لإحدى الكبر﴾ أي لإحدى الأمور العظام التي لا نظير لها.
﴿نذيرًا للبشر﴾ قال الزجاج: نصب “نذيرًا” على الحال، والمعنى إنها لكبيرة في حال الإنذار، قال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيء هو أدهى منها.
﴿لِمن شاء منكم أن يتقدَّمَ أو يتأخَّرَ﴾ هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم جوزي بثواب لا ينقطع، ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمدًا صلى الله عليه سلم عوقب عقابًا لا ينقطع.
﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ أي مرتهنة بكسبها.
﴿إلا أصحاب اليمين﴾ وهم أهل الجنة فإنهم لا يرتهنون، وقيل أصحاب اليمين الملائكة، وقيل أطفال المسلمين، وقيل المسلمون المخلصون ليسوا بمرتهنين لأنهم أدوا ما كان عليهم، وقيل غير ذلك.
﴿في جنات﴾ أي هم في جنات ونعيم ﴿يتساءلون﴾ أي يسألون الكفار الذين هم في النار.
﴿عنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي الكافرين.
﴿ما سلككم﴾ أي أدخلكم والمعنى أي شيء أدخلكم ﴿في سقر﴾ أي جهنم، وسؤالهم سؤال توبيخ لهم وتحقير وإلا فهم عالمون ما الذي أدخلهم النار، والجواب:
﴿قالوا﴾ أي قال المجرمون وهم الكافرون لهم ﴿لم نكُ مِنَ المصلين﴾ أي المؤمنين الذين يصلون.
﴿ولم نكُ نُطعم المسكين﴾ أي لم نتصدق عليه.
﴿وَكُنَّا نَخُوضُ﴾ في الباطل ﴿مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ فيه.
﴿وكُنَّا نُكذب بيوم الدين﴾ أي بيوم القيامة والحساب والثواب والعقاب.
﴿حتى أتانا اليقين﴾ أي الموت.
﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾ أي لا شفاعة لهم لأن الشفاعة إنما تكون لمن ءامن بالله ورسوله، وليس المعنى أن المكذبين بيوم الدين يُشفع لهم فلا تنفع شفاعة من يشفع لهم وإنما المعنى نفي الشفاعة للكفار.
﴿فما لهم عن التذكرة مُعرضينَ﴾ أي فما لهؤلاء المشركين عن مواعظ القرءان معرضين لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا.
ثم شبههم بالحمر المستنفرة في شدة إعراضهم ونفارهم عن الإيمان وءايات الله تعالى فقال عزَّ وجلَّ:
﴿كأنَّهم﴾ أي كأن هؤلاء الكفارَ في فرارهم من محمد صلى الله عليه وسلم ﴿حمر﴾ وهي الحمر الوحشية، جمع حمار ﴿مستنفرة﴾ أي نافرة.
وقرأ أبو جعفر، ونافع، وابن عامر بفتح الفاء، والباقون بكسرها، قال أبو عبيدة: من قرأ بفتح الفاء أراد “مذعورة”، ومن قرأ بكسر الفاء أراد “نافرة”.
﴿فرَّت﴾ أي نفرت وهربت ﴿من قَسْوَرة﴾ أي من رماة يرمونها، أو من الأسد، وذلك لأن الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت فكذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرءان هربوا منه.
﴿بل يريد كل امرئ منهم﴾ أي من المعرضين عن عظات الله وءاياته ﴿أن يُؤتى صُحُفًا﴾ أي أرادوا أن ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من الله عزَّ وجلَّ إلى فلان ابن فلان، وقيل: كانوا يقولون إن كان محمد صادقًا فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأَمنه من النار ﴿منتشرة﴾ أي منشورة غير مطوية تقرأ كالكتب التي يتكاتب بها أو كتبت في السماء نزلت بها الملائكة ساعة كتبت رطبة لم تطو بعد وهذا من زيادة تعنتهم.
أخرج ابن المنذر عن السدّي قال: قالوا: لئن كان محمد صادقًا فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءة وأمنة من النار، فنزلت: ﴿بل يريدُ كلُّ امرئٍ منهم أن يُؤتى صُحُفًا منتشرةً﴾.
﴿كلا﴾ أي ليس يكون ذلك، وهذا ردع عما أرادوه من اقتراح الآيات وليس الأمر كما يزعمون من أنهم لو أوتوا صحفًا منشرة صَدَّقوا ﴿بل لا يخافونَ الآخرةَ﴾ أي لا يخافون عقاب الله ولا يصدقون بالبعث والثواب والعقاب فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن التذكرة وهوَّنَ عليهم ترك الاستماع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
﴿كلا﴾ ردع عن إعراضهم عن التذكرة أي ليس الأمر كما يقول هؤلاء المشركون في هذا القرءان من أنه سحر يؤثر وأنه قول البشر ولكن ﴿إنهُ﴾ أي القرءان ﴿تذكرة﴾ أي موعظة من الله لخلقه ذكَّرهم به.
﴿فمن شاء ذكره﴾ أي من شاء من عباد الله الذين ذَكَّرَهُم الله بهذا القرءان ذكره أي اتعظ به فإنما يعود نفع ذلك عليه.
﴿وما يذكرون﴾ أي وما يتعظون ﴿إلا أن يشاء الله﴾ أي ليس يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم، وهذا تصريح بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ﴿هو أهل التقوى﴾ أي أهل أن يُتقى بأداء ما فرض واجتناب ما نهى عنه ﴿وأهل المغفرة﴾ أي أهل أن يغفر لمن تاب.
سورة القيامة
سورة القيامة
مكية، وهي أربعون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلاَّ لا وَزَرَ (11) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّؤُاْ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15) لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (25) كَلاَّ إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِي (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35) أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)
﴿لا أقسم بيوم القيامة﴾ أي أقسم بيوم القيامة وهو اليوم الذي فيه البعث والحشر وغير ذلك من أمور الآخرة، أقسم الله تعالى بيوم القيامة تعظيمًا لشأنه.
وقرأ ابن كثير: “لأُقسِمُ” بغير ألف بعد اللام.
﴿ولا أقسم بالنفس اللوامة﴾ أي أقسم بالنفس اللوامة، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها في ترك الطاعة ونحوها فهي على هذا ممدوحة ولذلك أقسم الله بها، وقال بعضهم: هي التي تلوم نفسها على ما فات وتندم على الشر لِمَ فعلته وعلى الخير لِمَ لَمْ تستكثر منه.
﴿أيحسبُ﴾ أي أيظن ﴿الإنسان﴾ أي الكافر المكذب والمنكر للبعث، وقال ابن عباس: يريد أبا جهل ﴿ألَّن نجمع عظامه﴾ أي بعد تفرقها ورجوعها رميمًا ورفاتًا مختلطة بالتراب وبعد ما نسفتها الريح فطيرتها في أباعد الأرض.
﴿بلى﴾ أي بلى نقدر على جمعها، وذَكَرَ العظام وإن كان المعنى إعادةَ الإنسان وجمعَ أجزائه المتفرقة لأن العظام هي قالب الخَلْق لا يستوي إلا باستوائها ﴿قادرين﴾ على جمعها وعلى أعظم من ذلك ﴿على أن نسوِّيَ بنانه﴾ وهي أصابع يديه ورجليه فنجعلها شيئًا واحدًا كخفّ البعير أو حافر الحمار فكان لا يأخذ ما يأكله إلا بفيه –أي فمه- كسائر البهائم ولكنه فرق أصابع يديه يأخذ بها ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط، وقيل في الآية إشارة إلى اختلاف بصمات أصابع الناس مع تشابه الأصابع.
﴿بل يريد الإنسان ليفجر أمامه﴾ أي أن الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ويدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان لا يثنيه عنها شيء ولا يتوب منها أبدًا، ويسوّف التوبة قال ابن عباس: “سوف أتوب سوف أعمل”، رواه البخاري. والأمام ظرف مكان استعير هنا للزمان، وقيل: يكذب الكافر بما أمامه من البعث والحساب.
﴿يَسئل أيَّان يوم القيامة﴾ أي متى يوم القيامة، وسؤاله هذا استهزاء وتكذيب وتعنت.
﴿فإذا برق البصر﴾ أي شَخص بصر الكافر يوم القيامة فلا يَطرِْفُ لما يرى من العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا.
وقرأ أهل المدينة: “بَرَقَ” بفتح الراء، والباقون بكسرها.
﴿وخسف القمر﴾ أي أظلم وذهب ضوؤه.
﴿وجمع الشمس والقمر﴾ أي يجمع بينهما في ذهاب الضوء، وقيل: يجمع بينهما في الطلوع من المغرب فيطلعان أسودين مكوَّرين وقيل يجمعان فيلقيان في النار.
﴿يقول الإنسان﴾ أي الكافر المكذب بالآخرة ﴿يومئذ﴾ أي يوم القيامة لما يعاين أهوالها ويريد أن يفر ﴿أين المفر﴾ أي أين الفرار.
﴿كلا﴾ ردع عن طلب الفرار ﴿لا وزر﴾ أي لا شيء يلجأ إليه من جبل أو حصن أو رجل أو غيره.
﴿إلى ربك﴾ أي إلى حكمه ومشيئته ﴿يومئذ المستقر﴾ أي مستقرهم أي موضع قرارهم من جنة أو نار.
﴿ينبَّؤا﴾ أي يُخبَر ﴿الإنسان﴾ أي ابن ءادم برًّا كان أو فاجرًا ﴿يومئذ بما قدّم وأخر﴾ أي بما أسلف من عمل سيء أو صالح، أو أخَّرَ من سنَّة سيئة أو صالحة يُعْمَل بها بعده.
﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ أي شاهد، وهو شهود جوارحه عليه: يداه بما بطش بهما ورجلاه بما مشى عليهما وعيناه بما أبصر بهما، وقيل في تفسير الآية غير ذلك.
﴿ولو ألقى﴾ الإلقاء هنا بمعنى القول ﴿معاذيره﴾ أي أعذاره، والمعنى: لو اعتذر بالقول وجاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه بأنه هو الشاهد عليها والحجة البينة عليها.
﴿لا تحرك﴾ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا تحرك يا محمد ﴿به لسانك﴾ أي بالقرءان ﴿لتعجل به﴾ أي بالقرءان، أخرج البخاري[1] عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حَرَّك به لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله ﴿لا تحرك به لسانكَ لتعجلَ بهِ﴾.
————-
1- رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب فإذا قرأناه فاتبع قرءانه.
﴿إنَّ علينا جمعهُ﴾ في صدرك، ﴿وقُرءانه﴾ أي ثم تقرؤه، والمعنى حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك.
﴿فإذا قرأناهُ﴾ أي فإذا قرأه الملَك المبلِّغ عنا ﴿فاتَّبع قُرءانه﴾ أي فاستمع قراءته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأ، قال ابن عباس: “قرأناهُ: بَيَّنَّاهُ، فاتَّبع: اعمل به” رواه البخاري.
﴿ثم إن علينا بيانهُ﴾ أي بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “علينا أن نُبَيّنه بلسانك”.
وبعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى حال الإنسان السابق ذكره المنكر البعث وأن همّه إنما هو في تحصيل حطام الدنيا الفاني لا في تحصيل ثواب الآخرة إذ هو منكر لذلك، فقال تعالى:
﴿كلا﴾ أي هذا رد عليهم وعلى أقوالهم أي ليس كما زعمتم ﴿بل تُحبُّون العاجلة﴾ أي أنتم قوم غلبت عليكم محبة شهوات الدنيا.
﴿ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ﴾ أي تدَعون وتتركون الآخرة والعمل بها.
وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو وابن عامر: “بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة” بالياء فيهما.
﴿وجوهٌ﴾ هي وجوه المؤمنين بالله ورسوله ﴿يومئذ﴾ أي يوم القيامة ﴿ناضرةٌ﴾ أي حسنة بهية مسرورة.
﴿إلى ربها ناظرة﴾ أي يرون الله تعالى في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا ثبوت مسافة.
ورؤية الله عزَّ وجلَّ في الآخرة للمؤمنين حق لا شك فيها، والأحاديث فيها صحاح.
﴿ووجوهٌ﴾ هي وجوه الكفار ﴿يومئذ﴾ أي يوم القيامة ﴿باسرةٌ﴾ أي كالحة كاسفة عابسة متغيرة الألوان مسودة.
﴿تظنُّ﴾ أي توقن، والظن هنا بمعنى اليقين ﴿أن يُفعل بها﴾ فِعلٌ هو في شدته ﴿فاقِرةٌ﴾ أي داهية تكسر فقار الظهر وتقصمه.
﴿كلا﴾ ردع وزجر عن إيثار الدنيا على الآخرة وتذكير لهم بما يؤولون إليه من الموت الذي تنقطع العاجلة عنده وينتقل منها إلى الآجلة التي يبقَون فيها مخلدين ﴿إذا بلغت﴾ أي نفس المحتضر المشرف على الموت ﴿التَّراقي﴾ جمع ترقوة وهي عظم يصل بين ثغرة النحر والعاتق، والعاتق موضع الرداء من المنكب.
﴿وقيل﴾ أي قال من حوله ﴿من راق﴾ أي من يرقيه فيشفيه برقيته، وقيل: هل من طبيب يشفيه، وقيل: قالت الملائكة بعضهم لبعض: من يرقى بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب.
﴿وظنَّ﴾ أي أيقن المحتضر ﴿أنه الفراق﴾ أي فراق الدنيا والأهل والمال والولد وذلك حين عاين الملائكة.
﴿والتفَّتِ الساق بالساق﴾ أي اتصلت الشدة بالشدة أي شدة الدنيا بشدة الآخرة وذلك شدة كرب الموت بشدة هول المطلع وإقبال الآخرة.
﴿إلى ربك يومئذ﴾ أي يوم القيامة ﴿المساقُ﴾ أي المرجع والمصير.
﴿فلا صدَّقَ﴾ أي لم يصدق بالقرءان ﴿ولا صلى﴾ أي لم يكن من المؤمنين فيصلي لله.
﴿ولكن كذب﴾ بالقرءان ﴿وتولى﴾ أي أعرض عن الإيمان.
﴿ثم ذهب إلى أهله﴾ أي إلى قومه ﴿يتمطَّى﴾ أي يتبختر في مشيته إعجابًا.
﴿أوْلى لك فأولى* ثم أولى لك فأولى﴾ تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد من الله تعالى للكافر، وتكراره هنا مبالغة في التهديد والوعيد.
﴿أيحسبُ﴾ أي أيظن ﴿الإنسانُ أن يُتركَ سُدى﴾ أي أن يُخلَّى مُهملاً لا يؤمر ولا يُنهى ولا يُكلَّف في الدنيا ولا يحاسب في الآخرة.
﴿ألم يكُ﴾ أي ألم يك هذا المنكر قدرة الله على إحيائه من بعد مماته وإيجاده بعد فنائه ﴿نُطْفَةً﴾ أي ماء قليلاً في صلب الرجل وترائب المرأة ﴿من مني يُمنى﴾ أي يصب في رحم المرأة.
وقرأ: “يُمنى” حفص ويعقوب بالياء، والباقون بالتاء.
﴿ثمَّ كان﴾ أي صار المني ﴿علقة﴾ أي قطعة دم جامدة ﴿فخلق﴾ أي خلق الله منه بشرًا مركبًا من أشياء مختلفة ﴿فسوَّى﴾ أي سواه شخصًا مستقلاً ناطقًا سميعًا بصيرًا.
﴿فجعل منه﴾ أي فخلق من الإنسان ﴿الزوجَينِ الذكر والأنثى﴾ أي الرجل والمرأة.
﴿أليس ذلك﴾ أي أليس الذي فعل ذلك فخلق هذا الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة حتى صيرَّه إنسانًا سويًّا له أولاد ذكور وإناث ﴿بقادرٍ على أن يُحييَ الموتى﴾ أي من مماتهم فيوجدهم كما كانوا قبل مماتهم، أي إن الله لا يعجزه إحياء ميت من بعد مماته.
وقد روى أبو داود في سننه[2] أن رجلاً كان يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ:
أليسَ ذلكَ بقادرٍ على أن يُحْيِيَ الموتى﴾ قال: سبحانك، فبلى، فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
————-
2- أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب الدعاء في الصلاة.
سورة الإنسان
سورة الإنسان
وتُسمى سورة الدهر، وهي مكية وقيل مدنية
وقيل فيها مكي ومدني، وهي إحدى وثلاثون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعَا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلًا وَأَغْلالًا وَسَعِيرًا (4) إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا (13) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (14) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَاْ (15) قَوَارِيرَاْ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا (19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (25) وَمِنْ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26) إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31)
﴿هل أتى﴾ أي قد أتى ﴿على الإنسانِ حينٌ من الدهر﴾ قيل: الإنسان هنا هو ءادم عليه السلام، وقيل: جميع الناس، والحين الذي مر عليه هي المدة التي بقي فيها إلى أن نُفخ فيه الروح، وقيل: الإنسان هنا هو ابن ءادم، والحين الذي مر عليه إما حين عدمه وإما حين كونه نطفة وانتقاله من رتبة إلى رتبة حتى حين إمكان خطابه وسُمّي إنسانًا باعتبار ما صار إليه ﴿لم يكُنْ شيئًا مذكورًا﴾ أي لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به وذلك قبل أن ينفخ فيه الروح.
﴿إنَّا خلقنا الإنسانَ﴾ أي بني ءادم ﴿مِن نُطفة﴾ أي من مني الرجل ومني المرأة ﴿أمْشاجٍ﴾ أي أخلاط وهو وصف للنطفة والمراد ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في الرحم فيكون منهما الولد ﴿نبتليهِ﴾ أي نختبره بالتكليف في الدنيا ﴿فجَعلناهُ سميعًا بصيرًا﴾ أي ذا سمع يسمع به وبصر يبصر به إنعامًا من الله على عباده بذلك.
﴿إنَّا هديناهُ السبيلَ﴾ أي بيَّنا له وعرَّفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر ﴿إمَّا شاكرًا﴾ أي مؤمنًا ﴿وإمَّا كَفُورًا﴾ أي كافرًا. ولما كان الشكر قلَّ من يتصف به قال “شاكرًا”، ولما كان الكفر كثُر من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر جاء كفورًا بصيغة المبالغة.
وأتبَعَ ذكرَ الفريقين الوعيدَ والوعدَ فقال عزَّ وجلَّ:
﴿إنا أعتدنا للكافرينَ﴾ أي هيأنا لمن أعرض عن الإيمان بالله أو برسوله ويدخل في ذلك من سب الله أو النبي أو القرءان ونحو ذلك مما فيه استهزاء بالله والرسول والشريعة ﴿سلاسِلًا﴾ جمع سلسلة، تكون في أعناقهم يسحبون بها في النار، ﴿وأغلالًا﴾ جمع غُل أي تشد بالأغلال فيها أيديهم إلى أعناقهم، ﴿وسعيرًا﴾ أي نارًا مسعرة يعذبون بها. وقرأ ابن كثير، وابن عامر، وحمزة: “سلاسل” بغير تنوين.
﴿إنَّ الأبرارَ﴾ أي المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم بأداء ما فرض واجتناب ما نهى عنه ﴿يشربون من كأس﴾ أي إناء فيه شراب ﴿كان مزاجها﴾ أي كان مزاج ما فيها من الشراب ﴿كافورًا﴾ يعني في طيب رائحتها كالكافور، وقيل: إن الكافور اسمُ عين ماء في الجنة يقال له عين الكافور أي يمازجه ماء هذه العين التي تسمى كافورًا.
﴿عينًا﴾ أي كان مزاج الكأس التي يشرب بها هؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين ﴿يشربُ بها﴾ أي يشربها، وقيل يشرب منها ﴿عبادُ الله﴾ المراد بعباد الله هنا المؤمنون لأن الكفار لا يتنعمون في الآخرة أبدًا ﴿يُفجرونها﴾ أي يُجرون تلك العين التي يشربون بها كيف شاءوا وحيث شاءوا من منازلهم وقصورهم ﴿تفجيرًا﴾ أي سهلًا لا يمتنع عليهم.
﴿يوفونَ بالنَّذر﴾ أي لا يُخلفون إذا نذروا، وقيل: كانوا في الدنيا يوفون بالنذر والنذر الإيجاب، والمعنى يوفون بما فرض الله عليهم فيدخل فيه جميع الطاعات من الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغير ذلك من الواجبات ﴿ويخافون﴾ أي يحذرون ﴿يومًا﴾ أي يوم القيامة ﴿كانَ شرُّهُ مُستطيرًا﴾ أي منتشرًا فاشيًا ممتدًّا والمعنى أنهم يوفون بالنذر وهم خائفون من شر ذلك اليوم وهوله وشدته.
﴿ويُطعمون الطعام على حُبِّهِ﴾ أي حب الطعام وقلته وشهوتهم له والحاجة إليه فهم مع ذلك يُغيثون الملهوف. وقد وصف الله الأبرار بأنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم بالطعام ويواسون به أهل الحاجة، وقيل “على حبه” أي ابتغاء مرضاته ﴿مسكينًا﴾ وهو الذي لا مال له يكفيه لسد حاجاته ﴿ويتيمًا﴾ وهو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ ولا شيء له ﴿وأسيرًا﴾ وهو المحبوس من الكفار. أخرج ابن المنذر عن ابن جرير في قوله: “وأسيرًا” قال: لم يكن النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأسِرُ أهل الإسلام ولكنها نزلت في أُسارى أهل الشرك كانوا يأسرونهم في العذاب، فنزلت فيهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاح إليهم. وقال ابن الجوزي: “فأما إطعامه ففيه ثواب بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام[1]: “في كل كَبِدٍ رطبةٍ أجرٌ” والآية محمولة على التطوع بالإطعام” اهـ.
————-
1- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم: باب الآبار على الطرق، وكتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم، والمساقاة: باب فضل سقي الماء، ومسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها.
﴿إنَّما نُطعمكم لوجهِ اللهِ﴾ أي ابتغاء مرضاته ﴿لا نُريدُ منكم جزاءً﴾ أي مكافأة ﴿ولا شُكورًا﴾ أي ولا أن تثنوا علينا بذلك، قيل إنهم لم يتكلموا به ولكن علم الله ذلك من قلوبهم بعلمه الأزلي فأثنى به عليهم، وقيل قالوا ذلك منعًا للمحتاجين من المكافأة، وقيل قالوا ذلك ليقتدي بهم غيرهم في ذلك وذلك لأن الإحسان إلى الغير تارة يكون لأجل الله تعالى لا يراد به غيره فهذا هو الإخلاص، وتارة يكون لطلب المكافأة أو لطلب الحمد من الناس أو لهما وهذان القسمان مردودان لا يقبلهما الله تعالى لأن فيهما رياء فنفَوا ذلك عنهم بقولهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورًا.
﴿إنَّا نخافُ من ربنا﴾ أي نطعمكم رجاء منا أن يؤمننا ربنا من عقوبته ﴿يومًا﴾ أي في يوم شديد هوله عظيم أمره ﴿عبوسًا﴾ أي تَعبِس فيه الوجوه من شدة مكارهه ﴿قمطريرًا﴾ أي شديدًا أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء.
﴿فَوَقاهم اللهُ﴾ أي دفع عنهم ﴿شرَّ ذلكَ اليوم﴾ أي بأسه وشدته وعذابه ﴿ولقَّاهم﴾ أي أعطاهم ﴿نضرةً﴾ أي حُسنًا في وجوههم ﴿وسرورًا﴾ أي فرحًا في قلوبهم.
﴿وجزاهم بما صبروا﴾ أي وأثابهم الله بما صبروا في الدنيا على طاعته والعمل بما يرضيه ﴿جنةً﴾ أي أُدخلوا الجنة ﴿وحريرًا﴾ أي أُلبسوا الحرير.
﴿مُتكئينَ﴾ أي جلوسًا متمكنين، وقيل الاتكاء الاضطجاع ﴿فيها﴾ أي في الجنة ﴿على الأرائكِ﴾ أي على السُّرُرِ في الحِجال وهي بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور ﴿لا يرون فيها﴾ أي لا يجدون وهم في الجنة ﴿شمسًا﴾ أي حر شمس ﴿ولا زمهريرًا﴾ أي ولا شدة برد
﴿ودانيةً عليهم ظلالها﴾ أي ظلال الأشجار في الجنة قريبة من المؤمنين الأبرار مُطلة عليهم زيادة في نعيمهم وإن كان لا شمس ولا قمر في الجنة ﴿وذُللت﴾ أي سخرت لهم ﴿قطوفها﴾ أي ثمارها ﴿تذليلًا﴾ أي تسخيرًا، فيتناولها القائم والقاعد والمضطجع لا يرد أيديهم شوك ولا بُعْدٌ، إن قام أحد ارتفعت له وإن جلس تدلّت عليه وإن اضطجع دنت منه فأكل منها.
﴿ويُطافُ عليهم﴾ أي يدور على هؤلاء الأبرار الخدمُ ﴿بآنيةٍ﴾ من الأواني التي يشربون فيها شرابهم وهي ﴿من فضةٍ وأكوابٍ﴾ أي الكيزان العظام التي لا ءاذان لها ولا عُرًى ﴿كانت قواريرَاْ* قواريرا من فضة﴾ أي في صفاء القوارير وبياض الفضة، فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من فضة ﴿قدَّروها﴾ أي الطائفون ﴿تقديرًا﴾ على قدر مراد الشاربين من غير زيادة ولا نقص.
﴿ويُسقون فيها﴾ أي الأبرار ﴿كأسًا﴾ أي خمرًا ولكنه ليس كخمر الدنيا ﴿كان مزاجها زنجبيلًا﴾ أي أن الكأس تمزج بالزنجبيل، وكانت العرب تستلذ من الشراب الذي يُمزج بالزنجبيل لطيب رائحته، فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب.
﴿عينًا فيها﴾ أي في الجنة ﴿تُسمّى سلسبيلًا﴾ أي سهلة المساغ في الحلق وليس كزنجبيل الدنيا.
﴿ويطوفُ عليهم﴾ أي يدور على المؤمنين الأبرار ﴿ولدانٌ﴾ أي غلمان يخلقهم الله تعالى لخدمة أهل الجنة ﴿مُخَلَّدونَ﴾ أي لا يموتون ﴿إذا رأيتهم﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الخطاب لكل مؤمن يدخل الجنة، والمعنى إذا رأيتَ هؤلاء الولدان ﴿حَسِبتهم لؤلؤًا منثورًا﴾ أي لحسنهم ونقاء بياض وجوههم وكثرتهم وانبثاثهم في مجالسهم، واللؤلؤ إذا نُثر على بساط كان أزينَ في النظر من المنظوم.
﴿وإذا رأيتَ﴾ أي إذا رأيتَ ببصرك ونظرتَ به ﴿ثَمَّ﴾ أي الجنة ﴿رأيتَ نعيمًا ومُلكًا كبيرًا﴾ أي واسعًا، فقد ثبت في صحيح البخاري[2] أن ءاخرَ أهل النار خروجًا منها وءاخرَ أهل الجنة دخولًا إليها له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد على حصير من جريد وقد أثَّر في جنبه، فبكى عمر، فقال له: “ما يبكيك”؟ قال: ذكرت كسرى ومُلكه، وهرمز ومُلكه، وصاحبَ الحبشة وملكه، وأنت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم على حصير من جريد؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة”، فأنزل الله: ﴿وإذا رأيتَ ثَمَّ رأيت نعيمًا ومُلكًا كبيرًا﴾.
————-
2- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار.
﴿عاليَهُم﴾ أي فوقهم ﴿ثيابُ سُندس﴾ أي الثياب الرقيقة من الديباج وهو الحرير ﴿خُضرٌ﴾ جمع أخضر ﴿وإستبرق﴾ وهو ما غَلُظَ من الديباج ﴿وحُلُّوا﴾ أي أهل الجنة ﴿أساور﴾ جمع أسورة ﴿من فضة وسقاهم ربُّهم﴾ أضاف الله السقيا إليه للتشريف ﴿شرابًا طهورًا﴾ طهور صفة مبالغة في الطهارة، ومن طُهْرِه أنه لا يصير بولًا نجسًا ولكنه يصير رَشْحًا يخرج من أبدانهم كرشح المسك.
وقرأ أهل المدينة وحمزة: “عَاليْهِم” بإسكان الياء وكسر الهاء، وقرأ الباقون بفتح الياء، وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: “خُضرٌ” بالرفع “وإستبرقٍ” بالخفض، وقرأ ابن كثير، وأبو بكر عن عاصم: “خضرٍ” بالخفض “وإستبرقٌ” بالرفع، وقرأ نافع، وحفص عن عاصم: “خضرٌ وإستبرقٌ” كلاهما بالرفع، وقرأ حمزة والكسائي: “خضرٍ وإستبرقٍ” كلاهما بالخفض.
﴿إنَّ هذا﴾ أي النعيم ﴿كان لكم جزاء﴾ أي ثوابًا على ما كنتم في الدنيا تعملون من الصالحات ﴿وكان سعيكم﴾ أي عملكم ﴿مشكورًا﴾ أي مقبولًا مُثابًا.
﴿إنَّا نحن نزَّلنا عليك﴾ أي يا محمد هذا ﴿القرءان﴾ ما افتريتَه ولا جئتَ به من عندك ولا من تلقاء نفسك كما يدعيه المشركون ﴿تنزيلًا﴾ أي نزل ءاية بعد ءاية ولم ينزل على النبي جملة واحدة وإنما أنزل عليه متفرقًا. ثم أمره الله بالصبر فقال:
﴿فاصبر لحكم ربك﴾ أي لقضاء ربك وتبليغ رسالته ﴿ولا تُطع منهم﴾ أي من المشركين ﴿ءاثمًا﴾ أي مرتكب الإثم الداعي لك إليه ﴿أو كفورًا﴾ أي الغالي في الكفر الداعي إليه، والكفور وإن كان ءاثمًا فإن فيه مبالغةً في الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يُتصور في حقه أن يطيع أحدًا منهم لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل ذلك.
أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمدًا يصلي لأطأن عنقه، فأنزل الله: ﴿ولا تطع منهم ءاثمًا أو كفورًا﴾، قال ابن الجوزي: “زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف وقد تكلمنا على نظائرها وبيّنا عدم النسخ” اهـ.
﴿واذكر اسمَ ربك﴾ أي صلّ لربك ﴿بُكرة﴾ يعني صلاة الصبح ﴿وأصيلًا﴾ يعني صلاة الظهر والعصر.
﴿ومِنَ الليل فاسجد لهُ﴾ يعني صلاة المغرب والعشاء ﴿وسبحه ليلًا طويلًا﴾ يعني صلاة التطوع بعد الصلاة المفروضة وهو التهجد بالليل.
﴿إنَّ هؤلاء﴾ يعني الكفار ﴿يحبون العاجلة﴾ أي يؤثرون الدنيا على الآخرة ﴿ويذرون﴾ أي ويَدَعُون ﴿وراءهم﴾ أي أمامهم وهو ما يستقبلون من الزمان ﴿يومًا ثقيلًا﴾ أي يومًا شديدًا وهو يوم القيامة، والمعنى أنهم يتركونه فلا يؤمنون به ولا يعملون له، واستعير الثقيل لليوم لشدته وهوله من ثقل الجرم الذي يتعب صاحبه.
﴿ونحنُ خلقناهم﴾ أي من طين ﴿وشددنا﴾ أي قوينا وأحكمنا وأحسنَّا ﴿أسرهم﴾ أي خَلْقَهم، وقيل شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب، وقيل الأسر مجرى البول والغائط وذلك أنه إذا خرج الأذى انقبضا، والكلام خرج مخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قابلوها بالمعصية، أي سوَّيتُ خلقك أيها الإنسان وأحكمتُه ثم أنت تكفر بي ﴿وإذا شئنا﴾ أي تبديل أمثالهم بإهلاكهم ﴿بدَّلنا أمثالهم تبديلًا﴾ ممن يطيع.
﴿إنَّ هذه﴾ أي السورةَ أو ءايات القرءان أو جملةَ الشريعة ليس على جهة التخيير بل على جهة التحذير من اتخاذ غير سبيل الله كما قال أبو حيان في تفسيره[1] ﴿تذكرة﴾ أي موعظة ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلًا﴾ أي طريقًا موصلًا إلى طاعته وطلب مرضاته.
﴿وما تشاءون﴾ أي الطاعة والاستقامة واتخاذ السبيل إلى الله ﴿إلا أن يشاءَ اللهُ﴾ أي لا يحصل ذلك إلا بمشيئة الله عزَّ وجلَّ، وفي هذه الآية حجة لأهل السنة حيث قالوا إن جميع ما يصدر من العبد من خير أو شر، طاعة أو معصية، إيمان أو كفر بخلق الله ومشيئته ﴿إنَّ الله كانَ عليمًا﴾ أي عالما بأعمالكم وما يصدر منكم قبل خلقكم ﴿حكيمًا﴾ أي في أمره ونهيه لكم وفي فعله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: “وما يشاؤون” بالياء.
﴿يُدخل من يشاء في رحمته﴾ وهم المؤمنون يُدخلهم الجنة ﴿والظالمين﴾ أي الكافرين إما بالإعراض عن الإيمان بالله أو الرسول أو بشتمهما ﴿أعدّ لهم﴾ أي في الآخرة ﴿عذابًا أليمًا﴾ أي عذابًا مؤلما موجِعًا وهو عذاب جهنم. وفي هذه الآية رد على الذين يقولون إن عذاب جهنم معنويٌّ لا حسي أي يزعمون أن ءايات الوعيد للتخويف فقط لا حقيقة لها في الآخرة وهذا إلحاد وكفر بالقرءان.
سورة المرسلات
سورة المرسلات
مكية، وهي خمسون ءاية
بسم الله الرحمن الرحيم
وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15) أَلَمْ نُهْلِكْ الأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ الآخِرِينَ (17) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19) أَلَمْ نَخْلُقكُّمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27) وَيْلٌ يوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) َ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30) لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنْ اللَّهَبِ (31) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ (35) وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50)
أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غارٍ إذ نزلت عليه {والمرسلات} فتلقيناها من فِيْه وإن فاه لرطبٌ بها، إذ خرجت حيةٌ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اقتلوها” قال: فابتدرناها فسبقتنا، قال فقال: “وُقيَتْ شرَّكم كما وُقيتم شرها”.
﴿وَالْمُرْسَلاتِ﴾ أي الرياح ﴿عُرفًا﴾ أي يتبع بعضها بعضًا كعُرف الفرس، وقيل المرسلات أي الملائكة، وعُرفًا أي التي أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى ونهيه.
﴿فالعاصفات عصفًا﴾ أي الشديدات الهبوب السريعات الممر، وقيل: الملائكة تعصِف بروح الكافر.
﴿والناشرات نشرًا﴾ أي الرياح التي تنشُر السحاب وتأتي بالمطر، وقيل: الملائكة الموكَّلون بالسحاب ينشُرونها.
﴿فالفارقات فرقًا﴾ أي الملائكة التي تفرّق بين الحق والباطل، وقيل: ءايات القرءان التي فرَّقت بين الحق والباطل.
﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكرًا﴾ أي الملائكة تلقي ما حملت من الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
﴿عُذرًا أو نُذرًا﴾ الإعذار هي بقيام الحجة على الخلق، والإنذار هو بالعذاب والنقمة.
﴿إنما توعدونَ لواقع﴾ أي ما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم لا محالة.
﴿فإذا النجوم طُمست﴾ أي ذهب ضوؤها ومُحي نورها.
﴿وإذا السماء فُرِجت﴾ أي فُتِحت وشقت.
﴿وإذا الجبال نُسفت﴾ أي قُلعت من أماكنها وفُتّتت وخُرقت.
﴿وإذا الرسل أقِّتَت﴾ أي وإذا الرسل أُجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة. وقرأ أبو عمرو: “وُقِّتَتْ” بواو مع تشديد القاف، وهما بمعنى واحد.
﴿لأيِّ يوم أجلت﴾ تعظيم لذلك اليوم وتعجيب من الله لعباده لما يقع فيه من الهول والشدة، والمعنى لأي يوم أجّلت الرسل ووقتت أي ما أعظمه وأهوله. ثم بيَّن ذلك وأيّ يوم هو فقال عزَّ وجلَّ:
﴿ليومِ الفصل﴾ أي أجّلت ليوم الفصل بين الخلائق فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.
﴿وما أدراكَ ما يومُ الفصل﴾ أَتْبَع التعظيم تعظيمًا أي وما أعلمك يا محمد ما يوم الفصل.
﴿ويلٌ يومئذٍ للمُكذبين﴾ أي عذاب وخزي لمن كذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد، وكرره في هذه السورة عند كل ءاية لمن كذب.
﴿ألم نُهلك الأولين﴾ أخبر الله عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين بالعذاب في الدنيا الذين كذبوا بالرسول المرسل إليهم كقوم نوح وعاد وثمود.
﴿ثم نتبعهم الآخرين﴾ أي نُلحق الآخرين بالأولين، أي كما أهلكنا الأولين قبلهم نهلك الآخرين وهم قوم إبراهيم ولوط ومَديَن الذين سلكوا سبيل الأولين في الكفر والتكذيب، وهذا وعيد لكفار مكة الذين كذبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم.
﴿كذلك نفعل بالمجرمين﴾ أي الكافرين، والمعنى مثل ما فعلناه بمن تقدم ممن كذب برسلي كذلك سنتي في أمثالهم من الأمم الكافرة وبمن أجرم فيما يستقبل فنهلكهم.
﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذبين﴾ أي بآيات الله ورسله.
﴿ألم نخلقكم من ماءٍ مهين﴾ أي ضعيف هو مني الرجل والمرأة.
﴿فجعلناه﴾ أي فجعلنا الماء المهين ﴿في قرار مكين﴾ أي في مكان حريز وهو الرحم يحفظ فيه من الآفات المفسدة له.
﴿إلى قدرٍ معلوم﴾ أي إلى وقت معلوم عند الله وهو وقت الولادة
﴿فقدرنا﴾ من القدرة أي قدرنا على خلقه وتصويره كيف شئنا ﴿فنعم القادرون﴾ حيث خلقناه في أحسن صورة وهيئة. وقرأ أهل المدينة والكسائي: “فَقَدَّرنَا” بالتشديد، وقيل: هما بمعنى واحد.
﴿ويلٌ يومئذ للمكذبين﴾ أي المنكرين للبعث لأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة.
﴿ألم نجعل﴾ أيها الناس ﴿الأرض﴾ لكم ﴿كِفاتًا﴾ أي وعاء.
﴿أحياءً﴾ أي على ظهرها ﴿وأمواتًا﴾ أي في بطنها، والمعنى ألم نجعل الأرض ضامَّة تضم وتجمع الأحيَاء على ظهورها في المساكن والمنازل والأمواتَ في بطونها في القبور فيدفنون فيها.
﴿وجعلنا فيها﴾ أي في الأرض ﴿رواسيَ﴾ أي ثوابت ﴿شامخات﴾ أي مرتفعات، والمعنى أن الله جعل في الأرض جبالا ثابتات شامخات مرتفعات ﴿وأسقيناكم ماءً فُراتًا﴾ أي عذبًا يشرب ويسقى منه الزرع، وهذه من نِعَمِ الله على عباده ذكَّرهم بها.
﴿ويلٌ يومئذٍ للمُكذبين﴾ أي المكذبين بهذه النعم.
﴿انطلقوا إلى ما كنتم بهِ تُكذبون﴾ أي يقال للكفار سيروا إلى ما كنتم تكذبون به في الدنيا من العذاب يعني النار وغيرها.
﴿انطلقوا إلى ظل﴾ أي إلى دخان وهو دخان جهنم إذا ارتفع ﴿ذي ثلاث شُعب﴾ أي تشعب إلى ثلاث شعب من شدته وقوته وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب، والشعب ما تفرق من جسم واحد.
ثم وصف الله الظل فقال عزَّ وجلَّ: ﴿لا ظليل﴾ أي ليس هو كالظل الذي يقي ويظلهم من حرّ الشمس ﴿ولا يُغني﴾ أي لا يدفع عنهم هذا الدخان شيئًا ﴿منَ اللهب﴾ أي لهب جهنم، أجارنا الله منها وجعلنا تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله.
﴿إنَّها﴾ أي النار ﴿ترمي بشرر﴾ وهو ما تطاير من النار في كل جهة ﴿كالقصر﴾ أي كالحصون والمدائن في العظم.
وقال ابن عباس: كنا نرفع الخشب بقصرٍ ثلاثةَ أذرع أو أقلَّ فنرفعُهُ للشتاء فنسميه القَصَر –بسكون الصاد وبفتحها-، وقيل: هو الغليظ من الخشب كأصول النخل وما أشبه ذلك.
﴿كأنه﴾ أي كأن الشرر الذي ترمي به جهنمُ كالقصر ﴿جِمالاتٌ﴾ جمع جمال وهي الإبل ﴿صُفْرٌ﴾ أي سود، شبهت هذه الشرر بالإبل السود والعرب تسمي السود من الإبل صفرًا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الجِمَالات الصُّفرُ هي قُلُوس السفينة أي حباله العظام إذا اجتمعت مستديرة بعضها إلى بعض جاء منها أجرام عظام، وقرأ الجمهور ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: “جِمالات” بكسر الجيم وبالألف والتاء، وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم: “جِمَالَةٌ”، وقرأ رويس عن يعقوب: “جُمَالات” بضم الجيم.
﴿ويلٌ يومئذٍ﴾ أي يوم القيامة ﴿للمكذبين﴾ أي المكذبين بهذا الوعيد الذي توعد الله به من كفر به من عباده.
﴿هذا يوم﴾ أي في يوم القيامة ﴿لا ينطقون﴾ أي لا يتكلمون أي في بعض مواطن القيامة ومواقفها وذلك لأن في بعضها يتكلمون وفي بعضها يختصمون وفي بعضها يُختم على أفواههم فلا ينطقون.
﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ أي مما اقترفوا في الدنيا من الذنوب، فليس لهم عذر في الحقيقة لأنه قد تقدم الإعذار والإنذار في الدنيا فلم يبق لهم عذر في الآخرة.
﴿ويلٌ يومئذ﴾ أي يوم القيامة ﴿للمكذبين﴾ يعني لما تبين أنه لا عذر لهم ولا حجة فيما أتوا به من الأعمال السيئة ولا قدرة لهم على دفع العذاب عنهم لا جَرَمَ قال في حقهم ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾.
﴿هذا يومُ الفصل﴾ أي يقال لهم هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق فيتبين المحق من المبطل والسعيد من الشقي ﴿جمعناكم﴾ أي جمع الله الذين كذَّبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم ﴿والأولين﴾ أي والكفار الذين كذَّبوا النبيين من قبله.
﴿فإن كان لكم﴾ أي في هذا اليوم وهو يوم الفصل ﴿كيدٌ﴾ أي حيلة في الخلاص من الهلاك كما كان لكم ما تكيدون به دين الله والمؤمنين ﴿فَكِيدونِ﴾ أي فاحتالوا اليوم وهم يعلمون أن الحيل يومئذ منقطعة وهذا تعجيز لهم وتوبيخ وتقريع فلهذا عقبه بقوله:
﴿ويلٌ يومئذ للمكذبين﴾ أي العذاب الشديد لهؤلاء المكذبين بالبعث والحساب والجزاء وغير ذلك.
﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ أي الذين ءامنوا بالله ورسوله وأدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات ﴿في ظلال﴾ جمع ظل وهو ظل الأشجار والقصور ﴿وعيون﴾ أي أنهار تجري خلال أشجار جناتهم من ماء وعسل ولبن وغير ذلك.
﴿وفواكهَ مما يشتهون﴾ أي يأكلون منها كلما اشتهوا فاكهة وجدوها حاضرة فليست فاكهة الجنة مقيدة بوقت دون وقت كما في أنواع فاكهة الدنيا، وفاكهة الجنة بسائر أنواعها موجودة دائمًا وأبدًا وأما فاكهة الدنيا توجد في بعض الأوقات دون بعض.
﴿كلوا﴾ أيها المؤمنون من هذه الفواكه ﴿واشربوا﴾ من هذه العيون كلما اشتهيتم ﴿هنيئًا﴾ أي لا تكدير عليكم ولا تنغيص فيما تأكلونه وتشربون منه ﴿بما كنتم تعملون﴾ أي هذا جزاء بما كنتم في الدنيا تعملون من طاعة الله.
﴿إنَّا كذلكَ نَجزي﴾ أي نثيب ﴿المحسنين﴾ أي أهل الإحسان في طاعتهم إيانا وعبادتهم لنا في الدنيا فلا نضيع في الآخرة أجرهم.
﴿ويلٌ يومئذ للمكذبين﴾ أي ويل للذين يكذبون خبر الله عما أخبرهم به من تكريمه هؤلاء المتقين بما أكرمهم به يوم القيامة.
﴿كلوا وتمتعوا﴾ هذا الخطاب للكفار في الدنيا ﴿قليلًا﴾ أي زمانًا قليلًا، إذ قصارى أكلكم وتمتعكم الموت وهو خطاب تهديد ﴿إنكم مجرمون﴾ أي كافرون مستحقون للعقاب.
﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذبين﴾ أي الذين يكذبون بما أعد الله لهم يوم القيامة من العذاب الشديد.
﴿وإذا قيل لهم﴾ لهؤلاء المشركين ﴿اركعوا﴾ أي صلّوا ﴿لا يركعون﴾ أي لا يصلون أي لا يؤمنون ليكونوا من أهل الصلاة.
وقيل إنما يقال لهم ذلك في الآخرة حين يُدْعَوْن إلى السجود فلا يستطيعون.
وقيل هذه الآية يخبر الله فيها عن الذين خالفوا أمره ونهيه لا يأتمرون بأمره ولا ينتهون عما نهاهم.
أخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله ﴿وإذا قيلَ لهم اركعوا لا يركعون﴾: “نزلت في ثقيف”.
﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ أي الذين كذبوا رسل الله فردّوا عليهم ما بلَّغوا من الله إياهم ونهيه بهم.
﴿فبأيّ حديث بعده يُؤمنون﴾ أي إن لم يصدقوا بالقرءان الذي هو المُعجِزُ والدلالة على صدق الرسول عليه السلام فبأي شيء يصدقون.
تم تفسير سورة المرسلات، وبذلك تم تفسير جزء تبارك، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة