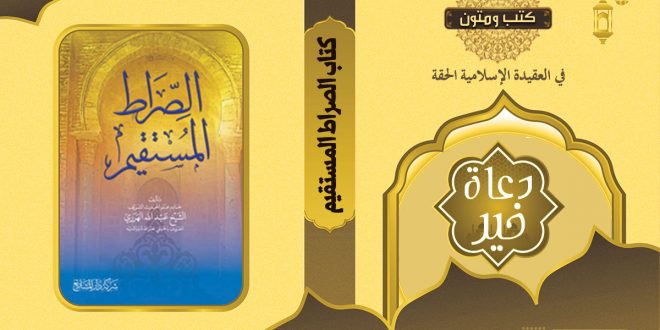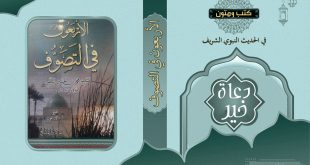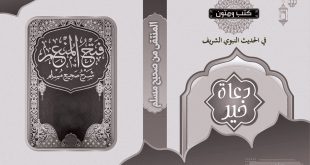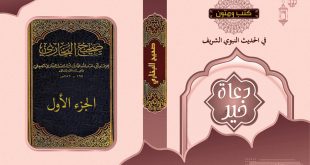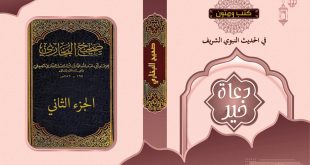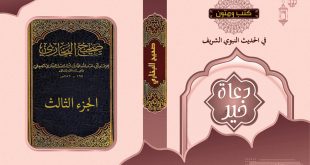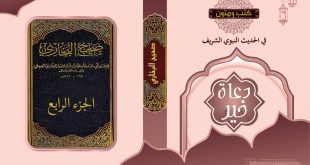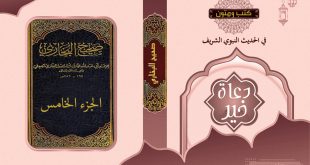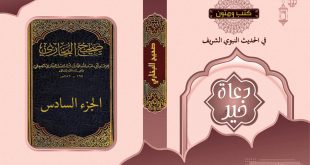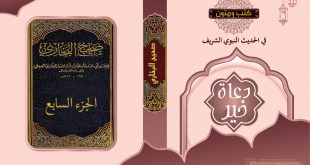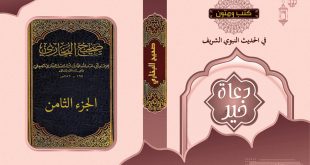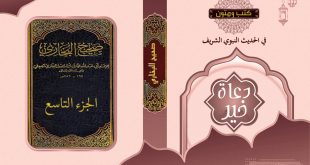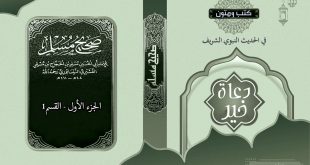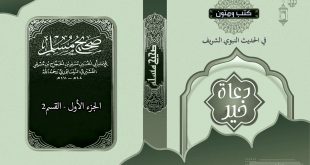بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ {18}﴾ [سورة الحشر]. وقالَ عليٌّ رضي الله عنهُ وكَرَّمَ وجهَهُ: “اليومَ العَملُ وغَدًا الحسابُ”، رواهُ البُخَاريُّ في كتابِ الرِّقاق1.
——————
1- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب في الأمل وطوله.
أعظَمُ حُقوقِ الله على عِبَادِه
اعلم أنَّ أعظمَ حقوقِ الله تعالى على عبادِهِ هوَ توحيدُه تعالى وأن لا يُشرَك به شىءٌ، لأنَّ الإشراكَ بالله هوَ أَكبرُ ذنبٍ يقترِفُه العبدُ وهوَ الذَّنبُ الذي لا يغفرُه الله ويَغفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لمن يَشاءُ. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء (48)﴾ [سورة النساء].
وكذلكَ جميعُ أنواعِ الكُفرِ لا يَغفرُها الله لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ (34)﴾ [سورة محمد].
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من شهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ وأنّ محمدًا عبدُه ورسولُه وأنَّ عيسى عبدُ الله ورسولُه وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه والجنةَ حقٌّ والنارَ حقٌّ أدخَلَهُ الله الجنةَ على ما كانَ منَ العملِ”، رواه البخاري ومسلم1. وفي حديثٍ ءاخَر: “فإنَّ الله حرَّمَ على النار من قالَ لا إله إلا الله يبتغي بذلكَ وجهَ الله” رواه البخاري2.
ويجبُ قرنُ الإيمانِ برسالةِ محمدٍ بشهادةِ أن لا إله إلا الله وذلك أقلُّ شىءٍ يحصلُ به النجاةُ من الخلودِ الأبديّ في النارِ.
——————
1- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله {يَا أَهْلَ الكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ(171)} [سورة النساء]، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا.
2-رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب المساجد في البيوت.
معنَى الشَّهادتينِ
فمعنَى شهادةِ أَنْ لا إله إلا الله إجمالا أعترفُ بلساني وأعتقدُ وأذعن بقلبي أَنَّ المعبودَ بحقٍّ هوَ الله تعالى فقط.
ومعنَى شهادةِ أنّ محمّدًا رسولُ الله أعترفُ بلساني وأُذعِنُ بقلبي أنَّ سيّدنَا محمَّدًا صلى الله عليه وسلم مرسَلٌ من عندِ الله إلى كافَّةِ العالمينَ من إنسٍ وجِنٍّ. صادقٌ في كلِّ ما يبَلِّغُه عن الله تعالى لِيُؤمِنُوا بشَريعَتِه ويتَّبِعُوه.
والمرادُ بالشّهادتينِ نفيُ الألوهيةِ عمَّا سوَى الله وإثباتُها لله تعالى معَ الإقرارِ برسالةِ سيدِنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13)﴾ [سورة الفتح]. فهذه الآيةُ صريحةٌ في تكفيرِ من لم يؤمن بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم فمن نازعَ في هذا الموضوعِ يكونُ قد عاندَ القرءانَ ومن عاندَ القرءانَ كَفرَ. .
وأجمعَ1 الفقهاءُ الإسلاميّونَ على تكفيرِ من دانَ بغيرِ الإسلامِ. وعلَى تكفيرِ من لم يكفِّرْهُ أو شَكَّ أو توقَّفَ كأن يقولَ أنا لا أقولُ إنَّه كافرٌ أو غيرُ كافر.
واعلَم باستيقانٍ أنَّهُ لا يصحُّ الإيمانُ والإسلامُ ولا تُقبلُ الأعمالُ الصالحةُ بدونِ الشهادتينِ بلفظِ أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أنّ محمَّدًا رسولُ الله أو ما في معناهما ولو بغَيرِ اللغةِ العربيةِ.
ويكفي لصحةِ الإسلامِ النطقُ مرَّةً في العُمُرِ ويبقى وجوبُها في كلِّ صلاةٍ لصِحَّةِ الصَّلاةِ، هذا فيمن كانَ على غيرِ الإسلامِ ثمَّ أرادَ الدخولَ في الإسلامِ. وأمَّا من نشَأَ على الإسلامِ وكانَ يعتقدُ الشَّهَادتينِ فلا يُشترط في حَقّه النُّطقُ بهما بل هو مسلمٌ لو لَم يَنطِق.
وقالَ صلى الله عليه وسلم: “قالَ الله تَعالى: وما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشىءٍ أحبَّ إليَّ مما افتَرضتُ عليه” حديث قدسيٌّ رواه البخاريُّ2. وأفضلُ وأوّلُ فرضٍ هوَ الإيمانُ بالله ورسولِه.
واعتقادُ أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي ما لَم يُقرن باعتقادِ أنَّ محمدًا رسولُ الله.
قالَ تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32)﴾ [سورة ءال عمران] أي لا يُحِبُّ الله من تولَّى عن الإيمانِ بالله والرسولِ لكفرهم والمراد بطاعة الله والرسول في هذه الآية الإيمان بهما.
فهذَا دليلٌ على أنَّ من لم يؤمن بالله ورسولِه محمدٍ صلى الله عليه وسلم فهُوَ كافرٌ وأنَّ الله تَعالى لا يُحِبُّه لكُفرِه.
فمن قالَ إنَّ الله يحبُّ المؤمنينَ والكافرينَ لأنه خلقَ الجميعَ فقد كذَّبَ القرءانَ فيقالُ لَهُ الله خلَقَ الجميعَ لكن لا يُحِبُّ الكُلَّ.
——————
1- الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/286).
2- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب التواضع.
الفَرضُ على كلِّ مكلَّفٍ
واعلم أنَّ النطقَ بالشهادَتين بعدَ البلوغ فرضٌ على كلِّ مكلَّفٍ مرَّةً واحدةً في عُمرِه بنيَّةِ الفرضِ عندَ المَالكيةِ لأنَّهُم لا يُوجبونَ التَّحيّاتِ في الصَّلاةِ إنّما هم يعتبرونَها سنَّةً وعندَ غيرهم كالشافعيةِ والحنَابلةِ تجبُ في كلِّ صلاةٍ لصحةِ الصلاةِ.
لا دينَ صحيحٌ إلا الإسلامُ
الدينُ الحقُّ عندَ الله الإسلامُ قالَ تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)﴾ [سورة ءال عمران]. وقالَ تَعالى أيضًا: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ (19)﴾ [سورة ءال عمران].
فكُلُّ الأنبياءِ مسلمونَ فمن كانَ متَّبعًا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلمٌ موسويٌّ، ومن كانَ متَّبعًا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهوَ مسلمٌ عيسويٌّ، ويَصحُّ أن يُقالَ لمن اتَّبعَ محمدًا صلى الله عليه وسلم مسلمٌ محمديٌّ.
والإسلامُ هو الدّينُ الذي رضيَهُ الله لعبادهِ وأمرَنا باتّباعِهِ.
ولا يُسمَّى الله مسلمًا كما تلفظَ به بعضُ الجهالِ.
فقديمًا كان البشرُ جميعُهم على دينٍ واحدٍ هو الإسلامُ. وإنّما حدثَ الشركُ والكفرُ بالله تعالى بعد النبي إدريس.
فكان نوحٌ أوّلَ نبيٍ أُرسِلَ إلى الكفارِ يدعو إلى عبادةِ الله الواحدِ الذي لا شريكَ له. وقد حذَّرَ الله جميعَ الرُّسُلِ مِن بعدهِ منَ الشركِ.
فقام سيدُنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديدِ الدعوةِ إلى الإسلام بعد أنِ انقطعَ فيما بينَ الناسِ في الأرضِ مؤيَّدًا بالمعجزاتِ الدَّالَّةِ على نبوتِهِ. فَدَخَلَ البعضُ في الإسلامِ، وجَحَدَ بنبوتِهِ أهلُ الضلالِ الذين منهم مَن كان مشركًا قبلا كفرقةٍ من اليهودِ عَبَدَت عُزيرًا فازدادُوا كفرًا إلى كفرهم. ءامنَ به بعضُ أهلِ الكتابِ اليهودِ والنصارى كعبدِ الله بن سلامٍ عالم اليهودِ بالمدينةِ، وأصحَمةَ النّجاشيّ ملكِ الحبشةِ وكان نصرانيًّا ثم اتَّبعَ الرسولَ اتباعًا كاملا وماتَ في حياةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وصلَّى عليه الرسولُ صلاةَ الغائبِ يومَ ماتَ1. أوحى الله إليه بموتِهِ. ثم كان يُرى على قبرهِ في الليالي نورٌ وهذا دليلٌ أنه صارَ مسلمًا كاملا وليًّا مِن أولياءِ الله رضيَ الله عنه.
والمبدأُ الإسلاميُّ الجامعُ لجميعِ أهلِ الإسلامِ عبادةُ الله وحدَه.
——————
1-) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز: باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك.
حُكمُ من يَدَّعي الإسلامَ لفظًا وهو مناقضٌ للإسلامِ معنًى
هناكَ طوائف عديدة كَذَّبت الإسلامَ معنًى ولو انتموا للإسلام بقولهم الشهادتين أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمدًا رسولُ الله وصلوا وصاموا لأنّهم ناقضوا الشهادتين باعتقادِ ما ينافيهما فإنّهم خرجوا من التوحيدِ بعبادتهم لغيرِ الله فهم كفَّارٌ ليسوا مسلمينَ كالذين يعتقدونَ ألوهيّةَ علي بن أبي طالبٍ أو الخَضِرِ أو الحاكمِ بأمرِ الله وغيرِهم أو بما في حكمِ ذلكَ منَ القولِ والفعلِ.
وحُكمُ من يجحدُ الشهادتين التكفيرُ قطعًا ومأواه جهنّمُ خالدًا فيها أبدًا لا ينقطعُ في الآخرة عنه العذابُ إلى ما لا نهايةَ له وما هو بخارجٍ من النارِ.
ومن أدَّى أعظمَ حقوقِ الله بتوحيدِهِ تعالى أي ترك الإشراكِ به شيئًا وتصديق رسولِهِ صلى الله عليه وسلم لا يخلدُ في نارِ جهنّم خلودًا أبديًّا وإن دخلَها بمعاصيه ومآله في النهايةِ على أيّ حالٍ كان الخروج من النّار ودخول الجنّةِ بعد أن يكون قد نالَ العقابَ الذي يستحقُّ إن لم يَعفُ الله عنه. قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “يخرجُ من النّارِ من قالَ لا إله إلا الله وفي قلبهِ وزن ذَرّةٍ من إيمانٍ” رواه البخاريُّ1.
وأمّا الذي قامَ بتوحيدهِ تعالى واجتنبَ معاصيه وقامَ بأوامره فيدخل الجنّة بلا عذابٍ حيث النعيمُ المقيمُ الخالدُ بِدلالة الحديث القدسي الذي رواهُ أبو هريرة قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عزَّ وجلَّ: “أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سَمِعَت ولا خَطَرَ على قلبِ بشر”. وقال أبو هريرة: “إقرؤوا إن شئتم قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)﴾ [سورة السجدة] رواهُ البخاري في الصحيحِ2.
——————
1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه.
2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.
بيانُ أقسامِ الكفرِ
واعلم يا أخي المسلم أن هناكَ اعتقاداتٍ وأفعالا وأقوالا تنقضُ الشهادتين وتوقِعُ في الكفرِ لأن الكفرَ ثلاثةُ أنواع: كفرٌ اعتقاديٌّ وكفرٌ فعليٌّ وكفرٌ لفظيٌّ، وذلك باتفاقِ المذاهبِ الأربعة كالنووي1 وابن المُقري2 من الشافعيةِ وابن عابدين3 من الحنفيةِ والبُهُوتي4 من الحنابلةِ والشيخ محمد عِلَّيش5 من المالكيةِ وغيرِهم فلينظرها من شاءَ. وكذلك غيرُ علماءِ المذاهبِ الأربعةِ من المجتهدينَ الماضينَ كالأوزاعيّ فإنه كان مجتهدًا له مذهبٌ كان يُعْمَلُ به ثم انقرضَ أتباعُهُ.
الكفرُ الاعتقاديُّ مكانُهُ القلبُ كنفيِ صفةٍ من صفاتِ الله تعالى الواجبةِ له إجماعًا كوجودهِ وكونهِ قادرًا وكونهِ سميعًا بصيرًا أو اعتقادِ أنه نورٌ بمعنى الضوءِ أو أنه روحٌ.
قال الشيخُ عبدُ الغنيّ النابلسيّ6: “مَن اعتقدَ أن الله ملأ السموات والأرضَ أو أنه جسمٌ قاعدٌ فوقَ العرشِ فهو كافرٌ وإن زعمَ أنه مسلمٌ”.
الكفرُ الفعليُّ: كإلقاءِ المصحفِ في القاذوراتِ قال ابنُ عابدينَ7: ولو لم يقصد الاستخفافَ لأن فعلَه يدلُّ على الاستخفافِ. أو أوراقِ العلومِ الشرعيةِ، أو أيّ ورقةٍ عليها اسمٌ من أسماءِ الله تعالى معَ العلمِ بوجودِ الاسمِ فيها. ومن عَلَّقَ شِعَارَ الكفرِ على نفسِهِ فإن كان بنيةِ التبرّكِ أو التّعظيمِ أو الاستحلالِ من غير ضرورة كان مُرتدًّا.
الكفرُ القوليُّ: كمن يشتم الله تعالى بقوله والعياذُ بالله من الكفر: أختَ ربك، أو ابنَ الله، يقعُ الكفر هنا ولو لم يعتقد أن لله أختًا أو ابنًا.
ولو نادى مسلمٌ مسلمًا ءاخرَ بقوله: يا كافرُ بلا تأويلٍ كفرَ القائلُ لأنه سمّى الإسلامَ كفرًا. ويكفرُ من يقولُ للمسلمِ يا يهوديُّ أو أمثَالها منَ العباراتِ بنيّةِ أنّه ليسَ بمسلمٍ إلا إذا قَصَدَ أنّه يشبهُ اليهودَ فلا يكفُر.
ولو قالَ شخصٌ لزوجتِهِ (أنتِ أحبُّ إليَّ من الله) أو (أعبدُك) كفرَ إن كان يَفهم منها العبادةَ التي هي خاصّةٌ لله تعالى.
ولو قالَ شخصٌ لآخرَ (الله يظلِمك كما ظلمتني) كفرَ القائلُ لأنه نسبَ الظلمَ إلى الله تعالى، إلا إذا كانَ يفهَمُ أن معنى يظلمُك ينتقمُ منكَ فلا نكفّره بل ننهاهُ.
ولو قالَ شخصٌ لشخصٍ ءاخر [بعامية بلاد الشام] والعياذُ بالله (يلعن ربّك8) كفرَ.
وكذلك يكفرُ من يقول للمسلم [بعامية بلاد الشام] (يلعن دينك) قال بعضُ الفقهاء إن قصدَ سيرته فلا يكفر. قال بعض الحنفية: يكفرُ إن أطلقَ أي إن لم يقصِد سيرَتَهُ ولا قصدَ دينَ الإسلام.
وكذلك يَكفرُ من يقولُ والعياذ بالله (فلان زاح ربّي) لأن هذا فيه نسبةُ الحركةِ والمكانِ لله9.
وكذلك يكفرُ من يقولُ والعياذ بالله (قدّ الله) يقصِدُ المُمَاثلة10.
وكذلك يكفرُ من نسبَ إلى الله جارحةً من الجوارح كقول بعض السفهاءِ (يا زبّ الله) وهو لفظٌ صريحٌ في الكفر لا يُقبَلُ فيه التأويلُ.
وكذلك يكفرُ من يقولُ (أنا ربُّ من عَمِلَ كذا).
وكذلك يكفرُ من يقولُ والعياذ بالله: (خَوَتْ ربّي)11.
أو قال للكافر (الله يكرمُك) بقصدِ أن يحبَّهُ الله كفَر لأنّ الله تعالى لا يحبُّ الكافرين كما قال تعالى: ﴿فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32)﴾ [سورة ءال عمران].
وكذلكَ القولُ للكافرِ (الله يَغفر لك)، إن قصدَ أن الله تعالى يغفرُ له وهو على كفرِهِ إلى الموتِ.
وكذلك يكفرُ من قالَ لمن ماتَ على الكفرِ (الله يرحمُه) بقصد أن يريحَه في قبرهِ لا بقصدِ أن يخفّفَ عنه عذابَ القبرِ من غير أن ينال راحةً فإنه إن قال ذلك بهذا القصد فيحتمل أنه لا يكفر.
ويكفرُ من يستعملُ كلمةَ الخلقِ مضافةً للناسِ في الموضعِ الذي تكونُ فيه بمعنى الإبرازِ من العدمِ إلى الوجودِ، كأن يقولَ شخصٌ ما: (اخلُق لي كذا كما خَلَقَكَ الله).
ويكفرُ من يشتِمُ عزرائيلَ عليه السلام كما قالَ ابنُ فَرحُونٍ (في تبصرةِ الحُكَّام12)، أو أيَّ ملَكٍ من الملائكةِ عليهم السلام.
وكذلكَ من يقولُ (أنا عايف الله)، أي كرهتُ الله.
ويكفر من يقول: (الله لا يتحملُ فلانًا) إذا فهمَ العَجز أو أن الله ينزعجُ منه، أما إذا كان يفهمُ من هذه الكلمةِ أن الله يكرَهُه فلا يكفر.
ويكفرُ من يقولُ: “يلعن سماء ربك”، لأنه استخفَّ بالله تعالى.
وكذلكَ من يُسمّي المعَابدَ الدينيةَ للكفارِ (بيوتَ الله)، وأما قولُه تعالى: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ (40)﴾ [سورة الحج] فالمرادُ به مَعَابدُ اليهودِ والنصَارى لَمّا كانوا على الإسلامِ لأنّها كمساجد أمةِ محمدٍ حيثُ إنَّ الكلَّ بُني لتوحيد الله وتمجيدِه لا لعبادةِ غير الله فقد سمَّى الله المسجدَ الأقصى مسجدًا وهو ليسَ من بناءِ أمةِ محمدٍ. فليتَّقِ الله امرُؤٌ وليَحذر أن يسميَ ما بُنِيَ للشركِ بيوتَ الله ومن لم يتَّقِ الله قال ما شاء.
وكذلك من حدَّث حديثًا كذبًا وهو يَعلمُ أنه كذبٌ فقال: الله شهيدٌ على ما أقولُ بقصد أن الله يعلمُ أن الأمر كما قلتُ لأنّه نسبَ الجهلَ لله تعالى لأن الله يَعلَمُ أنه كاذبٌ ليس صادقًا.
وكذلكَ لا يجوزُ القولُ: (كلُّ واحدٍ على دينه الله يُعينُه) بقصدِ الدُّعاءِ لكلٍّ.
ويكفرُ من يقولُ مُعَمِّمًا كلامَهُ: (الكلبُ أحسَنُ من بَني ءادم).
أو من يقولُ “العربُ جربٌ”، أمّا إذا خصَّص كلامَه لفظًا أو بقرينة الحالِ كقولِه اليومَ العربُ فسدوا ثم قالَ العربُ جربٌ فلا يَكفُرُ.
ويكفرُ من يُسمّي الشيطانَ بـ(بسم الله الرحمن الرحيم) لا إن ذَكَرَ البسملةَ بنيةِ التعوّذِ بالله من شرّهِ.
وهناكَ بعضُ الشعراء والكتّابِ يكتبُ كلماتٍ كفريةً كما كتبَ أَحَدُهُم (هربَ الله) فهذا من سوءِ الأدبِ مع الله الموقع في الكفرِ وقد قال القاضي عِياض في كتابه الشّفا13: “لا خلافَ أن سابَّ الله تعالى من المسلمينَ كافرٌ” اهـ.
ويكفر من يستحسن هذه الأقوالَ والعباراتِ وما أكثرَ انتشارَها في مؤلفاتٍ عديدةٍ.
وسوءُ الأدبِ مع الرسولِ صلى الله عليه وسلم بالاستهزاءِ بحالٍ من أحوالِه أو بعملٍ من أعمالِه كفرٌ.
والاستهزاءُ بما كُتبَ فيه شىءٌ من القرءانِ الكريمِ، أو الأنبياءِ عليهمُ السّلام، أو بشعائِر الإسلامِ أو بحكمٍ من أحكامِ الله تعالى كفرٌ قطعًا.
وكذلكَ استحسانُ الكفرِ من غيرِهِ كفرٌ لأنّ الرّضى بالكفرِ كفرٌ.
ولا يكفرُ من نقلَ14 عن غيرِهِ كفريّةً حصلت منه من غيرِ استحسانٍ لها بقولِه قالَ فلانٌ كذا، ولو أخَّرَ صيغةَ قالَ إلى ءاخر الجملةِ فيشترطُ أن يكونَ في نيتهِ ذكر أداةِ الحكايةِ مؤخرة عن الابتداءِ.
——————
1 ) المنهاج (ص/131)، روضة الطالبين: كتاب الردة (10/64).
2 ) الإرشاد (ص/181-182).
3 ) رد المحتار على الدر المختار، باب المرتد (3/283).
4 ) شرح منتهى الإرادات، باب حكم المرتد (3/386).
5 ) منح الجليل شرح مختصر خليل (9/205).
6 ) الفتح الرباني (ص/124).
7 ) رد المحتار (4/222).
8 ) هذه كلمة عامية تستعمل في بلاد الشام بمعنى ألعن ربك والعياذ بالله.
9 ) وكذلك يفهمون منها نسبة الانزعاج إليه والعياذ بالله تعالى.
10 ) أي هكذا يفهم منها العوام عند النطق يها.
11 ) أي جن.
12 ) تبصرة الحكام (2/196).
13 ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى(2/270).
14 ) كتابة أو قولا.
ما يستثنى من الكفرِ القولي
يُستثنَى من الكفرِ اللفظي: حالةُ سبقِ اللسانِ: أي أن يتكلمَ بشىءٍ من ذلكَ من غيرِ إرادةٍ بَل جَرى على لسانِه ولم يقصدْ أن يقولَه بالمَرَّةِ.
وحالةُ غيبوبةِ العَقل: أي عَدَمِ صَحو العقلِ.
وحالةُ الإكراه: فمن نطقَ بالكفرِ بلسانِه مُكرهًا بالقتل ونحوِه وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمانِ فلا يكفرُ قال تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ (106)﴾ الآية [سورة النحل].
حَالةُ الحكايةِ لكفرِ الغَير: فلا يَكفر الحاكي كُفْرَ غيره على غير وجه الرّضَى والاستحسانِ، ومستندُنا في استثناءِ مسئلةِ الحكايةِ قولُ الله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ (30)﴾ [سورة التوبة]، ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ (64)﴾[سورة المائدة].
ثم الحكايةُ المانِعَةُ لكفرِ حاكي الكفرِ إمّا أن تكونَ في أوّلِ الكلمةِ التي يحكيها عمّن تكلم بكفرٍ، أو بعدَ ذكره الكلمةَ عقبَها وقد كان ناويًا أن يأتي بأداةِ الحكايةِ قبلَ أن يقولَ كلمة الكفرِ، فلو قال: المسيحُ ابنُ الله قولُ النصارى، أو قالته النصارى فهي حكاية مانعةٌ للكفرِ عن الحاكي.
وحالةُ كونِ الشخصِ متأوّلا باجتهاده في فهمِ الشرع: فإنه لا يكفرُ المتأوّلُ إلا إذا كان تأوُّله في القطعيّات فأخطأ فإنّه لا يُعذَر كتأوُّل الذين قالوا بِقِدَم العالَم وأزليته كابن تيمية1 . وأما مثالُ من لا يكفر ممّن تأوَّل فهو كتأوُّل الذين منعوا الزكاةَ في عهدِ أبي بكر بأن الزكاةَ وجبَت في عهدِ الرسول لأن صلاتَهُ كانت عليهم سَكَنًا لهم وطُهرَةً ـ أي رحمةً وطمأنينة ـ وأن ذلك انقطعَ بموته فإنّ الصحابةَ لم يكفّروهم لذلك لأنّ هؤلاء فهموا من قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (103)﴾ [سورة التوبة] أن المرادَ من قوله خذ أي يا محمدُ الزكاةَ لتكون إذا دفعوها إليكَ سَكَنًا لهم، وأن هذا لا يحصلُ بعد وفاتِهِ فلا يجبُ عليهم دفعُهَا لأنه قد ماتَ وهو المأمورُ بأخذها منهم، ولم يفهموا أن الحكمَ عامٌّ في حالِ حياتهِ وبعد موتهِ وإنما قاتَلَهُم أبو بكرٍ كما قاتلَ المرتدينَ الذينَ اتبعُوا مسيلمةَ الكذاب في دعواهُ النُّبوَّةَ لأنه ما كان يُمكنهُ أن يأخذَ منهُم قَهْرًا بدونِ قتالٍ لأنهم كانوا ذَوِي قوة فاضطرَّ إلى القتالِ. وكذلك الذين فسّروا قول الله تعالى:﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (91)﴾ بأنّه تخييرٌ وليس تحريمًا للخمرِ فشربوها لأن عُمرَ ما كفّرهم وإنما قال: “اجلدوهم ثمانينَ ثمانينَ، ثم إن عادوا فاقتلُوهُم” اهـ. رواهُ ابنُ أبي شيبة2 .
إنَّما كفَّروا الآخرينَ الذين ارتدّوا عن الإسلامِ لتصديقهم لمسيلمةَ الكذَّاب الذي ادَّعى الرّسالةَ فمقاتلتُهم لهؤلاءِ الذين تأوّلوا منعَ الزكاةِ على هذا الوجهِ كان لأخذِ الحقّ الواجبِ عليهم في أموالهم، وذلك كقتالِ البُغاة فإنّهم لا يقاتلون لكفرِهم بل يقاتلونَ لردّهم إلى طاعةِ الخليفةِ، كالذين قاتلَهُم سيّدنا علي في الوقائعِ الثلاثِ: وقعةِ الجمل ووقعةِ صفين مع معاوية، ووقعةِ النَّهروان مع الخوارج، على أنَّ من الخوارجِ صنفًا هم كفَّارٌ حقيقةً فأولئكَ لهم حكمُهم الخاصُّ.
قالَ الحافظُ أبو زُرعة العِراقيُّ في نُكَتِهِ3 : “وقال شيخنا البُلقينيُّ: ينبغي أن يُقال بلا تأويلٍ ليَخرُجَ البغاةُ والخوارجُ الذين يستحلّونَ دماءَ أهلِ العَدْلِ وأموالَهُم ويعتقدونَ تحريمَ دمائِهم على أهلِ العَدْلِ، والذين أنكروا وجوبَ الزكاةِ عليهم بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالتّأويلِ فإنّ الصحابةَ رضي الله عنهم لم يكفّروهم” اهـ. وهذا شاهدٌ من منقولِ المذهبِ لمسئلةِ التّأويلِ بالاجتهادِ.
ومما يشهدُ من المنقولِ في مسئلةِ الاجتهاد بالتأوّلِ وحكايةِ الكفرِ قولُ شمس الدين الرمليّ في شرحِهِ على منهاج الطالبينَ في أوائلِ كتابِ الرّدّةِ في شرح قولِ النووي: الردّةُ قطعُ الإسلام بنيّةٍ أو قولِ كفرٍ ما نَصُّه 4: “فلا أثَر لسَبْقِ لسانٍ أو إكراهٍ واجتهادٍ وحكايةِ كُفْرٍ”.
وقولُ المُحَشّي ـ أي صاحب الحاشية على الشرح ـ نور الدين علي الشَّبرامَلّسي المتوفَى سنة ألف وسبعٍ وثمانين عند قولِ الرملي: “واجتهادٍ” ما نَصُّه5 : “أي لا مطلقًا كما هو ظاهرٌ لِمَا سيأتي من نحوِ كُفرِ القائلينَ بقِدَم العالَم مع أنّه بالاجتهادِ والاستدلالِ”. قال المُحَشِّي الآخَرُ على الرمليّ أحمدُ بنُ عبدِ الرزاق المعروفُ بالمَغربي الرّشيدي المتوفَّى سنة ألفٍ وستّ وتسعين قولُه6 : “واجتهادٍ” أي فيما لم يقُم الدليلُ القاطعُ على خلافِهِ بدليلِ كفرِ نحو القائلينَ بقِدَم العالَم مع أنّه بالاجتهادِ اهـ، ومن هنا يُعلم أنه ليس كلُّ متأوّلٍ يمنَعُ عنه تأويلُه التكفيرَ، فليجعلْ طالبُ العلم قولَ الرشيديّ المذكورَ فيما لم يَقُمْ دليلٌ قاطعٌ على ذُكْرٍ ـ يعني أن يكون مستحضرًا لهذه الكلمة في قلبه لأنها مهمَّة ـ، لأن التأوُّلَ مع قيامِ الدليلِ القاطعِ لا يمنَعُ التكفيرَ عن صاحبِهِ.
وقولُنا في الخوارج باستثناءِ بعضهم منَ الذين لم يكفَّروا لثبوتِ ما يقتضي التكفيرَ في بعضهم كما يؤيّدُه قولُ بعضِ الصحابةِ الذين رَوَوْا أحاديثَ الخوارج.
وأمّا ما يُروَى عن سيّدنا علي من أنه قال7 : “إخوانُنا بغَوا علينا” فليسَ فيه حجّةٌ للحُكْم على جميعهم بالإسلام، لأنه لم يثبت إسنادًا عن عليّ، وقد قطَعَ الحافظُ المجتهدُ ابنُ جريرٍ الطبريُّ بتكفيرهم وغيرُه8 ، وحملَ ذلك على اختلافِ أحوالِ الخوارج بأنّ منهم من وصَل إلى حدّ الكفر ومنهم مَن لم يَصِلْ، وهذه المسئلةُ بعضُهم عبَّر عنها بالاجتهاد وبعضُهم عبَّر عنها بالتأويلِ، فممّن عبَّر بالتأويل الحافظُ الفقيهُ الشافعيُّ سراجُ الدين البُلقينيُّ الذي قال فيه صاحبُ القاموس9 : “علامَةُ الدُّنْيا”، وعَبّرَ بعضُ شُرّاحِ10 منهاج الطالبينَ بالاجتهادِ وكِلْتا العبارتَين لا بُدَّ لهما من قَيْدٍ ملحوظٍ.
ومن هنا يُعلمُ أنه ليسَ كلُّ متأوّلٍ يَمنعُ عنه تأويلُه التكفيرَ، فلا يظنَّ ظانٌّ أن ذلك مطلقٌ لأنّ الإطلاقَ في ذلك انحلالٌ ومروقٌ من الدين. ألا ترى أن كثيرًا من المنتسبينَ إلى الإسلام المشتغلينَ بالفلسفةِ مَرَقوا من الدين باعتقادهم القولَ بأزلية العالم اجتهادًا منهم ومع ذلك أجمع المسلمونَ على تكفيرهم كما ذكر ذلك المحدّثُ الفقيه بدرُ الدينِ الزركشيُّ في شرح جمع الجوامع فإنه قال بعد أن ذكرَ الفريقينِ منهُم الفريقَ القائل بأزليةِ العالم بمادته وصورته والفريقَ القائلَ بأزلية العالم بمادتهِ أي بجنسهِ فقط ما نصّه11 : “اتّفقَ المسلمونَ على تَضليلِهم وتكفيرِهم”.
وكذلك المرجئة القائلون بأنه لا يضرُّ مع الإيمان ذنبٌ كما لا تنفع مع الكفر حسنةٌ إنما قالوا ذلك اجتهادًا وتأويلاً12 لبعض النصوص على غير وجهها فلم يُعذَروا، وكذلك ضلَّ فِرَقٌ غيرُهم وهم منتسبونَ إلى الإسلامِ كان زيغُهم بطريقِ الاجتهادِ بالتأويلِ نسألُ الله الثباتَ على الحق.
قاعدة: اللفظُ الذي له مَعنيانِ أحدُهما نوعٌ من أنواع الكفرِ والآخر ليسَ كفرًا، وكان المعنى الذي هو كفرٌ ظاهرًا لكن ليسَ صريحًا، لا يُكفَّر قائلُه حتى يُعرَفَ منه أيّ المعنيينِ أرادَ، فإن قال أردتُ المعنى الكفريَّ حُكِم عليه بالكفرِ وأجري عليه أحكامُ الردّة وإلا فلا يُحكمُ عليه بالكفرِ؛ وكذلكَ إن كانَ اللفظُ له معانٍ كثيرةٌ وكان كلُّ معانيهِ كفرًا وكان معنًى واحدٌ منها غيرَ كُفر لا يكفّرُ إلا أن يُعرَفَ منه إرادةُ المعنى الكفريّ، وهذا هو الذي ذكَرهُ بعضُ العلماء الحنفيّينَ في كتبهم، أما ما دام جازمًا بأنه ما حصل منه كفرٌ لكن يَرِد على بالهِ خلافُ ذلك فلا يجبُ عليه أن يتشهدَ ولا يجبُ عليه تجديد النكاحِ عندئذ. وأما ما يقولُه بعضُ الناسِ من أنه إذا كان في الكلمةِ تسعةٌ وتسعون قولا بالتكفيرِ وقولٌ واحدٌ بتركِ التكفيرِ أُخِذ بتركِ التكفيرِ فلا معنى له، ولا يصحُّ نسبَةُ ذلك إلى مالكٍ ولا إلى أبي حنيفة كما نسب سيدُ سابق13 شبهَ ذلك إلى مالكٍ وهو شائِعٌ على ألسنةِ بعض العصريّين فليتَّقُوا الله.
قالَ العلماءُ: أما الصريحُ أي الذي ليسَ له إلا معنًى واحدٌ يقتضي التكفيرَ فيُحكم على قائلِه بالكفرِ كقول أنا الله حتّى لَو صَدَرَ هذا اللفظُ من وليّ في حالةِ غيبةِ عقلِه يُعَزَّرُ ولو لم يكن هُوَ مكلَّفًا تلك الساعة قال ذلك عزُّ الدين بنُ عبدِ السلام14 ، وذلكَ لأن التعزيرَ يؤثّرُ فيمن غابَ عقلُه كما يؤَثّرُ في الصّاحي العاقل وكما يؤثّرُ في البهائم فإنها إذا جَمحَت فضُرِبَت تكفُّ عن جموحها مع أنها ليست بعاقلة. كذلك الوليُّ الذي نطقَ بالكفرِ في حالِ الغَيبة عندما يُضرب أو يُصرخ عليه يكفُّ للزّاجر الطبيعي. على أن الوليَّ لا يصدرُ منه كفرٌ في حالِ حضورِ عقلِه إلا أن يسبقَ لسانه لأن الوليَّ محفوظٌ من الكفرِ بخلاف المعصيةِ الكبيرةِ أو الصغيرةِ فإن ذلك يجوزُ على الولي لكن لا يستمر عليه بل يتوبُ عن قُربٍ. وقد يحصلُ من الولي معصية كبيرة قبل موتهِ بقليلٍ لكن لا يموت إلا وقد تابَ كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما فإنهما خرجا على أميرِ المؤمنينَ علي رضي الله عنه بوقوفهِما مع الذينَ قاتلوهُ في البصرةِ فذكَّر عليٌّ كُلا منهما حديثًا، أمَّا الزبير فقال له: ألم يقُل لكَ رسولُ الله “إنك لتقاتلَنَّ عليًّا وأنت ظالمٌ له” 15 فقال نسيتُ، فذهبَ منصرفًا عن قتالهِ ثم لحقهُ في طريقهِ رجلٌ من جيشِ عليّ فقتَلَهُ. فتابَ بتذكير علي له فلم يَمُتْ إلا تائبًا. وأما طلحةُ فقال له عليّ: ألم يَقُلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم “مَن كنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاهُ” 16 فذهبَ منصرفًا فضربَهُ مروانُ بنُ الحَكَمِ فقتلَهُ، وهو أيضًا تابَ وندِمَ عند ذكرِ علي له هذا الحديث. فكلٌّ منهما ما ماتَ إلا تائبًا. وكِلا الحديثينِ صحيحٌ بل الحديث الثانِي متواترٌ 17. وقد ذكرَ الإمامُ أبو الحسنِ الأشعري أن طلحةَ والزبيرَ مغفورٌ لهما لأجلِ البشارةِ التي بشَّرَهما رسولُ الله بها مع ثمانيةٍ ءاخرين في مجلسٍ واحدٍ فهذا من الإمامِ أبي الحسنِ الأشعري إثباتٌ أنهما أَثِمَا.
وكذلك قالَ في حق عائشةَ لأجلِ أنها مبشرةٌ أيضًا وكانت ندِمَتْ نَدمًا شديدًا مِن وقوفِها في المقاتلين لعلي حتى كانت عندما تذكُر سَيرَها إلى البصرةِ ووقوفَها مع المقاتلين لعلي تبكي بكاءً شديدًا يبتلُّ من دموعِها خمارها. وهذا متواترٌ أيضًا. وقال في غيرهِما من مقاتلي علي من أهل وقعة الجمَلِ ومن أهل صفينَ الذين قاتلوا مع معاوية عليًّا “مجوَّز غفرانه والعفو عنه” كما نقل ذلك الإمامُ أبو بكر بنُ فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتابهِ مجرد مقالات الأشعري 18، وابن فورك تلميذ تلميذ أبي الحسن الأشعري وهو أبو الحسن الباهلي رضي الله عنهم. وما يظنُّ بعضُ الجهَلة من أنَّ الوليَّ لا يقعُ في معصيةٍ فهو جهلٌ فظيعٌ. فهؤلاء الثلاثةُ طلحةُ والزبيرُ وعائشة من أكابرِ الأولياءِ.
قالَ إمامُ الحرمين الجُوينيُّ19 : “اتفقَ الأصوليونَ على أنّ من نطقَ بكلمةِ الرّدةِ ـ أي الكفر ـ وزعَمَ أنّه أضمرَ توريةً كُفّرَ ظاهرًا وباطِنًا” وأقرّهم على ذلك أي فلا ينفعهُ التأويلُ البعيدُ كالذي يقولُ: (يلعن رسول الله) ويقول قصدي برسولِ الله الصّواعق.
وقَدْ عَدَّ كثيرٌ من الفُقَهاءِ كالفَقيهِ الحنفيّ بَدْرِ الرَّشيدِ20 وهو قريبٌ من القرنِ الثامِنِ الهجريّ أشْياءَ كثيرةً فينبغي الاطّلاعُ عليها فإنَّ منْ لم يعرفِ الشرَّ يَقَعْ فيهِ فليُحْذَرْ، فقد ثبتَ عنْ أحدِ الصحابةِ أنَّهُ أخَذَ لسَانَهُ وخاطبَه: يا لِسَانُ قلْ خيرًا تَغْنَمْ، واسْكُتْ عن شرّ تَسْلَم، من قَبْلِ أن تَندمَ، إنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: “أكثرُ خطايا ابنِ ءادَمَ منْ لسانِهِ”21 ، ومِنْ هذه الخطايا الكفرُ والكبائرُ.
وفي حديثٍ ءاخرَ للرسولِ صلى الله عليه وسلم “إنّ العبدَ ليتكلّمُ بالكلِمَةِ ما يَتَبيَّنُ فيها يهوي بِهَا في النَّارِ أَبْعَدَ مما بينَ المشْرِق والمَغْرِبِ” رواه البخاريُّ ومسلمٌ من حديثِ أبي هريرة22.
——————
1 ) الموافقة (2/75)، المنهاج (1/83)، نقد مراتب الإجماع (ص/168)، الفتاوى (6/300)، مجموعة تفسير (/12-13).
2 ) المصنف (5/503)، وتاريخ ابن عساكر (24/390)، وسنن النسائي (3/252): كتاب الحد في الخمر: باب (2).
3 ) حاشية الرملي على شرح روض الطالب (4/117).
4 ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/414).
5 ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/414).
6 ) حاشية المغربي على نهاية المحتاج (7/414).
7 ) رواه البيهقي في سننه (8/173).
8 ) كالقاضي عياض والقرطبي انظر فتح الباري (12/300) وقد عزاه إلى الطبري في تهذيبه.
9 ) القاموس المحيط (ص/1524).
10 ) نهاية المحتاج (7/402).
11 ) تشنيف المسامع (4/70).
12 ) فإنهم تأولوا هذه الآية: ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلا الكَفُورَ (17)﴾ حملوها على أن معناها لا عقوبة في الآخرة إلا على الكافر. وهذا التأول لا ينفعهم.
13 ) فقه السنة (2/453).
14 ) حاشية الجمل (7/568).
15 ) رواه الحاكم في المستدرك (3/366). قال الحاكم “حديث صحيح” ووافقه المذهبي.
16 ) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الترمذي: “حديث حسن صحيح”.
17 ) فيض القدير (6/218).
18 ) مجرد مقالات الأشعري (ص/188).
19 ) عزاه في الزواجر إلى إمام الحرمين (1/32).
20 ) انظر رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات.
21 ) رواه البطراني في المعجم الكبير (10/197) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي “ورجاله رجال الصحيح”.
22 ) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان، أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق: باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار.
فائدةٌ مُهِمَّةٌ
حكمُ من يأتي بإِحدى أنواع هَذِهِ الكُفريّاتِ هو أن تَحْبَطَ أَعْمالُهُ الصالحةُ وحسنَاتُه جميعُهَا، فلا تُحسَبُ له ذرّةٌ من حَسَنَةٍ كانَ سَبَقَ لَهُ أن عَملهَا من صَدقةٍ أو حَجّ أو صيام أو صَلاةٍ ونَحْوِهَا. إنَّما تُحسَبُ له الحسناتُ الجديدَةُ التي يقومُ بها بَعْدَ تَجديد إيمانِه قال تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (5)﴾ [سورة المائدة].
وإذَا قالَ أستغفرُ الله قبلَ أنْ يُجَدّدَ إيْمانَه1 بقولِه أشْهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمدًا رَسُولُ الله وهو على حالَتِهِ هَذِهِ فَلا يَزيدُهُ قولُه أستَغْفِرُ الله إلا إثْمًا وكُفْرًا، لأنَّهُ يكذّبُ قولَ الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ (34)﴾ [سورة محمد]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (169)﴾ [سورة النساء].
روى ابن حبانَ 2 عن عِمران بنِ الحُصَيْن أتى رسولَ الله رجلٌ فقال يا محمدُ، عبدُ المطلب خيرٌ لقومِهِ منك كان يُطعمُهُم الكبدَ والسَّنَام وأنت تَنحَرُهم فقال رسولُ الله ما شاء الله3 فلما أرادَ أن ينصرفَ قالَ: ما أقولُ، قال: “قل اللهم قِني شرَّ نفسِي واعزِم لي على أرْشَدِ أمري” فانطلق الرجلُ ولم يكنْ أسلمَ، ثم قال لرسول الله إني أتيتُكَ فقلتُ علّمني فقلْتَ: “قُل اللهم قني شرَّ نفسي واعزِمْ لي على أرْشَدِ أمري” فما أقولُ الآن حينَ أسلَمْتُ قال: “قل اللهمَّ قني شرَّ نفسي واعزِم لي على أرْشدِ أمري اللهمّ اغفر لي ما أسررتُ وما أعلنْتُ وما عَمَدتُ وما أخطأتُ وما جَهِلْتُ”.
وَمِن أحكامِ الردةِ أنَّ المرتدَّ يَفسُدُ نِكاحُه قبلَ الدخولِ وكذا بعدَهُ إن لم يرجعْ إلى الإسلامِ في العدَّةِ، ولا يصِحُّ عقدُ نِكاحِه لا على مسلمةٍ ولا كافرةٍ ولوْ مرتدة مثله.
——————
1 ) أي بعد دخوله في الإسلام من جديد.
2 ) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2/128).
3 ) معناه رد عليه.
عَودٌ إلى تقسيمِ الكُفرِ لزيادةِ فائدة
واعلم أن الكفرَ ثلاثةُ أبوابٍ: إمّا تشبيهٌ، أو تكذيبٌ، أو تعطيلٌ.
أحدُها التشبيهُ: أي تشبيهُ الله بخلْقِه كمن يصفُه بالحدوثِ أو الفناءِ أو الجسمِ أو اللونِ أو الشكلِ أو الكمّية أي مِقدار الحَجْم أما ما ورَد في الحديثِ “إن الله جميلٌ” فليس معناهُ جميلَ الشكلِ وإنّما معناهُ جميلُ الصّفاتِ أو محسنٌ.
ثانيها التكذيبُ: أي تكذيبُ ما وردَ في القرءانِ الكريم أو ما جاءَ به الرسولُ صلى الله عليه وسلم على وجهٍ ثابتٍ وكان مما عُلِم من الدين بالضرورةِ كاعتقادِ فَنَاءِ الجنّةِ والنار، أو أن الجنةَ لذاتٌ غيرُ حسّيةٍ وأنّ النارَ ءالامٌ معنويّةٌ، أو إنكارِ بعثِ الأجسادِ والأرواح معًا أو إنكارِ وجوب الصلاةِ أو الصيامِ أو الزكاةِ، أو اعتقادِ تحريمِ الطّلاق أو تحليلِ الخمرِ وغيرِ ذلك ممّا ثبتَ بالقطعِ وظهرَ بين المسلمين.
وهذا بخلافِ من يَعتقدُ بوجوبِ الصلاةِ عليه مثلا لكنه لا يصلي فإنه يكونُ عاصيًا لا كافرًا كمن يعتقدُ عَدمَ وجوبِها عليهِ.
ثالثُها التعطيلُ: أي نفيُ وجودِ الله وهو أشدُّ الكفرِ.
وحكمُ من يُشبّهُ الله تعالى بخلقِهِ التكفيرُ قطعًا.
والسَّبِيلُ إلى صَرفِ التَّشبِيهِ اتباعُ هذِهِ القَاعِدَةِ القَاطِعَةِ: “مَهْما تَصَوَّرتَ ببَالِكَ فَالله بِخِلافِ ذَلِكَ” وَهِيَ مُجمَعٌ عَلَيها عِندَ أهلِ الحَقّ، وهي مَأخُوذَةٌ مِن قَولِهِ تَعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ (11)﴾ [سورة الشورى].
ومُلاحَظَةُ مَا رُويَ عن الصّدّيقِ (شِعرٌ من البَسِيْط)
العَجْزُ عَنْ دَرَكِ الإدْرَاكِ إدْرَاكُ والبَحثُ عنْ ذَاتِه كُفرٌ وإشراكُ1
وقولِ بَعْضِهم: لا يَعْرفُ الله على الحقِيقَةِ إلا الله تعالى.
ومَعرِفتُنا نحنُ بالله تَعالى لَيْسَتْ عَلى سَبِيْلِ الإحَاطَةِ بلْ بمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ لله تَعَالى كوُجُوبِ القِدَم لَهُ، وتَنْزيهِهِ عَمَّا يَستحيلُ علَيه تَعالى كاسْتِحالةِ الشّريكِ لهُ وما يجوزُ في حقّه تعالى كَخلْقِ شَىءٍ وتركِه.
قالَ الإمامُ الرفاعيُّ 2 3 : “غايةُ المعْرفةِ بالله الإيقانُ بوجُودِه تعالى بلا كيفٍ ولا مَكانٍ”.
——————
1 ) أورده الفقيه المحدث بدر الدين الزركشي الشافعي في تشنيف المسامع (4/80).
2 ) الرفاعي هو أحمد بن أبي الحسن علي وكان ممن جمع بين العلم والعمل والزهد. كان فقيهًا محدثًا مفسرًا ألف تآليف منها كتاب شرح التنبيه في الفقه الشافعي وألف في الحديث أربعين حديثًا بالإسناد، وتوفي سنة خمسمائة وثمانية وسبعين. ألف في ترجمته الإمام أبو القاسم الرافعي تأليفًا سماه “سواد العينين في مناقب أبي العلمين”.
3 ) كتاب الحكم (ص/36).
فائدةٌ
قَالَ الغَزَاليُّ في إحيَاءِ علوم الدّين1: “إنَّهُ (أي الله) أَزَليٌّ لَيسَ لوجُودِه أوَّلٌ وليسَ لوجُودِهِ ءاخِرٌ. وإنّه ليسَ بجَوهر يَتَحيَّزُ بَل يَتَعالى ويَتَقَدَّسُ عن مُنَاسَبَةِ الحوادِثِ وإنَّه لَيسَ بِجِسم مُؤَلّفٍ مِن جَواهِرَ، وَلَو جَازَ أنْ يُعتَقدَ أنَّ صانِعَ العَالَم جِسمٌ لَجازَ أنْ تُعتَقدَ الأُلوهيّةُ للشَّمْسِ والقَمرِ أو لشَىءٍ ءاخرَ من أقسَامِ الأجسَام فإذًا لا يُشْبهُ شَيئًا ولا يُشبِهُه شىءٌ بل هوَ الحيُّ القيّومُ الذي ليس كَمثْلهِ شَىءٌ وأنَّى يُشْبهُ المَخْلوقُ خالقَه والمُقَدَّرُ2 مُقدّرَه والمصَوَّرُ مُصَوّرَهُ” اهـ.
فليسَ هذَا الكلامَ الذي عابَه العلماءُ وإنّما عابَ السلفُ كلامَ المُبتدِعَةِ في الاعتقادِ كالمشبهةِ والمعتزلةِ والخوارجِ وسائرِ الفرقِ التي شذت عما كان عليه الرسولُ والصحابةُ الذين افترقوا إلى اثنتينِ وسبعينَ فرقة كما أخبرَ الرسولُ بذلك في حديثهِ الصحيحِ الثابتِ الذي رواه ابنُ حبانَ3 بإسنادهِ إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “افترقت اليهود إحدى وسبعينَ فرقة وافترقت النصارى على اثنتينِ وسبعينَ فرقة وستفترقُ أمتي إلى ثلاث وسبعينَ فرقة كلُّهم في النارِ إلا واحدة وهي الجماعة” أي السواد الأعظم.
وأما علمُ الكلامِ الذي يشتغلون به أهلُ السنةِ من الأشاعرةِ والماتريديةِ فقد عُمل به من قبل الأشعري والماتريدي كأبي حنيفةَ فإن له خمسَ رسائل في ذلك والإمام الشافعي كان يتقنهُ حتى إنه قال4: “أتقنَّا ذاك قبل هذا”، أي أتقنَّا علمَ الكلامِ قبل الفقهِ.
——————
1 ) إحياء علوم الدين (1/127-128).
2 ) الخلق المقدر أي له كمية هذا شكله مريح وهذا شكله غير ذلك وهذا حار وهذا بارد.
3 ) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (8/48).
4 ) رواه البيهقي في مناقب الشافعي (1/457).
الوقاية من النار
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)﴾ [سورة التحريم]. وجَاءَ في تَفْسِيرِ الآيةِ أنَّ الله يَأْمُرُ المُؤمِنينَ أنْ يَقُوا أَنْفُسَهم وأهْلَهُم النّارَ التي وَقُودُها الناسُ والحجارةُ بتَعلُّم الأمُور الدِّينيةِ، وتَعلِيم أهلِيهِم ذَلِكَ1 ، أي مَعْرِفَةِ ما فَرضَ الله فِعلَه أو اجتِنابَه أي الواجِبَاتِ والمُحرّماتِ وذَلِكَ كَي لا يَقَعَ في التَّشبِيهِ والتَّمثِيلِ والكُفرِ والضَّلالِ ذَلِكَ لأَنَّهُ من يُشَبّهُ الله تعَالى بشَىءٍ ما لمْ تَصِحَّ عِبَادَتُه، لأنَّه يَعبدُ شيئًا تَخيّلَه وتَوهَّمَه في مخيّلَتِه وأوْهامِه، قال أبو حامد الغزاليُّ: “لا تَصِحُّ العِبَادَةُ إلا بَعْدَ مَعْرِفَةِ المَعْبُودِ”.
——————
1 ) جاء ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب بإسناد قوي فقد رواه الحاكم في المستدرك (2/494) وقال: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”، والبيهقي في المدخل إلى السفن (1/337).
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة