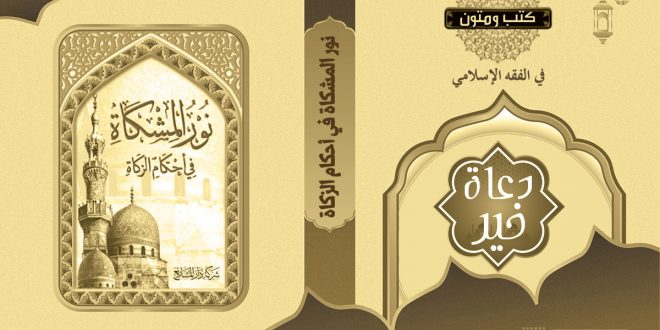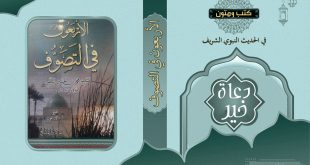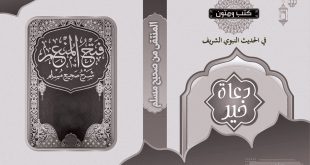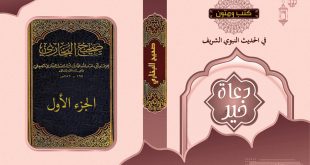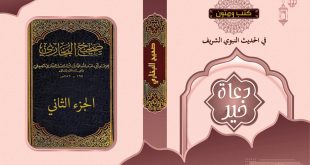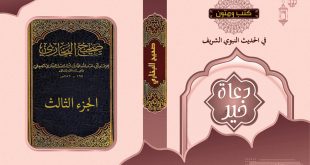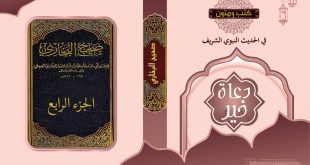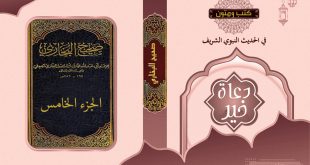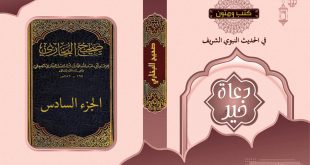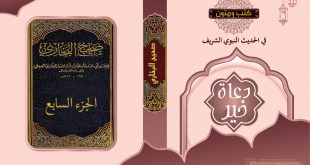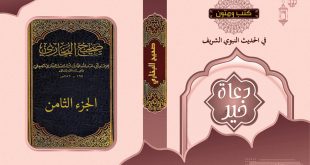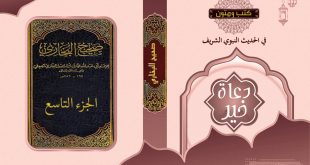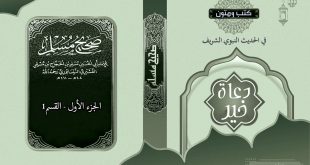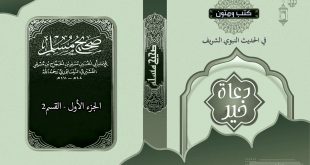نور المشكاة في أحكام الزكاة
مقدمة
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على رسول الله وسلَّم وبعد.
فهذه رسالة صغيرة تحوي كثيرًا من الأحكام التي يجب على ذوي الأموال معرفتها: كمعرفة الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومعرفة النصاب فيها، ووقت وجوبها، وغيرها.
والأحسن في كيفية تلقّي هذه الرسالة أن يكون على يد معلّم عارف بما فيها وأن لا يكتفي بمطالعتها، لأن التلّقِي هو شأن الصحابة والتابعين وأتباعهم في تعلّم علم الدين.
ونسأل الله أن ينفع بها والثواب الجزيل.
تعريفُ الزكاةِ
الزكاةُ لغةً النموُ والبركةُ وزيادةُ الخيِر، يُقالُ: زكا الزرعُ إذا نَما، وزَكَتِ النفقةُ إذا بورِك فيها، وفلانٌ زاكٍ أي كثيُر الخيِر؛ وتطلقُ على التطهيرِ قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ أي طهَّرَها من الأدناسِ؛ وعلى المدحِ قال تعالى: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ﴾ أي تمدَحوها.
وهي شرعاً اسم لما يخرجُ من مالٍ أو بدنٍ على وجهٍ مخصوصٍ لأنّ الزكاةَ إمّا زكاةُ مالٍ وهي المتعلّقةُ بالمواشي، والذهبِ، والفضّةِ، والزروعِ المقتاتةِ حالةَ الاختيارِ، والتمِر، والزبيبِ، وأموالِ التجارةِ؛ وإمّا زكاةُ بدنٍ وهي زكاةُ الفِطرِ.
والأصلُ في وجوبِها قبلَ الإجماع ءاياتٌ كقولِهِ تعالى: ﴿وَءَاتُوا الزَّكَاةَ﴾ وأحاديثُ كحديثِ “بُني الإسلامُ على خمسٍ”؛ ومن أنكرَ وجوبَها فقد كفر إلّا أن يكونَ قريبَ عهدٍ بالإسلامِ أو عاشَ في باديةٍ بعيدةٍ عن العلماءِ، ومن امتنعَ عن أدائِها مع اعتقادِ وجوبِها فلا يُكَفَّرُ ولكن يأخذُها الإمامُ منهُ قهرًا.
ومنع الزكاة من الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعنَ اللهُ ءاكلَ الربا وموكِلَهُ ومانعَ الزكاةِ” رواهُ ابنُ حبّان.
زكاة المواشي
فأمّا المواشي فتجبُ الزكاة في أجناسها الثلاثة وهي:
1- الإبل ويشمَلُ الذكور والإناث.
2- والبقر ويشمَل الذكور والإناث.
3- والغنم ويشمل الضأن والمعز.
ولا تجب الزكاةُ في غيرها من الحيوانات فلا تجب في الخيل ولا الحمر من حيث العين، ولا تجب في غيرها من الدواجن بالإجماع.
ويشترط لوجوب الزكاةِ فيها:
1- النصاب: وهو اسم لقدرٍ معلومٍ مما تجبُ فيه الزكاة فلا زكاةَ فيما دونه.
2- والحول: أي سنةٌ قمريةٌ فلا تجب الزكاةُ قبل تمامه ولو بلحظة.
3- والسَّومُ: وهو أن يرعاها مالكها أو من أذن له مالكُها في كلأٍ مباح أي الكلأ الذي لا مالك له إنما هو مشترك بين الناس. فلا تجب الزكاةُ في المعلوفةِ كلََّ الحول، أو معظم الحول، أو قدرًا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بيّن.
4- وأن لا تكون عاملةً: فلا تجب الزكاة في الإبل العاملةِ في النضح مثلاً.
وأوّلُ نصاب الإبل خمس وفيه شاة: جذعة ضأن وهي الأنثى من الضأن التي استكملت سنة أو أسقطت مقدم أسنانها، أو ثنية معز وهي الأنثى من المعز التي استكملت سنتين. ثم لا يزيد المخرج الواجب على شاة حتى تبلغ عشرًا، فإذا بلغت عشرًا يجب فيها شاتان. ويجب في خمسةَ عشرَ ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي الأنثى من الإبل التي استكملت سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي الأنثى من الإبل التي استكملت سنتين، وفي ست وأربعين حِقّة وهي الأنثى من الإبل التي استكملت ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة وهي الأنثى من الإبل التي استكملت أربع سنين. وفي ست وسبعين بنتا لبون من الإبل، وفي إحدى وتسعين حِقتان من الإبل، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون من الإبل ويستمر ذلك إلى مائة وثلاثين. ثم يتغيّر القدر الواجب إخراجه فيها على حسب ما فصّل الفقهاء: فيكون في كل أربعين من الإبل بنت لبون منها، وفي كل خمسين حقّة منها؛ فزكاة مائة وأربعين من الإبل حقّتان وبنت لبون، وزكاة مائة وخمسين ثلاث حقق وهكذا.
وأوّل نصاب البقر ثلاثون، ويجب فيها تبيع وهو الذكر من البقر الذي بلغ سنة، ويجب في كل أربعين مسنّة وهي الأُنثى من البقر التي بلغت سنتين، ثمّ يُقاس على هذا: ففي ستّين من البقر تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنّة، وفي ثمانين مسنّتان.
وإذا اتفق في إبل أو بقر فرضان في نصاب واحد وجب الأغبط منهما وهو الأنفع للمستحقين؛ ففي مائتي بعير ومائة وعشرين بقرة الأغبط من أربع حِقّات وخمس بنات لبون للإبل، وثلاث مسنّات وأربعة أتبعة للبقر، إن وجدت بمالِه بصفة الإجزاء، وإن وجد أحدهما بماله أخذه.
وأوّل نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة جذعة ضأن أو ثنية معز؛ وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة ست وهكذا.
تنبيه: ما كان بين النصابين في زكاة الماشية عفوٌ لا يجب فيه شىء، فيجب في مائة من الغنم ما يجب في أربعين منها، ويجب في خمسين من البقر ما يجب في أربعين منها.
زكاة الأثمان
وأمّا الأثمان فتجب الزكاة في شيئين منها، هما الذهب والفضّة، وأمّا غيرهما من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام الشافعي، ودليله على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذَابٍ أَلِيم﴾.
ولوجوب الزكاة فيهما يشترط شروط منها:
1- النصاب:
ونصاب الذهب الخالص عشرون مثقالاً وهو نحو 875،84 غرامًا من الذهب الخالص، ونحو 97 غرامًا من ذهب عيار (21)، ونحو113،17 غرامًا من ذهب عيار (18). ونصاب الفضة الخالصة مائتا درهم إسلامي وهو نحو 549،125 غرامًا. ويجب فيهما ربع العشر.
وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه، فزكاة عشرين مثقالاً ذهبًا ربع عُشرها وهو نصفُ مثقال، وزكاةُ ثلاثين ربع عشرها وهو ثلاثة أرباع مثقال. وزكاة مائتي درهم فضة خالصة ربع عشرها وهو خمسة دراهم، وزكاة ثلاثمائة منها ربع عشرها وهو سبعة دراهم ونصف.
2- والحول:
ولا يجب زكاة ما دون النصاب ولا ما لم يمضِ عليه حول.
وأمّا الحلي المباح الذي تلبسه المرأة فاختلف أَيجب زكاته أم لا والأحوط أن يزكّى، وأما الحلي المحرم، كالذهب إذا لبسه الرجل ففيه زكاة إذا بلغ النصاب.
زكاة الزروع والثمار
وأمّا الزروع والثمار فنصابُها خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”، والوَسْقُ ستون صاعًا بصاعه عليه الصلاة والسلام، والصاع أربعة أمداد، فيكون النصاب بالآصع ثلاثمائة، وبالأمداد ألفًا ومائتين. تنبيه: لا يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام ءاخر، ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارةً وبرودة؛ فلو أثمر له نخل و كرم فجُدَّ أي قطع، ثم أخرج طلعه في عامه وهو اثنا عشر شهرًا فلا يضم أحدهما إلى الآخر، ولو كان له نخلان فأطلع أحد نخليه ثم أطلع الثاني قبل جَداد الأول أو بعد جداده ضُم أحدهما إلى الأخر في إكمال النصاب إن اتحد العام، وأن يحين وقت الجداد كالجداد. وزرعا العام يضم بعضهما إلى بعض إذا حان وقت حصادهما في عام واحد. ولا يكمل جنس بجنس كحنطة وشعير وإنما يكمل نوع بنوع، كبرنيّ وعجوةٍ وهما نوعان من جنس التمر. وتجب زكاة الثمر ببدوّ صلاحه وهو أن يبلغ صفة يطلب فيها للأكل غالبًا؛ ففي حال كون ثمرة الكرم والنخل حصرمًا وبلحًا لا تجب زكاتهما، وبدوّ صلاح بعض الثمر كبدوّ صلاح الجميع. وتجب زكاة الزرع باشتداد الحبّ، لأنه حينئذٍ طعام، وقبل ذلك بقلٌ. ولا يصحّ الإخراج إلاّ بعد الجفاف والتصفية، فلا يخرج منه مختلطًا بسنبله. ويجب فيهما إن سقيا بمؤنة نصف العشر كأن سقيا بدولاب أو بنضح من نحو نهر بحيوان، والعشر إن سقيت بلا مؤنة كأن سقيت بماء السماء أو السيل.
زكاة عروض التجارة
وتجب زكاة عروض التجارة المملوكة بمعاوضة إذا بلغت النِّصاب آخر الحول، ومعنى التجارة تقليب المال في البيع والشراء بغرض الربح، وخرج بقيد كونها مملوكة بمعاوضة: المتملَكَة مجانًا فليس فيها زكاة، كأن كأن وَرِثَ شخصٌ إرثًا أو وَهبَهُ إنسانٌ هبةً.
ويشترطُ لوجوب الزكاة فيها شروط منها:
1- الحول: فتقوَّم عروض التجارة ءاخر الحول بالنقد الذي اشتريت به فإن اشتريت بالذهب قوّمت بالذهب وإن اشتريت بالفضة قومت بالفضّة؛ وإن اشتريت بغيرهما قومت بالنقد الغالب في ذلك البلد فإن كان النقدُ الغالب الذهب فبالذهب وإن كان النقد الغالب الفضّة فبالفضّة. فإن بلغت النصاب وجب زكاتُها وإلّا فلا، ويجب فيها ربع العشر.
ثم يجب في مذهب الإمام الشافعي عند الزكاة إخراجُ عين الذهب أو عين الفضّة، أمّا عند أبي حنيفة فيكفي إخراج ما يساوي القيمة من أيّ عملة من العملات، ويجزىء أيضًا عنده غير العملة من العروض، على أنّ تقويم عروض التجارة عنده يكون بالنقد الذي هو أنفع للفقراء، ويعتبر عند التقويم العروض بقيمة بيعها في السوق للناس. وما يصرفه الشخص من هذا المال في أثناء الحول لحاجاته أو يتصدّقُ به فلا يدخُلُ في الحساب عند الزكاةِ، وكذلك ما يمسكه الشخص للانتفاع بعينه أكلاً أو شرباً أو لبساً أو غير ذلك لا يدخل في الحساب.
2- وأن لا يقطع نية التجارة في أثناء الحول، فإن قطع نيّة التجارة في اثناء الحول فلا زكاة عليه، أمّا إن قطع نيّة التجارة بعدما حال الحول ففيه زكاة للعام الماضي، وأمّا بالنسبة للمستقبل فقد خرج عن كونه مال زكاة.
وأما ما كان من أموال التجارة دَينًا فيجب زكاته عند الشافعي، وعند أبي حنيفة ينقص قدر الدين.
فلا زكاة في غير ما ذكر من الأموال كالبيت الذي يمتلكه الشخص ليستغلّه بالإجارة ولو كان الشخص يمتلك عدة أبنية.
وكذلك من كان عنده سيارة يؤجرها للناس أو يستعملها لحاجاته لا تجب الزكاة فيها. ومثل ذلك الآلات التي تكون في المصانع لغزل أو خياطة أو غير ذلك، فلا زكاة في عينها لأنها لا تقلب بالبيع والشراء بقصد التجارة.
زكاة الفطر
وأمّا زكاة الفطر فتجبُ بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوّال: على كل مسلم فضل عن قوته، وقوت من عليه نفقتهم، ودينه، وكسوته، ومسكنه اللائقين به يوم الفطر وليلته صاع من غالب قوت البلد.
ويجب على الرجل فطرة زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ، وكل قريب هو في نفقته كالآباء والأمّهات؛ ولا تجب زكاة الفطر عن الكافر، ولا يصحّ إخراج فطرة الولد البالغ إلّا بإذنه.
وتجب زكاةُ الفطرِ بغروب الشمسِ من آخر يوم من رمضان على من أدرك جزءًا من رمضان وجزءًا من شوال، ويجب أداؤها قبل غروب شمس يوم العيد ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر؛ ويجوز تعجيلها من أوّل رمضان، والسُّنّة إخراجها يوم العيد وقبل الصلاة، ويكره بعد الصلاة.
***
تنبيه: تجب النيّة القلبيّة في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز وهو عزل القدر الذي يكون زكاةً عن ماله، وذلك كأن يقول بقلبه: هذه زكاةُ مالي أو بدني أو صدقة مالي المفروضة.
المستحقُّون للزكاة
ولا يجوز ولا يجزىء صرف الزكاة إلّا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم اللهُ في القرآن بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.
– والفقير: هو من لا يجدُ إلّا أقلّ من نصف كفايته، من حيثُ الطعام والملبسُ والمسكن وسائر ما لا بُدّ منه باعتبار ما يليق به.
– والمسكين: هو الذي يجدُ نصفَ كفايته لكنه لا يجد تمامها كمن يحتاج لعشرة فلا يجد إلّا ثمانية.
– والعاملون عليها: هم الذين نصبهم الخليفة أي السلطان لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرةً من بيت المال.
– والمؤلَّفة قلوبهم: هم من كانوا ضعيفي النيّة بين المسلمين بأن يكونوا دخلوا في الإسلام ولم يتآلفوا مع المسلمين فيعطون من الزكاة حتى تقوى نيّتهم بالإسلام، أو يكونوا شرفاء في قومهم يتوقع بإعطائهم إسلام نظرائهم.
– والرقاب: هم المكاتبون كتابة صحيحة أي الأرقّاء الذين تشارطوا مع أسيادهم على أنهم إن دفعوا كذا من المال يكونوا أحرارًا.
– والغارمون: هم المدينون الذين استدانوا لعمل حلال، أو استدانوا لحرام ثمّ تابوا، ويشترط لجواز إعطائهم من الزكاة أن يكونوا عجزوا عن وفاء الدين، وأن يكون الدَّيْن حالاً، أي حال أوان دفعه.
– ومعنى ﴿وفي سَبِيل اللَّهِ﴾ : الغزاة المتطوعون بالجهاد بأن لم يكن لهم سهم في ديوان المرتزقة من الفىء، فيعطون ما يحتاجونه للجهاد ولو كانوا أغنياء، إعانةً لهم على الغزو.
– وابن السبيل: هو المسافر أو مريد السفر المحتاج بأن لم يكن معه ما يكفيه لسفره فيعطى من الزكاة بشرط أن يكون سفره غير محرّم.
ولا يجوزُ دفعُ الزكاة لغير هؤلاء كدفعها لبناء المدارس والمستشفيات، ومن فعل ذلك لم تصحّ زكاة ماله.
ويشترطُ أن يكون الآخذ للزكاة من غير ءال النبيّ صلى الله عليه وسلم، والمراد من كان من بني هاشم جدّ النبيّ وبني المطّلب أخي هاشم.
ويشترط أيضًا أن لا يكون غنيا بمال يملكه أو بكسب يكتسبه يكتفي منه، وأن لا يكون ممن يجب على دافع الزكاة نفقته كالأب والأم والأولاد غير البالغين؛ وأمّا البالغون الفقراء المستوفون للشروط فيجوز أن يدفعها الأب لهم.
فائدة: قال المحدِّث الشيخ عبد الله الهرري (المعروف بالحبشي): قال بعض العلماء:
ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ويجوز دفعها إلى الساعي، وإنما استحبّ ذلك ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقّيها، قال أحمد (أي أحمد بن حنبل): أعجب إليّ أن يخرجها، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز. وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير: يضعها ربّ المال في مواضعها، وعن أبي الحسن قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها، ثم جئت مرة أخرى فرأيت أبا وائل وحده فقال لي: ردّها فضعها مواضعها.
وأمّا وجه فضيلة دفعها بنفسه فلأنه إيصال للحقّ إلى مستحقيه مع توفير أجر العمالة وصيانة حقّهم عن خطر الجناية، ومباشرة تفريج كربة مستحقّها وإغنائه بها، مع إعطائها للأوْلى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها. اهـ
ثم من أحكام الزكاة التي اتّفق عليها فقهاء الإسلام أنّها لا تدفع لغني أي إنسان مكتفٍ، بأن يكون يجد حاجاته الأصليّة من نفقةٍ وكسوةٍ وحاجةِ مسكنٍ، ولا لقوي على العمل والكسب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنها (أي الزكاة) لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب” رواه أبو داود في السنن وغيره، وهو حديث متّفق على صحّته. ولم يجعل الشرع الزكاة مثل سائر التبرّعات فإن الصدقة غير الزكاة تجوز للفقير والغني.
ثم الزكاة ليست في كل عمل خيري كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات، وقول الله ﴿وفي سَبِيل اللَّهِ﴾ بيَّن رسول الله أنه ليس المراد به كل مشروع خيري، بهذا الحديث المذكور ءانفًا فهو عليه السلام أفهمنا بهذا الحديث هذا الحكم، ورسول الله أفهم بمعاني القرءان من غيره؛ فلا يجوز العمل بقول بعض المدّعين للعلم: إنه يجوز صرفها في كل عمل خيري، وليس في هؤلاء مجتهد حتى يُقلّد، فتبيّن أنه لا يجوز تقليده.
فمصارفها هم الثمانية المذكورون في ءاية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرآءِ﴾ الآية. ومنهم العامل وهو من يبعثه الإمام أي الخليفة لجمع الزكوات من أرباب الأموال، قال الفقهاء: العامل يستحقّ من الزكاة أجرة ما عمله. قالوا: فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه إيّاها وإن شاء سمّاها له إجارة. وقالوا: فلو أدّاها المالك قبل قدوم العامل أو حملها للإمام أو نائب الإمام فلا شىء للعامل، لذلك قالوا: لو تولّى الإمام تفرقة الزكاة بنفسه لا بأيدي العاملين سقط سهم العامل ولا يأخذه الإمام.
ومن أحكامها أنه يجب أداؤها فورًا بعد حَوَلان الحول، ولا يجوز تأخيرها إلّا لانتظار من هو أولى بها من الفقراء الموجودين في البلد كقريب المزكّي الفقير والجار الفقير، كما قال ذلك الفقهاء من شافعيين وحنفيين ومالكيين وغيرهم.
تكميل: قال الفقهاء في تأكيد تحريم صرفها لغير الثمانية للذين ذكرهم الله في القرءان: إنها تحرم على الغازي المرتزق، قالوا: إنما يرزق من حصته من الفىء فإذا عدم الفىء واضطررنا إلى المرتزِق ليكفينا شر الكفّار أعانه الأغنياء من أموالهم لا من الزكاة، والمرتزق هو الجندي المسجّل في ديوان المجاهدين. فإذا كان هذا لا يعطى من الزكاة في هذه الحال التي فيها المسلمون بحاجة إلى استمرار هؤلاء المرتزقين في وظيفتهم مع أنهم متفرّغون للجهاد فكيف هؤلاء الذين تعمل لهم على حساب الزكاة مآدب ومآدب فتكلّف الآلاف المؤلفة كما فعل في بعض السنين الماضية، فهؤلاء عكسوا حديث رسول الله: “تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم”. وفي الحديث الصحيح: أن رجلين أتيا رسول الله يطلبان منه أن يعطيهما من الزكاة وكانا جَلْدَيْن (أي قويين) فصعَّد فيهما النظر وصوَّب ثم قال: “إنه لا حقّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب” ثم أعطاهما بعد أن حسن الظن بهما بأن اعتبرهما لا يجدان من العمل ما يَسدُّ حاجاتِهما الأصليّة. فبعد هذا الحكم من رسول الله كيف يجوز أن يُتصرّف فيها لإطعام هؤلاء الأغنياء بحجّة تنشيطهم لدفع الزكاة.
وليحذر من هؤلاء الذين زادوا على ما ذُكر بأن نشروا منشورًا ذكروا فيه انه تجب الزكاة على كل مسلم وتجب الزكاة في الدواجن، فخرقوا إجماعًا مضى عليه قرون؛ وقد أجمع علماء الإسلام من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أن لا زكاة في الدواجن، إنما الزكاة عند جمهور الأئمة في البهائم في الإبل والغنم والبقر.
وأموال الزكاة يجب توزيعها لمستحقّيها بأعيانها، فلا يجوز وضع أموال الزكاة في مواضع الربا، فالزكاة طهرة لا تخلط بخبث.
وليت شعري هل اطّلعوا على هذه الأحاديث ثم منعهم هواهم أن يعملوا بها أم لم يطّلعوا؟ فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. وفي حاشية ابن عابدين ج 1 ص 14 ما نصّه: “الزكاة دفعها فوري أي واجب على الفور، وعليه الفتوى، فيأثم بتأخيرها بلا عذر وتردّ شهادته”. وفي ردّ المحتار: “وقد ثبت عن أئمّتنا الثلاثة وجوب فوريتها”.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في المهذّب ما نصه: “وَمَنْ وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها لأنه حقّ يجب صرفه إلى الآدمي”، وقال الشيخ عليش المالكي في منح الجليل ج 2 ص 95 ما نصّه: “ووجب تفرقتها أي الزكاة فورا على المستحقين”.اهـ
والله سبحانه وتعالى أعلم
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة