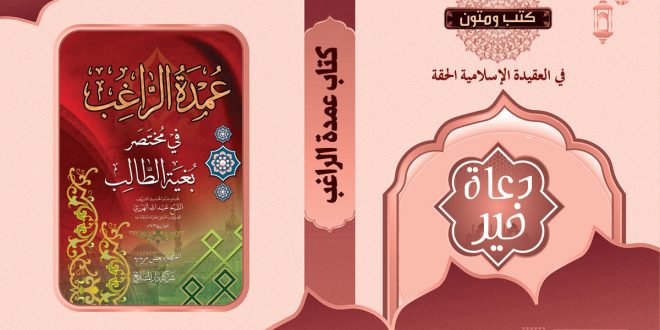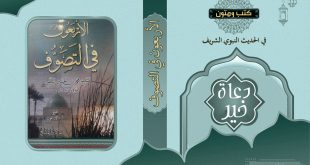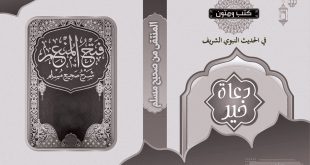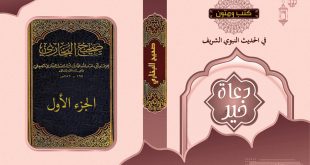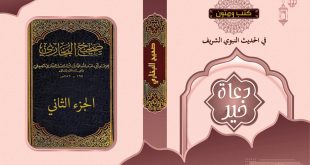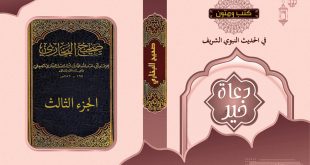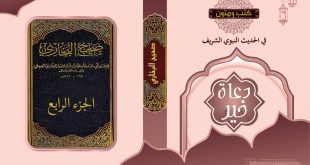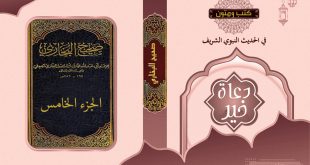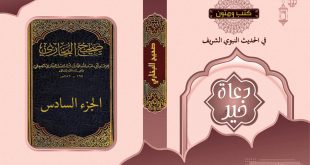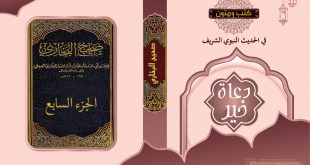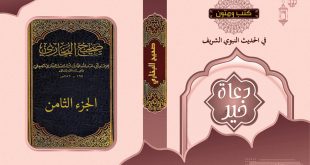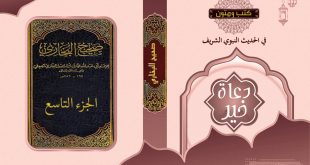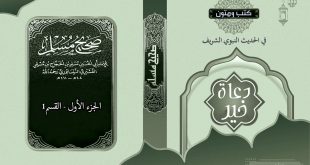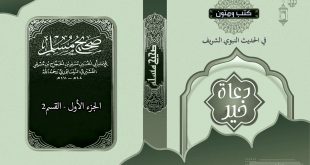بيان أحكام النفقة
قال المؤلف رحمه الله (فصل)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أحكام النفقة.
قال المؤلف رحمه الله (يجبُ على الموسِرِ نفقةُ أصولِهِ المعسرينَ أي الآباءِ والأمهاتِ الفقراءِ وإنْ قَدَرُوا على الكَسبِ)
الشرح يجب على من استطاع أن ينفق على أصوله أي الأب والجد وإن علا والأمِّ والجدة وإن علت إن كانوا معسرين بالمعروف بلا تقدير بحدٍّ معيَّنٍ. وإن كان لا يملك أملاكًا تكفيهم وجب عليه أن يعمل ويكسِب في تحصيل نفقتهم ولا فرق بين أن يكونوا قادرين على الكسب أو عاجزين.
قال المؤلف رحمه الله (ونفقةُ فروعِهِ أي أولادِهِ وأولادِ أولادِهِ إذا أعسَرُوا وعَجَزُوا عنِ الكسبِ لصغرٍ أو زمانةٍ أي مرضٍ مانعٍ منَ الكسبِ.)
الشرح تجب نفقة الفروع من الذكور والإناث إن أعسروا عمّا يكفيهم وعجزوا عن الكسب1 لصغر أو زمانة وكذلك إن كان عجزهم عن كفاية أنفسهم لجنون أو عمى أو مرض ومن ثَمَّ لو أطاقَ صغيرٌ الكسبَ أو أطاق تعلمه وكان لائقًا به جاز للولي أن يَحْمِلَهُ عليه وينفقَ عليه منه، فإِن امتنع أو هرب لزِمَ الوليَّ الإنفاقُ عليه، وأمّا البالغ غير العاجز عن الكسب لزمانة أو نحوها فلا يجب على الأصل الإنفاق عليه وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه لا فرق فيه بين الفرع الذكر والأنثى2. والنفقة التي تجب في حق الأصول والفروع هي الكسوةُ والسُكْنى اللائقةُ بهم والقوتُ والإِدامُ اللائقُ بهم، ولا يجب عليه إطعامهم إلى حد المبالغة في الشِّبع لكن أصل الإِشباع واجب3.
قال المؤلف رحمه الله (ويجبُ على الزوج نفقةُ الزوجةِ)
الشرح يجب على الزوج نفقة زوجته الممكِّنَةِ نفسها له ولو كانت أمةً مملوكةً أو كافرة وكذلك العاجزة عن التمكين لمرض.
وهذه النفقة هي في المذهب مُدّا طعامٍ لكل يوم على موسرٍ حرٍّ ومدٌّ على معسر ومدٌّ ونصفٌ على متوسط، وعليه طَحْنُهُ وعَجْنُهُ وخَبْزُهُ وأُدْمُ غالب البلد ويختلف بالفصول، ويقدِّر الأُدْمَ القاضي باجتهاده عند الاختلاف ويتفاوت بين موسر وغيره. ويجب لها كسوة تكفيها وءالة تنظيف4.
قال المؤلف رحمه الله (ومهرُها وعليهِ لها متعةٌ إن وقع الفراق بينهما بغيرِ سببٍ منها.)
الشرح أنَّه يجب على الزوج أداء مهر زوجته فإن كان حالاًّ فمتى طلبت وإن كان مؤجلاً فعند حلول الأجل لا قبله. ويشترط في المهر أن يكون مما يصح جعله مبيعًا أو ما يصح أن يكون منفعة مقصودة كتعليم القرءان أو سورة منه فيصح جعل المهر تعليم أقصر سورة من القرءان أو تعليم حرفةٍ كخياطة. ويجب للزوجة التي وقع الفراق بينها وبين زوجها بغير سبب منها5 متعة على الزوج6 وليست مقدارًا معيّنًا ولكن يستحب أن تكون للمتوسط ثلاثين درهمًا وأن لا تبلغ نصف مهر المثل، ويجزئ ما يتراضيان عليه ولو أقلَّ مُتَمَوَّلٍ فإن تنازعا قدَّرها القاضي باجتهاده معتبرًا حالهما.
قال المؤلف رحمه الله (وعلى مالِكِ العبيدِ والبهائم نفقتُهُمْ وأَنْ لا يكلِّفَهُمْ منَ العملِ مَا لا يطيقونَهُ ولا يضربَهم بغيرِ حقٍّ.)
الشرح روى البخاريّ في الصحيح أنّه صلى الله عليه وسلم قال «إخوانُكُم خَوَلُكُم7 مَلَّكَكُمُ الله إيّاهم فمن كان أخوه تحت يده فليُطْعِمْهُ مما يأكُلُ وليُلْبِسْهُ مما يلبَسُ ولا يُكَلِّفه من العمل ما يغلِبُهُ فإن كلفتموهم فأعينوهم»8 وروى مالك في الموطإ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «للمملوك طعامُهُ وكسوتُهُ بالمعروف»9 أي بلا إسراف ولا تقتير.
قال المؤلف رحمه الله (ويجبُ علَى الزوجةِ طاعتُهُ في نفسِهَا إِلا في مَا لا يحِلُّ وأنْ لا تصومَ النفلَ ولا تخرج منْ بيتِهِ إِلا بإِذْنِهِ.).
الشرح يجب على الزوجة طاعة الزوج فيما هو حقّ له عليها من الاستمتاع وما يتعلّق به إِلا فيما حرّمه الشرع من أمور الاستمتاع فلا يجب عليها أن تطيعه في الاستمتاع المحرم كأن كانت حائضًا أو نفساء وأراد أن يجامعها بل يحرم عليها، ولا يجب عليها أيضًا طاعته في الجماع إذا كانت لا تطيق الوطىء لمرضٍ. ويجب عليها أن تتزيّن له إن طلب منها ذلك وأن تترك ما يُعَكِّرُ عليه الاستمتاعَ من الروائح الكريهة كرائحة الثوم والبصل والسيجارة إن كان يتأذى بها10. ويجب عليها أن لا تصوم النفل وهو حاضر إلا بإذنه، أمّا الواجب كرمضان فإنها تصومه رضي أو لَم يرضَ لأن الله أحقّ أن يُطاع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه الترمذيّ11.
ويجب عليها أن لا تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته من غير ضرورة إلا بإذنه، فأمّا الخروج لضرورة فهو جائز وذلك كأن أرادت أن تستفتي أهل العلم فيما لا تستغني عنه وكان الزوج لا يكفيها ذلك فإنها تخرج بدون رضاه، وهذا شاملٌ لمعرفة ما هو من أصول العقيدة وما هو من الأحكام كأمور الطهارة كمسائل الحيض فإن لها تشعبًا. ومن الضرورة أن تخشى اقتحامَ فَجَرةٍ في المنـزل الذي أسكنها فيه أو انهدامَهُ.
————-
1- قال في شرح المنهج وبما ذُكر أي من تقييد الفرع بالعجز والإطلاق في الأصل عُلم أنهما [أي الأصل والفرع] لو قدرا على كسب لائق بهما وجبت لأصلٍ لا فرعٍ لعِظَم حرمة الأصل اﻫ
2- في المجموع من له مال يكفيه لنفقته أو هو مكتسب لا تجب نفقته على القريب سواء كان مجنونًا صغيرًا زمنًا أو بخلافه. ومن لا مال له ولا هو مكتسب ينظر إن كان به نقص في الحكم كالصغير والمجنون أو في الخلقة كالزمن والمريض والأعمى لزم القريب نفقته فإذا بلغ الصغير والمجنون حدًّا يمكن أن يعلم حرفة أو يحمل على الكسب فللولي أن يحمله عليه وينفق عليه من كسبه لكن لو هرب عن الحرفة أو ترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى القريب نفقته وكذا لو كان لا تليق به الحرفة اﻫ
3- قال البجيرمي في حاشيته على فتح الوهاب قال الغزالي ولا يجب إشباعه أي المبالغة فيه أما أصل الشبع فواجب اﻫ
4- في حاشية الجمل نقلاً عن شرح الرملي والبرموي والقليوبي والشبراملسي ما يتلخص منه أن قوله وءالة تنظيف أي لبدنها وثيابها ويُرجَع في قدر ذلك للعادة. ومنها المشط قال القفال وخِلالٌ، ويُعلم منه وجوب السواك بالأولى. والأوْجَهُ كما بحثه الأذرعي عدم وُجوب ءالة تنظيف لبائن حامل وإن أوجبنا نفقتها كالرجعية نعم يجب لها ما يزيل شعثها فقط. ويجب لها ما يُغسل به الرأس وكذا ما تُغسل به الثياب والأيدي والأواني من نحو صابون أو أشنان. وله منعها من أكل ذي ريح كريه أو لبسه مثلا ونحو ذلك وإن خالفت نشزت. وليس عليه دواء مرض ولا ما يُزيّن ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد في الأصداغ ونحوها للنساء لا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به. ولها أجرة حمّام اعتيد، ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعـي اﻫ
5- قال في إعانة الطالبين أي فراق حاصل بغير سببها أي وبغير سببهما وبغير سبب ملكه لها وذلك كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه بخلاف ما إذا كان الفراق حصل بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها أو بسببهما كأن ارتدا معًا أو بسبب ملكه لها بأن اشتراها بعد أن تزوجها فلا متعة في ذلك كله قوله (وبغير موت أحدهما) معطوف على بغير سببها أي وفراق حاصل بغير موت أحد الزوجين أي أو موتهما معًا. وخرج به ما إذا كان الفراق بموت أحدهما أي أو موتهما فلا متعة فيه اﻫ
6- إلا أن وجب لها نصف المهر كأن طلقها قبل الدخول فلا متعة لها.
7- أي خدمكم وعبيدكم كذا في فتح الباري.
8- صحيح البخاري، باب المعاصي من الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك.
9- موطأ مالك، باب الأمر بالرفق بالمملوك.
10- قال النووي في الروضة للزوج منعها من تعاطي الثوم وما له رائحة مؤذية على الأظهـر اﻫ
11- سنن الترمذي، باب ما جاء في طاعة الإمام.
بيان الواجبات القلبية
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان الواجبات القلبية.
قال المؤلف رحمه الله (منَ الواجِباتِ القَلبِيّةِ الإِيمانُ بالله وبما جَاءَ عنِ الله والإِيمانُ برسُولِ الله وبِمَا جَاءَ عنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)
الشرح أن مِما يجبُ على المكلَّفِينَ مِنْ أعمالِ القُلوب الإِيمانَ بالله وهو أصلُ الواجباتِ أي الاعتقادَ الجازمَ بوجودهِ تَعالى على ما يليقُ به وهو إثباتُ وجودِه بلا كيفيّةٍ ولا كميّةٍ ولا مكانٍ. ووجوبُ هذا لِمَنْ بَلَغَتْهُ الدّعوةُ مِما اتُفِقَ علَيه بلا خلافٍ، ويَقرِنُ بذلكَ الإيمانَ بما جاءَ به سيدُنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم عن الله تَعالى منَ الإيمانِ بهِ أنه رسولُ الله والإِيمانِ بحقيَّة ما جاءَ به عن الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله ( الإخلاصُ وهوَ العَملُ بالطّاعةِ لله وحْدَهُ)
الشرح أن مِنْ أعمالِ القلُوب الواجبةِ الإخلاصَ وهو إخلاصُ النية من أن يقصد بها عند العمل الصالح محمَدةَ الناسِ والنّظرَ إليه بعَينِ الاحتِرام والتّعظيم والإجلالِ
قالَ تعالى ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحَدًا﴾1 ففي الآية نَهْيٌ عن الرياء لأنّه الشِركُ الأصْغر. وقد روى الحاكم في المستدرَك أن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال « اتَّقوا الرِّياءَ فإنَّهُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ » صححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه.
قال المؤلف رحمه الله (والنَّدمُ علَى المعَاصِي)
الشرح منَ الواجباتِ القَلبِيّة التّوبةُ منَ المعَاصِي إن كانت كبيرةً وإن كانت صغيرةً وركنها الأكبر النّدم، ويجبُ أن يكونَ النّدمُ لأجلِ أنه عصَى ربَّه فإنه لو كانَ نَدَمُهُ لأجل الفضِيحَة بينَ الناسِ لم يكنْ ذلكَ تَوبةً.
قال المؤلف رحمه الله (والتّوكُّلُ علَى الله)
الشرح قال الله تعالى ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾2. التّوكلُ هو الاعتمادُ فيجبُ على العَبْد أن يكونَ اعتمادُه على الله لأنّه خالقُ كلّ شَىء منَ المنَافِع والمضَارّ وسائِر ما يَدخُل في الوجُودِ فلاَ ضَارَّ ولا نافعَ على الحقيقةِ إلا الله. فإذا اعتقَد العبدُ ذلكَ ووَطَّنَ قلبَه علَيه كانَ اعتمادُه على الله في أمُورِ الرّزْقِ والسّلامةِ منَ المضَارّ فجملةُ التوكّل تفويضُ الأمر إلى الله تعالى والثّقةُ به مع ما قُدّرَ للعبد من التّسَبُّب أي مباشرة الأسباب.
قال المؤلف رحمه الله (والمُراقبةُ لله)
الشرح مِنْ واجباتِ القَلْب المُراقَبةُ لله. ومعنَى المُراقبةِ استِدامةُ خوفِ الله تعالى بالقلْب بِتَجَنُّبِ ما حرَّمه وتَجنُّبِ الغَفلةِ عن أداء ما أَوجَبه ولذلكَ يجبُ على المُكلّفِ أوّلَ ما يَدخلُ في التكليفِ أن ينوِيَ ويَعزِمَ أنْ يأتيَ بكلّ ما فَرضَ الله عليه مِنْ أداءِ الواجباتِ واجتنابِ المُحرّماتِ. قال الله تعالى ﴿فَلاَ تَخافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾3.
قال المؤلف رحمه الله (والرّضَا عنِ الله بمعنَى التّسليمِ لَهُ وتركِ الاعتراض)
الشرح يجبُ على المُكلَّفِ أن يَرضَى عن الله أي أن لا يعتَرِضَ على الله لا اعتقادًا ولا لفظًا لا باطنًا ولا ظاهِرًا في قضَائِه وقدَرِه فيَرضَى عن الله تبارك وتَعالى في تقدِيرهِ الخيرَ والشرَّ والحُلوَ والمُرَّ والرِضا والحُزْنَ والرّاحةَ والأَلَم معَ التّمييزِ في المَقدُور والمَقضِيّ فإنّ المقدورَ والمقضِيَّ إما أن يكونَ مما يحبه الله وإمّا أن يكونَ مما يكرهُه الله فالمقضِيُّ الذي هو محبوبٌ لله على العبدِ أن يحبه والمقضِيُّ الذي هو مكروهٌ لله تعالى كالمحرّماتِ فعلى العبدِ أن يكرهَه مِنْ غيرِ أن يكرَه تقديرَ الله وقضاءَه لذلكَ المقدورِ، فالمَعاصِي مِنْ جُملة مقدُوراتِ الله تعالى ومقضِيّاتهِ فيجبُ على العبدِ كراهِيَتُها مِنْ حيثُ إنّ الله تعالى يكرَهُها ونهَى عبادَه عنها، فليسَ بينَ الإِيمانِ بالقَضاء والقَدر وبينَ كراهِيَةِ بعضِ المَقدوراتِ والمقضيّاتِ تَنافٍ لأنّ الذي يجبُ الرِضا به هو القدَرُ الذي هو تقدِيرُ الله الذي هو صِفَتُه والقضاءُ الذي هو صِفَتُه وأمّا الذي يجبُ كراهيتُهُ فما كانَ منَ المَقدُورات والمقضِيّات مُحَرّمًا بحُكْم الشّرع.
قال المؤلف رحمه الله (وتعظيم شعائر الله)
الشرح يجب تَعظِيم شَعائرِ الله فيحرم الإخلال بذلك والاستِهانَةُ بها ومن شعائر الله المساجد، وتبخيرها من تعظيمها. قال أبو يعلى في مسنده حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجـمّر مسجد رسول الله صلى الله عليـه وسلـم كلَّ جمعة اﻫ4
قال المؤلف رحمه الله (والشكرُ علَى نِعَمِ الله بمعنَى عَدَمِ استِعمالِهَا في مَعصِيةٍ)
الشرح الشُكْر قِسْمانِ شُكرٌ واجِبٌ وشُكرٌ مَندُوبٌ، فالشكرُ الواجبُ هو ما علَى العبدِ من العملِ الذي يَدُلّ على تَعظيمِ المُنعم الذي أَنعمَ عليه وعلى غيره وذلك بتَرك العِصْيان لله تباركَ وتَعالى في ذلكَ هذا هو الشكرُ المَفرُوض على العَبدِ، فمَنْ حفِظَ قلبَه وجَوارحَه وما أَنعمَ الله به علَيه من استِعمال شَىءٍ منْ ذلكَ في مَعصِيةِ الله فهوَ العَبدُ الشّاكرُ، ثم إذا تَمكَّن في ذلك سُمّيَ عَبدًا شكُورًا5، قالَ الله تعالى ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ﴾6 فالشكورُ أقلُ وجُودًا منَ الشّاكِر الذي هو دُونَه.
والشُكرُ المَندُوبُ هو الثّناءُ على الله تعالى الدالُّ علَى أنَّه هو المتَفضّلُ على العبادِ بالنّعم التي أنْعَم بها علَيهم مِما لا يَدخُل تحتَ إحصَائِنا. ويُطلَقُ الشّكرُ شَرعًا أيضًا على القِيام بالمُكافأَةِ لِمَنْ أسْدَى مَعرُوفًا مِنَ العِبادِ بَعضِهم لِبَعْضٍ.
قال المؤلف رحمه الله (والصَّبْرُ علَى أَدَاءِ ما أَوجَبَ الله والصَّبرُ عَمَّا حَرّمَ الله تعالى وَعَلَى مَا ابْتَلاكَ الله بِهِ)
الشرح الصّبرُ هو حَبْسُ النّفْسِ وقَهرُها على مَكرُوه تَتحمَّلُه أو لَذِيذٍ تُفارِقُه، فالصّبرُ الواجبُ على المُكلَّفِ هو الصبر على أداءِ ما أوجَب الله منَ الطّاعاتِ والصبرُ عمّا حرم الله أي كفُّ النّفسِ عمَّا حرَّم الله والصّبرُ على تَحمُّلِ ما ابتَلاهُ الله به بمعنَى عدمِ الاعتراضِ على الله أو الدّخُولِ فيما حرَّمه بسَبب المصِيبةِ فإِنَّ كثِيرًا من الخلقِ يقعون في المعاصِي بتركِهمُ الصّبْرَ على المصائِب وهم في ذلك على مَراتبَ مختلِفَةٍ فمِنهم من يقع في الرِدّة عند المصِيبةِ، ومنهُم من يقع فيما دون ذلك من المعاصي كمحاولةِ جلبِ المالِ بطريقٍ مُحرَّم باكتِسابِ المكاسِب المُحرَّمةِ ومُحاولةِ الوصولِ إلى المالِ بالكذب ونحوِه كما يَحصُل لكثير من الناس بسبب الفقر.
قال المؤلف رحمه الله (وبُغْضُ الشّيطانِ)
الشرح يَجبُ على المكلَّفِينَ بُغضُ الشّيطان أي كَراهِيَتُه لأنّ الله تعالى حَذَّرنا في كِتابهِ منه تَحذيرًا بالغًا قال الله تعالى ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ 7والشّيطانُ هو الكافرُ منْ كفّارِ الجنّ، ويُطلَقُ الشّيطانُ ويُرادُ به إبليسُ الذي هوَ جَدُّهُمُ الأَعْلَى.
قال المؤلف رحمه الله (وبُغْضُ المَعاصِي)
الشرح يجبُ كراهيَةُ المعَاصِي مِنْ حيثُ إنَّ الله تَباركَ وتَعالى حرَّمَ على المكلّفِين اقتِرافَها فيجبُ كراهِية المَعاصِي وإنكارُها بالقَلب مِن نَفسِه أو مِن غَيرِه.
قال المؤلف رحمه الله (ومَحبةُ الله ومَحبّةُ كَلامِهِ ورَسُولِهِ والصّحَابةِ والآلِ والصَّالحينَ.)
الشرح يجبُ على المُكلَّفِ مَحبَّةُ الله تعالى بتعظيمه على ما يليق به ومَحبَّةُ كلامِه بالإيمان به ومَحبَّةُ رَسُولِه محمّدٍ صلى الله عليه وسلَّم بتعظيمه كما يجب ومحبة سائر إخوانِه الأنبياءِ كذلك،
وكمال هذه المحبة يكون بالانقياد لشرع الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾8.
وأَمَّا معنى محبةِ الصّحابة فهو تعظيمُهم لأنَّهم أنصارُ دينِ الله ولا سيَّما السّابقون الأوَّلون مِنهُم مِنَ المهاجرينَ والأنصار. والمعنى أنه يجب محبّتُهم من حيثُ الإجمال وليسَ المعنى أنه يجب محبّةُ كلّ فرد منهم.
وأمّا الآلُ فإنْ أُريدَ به مُطلَقُ أتباعِ النّبيّ الأتقياءِ فتَجِبُ مَحبَّتُهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى لما لهم من القُرب إليه بطاعته الكاملة وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون فوجوبُ مَحَبَّتِهِمْ لما خُصوا به من الفضل9 قال الله تعالى ﴿إنما يريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عنكمُ الرِّجْسَ أهلَ البيتِ ويُطَهِّرَكُمْ تطهيرًا﴾10
ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله.
————-
1- [سورة الكهف/ الآية۱۱۰]. وفي تفسير الطبري ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ يقول فمن يخاف ربَّهُ يومَ لقائه ويراقبه على معاصيه ويرجو ثوابه على طاعته ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا﴾ يقول فليخلص له العبادة وليفرد له الربوبية. ثم قال وقوله ﴿وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ يقول ولا يجعل له شريكًا في عبادته إياه وإنما يكون جاعلاً له شريكًا بعبادته إذا راءى بعمله الذي ظاهره أنه لله وهو مريد به غيره اﻫ
2- [سورة المجادلة/ الآية 10].
3- [سورة ءال عمران/ الآية 175].
4- قال الحافظ الهيثمي وفيه عبد الله بن عمر العمري وَثَّقَه أحمد وغيره واختلف في الاحتجاج به اﻫ
5- قال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث «أفلا أكون عبدًا شكورًا» وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال الله تعالى ﴿اعملوا ءال داود شُكْـرًا﴾ اﻫ ثم قال والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة فمن كثر ذلك منه سمي شكورًا ومن ثم قال سبحانه وتعالى ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ اﻫ وفي تفسير القرطبي فقال سهل بن عبد الله الشكر الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية اﻫ
6- [سورة سبإ/ الآية 13].
7- [سورة فاطر/ الآية 6].
8- [سورة ءال عمران/ الآية 31].
9- وءال الرجل أهله وعياله وءاله أيضًا أتباعه اﻫ كذا في مختار الصحاح.
10- [ الأحزاب/ الآية ٣٣].
بيان معاصي القلب
قال المؤلف رحمه الله (فصل)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان معاصي القلب.
قال المؤلف رحمه الله (ومنْ معاصِي القلبِ الرياءُ بأعمالِ البِرّ أي الحسنات وهُوَ العملُ لأجلِ الناسِ أي ليمدحُوهُ ويُحبطُ ثوابَها وهو من الكبائر)
الشرح أن في هذه الجملة بيانَ معصيةٍ مِنْ معاصِي القَلب وهي الرياءُ وهو من الكبائر وهو أن يقصِدَ الإنسانُ بأعمالِ البِرّ كالصّوم والصلاةِ وقراءةِ القرءانِ والحجّ والزكاةِ والصّدقَات والإِحسانِ إلى الناس مَدْحَ الناسِ وإجلالَهُم له فإذا زادَ على ذلكَ قَصْدَ مَبرَّةِ الناسِ له بالهَدايا والعَطايا كانَ أسوأَ حالاً لأنّ ذلك مِن أكلِ أموالِ الناسِ بالبَاطلِ. والرِياءُ يُحبِطُ ثَوابَ العَملِ الذي قَارنَه فإنْ رجَع عن ريائه وتابَ أثناءَ العملِ فما فَعلَه بعد التّوبةِ منه له ثوابُهُ، فأيُّ عَمل مِنْ أعمالِ البِرّ دخَلَه الرِياءُ فلا ثوابَ فيه سَواءٌ كان جرَّدَ قَصدَه للرياءِ أو قرَنَ به قَصْدَ طلبِ الأَجْرِ منَ الله تعالى فلا يجتَمِعُ فى العمل الثوابُ والرياءُ لحديثِ أبي داود والنسائي بالإِسناد إلى أبي أُمامةَ قالَ جاءَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ الله أرأيتَ رجلاً غزا يلتمِسُ الأجرَ والذِكر ما لهُ، قال «لا شىءَ له» فأعادها ثلاثًا كلَّ ذلك يقولُ «لا شىءَ له» ثم قالَ لَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم «إِنَّ الله لا يقبَلُ منَ العَملِ إلا ما كان خالِصًا له وما ابتُغِيَ به وجْهُه» وَجَوَّدَ الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح.
قال المؤلف رحمه الله (والعُجْبُ بطَاعةِ الله وهو شُهودُ العِبادةِ صَادِرةً منَ النّفسِ غائبًا عَنِ المِنَّةِ)
الشرح من مَعاصِي القَلْبِ التي هي من الكبائر أن يَشْهَد العبدُ عبادتَه ومَحاسِنَ أعْمالِهِ صَادِرةً من نفسه غائبًا عن شهود أنها نعمة من الله عليه أي غافلاً عن تَذَكُّرِ أنَّها نِعمةٌ منَ الله علَيه أي أنّ الله هو الذي تفضَّلَ عليه بها فأقدَره عليها وألهمَه فيَرى ذلكَ مزِيّةً لهُ1.
قال المؤلف رحمه الله( والشّكُّ في الله)
الشرح أن مِنْ معَاصِي القَلْب الشكَّ في الله أي في وجودِه أو قُدرَتهِ أو وَحْدانيته أو حكمتِه أو عَدلِه أو في عِلْمِه أو في صفة أخرى من الصفات الثلاث عشرة فالشكُ هنا يضرُّ ولو كان مجرّدَ تردُّد ما لم يكن خاطِرًا يَرِدُ على القَلْب بلا إرادةٍ. قال الله تعالى ﴿إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾2 دلَّت الآيةُ على أنَّ مَنْ شكَّ في وجودِ الله أو قُدرتِه أو نحوِ ذلك ليسَ بمؤمن وأنَّ الإيمانَ لا يَحصُل إلا بالجَزْمِ وأنّ التردّد ينافيه.
قال المؤلف رحمه الله (والأَمنُ مِنْ مَكْرِ الله والقُنُوطُ مِن رَحْمَةِ الله)
الشرح أن مِن المَعاصِي القَلبيّةِ الأمنَ مِن مَكرِ الله والقُنوطَ مِن رَحمةِ الله أمَّا الأَمنُ من مَكرِ الله فمعناه الاستِرسالُ في المَعاصِي معَ الاتّكالِ على الرَّحمة فهذا مِنَ المعَاصِي الكَبائرِ مِمّا لا يَنقُلُ عن المِلّةِ. وأمّا القُنوطُ مِنْ رَحمةِ الله فهو أنْ يُسِيءَ العبدُ الظنَّ بالله فيعتَقِدَ أنّ الله لا يغفِرُ لهُ ألبتّةَ وأنَّه لا مَحالةَ يُعذّبهُ وذلك نَظرًا لكَثْرةِ ذنُوبه مثلاً فهو بهذا المعنى كبيرةٌ منَ الكَبائرِ لا يَنقُل عن الإسلام. وطريقُ النجاة الذي ينبغي أن يكونَ عليه المؤمن أن يكون خائفًا راجيًا يخافُ عقابَ الله على ذنوبه ويرجُو رحمةَ الله
أمّا عند الموتِ فيُغلّبُ الرجاءَ على الخوف3.
قال المؤلف رحمه الله (والتّكبُّرُ على عِبادِهِ وهُوَ رَدُّ الحقّ على قائِلِهِ واستِحقارُ الناسِ)
الشرح أن مِنْ معَاصي القلبِ التي هي من الكبائر التّكَبُّرَ على عبادِ الله وهو نوعان أولهما ردُّ الحقّ على قائِله مع العِلم بأنّ الصوابَ مع القائلِ لنَحْوِ كونِ القائلِ صغيرَ السنّ فيستعظِمُ أن يَرجِعَ إلى الحقّ مِن أجلِ أنّ قائلَه صغيرُ السّنِ وثانيهما استحقارُ الناسِ أي ازدِراؤُهُم كأن يتكبَّر على الفقيرِ وينظرَ إليه نظَرَ احتِقار أو يُعرِض عنه أو يترفَّعَ عليه في الخِطابِ لكونه أقل منه مالاً4. وقد نهى الله تعالى عبادَه عن التكبّر قال الله تعالى ﴿وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾5 أي ولا تُعرض عنهم متكبرًا6 والمعنى أقبل على الناس بوجهك متواضعًا ولا تُوَلّهم شِقَّ وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا﴾7 أي لا تمشِ مِشْيَةَ الكِبْرِ والفَخْرِ8.
قال المؤلف رحمه الله (والحِقدُ وهو إضمارُ العداوةِ إذا عَمِلَ بمقتَضاهُ ولمْ يَكْرَهْهُ)
الشرح أن مِنْ معَاصِي القلب الحِقدَ وهو مَصدَرُ حَقَدَ يَحْقِدُ وهو إضْمارُ العَداوةِ للمُسْلمِ معَ العَملِ بمقتَضاهُ تصميمًا أو قولاً أو فعلاً فإذا لم يعمل بمقتضى ذلك لا يكون معصية. وينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ففي الصَّحِيح «مَنْ أحبَّ أن يُزَحزَحَ عنِ النارِ وَيُدخَلَ الجَنَّةَ فلْتأتهِ مَنِيَّتُه وهو يؤمنُ بالله واليَوم الآخِر وليأتِ الناسَ بما يُحبُ أن يؤتَى إليه» رواه مسلم9 والبيهقي10 وغيرهما.
قال المؤلف رحمه الله (والحَسَدُ وهُوَ كَراهِيةُ النّعمَةِ للمُسْلمِ واستِثقالُها وعَمَلٌ بمقتضاه)
الشرح أن من معاصِي القلب الحَسدَ. قال الله تعالى ﴿ومن شر حاسد إذا حسد﴾11 أي أستجير بالله من شر الحاسد إذا أظهره أما إذا لم يُظْهِر الحسدَ فلا يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره. والحسد هو أن يكره الشّخصُ النّعمةَ التي أنعم الله بها على المسلم دينيّةً كانت أو دنيويّةً ويتمنى زوالَها ويستثقلها له، وإنما يكونُ معصَيةً إذا عمل بمقتضاه تصميمًا أو قولاً أو فعلاً أما إذا لم يقترن به العمل فليس فيه معصيةٌ12.
قال المؤلف رحمه الله (والمَنُّ بالصدقةِ ويُبطِلُ ثوابَهَا كأن يقول لمن تصدق عليه ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا)
الشرح مِنْ مَعاصِي القلب التي هي منَ الكبائر المنُّ بالصَّدقة وهو أن يُعدّدَ نِعمتَه على ءاخذها كأن يقولَ لهُ ألم أفْعَلْ لك كذا وكذا حتى يكسِرَ قلبَه أو يَذكرَها لِمَنْ لا يُحِبُّ الآخِذُ اطّلاعَه عليها وهو يُحبِطُ الثّوابَ ويُبطِلُهُ قالَ الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾13. وإنّما عدَّها من مَعاصي القَلْب لأنّ المَنّ يكون أصْلاً في القلبِ لأنّ المَانَّ يقصِدُ إيذاءَ الشّخصِ فيتفَرَّعُ من ذلكَ العمَلُ البَدنيُّ وهو ذِكرُ إنْعامِه على الشّخصِ بلِسَانهِ.
قال المؤلف رحمه الله (والإصْرارُ علَى الذنبِ)
الشرح أن مِن المعَاصِي القَلبيّة الإصرارَ على الذَّنب وعُدَّ هذا مِنْ معاصي القلبِ لأنه يَقتَرنُ به قصْدُ النّفسِ مُعاوَدَةَ ذلكَ الذّنبِ وعَقْدُ القَلْبِ على ذلكَ ثم يَستَتبعُ ذلكَ العملَ بالجَوارح. والإصرارُ الذي هو مَعدودٌ منَ الكبائر هو أن تغلِبَ مَعاصِيه طاعاته فيصير عدد معاصيه أكبرَ من عدد طاعاته أي بالنسبة لما مَضَى وليسَ بالنسبة ليومِه فقط فيصير بذلك واقعًا في هذه الكبيرة. وأمّا مُجَرّدُ تكرارِ الذّنب الذي هو منْ نَوع الصّغائِر والمُداوَمَةِ علَيه فليسَ بكَبِيرة إذا لم يَغلبْ ذلكَ الذنبُ طاعاتهِ.
قال المؤلف رحمه الله (وسوءُ الظنِّ بالله وبِعبادِ الله)
الشرح مِنْ معاصي القلبِ سوءُ الظنِ بالله وهو أن يَظنَ بربّه أنَّه لا يَرحمهُ بل يعذّبُه، وسوء الظن بعباد الله وهو أن يَظُنَّ بعبادِهِ السّوءَ بغيرِ قَرينةٍ معتبرةٍ قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ﴾14 15 قال الزجّاج هو ظنك بأهل الخير سوءًا فأما أهل الفسق فلنا أن نظن فيهم مثلَ الذي ظهر منهم اﻫ والإثم المذكور في الآية الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب. وقد روى البخاري16 ومسلم17 من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إياكمْ والظنَّ فإن الظنَّ أكذبُ الحديث» فالظن الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الظن بلا قرينة معتبرة18.
قال المؤلف رحمه الله (والتّكذِيبُ بالقَدرِ)
الشرح أن مِنْ معَاصِي القَلْب التكذيبَ بالقَدر وهو كفرٌ وذلكَ بأنْ يعتقدَ العَبدُ أنّ شيئًا منَ الجَائزاتِ العَقليّةِ يَحصُل بغَير تقدِيرِ الله قال الله تعالى ﴿إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾19. وقَد فُسِّر القَدرُ بالتّدبير، ومعناهُ أنّ الله دبّر في الأزلِ الأشياءَ فإذا وقَعت تكونُ على حسَب تقديرهِ الأزليّ20.
قال المؤلف رحمه الله (والفَرحُ بالمعصيةِ مِنهُ أَوْ مِنْ غيرِهِ)
الشرح أن مِنْ مَعاصِي القَلب الفَرحَ بالمعصيةِ الصّادرةِ منه أو مِنْ غيرِه فمَن علِمَ بمعصيةٍ حصَلت مِنْ غيرِه ولو لَم يشهدها ولو في مكانٍ بَعيد ففرح بذلك فقد عصَى الله، وأما الفرَحُ بكفر الغير فهو كفرٌ.
قال المؤلف رحمه الله (والغَدرُ ولو بكافرٍ كأنْ يؤمّنَهُ ثُمَّ يقتلَهُ)
الشرح أنّ الغَدرَ منَ المعَاصي المُحرَّمة وهو مِنْ قِسْم الكَبائر وذلكَ كأن يقولَ لشخصٍ أنت في حِمايتي ثم يَفْتِكَ به هو أو يدلَّ عليه مَنْ يفتِكُ به.
ومن الغَدْر المُحرَّم الذي هو من الكبائر أن يغدِر بالإِمام بعدَ أن يُبايعَه بأن يعودَ مُحاربًا له أو يعلنَ تَمرُّدَه على طاعَتِه أي بعد حصول الإمامة له شرعًا أي بعد أن يصير خليفة وذلكَ متّفقٌ على حُرمَتِه إن كان ذلك الإمامُ راشدًا21.
وأمّا الغَدْرُ بالكَافِر فهو أنَّه إذا أمَّن الكافرَ الإِمامُ أو غيرُهُ منَ المسلمينَ بأن قيلَ له لا بأسَ عليكَ أو أنتَ ءامنٌ فيَحرُم الغدرُ به بالقَتل أو نحوِه قال الله تعالى ﴿وإن أحدٌ من المشركينَ اسْتجارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كلامَ الله﴾ الآيةَ22 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أمَّن رجلاً على دمه ثم قتله فأنا بريءٌ منه23 ولو كان المقتولُ كافرًا» رواه ابن حبان24.
ومن الغَدْر المُحرَّم أن يعامِلَ المسلمُ الكافرَ بالبَيع والشِراء فيَخُونَه في الوَزن أو الكَيل وأنْ يُضَيّعَ ودِيْعَةً استَودعَه إيّاها الكافرُ فيُتلِفَها أو يَجْحَدها وأنْ يشتَرِيَ منه شيئًا بثَمنٍ مؤجَّلٍ ثم يَجْحَدَه.
قال المؤلف رحمه الله (والمكرُ)
الشرح أن مِنْ معاصي القَلبِ المَكْرَ، والمكرُ والخَدِيعَةُ بمعنًى واحدٍ وهوَ إيقاعُ الضّرر بالمسلم بطَريقة خفِية. روى الحاكم في المستدرك25 حديث «المَكْرُ والخديعة في النّار» فمَنْ مكَر بأحَدٍ منَ المسلمينَ فقد وقعَ في كبيرة.
قال المؤلف رحمه الله (وبُغْضُ الصّحابةِ والآلِ والصَّالحينَ)
الشرح أن مِنْ مَعاصِي القَلْب بُغضَ أَصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم. والصحابي هو من لقيه في حياتِهِ صلى الله عليه وسلَّم مع الإيمانِ به سَواءٌ طالت صحبته له صلى الله عليه وسلَّم أو لم تَطل ومات على ذلك ولو تخلّلت بينَ صُحبته له وبين موته على الإسلامِ ردّة. والذي يُبْغِضُ كلَّ الصحابة يكفر. وأمّا الآلُ فالمرادُ بهم هنا أقرباؤه صلى الله عليه وسلَّم المؤمنونَ وأزواجُه. وأمَّا الصّالحونَ فالمُرادُ بهمُ الأتقياءُ الذين أدَّوْا الواجبات واجتنبوا المحرمات.
قال المؤلف رحمه الله (والبُخْلُ بما أَوجَبَ اللهُ والشُّحُّ والحِرصُ)
الشرح أنّ مِن معاصِي القلب البخلَ بما أوجبَ الله تعالى كالبُخل عن أداءِ الزكاةِ للمستحِقّين والبُخل عن دفع نفقةِ الزّوجة الواجبة والأطفالِ والبخلِ عن نفقة الأبوين المحتَاجين والبخلِ عن مُواساةِ القريب مع حاجتِه. ويُرادِفُه الشُّحُّ وهوَ بمعناه إلا أنّ الشُّحّ يُخَصُّ بالبُخْلِ الشّديدِ26. وقَرِيبٌ مِنْ ذلكَ الحِرصُ لأنّ الحِرْص هو شِدَّةُ تعلُّقِ النّفس لاحتِواء المالِ وجمعِه على الوَجه المذموم كالتّوصُّلِ به إلى التّرفّعِ على الناسِ والتّفاخرِ وعدَمِ بذلهِ إلا في هَوى النّفْسِ.
قال المؤلف رحمه الله (والاستِهانةُ بما عظَّمَ الله والتصغيرُ لِمَا عظَّمَ الله مِنْ طاعةٍ وكذلك الاستهانة بمعصيةٍ أو قُرءانٍ أو علْمٍ أو جنّةٍ أو نارٍ)
الشرح أن مِن معاصِي القلب قِلَّةَ المبالاةِ بما عَظَّمَ الله تعالى مِنَ الأُمور كأَنْ يحتقرَ الجنّةَ كقولِ بعضِ الدَجاجِلَةِ المُتصَوّفة “الجنّةُ لُعبَةُ الصِّبيانِ” وقولِ بَعضِهِم “الجَنّة خَشْخاشَة الصِبيان” وهذا حكمُه الرِدّةُ. ومنْ ذلك قولُ بعضِهم “جَهنَّمُ مستشفى” أي محَلُّ طِبابة وعِلاج وتَنظِيف ليسَت محَلَّ عِقابٍ وتَعذِيبٍ وذلكَ إلحَادٌ وكفرٌ، وهذا قول جماعة أمين شيخو الدمشقي الذين زعيمهم اليوم عبد الهادي الباني فعلى زعمهم التعذيب لا يجوز وصف الله به ويقولون عن الآية ﴿شديدِ العقاب﴾27 معناه شديد التعقب، ويقولون إن الأنبياءَ لم يُقتل أحد منهم ويزعُمون أن قول الله تعالى ﴿وقَتْلِهِمُ الأنبياءَ﴾28 معناه “قَتْلُ الكفارِ دعوتَهُمْ” ويقولون “الأنبياء لا يصابون بجروح بسلاح الكفار” وينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رَبَاعِيَتُهُ وشُجَّ وجهه29، ويقولون “الله شاء السعادة لجميع خلقه” وهذا قول المعتزلةِ لا أهلِ السنة ويقولون “علم الدين يؤخذ من قلوب مشايخهم النقشبنديين30 من قلب إلى قلب وليس من الكتب31” فهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم ومن أمثالهم.
ولا يجوز أن يقال عن معصية من المعاصي كبيرةً أو صغيرةً “معليش” وهي في اللغة العامية معناها لا بأس بذلك فمن قال عن معصية وهو يعلم أنها معصية هذه الكلمة بمعنى لا بأس فهو مكذب للدين فيكون مرتدًا.
ومنْ جملة المَعاصي القَلبيّة الاستهانةُ بشىء منَ القرءان أو بشىء منْ علم الشّرع أي عِلم الدّين أو بالجنّةِ أو النارِ وقد ذكَرْنا بعضَ الأمثِلة للاستهانةِ بالجَنّة والنارِ، وأمّا الاستهانةُ بالقرءانِ فكمثل ما رواه الإمام عبد الكريم القشيري32 في الرسالة أن عَمْرَو بنَ عثمانَ33 المكيَّ صوفيَّ مكةَ في عصره رأى الحلاج الحسين بن منصور34 يكتب شيئًا فقال له ما هذا فقال هذا شىء أعارض به القرءان فمقته35 بعد أن كان يُحَسّنُ به الظن وصار يلعنه ويحذر منه حتى بعد أن غادر الحلاج مكة فإنه كان يكتب في التحذير منه إلى الناحية التي يَحُلُّ بها الحلاج36، وكالذي حصل مِن بعض التّجَّانيّة في الحبشةِ من إظهارِ الاستغناءِ بصلاةِ الفاتح عن القرءانِ حتى قال قائلُهم بكلامِهم ما معناه ما لَكُم تحمِلُون هذا الرغيفَ الثّقيلَ يعني القرءانَ ونحنُ بغُنْيةٍ عنه بصلاةِ الفاتحِ، وصلاةُ الفاتح هي كلمةٌ وجِيزةٌ وهيَ هذهِ الصيغةُ “اللّهمَّ صَلِّ على سيّدِنا محمدٍ الفاتِحِ لِما أُغلِقَ الخاتِم لِما سَبَقَ ناصِر الحَقّ بالحقّ والهادِي إلى صِراطِك المستقيمِ وعلى ءالهِ وصحبِه حقَّ قدرِهِ ومِقدارِهِ العظيم” وهي في الأصل مِن تأليفِ الشيخ مصطفى البَكريّ الصُوفيِ ثم استَعملَها كثيرٌ من التّجانيّة واعتبر قسم منهم المرَّة الواحِدَة منها تعدِلُ سِتّةَ ءالافِ خَتْمَةٍ منَ القرءان وادّعَوْا أنَّ ذلك مِما شافَهَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم يقظةً الشيخَ أبا العباسِ التّجّانيَّ37 الذي تنتَسِبُ إليه التّجانيّةُ، على أنّنا لا نجزِم بأن الشيخَ أبا العبّاس هو القائلُ لِما يَدَّعونه لاحتمال أن يكونوا قد كذبوا عليه.
————-
1- اﻫ قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عند ذكر الكبر والعجب والخيلاء فعُلم أن العجب إنما يكون بوصف هو كمال في حد ذاته لكنه ما دام خائفًا من سلبه من أصله فهو غير معجب به وكذا لو فرح به من حيث إنه نعمة من الله تعالى أنعم بها عليه بخلاف ما إذا فرح به من حيث إنه كمال متصف به مع قطع نظره عن نسبته إلى الله تعالى فإن هذا هو العُجْبُ فهو استعظام النعمة والرُكون إليها مع نسيان إضافتها إلى الله تعالى اﻫ وقال مثله الغزالي في إحياء علوم الدين.
2- [سورة الحجرات/ الآية 15].
3- قال الحافظ ابن حجر في الفتح وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته ويؤيده حديث «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» اﻫ
4- روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنه كان في وصية نوح لابنه يا بنيّ أوصيك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين أوصيك بشهادة أن لا إله إلا الله فإنها لو كانت السموات والأرض في كفة وهي في كفة لوزنتها وأوصيك بالتسبيح فإنها عبادة الخلق وبالتكبير وأنهى عن خصلتين عن الكبر والخيلاء قيل يا رسول الله أمن الكبر أن أركب الدابة النجيبة وألبس الثوب الحسن قال لا قيل فما الكبر قال أن تسفه الحق وتغمص الناس اﻫ قال الحافظ الهيثمي رواه كلّه أحمد ورواه الطبراني بنحوه ورواه البزّار من حديث ابن عمرو ورجال أحمد ثقات اﻫ وفي الأدب المفرد للبخاري في باب الكبر عن عبد الله بن عمرو أنه قال كنا جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديثَ إلى أن قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال «لا» قال فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان قال «لا» قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها قال «لا» قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال «لا» قال يا رسول الله فما الكبر قال «سفه الحق وغمص الناس» اﻫ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة قال «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس». ذكره في باب تحريم الكبر وبيانه. قال النووي في شرح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم «وغمط الناس» هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة هكذا هو في نسخ صحيح مسلم رحمه الله قال القاضي عياض رحمه الله لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بطاء قال وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره «غمص» بالصاد وهما بمعنى واحد ومعناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه بفتح الميم يغمطه بكسرها وغمطه بكسر الميم يغمطه بفتحها أما بطر الحق فهو دفعه وانكاره ترفعًا وتجبرًا اﻫ
5- [سورة لقمان/ الآية 18].
6- قال الطبري في تفسير هذه الآية وتأويل الكلام ولا تعرض بوجهك عمن كلمته تكبرًا واستحقارًا لمن تكلمه اﻫ
7- [سورة لقمان/ الآية 18].
8- قال الطبري في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تمـشِ في الأرض مختالاً مستكبرًا اﻫ
9- صحيح مسلم، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء.
10- سنن البيهقي، باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج.
11- [سورة الفلق/ الآية ٥].
12- قال ابن حجر في الفتح الحسد تمني زوال النعمة عن المنعَم عليه ثم قال وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل اﻫ
13- [سورة البقرة/ الآية 264].
14- [سورة الحجرات/ الآية 12].
15- قال الرازي في تفسيره فقوله ﴿اجتنبوا كثيرًا﴾ وقوله تعالى ﴿إن بعض الظن إثم﴾ إشارة إلى الأخذ بالأحوط كما أن الطريق المخوفة لا يتفق كل مرة فيه قاطع طريق لكنك لا تسلكه لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فتسلكه مع رفقة كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ اﻫ
16- صحيح البخاري، باب لا يخطب على خطية أخيه حتى ينكح أو يدع.
17- صحيح مسلم، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها.
18- قال القرطبي في الجامع لأحكام القرءان قال علماؤنا فالظن هنا وفي الآية هو التهمة ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ثم قال وإن شئت قلت والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر فظنُّ الفساد به والخيانة محرم بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث اﻫ وقال أبو حيان في البحر المحيط ﴿اجتنبوا كثيرًا من الظن﴾ أي لا تعملوا على حسبه، وأمر تعالى باجتنابه لئلا يجترئ أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه وباطله. والمأمور باجتنابه هو بعض الظن المحكوم عليه بأنه إثم وتمييز المجتنَب من غيره أنه لا يعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كمن يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث كالدخول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة نساء المغاني وإدمان النظر إلى المرد فمثل هذا يقوي الظن فيه أنه ليس من أهل الصلاح ولا إثم فيه وإن كنّا لا نراه يشرب الخمر ولا يزني ولا يعبث بالشبان بخلاف من ظاهره الصلاح فلا يظن به السوء فهذا هو المنهي عنه ويجب أن يزيله. والإثم الذنـب الذي يستحق صاحبه العقـاب اﻫ
19- [سورة القمر/ الآية 49].
20- قال الحنفية «أو قال المظلوم هذا بتقدير الله تعالى فقال الظالم أنا أفعل بغير تقدير الله تعالى كفر» اﻫ نقله عنهم النووي في الروضة وأقره.
21- وقد روى مسلم في الصحيح في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من كره من أميره شيئًا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» اﻫ
22- [سورة التوبة/ الآية6].
23- وفي هذا بيان أن هذا الذنب من الكبائر وليس المراد أنه يخرج من الدين.
24- صحيح ابن حبان، ذكر الزجر عن قتل المرء من أمنه على دمه.
25- المستدرك على الصحيحين.
26- قال النووي في شرح مسلم باب تحريم الظلم قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع اﻫ
27- [سورة غافر/ الآية ٢].
28- [سورة ءال عمران/ الآية ١٨١].
29- وقد روى البخاري في صحيحه باب اللهو بالحراب ونحوها عن سهل قال «لما كُسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأُدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقأ الدم» اﻫ
30- الطريقة النقشبندية طريقة مستقيمة في أصلها من طرق أهل الله لكن قسمٌ من المنتسبين إليها شذوا كجماعة أمين شيخو.
31- قال الشيخ أبو الهدى الصيادي في كتابه مراحل السالكين “كما قال كثير من الوجودية كُمَّلُ الأولياء يأخذون العلم من المعدن الذي أخذ منه الأنبياء والرسل من ذلك المعدن فالعلم الذي أخذ بواسطة الرواة والأسانيد ليس بعلم وهذا هو الضلال البعيد والعصيان الذي ما عليه من مزيد” اﻫ
32- أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن أبو الأسعد القشيري النيسابوري خطيب نيسابور وكبير القشيرية في وقته. كان أسند من بقي بخراسان وأعلاهم رواية. حدث عن أبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف وأبي بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي وأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم في ءاخرين. صنف كتبًا في علوم الصوفية. روى عنه ابن عساكر وابن السمعاني وءاخرون وكانت الرحلة إليه. قال أبو سعد السمعاني ولد في ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاثمائة وتوفي في سادس عشر ربيع الآخر من سنة خمس وستين وأربعمائة بنيسابور.
انظر الأعلام والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد.
33- عمرو بن عثمان بن كرب أبو عبد الله المكي صوفيٌّ عالمٌ بالأصول من أهل مكة. له مصنفات في التصوف وأجوبة لطيفة في العبارات والاشارات. قال أبو نعيم معدود في الأولياء أحكم الأصول وأخلص في الوصول. من أقواله ثلاثة أشياء من صفات الأولياء الرجوع إلى الله في كل شىء والفقر إلى الله في كل شىء والثقة به في كل شىء وقال عمرو اعلم أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرتك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو أنس اوضياء أو جمال أو شبح أو نور أو شخص أو خيال فالله بعيد من ذلك كله بل هو أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع إلى قوله ﴿ليس كمثله شىء﴾ وقال ﴿لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد﴾. وقال المروءة التغافل عن زلل الاخوان. زار أصبهان ومات سنة 297 ﻫ ببغداد وقيل بمكة.
انظر الأعلام وتاريخ بغداد.
34- أصله من بيضاء فارس ونشأ بواسط العراق أو بتستر وانتقل إلى البصرة، وظهر أمره سنة 299 ﻫ. كان من القائلين بالحلول فكفره العلماء وأفتى القاضي أبو عمر المالكي في أيام الخليفة المقتدر بالله بردته ووجوب قتله فقطعت أطرافه ثم قطعت رقبته ثم أحرق ثم ذر رماده في دجلة وكان ذلك سنة 309 ﻫ
انظر سير أعلام النبلاء وتاريخ بغداد والأعلام.
35- قال القشيري في الرسالة القشيرية في باب الشوق ومن المشهور أن عمرو بن عثمان المكي رأى الحسين بن منصور أي الحلاج يكتب شيئًا فقال ما هذا فقال هو ذا أعارض القرءان فدعا عليه وهجره اﻫ
36- وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أن عمرو بن عثمان لم يزل يكتب الكتب إلى نواحٍ يحذّر منه اﻫ
37- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد وأمه عائشة بنت محمد ابن السنوسي التجاني. ولد سنة ١١٥٠ ﻫ في قرية عين ماضي ودفن في فاس سنة ١٢٣٠ ﻫ. جده أحمد بن محمد أول من نـزل عين ماضي وتزوج من تجّان فنسبت ذريته إلى أخوالهم. يصل نسبه إلى مولانا محمد النفس الزكية ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن عليّ بن أبي طالب.
ولمزيد اطلاع على مقالات التجانية الشاذة عليك بكتاب مشتهى الخارف الجاني للشيخ محمد الخضر الشنقيطي جمعه من كلامه بعض طلابه بإشارته.
بيان معاصي البطن
قال المؤلف رحمه الله: فصلٌ
الشرح: أن هذا فصل معقود لبيان معاصي البطن.
قال المؤلف رحمه الله: ومن معاصي البطن أكل الربا والمكس والغصب والسرقة وكل مأخوذ بمعاملة حرّمها الشرع.
الشرح: أن هذا الفصلَ وما بعده من الفصول عُقِدَ لِبَيانِ معاصي الجوارح فكلُّ مال يدخل على الشخص بطريق الربا أكله حرام، والمرادُ بالأكلِ هنا الانتفاعُ به سواءٌ كان أكلاً واصِلاً للبَطْن أو انتِفاعًا باللُبْس أو انتفاعًا بغَير ذلك مِنْ وجوه التّصرّفات بأنواع الانتفاعاتِ. وما كان واصِلاً إلى يدِ الشخص مِنْ طريقِ الرّبا مِن المالِ فهو كبيرةٌ سواءٌ في ذلك الآخِذ والعاملُ في نَحو الكتابةِ لعقُود الرّبا بينَ المتَرابِيَيْن ومثلُهُما الدافعُ لحديثِ: “لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ءاكلَ الرّبا ومُوكِلَهُ وكاتبَهُ وشاهِدَيه” رواه مسلم وفي روايةٍ لأبي داود “وشاهِدَه”، فاللعنُ المذكورُ في الحديثِ شمَلَ الكاتِب إنْ كان يَكتُب بأُجرةٍ أو بغَيرِ أُجرَةٍ، والشاهِدَينِ سَواءٌ كانا بأجرةٍ أو بغَير أُجرة، وقَد مرّ بيانُ أنواعِه.
ومن ذلكَ أكلُ المكْسِ وهو ما يأخذُه السلاطين الظلمة من أموالِ الناس بغير حق على البضَائع والْمَزارع والبسَاتِين وغيرِ ذلك.
ومن ذلك أكل الغصب أي المغصوب، والغَصبُ هو الاستيلاءُ على حقّ الغَير ظُلمًا اعتِمادًا على القُوَّة فخَرجَ ما يؤخَذُ منَ الناسِ بحقّ كالذي يأخذُه الحاكمُ لِسَدّ الضّروراتِ مِنْ أموالِ الأغنياءِ إذا لم يوجَدْ في بيتِ المالِ ما يكفي لذلكَ فإنَّ ذلكَ ليسَ غَصْبًا بل نَصَّ الفقهاءُ على أنّه يجوزُ أن يأخذَ الحاكمُ من أموالِ الأغنياءِ ما تقتضيه الضّروراتُ ولو أدَّى ذلك إلى أنْ لا يتركَ لهم إلا نفَقةَ سَنة، وهذا من جُملةِ النِظام الإسلامِي وأيُّ نِظام أحسَنُ من هذا.
ومن ذلكَ أكلُ السّرقة وهي أخذُ المالِ خُفْيةً ليسَ اعتِمادًا على القُوّةِ. ويلتَحقُ بذلك أكلُ كُلّ مالٍ مأخوذٍ بِمُعاملَة حرَّمها الشّرعُ مما مرَّ بيانُه. وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “إنَّ أناسًا يتخَوَّضُونَ في مالِ الله بغيرِ حقّ فلَهمُ النارُ يومَ القيامة” رواه البخاري من حديثِ خَولة الأنصاريّة عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: وشُربُ الخَمرِ وحدُّ شارِبها أربعونَ جلدةً للحرّ ونصفُها للرقيقِ وللإمامِ الزيادةُ تَعزيرًا.
الشرح: من معاصي البطن شرب الخمرِ وهو من الكبائر وهي كما قال سيدنا عمر: “ما خَامرَ العقلَ” أي غيّرَه رواه عنه البخاري في الصحيح في كتاب الأشربة. وأمّا حَدُّ الخَمْر فهو في الأصل بالنسبةِ لشَارِبها الحرّ أربعونَ جَلدة وللرقيقِ عِشرُون، ثم إذا اقتَضتِ المصلحة الزيادةَ على ذلكَ جازَ إلى الثمانين.
قال المؤلف: ومنها أكلُ كل مسكر.
الشرح: أن من مَعاصِي البَطن أكلَ كلّ مسكر. وليُعلَم أنَّ الإسكارَ هو تغيير العَقل مع الإطرابِ أي مع النّشوةِ والفرَحِ وأمّا ما يغير العقل بلا إطرابٍ وكذلك ما يخدر الحَواسّ من غيرِ تغييرِ العقلِ فلا يُسَمَّى خَمرًا ولكنّه حَرامٌ فالمخدّرَاتُ كالحشيشة والأُفيون ونحوهما ليسَت مسْكِرَةً ولكنّ تحريـمَها يُفهَم من قولِ الله تعالى:{ولا تقتلوا أنفسكم} [سورة النساء] أفهمَتْنا الآيةُ أنَّ كلَّ ما يؤدّي بالإنسان إلى الهلاكِ فهو حرامٌ أن يتعاطاه.
قال المؤلف رحمه الله: وكلّ نَجِسٍ ومُستَقْذَرٍ.
الشرح: أكلُ النّجاساتِ من جُملَةِ مَعاصِي البطن كالدّم الْمَسفوح أي السّائِل ولحمِ الخِنـزير والـمَيْتةِ. وكذلكَ الـمُستَقْذَرُ يَحرمُ أَكلُه وذلكَ كالـمُخاطِ والمنيّ وأمّا البُصَاقُ فيكون مستَقْذَرًا إذا تجمَّع على شىء مثلاً بحيث تنفِرُ منه الطّباعُ السّليمة أي بعد خروجه من الفم أمّا ما دام في الفم فليس له حكم المستقذر وكذلك البلل ليس له حكم المستقذرِ بالنسبة للأكل ونحوه فَلْيُتنَبّه لذلك. والمستقذرُ هو الشىءُ الذي تعَافُه النَّفسُ أي تنفِرُ منه طبيعةُ الإنسان.
قال المؤلف رحمه الله: وأَكلُ مَالِ اليتيمِ أو الأوقافِ على خِلافِ ما شَرطَ الواقِفُ.
الشرح: أن من مَعاصِي البطن أكلَ مالِ اليَتيم بغير حق وهوَ مُحَرَّمٌ بالنص. قال تعالى: {إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنَّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا}.[سورة النساء] فلا يجوز التّصرف بمال اليتيم على خلاف مصلحته.
ومنها أكلُ مالِ الأوقافِ على ما يُخالِفُ شَرْطَ الواقفِ بأنْ لم يَدخُلْ تحتَ شَرطِ الواقِف. فمَن وقَف بيتًا لسكن الفقراء فلا يجوز للأغنياء أن يَسكنوه ومن وقف بيتًا لسكنِ طلبة الحديث فلا يجوز لغيرهم أن يسكنوه ومن وقف بيتًا لسكنِ حَفَظَةِ القرءانِ فلا يجوز لغيرهم أن يَسكنوه.
قال المؤلف رحمه الله: والْمَأخُوذِ بوَجْهِ الاستِحياءِ بغَيرِ طِيْبِ نَفْسٍ منهُ.
الشرح: مِنْ جُملَةِ معاصي البطن أكلُ ما يُؤخَذُ هبةً مِنَ الغَيرِ بغَير طِيبِ نفسٍ منه كأن يكونَ أعطاه استِحياءً منه أو استحياء مـمَّن يَحضُر ذلك المجلسَ وذلك لأنه يَدخُلُ تحتَ حديثِ: “لا يحِلُ مالُ امرِئ مُسلِم إلا بطِيب نفسٍ منه” رواه الدارقطني والبيهقي فالذي يأخذُ شيئًا من مسلم بطريق الحياء حرامٌ عليه أن يأكلَه ولا يدخلُ في مِلْكِه ويجبُ عليه أن يرُدَّه.
بيان معاصي العين
الشرح: أن هذا فصل معقود لبيان معاصي العين.
قال المؤلف رحمه الله: ومِنْ مَعاصِي العَينِ النَّظرُ إلى النّساءِ الأجنبيّاتِ بشَهْوةٍ إلى الوَجهِ والكفّينِ، وكذا نَظَرُهُنَّ إليهمْ إنْ كانَ إلى ما بينَ السُرَّةِ والرُكبَةِ ونَظرُ العَوراتِ
الشرح: أن هذا الفَصْلَ مَعقُودٌ لبَيانِ مَعاصِي العَينِ. وأورد فيه حكم النّظر إلى النّساءِ الأجنبياتِ فالنظرُ إلى وجه المرأةِ الأجنبيّة وكفّيها بشَهوة حَرام بخلاف النظَر إلى ما سِوى الوجهِ والكفينِ فإنه يَحرمُ ولو بلا شَهوةٍ أو خَوفِ فِتنةٍ فإنْ نظَر بلا قَصدٍ بأن وقعَ بصَرُه على عورتها فيجب عليه صرفه أو مع القَصدِ إلى الوجه والكفينِ بلا شَهوةٍ ثم شعَر من نفسِه التّلَذُّذَ وجَبَ عليه صَرفُ نظَره أيضًا فالنظرةُ الأُولى لا مؤاخذةَ فيها. رَوى التّرمذِيّ وأبو داودَ من حديثِ بُرَيْدَةَ مرفوعًا:”يا عليُّ لا تُتْبِعِ النّظرةَ النّظرةَ فإِنَّ لك الأُولى وليسَتْ لكَ الثّانيةُ”. ونقَلَ بعضُ الفُقهاء الإجماعَ على جَوازِ النظر بلا شهوة إلى الوجه والكفين.
ومن جملة معاصي العين النظر إلى العورات ولو مع اتحاد الجنس وهو على الرجل نظر ما بين السرة والركبة من الرجل، وعلى المرأة النظر إلى ما بين السرة والركبة من المرأة.
قال المؤلف رحمه الله: ويَحرمُ على الرَّجُلِ والْمَرأَةِ كَشْفُ السَّوأَتينِ في الخَلْوةِ لِغَيرِ حَاجةٍ. الشرح: أنّ مُقتضى ذلكَ جَوازُ كَشْفِهما في الخَلْوة لأية حَاجَةٍ كَتبرُّدٍ. وعورة الرجل في الخلوة السوأتان والمرأةِ ما بين السرة والركبة. قال المؤلف رحمه الله: وحَلَّ مع المَحْرمِيّةِ أو الجِنْسِيَّةِ نَظرُ ما عَدا ما بَينَ السُّرةِ والرّكبةِ إذا كانَ بغَيرِ شَهْوةٍ.
الشرح: أنَّ مقدارَ عَورةِ الْمَرأة مع مَحارِمها ما بينَ السُّرّة والركبةِ.
وكذلكَ العَورةُ مع اتّحادِ الجِنسِ أي عورةُ المرأةِ معَ المرأةِ هذا القَدْرُ من بدَنِها هذا إذا كانت مسلمة وأما أمام الكافرة فلا يجوز للمسلمة أن تكشِف من جسَدِها إلا ما تكشِفُهُ عند العمل عادةً كالرأسِ والسّاعدِ والعنُق ونصف الساق. وكذلك عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة. ويحِلُ النّظر بلا شهوة لما سِوَى العورة.
قال المؤلف رحمه الله: ويَحرمُ النّظرُ بالاستِحقارِ إلَى الْمُسلمِ.
الشرح: مِنْ محرّمات العَين النّظَرُ إلى المسلم بالاستحقارِ والازدراءِ إمّا لفَقْره أو لكونه ضعيفَ الجِسْم أو نحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: والنَّظرُ في بَيتِ الغَيرِ بغَيرِ إذْنِهِ أو شَىءٍ أخْفاهُ كذلكَ.
الشرح: أنَّه يَحرُم النّظَرُ في بيتِ الغير بغَير إذْنه أي مِما يَكْرَه عادةً ويتأذَّى به مَنْ في البَيت، وذلكَ كالنّظر في نَحوِ شَقّ الباب أو ثُقْبٍ فيه إلى من في البيتِ أو ما يَحتَوِي عليه البَيتُ مِما يتأذّى صاحبُ البَيتِ بالنظر إليه كأنْ يكونَ صاحبُ الدار مكشوفَ العَورةِ أو بها مَحْرَمُه كبنتِهِ أو نحوها كزوجته. وكذلكَ النَّظر إلى شىء أخفاه الغَيرُ مما يتأذَّى بالنظر إليه.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة