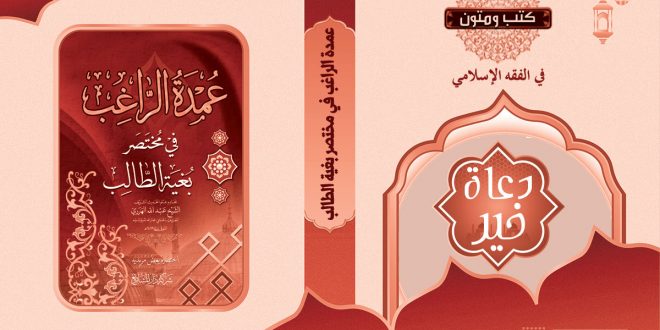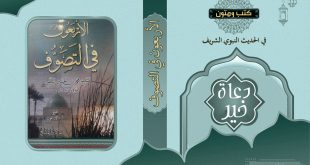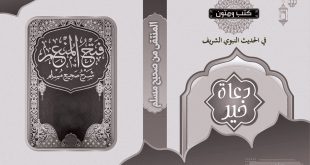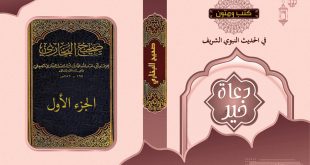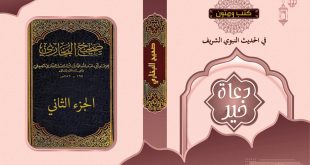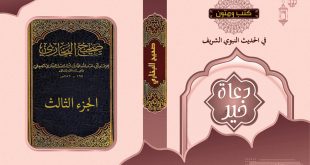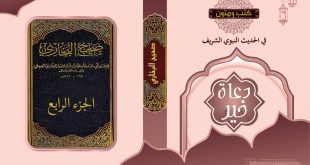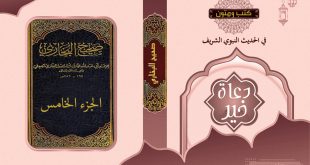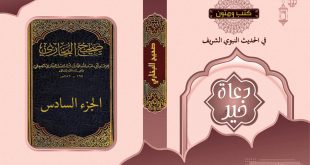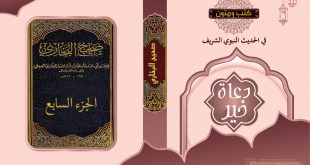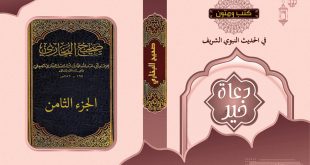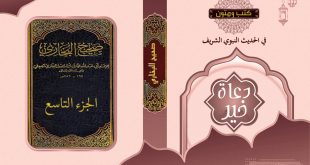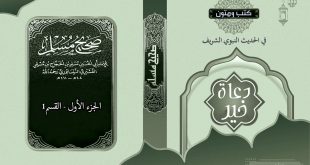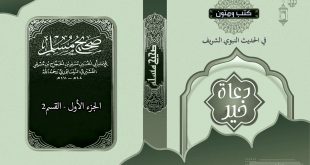فصل معقود لبيان معاصي القلب
قال المؤلف رحمه الله (فصل)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان معاصي القلب.
قال المؤلف رحمه الله (ومنْ معاصِي القلبِ الرياءُ بأعمالِ البِرّ أي الحسنات وهُوَ العملُ لأجلِ الناسِ أي ليمدحُوهُ ويُحبطُ ثوابَها وهو من الكبائر)
الشرح أن في هذه الجملة بيانَ معصيةٍ مِنْ معاصِي القَلب وهي الرياءُ وهو من الكبائر وهو أن يقصِدَ الإنسانُ بأعمالِ البِرّ كالصّوم والصلاةِ وقراءةِ القرءانِ والحجّ والزكاةِ والصّدقَات والإِحسانِ إلى الناس مَدْحَ الناسِ وإجلالَهُم له فإذا زادَ على ذلكَ قَصْدَ مَبرَّةِ الناسِ له بالهَدايا والعَطايا كانَ أسوأَ حالاً لأنّ ذلك مِن أكلِ أموالِ الناسِ بالبَاطلِ. والرِياءُ يُحبِطُ ثَوابَ العَملِ الذي قَارنَه فإنْ رجَع عن ريائه وتابَ أثناءَ العَملِ فما فَعلَه بعد التّوبةِ منه له ثوابُهُ، فأيُّ عَمل مِنْ أعمالِ البِرّ دخَلَه الرِياءُ فلا ثوابَ فيه سَواءٌ كان جرَّدَ قَصدَه للرياءِ أو قرَنَ به قَصْدَ طلبِ الأَجْرِ منَ الله تعالى فلا يجتَمِعُ فى العمل الثوابُ والرياءُ لحديثِ أبي داود والنسائي بالإِسناد إلى أبي أُمامةَ قالَ جاءَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ الله أرأيتَ رجلاً غزا يلتمِسُ الأجرَ والذِكر ما لهُ، قال «لا شىءَ له» فأعادها ثلاثًا كلَّ ذلك يقولُ «لا شىءَ له» ثم قالَ لَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم «إِنَّ الله لا يقبَلُ منَ العَملِ إلا ما كان خالِصًا له وما ابتُغِيَ به وجْهُه» وَجَوَّدَ الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح.
قال المؤلف رحمه الله (والعُجْبُ بطَاعةِ الله وهو شُهودُ العِبادةِ صَادِرةً منَ النّفسِ غائبًا عَنِ المِنَّةِ)
الشرح من مَعاصِي القَلْبِ التي هي من الكبائر أن يَشْهَد العبدُ عبادتَه ومَحاسِنَ أعْمالِهِ صَادِرةً من نفسه غائبًا عن شهود أنها نعمة من الله عليه أي غافلاً عن تَذَكُّرِ أنَّها نِعمةٌ منَ الله علَيه أي أنّ الله هو الذي تفضَّلَ عليه بها فأقدَره عليها وألهمَه فيَرى ذلكَ مزِيّةً لهُ1.
قال المؤلف رحمه الله( والشّكُّ في الله)
الشرح أن مِنْ معَاصِي القَلْب الشكَّ في الله أي في وجودِه أو قُدرَتهِ أو وَحْدانيته أو حكمتِه أو عَدلِه أو في عِلْمِه أو في صفة أخرى من الصفات الثلاث عشرة فالشكُ هنا يضرُّ ولو كان مجرّدَ تردُّد ما لم يكن خاطِرًا يَرِدُ على القَلْب بلا إرادةٍ. قال الله تعالى ﴿إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾2 دلَّت الآيةُ على أنَّ مَنْ شكَّ في وجودِ الله أو قُدرتِه أو نحوِ ذلك ليسَ بمؤمن وأنَّ الإيمانَ لا يَحصُل إلا بالجَزْمِ وأنّ التردّد ينافيه.
قال المؤلف رحمه الله (والأَمنُ مِنْ مَكْرِ الله والقُنُوطُ مِن رَحْمَةِ الله)
الشرح أن مِن المَعاصِي القَلبيّةِ الأمنَ مِن مَكرِ الله والقُنوطَ مِن رَحمةِ الله أمَّا الأَمنُ من مَكرِ الله فمعناه الاستِرسالُ في المَعاصِي معَ الاتّكالِ على الرَّحمة فهذا مِنَ المعَاصِي الكَبائرِ مِمّا لا يَنقُلُ عن المِلّةِ وأمّا القُنوطُ مِنْ رَحمةِ الله فهو أنْ يُسِيءَ العبدُ الظنَّ بالله فيعتَقِدَ أنّ الله لا يغفِرُ لهُ ألبتّةَ وأنَّه لا مَحالةَ يُعذّبهُ وذلك نَظرًا لكَثْرةِ ذنُوبه مثلاً فهو بهذا المعنى كبيرةٌ منَ الكَبائرِ لا يَنقُل عن الإسلام.وطريقُ النجاة الذي ينبغي أن يكونَ عليه المؤمن أن يكون خائفًا راجيًا يخافُ عقابَ الله على ذنوبه ويرجُو رحمةَ الله
أمّا عند الموتِ فيُغلّبُ الرجاءَ على الخوف3.
قال المؤلف رحمه الله (والتّكبُّرُ على عِبادِهِ وهُوَ رَدُّ الحقّ على قائِلِهِ واستِحقارُ الناسِ)
الشرح أن مِنْ معَاصي القلبِ التي هي من الكبائر التّكَبُّرَ على عبادِ الله وهو نوعان أولهما ردُّ الحقّ على قائِله مع العِلم بأنّ الصوابَ مع القائلِ لنَحْوِ كونِ القائلِ صغيرَ السنّ فيستعظِمُ أن يَرجِعَ إلى الحقّ مِن أجلِ أنّ قائلَه صغيرُ السّنِ وثانيهما استحقارُ الناسِ أي ازدِراؤُهُم كأن يتكبَّر على الفقيرِ وينظرَ إليه نظَرَ احتِقار أو يُعرِض عنه أو يترفَّعَ عليه في الخِطابِ لكونه أقل منه مالاً4. وقد نهى الله تعالى عبادَه عن التكبّر قال الله تعالى ﴿وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾5 أي ولا تُعرض عنهم متكبرًا6 والمعنى أقبل على الناس بوجهك متواضعًا ولا تُوَلّهم شِقَّ وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا﴾7 أي لا تمشِ مِشْيَةَ الكِبْرِ والفَخْرِ8.
قال المؤلف رحمه الله (والحِقدُ وهو إضمارُ العداوةِ إذا عَمِلَ بمقتَضاهُ ولمْ يَكْرَهْهُ)
الشرح أن مِنْ معَاصِي القلب الحِقدَ وهو مَصدَرُ حَقَدَ يَحْقِدُ وهو إضْمارُ العَداوةِ للمُسْلمِ معَ العَملِ بمقتَضاهُ تصميمًا أو قولاً أو فعلاً فإذا لم يعمل بمقتضى ذلك لا يكون معصية. وينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ففي الصَّحِيح «مَنْ أحبَّ أن يُزَحزَحَ عنِ النارِ وَيُدخَلَ الجَنَّةَ فلْتأتهِ مَنِيَّتُه وهو يؤمنُ بالله واليَوم الآخِر وليأتِ الناسَ بما يُحبُ أن يؤتَى إليه» رواه مسلم9 والبيهقي10 وغيرهما.
قال المؤلف رحمه الله (والحَسَدُ وهُوَ كَراهِيةُ النّعمَةِ للمُسْلمِ واستِثقالُها وعَمَلٌ بمقتضاه)
الشرح أن من معاصِي القلب الحَسدَ. قال الله تعالى ﴿ومن شر حاسد إذا حسد﴾11 أي أستجير بالله من شر الحاسد إذا أظهره أما إذا لم يُظْهِر الحسدَ فلا يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره. والحسد هو أن يكره الشّخصُ النّعمةَ التي أنعم الله بها على المسلم دينيّةً كانت أو دنيويّةً ويتمنى زوالَها ويستثقلها له، وإنما يكونُ معصَيةً إذا عمل بمقتضاه تصميمًا أو قولاً أو فعلاً أما إذا لم يقترن به العمل فليس فيه معصيةٌ12.
قال المؤلف رحمه الله (والمَنُّ بالصدقةِ ويُبطِلُ ثوابَهَا كأن يقول لمن تصدق عليه ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا)
الشرح مِنْ مَعاصِي القلب التي هي منَ الكبائر المنُّ بالصَّدقة وهو أن يُعدّدَ نِعمتَه على ءاخذها كأن يقولَ لهُ ألم أفْعَلْ لك كذا وكذا حتى يكسِرَ قلبَه أو يَذكرَها لِمَنْ لا يُحِبُّ الآخِذُ اطّلاعَه عليها وهو يُحبِطُ الثّوابَ ويُبطِلُهُ قالَ الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾13. وإنّما عدَّها من مَعاصي القَلْب لأنّ المَنّ يكون أصْلاً في القلبِ لأنّ المَانَّ يقصِدُ إيذاءَ الشّخصِ فيتفَرَّعُ من ذلكَ العمَلُ البَدنيُّ وهو ذِكرُ إنْعامِه على الشّخصِ بلِسَانهِ.
قال المؤلف رحمه الله (والإصْرارُ علَى الذنبِ)
الشرح أن مِن المعَاصِي القَلبيّة الإصرارَ على الذَّنب وعُدَّ هذا مِنْ معاصي القلبِ لأنه يَقتَرنُ به قصْدُ النّفسِ مُعاوَدَةَ ذلكَ الذّنبِ وعَقْدُ القَلْبِ على ذلكَ ثم يَستَتبعُ ذلكَ العملَ بالجَوارح. والإصرارُ الذي هو مَعدودٌ منَ الكبائر هو أن تغلِبَ مَعاصِيه طاعاته فيصير عدد معاصيه أكبرَ من عدد طاعاته أي بالنسبة لما مَضَى وليسَ بالنسبة ليومِه فقط فيصير بذلك واقعًا في هذه الكبيرة. وأمّا مُجَرّدُ تكرارِ الذّنب الذي هو منْ نَوع الصّغائِر والمُداوَمَةِ علَيه فليسَ بكَبِيرة إذا لم يَغلبْ ذلكَ الذنبُ طاعاتهِ.
قال المؤلف رحمه الله (وسوءُ الظنِّ بالله وبِعبادِ الله)
الشرح مِنْ معاصي القلبِ سوءُ الظنِ بالله وهو أن يَظنَ بربّه أنَّه لا يَرحمهُ بل يعذّبُه، وسوء الظن بعباد الله وهو أن يَظُنَّ بعبادِهِ السّوءَ بغيرِ قَرينةٍ معتبرةٍ قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ﴾14 15 قال الزجّاج هو ظنك بأهل الخير سوءًا فأما أهل الفسق فلنا أن نظن فيهم مثلَ الذي ظهر منهم اﻫ والإثم المذكور في الآية الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب. وقد روى البخاري16 ومسلم17 من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إياكمْ والظنَّ فإن الظنَّ أكذبُ الحديث» فالظن الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الظن بلا قرينة معتبرة18.
قال المؤلف رحمه الله (والتّكذِيبُ بالقَدرِ)
الشرح أن مِنْ معَاصِي القَلْب التكذيبَ بالقَدر وهو كفرٌ وذلكَ بأنْ يعتقدَ العَبدُ أنّ شيئًا منَ الجَائزاتِ العَقليّةِ يَحصُل بغَير تقدِيرِ الله قال الله تعالى ﴿إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾19. وقَد فُسِّر القَدرُ بالتّدبير، ومعناهُ أنّ الله دبّر في الأزلِ الأشياءَ فإذا وقَعت تكونُ على حسَب تقديرهِ الأزليّ20.
قال المؤلف رحمه الله (والفَرحُ بالمعصيةِ مِنهُ أَوْ مِنْ غيرِهِ)
الشرح أن مِنْ مَعاصِي القَلب الفَرحَ بالمعصيةِ الصّادرةِ منه أو مِنْ غيرِه فمَن علِمَ بمعصيةٍ حصَلت مِنْ غيرِه ولو لَم يشهدها ولو في مكانٍ بَعيد ففرح بذلك فقد عصَى الله، وأما الفرَحُ بكفر الغير فهو كفرٌ.
قال المؤلف رحمه الله (والغَدرُ ولو بكافرٍ كأنْ يؤمّنَهُ ثُمَّ يقتلَهُ)
الشرح أنّ الغَدرَ منَ المعَاصي المُحرَّمة وهو مِنْ قِسْم الكَبائر وذلكَ كأن يقولَ لشخصٍ أنت في حِمايتي ثم يَفْتِكَ به هو أو يدلَّ عليه مَنْ يفتِكُ به.
ومن الغَدْر المُحرَّم الذي هو من الكبائر أن يغدِر بالإِمام بعدَ أن يُبايعَه بأن يعودَ مُحاربًا له أو يعلنَ تَمرُّدَه على طاعَتِه أي بعد حصول الإمامة له شرعًا أي بعد أن يصير خليفة وذلكَ متّفقٌ على حُرمَتِه إن كان ذلك الإمامُ راشدًا21.
وأمّا الغَدْرُ بالكَافِر فهو أنَّه إذا أمَّن الكافرَ الإِمامُ أو غيرُهُ منَ المسلمينَ بأن قيلَ له لا بأسَ عليكَ أو أنتَ ءامنٌ فيَحرُم الغدرُ به بالقَتل أو نحوِه قال الله تعالى ﴿وإن أحدٌ من المشركينَ اسْتجارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كلامَ الله﴾ الآيةَ22 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أمَّن رجلاً على دمه ثم قتله فأنا بريءٌ منه23 ولو كان المقتولُ كافرًا» رواه ابن حبان24.
ومن الغَدْر المُحرَّم أن يعامِلَ المسلمُ الكافرَ بالبَيع والشِراء فيَخُونَه في الوَزن أو الكَيل وأنْ يُضَيّعَ ودِيْعَةً استَودعَه إيّاها الكافرُ فيُتلِفَها أو يَجْحَدها وأنْ يشتَرِيَ منه شيئًا بثَمنٍ مؤجَّلٍ ثم يَجْحَدَه.
قال المؤلف رحمه الله (والمكرُ)
الشرح أن مِنْ معاصي القَلبِ المَكْرَ، والمكرُ والخَدِيعَةُ بمعنًى واحدٍ وهوَ إيقاعُ الضّرر بالمسلم بطَريقة خفِية. روى الحاكم في المستدرك25 حديث «المَكْرُ والخديعة في النّار» فمَنْ مكَر بأحَدٍ منَ المسلمينَ فقد وقعَ في كبيرة.
قال المؤلف رحمه الله (وبُغْضُ الصّحابةِ والآلِ والصَّالحينَ)
الشرح أن مِنْ مَعاصِي القَلْب بُغضَ أَصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم. والصحابي هو من لقيه في حياتِهِ صلى الله عليه وسلَّم مع الإيمانِ به سَواءٌ طالت صحبته له صلى الله عليه وسلَّم أو لم تَطل ومات على ذلك ولو تخلّلت بينَ صُحبته له وبين موته على الإسلامِ ردّة. والذي يُبْغِضُ كلَّ الصحابة يكفر. وأمّا الآلُ فالمرادُ بهم هنا أقرباؤه صلى الله عليه وسلَّم المؤمنونَ وأزواجُه. وأمَّا الصّالحونَ فالمُرادُ بهمُ الأتقياءُ الذين أدَّوْا الواجبات واجتنبوا المحرمات.
قال المؤلف رحمه الله (والبُخْلُ بما أَوجَبَ اللهُ والشُّحُّ والحِرصُ)
الشرح أنّ مِن معاصِي القلب البخلَ بما أوجبَ الله تعالى كالبُخل عن أداءِ الزكاةِ للمستحِقّين والبُخل عن دفع نفقةِ الزّوجة الواجبة والأطفالِ والبخلِ عن نفقة الأبوين المحتَاجين والبخلِ عن مُواساةِ القريب مع حاجتِه. ويُرادِفُه الشُّحُّ وهوَ بمعناه إلا أنّ الشُّحّ يُخَصُّ بالبُخْلِ الشّديدِ26. وقَرِيبٌ مِنْ ذلكَ الحِرصُ لأنّ الحِرْص هو شِدَّةُ تعلُّقِ النّفس لاحتِواء المالِ وجمعِه على الوَجه المذموم كالتّوصُّلِ به إلى التّرفّعِ على الناسِ والتّفاخرِ وعدَمِ بذلهِ إلا في هَوى النّفْسِ.
قال المؤلف رحمه الله (والاستِهانةُ بما عظَّمَ الله والتصغيرُ لِمَا عظَّمَ الله مِنْ طاعةٍ وكذلك الاستهانة بمعصيةٍ أو قُرءانٍ أو علْمٍ أو جنّةٍ أو نارٍ)
الشرح أن مِن معاصِي القلب قِلَّةَ المبالاةِ بما عَظَّمَ الله تعالى مِنَ الأُمور كأَنْ يحتقرَ الجنّةَ كقولِ بعضِ الدَجاجِلَةِ المُتصَوّفة “الجنّةُ لُعبَةُ الصِّبيانِ” وقولِ بَعضِهِم “الجَنّة خَشْخاشَة الصِبيان” وهذا حكمُه الرِدّةُ. ومنْ ذلك قولُ بعضِهم “جَهنَّمُ مستشفى” أي محَلُّ طِبابة وعِلاج وتَنظِيف ليسَت محَلَّ عِقابٍ وتَعذِيبٍ وذلكَ إلحَادٌ وكفرٌ، وهذا قول جماعة أمين شيخو الدمشقي الذين زعيمهم اليوم عبد الهادي الباني فعلى زعمهم التعذيب لا يجوز وصف الله به ويقولون عن الآية ﴿شديدِ العقاب﴾27 معناه شديد التعقب، ويقولون إن الأنبياءَ لم يُقتل أحد منهم ويزعُمون أن قول الله تعالى ﴿وقَتْلِهِمُ الأنبياءَ﴾28 معناه “قَتْلُ الكفارِ دعوتَهُمْ” ويقولون “الأنبياء لا يصابون بجروح بسلاح الكفار” وينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رَبَاعِيَتُهُ وشُجَّ وجهه29، ويقولون “الله شاء السعادة لجميع خلقه” وهذا قول المعتزلةِ لا أهلِ السنة ويقولون “علم الدين يؤخذ من قلوب مشايخهم النقشبنديين30 من قلب إلى قلب وليس من الكتب31” فهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم ومن أمثالهم.
ولا يجوز أن يقال عن معصية من المعاصي كبيرةً أو صغيرةً “معليش” وهي في اللغة العامية معناها لا بأس بذلك فمن قال عن معصية وهو يعلم أنها معصية هذه الكلمة بمعنى لا بأس فهو مكذب للدين فيكون مرتدًا.
ومنْ جملة المَعاصي القَلبيّة الاستهانةُ بشىء منَ القرءان أو بشىء منْ علم الشّرع أي عِلم الدّين أو بالجنّةِ أو النارِ وقد ذكَرْنا بعضَ الأمثِلة للاستهانةِ بالجَنّة والنارِ، وأمّا الاستهانةُ بالقرءانِ فكمثل ما رواه الإمام عبد الكريم القشيري32 في الرسالة أن عَمْرَو بنَ عثمانَ33 المكيَّ صوفيَّ مكةَ في عصره رأى الحلاج الحسين بن منصور34 يكتب شيئًا فقال له ما هذا فقال هذا شىء أعارض به القرءان فمقته35 بعد أن كان يُحَسّنُ به الظن وصار يلعنه ويحذر منه حتى بعد أن غادر الحلاج مكة فإنه كان يكتب في التحذير منه إلى الناحية التي يَحُلُّ بها الحلاج36، وكالذي حصل مِن بعض التّجَّانيّة في الحبشةِ من إظهارِ الاستغناءِ بصلاةِ الفاتح عن القرءانِ حتى قال قائلُهم بكلامِهم ما معناه ما لَكُم تحمِلُون هذا الرغيفَ الثّقيلَ يعني القرءانَ ونحنُ بغُنْيةٍ عنه بصلاةِ الفاتحِ، وصلاةُ الفاتح هي كلمةٌ وجِيزةٌ وهيَ هذهِ الصيغةُ “اللّهمَّ صَلِّ على سيّدِنا محمدٍ الفاتِحِ لِما أُغلِقَ الخاتِم لِما سَبَقَ ناصِر الحَقّ بالحقّ والهادِي إلى صِراطِك المستقيمِ وعلى ءالهِ وصحبِه حقَّ قدرِهِ ومِقدارِهِ العظيم” وهي في الأصل مِن تأليفِ الشيخ مصطفى البَكريّ الصُوفيِ ثم استَعملَها كثيرٌ من التّجانيّة واعتبر قسم منهم المرَّة الواحِدَة منها تعدِلُ سِتّةَ ءالافِ خَتْمَةٍ منَ القرءان وادّعَوْا أنَّ ذلك مِما شافَهَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم يقظةً الشيخَ أبا العباسِ التّجّانيَّ37 الذي تنتَسِبُ إليه التّجانيّةُ، على أنّنا لا نجزِم بأن الشيخَ أبا العبّاس هو القائلُ لِما يَدَّعونه لاحتمال أن يكونوا قد كذبوا عليه.
————-
1- اﻫ قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عند ذكر الكبر والعجب والخيلاء فعُلم أن العجب إنما يكون بوصف هو كمال في حد ذاته لكنه ما دام خائفًا من سلبه من أصله فهو غير معجب به وكذا لو فرح به من حيث إنه نعمة من الله تعالى أنعم بها عليه بخلاف ما إذا فرح به من حيث إنه كمال متصف به مع قطع نظره عن نسبته إلى الله تعالى فإن هذا هو العُجْبُ فهو استعظام النعمة والرُكون إليها مع نسيان إضافتها إلى الله تعالى اﻫ وقال مثله الغزالي في إحياء علوم الدين.
2- [سورة الحجرات/ الآية 15].
3- قال الحافظ ابن حجر في الفتح وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته ويؤيده حديث «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» اﻫ
4- روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنه كان في وصية نوح لابنه يا بنيّ أوصيك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين أوصيك بشهادة أن لا إله إلا الله فإنها لو كانت السموات والأرض في كفة وهي في كفة لوزنتها وأوصيك بالتسبيح فإنها عبادة الخلق وبالتكبير وأنهى عن خصلتين عن الكبر والخيلاء قيل يا رسول الله أمن الكبر أن أركب الدابة النجيبة وألبس الثوب الحسن قال لا قيل فما الكبر قال أن تسفه الحق وتغمص الناس اﻫ قال الحافظ الهيثمي رواه كلّه أحمد ورواه الطبراني بنحوه ورواه البزّار من حديث ابن عمرو ورجال أحمد ثقات اﻫ وفي الأدب المفرد للبخاري في باب الكبر عن عبد الله بن عمرو أنه قال كنا جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديثَ إلى أن قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال «لا» قال فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان قال «لا» قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها قال «لا» قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال «لا» قال يا رسول الله فما الكبر قال «سفه الحق وغمص الناس» اﻫ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة قال «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس». ذكره في باب تحريم الكبر وبيانه. قال النووي في شرح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم «وغمط الناس» هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة هكذا هو في نسخ صحيح مسلم رحمه الله قال القاضي عياض رحمه الله لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بطاء قال وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره «غمص» بالصاد وهما بمعنى واحد ومعناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه بفتح الميم يغمطه بكسرها وغمطه بكسر الميم يغمطه بفتحها أما بطر الحق فهو دفعه وانكاره ترفعًا وتجبرًا اﻫ
5- [سورة لقمان/ الآية 18].
6- قال الطبري في تفسير هذه الآية وتأويل الكلام ولا تعرض بوجهك عمن كلمته تكبرًا واستحقارًا لمن تكلمه اﻫ
7- [سورة لقمان/ الآية 18].
8- قال الطبري في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تمـشِ في الأرض مختالاً مستكبرًا اﻫ
9- صحيح مسلم، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء.
10- سنن البيهقي، باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج.
11- [سورة الفلق/ الآية ٥].
12- قال ابن حجر في الفتح الحسد تمني زوال النعمة عن المنعَم عليه ثم قال وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل اﻫ
13- [سورة البقرة/ الآية 264].
14- [سورة الحجرات/ الآية 12].
15- قال الرازي في تفسيره فقوله ﴿اجتنبوا كثيرًا﴾ وقوله تعالى ﴿إن بعض الظن إثم﴾ إشارة إلى الأخذ بالأحوط كما أن الطريق المخوفة لا يتفق كل مرة فيه قاطع طريق لكنك لا تسلكه لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فتسلكه مع رفقة كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ اﻫ
16- صحيح البخاري، باب لا يخطب على خطية أخيه حتى ينكح أو يدع.
17- صحيح مسلم، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها.
18- قال القرطبي في الجامع لأحكام القرءان قال علماؤنا فالظن هنا وفي الآية هو التهمة ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ثم قال وإن شئت قلت والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر فظنُّ الفساد به والخيانة محرم بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث اﻫ وقال أبو حيان في البحر المحيط ﴿اجتنبوا كثيرًا من الظن﴾ أي لا تعملوا على حسبه، وأمر تعالى باجتنابه لئلا يجترئ أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه وباطله. والمأمور باجتنابه هو بعض الظن المحكوم عليه بأنه إثم وتمييز المجتنَب من غيره أنه لا يعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كمن يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث كالدخول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة نساء المغاني وإدمان النظر إلى المرد فمثل هذا يقوي الظن فيه أنه ليس من أهل الصلاح ولا إثم فيه وإن كنّا لا نراه يشرب الخمر ولا يزني ولا يعبث بالشبان بخلاف من ظاهره الصلاح فلا يظن به السوء فهذا هو المنهي عنه ويجب أن يزيله. والإثم الذنـب الذي يستحق صاحبه العقـاب اﻫ
19- [سورة القمر/ الآية 49].
20- قال الحنفية «أو قال المظلوم هذا بتقدير الله تعالى فقال الظالم أنا أفعل بغير تقدير الله تعالى كفر» اﻫ نقله عنهم النووي في الروضة وأقره.
21- وقد روى مسلم في الصحيح في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من كره من أميره شيئًا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» اﻫ
22- [سورة التوبة/ الآية6].
23- وفي هذا بيان أن هذا الذنب من الكبائر وليس المراد أنه يخرج من الدين.
24- صحيح ابن حبان، ذكر الزجر عن قتل المرء من أمنه على دمه.
25- المستدرك على الصحيحين.
26- قال النووي في شرح مسلم باب تحريم الظلم قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع اﻫ
27- [سورة غافر/ الآية ٢].
28- [سورة ءال عمران/ الآية ١٨١].
29- وقد روى البخاري في صحيحه باب اللهو بالحراب ونحوها عن سهل قال «لما كُسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأُدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقأ الدم» اﻫ
30- الطريقة النقشبندية طريقة مستقيمة في أصلها من طرق أهل الله لكن قسمٌ من المنتسبين إليها شذوا كجماعة أمين شيخو.
31- قال الشيخ أبو الهدى الصيادي في كتابه مراحل السالكين “كما قال كثير من الوجودية كُمَّلُ الأولياء يأخذون العلم من المعدن الذي أخذ منه الأنبياء والرسل من ذلك المعدن فالعلم الذي أخذ بواسطة الرواة والأسانيد ليس بعلم وهذا هو الضلال البعيد والعصيان الذي ما عليه من مزيد” اﻫ
32- أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن أبو الأسعد القشيري النيسابوري خطيب نيسابور وكبير القشيرية في وقته. كان أسند من بقي بخراسان وأعلاهم رواية. حدث عن أبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف وأبي بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي وأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم في ءاخرين. صنف كتبًا في علوم الصوفية. روى عنه ابن عساكر وابن السمعاني وءاخرون وكانت الرحلة إليه. قال أبو سعد السمعاني ولد في ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاثمائة وتوفي في سادس عشر ربيع الآخر من سنة خمس وستين وأربعمائة بنيسابور.
انظر الأعلام والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد.
33- عمرو بن عثمان بن كرب أبو عبد الله المكي صوفيٌّ عالمٌ بالأصول من أهل مكة. له مصنفات في التصوف وأجوبة لطيفة في العبارات والاشارات. قال أبو نعيم معدود في الأولياء أحكم الأصول وأخلص في الوصول. من أقواله ثلاثة أشياء من صفات الأولياء الرجوع إلى الله في كل شىء والفقر إلى الله في كل شىء والثقة به في كل شىء وقال عمرو اعلم أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرتك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو أنس اوضياء أو جمال أو شبح أو نور أو شخص أو خيال فالله بعيد من ذلك كله بل هو أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع إلى قوله ﴿ليس كمثله شىء﴾ وقال ﴿لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد﴾. وقال المروءة التغافل عن زلل الاخوان. زار أصبهان ومات سنة 297 ﻫ ببغداد وقيل بمكة.
انظر الأعلام وتاريخ بغداد.
34- أصله من بيضاء فارس ونشأ بواسط العراق أو بتستر وانتقل إلى البصرة، وظهر أمره سنة 299 ﻫ. كان من القائلين بالحلول فكفره العلماء وأفتى القاضي أبو عمر المالكي في أيام الخليفة المقتدر بالله بردته ووجوب قتله فقطعت أطرافه ثم قطعت رقبته ثم أحرق ثم ذر رماده في دجلة وكان ذلك سنة 309 ﻫ
انظر سير أعلام النبلاء وتاريخ بغداد والأعلام.
35- قال القشيري في الرسالة القشيرية في باب الشوق ومن المشهور أن عمرو بن عثمان المكي رأى الحسين بن منصور أي الحلاج يكتب شيئًا فقال ما هذا فقال هو ذا أعارض القرءان فدعا عليه وهجره اﻫ
36- وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أن عمرو بن عثمان لم يزل يكتب الكتب إلى نواحٍ يحذّر منه اﻫ
37- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد وأمه عائشة بنت محمد ابن السنوسي التجاني. ولد سنة ١١٥٠ ﻫ في قرية عين ماضي ودفن في فاس سنة ١٢٣٠ ﻫ. جده أحمد بن محمد أول من نـزل عين ماضي وتزوج من تجّان فنسبت ذريته إلى أخوالهم. يصل نسبه إلى مولانا محمد النفس الزكية ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن عليّ بن أبي طالب.
ولمزيد اطلاع على مقالات التجانية الشاذة عليك بكتاب مشتهى الخارف الجاني للشيخ محمد الخضر الشنقيطي جمعه من كلامه بعض طلابه بإشارته.
فصل معقود لبيان معاصي البطن
قال المؤلف رحمه الله: فصلٌ
الشرح: أن هذا فصل معقود لبيان معاصي البطن.
قال المؤلف رحمه الله: ومن معاصي البطن أكل الربا والمكس والغصب والسرقة وكل مأخوذ بمعاملة حرّمها الشرع.
الشرح: أن هذا الفصلَ وما بعده من الفصول عُقِدَ لِبَيانِ معاصي الجوارح فكلُّ مال يدخل على الشخص بطريق الربا أكله حرام، والمرادُ بالأكلِ هنا الانتفاعُ به سواءٌ كان أكلاً واصِلاً للبَطْن أو انتِفاعًا باللُبْس أو انتفاعًا بغَير ذلك مِنْ وجوه التّصرّفات بأنواع الانتفاعاتِ. وما كان واصِلاً إلى يدِ الشخص مِنْ طريقِ الرّبا مِن المالِ فهو كبيرةٌ سواءٌ في ذلك الآخِذ والعاملُ في نَحو الكتابةِ لعقُود الرّبا بينَ المتَرابِيَيْن ومثلُهُما الدافعُ لحديثِ: “لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ءاكلَ الرّبا ومُوكِلَهُ وكاتبَهُ وشاهِدَيه” رواه مسلم وفي روايةٍ لأبي داود “وشاهِدَه”، فاللعنُ المذكورُ في الحديثِ شمَلَ الكاتِب إنْ كان يَكتُب بأُجرةٍ أو بغَيرِ أُجرَةٍ، والشاهِدَينِ سَواءٌ كانا بأجرةٍ أو بغَير أُجرة، وقَد مرّ بيانُ أنواعِه.
ومن ذلكَ أكلُ المكْسِ وهو ما يأخذُه السلاطين الظلمة من أموالِ الناس بغير حق على البضَائع والْمَزارع والبسَاتِين وغيرِ ذلك.
ومن ذلك أكل الغصب أي المغصوب، والغَصبُ هو الاستيلاءُ على حقّ الغَير ظُلمًا اعتِمادًا على القُوَّة فخَرجَ ما يؤخَذُ منَ الناسِ بحقّ كالذي يأخذُه الحاكمُ لِسَدّ الضّروراتِ مِنْ أموالِ الأغنياءِ إذا لم يوجَدْ في بيتِ المالِ ما يكفي لذلكَ فإنَّ ذلكَ ليسَ غَصْبًا بل نَصَّ الفقهاءُ على أنّه يجوزُ أن يأخذَ الحاكمُ من أموالِ الأغنياءِ ما تقتضيه الضّروراتُ ولو أدَّى ذلك إلى أنْ لا يتركَ لهم إلا نفَقةَ سَنة، وهذا من جُملةِ النِظام الإسلامِي وأيُّ نِظام أحسَنُ من هذا.
ومن ذلكَ أكلُ السّرقة وهي أخذُ المالِ خُفْيةً ليسَ اعتِمادًا على القُوّةِ. ويلتَحقُ بذلك أكلُ كُلّ مالٍ مأخوذٍ بِمُعاملَة حرَّمها الشّرعُ مما مرَّ بيانُه. وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “إنَّ أناسًا يتخَوَّضُونَ في مالِ الله بغيرِ حقّ فلَهمُ النارُ يومَ القيامة” رواه البخاري من حديثِ خَولة الأنصاريّة عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: وشُربُ الخَمرِ وحدُّ شارِبها أربعونَ جلدةً للحرّ ونصفُها للرقيقِ وللإمامِ الزيادةُ تَعزيرًا.
الشرح: من معاصي البطن شرب الخمرِ وهو من الكبائر وهي كما قال سيدنا عمر: “ما خَامرَ العقلَ” أي غيّرَه رواه عنه البخاري في الصحيح في كتاب الأشربة. وأمّا حَدُّ الخَمْر فهو في الأصل بالنسبةِ لشَارِبها الحرّ أربعونَ جَلدة وللرقيقِ عِشرُون، ثم إذا اقتَضتِ المصلحة الزيادةَ على ذلكَ جازَ إلى الثمانين.
قال المؤلف: ومنها أكلُ كل مسكر.
الشرح: أن من مَعاصِي البَطن أكلَ كلّ مسكر. وليُعلَم أنَّ الإسكارَ هو تغيير العَقل مع الإطرابِ أي مع النّشوةِ والفرَحِ وأمّا ما يغير العقل بلا إطرابٍ وكذلك ما يخدر الحَواسّ من غيرِ تغييرِ العقلِ فلا يُسَمَّى خَمرًا ولكنّه حَرامٌ فالمخدّرَاتُ كالحشيشة والأُفيون ونحوهما ليسَت مسْكِرَةً ولكنّ تحريـمَها يُفهَم من قولِ الله تعالى:{ولا تقتلوا أنفسكم} [سورة النساء] أفهمَتْنا الآيةُ أنَّ كلَّ ما يؤدّي بالإنسان إلى الهلاكِ فهو حرامٌ أن يتعاطاه.
قال المؤلف رحمه الله: وكلّ نَجِسٍ ومُستَقْذَرٍ.
الشرح: أكلُ النّجاساتِ من جُملَةِ مَعاصِي البطن كالدّم الْمَسفوح أي السّائِل ولحمِ الخِنـزير والـمَيْتةِ. وكذلكَ الـمُستَقْذَرُ يَحرمُ أَكلُه وذلكَ كالـمُخاطِ والمنيّ وأمّا البُصَاقُ فيكون مستَقْذَرًا إذا تجمَّع على شىء مثلاً بحيث تنفِرُ منه الطّباعُ السّليمة أي بعد خروجه من الفم أمّا ما دام في الفم فليس له حكم المستقذر وكذلك البلل ليس له حكم المستقذرِ بالنسبة للأكل ونحوه فَلْيُتنَبّه لذلك. والمستقذرُ هو الشىءُ الذي تعَافُه النَّفسُ أي تنفِرُ منه طبيعةُ الإنسان.
قال المؤلف رحمه الله: وأَكلُ مَالِ اليتيمِ أو الأوقافِ على خِلافِ ما شَرطَ الواقِفُ.
الشرح: أن من مَعاصِي البطن أكلَ مالِ اليَتيم بغير حق وهوَ مُحَرَّمٌ بالنص. قال تعالى: {إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنَّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا}.[سورة النساء] فلا يجوز التّصرف بمال اليتيم على خلاف مصلحته.
ومنها أكلُ مالِ الأوقافِ على ما يُخالِفُ شَرْطَ الواقفِ بأنْ لم يَدخُلْ تحتَ شَرطِ الواقِف. فمَن وقَف بيتًا لسكن الفقراء فلا يجوز للأغنياء أن يَسكنوه ومن وقف بيتًا لسكنِ طلبة الحديث فلا يجوز لغيرهم أن يسكنوه ومن وقف بيتًا لسكنِ حَفَظَةِ القرءانِ فلا يجوز لغيرهم أن يَسكنوه.
قال المؤلف رحمه الله: والْمَأخُوذِ بوَجْهِ الاستِحياءِ بغَيرِ طِيْبِ نَفْسٍ منهُ.
الشرح: مِنْ جُملَةِ معاصي البطن أكلُ ما يُؤخَذُ هبةً مِنَ الغَيرِ بغَير طِيبِ نفسٍ منه كأن يكونَ أعطاه استِحياءً منه أو استحياء مـمَّن يَحضُر ذلك المجلسَ وذلك لأنه يَدخُلُ تحتَ حديثِ: “لا يحِلُ مالُ امرِئ مُسلِم إلا بطِيب نفسٍ منه” رواه الدارقطني والبيهقي فالذي يأخذُ شيئًا من مسلم بطريق الحياء حرامٌ عليه أن يأكلَه ولا يدخلُ في مِلْكِه ويجبُ عليه أن يرُدَّه.
فصل معقود لبيان معاصي العين
قال المؤلف رحمه الله: فصلٌ.
الشرح: أن هذا فصل معقود لبيان معاصي العين.
قال المؤلف رحمه الله: ومِنْ مَعاصِي العَينِ النَّظرُ إلى النّساءِ الأجنبيّاتِ بشَهْوةٍ إلى الوَجهِ والكفّينِ وإلى غَيرِهِمَا مُطْلقًا وكذا نَظَرُهُنَّ إليهمْ إنْ كانَ إلى ما بينَ السُرَّةِ والرُكبَةِ ونَظرُ العَوراتِ
الشرح: أن هذا الفَصْلَ مَعقُودٌ لبَيانِ مَعاصِي العَينِ. وأورد فيه حكم النّظر إلى النّساءِ الأجنبياتِ فالنظرُ إلى وجه المرأةِ الأجنبيّة وكفّيها بشَهوة حَرام بخلاف النظَر إلى ما سِوى الوجهِ والكفينِ فإنه يَحرمُ ولو بلا شَهوةٍ أو خَوفِ فِتنةٍ فإنْ نظَر بلا قَصدٍ بأن وقعَ بصَرُه على عورتها فيجب عليه صرفه أو مع القَصدِ إلى الوجه والكفينِ بلا شَهوةٍ ثم شعَر من نفسِه التّلَذُّذَ وجَبَ عليه صَرفُ نظَره أيضًا فالنظرةُ الأُولى لا مؤاخذةَ فيها.
رَوى التّرمذِيّ وأبو داودَ من حديثِ بُرَيْدَةَ مرفوعًا:”يا عليُّ لا تُتْبِعِ النّظرةَ النّظرةَ فإِنَّ لك الأُولى وليسَتْ لكَ الثّانيةُ”.
ونقَلَ بعضُ الفُقهاء الإجماعَ على جَوازِ النظر بلا شهوة إلى الوجه والكفين.
ومن جملة معاصي العين النظر إلى العورات ولو مع اتحاد الجنس وهو على الرجل نظر ما بين السرة والركبة من الرجل، وعلى المرأة النظر إلى ما بين السرة والركبة من المرأة.
قال المؤلف رحمه الله: ويَحرمُ على الرَّجُلِ والْمَرأَةِ كَشْفُ السَّوأَتينِ في الخَلْوةِ لِغَيرِ حَاجةٍ.
الشرح: أنّ مُقتضى ذلكَ جَوازُ كَشْفِهما في الخَلْوة لأية حَاجَةٍ كَتبرُّدٍ. وعورة الرجل في الخلوة السوأتان والمرأةِ ما بين السرة والركبة.
قال المؤلف رحمه الله: وحَلَّ مع المَحْرمِيّةِ أو الجِنْسِيَّةِ نَظرُ ما عَدا ما بَينَ السُّرةِ والرّكبةِ إذا كانَ بغَيرِ شَهْوةٍ.
الشرح: أنَّ مقدارَ عَورةِ الْمَرأة مع مَحارِمها ما بينَ السُّرّة والركبةِ.
وكذلكَ العَورةُ مع اتّحادِ الجِنسِ أي عورةُ المرأةِ معَ المرأةِ هذا القَدْرُ من بدَنِها هذا إذا كانت مسلمة وأما أمام الكافرة فلا يجوز للمسلمة أن تكشِف من جسَدِها إلا ما تكشِفُهُ عند العمل عادةً كالرأسِ والسّاعدِ والعنُق ونصف الساق. وكذلك عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة. ويحِلُ النّظر بلا شهوة لما سِوَى العورة.
قال المؤلف رحمه الله: ويَحرمُ النّظرُ بالاستِحقارِ إلَى الْمُسلمِ.
الشرح: مِنْ محرّمات العَين النّظَرُ إلى المسلم بالاستحقارِ والازدراءِ إمّا لفَقْره أو لكونه ضعيفَ الجِسْم أو نحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: والنَّظرُ في بَيتِ الغَيرِ بغَيرِ إذْنِهِ أو شَىءٍ أخْفاهُ كذلكَ.
الشرح: أنَّه يَحرُم النّظَرُ في بيتِ الغير بغَير إذْنه أي مِما يَكْرَه عادةً ويتأذَّى به مَنْ في البَيت، وذلكَ كالنّظر في نَحوِ شَقّ الباب أو ثُقْبٍ فيه إلى من في البيتِ أو ما يَحتَوِي عليه البَيتُ مِما يتأذّى صاحبُ البَيتِ بالنظر إليه كأنْ يكونَ صاحبُ الدار مكشوفَ العَورةِ أو بها مَحْرَمُه كبنتِهِ أو نحوها كزوجته. وكذلكَ النَّظر إلى شىء أخفاه الغَيرُ مما يتأذَّى بالنظر إليه.
فصل معقود لبيان معاصي اللسان
قال المؤلف رحمه: فصلٌ:
الشرح: أن هذا فصل معقود لبيان معاصي اللسان.
قال المؤلف رحمه الله: ومنْ معاصِي اللِّسانِ الغِيبةُ وهيَ ذِكرُكَ أخَاكَ الْمُسلِمَ بما يكرَهُهُ مِمَّا فيهِ في خَلفِهِ.
الشرح: من محرمات اللسان الغيبة، وهي ذِكرك أَخاكَ المسلمَ الحيَّ أو الميّتَ بما يكرَهُه لو سمعَ سواءٌ كان مِما يتعلقُ ببدنهِ أو نَسَبه أو ثَوبه أو دارِه أو خُلُقِهِ كأنْ يقولَ فلانٌ قصيرٌ، أو أحوَلُ، أو أبوه دَبّاغٌ أو إسكافٌ أو فلانٌ سيّئ الخُلُقِ، أو قليلُ الأَدَب، أو لا يَرى لأحَدٍ حقًّا عليه، أو لا يَرى لأحدٍ فضلاً، أو كثيرُ النّوم، أو كثيرُ الأكل، أو وسِخُ الثياب، أو دارُه رَثَّةٌ، أو ولَدُه فلانٌ قليلُ التّربيةِ، أو فلانٌ تحكمُه زوجتُه، ونحوُ ذلك مِنْ كلّ ما يَعلَمُ أنّه يكرَهُه لو بلَغه. قال الله تعالى: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه﴾ [سورة الحجرات] الآيةَ.
وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: “أتَدْرُونَ ما الغِيبةُ” قالوا: الله ورسولُه أعلمُ قال “ذِكرُك أخاك بما يكرَهُ” قال: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقولُ قال “إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتَبْتَهُ وإن لم يكن فيه فقد بَهَتَّهُ”. وقد اختلفَ كلامُ العلماءِ في الغيبة فمنهم من اعتبرها كبيرةً ومنهم من اعتبرها صغيرةً، والصّوابُ التَّفصيلُ في ذلك فإنْ كانت الغيبةُ لأهلِ الصّلاح والتّقوى فتلك لا شكَّ كبيرةٌ وأمّا لغيرهم فلا يُطلَقُ القولُ بكونها كبيرةً لكن إذا اغتيب المسلمُ الفاسقُ إلى حد الإفحاش كأن بالغ شخص في ذكر مساوئه على غيرِ وجهِ التحذيرِ كان ذلك كبيرة، وعلى ذلك يحمل حديث: “إن أربى الربا استطالةُ الرجلِ في عِرض أخيه المسلم” رواه أبو داود فإن هذه الاستطالة كبيرة بل من أشد الكبائر لوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بأنها أربى الربا أي أنها في شدة إثمها كأشد الربا.
وكما تَحرمُ الغِيبةُ يَحرمُ السّكوتُ علَيها معَ القُدرةِ على النَّهْيِ ويحرم تَركُ مُفارقة الْمُغتابِ إن كان لا ينتهي معَ القُدرَةِ على المفارقة.
وقد تكونُ الغيبَةُ جائزةً بل واجبةً وذلكَ في التحذير الشرعي من ذِي فِسق عَمَلِيّ أو بِدعة اعتقاديّةٍ ولو مِنَ البِدَع التي هي دون الكفر كالتّحذير منَ التّاجر الذي يَغُشّ في مُعاملاتِه وتَحذيرِ صاحِبِ العمل من عاملِه الذي يخونُه، وكالتّحذير من المتصدّرِين للإفتاءِ أو التّدريس أو الإقراء مع عدم الأهلِيّة فهذِه الغيبةُ واجِبةٌ.
ومن الْجَهل بأمور الدين استنكارُ بعضِ الناسِ التحذيرَ من العامِل الذي يخونُ صاحبَ العمَل احتجاجًا بقولِهم إنَّ هذا قطْعُ الرِزقِ على الغير فهؤلاء يؤثرون مُراعاةَ جانِب العَبدِ على مُراعاةِ شَرِيعَةِ الله.
وقد قسَّم بعضُ الفقهاءِ الأسبابَ التي تُبِيح الغِيبةَ إلى سِتةٍ جَمعها في بيتٍ واحِد قالَ من الوافر
تَظَلَّمْ وَاسْتَعِنْ وَاسْتَفْتِ حَذِّرْ **** وَعَرِّفْ وَاذْكُرَنْ فِسْقَ الْمُجَاهِرْ
وَمِنَ الْجَهْلِ القَبيحِ قولُ بَعْضِ النَّاسِ حِينَمَا تُنْكِرُ عَليْهِمُ الغيبَةَ “إني أقول هذا في وجهه ” كأنهم يظنون أنه لا بأس إذا اغتيب الشخص بما فيه، وهؤلاء لم يعلموا تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للغيبة بقوله “ذكرك أخاك بما يكره” قيل أرأيتَ يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول قال: “إن كان فيه ما تقول فقد اغْتَبْتَهُ” إلى ءاخر الحديث وقد تقدم رواه مسلم وأبو داود.
والغيبة قد تكون بالتصريح أو الكناية أو التعريض. ومن التعريض الذي هو غيبةٌ أن تقول إذا سُئِلْتَ عن شخص مسلم الله لا يبتلينا معناه أنه مبتلًى بما يُعاب به وأن تقولَ الله يصلحنا لأنك أردت به التعريضَ بأنه ليس على حالة طيبة.
قال المؤلف رحمه الله: والنَّمِيمةُ وهيَ نَقلُ القَولِ للإِفسَادِ.
الشرح: النَّميمة من الكبائر وهي مِنْ جُملة مَعاصي اللسانِ لأنّها قولٌ يُراد به التّفريقُ بينَ اثنين بما يتضَمَّنُ الإفسادَ والقَطيعةَ بينَهما أو العَداوة ، ويُعبَّر عنها بعبارةٍ أُخرى وهي نَقلُ كلامِ الناسِ بعضِهم إلى بعضٍ على وجه الإفسادِ بينهم قال الله تبارك وتعالى: ﴿هَمَّازٍ مّشَّاءٍ بِنَمِيم﴾ [سورة القلم] وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “لا يَدخُلُ الْجَنَّةَ قتَّاتٌ” رواه البخاري. والقتَّاتُ النمَّامُ.
والنميمة والغيبة وعدم التنـزه من البول من أكثر أسباب عذاب القبر.
تنبيه: ليعلم أن قوله تعالى: ﴿والفتنة أشد من القتل﴾ [سورة البقرة] معناه أن الشِرْكَ أشدُ من القتل وليس معناه أنّ مجرد الإفساد بين اثنين أشدُّ من قتل المسلم ظلمًا بل الذي يعتقد ذلك يكفر والعياذ بالله لأن الجاهل والعالم من المسلمين يعرفان أن قتل الشخص ظلمًا أشد في شرع الله من مجرد الإفساد بينه وبين ءاخرَ لا يخفى ذلك على مسلم مهما بلغ به الجهل.
قال المؤلف رحمه الله: والتَحْريشُ مِنْ غَيرِ نَقْلِ قَولٍ ولَو بَينَ البَهائمِ.
الشرح: من جملةِ مَعاصي اللسانِ التي هي من الكبائر التّحريشُ بالْحَثّ على فِعْل مُحَرَّم لإِيقاع الفِتنة بينَ اثنين، وكذلكَ التّحريش بينَ الكَبْشَينِ مَثلاً أو بينَ الدّيكَين ولو مِنْ دونِ قولٍ بل باليَدِ ونحوِها.
قال المؤلف رحمه الله: والكَذِبُ وهوَ الإخبارُ بخِلافِ الواقعِ.
الشرح: مِنْ مَعاصي اللسانِ الكذِب وهو عندَ أهلِ الْحَقِّ الإخبارُ بالشّىءِ على خلافِ الواقِع عمدًا أي مع العِلم بأنَّ خَبره هذا على خِلافِ الواقِع فإن لم يكن مع العلم بذلك فليسَ كَذِبًا مُحَرَّمًا. وهو حَرامٌ بالإجماع سواءٌ كانَ على وجه الجِدّ أو على وجهِ المزح ولو لم يكنْ فيه إضرارٌ بأحد كما وردَ مَرفُوعًا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم ومَوقُوفًا بإسناد صحيح على بعض الصحابة “لا يَصْلُحُ الكذِبُ في جِدّ ولا في هَزْل” وروى مسلم في الصحيح “إياكَ والكذبَ فإن الكذبَ يهدي إلى الفجور وإن الفجورَ يهدي إلى النار ولا يزالُ العبدُ يكذبُ ويَتَحَرَّى الكذبَ حتى يُكْتَبَ عند الله كَذّابًا” روى الحديثين ابنُ ماجهْ في سياق واحد عن ابن مسعود. ومعنى قوله عليه السلام “يهدي إلى الفجور” هو وسيلة إلى ذلك أي طريق توصل إلى ذلك، وما أكثر من هلك باستعمال الكذب في الهزل والمزح. وأشد ما يكون من ذلك إذا كان يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال أو ترويع مسلم يَظُنُّ أنه صدقٌ، ومن أمثلة ذلك أن رجلاً كان بين أصدقائه في مكان فأقبل أعمى فقال هذا الرجل قال الله تعالى: “إذا رأيت الأعمى فكُبَّهُ إنَّك لستَ أكرمَ من ربّهِ” قاله لإضحاك الحاضرين لأن هذا أو ما أشبهه عند هؤلاء السفهاء الجاهلين بالدين من الطُّرَفِ ولم يَدْرِ هذا ومن كان معه أن هذا يتضمّن كذبًا على الله بجعل هذا الكلامِ السفيهِ قرءانًا وأنه يتضمن تحليلَ الحرامِ المعلومِ من الدين بالضرورة حرمَتُهُ لأنه لا يجهل حكمَ هذا الفعلِ مسلمٌ أنه حرامٌ مهما بلغ في الجهل.
قال المؤلف رحمه الله: واليَمينُ الكاذبةُ.
الشرح: مِن معاصي اللِسان اليَمين الكاذِبة وهي منَ الكبائر لأنَّ الْحَلِفَ بالله تباركَ وتعالى بخلافِ الواقع بذِكرِ اسمهِ أو صفة من صفاته كقول وحَياةِ الله أو والقرءانِ أو وعَظَمَةِ الله أو وعزّةِ الله أو نحوِ ذلك من صفاتِه تهاوُنٌ في تعظيم الله تعالى.
تنبيهٌ: لا يجوز أن يقال وحياةِ القرءان لأن القرءانَ لا يوصَفُ بالحياةِ ولا بالموت.
قال المؤلف رحمه الله: وألفاظُ القَذْفِ وهيَ كثيرةٌ حاصِلُهَا كلُّ كلِمةٍ تَنسُبُ إنسَانًا أو واحِدًا مِنْ قرابَتِهِ إلى الزّنى فهيَ قَذفٌ لِمَنْ نُسِبَ إليهِ إِمَّا صَريحًا مُطْلقًا أو كِنايةً بنيّةٍ.
الشرح: من جملةِ معاصِي اللسانِ الكلام الذي يُقذَفُ أي يُرمَى به شَخصٌ بالزِنى ونَحوِه. والقذفُ إن كان بنسبةِ صريح الزِنى كأن يقولَ في رجل فلانٌ زانٍ أو في امرأةٍ فلانةُ زانيةٌ وكذلكَ قولُه فلانٌ لاطَ بفلانٍ أو لاطَ به فلانٌ أو فلانٌ لائطٌ سَواءٌ نَوى به القذف أو لم يَنْوِ يوجبُ الحدَ على القاذفِ ، فإن كان كنايةً بأن كان اللفظُ غيرَ صريح بل يَحْتَمِلُ القذفَ وغيره كأن يقولَ لشخص يا خَبيثُ أو يا فاجِرُ أو يا فاسِقُ ونوَى القَذْفَ كانَ قَذفًا مُوجبًا للحَدّ أيضًا. وأما التعريض كقوله نحن أولاد حلال مريدًا بذلك أن فلانًا ابنُ زنًى فإنه مع حرمته لا حد فيه. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:”اجتنبوا السبع الموبقات” أي المهلكات قيل وما هن يا رسول الله قال “الشركُ بالله والسحر وقتلُ النفس التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولّي يومَ الزحفِ وقذفُ المحصَنات الغافلات المؤمنات” ومعنى المحصنات العفيفات اللاتي لم يمسهن الزنا ولا تُعْرَفُ عليهن الفاحشة.
قال المؤلف رحمه الله: ويُحَدُّ القَاذفُ الْحُرُّ ثَمانِيْنَ جَلْدَةً والرَّقيقُ نِصفَها.
الشرح: أنَّ الله تَبارك وتَعالى أنزلَ في شَرْعِه حُكمَ القاذف، فالقاذفُ إمَّا أنْ يكونَ حرًّا أو عبدًا فالْحُرُّ حدُّه ثَمَانون جَلْدَةً بِسَوْطٍ والعبدُ حَدُّه نِصفُ ذلكَ وهو أربعونَ جَلْدَةً، وهذا الحكمُ مُجْمَعٌ عليه.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها سَبُّ الصّحابةِ.
الشرح: من معاصي اللّسانِ سَبُّ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ﴿والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾ [سورة التوبة] هؤلاء هم أولياء الصحابة وسبُّ أحدِهم أعظم إثمًا وأشد ذنبًا من سب غيره.
وليسَ مِنْ سَبّ الصّحابة القَولُ إنّ مقاتِلي عليّ منهم بغاةٌ لأنّ هذا مما صرَّح به الحديثُ بالنّسبة لبَعضِهم وهم أهلُ صِفّينَ فقد قال صلى الله عليه وسلم: “ويحَ عمّارٍ تقتلُهُ الفئةُ الباغيةُ” رواه البخاري وغيره وهو حديث متواتر، وقالَ ذلك الإمامُ الشافعيُّ رضي الله عنه. ورَوى البيهقيُّ في السُنَنِ الكُبْرى وابنُ أبي شَيبةَ في مُصنَّفه عن عمَّارِ بنِ ياسرٍ أنَّه قال لا تقولُوا كفرَ أهلُ الشام ولكنْ قولُوا فَسقُوا وظَلمُوا اهـ يعني بأهلِ الشامِ الْمُقاتِلينَ لأمير المؤمنينَ عليّ في وَقْعَةِ صِفّينَ، ومعلومٌ مَنْ هو عمّارٌ، هو أحدُ الثلاثةِ الذينَ قال فيهمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم “إنَّ الْجَنةَ تَشتاقُ إلى ثلاثةٍ” الحديثَ، وقالَ فيه “عَمّارٌ مُلِئَ إيْمانًا إلى مُشَاشِهِ” والحاصل الذي تلخص مما تَقَدَّمَ أن سب الصحابة على الإجمال كفر وأما سبُّ فرد من الأفراد منهم فهو معصية إلا أن يَعِيْبَهُ بشىء لسبب شرعي فلا حرمة في ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: وشَهادةُ الزُّورِ.
الشرح: أنَّ من معاصي اللسانِ شَهادةَ الزُور. والزُّورُ الكَذِبُ. وشهادة الزور من أكبرِ الكبائِر قالَ صلى الله عليه وسلم “عَدَلَتْ شهادَةُ الزُّورِ الإشْراكَ بالله” أي شُبِّهَتْ به وليسَ المرادُ أنها تَنقُلُ فاعِلَهَا عن الدّين. والحديثُ رواه البيهقي.
قال المؤلف رحمه الله: ومَطْلُ الغَنِيّ ـ أيْ تأخِيرُ دَفْعِ الدَّينِ معَ غِناهُ أيْ مَقْدرتِهِ.
الشرح: أن مَطْلَ الغَنيّ من جُملةِ مَعاصي اللسانِ التي هي من الكبائر لأنّه يتضَمَّنُ الوَعْدَ بالقولِ بالوفاءِ ثم يُخلِفُ. روى أبو داود في سُنَنِهِ “لَيُّ الواجِد يُحِلُ عِرضَه وعقُوبَته “. معنى الحديث أنَّ لَـيَّ الواجِد أي مُماطَلةَ الغنِيّ القادر على الدَّفْع يُحلُّ عِرْضَه وعُقوبتَهُ أي يُحِلُ أن يُذكَر بين الناسِ بالْمَطْلِ وسُوءِ المعاملةِ تحذيرًا ويُحِلُ عقوبتَهُ بالحبس والضّربِ ونَحوِهما.
قال المؤلف رحمه الله: والشَّتْمُ واللَّعْنُ.
الشرح: من معاصي اللسانِ شَتم المسلم أي سَبّه ، روى البخاريُّ أنّه صلى الله عليه وسلم قال: “سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وقِتَالُه كُفرٌ” أي أنَّ سَبَّ المسلم مِنَ الكبائرِ بدليلِ تَسميتهِ فُسوقًا وأطلَق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قِتالهِ لَفظَ الكفرِ لأنه شبيهٌ بالكفرِ لا يَعنِي أنه يَنقُل عن الْمِلَّة لأنَّ الله تعالى سمَّى كِلتا الطّائفَتَين المتقاتلتين مؤمِنينَ في قوله تعالى:”وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا” [سورة الحجرات] الآية.
وأمّا اللعن فمعناهُ البعد من الخير. ولَعنُ المسلم منَ الكبائر قال صلى الله عليه وسلم “لَعْنُ الْمُسْلِمِ كَقَتْلِهِ” رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله: والاستِهزاءُ بالْمُسلمِ وكلُّ كلامٍ مُؤْذٍ لهُ.
الشرح: أن من معاصي اللسان الاستهزاءَ بالمسلِم أي تحقيرَه، وكذلكَ كلُّ كلام مؤذٍ للمُسلم أي إذا كانَ بغَيرِ حقّ. وفي حُكمِ الكلامِ المؤذي الفِعلُ والإشارةُ اللذانِ يتضَمّنانِ ذلكَ.
قال المؤلف رحمه الله: والكَذِبُ علَى الله وعَلَى رَسُولِهِ.
الشرح: من جملةِ معاصِي اللّسان الكذبُ على الله سبُحانه وتعالى وكذا الكذِبُ على رسولِهِ صلى الله عليه وسلم، ولا خِلافَ في أنَّ ذلكَ منَ الكبائر بل مِنَ الكَذِب على الله ورسولِه ما هو كفرٌ كأن يَنسُبَ إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمَ ما عُلِمَ حِلُّهُ بالضرورة أو تحليل ما عُلمت حرمتُهُ بالضرورة. قال الله تعالى: ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة﴾ [سورة الزمر] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنّ كذِبًا عليَّ ليسَ ككَذِبٍ على أحَدٍ فمَنْ كذَبَ عليَّ متعَمّدًا فَلْيَتَبوّأْ مَقعَدَه مِنَ النار” رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله: والدَّعوَى البَاطِلةُ.
الشرح: أن من جُملَةِ مَعاصِي اللسانِ الدَّعوى الباطلةَ كأنْ يدَّعيَ على شَخصٍ ما ليس له اعتمادًا على شهادةِ الزُّور أو على جاهِهِ.
قال المؤلف رحمه الله: والطَّلاقُ البِدْعِيُّ وهوَ ما كَانَ في حَالِ الْحَيضِ أو في طُهْرٍ جامَعَ فيهِ.
الشرح: من معاصي اللسانِ الطّلاقُ البِدعيُّ وهو أنْ يُطلّقَ امرأتَهُ في طُهْرٍ جامَعها فيه أو في حَيض أو نِفاس وقد تقدم بيانه. ومَع حُرمَةِ ذلكَ فإنَّ الطّلاقَ يقع فيه.
قال المؤلف رحمه الله: والظّهارُ وهوَ أنْ يَقولَ لِزَوجَتِهِ أنتِ عليَّ كظَهرِ أُمّي أيْ لا أجامِعُكِ.
الشرح: أن من معاصي اللسانِ الظهارَ وهو أن يقول لزوجته ولو رَجْعِيَّةً أنتِ عليَّ كظهرِ أمّي وكذلك قولُه أنتِ كَيَدِها أو بطنها لِما فيه من إيذاءٍ للمرأة. وهو منَ الكبائر. ومثلُ الأمِ سائر المحارم فلو قال لزوجته أنت عليَّ كظهر أختي أو يدها أو بطنها فهو ظهارٌ مُحَرَّمٌ.
قال المؤلف رحمه الله: وفيهِ كَفّارةٌ إِنْ لَمْ يُطَلّقْ بَعدَهُ فَورًا وهيَ عِتقُ رقَبَةٍ مؤمنةٍ سَلِيمَةٍ فإِنْ عَجَزَ صَامَ شَهْرَينِ مُتَتابِعَينِ فإِنْ عَجَزَ أطْعمَ سِتّينَ مِسْكينًا ستّينَ مُدًّا.
الشرح: يتَرتَّبُ على الظّهار إنْ لم يُتْبِعْهُ الزّوجُ بالطّلاقِ فَورًا الكَفّارةُ وحُرمَةُ جِماعِها قبلَ ذلكَ. وكفّارَتُه إحدى ثلاثِ خِصالٍ على الترتيب:
الأُولى: إعتاقُ رقَبةٍ مسلمة أي نفسٍ مملوكة عبدٍ أو أَمةٍ سليمةٍ عمّا يُخِلُّ بالعَمل والكَسْبِ إخلالاً بيّنًا.
والثانيةُ: صيامُ شهرينِ مُتَتابِعَينِ أي إنْ عَجَز عن إعتاقِ الرّقَبةِ وقتَ الأداء، وَينقطِعُ التّتابُعُ بفَواتِ يوم منَ الشّهرَيْنِ.
والثّالثةُ: إطعامُ سِتّين مِسْكينًا أو فَقِيرًا كلَّ مِسكِين مدًّا مِما يصِحُّ دفعُه عن زكاةِ الفِطْرَةِ فلا يصِحُ دَفعُها لِواحِدٍ بعينه كلَّ يومٍ ويصِحُّ أن يَجمَع السّتّينَ في ءانٍ واحِدٍ ويضعَها بينَهم فيُملّكَهم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها اللَّحنُ في القُرءانِ بِما يُخِلُّ بالْمَعنَى أو بالإعرابِ وإنْ لَم يُخِلَّ بالْمَعنى.
الشرح: من معاصي اللسانِ أن يقرأ القرءان مع اللحن ولو كانَ لا يُخِلُّ بالْمَعنى ولم يغيّرْه لكن تعمَّدَه، ويجب إنكار ذلك عليه فإنه يجب تصحيحُ القراءةِ إلى الْحَدِّ الذي يَسْلَمُ فيه مِنْ تَغيير الإعرابِ والحرفِ ومِنْ قَطْعِ الكَلِمَةِ بَعضِها عن بَعضٍ وجُوبًا عَينِيًّا بالنِسبة للفَاتِحَةِ ووجُوبًا كِفائيًّا بالنّسبةِ لغَيرِها، فيَجِبُ صَرفُ جميعِ الوقتِ الذي يُمكِنُه لِتحصيل تَصحِيح الفاتِحةِ فإنْ قصَّرَ بحيث لَم تصح قراءته للفاتحة عصَى ولزِمَه قَضَاءُ صَلَواتِ الْمُدَّةِ التي أمْكنَه التَّعلُّم فيها فلَمْ يتَعلَّم.
قال المؤلف رحمه الله: والسؤالُ للغَنيّ بمالٍ أو حِرْفَةٍ.
الشرح: من جُملَةِ معاصي اللسانِ أنْ يَسألَ الشّخصُ الْمُكتَفِي بالمالِ أو الحِرفة بأن كان مالكًا ما يكفيه لحَاجاتِهِ الأصليّة أو كان قادرًا على تَحصِيل ذلكَ بكَسْبٍ حَلالٍ وذلكَ لحَديثِ “لا تَحِلّ الْمَسئَلةُ لِغَنيّ ولا لذي مِرَّةٍ سَويّ” رواه أبو داود والبيهقي.
والْمِرَّةُ هي القُوّة أي القُدرَةُ على الاكتِسَاب والسَّويُّ تامُّ الخَلْقِ.
قال المؤلف رحمه الله: والنَّذْرُ بقَصْدِ حِرمانِ الوَارثِ.
الشرح: أن من معاصي اللسانِ أن ينذُرَ الرجلُ نَذرًا يَقصِدُ به أن يَحرِمَ وارِثَه، ولا يصح ذلك النذرُ، أما لو لم يكن قصده بالنذر حرمانَ الوارث فلا يحرم. قال المؤلف رحمه الله: وتَركُ الوَصِيةِ بدَين أو عَيْنٍ لا يَعلَمُهُمَا غَيرُهُ.
الشرح: من معاصي اللسانِ ترك الوصيّة بدَيْنٍ على الشّخصِ أو عَيْنٍ لغيرهِ عنده بطريق الوديعةِ أو نحوِها فيجبُ على مَنْ عليه أو عندَه ذلكَ أن يُعْلِمَ به غيرَ وارِثٍ يَثبُت بقَولِه ولو واحِدًا ظَاهِرَ العَدالَة إنْ خافَ ضَياعه بِمَوتِه أو يَرُدَّه حَالاً خَوفًا من خِيانَةِ الوارِث فإن علِمَ بها غَيرُهُ كانتِ الوصِيّةُ مَندُوبَةً. ويَشمَلُ ما ذُكِرَ ما كانَ دَينًا لله كالزكاة.
قال المؤلف رحمه الله: والانتِماءُ إلى غَيرِ أَبيهِ أو إلى غَيرِ مَوالِيهِ.
الشرح: من معاصي اللِسان التي هي من الكبائر أنْ يَنْتَمِيَ الرجلُ إلى غَيرِ أبيه أو أنْ ينتَمِيَ الْمُعْتَقُ إلى غَيرِ مَوالِيْهِ أي الذينَ هم أعتقوه فلهم علَيه وَلاءُ عَتاقةٍ لأنَّ في ذلكَ تَضْييعَ حقّ. روى أبو داودَ والترمذي وابنُ ماجَهْ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَن ادَّعى إلى غيرِ أبيه فعَليه لعنَةُ الله”.
قال المؤلف رحمه الله: والْخِطْبَةُ على خِطْبةِ أخِيْهِ.
الشرح: من معاصي اللسانِ أنْ يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيْه أي أخيهِ في الإِسلام. وإنما يَحرمُ ذلك بعدَ الإجابة مِمّن تُعتَبَر مِنه مِنْ وليّ مُجْبرٍ أو منها أو منها ومن ولي أي بدونِ إذنِ الخاطبِ الأوَّلِ وذلك لما في الخِطبة على خِطبة أخيه من الإيذاء وما تسببه من القطيعة فأمَّا إنْ أَذِنَ فلا حُرمَة قي ذلكَ وكذلكَ إنْ أعرَضَ عنها. وقد روى البخاري ومسلم من حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “لا يَخْطُبْ أَحَدُكُم على خِطْبَةِ أخيه حتى يَتْركَ الخاطبُ قَبْلَه أو يأذَن له”.
قال المؤلف رحمه الله: والفَتْوى بغَيرِ عِلْمٍ.
الشرح: من معاصي اللسانِ التي هي منَ الكبائر أنْ يُفتِيَ الشخصُ بفَتْوى بغَيرِ عِلْم. قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ اْلسَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ (36)[سورة الإسراء] أي لا تقُلْ قولاً بغير عِلم، فمن أفتى فإن كان مجتهدًا أفتى على حسَبِ اجتِهادِه وإنْ لم يكنْ مجتهدًا فليسَ لهُ أنْ يُفتِيَ إلا اعتمادًا على فتوى إمامٍ مجتهدٍ أي على نصّ له أو وجه استخرَجَه أصحَابُ مَذهَبِه مِنْ نَصّ لهُ، ولا يُغْفِلْ كلمةَ لا أدري فقَد جاءَ عن مالكٍ رضيَ الله عنه أنّه سُئِل ثمانيةً وأربَعينَ سؤالاً فأجابَ عن سِتّةَ عشرَ وقالَ عن البقيّةِ “لا أدري” اهـ روى ذلك صاحبه هيثم بن جميل.
ورُوي عن سيدنا عليّ أنه سئل عن شىء فقال: “وا بردَها على الكبد أن أُسأل عن شىء لا علم لي به فأقول لا أدري” اهـ رواه الحافظ العسقلاني في تخريجه على مختصر ابن الحاجب الأصليّ.
قال المؤلف رحمه الله: وتَعلِيمُ وتَعلُّمُ عِلْمٍ مُضِرّ لِغَيرِ سَببٍ شَرْعيّ.
الشرح: مِنْ مَعاصِي اللسانِ تَعليم الشّخصِ غَيرَه كلَّ عِلم مُضِرّ شَرعًا وتَعلُمُ الشّخصِ ذلكَ لأنّ مِنَ العِلْم ما هو مُحَرَّمٌ كالسّحْر والشَّعوذةِ وعِلْمِ الحَرْفِ الذي يُقصَدُ لاستِخراجِ الأمور الـمُستَقبَلَةِ أو الأمورِ الخَفيّةِ مِمَّا وقَع وقَد عَدَّ هذا العِلمَ مِنَ العلُومِ الـمُحرَّمةِ السيوطيُّ وغَيرُه.
قال المؤلف رحمه الله: والحُكمُ بغَيرِ حُكْمِ الله.
الشرح: من معاصي اللسانِ الحكم بغير حكم الله أي بغير شرعه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [سورة المائدة] الآيةَ. والحكمُ بغَير ما أنزلَ الله منَ الكبائرِ إجماعًا. وأما الآيات الثلاث التي في المائدة وهي :﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ﴾(44)[سورة المائدةِ] والتي فيها ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ﴾(45)[سورة المائدة] والتي فيها ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ﴾(47)[سورة المائدة] فقد روى مسلم عن البَراء بنِ عَازب أنَّ اليهودَ حرَّفوا حكمَ الله الذي أنزلَه في التوراةِ حيثُ حكَمُوا على الزّاني الـمُحْصَنِ بالجَلد والتَّحمِيم وقد أنزلَ الله الرَّجمَ في التّوراة فنـزلت فيهم الآيات المذكورة، ومعنى الآيات أن من جحد حكم الله أو ردَّه فقد كفر، وليسَ في الآيةِ الأُولى تكفيرُ الحاكم الـمُسلم لمجَرّد أنّه حكَم بغَير الشرع فإنَّ المسلمَ الذي يَحكُم بغَير الشّرع مِنْ غيرِ أن يَجْحَد حكمَ الشّرع في قَلبِه ولا بِلسَانِه وإنّما يَحكُم بهذه الأحكام العُرفيةِ التي تَعارفَها الناسُ فيما بينَهم لكونِها موافِقةً لأهواء الناسِ مُتَداوَلةً بين الدُولِ وهو غيرُ معترِفٍ بصِحّتها على الحقيقةِ ولا معتقِدٌ لذلكَ وإنّما غايةُ ما يقولُه إنه حكمٌ بالقانونِ لا يجوزُ تكفيرُهُ أي اعتبارُهُ خَارجًا منَ الإسلام. وقد قالَ ابنُ عباس رضيَ الله عنهُما في تفسير ءايةِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ﴾(44) ﴿سورة المائدة﴾ ليس الذي تذهبون إليه الكفرَ الذي ينقل عن الملة بل كفرٌ دون كفر اهـ أي ذنبٌ كبيرٌ وهذا الأثر عن ابن عباس صحيح ثابت رواه الحاكم في المستدرك وصحّحه ووافقه على تصحيحه الذهبيُ. وهذا التفسير للآية يشبه تفسير الحديث الذي رواه البخاريُّ أنّه صلى الله عليه وسلم قال عن قِتال المسلم إنّه كفرٌ اهـ
ومن عقائد أهلِ السُنَّةِ المتَّفقِ علَيها أنه لا يُكَفَّرُ مسلمٌ بذَنْب إن لم يستحِلَّه وإنَّما يَكفُر الذي يستَحِلُّه أي على الوَجْه المقَرَّر عندَ أهلِ العلم فإنَّ المسئلةَ يَدخلُها تفصِيلٌ، فإنّه إنِ استَحلَّ مَعصِيةً مَعلُومًا حكمُها منَ الدّين بالضّرورة كأَكْلِ لَحْم الخِنـزير والرِشوة فهو كفرٌ أي خروجٌ منَ الإسلام وإن لَم يكن حكمُها مَعلومًا منَ الدّين بالضّرورة لَم يَكفُر مستَحِلُّها إلا أنْ يكونَ استحلاله من بابِ ردّ النّصِ الشّرعي بأنْ عَلِمَ بورُودِ الشّرع بتَحْرِيمها فعانَد فاستَحلَّها لأنَّ ردّ النّصُوص كفرٌ كما قالَه النَّسفيُّ في عقيدتِه المشهورةِ والقاضِي عِياضٌ والنّوويُّ وغَيرُهم. فإذا عُرِفَ ذلكَ عُلِم أنَّ ما يُوجَدُ في مؤلَّفات سيّد قطب مِنْ تكفيرِ مَنْ يَحكُم بغَير الشّرع تكفيرًا مطلقًا بلا تفصيل لا يُوافِقُ مَذْهبًا منَ الـمَذاهِب الإِسلاميةِ، وإنّما هو من رأيِ الخوارجِ الذينَ قاعِدَتُهم تكفيرُ مُرتكِبِ المعصِية، فقَد ذكَرَ الإمامُ أبو منصور البغداديُّ أنّ صِنفًا منَ الطّائِفة البَيْهَسِيَّةِ مِنَ الخَوارج كانت تُكفّرُ السّلطانَ إذا حَكَم بغَير الشّرع وتكفّر الرّعايا من تابَعه ومَنْ لم يتابِعْه، ذكَرَ ذلكَ في كِتابه تفسير الأسماء والصّفات. فليُعْلَمْ أنَّ سيّدَ قُطْبٍ ليسَ لهُ سَلَفٌ في ذلكَ إلا الخَوارجُ.
قال المؤلف رحمه الله: والنَّدْبُ والنّياحَةُ.
الشرح: مِنْ مُحَرّماتِ اللسانِ التي هي من الكبائر النَّدبُ والنّياحة فالنَّدبُ هو ذِكْرُ مَحاسِنِ الْمَيّت برَفْع الصّوْتِ كواجبَلاه وواكَهْفاه،
وأما النّياحَةُ فهي الصّياحُ على صورة الْجَزَعِ لِمُصِيْبَةِ الْمَوتِ فتَحرُم إذا كانت عن اختيارٍ لا عن غلَبة. وقد روى البزّار وغيرُه مرفوعًا: “صَوتان مَلعُونانِ في الدُنْيا والآخِرَة مِزمارٌ عندَ نِعمةٍ ورنَّةٌ عندَ مُصِيبةٍ”.
قال المؤلف رحمه الله: وكلُّ قولٍ يَحُثُّ على مُحَرّم أو يُفَتّرُ عنْ واجِبٍ وكلُّ كَلامٍ يَقْدَحُ في الدّينِ أو في أحدٍ من الأنبياءِ أو في العلَماءِ أو القرءانِ أو في شَىءٍ مِنْ شَعائرِ اللهِ.
الشرح: كل كلامٍ يشجّع الناس على فعل المحرمات أو يثبّطُ هِمَمَهُم عن فعل الواجبات كأن يقول لمسلم اقعد معنا الآن ولا تصلّ فإنك تقضي الصلاة فيما بعد فهو محرّم.
وكلّ كلام يقدح في الدّين أي يُنَقّصُ الدّينَ أو في أحدٍ منَ الأنبياء أو في جميع العلماءِ أو القرءانِ أو شىءٍ مِن شعائر الله كالصلاة والزكاة والأذان والوضوء ونحوِ ذلك فهو كفر
قال المؤلف رحمه الله: ومنها التّزميرُ.
الشرح: أن من معاصي اللسانِ التَّزميرَ وهوَ النفخ بالْمِزمار وهو أنواع:
مِنها قصَبةٌ ضَيّقَةُ الرأسِ متَّسِعَةُ الآخِر يُزْمَرُ بها في الْمَواكِب والْحُروب على وَجْهٍ مُطرِب.
ومنها ما هي قصَبة مثلُ الأُولى يُجْعَلُ في أسفَلِها قِطعةُ نُحاسٍ مُعوجَّةٌ يُزْمَر بها في أعْراسِ البَوادِي.
وتَحرِيْمُ ذلك كسائرِ ءالات اللهو الْمُطرِبَة بِمُفرَدِها هو ما عليه الْجُمهورُ ولا يُلتفت إلى القول الشاذ الذي قال به بعض الشافعية والحنفية لكن لا يكفّرُ مستحل ذلك إلا أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ومع ذلك يقول عنه إنه حلال.
قال المؤلف رحمه الله: والسّكُوتُ عنِ الأَمرِ بالْمَعرُوفِ والنَّهْيِ عنِ الْمُنكَرِ بغَيرِ عُذْرٍ.
الشرح: من معاصي اللسانِ السّكوتُ عن الأَمر بالْمَعروف وعن النَّهي عن الْمُنكر بلا عذر شرعيّ بأنْ كانَ قادرًا ءامنًا على نَفْسِه ونحوِ مالِهِ قال الله تعالى: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصَوْا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون﴾ [سورة المائدة].
وقد شرط الفقهاءُ لِجَواز إنكارِ المنكر أي المحرمات على فاعِلها كونَ ذلك المنكرِ محرّمًا بالإجماعِ فلا يُنْكَرُ الْمُختَلَفُ فيه بينهُم إلا على من يَرى حُرمتَه وكونَه لا يؤدّي إلى مَفْسَدَةٍ أعْظَمَ فإنْ أدَّى الإِنكارُ إلى ذلكَ حَرُمَ. لكن لا مانع من أن يُرْشَدَ الشخص إذا أخذَ برخصة في مذهبٍ يُرَخّص له ما هو محرم في مذهبه إلى الأخذِ بالاحتياطِ من دون إنكارٍ عليه فيقال له لو فعلت كذا كان أحسن، كما إذا رأى رجلاً يقتصر على ستر العورة المغلظة وهو لا يرى كشفَ الفخِذِ حرامًا لأنه يقلد إمامًا يجيز ذلك فيجوز أن يقال لهذا لو جعلت سترتك شاملة لما بين السرة والركبة أو أزيدَ. وتركُ الإنكار فيما اخْتَلَفَ في تحريمه الأئمة ذَكَرَهُ بعضُ الشافعية والمالكية كابن حجر الشافعي وعز الدين المالكي.
قال المؤلف رحمه الله: وكَتمُ العِلْمِ الواجبِ مع وجُودِ الطّالبِ.
الشرح: مِنْ مَعاصِي اللسانِ التي هي من الكبائر كَتْم العِلْم الواجِب معَ وجُود الطّالِب قال الله تعالى: ﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بيَّنَّاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون﴾ [سورة البقرة]. وروى ابنُ ماجهْ والحاكمُ وابنُ حِبّان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من سُئلَ عن عِلْم فكتَمه أُلْجِمَ يَومَ القِيامةِ بِلِجَامٍ من نار” واللّجامُ المذكورُ في الحديث هو مثلُ الذي يوضع في فمِ الفَرسِ لكنه من نار، فتَعليمُ العِلْم يكونُ في حالٍ فَرضَ كِفاية وفي حالٍ فرضَ عَين والأولُ مَحَلُّه كما إذا كانَ يُوجَدُ أكثرُ من واحِدٍ مِمّن تأهّلَ لذلكَ وتَحْصُلُ بكل منهم الكفاية والثاني كما إذا لم يكنْ هناكَ غيرُ شَخص واحد أهلٍ فلا يَجوز في هذهِ الحالِ أن يُحِيلَ الْمُفْتي الأهلُ أو العالِمُ الذي هو أهلٌ طالبَ العلم إلى غَيرِهِ.
قال العلماء مَنْ تعلَّم علمَ الدّين الضروريَّ ثم نَسِيَ بعضَه يجب عليه استعادَةُ ما نَسِيَ. وقالوا يجب وجودُ عالم يصلح للفتوى في كل مسافة قصر وقاض في كل مسافة عَدْوَى أي نصفِ مرحلة. وذَكَرَ الغزالي أنه يجب وجود عالم يقوم بالرد على الملحدين والمشككين في العقيدة بإيراد الشُّبَهِ في كل بلد أي بحيث يكون ذلك العالم عارفًا بالحجج النقلية والعقلية، وذلك هو علم الكلام الذي عُرف به أهل السنة ليس علمَ الكلام الذي عند المبتدعة كالمعتزلة لأنهم ألفوا كتبًا عديدة أوردوا فيها شُبَهًا عقليةً وتمويهاتٍ بالنصوص الشرعية ليغرُّوا بها القاصرين في الفهم.
قال المؤلف رحمه الله: والضّحِكُ لِخُروجِ الرِيحِ أو على مُسْلِمٍ استِحقارًا لهُ.
الشرح: مِنْ مُحَرّمَاتِ اللسانِ الضَّحِك لِخُروج رِيحٍ من شخصٍ أي إذا لم يكن الضاحك مغلوبًا وكذلكَ الضحك لغَير ذلكَ استِحقارًا لِمَا فيه منَ الإيذاءِ. ومثلُ المسلم في هذه المسألة الذميّ.
قال المؤلف رحمه الله: وكَتْمُ الشَّهادَةِ.
الشرح: أن من جُملَةِ مَعاصي اللّسانِ التي هي من الكبائر كَتْمَ الشّهادةِ بلا عذر.
قال الجلال البلقيني إن ذلك مقيّد بما إذا دُعي إلى الشهادة اهـ ومراده في غير شهادة الْحِسبة فإن شهادة الْحِسبة لا تتقيّد بالطلب كما لو علم اثنان ثقتان بأن فلانًا طلّق امرأته طلاقًا يمنع معاشرتها بأن يكون طلاقًا بائنًا بالثلاث أو بانتهاء العدة قبل الرجعة ويريد أن يعود إلى معاشرتها بغير طريق شرعي وجب عليهما أن يشهدا عند الحاكم ولو من غير طلب منه.
قال المؤلف رحمه الله: وتَركُ ردّ السّلام الواجِب عَلَيكَ.
الشرح: أن مِنْ مَعاصِي اللسانِ تَركَ ردّ السّلام الواجِب رَدُّه وجُوبًا عَينيًّا بأنْ صَدَرَ ابتداؤه مِنْ مُسلِم مكلَّفٍ على مُسلِمٍ مُعَيَّن، أو وجُوبًا كِفائيًا بأنْ صَدَر منه على جَماعةٍ مكلَّفِينَ ، أي مع اتِّحاد الْجِنْس لقوله تعالى: ﴿وإذا حُيِّيتم بتحية فحَيُّوا بأحسنَ منها أو رُدوها﴾ ﴿سورة النساء﴾، أما إذا اختلَفَ الْجِنْسُ بأن سلَّمَتْ شَابَةٌ على أجنَبي لم يجبِ الردُّ فيَبقَى الْجَوازُ إنْ لم تُخْشَ فِتنةٌ وكذلكَ العَكسُ. وأما السلام المكروه كالسّلام على قاضي الحاجَةِ في حالِ خُروج الخبث أو الآكِل الذي في فمه اللُّقمَةُ ونَحوِ ذلك فلا يجبُ ردُّه، وكذلكَ لا يجب الرد على البِدْعيّ الْمُخالِف في الاعتقادِ مِمَّن لا تَبلُغُ بِدعَتُه إلى الكُفْرِ.
تنبيه: قال الحليمي في مسئلة السلام على الأجنبية كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونًا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلّم وإلا فالصمت أسلم اهـ فتبيّن من ذلك حكم جواز تسليم المرأة الأجنبية على الرجل والعكسُ خلافَ ما قال بعض المتأخرين من الشافعية ممن ليسوا من أصحاب الوجوه بل مبلغهم في المذهب أنهم من النقلة فقط، وهذه الطبقة لا يثبت المذهب بكلامها إنما يثبت المذهب بنصّ الإمام الشافعي رضي الله عنه ثم بالوجوه التي يستخرجها أصحاب الوجوه كالحليمي. وأما قول عَمْرُو بنِ حُرَيث “لا تسلّم النساء على الرجال” فليس فيه التحريم الذي قاله بعض المتأخرين إنما غاية ما فيه الكراهة التنـزيهية.
قال المؤلف رحمه الله: وتَحرمُ القُبلَةُ للحَاجّ والْمُعتَمِرِ بشَهوَةٍ ولصَائمٍ فَرضًا إن خشِيَ الإنزَالَ، ومن لا تحلّ قبلته.
الشرح: أن من معاصي اللسانِ القُبلَةَ بشهوة إذا كانت منَ الْمُحْرِم بالنُّسُك، وكذلك الصائمُ صومَ فَرض بأن كانَ من رمضانَ أو نذرًا أو كفّارةً أو نحوَ ذلك إن خشِيَ الإنزالَ وقيل يُكره بخلافِ النّفل فإنه يَجوزُ قَطْعُه، ولا يَبْطُل صَومُ الفَرضِ بها إن لم يُنْـزِل.
ومن معاصيه أيضًا قُبْلَةُ مَنْ لا تَحِلُّ قُبْلَتُهُ كالأَجنبيةِ وهيَ في عُرْفِ الفقهاءِ مَنْ سِوَى مَحارِمه وزَوجتِه وأَمتِه.
فصل معقود لبيان معاصي الأذن
قال المؤلف رحمه الله: فصلٌ.
الشرح: أن هذا فصل معقود لبيان معاصي الأذن.
قال المؤلف رحمه الله: ومنْ مَعاصِي الأُذُنِ الاستِماعُ إلى كلامِ قومٍ أَخْفَوْهُ عَنْهُ.
الشرح: أن من معاصي الأذن الاستماعَ إلى كلام قَوْمٍ علم أنهم يكرهونَ اطّلاعه علَيه وهو من الكبائر ونوع من التجسس المحرم. وقد صَحَّ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: “مَن استَمَع إلى حديثِ قَوم وهُم لهُ كارِهُونَ صُبَّ في أُذُنَيْهِ الآنُكُ يومَ القِيامةِ” رواه البخاري، والآنُكُ بِمَدّ الألِف وضَمِّ النُون الرَّصاصُ الْمُذابُ.
قال المؤلف رحمه الله: وإلى الْمِزْمارِ والطُّنبُورِ وهو ءالَةٌ تُشْبِهُ العُودَ وسَائرِ الأصْواتِ الْمُحَرَّمَةِ.
وكالاستِماع إلى الغِيْبةِ والنّمِيمةِ ونَحْوِهما بخِلافِ ما إذا دَخلَ عليهِ السَّماعُ قَهرًا وكَرِهَهُ ولَزِمَهُ الإنكارُ إنْ قَدرَ.
الشرح: أن مِنْ مَعاصِي الأذُنِ الاستِماعَ إلى الْمِزْمار والطُّنبُور وهو بِضَمِّ الطّاء ءالةٌ معروفةٌ لها أوتار مِنْ ءالاتِ اللّهوِ الْمُطرِبةِ بمفردِها وإلى ما فيه معنَى ذلكَ من الآلات.
أمّا الصَّنْجُ وهي قِطْعَتانِ من نُحَاس تُضرَبُ إحْداهُما بالأُخرى فلَيْسَت مِنْ ءالاتِ اللّهو الْمُطرِبَةِ بِمُفرَدِها وقد مالَ إمامُ الْحَرمَينِ إلى عَدم حُرمتِها وهو الصّحيحُ.
وأما إذا دخل عليه السماع قهرًا بلا استماع منه فليس عليه ذنب لكن يُشتَرطُ في ارتفاع الإثم في السَّماع إذا كانَ بلا قَصْد أنْ يَكرَهَ ذلكَ.
ويُشتَرطُ للسّلامة مِنَ الإثم الإنكارُ لِمَا يَحرُم مِنْ ذلكَ بيدِه أو لِسَانِه إن قَدر وإلا فيَجِبُ عليه الإنكارُ بقلبهِ ومفارقَةُ الْمَجْلِس إنْ كان جَالسًا فِيه.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة