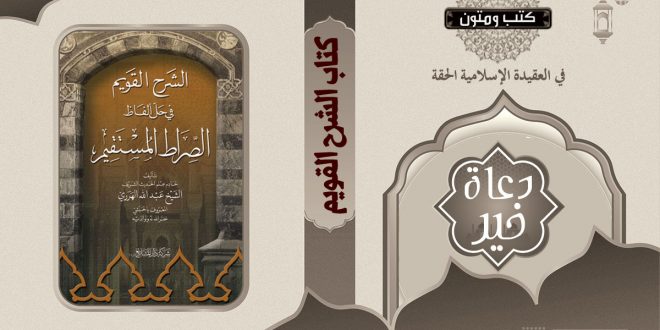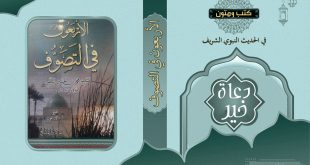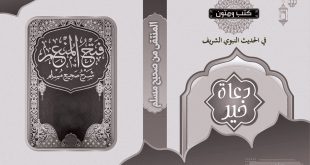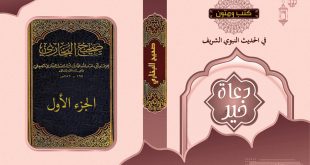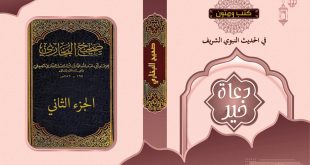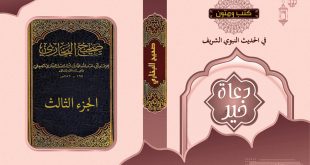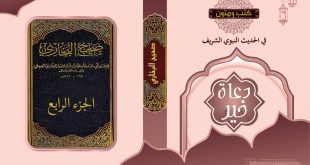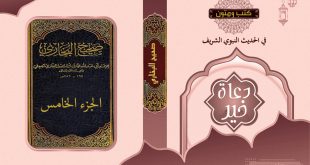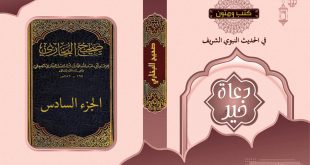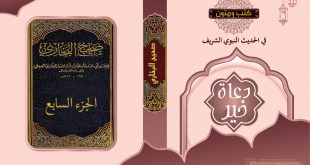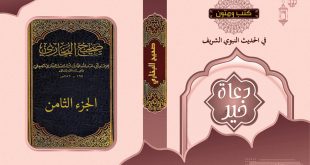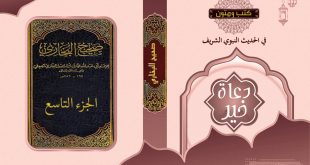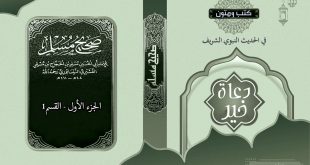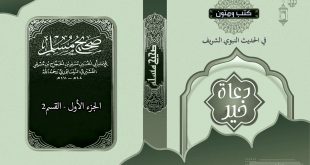فَائِدَةٌ جَلِيْلَةٌ
وممّا يدلُّ على أنّ الله شاءَ حصولَ الكفرِ قولُهُ تعالى في صفةِ الكفَّارِ يومَ القيامةِ: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ﴾ [سورة فصلت/21] الكفّارُ في حالٍ من الأحوالِ يوم القيامةِ يختمُ الله على أفواهِهِم لأنّهم كانوا أنكروا الكفرَ الذي كفَروهُ من شدَّةِ اضطرابهم فقالوا: نحنُ ما أشركنا، فمنعَ الله أفواههم من الكلامِ وأنطَقَ جوارِحَهم وجلودَهُم فشهدت عليهم بما عملوا.
وفي قوله تعالى: ﴿مَن يَشَإِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [سورة الأنعام/39] دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ الله شاءَ كفر الكافر وإيمان المؤمن فَنَفَذَ مرادُ الله.
ومعنى قوله تعالى: ﴿مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ﴾ [سورة الأنعام/111] أي أنَّ حسنات العبادِ من إيمانٍ وما يتبعهُ لا يكونُ إلا بمشيئةِ الله.
وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاء اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ [سورة الأنعام/35] أي لم يشأ هدايةَ جميعهم.
وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾ (99) أي لم يشأ للجميعِ أن يؤمنوا وإن كانَ أمرَهُم بالإيمانِ.
معنى الهداية
قال المؤلف رحمه الله: والهِدَايَةُ علَى وَجْهَينِ:
أحدُهُما: إبَانَةُ الحَقّ والدُّعاءُ إلَيهِ، ونَصْبُ الأَدِلَّةِ عليه، وعلَى هذَا الوَجْهِ يَصِحُّ إضَافَةُ الهِدَايةِ إلى الرُّسُلِ وإلَى كُلّ دَاعٍ لله.
الشرح: الهدايةُ على معنيين وأحدُ المعنَيَينِ إبانةُ الحَقّ والدّعاءُ إليه أي أمرُ النّاسِ بهِ، فالأنبياءُ بهذا المعنَى هداةٌ لأنَّهم دَلُّوا النَّاسَ على الخيرِ وبيَّنوا للنَّاسِ ما يحبّهُ الله، وحذَّروا النَّاسَ ممّا لا يحبُّهُ الله.
فالأنبياءُ وظيفتُهُم التي هي فرضٌ عليهم أن يؤدّوها البيانُ والدّلالةُ والإرشادُ، ثمَّ بعدَ ذلكَ من كانَ الله شاءَ له الاهتداءَ يهتدي بقولِ هؤلاءِ الأنبياءِ بالأخذِ بدعوتِهِم ونصيحَتهم، ومن لم يشإ الله أن يهتديَ لا يهتدي مهما رأوا من المعجزاتِ، هذا أبو جهلٍ رأى انشقاقَ القمرِ وغيرُه من صناديدِ الكُفرِ ولم يهتد منهم إلا الذي شاءَ الله له أن يهتديَ ولذلكَ بعضُ العلماء قال:
ربّ إنَّ الهُدَى هُدَاكَ وءايَا ***** تُكَ نورٌ تهدي بهَا من تَشَاء
معناهُ الآياتُ لا تَهدي بذاتِها إنَّما يهتدي بها من شاءَ الله لهم الهدايةَ، والذين لم يشإ الله لهم الهدايةَ فلا المعجزاتُ تؤثّرُ فيهم ولا العِبَرُ التي حَصَلت لمن قبلهم ممَّن كذَّبوا الأنبياءَ، فالدُّعَاءُ إلى الحَقّ يُقالُ له هدايةٌ، وكذلك نَصبُ الأَدِلَّةِ عليهِ.
قال المؤلّف رحمه الله: كَقَولِه تَعالى في رَسُولِه محمّدٍ صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [سورة الشورى/52].
الشرح: أي يا محمَّدُ أنت تدلُّ على صراطٍ مستقيمٍ، وتبيّنُ للخلقِ طريقَ الهدايةِ طريقَ الهُدَى، ليس معناه أنتَ تَخلُقُ الاهتداءَ في قلوبِ النّاسِ، فالرّسولُ لا يملكُ القلوبَ فهو يقولُ لهم ءامنوا بالله ورسولِهِ ولا تُشركوا بهِ شيئًا، هذا يقالُ له هدايةٌ، والدَّليلُ على أنَّ الهدايةَ هنا ليست بمعنَى خَلقِ الاهتداءِ في قلوبِ العبادِ أنَّ أبا طالبٍ ماتَ كافرًا، أليس الرّسولُ كان يحبُّ لأبي طالب أن يهتديَ ومع ذلك أبو طالبٍ ماتَ كافرًا، مع أنّه كانَ يحبُّ الرّسولَ ويدافعُ عنه ولكنّه ما رَضِيَ أن يَنطِقَ بالشّهادتينِ لمَّا كانَ على فراشِ الموتِ حين دخلَ عليه الرّسولُ فقالَ له: “يا عمّ قُل لا إلهَ إلا الله أشهدْ لكَ بها عندَ الله” فلم يَفعل وقالَ: إنّي على مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، وقد كان قالَ قبلَ ذلكَ: لولا أن تُعيّرني بهَا قريش لأقررتُ بها عينك، ثمَّ لمَّا ماتَ جاءَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ إلى الرَّسولِ فقالَ: يا رسولَ الله إنَّ عمَّكَ الشّيخَ الضَّالَّ قد ماتَ قال: “اذهَب فَوَارِهِ” جَهّزهُ للدَّفنِ، والرسولُ ما خرجَ في جنازتِهِ فلو كانَ يحبُّهُ لشخصِهِ كان خرجَ في جنازتِهِ، وهذا دليلٌ لنا على أنّهُ ما كانَ يحبُّ شخصهُ بل كانَ كارهًا لهُ من حيثُ كفره ولا يجوزُ اعتقادُ أن نبيًّا من الأنبياءِ يحبُّ واحدًا من الكفارِ القريبِ والبعيدِ لقولِ الله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [سورة ءال عمران/32] وأنبياءُ الله لا يحبونَ الكافرينَ لأن الله لا يحبهم، إنّما كانَ يحبُّ اهتداءَهُ، ومعنَى قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاء﴾ [سورة القصص/56]، أي يا محمَّدُ أنتَ لا تستطيعُ أن تَخلُقَ الاهتداءَ في قلبِ من أحببتَ اهتداءَهُ، فمن أحببتَ اهتداءَهُ لا تهديهِ إن شاءَ الله أن لا يهتدي، ﴿وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاء﴾ أي من شاءَ الله له الهداية في الأزلِ يهتدي.
الرّسولُ كانَ يحبُّ أن يهتديَ أبو طالبٍ لأنّه قريبُهُ ولأنّه حماهُ ولأنّه كان يناضلُ عنهُ، لكنَّ الله ما شاءَ له الإيمانَ فماتَ ولم يُسلِم، وقد سألَ العباسُ الرسولَ فقالَ: يا رسولَ الله إنَّ عَمَّكَ أبا طالبٍ كان يحبُّكَ ويناضلُ عنكَ فهل نفعته قال: “إنه يكون يوم القيامة في ضَحضَاحٍ من نارٍ، ولولا أنا لكانَ في الدَّركِ الأسفلِ من النَّار” رواه البخاري، ومعناهُ الله جَعَلَ جزاءَهُ من نارِ جهنَّم أنّ النّارَ تأخُذُ منه إلى القدمِ فقط، لا يدخل المكانَ الذي هو بُعدهُ في النّزولِ مسافة سبعينَ عامًا كغيرِهِ من الكفّارِ، الكفّارُ لا بدَّ أن يكون كلُّ واحدٍ منهم يصلُ إلى ذلكَ المكان ويُفهَمُ من قولِهِ صلى الله عليه وسلم: “ولولا أنا لكانَ في الدّركِ الأسفلِ من النّارِ” أنّ الرّسولَ نفعَهُ، ومع هذا فإنه لا يخففُ عنه بل يبقى على هذهِ الحالِ أبدَ الآبدينَ، وهذا دليلٌ على أنَّهُ لم يَمُت مُسلمًا.
قال المؤلّف رحمه الله: وقَولِهِ تَعَالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ [سورة فصلت/17].
الشرح: أي بَيَّنَّا لهم الحقَّ وَدَللنَاهُم عليهِ، وثمودُ قبيلةٌ من قبائلِ العربِ قبلَ سيّدنا محمّدٍ وهم قومُ نبيّ الله صالحٍ، ومساكنهم بعدَ المدينةِ بثلاثمائةِ كيلو مترٍ تقريبًا إلى جهةِ الشّامِ، فثمودُ بَيَّنَ الله لهم طريقَ الخيرِ فأرسلَ إليهم صالحًا فبيَّن لهم طريقَ الهُدَى طريقَ الإسلامِ فكذَّبوه، وكفروا بنبيّهم فأهلَكَهم الله، فمعنى قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُم﴾ (17) دللناهم على الحَقّ ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ (17) أي كَذَّبوا نبيَّهم فأهلَكَهُم الله بطغيانِهِم، أمرَ جبريلَ فصاحَ بهم فهلكوا. ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ (17) أي اختاروا الضَّلالَ ولم يقبلوا الإيمانَ.
فائدة: قولُهُ تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ﴾ (82) ﴿مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (83) [سورة هود].
أي على قبيلةِ لوط أمطرَ الله عليهم حجارةً كانت مسوَّمَةً أي مُعلّمةً كلّ واحدةٍ عليها علامةٌ على من تنزلُ عليهِ، وقد جمعَ الله عليهم عذابًا بأن قَلَبَ جبريلُ قُرَاهم وزَادَهم تلكَ الحجارة، أما قولُ الله تعالى ﴿عِندَ رَبِّكَ﴾ [سورة هود/83] ليسَ معناهُ أن الله تعالى بمكانٍ وأن تلك الحجارة قُربَ الله بالمسافَةِ، فليسَ للمشبهةِ في ذلكَ حجة بل هذه الآية حجةٌ عليهم، لأنه لا يُمكِنُ أن يُرادَ بها أن هذه الحجارة بجانبِ الله تعالى على مقتَضَى ما يزعمونَ من أن الله جسمٌ قاعدٌ فوقَ العرشِ، فمن شدةِ جهلهِم يحتجونَ بكلمةِ عند ربّك على إثباتِ الحيزِ والمكانِ لله، فما أبعدَهُم عن فَهمِ لغةِ العربِ.
إن كانت الوهابيةُ تنتَسِبُ إلى بني تميم التي هي إحدى قبائل العربِ المشهورةِ القديمةِ، فأجدادُهُم الذين كانوا في زَمَنِ النبي لا يفهمونَ التحيزَ والجهةَ من هذه الآياتِ المتشابهاتِ التي تَفهمُ منها الوهابيةُ التحيزَ في المكانِ والجهةِ لله إنما علمهم هذا محمد بن عبد الوهاب بما أخذه من كتب ابن تيمية المجسّم، وسبحان الله الذي يخصُّ من يشاءُ بما يشاءُ وجعلَ الفهمَ خير ما يؤتاهُ الإنسانُ.
قال المؤلّف رحمه الله: والثَّاني: مِنْ جِهَةِ هِدَايَةِ الله تعالى لعِبادِه، أيْ خَلْقِ الاهتداءِ في قُلوبِهم كقَوْلِه تعَالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [سورة الأنعام/125] والإضْلالُ خَلْقُ الضَّلالِ في قُلُوبِ أهْلِ الضَّلالِ. فَالعبادُ مشيئَتُهم تابعةٌ لمشيئةِ الله قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ﴾ [سورة الإنسان/30].
وهذه الآيةُ من أوضحِ الأدلةِ على ضلالِ جماعَةِ أمين شيخو لأنهم يقولونَ إن شاءَ العبدُ الهدايةَ يهديهِ الله وإن شاءَ العبدُ الضلالَ يضلهُ الله، فماذا يقولونَ في هذه الآيةِ: ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ﴾ (125) فإنَّهَا صريحةٌ في سبقِ مشيئةِ الله على مشيئةِ العبدِ لأنَّ الله نَسَبَ المشيئةَ إليه وما ردَّهَا إلى العبادِ. فأولئكَ كأنهم قالوا من يُرد العبدُ أن يشرحَ صدرهُ للإسلامِ يشرح الله صدرَهُ، ثم قولُهُ: ﴿وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ﴾ (125) فلا يُمكِنُ أن يرجعَ الضميرُ في يُرد أن يُضلهُ إلى العبدِ لأن هذا يجعلُ القرءانَ ركيكًا ضعيفَ العبارةِ والقرءانُ أعلى البلاغَةِ لا يوجَدُ فوقَه بلاغةٌ، فبانَ بذلكَ جهلُهُم العميقُ وغباوَتُهم الشديدةُ. وعلى مُوجَبِ كلامِهم يكونُ معنَى الآية ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ﴾ (125) أن العبدَ الذي يريدُ أن يهديَهُ الله يشرحُ الله صدرَهُ للهُدَى وهذا عكسُ اللفظِ الذي أنزلَهُ الله وهكذا كانَ اللَّازمُ على موجَبِ اعتقادِهم أن يقولَ الله والعبدُ الذي يريدُ أن يضلّهُ الله يَجعَل صدرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا، وهذا تحريفٌ للقرءانِ لإخراجِهِ عن أساليبِ اللغةِ العربيةِ التي نَزَلَ بها القرءانُ وفَهِمَ الصحابةُ القرءانَ على موجَبِها، والدليلُ على أنهم يفهمونَ القرءانَ على خلافِ ما تفهمهُ هذه الفرقةُ اتفاق المسلمينَ سلفُهُم وخَلَفُهُم على قولِهِم: ما شاءَ الله كانَ وما لم يشأ لم يَكُن.
الشرح: الهدايةُ بمعنى خَلقِ الاهتداءِ خاصّةٌ بالله تعالى، فالذي يُريدُ الله أن يهديَهُ يُحبّبُ الإسلامَ إليهِ، ومن يُرد الله أن يُضِلَّهُ يَجعَلْ صدرَهُ ضيّقًا حرجًا فلا يُحبّب الإسلامَ إليه.
والإضلالُ معناهُ خَلقُ الضَّلالِ في قلوبِ الكافرينَ، فهو سبحانه يَخلُقُ الاهتداءَ في قلوبِ من يشاءُ من عبادِهِ فضلًا منه وكرمًا، ويخلقُ الضّلالةَ في قلوبِ من يشاءُ من عبادِهِ عدلا منه لا ظُلمًا. وهذه الآية فيها دليل على فساد عقيدة المعتزلة حيث قالوا يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد فعلى قولهم الله ليس حكيمًا حيث إنه لم يجعل كلهم مؤمنين.
قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ﴾ [سورة ءال عمران/176] وهذه الآيةُ من أوضحِ الآياتِ في أن كلامَ هذه الفرقة تحريفٌ لدينِ الله لأنه قال: ﴿لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ (41) معناهُ الله ما شاءَ أن يُطَهّرَ قلوبَهُم، وهم يقولونَ هو شَاءَ ولكن هم امتنعوا، فهذا ظاهرٌ في أنَّ الله تعالى ما شاءَ لهم الإيمانَ، ومشيئةُ العبدِ تابعةٌ لمشيئةِ الله قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ﴾ [سورة الإنسان/30] معناهُ أنتم لا تكونُ منكم مشيئةٌ إلا بمشيئةِ الله، بمعنى أنَّ الله تعالى هو يخلقُ فينا هذه المشيئة. ثم بيَّنَ الله أن ما شاءَ أن يتنفذ من مشيئاتِهم التي خَلَقَهَا فيهم تَنفذُ وما لم يشأ نفوذَها لا تنفذُ كما دلَّ قولُه تعالى في حق أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [سورة القصص/56] معناهُ أن الرسولَ كان يشاءُ أن يهتديَ أبو طالبٍ لكنَّ الله ما شاءَ، فلم تنفذ مشيئة الرسولِ.
ومن الأدلَّةِ الواضحةِ في أنَّ الله هو الذي شاءَ الضَّلالَة لمن ضَلَّ من عبادِهِ قولُه تعالى: ﴿فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ [سورة المائدة/41] فالله يخاطِبُ رسولهُ بأنَّهُ شاءَ أن يضلَّ أولئكَ فَضَلّوا وكَرِهوا الإيمانَ وأنت لا تستطيعُ أن تَخلُقَ فيهم الاهتداءَ لأنَّ الله ما شاءَ أن يطهّرَ قلوبَهم من الكُفرِ، فمن هنا نَعلَمُ أنَّ الأنبياءَ وظيفتُهم التي هي فرضٌ عليهم أن يؤدوها البيانُ والدّلالةُ والإرشادُ والأمرُ والنّهيُ، ليسَ لهم قدرةٌ على خلقِ الهُدَى في قلوبهم، لا أحد يستطيعُ أن يخلُقَ الهُدَى في قلبِ عبدٍ لا مَلَكٌ ولا نبيٌّ. وقوله: ﴿وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ﴾ (41) أي ضلالته ﴿فَلَن تَمْلِكَ﴾ (41) أي يا محمّد ﴿لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا﴾ (41) ، كم من أقارب للرّسولِ ما استطاعَ الرّسولُ أن يهديَ قلوبَهم فيؤمنوا وهذا معنى قولِ الله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [سورة البقرة/272] أي لستَ مكلفًا بأن تَجعَلَهم مؤمنينَ معتقدينَ قلبًا إنما عليكَ البيانُ.
وهذه الآيةُ موافِقَةٌ لقولِهِ تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [سورة البقرة/256] وإن كان المشهورُ عند المفسرينَ أمرينِ أحدُهُما ليسَ لكَ أن تُكرِهَ أهلَ الذّمّةِ ما داموا يدفعونَ الجزيَةَ ويخضعونَ لسلطَةِ الإسلامِ ليس لكَ في هذه الحالِ أن ترفعَ عليهم السلاحَ حتى يسلموا.
والتفسيرُ الثاني: أنَّ هذا قبلَ نزولِ ءايةِ القتالِ أي ليسَ لكَ أن تُكرهَهُم على الإسلامِ الآن، ثم أنزلَ الله تعالى ءايةَ القتالِ: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [سورة التوبة/29] إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (29).
تَقدِيْرُ الله لا يَتَغيَّرُ
قال المؤلّف رحمه الله: تَقدِيْرُ الله لا يَتَغيَّرُ
صَلاةُ مُصَلّ ولا غيرُ ذلكَ منَ الحسَنَاتِ بلْ لا بُدَّ أنْ يكُونَ الخَلْقُ علَى مَا قَدَّرَ لَهُم في الأزلِ مِنْ غَيرِ أنْ يتَغيَّرَ ذَلِكَ.
الشرح: الله تعالى إذا قَدَّرَ أنَّ واحدًا من عبادِهِ يصيبُهُ كذا لا بدَّ أن يصيبَهُ ذلك الشىء ولو تصدَّقَ ذلك الإنسانُ صدقةً أو دعا أو وَصَلَ رَحِمَهُ أو عَملَ إحسانًا لأقاربِهِ لأمّهِ وأختِهِ وعمّتِهِ وخالتِهِ وأبيهِ وجدّهِ ونحوِ ذلك من أهلِهِ لو عملَ لهم إحسانًا لا بدَّ أن يتنفّذَ ما قَدَّرَ الله أن يصيبَ هذا الإنسان، ولا يجوزُ أن يعتقدَ الإنسان أنّه إن تصدّقَ بصدقةٍ أو وَصَلَ رحمَهُ أو دعا دعاءً ينجو ممّا قَدَّرَ الله أن يصيبَهُ كما يزعمُ بعضُ الناسِ في ليلةِ النصفِ من شعبانَ أنهم إن دعوا الله في هذه الليلة يذهبُ عنهم شىءٌ قَدَّرَ الله أن يصيبَهم، وهذا بخلافِ الذي يظنُّ أن الله كَتَبَ قَدَرًا مُعَلقًا بأن فلانًا إن فَعَلَ كذا يصيبُ كذا من مطالبهِ أو يدفعُ عنه شىءٌ من البلاءِ وإن لم يفعل كذا لا ينال ما طلبَهُ فهذا جائزٌ لأن الملائكةَ يكتبونَ في صُحفهم على وجهِ التعليقِ على حَسَبِ ما يتلقونَ من قِبَلِ الله تعالى فهذا لا ينافي الإيمانَ بالقَدَرِ. أمّا إن قالَ إن شاءَ الله تعالى في الأزلِ أن يصيبَني هذا الشَّىء إن لم أفعل كذا أو كذا من صلةِ الرَّحِمِ أو التَّصدقِ ونحوِ ذلك لكن عَلمَ أنّه إن دعوتُ أو تصدَّقتُ بصدقةٍ أو أحسنتُ إلى أهلي وإلى رَحِمي يُنجّيني من ذلكَ أسلمُ بالدُّعاءِ أو بالصَّدقةِ أو بصلةِ الرَّحمِ، هذا لا ضَرَرَ فيهِ.
وأمّا الذي يدعو في ليلةِ النّصفِ من شعبانَ بنيّةِ أن يَسلَمَ ممَّا قَدَّرَ الله وعَلِمَ أنّه يصيبهُ لا محالةَ هذا كافرٌ لأنّه جَعَلَ الله متغيّر المشيئةِ والعلمِ، وتغير العلمِ والمشيئةِ من صفاتِ المخلوقاتِ، وأما قولُهُ تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [سورة الرحمن/29] فليسَ معناه أن الله يغيّرُ مشيئتَهُ باختلافِ الأزمانِ والأحوالِ بل معناهُ يَخلُقُ خلقًا جديدًا، كل يومٍ يغيّرُ في خلقِهِ ولا يتغيرُ في علمِهِ ومشيئتِهِ.
وأمّا الحديثُ الذي رواه التّرمذيُّ: “لا يَرُدّ القضاء شىء إلا الدُّعاء” فالمرادُ بهِ القضاءُ المعلَّقُ، لأنَّ القضاءَ منه ما هو معلَّقٌ ومنه ما هو مُبرَمٌ لا يتغيّرُ وقد سَبَقَ شرحُ هذا، فالمعلَّقُ معناهُ أنّه معلَّقٌ في صُحُفِ الملائكةِ التي نقلوها من اللّوحِ المحفوظِ، مثلًا يكون مكتوبًا عندهم فلانٌ إن وَصَلَ رحمَهُ أو بَرَّ والديهِ أو دَعا بكذا يعيشُ إلى المائةِ أو يُعطى كذا من الرّزقِ والصّحَّةِ وإن لم يفعل ذلك يعيشُ إلى السّتين ولا يُعطَى كذا من الرّزقِ والصّحَّةِ، هذا معنى القَضَاء المعلَّق أو القَدَر المعلَّق، وليس معناهُ أنّ تقديرَ الله الأزلي الذي هو صفتُهُ معلَّقٌ على فِعلِ هذا الشَّخصِ أو دعائِهِ، فالله تعالى يَعلَمُ كلّ شىءٍ لا يخفَى عليه شىءٌ، هو يعلمُ بعلمِهِ الأزليّ أيَّ الأمرَين سيختارُ هذا الشّخص وما الذي سيصيبُهُ، واللّوحُ المحفوظُ كُتِبَ فيه ذلك أيضًا. وعلى مثلِ ذلك يُحمَلُ الحديثُ الذي رواه البيهقيُّ عن ابن عبَّاسٍ أنّه قال: “لا ينفعُ حَذَرٌ من قَدَرٍ ولكنَّ الله عزَّ وجلَّ يمحو بالدّعاءِ ما شَاءَ من القَدَرِ”، فقوله: “لا ينفعُ حَذَرٌ من قَدَرٍ” معناه فيما كتبَ من القضاءِ المحتومِ، وقوله: “ولكنَّ الله يمحو بالدُّعاءِ ما شاءَ من القَدَرِ” معناه المقدورُ.
وممَّا استدلَّ بهِ أهلُ الحقّ على أنَّ الله لا يغيّرُ مشيئتَهُ لدعاءِ داعٍ الحديثُ الذي رواه الحافظُ عبد الرّحمن بن أبي حاتمٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “سألتُ ربّي لأمتي أربعًا فأعطاني ثلاثًا ومنعني واحدةً….” الحديث، وفي رواية مسلمٍ: “سألتُ ربّي ثلاثًا فأعطاني ثِنتينِ وَمَنَعَنِي واحدةً”، وفي روايةٍ: “وإنَّ ربّي قالَ: يا محمَّدُ إنّي إذا قضيتُ قَضَاءً فإنّه لا يُرَدُّ”، فلو كانَ الله يغيّرُ مشيئتَهُ بدعوةٍ لَغَيَّرها لحبيبهِ المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنَّ الله عزَّ وجلَّ لا تتغيَّرُ صفاتُهُ.
قال المؤلّف رحمه الله: وأمَّا قَولُ الله تعالى: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [سورة الرعد/39] فليسَ مَعناهُ أنَّ المحْوَ والإثْباتَ في تَقديرِ الله، بل المعنى في هذا أنَّ الله جَلَّ ثناؤه قد كتَبَ ما يُصِيبُ العَبدَ من عبادِه من البلاءِ والحِرمَان والموتِ وغَيرِ ذلكَ وأنَّه إنْ دعَا الله تَعالى أو أطاعَه في صِلةِ الرَّحم وغَيرِها لم يُصِبْهُ ذلكَ البلاءُ ورزقَه كثيرًا أو عمَّرَهُ طويلًا، وكتَبَ في أمّ الكتابِ ما هُوَ كَائنٌ من الأَمْرين، فَالمحْوُ والإثْباتُ رَاجِعٌ إلى أحدِ الكتَابين كما أشَارَ إليه ابنُ عبّاسٍ، فقد روى البَيهقيُّ عن ابنِ عَبّاسٍ في قَولِ الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (39) قال: يَمحُو الله ما يَشَاءُ من أحَدِ الكتابين، همَا كتَابان يمحُو الله ما يشَاءُ من أحَدِهما ويُثْبِتُ وعندَه أمُّ الكتابِ. ا.هـ.
الشرح: عبدُ الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنه فَسَّرَ قولَ الله تعالى : ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (39) بالقضاءِ المُعَلَّقِ، أمّا الشَّافعيُّ رضي الله عنه فقد فَسَّرَهُ بالنَّاسخِ والمنسوخِ أي أن الله تعالى يمحو ما يشاءُ من القرءانِ أي يرفَعُ حكمهُ وينسخهُ بحكمٍ لاحِقٍ، ويثبتُ ما يشاءُ من القرءانِ فلا ينسخهُ، وما يبدَّل وما يثبت كلُّ ذلكَ في كتابٍ، وهذا في حياةِ الرّسولِ أمّا بعدَ وفاتِهِ فلا نَسخ، يقول البيهقيُّ: “هذا أصحُّ ما قيلَ في تأويلِ هذه الآيةِ”.
وأمّا قولُهُ تعالى: ﴿وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (39) أي جملة الكتاب معناهُ اللوحُ المحفوظُ يشتمِلُ على المَمحُوّ والمُثْبتِ، وأمّا في غيرِ اللّوحِ المحفوظِ ممّا يستنسخُهُ الملائكةُ أو يكتبهُ المَلَكُ في أمرٍ خاصٍّ هذا فيه ذكر أحدِ الوجهينِ، أي أنهم كتبوا في صحفِهِم مثلًا فلانٌ إن وَصَلَ رحمَهُ يعيشُ إلى المائةِ وإن لم يصل رحمهُ يعيشُ إلى الستين، أمَّا أيُّ الأمرينِ سيقَعُ أخيرًا هم لا يعرفونَ في الابتداءِ، ليسَ موكولا إلى الملائكَةِ علمُ المستقبلِ، إنَّما هم يكتبونَ ما أُمروا بهِ، وهذا بالنسبةِ لمن لم يطلعه الله منهم على الأمرينِ.
وأمّا قولُ البيهقي عن ابن عباس: “هما كتابانِ يمحو الله ما يشاءُ من أحدِهما ويثبتُ” فأحدُ الكتابين هو الذي كتبَ في اللوحِ المحفوظِ والآخرُ هو الذي في أيدي الملائكةِ الذين أُمِروا بالاستنساخِ من اللّوحِ. أنزل الله تعالى القرءانَ مُفَرّقًا على الرسولِ ثمَّ كانَ من الآياتِ ما يرفعُ بعد نزولِهِ فيخرج عن كونِهِ قرءانًا ومنه ما يبقى تلاوةً لكنَّ حكمهُ يُرفَعُ هذا يقالُ له المنسوخُ، هذا معنى الآية، أي يمحو بعض ما نَزَلَ من القرءانِ عن حكمِ القرءانِ ويثبت ما يشاءُ وهو الأكثرُ لأن المنسوخَ قليلٌ جدًّا. ومما نزلَ قرءانًا ثم رفعت تلاوتُهُ ما رواهُ أنسٌ قال: “إنا كُنَّا نقرأُ قرءانًا يا ربنا أبلغ قَومنا أنا قد لَقينا رَبَّنا فَرَضِيَ عنا وأرضَانَا” ثم رُفِعَ ذلكَ.
والنَّسخُ لا يخلو من حكمةٍ، بل هو ممَّا تقتضيهِ الحكمةُ، لأنَّ الآيةَ تنزلُ فيُعمَلُ بمقتضاها بُرهةً ثمّ يرفَعُ حكمُهَا وتأتي أخرى بدلها كانت الحكمةُ قبل رفع العملِ بها العمل بها، ثمَّ كانت مصلحةُ العبادِ في رفعِ ذلكَ الحكم، لأنَّ الأَوامرَ والنَّواهيَ الإلهيّة منها ما هي مؤبَّدةٌ ومنها ما هي مؤقَّتةٌ، فالظُّلمُ مثلًا حُرّمَ في كلّ الشّرائعِ، وكذلكَ أشياء أخرى كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
وأمّا قولُه تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [سورة الرحمن/29] فليسَ معناهُ أنَّ الله يغيّرُ مشيئتَهُ، وإنّما معناهُ كما قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “يَغفِرُ ذنبًا ويُفرّج كَربًا ويرفَعُ قومًا ويضَعُ ءاخرينَ” رواه ابن حبان، ويوافقُ هذا قول النَّاس: سبحانَ الذي يغيّرُ ولا يتغيّرُ، وهو كلامٌ جميلٌ، إذ التَّغيُّر في المخلوقاتِ وليس في الله وصفاتِهِ، وذلك كما مرَّ أن فعلَ الله صفتُهُ في الأزلِ والمفعول مخلوقٌ هذا عند كثيرٍ من السلفِ كأبي حنيفة وصاحبيهِ والبخاري وبعضِ قدماءِ الأشاعرةِ وعلى ذلكَ الطحاويُّ أبو جعفر أحمدُ بن سلامةَ المصريُّ وهو معدودٌ من السَّلَفِ لأنه ولدَ سنة مائتين وسبع وعشرينَ وتوفي سنة ثلاثمائة وإحدى وعشرين قبلَ الأشعري وقبل الماتريدي بل على كلامِ أبي جعفر هذا جمهورُ مَذهَبِ السلفِ لقولِهِ في أولِ عقيدتِهِ: “هذا ذِكرُ بيانِ عقيدةِ أهلِ السنةِ والجماعةِ”، ورجَّحَ الحافظُ ابن حجر العسقلانيُّ ذلكَ، وعلى هذا الماتريديةُ. وأما جمهورُ الأشاعرةِ فالفعلُ عندهم حادثٌ غيرُ قائمٍ بذاتِ الله إنما هو متعلق القدرةِ الأزليةِ، ومذهبُ الماتريدية أَلَّفَ فيه كثيرٌ مثل القاضي بدر خواهرزاده ألَّفَ قصيدةً جامعةً، وكلا المذهبينِ ليسَ فيه وصف الله بصفةٍ حادثةٍ، ولا يؤدي اختلافُهم إلى تبديعٍ وتفسيقٍ وتضليلٍ لأن هذا في فروعِ العقيدةِ ليس في أصولِها، وهذا كالخلاف الذي حصل فيما بين بعض الصحابة لأن الصحابة اختلفوا في رؤيةِ النبي ربه ليلةَ المعراجِ فعائشةُ وابنُ مسعودٍ نَفَيَا وأثبتَ عبدُ الله بن عباسٍ وأنسُ بن مالكٍ، وتَبِعَ كلًّا من المذهبين كثيرٌ من التابعينَ، فكما أن هذا لا يؤدي إلى تبديعِ بعضِ الصحابةِ وتفسيقِهِ كذلكَ هذا الذي جَرَى بين الماتريديةِ والأشاعرةِ لا يؤدي إلى ذلكَ. فعندَ الأشاعرة صفاتُ المعاني القائمة بذاتِ الله الأزليةُ ثمانيةٌ: الحياةُ والقدرةُ والإرادةُ والعلمُ والسمعُ والبصرُ والكلامُ والبقاءُ وذلك كما قال الشاطبيُّ:
حيٌّ عليمٌ قديرٌ والكلامُ لَهُ ***** بَاقٍ سميعٌ بصيرٌ ما أَرَادَ جَرَى
أما متأخرو الأشاعرةِ أكثرُهم يقولونَ: صفاتُ المعاني سبعةٌ: البقاءُ اعتبروه ليس من صفات المعاني، لكنَّ الإمامَ أبا الحسن الأشعريَّ عَدَّهُ صفةً من صفات المعاني ذاتيةً قائمةً بذاتِ الله ومعهُ جمهورُ الأشاعرةِ، وهذا هو المعتمدُ.
وأما المشبهةُ فعندهم ليس لله صفة ذاتية أزلية أبدية غير حادثة إلا الوجود، وقد أشركَ فيه ابنُ تيمية مع الله جنسَ العالمِ ونوعَهُ فإنه جَعَلَ جنسَ العالمِ أزليًّا لم يزل مع الله وهذا شىءٌ انفردَ فيه ابنُ تيمية من بين المشبهةِ أسلافِهِ، والعجبُ منه كيف يصحُّ عندَهُ الأزليةُ والتجددُ فإنه يقولُ إرادةُ الله أزليةُ النوعِ حادثةُ الأفرادِ بمعنَى أنه تحدُثُ له إرادةٌ بعد كل إرادةٍ، فكيفَ يصحُّ النوعُ أزليًّا مع حدوثِ الأفرادِ، هذا عندَ العقلاءِ خروجٌ عن دائرةِ العقلِ، حتى إنّ محمد عبدُه الذي فيه ما فيهِ استهجنَ كلامَ ابن تيمية في رسالتِهِ لكنه أظهرَ ترددًا في ثبوتِ ذلكَ عنهُ ولا معنَى للترددِ في ذلكَ فإنه قَرَّرَ ذلكَ في عدة من كتبهِ بإسهابٍ وإطالةٍ في العباراتِ، ولعل عباراته في ذلكَ لو جُمِعَت من كتبهِ كلها لجاءت مجلَّدًا، ومن العجبِ العجيبِ جعله هذا مذهب المحدّثينَ وهل كلُّ رأي يعجبُهُ يجعلهُ مذهبَ المحدثينَ زورًا وبهتانًا، وهل خفيَ عليهِ أن جمهورَ المحدثينَ الحفاظَ هم أشاعرةٌ وأن الدارقطنيَّ مُثنٍ على أبي الحسن الأشعري، ومن أشهرِهم وإمامِهم البيهقي، ومنهم الحافظُ أبو المكارمِ، ومنهم الحافظُ تقيُّ الدين بن دقيق العيدِ، ومنهم الحافظُ زين الدين العراقيُّ شيخُ الحافظِ ابن حجر، ومنهم شيخُ مشايخِ الحافظِ ابن حجر أبو سعيدٍ العلائيُّ، ومنهم الحافظُ سراجُ الدين بن الملقّن، ومنهم خاتمةُ الحفاظِ محمد مرتضى الزبيديُّ، وهؤلاء المذكورونَ مشاهيرُ حفاظِ الأشاعرةِ وهناكَ كثيرٌ منهم لم يبلغوا في الشهرةِ مثل هؤلاء وأما محدّثوهم فلا يُحصونَ، أما المشبهةُ كابن تيمية فمنهم من سَبَقَه كأبي إسماعيل المجسمِ ومنهم من عاصرَهُ كتلميذهِ ابن عبد الهادي، فكيفَ تصحُّ دعوَى ابن تيمية أن هذا مذهب المحدّثين وليس هذا إلا مذهب المُحْدَثين من الفلاسفة فإن الفلاسفة قال متقدموهم العالم أزلي بجنسه وأفراده، وقال المحدَثون العالم قديم بجنسه وأما أفراده حادثة، فابن تيمية لترويج رأيه الفاسد الذي وافق المحدثين من الفلاسفة افترى على المُحَدّثين فقال هذا ما عليه المحدّثون أو كثيرٌ منهم. أما كتابُ الرؤية المنسوب للأشعري الذي فيه التشبيه فقد نَفَى صحتَهُ عنهُ بعضُ الحفاظِ وهو الحافظُ علي بن المفضّل المقدسي.
ومن أعجبِ العجبِ من أمرِ ابن تيمية أنه ينفي الإجماعَ وينسبُ إلى الإمامِ أحمدَ أنه قالَ من يدَّعي الإجماعَ فهو كاذبٌ ثم هوَ في مسائل أخرى ينقُلُ الاتفاقَ والإجماعَ بل يصرّحُ بلا استحياءٍ باتفاقِ العلماءِ فضلًا عن المجتهدينَ، وأحمدُ ليس كما قالَ ابن تيمية فقد ثبتَ عنهُ القولُ بالإجماعِ في مسئلةِ بيعِ الكالئ بالكالئ وفي مسائلَ أخرى.
قال المؤلّف رحمه الله: والمحْوُ يَكُونُ في غيرِ الشَّقَاوةِ والسَّعَادةِ.
الشرح: المحوُ من الكتابِ الذي كُتِبَ يكونُ في غير السَّعادةِ والشّقاوةِ، لأنّ السّعادةَ والشّقاوةَ لا يدخلهما المحوُ والإثباتُ باعتبارِ المَئَالِ.
قال المؤلّف رحمه الله: فَقد رَوى البَيْهقيُّ أَيْضًا عَن مُجَاهِدٍ أنَّه قالَ في تفسيرِ قولِ الله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم﴾ [سورة الدخان/4] : “يُفْرَقُ في لَيْلةِ القَدْرِ مَا يكونُ في السَّنَةِ مِنْ رِزْقٍ أو مُصِيْبَةٍ، فأمَّا كِتَابُ الشَّقَاءِ والسَّعَادَةِ فَإنَّه ثَابتٌ لا يُغَيَّرُ”. اهـ.
الشرح: مجاهدُ بن جبرٍ تلميذُ ابن عباسٍ ابنِ عمّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلامَ الذي فيه دليلٌ على أنَّ قضاءَ الله المبرمَ لا يغيّرُ.
وأمّا قولُهُ تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (4) فمعناهُ كما قالَ عبدُ الله ابن عبّاسٍ ترجمانُ القرءانِ إنَّ ليلةَ القدرِ التي هي من رمضانَ هي الليلةُ التي يُفرَقُ فيها كلُّ أمرٍ حكيمٍ أي كلّ أمرٍ مبرمٍ، أي أنه يكون تقسيمُ القضايا التي تحدثُ للعالمِ من تلكَ الليلة إلى مثلِها في العامِ المقبلِ ممَّا يحدُثُ في تلكَ السّنةِ من موتٍ وصحّةٍ ومرضٍ وفقرٍ وغنًى وغيرِ ذلك ممَّا يطرأُ من الأحوالِ المختلفةِ من تلكَ الليلةِ إلى مثلِها في العامِ القابلِ، وليسَ في ليلةِ النّصفِ من شعبانَ كما يظنُّ كثيرٌ من النَّاس.
وإنما الذي وَرَدَ في الحديثِ الصحيحِ: “يَطَّلِعُ الله إلى خلقه في ليلةِ النصفِ من شعبانَ فيغفرُ لجميع خَلْقِهِ إلا لمشركٍ أو مشاحنٍ” رواه ابن حبان في صحيحه.
والمشاحِنُ معناهُ الذي بينَهُ وبينَ مسلمٍ ءاخرَ عداوةٌ وحقدٌ وبغضاء، أما من سوى هذين فكلُّ المسلمينَ يغفرُ لهم يغفرُ لبعضٍ جميع ذنوبهم ولبعضٍ بعض ذنوبهم. أما الحديثُ الآخرُ: “فيغفر لأكثر من عددِ شعرِ غنم كَلْبٍ” فغيرُ صحيحٍ، رواه ابن ماجه والترمذي وضعفه.
قال المؤلّف رحمه الله: فَلِذَلِكَ لا يَصِحُّ عن رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم الدُّعاءُ الذي فيهِ: “إنْ كنتَ كَتبتَنِي في أمّ الكتابِ عِندَكَ شَقِيًّا فَامْحُ عَنّي اسْمَ الشَّقَاءِ وأَثبتْني عِندَكَ سَعيدًا، وإن كُنتَ كتبتني في أمّ الكِتابِ مَحرُومًا مُقَتَّرًا عليَّ رِزْقي فَامحُ عَنّي حِرْمَاني وتَقْتيرَ رِزْقي وأَثبتني عندَكَ سَعِيدًا مُوَفّقًا للخَيرِ، فإنّكَ تَقُولُ في كِتابِكَ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [سورة الرعد/39]” ولا مَا أشْبَهَهُ.
الشرح: إذا تقرَّرَ هذا فلا التفاتَ إلى نسبةِ هذا الذّكرِ الذي يَعمَلُ به بعضُ الناسِ في ليلةِ النصفِ من شعبانَ الذي أولهُ: “يا مَن يَمنُّ ولا يُمنُّ عليهِ”، وفيه: “اللهم إن كنتَ كَتَبتَني في أمّ الكتابِ شَقيًّا أو مَحرومًا أو مُقتَّرًا عليَّ رزقي فامحُ اللهم شقاوَتي والإقتَار عليَّ في رزقي” إلى عمرَ ومجاهدٍ وغيرِهما مِنَ السلفِ، فلا يثبتُ شىءٌ من ذلكَ كما أشَارَ إلى ذلكَ الحافظُ البيهقيُّ في كتابِ القَدَرِ، وقد ذكرَ البيهقيُّ أن مجاهدًا قال: “ذلكَ في السعادةِ والشقاوةِ” ثم رجعَ عن ذلكَ في العامِ الذي يليهِ. ويتضمنُ ذلك الذّكرُ شذوذًا ءاخرَ وهو أن الليلةَ التي يُفرَقُ فيها كلُّ أمرٍ حكيمٍ ويُبرمُ هي ليلةُ النصفِ من شعبانَ والصحيحُ أنها ليلةُ القدرِ، لكن من يفعلُ ذلكَ كثيرٌ في عدةٍ من البلادِ ويوافِقُهم على ذلكَ بعضُ المشايخ مع إضافةِ قراءةِ سورةِ يس وغيرِها إلى ذلكَ فينبغي تحذيرهم من ذلك لأن هذا لمّا يقرؤهُ الجاهلُ الذي لم يتعلَّم العقيدةَ يظنُّ أن الله يُغيرُ مشيئتَهُ تلكَ الليلة لمن حَضَرَ هذا الاجتماعَ، واعتقادُ تغيرِ مشيئةِ الله كفرٌ لأن في ذلكَ نسبةَ الحدوثِ إلى الله والحدوثُ ينافي الألوهيةَ إلا عندَ من لا يميّزُ بينَ القِدَمِ والحدوثِ كابنِ تيمية فكأنّهُ لم يقرأ قولَ الله تعالى: ﴿هُوَ الأَوَّلُ﴾ [سورة الحديد/3] وهذا معناهُ أنَّ الله كانَ موجودًا قبلَ حدوثِ كلّ العالمِ بنوعِهِ وأفرادِهِ، وعلماءُ المسلمينَ لا يُفرّقونَ بين نوعِ العالَمِ وأفرادِهِ في أن كلًّا خلقٌ لله عزَّ وجلَّ.
وأمَّا إن كانَ هؤلاءِ الذين يقرءونَ هذا الدعاءَ المذكور يفهمونَ منه إن كانَ شاءَ الله في الأزلِ أن يُنجّينا من المصائبِ ويوسّع علينا في رزقِنَا بدعائِنَا في هذه الليلةِ، يحصلُ لنا على حسبِ علمِهِ ومشيئتِهِ الأزليين، لم يكن في ذلك ضَرَرٌ على العقيدةِ، لكنَّ هذا اللفظ الذي يقرءونَهُ غلطٌ، أما الذي يعتقدُ أنَّ الله يغيّرُ لهم مشيئتهُ إذا دعوا بهذا الدُّعاءِ بخلافِ مشيئتِهِ وعلمِهِ السابِقَينِ فهذا يكفُرُ، وإن كثيرًا من هؤلاءِ ما تعلَّموا أنَّ الله لا تَحدُثُ له مشيئةٌ جديدةٌ ولا عِلمٌ جديدٌ ولا قُدرَةٌ جديدةٌ، علمُهُ أزليٌّ أبديٌّ محيطٌ، ومشيئتُهُ أزليّةٌ أبديّةٌ، ويظنّونَ أنَّ الله تحدُثُ فيه مشيئةٌ جديدةٌ فيغيّرُ ويبدّلُ ومن اعتقدَ ذلكَ فَسَدَت عقيدتُهُ.
قال المؤلّف رحمه الله: وَلَم يَصِحَّ هذَا الدُّعاءُ أيْضًا عن عُمَرَ ولا عن مُجاهِدٍ ولا عن غيرِهما منَ السَّلَفِ كَما يُعلَمُ ذلكَ مِن كِتَابِ “القَدَرِ” للبَيهقيّ.
الشرح: ألفَ الحافظُ البيهقيُّ كتابًا سماهُ “كتاب القَدَر” وسَّعَ فيه الكلامَ في هذا الأمر، وقد ذكرَ في هذا الكتابِ أنّه لم يثبت لا عن سيّدنا عمرَ ولا عن مجاهدٍ ولا غيرِهما ذاكَ اللفظُ المرويُّ في ليلةِ النّصفِ من شعبانَ، لكن بعضهُ يُروَى عن سيّدنا عمرَ ولم يثبت وبعضهُ يُروى عن مجاهدٍ ولم يثبت.
قال البيهقي في كتاب القدر وأما ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن إسماعيل السكري حدَّثنا أبو قريش، حدَّثنا أبو محمّد نصر بن خلف النيسابوري، حدَّثنا يعلى بن عبيد، حدَّثنا عبد الرَّحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: ما دعا عبد بهذه الدعوات إِلا وسَّع الله عليه في معيشته: يا ذا المنّ ولا يُمنُّ عليك، يا ذا الجلال والإِكرام، يا ذا الطَّوْل لا إِلهبهه إِلا أنت، ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، ومأمن الخائفين، إن كنت كتبتني في أمّ الكتاب عندك شقيًّا فاثمح عنّي اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدًا، وإن كنت كتبتني في أُمّ الكتاب محرومًا مقتّرًا عليَّ رزقي فاثمح عنّي حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدًا موفقًا للخير، فإنك تقول في كتابك: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (39) انتهى.
قال: فهذا موقوف.
وروي عن أبي حكيمة، عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطّاب وهو يطوف بالكعبة يقول: اللَّهمَّ إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتَ عليَّ الشّقوة والذنب والمَقت فامحني وأثبتني في السعادة ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (39). انتهى. هكذا رواه حمّاد بن سلمة، عن أبي حكيمة، وبمعناه رواه هشام الدَّستوائي، عن أبي حكيمة مختصرًا وقال: “فإِنَّك تمحو ما تشاء وتُثبت وعندك أمّ الكتاب”. انتهى. وأبو حكيمة اسمه عصمة بصري تفرَّد به فإن صحَّ شىء من هذا فمعناه يرجع إلى ما ذكرنا من محو العمل والحال. وتقدير قوله: اللَّهمَّ إن كنت كتبتني أعمل عمل الأشقياء وحالي حال الفقراء برهة من دهري فاثمح ذلك عنّي بإثبات عمل السعداء وحال الأغنياء، واجعل خاتمة أمري سعيدًا موفّقًا للخير فإِنَّك قلت في كتابك: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء﴾ (39) أي من عمل الأشقياء ﴿وَيُثْبِتُ﴾ (39) أي من عمل السعداء ويبدّل ما يشاء من حال الفقر ويثبت ما يشاء من حال الغنى.
ثمَّ المحو والإِثبات جميعًا مسطوران في أُمِّ الكتاب، وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو منصور النَضْرُويي، حدَّثنا أحمد بن نجدة، حدَّثنا سعيد بن منصور، حدَّثنا جرير، عن منصور قال: قلت لمجاهد: ما تقول في هذا الدعاء: اللَّهمَّ إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فاثمحه منهم واجعله في السعداء، فقال: حسن. ثم مكثت حولا فسألته عن ذلك فقال: ﴿حم﴾ (1) ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ (2) ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ (3) ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (4) [سورة الدخان]. قال: يفرق في ليلة القدر ما يكون في السّنة من رزق أو مصيبة، فأمَّا كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يُغيَّر. انتهى كلام البيهقي، يعني رجع عن قوله الأول إلى الثاني.
ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد، حدَّثنا أحمد بن عبيد الله يعني النَّرسِي، حدَّثنا عبيد الله بن موسى، حدَّثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس في قوله عزَّ وجلّ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [سورة الرعد/39] قال: “يريد أمر السماء، يعني في شهر رمضان، فيمحو ما يشاء غير الشقاء والسعادة والموت والحياة”. انتهى.
وأخبرنا أبو زكريا، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي، حدَّثنا عثمان بن سعيد، حدَّثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبّاس في قوله: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء﴾ (39) يقول: “يُبدِّل الله ما يشاء من القرءان فَيَنْسَخُهُ، ﴿وَيُثْبِتُ﴾ (39) يقول: يثبت ما يشاء لا يُبدله، ﴿وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (39) يقول: جملة ذلك عنده في أمّ الكتاب الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب”، هذا أصحّ ما قِيل في تأويل هذه الآية وأجراه على الأصول، وعلى مثل ذلك حملها الشافعي رحمه الله؛ ومن أهل العلم من زعم أَنَّ المراد بالزيادة في العمر نفي الآفات عنه والزيادة في عقله وفهمه وبصيرته. انتهى كلام البيهقي.
فأنظر أيُّها الطالب الوقوف على الحقيقة وتأمَّل أنَّ هذه الألفاظ المروية عن ابن مسعود وعمر وابن عبّاس ليس فيها هذه الكلمات التي اعتادَ بعض الناس قراءتها في ليلة النصف من شعبان إِنَّما المذكور في ذلك بعضُ ما يقرءونه. واثعلم أنَّ البيهقي لم يصحِّح شيئًا من هذه الروايات وقد أتى بصيغة التردّد فيما روى عن عمر للدلالة على عدم ثبوته، وترجيحُهُ أن يكون المعنى المراد بالآية الناسخَ والمنسوخَ دليلٌ على أنه لم يثبت عنده ما سوى ذلك. وأنت قد رأيت أنَّ البيهقي لم يعرِّج على الكلمة التي اعتادوها وهي: “اللَّهمَّ أسألك بالتجلّي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم” بالمرَّة، بل الصحيح أنَّ تلك الليلة هي ليلة القدر كما يفهم ذلك من قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ [سورة الدخان/3] مَعَ قولِهِ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [سورة القدر1].
فلا تكنْ أسيرَ التقليد في غير معنى.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة