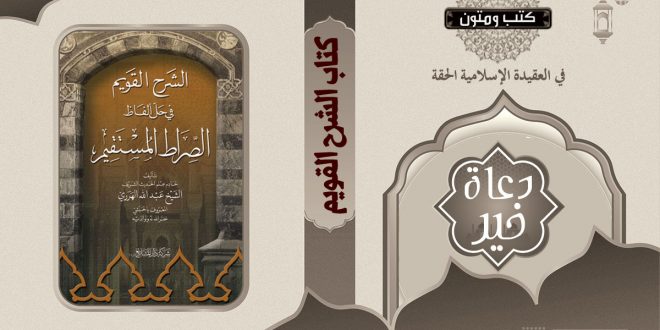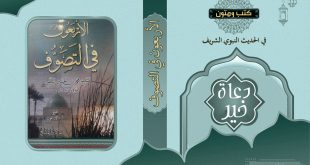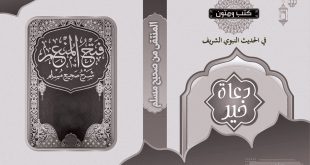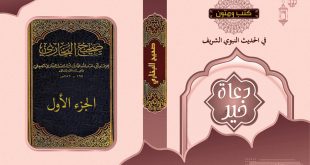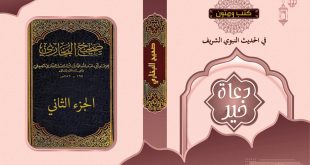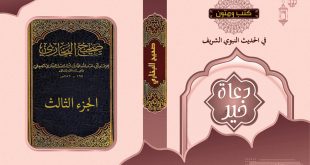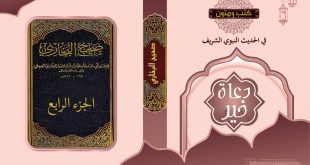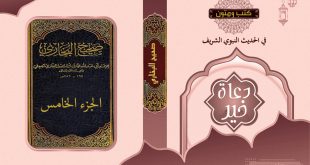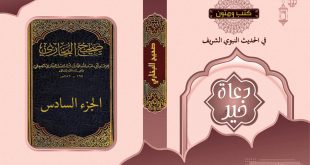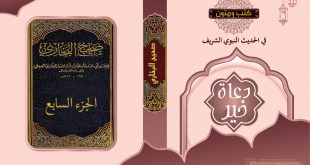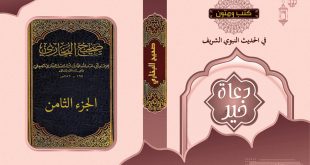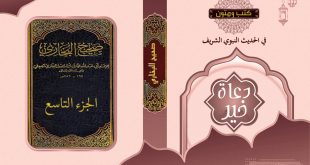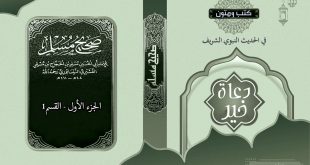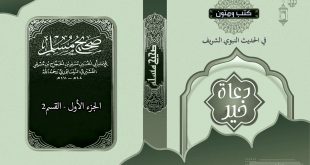تفسير قوله تعالى: ﴿مِن رُّوحِنَا﴾
قال المؤلف رحمه الله: تفسير قوله تعالى: ﴿مِن رُّوحِنَا﴾ (12) وقوله تعالى: ﴿مِن رُّوحِي﴾ (72).
لِيُعْلَمْ أنَّ الله تَعالى خَالِقُ الرُّوح والجَسَدِ فَلَيسَ رُوحًا ولا جَسَدًا، ومَعَ ذلِكَ أضَافَ الله تَعَالى رُوحَ عِيسَى صلى الله عليه وسلم إلى نَفْسِه على مَعْنى المِلْكِ والتَّشْريفِ لا للجُزْئِيَّةِ في قَولِه تَعالى:﴿مِن رُّوحِنَا﴾ [سورة الأنبياء/91]، وكذلكَ في حَقّ ءادَمَ قولُهُ تعَالى ﴿مِن رُّوحِي﴾ [سورة ص/72] فَمعنَى قَولِهِ تَعالَى: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا﴾ [سورة الأنبياء12] أَمَرْنَا جِبْرِيلَ عليهِ السّلامُ أنْ يَنفُخَ في مَرْيمَ الرّوحَ التي هِي مِلْكٌ لَنا ومُشَرَّفَةٌ عِنْدَنَا.
الشرح: كِلتا الإضافتينِ للتَّشريفِ مع إثباتِ الملكِ أي أنهما ملكٌ لله وخلقٌ له، فإن قيلَ كلُّ الأرواحِ ملكٌ لله وخلقٌ له فما فائدةُ الإضافَةِ؟ قيل: فائدةُ الإضافةِ الدّلالةُ على شرفهِمَا عندَ الله. ولا يجوزُ عقلًا أن يكونَ الله روحًا لأن الرّوحَ حادثٌ. وعلى مثلِ ذلكَ يُحمَلُ حديثُ: “خلقَ الله ءادمَ على صورتِهِ” رواه البخاري، ومعناهُ إضافة الملك والتشريف لا إضافة الجزئية أي على الصّورةِ التي خَلَقَهَا وجعلَهَا مشرَّفةً مكرَّمةً.
الشّىءُ يضافُ إلى الله إما بمعنى أنه خَلقٌ لهُ هوَ خَلَقَهُ وكَوَّنَهُ ويضافُ إلى الله على أنه صفتهُ، فإذا قلنا قدرةُ الله علمُ الله هذه الإضافةُ إضافةُ الصّفةِ إلى الموصوفِ، أما إذا قلنا ناقة الله بيت الله هذه إضافةُ المِلكِ والتَّشريفِ، فالكعبةُ نسمّيها بيت الله وكلُّ مسجدٍ كذلكَ.
قال المؤلف رحمه الله: لأَنَّ الأَرْواحَ قِسْمَانِ: أَرْوَاحٌ مُشَرَّفَةٌ، وَأَرْوَاحٌ خَبِيثَةٌ، وَأرْوَاحُ الأنْبِيَاءِ منَ القِسْمِ الأوَّلِ، فَإِضَافَةُ رُوحِ عِيسَى ورُوح ءادَمَ إلى نَفْسِه إضَافَةُ مِلك وتَشْريفٍ. ويَكفُر من يَعتَقدُ أنَّ الله تعالى روحٌ، فالرّوحُ مخلوقةٌ تَنزَّهَ الله عن ذلِكَ.
الشرح: حتى نَعرفَ أن الله أعطى عيسى وءادمَ منزلةً عندَهُ أضافَ روحَ عيسى وءادمَ إلى نفسهِ ليس على معنى الجزئيّةِ، وكما أضافَ ناقة صالحٍ إلى نفسِهِ فقال ﴿نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا﴾ [سورة الشمس/13] لما كانَ لها من خصوصيّةٍ على غيرها من النُّوقِ بالشّأنِ العظيمِ الذي كان لها، لأنه هو خالقُهَا هو الذي أخرجَهَا من الصَّخرةِ وأخرجَ معها فصيلها وكانت تعطي أهلَ البلدِ كفايتهم من الحليبِ فيأخذونَ منها الحليبَ في يومِ ورودِها الذي هي خُصصَت بهِ الذي لا تَرِدُ مواشيهم به، فدلَّ ذلكَ على مكانَتِها فأنزلَ الله على نبيّه ﴿نَاقَةَ اللهِ﴾ (13) وقد أنذروا أن يعتدوا على ناقةِ الله وعلى سُقياها أي اليوم الذي تَرِدُ فيهِ إلى الماءِ، ذلك اليوم لا تورد مواشيهم الماء.
قال المؤلف رحمه الله: وكذَلِكَ قَولُه تَعَالى في الكَعْبةِ ﴿بَيْتِيَ﴾ [سورة الحج/26] فَهِيَ إضَافَةُ مِلكٍ للتشريفِ لا إضَافَةُ صِفَةٍ أو مُلابَسَةٍ لاسْتِحَالَةِ المُلامَسَةِ أو المُماسَّةِ بَيْنَ الله والكَعْبَةِ. وكذلك قولُ الله تعالى: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ﴾ [سورة المؤمنون/116] ليسَ إلا للدلالةِ على أن الله خالقُ العرشِ الذي هو أعظمُ المخلوقاتِ ليسَ لأن العرشَ له ملابَسَةٌ لله بالجلوسِ عليهِ أو بمحاذاتِهِ من غيرِ جلوسٍ، ليس المعنى أن الله جالسٌ على عرشِهِ باتصالٍ وليس المعنى أن الله محاذٍ للعرشِ بوجودِ فراغٍ بينَ الله وبينَ العَرشِ إن قُدّرَ ذلكَ الفراغُ واسعًا أو قصيرًا كلُّ ذلكَ مستحيلٌ على الله، وإنما مزيةُ العرشِ أنه كعبةُ الملائِكَةِ الحافينَ من حولِهِ كمَا أن الكعبةَ شُرفَت بطوافِ المؤمنينَ بها. ومن خواصّ العرشِ أنه لم يُعصَ الله تعالى فيهِ، لأنَّ مَن حولَهُ كُلُّهم عبادٌ مكرمونَ لا يَعصونَ الله طرفةَ عينٍ، ومن اعتقدَ أن الله خلقَ العرشَ ليجلِسَ عليهِ فقد شَبَّهَ الله بالملوكِ الذين يعملونَ الأسِرةَ الكبارَ ليجلسوا عليها ومن اعتقدَ هذا لم يَعرِف الله.
الشرح: إضافةُ الصّفةِ هي كقولنا: قدرةُ الله وعلمُ الله ونحو ذلك، وأما الملابسةُ فهي علاقةٌ بين شيئينِ بمعنى الاتّصالِ ونحوِه، إذا كانَ شىءٌ متَّصلًا بشىءٍ قد يضافُ إليه من أجلِ هذه العلاقة، إذا أريدَ الإخبارُ عن سكنِ زيدٍ وإقامتِهِ بأرضٍ فقِيل فلانٌ بلدهُ البصرةُ، فالملابسةُ بين زيدٍ والبصرةِ هي السَّكنُ والإقامةُ فإضافةُ البيتِ إلى الله ليست من هذا القبيل. كذلكَ إضافةُ صورةِ ءادَم إلى الله ليست من بابِ الجزئيةِ فمن اعتقدَ أن الله روحٌ فاقتطعَ من ذاتِهِ الذي هو روحٌ قطعةً فجعلها ءادمَ فكأنه قالَ إن الله وَلَدَ ءادمَ، ومن قالَ إن معنى خَلقَ الله ءادمَ على صورتِهِ أي صورة تشبهُ الله فقد كَفَرَ أيضًا، فلم يبقَ تفسيرٌ صحيحٌ للحديثِ إلا أن يُقالَ إضافةُ المِلكِ إلى مالِكِهِ بمعنى التشريفِ أو أن يقالَ على ما هوَ الغالبُ عندَ السلفِ خَلَقَ الله ءادمَ على صورتِهِ بلا كيفٍ.
ولما قال الله تعالى في القرءانِ الكريمِ عن الكعبةِ لإبراهيمَ وإسماعيلَ ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾ [سورة البقرة/125] فذلك لِيُفهمنا أن للكعبة عندَه مقامًا عاليًا وأنها مشرفةٌ عندَهُ، وهذا ليسَ من بابِ إضافةِ الصّفةِ ولا من بابِ إضافةِ المُلابسَةِ كما في قولِكَ صاحبُ زيدٍ عمرو، عمرٌو صاحب أضيفَ إلى زيدٍ للملابسةِ لأن بينهما علاقة الصُّحبَةِ.
قال المؤلف رحمه الله: ويَكفُرُ من يَعتَقِدُ المُمَاسَّةَ لاسْتِحالتِها في حَقِّ الله تَعَالى.
الشرح: لأنَّ ذلك يؤدّي إلى جَعلِ ذاتِ الله مقدَّرًا مَحدودًا متناهيًا. إذا دخلتَ بيتًا فاستندتَ إلى جدارِهِ هذا يقالُ له مماسَّةٌ لَمَسَ جسمُكَ جسمَهُ.
تَفْسِيرُ الآيَةِ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾
قال المؤلف رحمه الله: تَفْسِيرُ الآيَةِ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [سورة طه/5].
يَجِبُ أن يكونَ تفسيرُ هذه الآية بغيرِ الاستِقْرارِ والجلُوسِ ونحوِ ذلكَ ويَكْفُر منْ يعتَقِدُ ذَلِكَ.
الشرح: الذي يعتقدُ أن معنى قولِ الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) جَلَسَ أو استقرَّ أو حاذَى العرشَ يكفُرُ.
قال المؤلف رحمه الله: فَيَجِبُ تَركُ الحَمْلِ علَى الظّاهِر بَلْ يُحمَلُ على مَحْمِلٍ مُسْتَقِيمٍ في العُقُولِ فتُحمَلُ لفْظَةُ الاسْتِواءِ علَى القَهْرِ ففي لُغَةِ العَرَبِ يُقَالُ اسْتَوى فُلانٌ على المَمَالِكِ إذَا احْتَوَى علَى مَقَالِيدِ المُلْكِ واسْتَعْلَى علَى الرّقَابِ.
الشرح: ءايةُ الاستواءِ تُحمَلُ على القهرِ، أو يقالُ استوى استواءً يليقُ به، أو يقالُ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) بلا كيفٍ، أما من أرادَ التّأويلَ التّفصيليَّ فيقولُ قَهَرَ ويجوزُ أن يقولَ استولى.
ومعنى قول المؤلف: “واستعلى على الرّقَابِ” أي استولى على الأشخاصِ أي على أهلِ البلدِ.
ومعنى قَهرِ الله للعرشِ الذي هو أعظمُ المخلوقاتِ أن العرشَ تحت تصرُّفِ الله هو خلقَهُ وهو يحفظهُ، يحفظُ عليهِ وجودهُ ولولا حفظُ الله تعالى له لهوَى إلى الأسفلِ فتحطَّمَ، فالله تعالى هو أوجدَهُ ثم هو حفظهُ وأبقاهُ، هذا معنى قَهَرَ العرشَ، هو سبحانَهُ قاهرُ العالمِ كلّه، هذه الشّمسُ والقمرُ والنّجومُ لولا أن الله يحفظُها على هذا النّظامِ الذي هي قائمةٌ عليه لكانت تهاوَت وحطَّمَ بعضُها بعضًا واختلَّ نظامُ العالمِ.
والإنسانُ قهرَهُ الله بالموتِ، أيُّ مَلِكٍ وأيُّ إنسانٍ رُزِقَ عمرًا طويلًا لا يملكُ لنفسِهِ أن يحميَ نفسَهُ من الموتِ فلا بدَّ أن يموتَ.
وليُعلَم أن الاستواءَ في لغةِ العربِ له خمسة عشرَ معنًى كما قالَ الحافظُ أبو بكر بن العربيّ ومن معانيهِ: الاستقرارُ والتَّمامُ والاعتدَالُ والاستعلاءُ والعلوُّ والاستيلاءُ وغير ذلك، ثم هذه المعاني بعضُها تليقُ بالله وبعضُها لا تليقُ بالله. فما كان من صفات الأجسام فلا يليق بالله.
يقولُ حسن البنّا في كتابِ العقائدِ الإسلاميَّةِ: “السَّلفُ والخلفُ ليس بينهم خلافٌ على أنه لا يجوزُ حملُ ءايةِ الاستواءِ على المعنى المتبادرِ” وهذا الكلام من جواهِرِ العلمِ.
فإن قالَ الوهَّابيُّ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) “على” أي فوق، يقالُ لهم: فماذا تقولونَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [سورة المجادلة/10] هل يفهمونَ من هذه الآية أن العبادَ فوق الله؟ فإن “على” تأتي لعلوّ القدرِ وللعلوّ الحِسّيّ، وقد قالَ الله تعالى مُخبرًا عن فرعون أنه قالَ: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾ [سورة النازعات/24] أرادَ علوَّ القهرِ بقولِهِ: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾ (24).
وقد ذَكَرَ الإمامُ أبو منصورٍ الماتريديُّ في تأويلاتِهِ في قولِهِ تعالى ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [سورة الأعراف/54] يقولُ: “أي وقد استوى”، ومعناهُ أنَّ الله كانَ مستويًا على العرشِ قبلَ وجودِ السمواتِ والأرضِ، وبعضُ الناسِ يتوهَّمُ من كلمةِ “ثم” أن الله استوى على العرشِ بعد أن لم يكن يظنُّونَ أن ثُمَّ دائمًا للتّأخُّر، ويصحُّ في اللُّغة أن يقالَ أنا أعطيتُكَ يوم كذا كذا وكذا ثم إني أعطيتُكَ قبلَ ذلك كذا وكذا، فإن “ثم” ليست دائمًا للتَّأخُّرِ في الزَّمنِ، أحيانًا تأتي لذلكَ وأحيانًا تأتي لغيرِ ذلكَ، قال الشَّاعر: إِنَّ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أبُوهُ ***** ثُمّ قَدْ سَادَ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّهْ ويُروى عن أمّ سلمةَ إحدى زوجاتِ الرّسولِ ويروى عن سفيانَ بنِ عيينةَ ويروى عن مالكِ بن أنسٍ أنهم فَسَّروا استواءَ الله على عرشِهِ بقولهم: الاستواءُ معلومٌ ولا يقالُ كيفٌ والكيفُ غيرُ معقولٍ. ومعنى قولهم: “الاستواءُ معلومٌ” معناهُ معلومٌ ورودُهُ في القرءانِ أي بأنه مستوٍ على عرشِهِ استواءً يليقُ به، ومعنى: “والكيفُ غير معقولٍ” أي الشَّكلُ والهيئةُ والجلوسُ والاستقرارُ هذا غير معقولٍ أي لا يقبلُهُ العقلُ ولا تجوزُ على الله لأنها من صفات الأجسامِ، وسُئِلَ الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه عن الاستواءِ فقال: “استوى كما أخبَرَ لا كما يَخطُرُ للبشرِ”.
وقد ثبَت عن الإمامِ مالكٍ بإسنادٍ قويّ جيدٍ أنه قال في استواء الله: “استوى كما وَصَفَ نفسَهُ ولا يقالُ كيف وكيف عنه مرفوعٌ”، ولا يصحُّ عن مالكٍ ولا عن غيرِهِ من السلفِ أنه قال الاستواءُ معلومٌ والكيفيةُ مجهولةٌ فهذه العبارةُ لم تَثبُت من حيثُ الإسنادُ عن أحدٍ من السلفِ، وهي موهِمَةٌ معنًى فاسدًا وهو أن استواءَ الله على العرشِ هو استواءٌ له هيئةٌ وشكلٌ لكن نحنُ لا نعلمُهُ وهذا خلافُ مرادِ السلفِ بقولهم: “والكيفُ غيرُ معقول”. وهذه الكلمةُ قالها بعض الأشاعرة مع تنزيهِهِم لله عن الجسميةِ والتحيزِ في المكانِ والجهةِ وهي كثيرةُ الدورانِ على ألسنةِ المشبهةِ والوهابيةِ لأنهم يعتقدونَ أن المرادَ بالاستواءِ الجلوسُ والاستقرارُ أي عند أغلبِهم وعندَ بعضِهم المحاذاةُ فوق العرش من غير مماسة، ولا يدرونَ أن هذا هو الكيفُ المنفيُّ عن الله عند السلفِ، ولا يُغتَرُّ بوجودِ هذه العبارةِ في كتابِ إحياء علومِ الدينِ ونحوهِ ولا يريدُ مؤلفُهُ الغزاليُّ ما تفهمُهُ المشبهةُ لأنه مُصَرّحٌ في كتبِهِ بأنَّ الله منزهٌ عن الجسميةِ والتحيزِ في المكانِ وعن الحَدّ والمقدارِ لأن الحدَّ والمقدارَ من صفاتِ المخلوقِ قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [سورة الرعد/8]. فالتحيز في المكان والجهة من صفات الحجم والله ليس حجمًا. وما يوجد في بعض كتب الأشاعرة من هذه العبارة الاستواء معلوم والكيفية مجهولة غلطة لا أساس لها عن السلف لا عن مالك ولا عن غيره وهي شنيعة لأنها يفهم منها المشبه الوهابيّ وغيره أن الاستواء كيفٌ لكن لا نعلمه مجهول عندنا. وأما من أوردها من الأشاعرة فلا يفهمون هذا المعنى بل يفهمون أن حقيقة الاستواء غير معلوم للخلق فالوهابية تقصد بها ما يناسب معتقدها من أن الله حجم له حيّز. والعجب منهم كيف يقولون إنّ الاستواء على العرش حسيّ ثم يصفونه بالكون مجهولا. ولعلهم يريدون بهذا هل هو قعود على شكل تربيع أم على شكل ءاخر.
فإن قيلَ: لماذا قالَ الله تعالى بأنه استوى على العرشِ على حَسَبِ تفسيرِكم بمعنى قَهَر وهو قَاهرُ كلّ شىءٍ؟ نقول لهم: أليسَ قال: ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [سورة التوبة] مع أنه ربُّ كلّ شىءٍ؟!
قال المؤلف رحمه الله: كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:
قَد اسْتَوَى بِشْرٌ علَى العِراقِ ***** مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ ودَمٍ مُهْراقِ
الشرح: “مهراق” تُلفظ القافُ المكسورةُ وكأنَّ في ءاخرِها ياءً ولو لم تكن الياءُ مكتوبةً، والمعنى أنه سَيطَرَ على العراقِ ومَلَكَهَا من غير حَربٍ وإراقَةِ دِمَاءٍ.
قال المؤلف رحمه الله: وفَائِدَةُ تَخْصِيص العَرْشِ بالذّكْرِ أنَّهُ أعْظَمُ مَخلُوقَاتِ الله تَعَالى حجمًا فيُعْلَمُ شُمُولُ ما دُوْنَه مِنْ بَابِ الأَوْلَى. قَالَ الإمَامُ عَلِيٌّ: “إنَّ الله تَعَالى خَلَقَ العَرْشَ إِظْهَارًا لقُدْرَتِهِ، ولمْ يَتّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ”. رواهُ الإمامُ المحدثُ الفقيهُ اللغويُّ أبو منصورٍ التميميُّ في كتابهِ التبصرة.
الشرح: إذا قلنا: الله تعالى قَهَرَ العرشَ معناهُ قَهَرَ كلَّ شىءٍ وإنما خصَّ العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات حجمًا وهو محدود لا يعلم حده إلا الله. وبئسَ معتقدُ ابن تيمية فإنه قال: الله محدود لكن لا يعلم حده إلا هو اهـ فيقال لمن يقول قوله هذا قد قلت الله محدود لكن لا يعلم حده إلا هو فقد شبهته بالعرش فماذا يفيد قولكم في الله إن له حدًّا لكن لا يعلم حده إلا هو.
فإن قيلَ: كيفَ تقولونَ خَلقَهُ إظهارًا لقدرتِهِ ونحنُ لا نَراهُ؟ نقولُ: الملائكةُ الحافُّونَ حولَهُ يرونَهُ والملائكةُ لما ينظرونَ إلى عِظَمِ العرشِ يزدادونَ خوفًا ويزدادونَ عِلمًا بكمالِ قدرةِ الله، لهذا خَلَقَ الله العرشَ. وقولُ سيدنا علي الذي مرّ ذكره رواهُ الإمام أبو منصورٍ البغداديُّ في كتابه التبصرة.
قال المؤلف رحمه الله: أَوْ يُقَالُ: اسْتَوَى اسْتِوَاءً يَعْلَمُهُ هُوَ مَع تَنزِيْهِهِ عن اسْتِواءِ المخْلُوقِيْنَ كَالجُلوسِ والاسْتِقرارِ.
الشرح: مَن شَاءَ يقولُ: استوى استواءً يليقُ بهِ من غير أن يُفَسّرَهُ بالقهرِ أو نحوِه فيكونُ أوَّل تأويلًا إجماليًّا، ومن شَاءَ أوَّلَ تأويلًا تفصيليًّا فقال: استوى أي قَهَرَ.
قال المؤلف رحمه الله: واعْلَم أَنَّه يَجِبُ الحَذَرُ مِنْ هؤلاءِ الذينَ يُجِيزُوْنَ علَى الله القُعُودَ علَى العَرْشِ والاسْتِقْرارَ عليه مُفَسّرينَ لِقَوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) بالجُلُوسِ أو المحاذاةِ من فوق.
الشرح: هؤلاءِ هم الوهّابيّةُ وقَبلهم أناسٌ كانوا يعتقدونَ ذلكَ ففسَّروا الآيةَ بالجلوسِ فقالوا: الله تعالى قاعدٌ على العرشِ، هؤلاءِ يجبُ الحَذَرُ منهم.
قال المؤلف رحمه الله: ومُدَّعِينَ أَنَّه لا يُعْقَلُ مَوْجُودٌ إلا في مَكَانٍ، وحُجَّتُهم دَاحِضَةٌ.
الشرح: يقولون: كيفَ يكونُ موجودٌ بلا مكانٍ، والموجودُ لا بدَّ له من مكانٍ، الله موجود إذًا له مكانٌ، وحجَّتُهم هذهِ داحضةٌ باطلةٌ، لأنهُ ليسَ من شرطِ الوجودِ التحيزُ في المكانِ أليسَ الله كان موجودًا قبل المكانِ والزمانِ وكلّ ما سواهُ بشهادةِ حديثِ: “كان الله ولم يكن شىءٌ غيرُهُ” فالمكانُ غيرُ الله والجهاتُ والحجمُ غيرُ الله فإذًا صحَّ وجودُهُ تعالى شرعًا وعقلًا قبلَ المكانِ والجهاتِ بلا مكانٍ ولا جهةٍ، فكيفَ يستحيلُ على زعم هؤلاءِ وجودُهُ تعالى بلا مكانٍ بعد خلقِ المكانِ والجهاتِ. ومصيبةُ هؤلاءِ أنهم قاسوا الخالقَ على المخلوقِ قالوا: كما لا يُعقَلُ وجودُ إنسانٍ أو مَلَكٍ أو غيرِ ذلكَ من الأجسامِ بلا مكانٍ يستحيلُ وجودُ الله بلا مكانٍ فَهَلَكوا.
قال المؤلف رحمه الله: ومُدَّعِيْنَ أيضًا أنَّ قَوْلَ السَّلَفِ اسْتَوى بلا كَيْفٍ مُوافِقٌ لذَلِكَ وَلم يَدْرُوا أنَّ الكَيْفَ الذي نَفاهُ السَّلَفُ هُوَ الجُلُوسُ والاسْتِقْرارُ والتّحَيُّزُ إلى المَكَانِ والمُحَاذاةُ وكلُّ الهيئاتِ من حركةٍ وسكونٍ وانفعَالٍ.
الشرح: المحاذاةُ والجلوسُ والاستقرارُ هذا الكيفُ الذي نفاهُ السَّلفُ الذين قالوا في قوله تعالى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) استوى بلا كيفٍ، ومرادُهُم بقولهم بلا كيفٍ ليسَ استواءَ الجلوسِ والاستقرارِ والمحاذاةِ. المحاذاةُ معناهُ كونُ الشّىءِ في مقابلِ شىءٍ، فنحنُ حينَ نكونُ تحتَ سطحٍ فنحنُ في محاذاتِهِ، وحينَ نكونُ في الفضاءِ نكونُ في محاذاةِ السماءِ، والسماءُ الأولى تحاذي السماءَ التي فوقَها، والكرسيُّ يحاذي العرشَ، والعرش يحاذي الكرسيّ من تحت، والله تَعَالَى لا يجوزُ عليهِ أن يكونَ هكذا على العرشِ محاذيًا لهُ فلا يجوزُ أن يكونَ جالسًا عليهِ ولا أن يكونَ مضطجِعًا عليهِ ولا أن يكونَ في محاذاتِهِ، إذ المحاذي إما أن يكونَ مساويًا للمحاذَى وإما أن يكونَ أكبر منهُ وإما أن يكونَ أصغر منهُ، وكلُّ هذا لا يصحُّ إلا للشّىء الذي له جِرمٌ ومساحةٌ والذي له جِرمٌ ومساحةٌ محتاجٌ إلى من رَكَّبَهُ، والله منزَّهٌ عن ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: قالَ القُشَيْرِيُّ: “والذي يَدْحَضُ شُبهَهُم أَنْ يُقالَ لَهُم: قَبْلَ أنْ يَخْلُقَ العَالَمَ أو المَكَانَ هَلْ كَانَ موجودًا أمْ لا؟ الشرح: من أرادَ أن يَكسِرَ هؤلاءِ المشبهةَ يقولُ لهم: هل الله كانَ موجودًا قبلَ المكانِ أم لا؟ فإن قالوا: نعم كان موجودًا يقال لهم: إذًا وجودُهُ بلا مكانٍ صحيحٌ، لأنَّكم اعترفتُم أنهُ قبلَ المكانِ كانَ موجودًا بلا مكانٍ، نحنُ نقولُ: والآنَ هو موجودٌ بلا مكانٍ.
قال المؤلف رحمه الله: فَمِنْ ضَرُورَةِ العَقْلِ أنْ يَقُولُوا بَلَى فَيَلْزَمُه لَوْ صَحَّ قَولُه لا يُعْلَمُ مَوجُودٌ إلا في مَكَانٍ أحَدُ أمْرَينِ: إمَّا أنْ يَقُولَ: المكانُ والعَرْشُ والعَالَمُ قَدِيمٌ، وإمَّا أَنْ يَقُولَ: الرَّبُّ مُحْدَثٌ، وهذا مآلُ الجَهَلةِ الحشوِيّةِ، لَيْسَ القَدِيمُ بالمُحْدَثِ والمُحْدَثُ بالقَدِيمِ” اهـ.
الشرح: هذا نهايةُ كلام الحشْويّةِ، وهم الذين يثبتونَ لله المكانَ، يقالُ لهم: ليسَ القديمُ بالمحدَثِ ولا المحدَثُ بالقديمِ، أي القديمُ لا يكونُ محدَثًا والمحدَثُ لا يكونُ قديمًا، والمحدَثُ هو المخلوقُ أي الذي لم يكن موجودًا ثم صارَ موجودًا وهو العالَمُ. والحشويَّةُ بتسكينِ الشينِ ويقالُ بفتحهَا.
وقَالَ القشيريّ أَيْضًا في التَّذكِرَةِ الشَّرقِيَّةِ: “فَإنْ قِيلَ ألَيْسَ الله يَقُولُ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [سورة طه/5] فَيَجبُ الأَخْذُ بظَاهِرهِ، قُلْنَا: الله يَقُولُ أَيْضًا: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [سورة الحديد/4]، ويقولُ: ﴿أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [سورة فصلت/54] فَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ نَأْخُذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الآياتِ حَتَّى يَكُونَ عَلى العَرْشِ وعِنْدَنا ومَعَنا ومُحِيطًا بالعَالَمِ مُحْدقًا بهِ بالذَّاتِ في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ.
الشرح: إن قالت المشبهةُ المجسمةُ لنا: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) نأخذُ بظاهرِهِ فنقولُ إنهُ هناكَ ونُثبِتُ أنهُ ساكنٌ على العرشِ قاعدٌ عليه أو مستقرٌّ، قلنا لهم: الله تعالى قالَ أيضًا: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ (4) وقالَ: ﴿أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (54) فنحنُ إذَا على زَعمِكُم أخذنَا بظاهرِ هاتينِ الآيتينِ كما أنتم أخذتُم بظاهرِ استوَى فقلتم ساكنٌ فوقُ، فيكونُ الله تعالى على كلامِكُم معَنَا وعلى العرشِ ومحيطًا بنا وبالعالمِ هكذا كالدَّائرَةِ فهل هذا يصحُّ عندكم؟ فإن حملتُم أنتم تلكَ على ظاهِرِهَا ونحنُ حملنَا هاتين الآيتينِ على ظاهِرِهِمَا، الله على زَعمِكُم يكونُ بذاتِهِ فوقَ العرشِ ويكونُ بذاتِهِ مع كلّ شخصٍ في الأرضِ ويكونُ كالدّائرةِ المحيطةِ بما فيها فماذا تقولونَ؟ فليسَ لهم جوابٌ، فهل يصحُّ في العقلِ أن يكونَ الله بذاتِهِ فوق، وهو بذاتِهِ مع كلّ شخصٍ لأن ظاهرَ قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ (4) أنه مع هذا بذاتِهِ ومع هذا ومع هذا، وظاهرَ قول الله تعالى: ﴿أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (54) أن يكونَ هو كالدّائرةِ تحيطُ بما فيها بما في ضِمنِهَا، فهذا لا يُعقَلُ أي أن يكونَ الشَّىءُ الواحِدُ في أماكنَ متعدّدةٍ بذاتٍ واحدٍ، هذا معنى قولِ أبي نصرٍ القشيريّ رحمَهُ الله وهو حجةٌ مفحمَةٌ قاطعَةٌ.
قال القشيريّ رحمه الله: والوَاحِدُ يَسْتَحِيلُ أنْ يَكُونَ بذَاتِهِ في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ بِكُلّ مَكَانٍ.
الشرح: الشَّىءُ الواحِدُ بعينِهِ لا يصحُّ في العقلِ أن يكونَ في كلّ مكانٍ، أما ما يقولهُ الصُّوفيَّةُ: إن الوليَّ يكونُ له شبحٌ مثاليٌّ أي غير الجسمِ الأصليّ فلا يحيلُهُ العقلُ لأنهم لا يقولونَ الذّاتُ الذي هنا بعينِهِ هناكَ يكونُ، إنما يكونُ مثالُهُ.
قال القشيريّ رحمه الله: قَالُوا: قَولُه: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ (4) يَعْني بالعِلْم، و:﴿بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (54) إحَاطَةَ العِلْمِ، قُلْنَا: وقَوْلُه: ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) قَهَرَ وحَفِظَ وأَبْقَى”، انتهى.
قال المؤلف رحمه الله: يعني أَنَّهُم قَد أَوَّلُوا هَذِهِ الآيَاتِ وَلَمْ يَحْمِلُوها علَى ظَواهِرِهَا فَكَيفَ يَعِيْبونَ علَى غَيْرِهم تَأْوِيلَ ءايةِ الاستِواءِ بالقَهْرِ، فَما هَذا التّحَكُّمُ؟! الشرح: إن قالوا: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ (4) أي بعلمِهِ أي عالمٌ بنا أينَما كُنَّا وليسَ معناهُ على الظَّاهِرِ أنهُ مَع هذا ومَع هذا، وإن قالوا الإحاطةُ إحاطةُ العلمِ، نقولُ لهم: نحنُ كذلكَ نُؤوّلُ استَوى بِقَهَرَ كما أنتم أوَّلتم هاتينِ الآيتينِ فما هذا التحكُّمُ أي ما هذه الدَّعوَى التي بلا دليلٍ.
ثم قال القشيري رحمه الله: “ولَو أشعرَ مَا قُلنا تَوَهُّمَ غَلَبَتِهِ لأَشْعَر قَولُه: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [سورة الأنعام/18] بذَلِكَ أَيْضًا حَتَّى يُقَالَ كانَ مَقْهُورًا قَبْلَ خَلْقِ العِبَادِ هَيْهاتَ إذْ لَم يَكُنْ للعِبَادِ وجُودٌ قَبْل خَلْقِه إيَّاهُمْ بَلْ لَو كَانَ الأمْرُ على ما توهّمَهُ الجَهَلَةُ مِنْ أنّهُ اسْتِواءٌ بالذّاتِ لأَشْعَرَ ذَلِكَ بالتَّغَيُّرِ واعْوِجَاجٍ سَابقٍ علَى وَقْتِ الاسْتِوَاءِ فإِنَّ البَارِئ تَعَالَى كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ العَرْشِ، ومَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: العَرْشُ بالرَّبّ اسْتَوى أمْثَلُ مِنْ قَوْلِ من يَقُولُ الرَّبُّ بالعَرْشِ استَوى، فَالرَّبُّ إذًا مَوْصُوفٌ بالعُلُوّ وفَوْقِيَّةِ الرُّتْبَةِ والعَظَمَةِ ومُنزَّهٌ عَنِ الكَوْنِ في المَكَانِ وعَنِ المُحَاذَاةِ” اهـ.
الشرح: المحاذاةُ المقابلةُ، والله تعالى منزَّهٌ عن أن يكونَ في مقابلةِ العرش، فإن قالوا: قَهَرَ يدلُّ على أنهُ كان مُغَالبًا، أي أنهُ كانَ يتشاجرُ ويتغالبُ مع غيرِهِ فلا يصحُّ هذا التّأويلُ، نقول لهم: هوَ تباركَ وتعالى قالَ: ﴿وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [سورة الرعد/16] إذًا يلزم على قولكم هنا أن يكون مغالبًا ثم غلب فهل تقولونَ بذلكَ؟ قال القشيري رحمه الله: “وقَدْ نَبغَتْ نَابِغَةٌ مِنَ الرَّعَاع لَوْلا اسْتِنْزَالُهم للعَوامّ بمَا يَقْرُبُ من أَفْهامِهِم ويُتَصَورُ في أوْهَامِهِم لأَجْلَلتُ هذَا الكِتَابَ عن تلطيخِهِ بذِكْرِهم، يَقولونَ: نَحنُ نأْخُذُ بالظَّاهِرِ ونَحْملُ الآياتِ المُوهِمَةَ تَشْبِيهًا والأخْبارَ المُوهِمَةَ حَدًّا وعُضْوًا علَى الظَّاهِر ولا يَجُوزُ أنْ نُطَرّقَ التَّأْويلَ إلى شَىءٍ مِن ذَلكَ، ويَتمَسَّكُونَ على زَعْمِهم بقَولِ الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ﴾ [سورة ءال عمران/7]. وهَؤلاءِ والذِي أَرْوَاحُنا بِيَدِهِ أَضَرُّ علَى الإسْلامِ مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى والمَجُوسِ وعَبَدَةِ الأَوْثَانِ لأَنَّ ضَلالاتِ الكُفَّارِ ظَاهِرَةٌ يَتَجَنَّبُها المُسْلِمُونَ، وهَؤلاءِ أَتَوا الدّينَ والعَوَامَّ مِنْ طَرِيْقٍ يَغْتَرُّ بِه المُستَضْعَفُونَ فَأَوْحَوا إلى أَوْليَائِهمْ بهَذِهِ البِدَعِ وأَحَلُّوا في قُلُوبِهم وَصْفَ المَعْبُودِ سُبْحَانَه بالأَعْضاءِ والجوَارِحِ والرُّكوبِ والنُّزولِ والاتّكاءِ والاسْتِلْقاءِ والاسْتِوَاءِ بالذّاتِ وَالتّرَدُّدِ في الجِهَاتِ.
الشرح: التَّردُّدُ أي التَّنقُّلُ في الجهاتِ، والرَّعَاعُ أي السُّفَهَاءُ، وهؤلاءِ أوهموا الناسَ أن الله تعالى لهُ حركةٌ وتردُّدٌ في الجهاتِ وأن له أعضاء لأنهم يُورِدون هذه الآياتِ ويقولونَ نحنُ نأخذُ بالظَّاهرِ وهؤلاءِ ضَرَرُهم كبيرٌ.
قال القشيري رحمه الله: “فَمن أَصْغَى إِلى ظَاهِرِهم يُبَادِرُ بِوَهْمِه إِلى تَخيُّلِ المَحْسُوسَاتِ فَاعْتَقَدَ الفَضَائِحَ فَسَالَ بِه السَّيْلُ وَهُوَ لا يَدْرِي”. اهـ.
الشرح: المحسوسات معناه الأشياء التي نراها بأعيننا من المخلوقات، فهؤلاء المشبهة يوهمون الناس أن الله مثل ذلك، مثل هذه الأشياء البشرِ والضَّوء ونحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: فَتَبيَّنَ أنَّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: “إِنَّ التَّأْوِيلَ غَيرُ جَائِزٍ” خَبْطٌ وَجَهْلٌ وهُوَ مَحْجُوجٌ بقَولِه صلى الله عليه وسلم لابنِ عَبّاسٍ: “اللّهُمَّ عَلّمْهُ الحِكْمَة وتَأْوِيلَ الكِتَابِ” رواهُ البُخَارِيُّ وابنُ مَاجَه وغَيْرُهُما بألْفَاظٍ مُتَعَدّدَةٍ.
الشرح: قولُهُ عليهِ الصّلاةُ والسَّلامُ لعبدِ الله بن عبّاسٍ: “اللهمَّ عَلّمهُ الحِكمَةَ والتَّأويلَ” أي أن الرسولَ دَعَا له أن يعلمهُ الله تأويلَ القرءانِ والحديثِ، هذا الحديثُ يَكسِرهُم فيقالُ لهم: كيفَ تُنكِرونَ التَّأويلَ والرسولُ دَعَا لابن عبّاسٍ بالتّأويلِ فلو كانَ غير جائزٍ فيكونُ الرسولُ صلى الله عليه وسلم على زَعمِكُم دعا بدعاءٍ غير جائزٍ.
قال المؤلف رحمه الله: قَالَ الحَافِظُ ابنُ الجَوْزيّ في كِتَابِهِ “المَجَالِسُ”: “ولا شَكَّ أنَّ الله اسْتَجَابَ دُعَاءَ الرّسُولِ هذا” اهـ، وشَدَّدَ النَّكِيرَ والتَّشْنِيعَ علَى مَنْ يَمْنَعُ التَّأْوِيلَ وَوَسَّعَ القَوْلَ في ذَلِكَ، فَلْيُطَالِعْهُ مَنْ أرَادَ زِيَادَةَ التّأَكُّدِ.
الشرح: الحافظُ ابن الجوزيّ الحنبليّ تَكلَّمَ بهذا الأمرِ بقوَّةٍ فمَن شَاءَ أن يَعرِفَ هذا الموضوع أكثر فَليُطَالِع كُتُبَ ابن الجوزيّ ككتابه الباز الأشهب، وكتابه دفع شبه التشبيه بأكفّ التنزيه، وكتابه أخبار الصفات فإن فيها تشنيعًا كبيرًا على الحنابلة الذين يجسمون الله وينسبون التجسيم لأحمد وهو برىء من ذلك. ويكفي في تفنيد ذلك ما قاله صاحب الخصال من الحنابلة قال أحمد: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر اهـ. فهم كاذبون في انتسابهم لأحمد.
قال المؤلف رحمه الله: ومَعْنَى قَوْلِه تَعَالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ [سورة النحل/50] فَوْقِيّةُ القَهْرِ دُونَ المكانِ والجِهَةِ أي لَيْسَ فوقيةَ المَكانِ والجهَةِ.
ومَعْنى قَولِه تعالى: ﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [سورة الفجر/22] لَيْسَ مَجِيءَ الحَرَكَةِ والانْتِقَالِ والزَّوَالِ وإفْراغِ مَكَانٍ وَمَلْءِ ءاخَرَ بالنسبة إلى الله ومَن اعْتَقَدَ ذَلِكَ يَكْفُرُ.
الشرح: معناهُ بالنسبةِ إلى الملائكَةِ المجيءُ المحسوسُ الذي هو حركةٌ وانتقالٌ، فهذهِ الآيةُ فيها استعمالُ اللفظِ الواحِدِ لمَعنَيينِ مُختَلِفَينِ.
قال المؤلف رحمه الله: فالله تَعَالى خَلَقَ الحَرَكَةَ والسُّكُونَ وكُلَّ مَا كَانَ مِنْ صِفَاتِ الحَوَادِثِ فلا يُوْصَفُ الله تعَالى بالحَرَكَةِ وَلا بالسُّكُونِ، والمَعْنيُّ بِقَوْلِهِ: ﴿وَجَاء رَبُّكَ﴾ (22) جَاءَ أمْرُ رَبّكَ أيْ أثَرٌ مِنْ ءاثَارِ قُدْرَتِه. وقَدْ ثَبَتَ عَن الإمَامِ أحْمَدَ أنَّهُ قَالَ في قَولِه تَعَالَى ﴿وَجَاء رَبُّكَ﴾ (22) إنمَا جَاءَتْ قُدْرَتُه، رَوَاهُ البَيهَقِيُّ في مَنَاقِبِ أحْمدَ وقَدْ مَرَّ ذكره.
الشرح: تقدم تفصيل ذلكَ فيما قَدَّمنا مِن هذا الشرحِ.
تَفْسِيرُ مَعِيَّةِ الله المَذْكُورَةِ في القُرْءَانِ
قال المؤلف رحمه الله: تَفْسِيرُ مَعِيَّةِ الله المَذْكُورَةِ في القُرْءَانِ.
وَمَعْنَى قَولِه تَعَالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [سورة الحديد/4] الإحاطةُ بالعِلْمِ.
الشرح: أي محيطٌ بكم عِلمًا لا يَخفَى عليه شىءٌ أينما كنتم. وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [سورة ق/16] معناهُ أنَّ الله تعالى أعلمُ بالعَبدِ من نفسِهِ، هُوَ أعلمُ بنا من أنفسِنا، الله تعالى تعظيمًا لنفسِهِ يقولُ ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾ (16) أي إلى العبدِ ﴿مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (16) الوريدُ عرقانِ في الإنسانِ من جَانِبَي الرقبةِ ينزلانِ من الرَّأسِ ويتَّصلانِ بعرقِ القلبِ.
وقد قال النازليُّ صاحبُ التَّفسيرِ المعروفِ: “لا يجوزُ أن نقولَ إنهُ تعالى بكلّ مكانٍ، وهذا قولُ جهلةِ المتصوّفةِ”، وقال الشيخُ عبد الوهَّابِ الشَّعرانيُّ: قالَ عليٌّ الخوَّاصُ – يعني شيخهُ في التصوفِ -: “لا يجوزُ أن يقالَ إنه تعالى بكلّ مكانٍ”، وأوَّلُ من قالَ هذا القول رجلٌ اسمُهُ جهمُ بن صفوانَ.
قال المؤلف رحمه الله: وتَأْتي المَعِيَّةُ أَيْضًا بمعْنى النُّصْرَةِ والكِلاءَةِ، كقَولِه تعَالى: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ﴾ [سورة النحل/128].
الشرح: معنى الآيةِ أن الله مع الذين يخافونَهُ، أي ينصرُهُم ويحفظُهُم، وليسَ معناهُ يمشي ويَنتَقِلُ مَعهم، فإنَّ الله تعالى نَصَرَ الأولياءَ وحفظَهُم من أن يُغرقَهُم الشّيطانُ في المعاصي، وما أقبح قول ابن تيمية إنّ الله على العرش حقيقة ومعنا حقيقة. هذا مع أنه ثبت عنه أنه قال: إن الله بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر اهـ وقد صدق قول الحافظ أبي زرعة العراقي فيه: علمه أكبر من عقله اهـ أي محفوظاته أكبر من فهمه أي أنه فاسد الفهم كثير الحفظ.
وأما النَّصرُ إن كانَ بالنّسبةِ للأعداءِ كالكفّارِ فالمؤمنُ منصورٌ معنًى ولو كانَ بحسبِ الظَّاهرِ أصابَهُ من العدوّ تلفُ مالٍ ونفسٍ، فهو منصورٌ لأن الحقَّ مَعَهُ، فكم من نبيّ قَتَلَهُ الكفَّارُ، والأنبياءُ ليسوا هَيّنينَ عندَ الله، أما أعداؤهُم فهم المغلوبونَ لأنهم على باطلٍ وفي الآخرةِ ليسَ لهم إلا العذابُ الأليمُ، أما أولياءُ الله فهم في الدنيا منصورون بالحجة وأحيانًا بالحجة والغلبة الظاهرة وفي الآخرة منصورون حجة وظاهرًا وهذا معنى قول الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءامَنُوا﴾ الآية [سورة غافر/51]. فمعنَى معيّةِ الكلاءةِ والنُّصرةِ يحفظُهُم من أن يغرقوا في المعاصي فَيَصيروا أُسَرَاءَ للشّيطانِ.
المعيَّةُ الأولى في قولِه تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ (4) تشملُ جميعَ الخلقِ المؤمنَ والكافرَ، لأن الله عالمٌ بأحوالِ الجميعِ، بأحوالِ المؤمنينَ وبأحوالِ الكافرينَ لا يَخفَى عليه شىءٌ، أما معيَّةُ الكلاءةِ والنُّصرَةِ فهي خاصَّةٌ بالمؤمنينَ الأتقياء.
تنبيهٌ: قولُهُ تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الروم/47] أي أننا نتفضَّلُ ونتكرَّمُ عليهم، وليس المعنَى أنه فرضٌ على الله لأنه لا يجبُ شىءٌ على الله، فالله تعالى ليسَ لأحدٍ حقٌّ لازمٌ عليه أي أمرٌ يلزمُهُ وهو مجبورٌ عليهِ وإن تَرَكَهُ يكونُ ظالمًا، الله منزَّهٌ عن ذلك، إنما الله متفضّلٌ على عبادِهِ المؤمنينَ بأن يكرمَهُم إن هم أدَّوا ما عليهم، ومن هنا كَرِهَ الإمامُ أبو حنيفةَ أن يقولَ الرّجلُ: أسألُكَ بحقّ فلانٍ، لأنه يَرَى أن هذه العبارة توهِمُ أن على الله حقًّا لخلقِهِ لازمًا له فمن هذهِ الحيثية كَرِهَ ذلكَ، ثم غيرُ أبي حنيفة يَرَى أن هذه العبارة لا تُوهِمُ ذلك إنما معناهُ أسأَلكَ بما لفلانٍ عندَك من الفضلِ والكرامةِ أن تعطيَنَا كذا وكذا، وهذا هو القولُ الصَّحيحُ الرَّاجحُ لثبوته في الحديث وهو حديث “أسألك بحق السائلين عليك” إلى ءاخره. فإنه حديث حسن كما قال الحافظ ابن حجر وغيره.
قال المؤلف رحمه الله: ولَيسَ المعْنِيُّ بِهَا الحلولَ والاتّصالَ ويَكْفرُ مَنْ يَعتَقِدُ ذَلِكَ لأَنَّهُ سُبْحانَهُ وتَعَالى مُنَزَّهٌ عن الاتّصالِ والانْفِصَالِ بالمَسَافَةِ. فَلا يُقَالُ إنَّه مُتَّصِلٌ بالعَالَم ولا مُنْفَصِلٌ عَنْهُ بالمَسَافَةِ لأَنَّ هذِهِ الأمُور مِنْ صِفَاتِ الحَجمِ والحجمُ هو الذي يَقبَلُ الأمرَينِ والله جلَّ وعَلا لَيْسَ بحادِثٍ، نفَى ذلكَ عن نفسِهِ بقولِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ (11).
الشرح: لا يجوزُ على الله أن يكون متَّصلًا بالعالمِ ولا منفصلًا عن العالمِ بالمسافةِ، وحينما يراهُ المؤمنونَ في الآخرةِ بعدما يدخلونَ الجنَّةَ يرونَهُ بلا مسافةٍ بينهم وبينَهُ، لا يرونَهُ حجمًا لطيفًا ولا حجمًا كثيفًا ولا بمسافةٍ قريبةٍ أو بعيدةٍ.
قال المؤلف رحمه الله: وَلا يُوصَفُ الله تَعَالى بالكِبَرِ حَجْمًا ولا بالصّغَرِ، ولا بالطُّولِ ولا بالقِصَرِ، لأَنَّهُ مُخالِفٌ للحَوادِثِ، ويَجبُ طَرْدُ كُلّ فِكْرَةٍ عَن الأَذْهَانِ تُفْضِي إلى تَقْدِيرِ الله تَعالى وتَحدِيدِه.
الشرح: كلُّ شىءٍ يوهِمُ أن الله له حجمٌ ومساحةٌ وكميَّةٌ يجبُ إخراجُهُ من القلبِ لأن الله منزَّهٌ عن ذلكَ كُلِّهِ. فالحجمُ حادِثٌ مهما كان صغيرًا أو كبيرًا، وأصغرُ الأشياءِ يقالُ له الجوهرُ الفردُ وهو لا ينقسِمُ وأعظمُ الأجرامِ هو العرشُ، والله تعالى لا يُشبهُ هذا ولا هذا. كلُّ شىءٍ فيه تأليفٌ وتركيبٌ محتاجٌ إلى من ألَّفَهُ وركَّبَهُ والله منزَّه عن أن يكونَ كذلكَ، فالمؤمنُ يُريحُ ضميرَهُ باعتقادِ أنه مهما تصوَّرَ ببالِهِ فالله بخلاف ذلك، فإذا لَزِمَ هذا ارتاحَ ضميرُهُ.
فكلُّ الخواطرِ التي تؤدّي إلى جَعلِ الله تعالى ذا مقدارٍ وشكلٍ وهيئةٍ تُنبَذُ وتُطردُ، فالمؤمنُ يتركُ هذه الخواطر وينشغلُ بغيرِها، وقد قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الحديثِ الذي رواه عنه أبو القاسم الأنصاريُّ: “لا فِكرَةَ في الرَّبّ” معناهُ أن الله تعالى لا يُدرِكُهُ الوَهمُ، لأن الوهمَ يُدرِكُ الأشياءَ التي ألِفَهَا أو هي من جنسِ ما ألفَهُ كالإنسانِ والغمامِ والمطرِ والشجرِ والضوءِ والظلامِ والريحِ والظلِ ونحوِ ذلك، والأشياءُ الحادثةُ لو لم يرها الإنسانُ كالعرشِ يستطيعُ أن يتصوَّرها ولو من بعضِ الوجوهِ، وكذلك إذا ذُكِرَت لنا الجنةُ يمكننا أن نتصوَّرَها في أوهامِنا فنصادفُ الحقيقةَ في بعضِ الصفاتِ ونخطئ في بعض الصفاتِ، أما الله تعالى فلا تدركهُ تصوراتُ العبادِ وأوهامُهُم وقد قال أبيُّ بن كعبٍ الذي هو من مشاهير الصحابةِ في تفسيرِ قولهِ تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى﴾ (42) : “إليهِ ينتهي فِكرُ من تَفَكَّرَ” رواهُ أبو القاسم الأنصاريُّ في شرحِ الإرشادِ.
قال المؤلف رحمه الله: كَانَ اليَهُودُ قَدْ نَسَبُوا إلى الله تعالى التَّعَبَ، فَقَالوا إنَّه بَعْدَ خَلْقِ السَّمواتِ والأرْضِ استَراحَ فاسْتَلْقَى علَى قَفَاهُ، وقولهم هَذَا كُفرٌ.
والله تعَالى مُنزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، وعَنِ الانْفِعالِ كالإحْسَاسِ بالتَّعبِ والآلام واللذَّاتِ، فالذي تَلحَقُهُ هَذِهِ الأحْوالُ يَجبُ أنْ يكُونَ حَادِثًا مَخْلُوقًا يَلْحَقُه التّغَيُّرُ، وهَذا يَسْتَحيلُ عَلى الله تعَالى.
قالَ تَعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ [سورة ق/38].
الشرح: اليهودُ قالت إن الله خَلَقَ السَّموات والأرضَ في ستَّةِ أيّامٍ ثم استراحَ يومَ السَّبتِ فاستلقى على قَفَاهُ، جعلوهُ جسمًا له أعضاءٌ، وكذلك المشبهةُ جعلتهُ جسمًا له أعضاء فقالت إنه جالس على العرش. فالمشبهةُ إخوةُ اليهودِ وإن ظنوا بأنفسِهم أنهم مُوحّدونَ وقد أخبرَ الله تعالى أنه خَلَقَ السَّموات والأرضَ وما أصابَهُ من لُغوبٍ واللغوبُ معناهُ التعبُ، لأن الله منزَّهٌ عن التَّعبِ وعن كُلّ الانفعالاتِ، ومنزَّهٌ عن الغضبِ بالانفعالِ والرّضَا بالانفعالِ.
فائدةٌ: خُلِقَت الأرضُ يومَ الأحدِ والاثنينِ ثم خُلِقَت السَّمواتُ في اليومين التاليين الثلاثاء والأربعاء، ثم خُلِقَت البهائمُ والأشجارُ الخميس والجمعة، ثم دُحِيَت الأرضُ، والدَّحوُ هو البَسطُ بأن خَلَقَ فيها الأشجارَ والأنهارَ وسائرَ المرافِقِ وذلك معنَى قولِ الله: ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [سورة النازعات/30] وليس معنَى الدحو جعلها كرويةً وهذا خلافُ اللغةِ، ثم خُلِقَ ءادمُ ءاخر يومِ الجمعةِ، وكلُّ يومٍ من هذه الأيّامِ السّتةِ التي خُلِقَت فيها السَّمواتُ والأرضُ قَدرُ ألفِ سنةٍ بتقديرِ أيَّامنا هذهِ. وكلُّ شىءٍ ينتفعُ بهِ ابنُ ءادم خُلقَ قبلَ ابن ءادم، البهائمُ خلقت لننتفعَ بها وكذلكَ الطّيورُ قالَ تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [سورة الجاثية/13].
والأرضُ مسطوحةٌ شبيهةٌ بالكرةِ لا تنافي بينَ الأمرينِ بين سَطحِهَا وبينَ شبههَا بالكرةِ، لأن معنَى مسطوحة موسَّعة، قال تعالى: ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [سورة النازعات/30] معناهُ وسَّعَهَا، وليس معنَى قوله تعالى: ﴿وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [سورة الغاشية/20] أنها ليست شبيهةً بالكرةِ، فالأرضُ لها شبهٌ بالكرةِ وهي واسِعَةٌ.
قال المؤلف رحمه الله: إنَّما يَلْغَبُ مَن يَعْمَلُ بالجَوارِحِ والله سُبْحَانَهُ وتَعَالى مُنزَّهٌ عن الجارِحَةِ.
الشرح: الذي يلغَبُ هو الذي يفعلُ بالجوارحِ أما من فعلُهُ بلا جارحة ولا حركةٍ ولا ءالةٍ ولا مباشرةٍ بل بالقدرةِ والإرادةِ والعلمِ فلا يَلغَبُ أي لا يلحقهُ تَعَبٌ.
قال المؤلف رحمه الله: قال تَعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة غافر/20].
الشرح: البارئ موصوف بالبصرِ أي بالرُّؤية، وبالسَّمع أي أنه يسمَعُ الأصواتَ لا بسمع حادث عند حدوث الأصوات، ويرى ذاته والمخلوقات برؤية أزلية ليست برؤية تحدث له عند حدوث المرئيات وذلك لأن ذلك شأن العباد يسمعون الأصوات بسمع يحدث لهم عند حدوثها ويرون المبصَرات برؤية تحدث لهم عند رؤيتها.
قال المؤلف رحمه الله: فَالله تَعالى سَميعٌ وبَصيرٌ بلا كيْفِيَّةٍ، فالسَّمْعُ والبَصَرُ هُمَا صِفَتَانِ أزَليّتانِ بلا جَارحَةٍ، أيْ بلا أُذُنٍ أوْ حَدَقَةٍ وبلا شَرْطِ قُرْبٍ أو بُعْدٍ أو جِهَةٍ، وبدُوْنِ انبِعَاثِ شُعاعٍ منَ البَصَرِ، أو تَمَوُّجِ هَوَاءٍ.
ومَنْ قَالَ لله أُذُنٌ فَقَدْ كَفَرَ، ولَو قَالَ لَه أُذُنٌ لَيْسَت كآذانِنا، بِخلافِ مَنْ قالَ لهُ عَيْنٌ ليسَتْ كعُيُونِنَا وَيَدٌ لَيْسَت كأَيدينَا بل بمَعْنَى الصّفَةِ فَإنَّهُ جَائِزٌ لوُرُودِ إطْلاقِ العَيْنِ واليَدِ في القرءانِ ولَم يَرِدْ إطْلاقُ الأُذُنِ عَلَيْهِ.
الشرح: لا يجوزُ أن يقالَ لله أُذُنٌ ليست كآذانِنَا لأنه لم يَرِد إطلاقُ الأذنِ مضافًا إلى الله لا في الكتابِ ولا في السنةِ، أما أن يقالَ لله عينٌ ليست كأعيننا، أو لله يدٌ ليست كأيدينا، أو لله وجهٌ ليس كوجوهِنا فيجوزُ لأن ذلك وَرَدَ في الشَّرعِ لكن مع تنزيهِ الله عن الجارحةِ، ولا نقيسُ على اليدِ والوجهِ والعينِ لأن هذا وَرَدَ وذاك لم يَرِد، قالَ أبو الحسن الأشعري: “ما أَطلَقَ الله على نفسِهِ أطلقناهُ عليهِ وما لا فلا”.
وأما الحديثُ الذي فيه: “لله أشدُّ أَذَنًا” فالأَذَنُ هو الاستماعُ وليس الأُذُنُ.
تَفْسِيرُ قَولِه تَعَالى: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾
قال المؤلف رحمه الله: تَفْسِيرُ قَولِه تَعَالى: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ (115).
قَالَ تَعَالى:﴿وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة/115]، المَعْنَى: فأَيْنَما تُوَجّهُوا وجُوْهَكُم في صَلاةِ النَّفْلِ في السَّفرِ فَثمَّ قِبلَةُ الله، أيْ: فتِلْكَ الوِجْهَةُ التي تَوجَّهْتُم إِلَيْها هِيَ قِبْلَةٌ لَكُم، ولا يُرادُ بالوَجْهِ الجَارِحَةُ. وحُكْمُ مَنْ يَعتَقِدُ الجَارحَةَ للهِ التَّكْفِيْرُ، لأَنَّهُ لَو كَانَتْ لَهُ جَارِحَةٌ لكانَ مِثْلًا لنَا يَجُوزُ عَليه مَا يَجُوزُ عَلَيْنا مِنَ الفَناءِ.
الشرح: المشرقُ ملكٌ لله والمغربُ ملكٌ لله فأينما تولُّوا فثمَّ وجهُ الله أي أينما تَستَقبلوا في صلاةِ النَّفلِ وأنتم راكبونَ الدابةَ في سفرِكم فهناكَ قِبلةُ الله، فالمسافرُ إذا كان راكبًا الدابةَ يجوزُ أن يصلّي النَّفلَ إلى الجهةِ التي يريدُها، ولا يلتحقُ بذلك راكبُ السياراتِ والطائراتِ كما يُفهَمُ ذلك من كُتُبِ الفقهِ. ففي هذه الآيةِ أطلقَ الله على نفسِهِ لفظَ الوجهِ، فنحن ليسَ لنا أَن نَرُدَّ ذلك لكن علينا أن نعتقدَ أن الوجهَ إذا أُطلِقَ على الله ليس هذا الجزء، ليس الجارحةَ التي نعرفُهَا، فالذي يعتقدُ في الله الجارحةَ يكفرُ. وتكفير المجسم هو مذهب السلف قاله الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما، فقول بعض المنتسبين المتأخرين للمذهب الشافعي بعدم تكفيرهم مخالف لما عليه السلف، فلا التفات إلى ما في كتاب عز الدين بن عبد السلام الذي هو من متأخري الشافعية.
فإذا قالَ قائلٌ: هل في القرءانِ مذكورٌ أنه منزّهٌ عن الجارحةِ عن اللمسِ واللسانِ والأُذنِ؟ نقولُ: يكفي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ (11) . لأنه لو كانَ له جارحةُ سمعٍ أو جارحةُ بصرٍ لكان مِثلًا لنا ولو كان مثلًا لنا لم يكن إلهًا. وأما اعتقادُ أن لله سمعًا وبصرًا بجارحتين ويضيف إلى ذلكَ قوله لا كجوارحِنَا فهو مناقضَةٌ.
قال المؤلف رحمه الله: وَقَدْ يُرادُ بالوَجْهِ الجِهَةُ التي يُرادُ بها التّقَرُّبُ إلى الله تَعالى، كأَنْ يَقُولَ أحَدُهُم: “فَعَلْتُ كَذا وكَذا لِوَجْهِ الله”، ومَعْنَى ذلِكَ “فَعَلْتُ كَذا وكذا امْتِثَالا لأَمْرِ الله تَعَالى”.
الشرح: يقالُ وجهُ الله بمعنى قصد التقرب إلى الله، وإذا قالَ قائلٌ: عملتُ هذا لوجهِ الله أو ابتغاءَ وجهِ الله فمعناهُ عملتُ هذا للتَّقرُّب إلى الله تعالى وموافقةً وامتثالا لأمرِ الله، أليسَ الله يقول: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [سورة الحج/77]. وهذا المعنى لا يصح سواه في نحو حديث “أقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها” فليس للوجه في هذا الحديث معنى إلا طاعة الله. فماذا يفعل المجسم إذا جاء إلى هذا الحديث أيفسره على حسب اعتقاده أن لله وجهًا بمعنى الجزء والحجم المركب على البدن ولا يجرؤ على ذلك هنا فلماذا يعتقد في نحو ءاية ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ (27) وءاية ﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾ (88) الحجمَ المعروفَ المركبَ على البدن، فيجب عليه أن يترك اعتقاده وليقل ما يناسب معنى هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان بهذا اللفظ وليلتزم تفسير الرواية الأخرى لهذا الحديث “أقرب ما تكون المرأة إلى الله إذا كانت في قعر بيتها” على معنى تلك الرواية، فكلتا الروايتين صحيحة إسنادًا ومعناهما واحد.
فمن اعتقدَ أن وجهَ الله هو الحجمُ فقد أَلحَدَ وَكَفَرَ لأن الحجمَ مخلوقٌ إن كان كثيفًا وإن كان لطيفًا لا بدَّ لهُ من مقدارٍ، قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [سورة الرعد/8] فالحجمُ مهما كان صغيرًا ومهما كان كبيرًا له مقدارٌ فالله منزهٌ عن أن يكونَ حجمًا لطيفًا أو كثيفًا لأن الحجمَ لا بدَّ أن يكونَ له مقدارٌ.
قال المؤلف رحمه الله: ويَحْرُمُ أنْ يُقالَ كَما شَاعَ بينَ الجُهَّالِ: “افتَح النَّافِذَةَ لِنَرى وجْهَ الله”، لأنَّ الله تعالى قالَ لِمُوسَى: ﴿لَن تَرَانِي﴾ [سورة الأعراف/143]، ولَوْ لَم يَكُن قَصْدُ النّاطِقينَ بهِ رُؤيةَ الله فَهو حَرامٌ.
الشرح: هذا الكلامُ حرامٌ مهما كانت نيةُ اللافِظِ بهِ، لأنَّ هذا الكلامَ يُوهمُ أن لله جهةً، وأنه يُرَى بالعينِ في الدُّنيا وأنه هذه السماء الدنيا أو هذا الفراغ.
تفسير: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾
قال المؤلف رحمه الله: تفسير: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (35).
فَقَوْلُه تَعالى: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (35) مَعنَاهُ أنَّ الله تَعالى هَادِي أهْل السَّمواتِ والأَرْضِ لنُورِ الإيْمانِ، رَوَاهُ البَيهَقيُّ عن عَبدِ الله بنِ عبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُما، فَالله تعَالى ليْسَ نُورًا بمَعنى الضّوْءِ، بلْ هوَ الذي خَلَقَ النُّورَ، قَالَ تَعَالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [سورة الأنعام/1] أي خَلقَ الظُّلماتِ والنورَ، فكيفَ يُمكِنُ أنْ يكُونَ نُورًا كَخَلْقِه، تَعالى الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا. وحُكْمُ من يَعتقِدُ أنَّ الله تعَالى نُورٌ أيْ ضَوءٌ التّكفيرُ قَطْعًا. وهذه الآيةُ ﴿الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ (1) أصرحُ دليلٍ على أن الله ليسَ حجمًا كثيفًا كالسموات والأرض وليس حجمًا لطيفًا كالظلماتِ والنور، فمن اعتقدَ أن الله حجمٌ كثيفٌ أو لطيفٌ فقد شبَّه الله بخلقهِ والآية شاهدةٌ على ذلكَ. أكثرُ المشبهةِ يعتقدونَ أن الله حجمٌ كثيفٌ وبعضُهم يعتقدُ أنه حجمٌ لطيفٌ حيث قالوا إنه نورٌ يتلألأ، فهذه الآيةُ وحدَها تكفي للردِ على الفريقينِ.
وهُنَاكَ العَديدُ منَ العَقَائِدِ الكُفْريَّةِ كَاعْتِقادِ أنَّ الله تعَالى ذُو لَوْنٍ أو ذُو شَكْلٍ فليَحْذَرِ الإنسَانُ مِنْ ذَلِك جَهْدَهُ علَى أيّ حَالٍ.
الشرح: يقولُ الله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء﴾ [سورة النور/35] فقوله تعالى في ءاخرِ الآية ﴿يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء﴾ (35) يفسّرُ أوَّلَ الآية، ويبيّنُ لنا أن الله تعالى عَنَى بقولِهِ ﴿اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (35) أنه أعطى الإيمانَ لأهلِ السَّمواتِ وهم الملائكة ولمن شَاءَ من أهلِ الأرضِ من الإنسِ والجنّ. الإيمانُ هو نورُ الله هذا معنى ﴿اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (35) ، وبعضهم قالَ: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (35) أي مُنيرُ السَّمواتِ والأرضِ.
وأما الحديثُ الذي رواهُ مسلمٌ وفيه أن رسولَ الله قال: “نورٌ أَنَّى أَرَاهُ”. فقد نَقَلَ الحافظُ العراقيُّ أن أحمدَ استنكرَهُ، ولو صحَّ لكانَ معناهُ مَنَعَني نورٌ مخلوقٌ من رؤية الله بعينَي رأسي، والتقديرُ فاعلٌ لِفِعلٍ محذوفٍ. ومن فسّر هذا الحديث بالنور الذي هو ضد الظلمة فقد كذب هذه الآية ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ (1).
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة