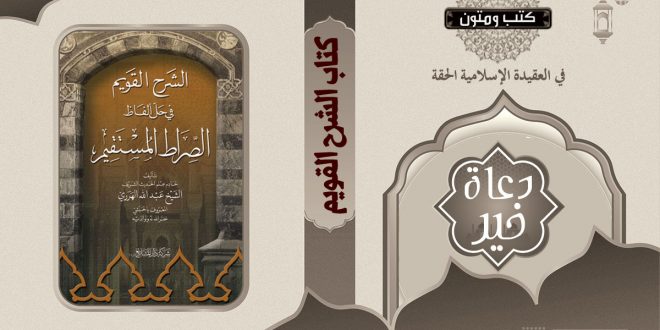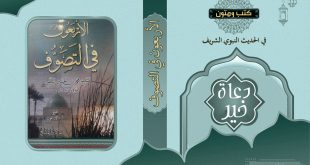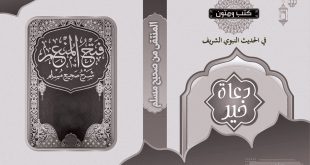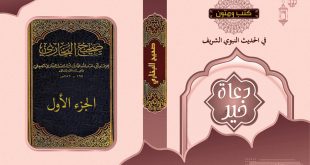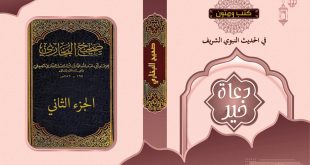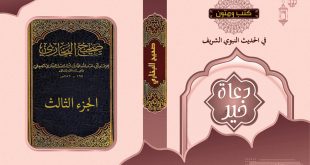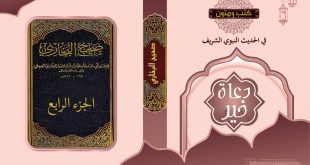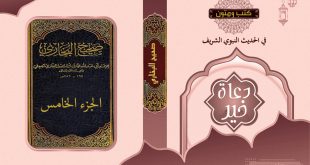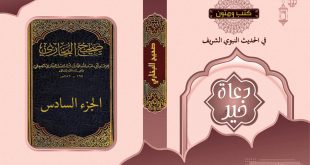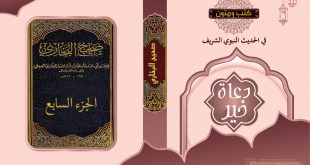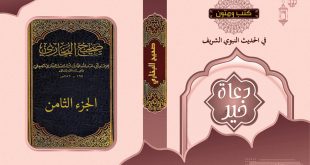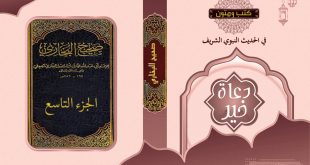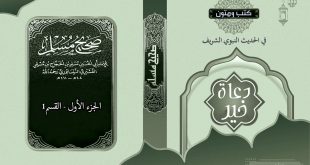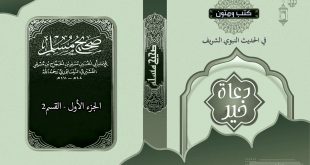صِفَاتُ الله كُلُّها كاملةٌ
قال المؤلف رحمه الله: صِفَاتُ الله كُلُّها كاملةٌ.
صِفَاتُ الله أزَلِيَةٌ أَبدِيَةٌ، لأَنَّ الذَّاتَ أزَليٌّ فَلا تَحْصُلُ لَهُ صِفَةٌ لَم تَكُنْ في الأَزَلِ، أمَّا صِفَاتُ الخَلْقِ فَهِيَ حَادِثَةٌ تَقْبَلُ التَّطَوُّرَ مِنْ كَمَالٍ إلى أكْمَلَ فَلا يتجدَّدُ عَلى عِلْمِ الله تَعَالَى شَىءٌ. والله تَعَالَى خَلَقَ كُلَّ شَىءٍ بِعلْمِه الأَزَليّ وقُدْرَتِه الأَزَلِيَّةِ ومَشِيْئَتِه الأَزَلِيَّةِ، فَالمَاضِي والحَاضِرُ والمُسْتَقْبَلُ بِالنّسْبَةِ لله أَحَاطَ بِه بِعِلْمِهِ الأَزَلِيّ.
الشرح: أنه لما ثَبَتَت الأزليَّةُ لذاتِ الله وَجَبَ أن تكون صفاتُهُ كلُّها أزليَّةً أبديَّةً لا تَقبَلُ التَّغيُّرَ والتَّطوُّرَ لأن التّغيُّرَ والتَّطوُّرَ من حالٍ إلى حالٍ علامةُ الحدوثِ، فالإنسان يقبل الزّيادةَ والنُّقصانَ والتغيُّرَ من الكمالِ إلى النَّقصِ والعكس أما الله تعالى لا يزدَادُ ولا ينقصُ، فصفاتُ الله لا تقبلُ التّطوُّرَ من كمالٍ إلى أكملَ وعلمُ الله لا يزدادُ ولا ينقصُ بل علمُهُ كاملٌ كما سائر صفاته يعلمُ به كلَّ شَىءٍ، فلا يتجدّدُ له علمٌ جديدٌ بل هو عالمٌ في الأزلِ بكلّ شىءٍ فالتّغيُّرُ يحصُلُ في المعلومِ الحادِثِ لا في علمِ الله الأزليّ، فالله يعلمُ ما كانَ في الماضي وما يكون في الوقتِ الحاضرِ وما سيكون في المستقبلِ حتى الأشياء التي تتجدَّدُ في الآخرةِ الله عَلِمَ بها في الأزل، حتى أنفاسَ أهل الجنةِ وأهل النار التي تتجدَّدُ بلا انقطاعٍ الله تعالى يعلمُ بتفصيلها، هنا يحتارُ العقلُ، فإذا أجرى الشّخصُ قلبَهُ في هذه المسئلةِ الوهمُ ينهارُ، هنا يقولُ كيفَ يكونُ علمُهُ محيطًا بما لا نهايةَ لهُ، وأنفاسهُمْ جاريةٌ لا انقطاعَ لها؟!!
قال المؤلف رحمه الله: وأما قولُهُ تَعَالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [سورة محمد/31] فَلَيسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّه سَوْفَ يَعْلَمُ المُجَاهِدِينَ بَعْدَ أَنْ لَم يَكُنْ عَالِمًا بِهِم بِالامْتِحَانِ والاخْتِبَارِ، وَهَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَى الله تَعَالَى، بَلْ مَعْنَى الآيَةِ حَتَّى نُمَيّزَ أي حَتَّى نُظْهِرَ لِلْعِبَادِ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ مِنْ غَيْرِهِم. ويَكْفُرُ مَنْ يَقُولُ إنَّ الله تَعَالى يَكْتَسِبُ عِلْمًا جَدِيدًا.
الشرح: هذه الآية لا تعني أن الله يتجدَّدُ له علمٌ إنما تعني الآية أن الله تعالى يَبتَلي عبادَهُ حتى يُظهِرَ ويُميّزَ لعبادِهِ من هو الصَّادقُ ومن هو غير الصَّادقِ، فالملائكةُ يعرفونَ أن هذا صادقٌ صابرٌ على طاعةِ الله وأن هذا ليس بصابرٍ، يَكشِفُ الله تعالى لهم ولمن شاءَ من خلقِهِ مَن الذين يجاهدونَ في سبيلِ الله صابرين على المشقَّاتِ، يُظهِرهم لعبادِهِ مِن غيرِهم الذين لا يصبرونَ، وهو عالمٌ بعلمِهِ الأزليّ من هو الصَّابرُ ومن هو غير الصّابر كما نقلَ ذلكَ البخاريُّ عن أبي عبيدةَ مَعمرِ بن المُثنَّى وهذا شبيهٌ بقوله تعالى: ﴿لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [سورة الأنفال/37].
ولا يجوزُ اعتقادُ أن الله تعالى يتجدَّدُ له علمٌ لم يكن عَلِمَهُ في الأزلِ بل يكفرُ من اعتقدَ ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: وَصِفَاتُ الله تَعَالَى كُلُّها كاملةٌ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَللهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى﴾ [سورة الأعراف/180].
الشرح: قولُه تعالى: ﴿وَللهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ﴾ [سورة الأعراف/180] معناهُ أن الله تعالى له الأسماءُ التي تدلُّ على الكمالِ، فالله لا يُوصَفُ إلا بصفةِ كمالٍ فما كانَ من الأسماءِ لا يدلُّ على الكمالِ لا يجوزُ أن يكونَ اسمهُ كما يُسمّيه بعضُ النّاس “ءاه”، وبعضُهم سمّاهُ “روحًا”، وقد وَرَدَ في كتابِ قوتِ القلوبِ في أثناءِ ذِكْرٍ ساقَهُ طويل لفظُ “يا روح” وهذا إلحادٌ وكُفرٌ فَليُجتَنَب هذا ونحوه فهذا لا يجوزُ لأن كلمةَ ءاه وَضَعَهَا العربُ لِتَدُلَّ على الشّكايةِ والتّوجُّعِ وقد روى الترمذي أن رسول الله قال: “إذا تثاءبَ أحدُكم فَليَضَع يدهُ على فِيْهِ، وإذا قالَ ءاه ءاه فإنَّ الشّيطانَ يضحَكُ من جوفِهِ” أي يدخل إلى فمِهِ ويسخرُ منه.
ومن الدّليلِ على أن ءاه ليس من أسماءِ الله أن الفقهاءَ قالوا إن من قالَ ءاه في الصّلاةِ عامدًا بطلَتْ صلاتُهُ، ومعلومٌ أن ذِكرَ الله لا يبطلُ الصلاةَ، فلو كانَ ءاه من أسماءِ الله لما أبطَلَ الصلاةَ.
وأسماءُ الله الحسنى يُطلَقُ عليها صفات الله ويُطلقُ عليها أسماء الله إلا لفظ الجلالةِ لا يطلقُ عليه الصّفة، ثم إن أسماء الله تعالى قسمانِ قسم لا يُسمَّى به غيرُهُ وقسمٌ يُسمَّى به غيرُه، الله والرَّحمنُ والقدُّوسُ والخالقُ والرَّزَّاقُ ومالكُ الملكِ وذو الجلالِ والإكرامِ والمحيي المميت لا يُسمَّى به إلا الله، أما أكثرُ الأسماءِ فيُسمَّى به غيرُ الله أيضًا، فيجوزُ أن يسمّيَ الشَّخصُ ابنَهُ رحيمًا والمَلِك كذلك والسَّلام كذلك.
فائدة: أسماءُ الله الحسنى التّسعةُ والتّسعونَ مَن حَفِظَهَا وفَهِمَ معناها مضمونٌ له الجنةُ، ويوجَدُ غيرُها أسماءٌ لله ولكن ليسَ لها هذه الفضيلة التي هي للأسماءِ التّسعة والتّسعين، وأسماءُ الله الحسنى بأيّ لغةٍ كُتِبَت يَجِبُ احتِرَامُها.
قال المؤلف رحمه الله: وقالَ تَعالى: ﴿وَللهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ﴾ [سورة النحل/60] فَيَسْتَحِيلُ في حَقّهِ تَعالى أيُّ نَقْصٍ.
الشرح: معنى هذه الآية لله الوصفُ الذي لا يُشبِهُ وصفَ غيرِهِ. أما اتفاقُ اللّفظِ فلا يعني اتّفاقَ المعنى، فالله تعالى يوصَفُ بالصّفاتِ التي تَدلُّ على الكمالِ والتي لا تكونُ لغيرهِ، والله يستحيلُ في حقّهِ أيُّ نقصٍ كالجهلِ والعجزِ.
قال المؤلف رحمه الله: وأَمَّا قَولُه تَعَالى: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [سورة ءال عمران/54] فَالمَكْرُ مِنَ الخَلْقِ خُبْثٌ وخِدَاعٌ لإِيْصَالِ الضَّرَرِ إلى الغَيْرِ باسْتِعْمَالِ حِيلَةٍ، وَأَمَّا مِنَ الله تَعالى فَهُو مُجَازَاةُ المَاكِرينَ بالعُقُوبَةِ مِنْ حَيْثُ لا يَدْرُونَ. وبِعبَارَةٍ أُخْرَى إِنَّ الله أَقْوَى في إيصَالِ الضَّرَرِ إلى المَاكِرِينَ منْ كُلّ مَاكِرٍ جَزَاءً لَهُم علَى مَكْرِهم، فَالمَكْرُ بِمَعْنى الاحْتِيَالِ مُسْتَحِيلٌ علَى الله.
الشرح: في هذه الآية أسندَ الله إلى نفسِهِ المكرَ، ومكرُ الله ليس كمكرِ العبادِ، مكرُ الإنسانِ أن يحاوِلَ إيصالَ الضَّررِ إلى إنسانٍ بطريقةٍ خفيَّةٍ يحتاجُ فيها إلى استعمالِ بعض الحيلِ، أما مكرُ الله فليس هكذا، مكرُ الله هو إيصالُ الضَّررِ إلى من يشاءُ من عبادِهِ من حيثُ لا يعلم ذلك العبد ولا يظنُّ ولا يحسبُ أن الضَّررَ يأتيهِ من هنا.
فمكرُ العبدِ مذمومٌ أما مكرُ الله لا يُذمُّ لأنَّ الله لا يجوزُ عليه الظلمُ، لا يكونُ ظالمًا إن انتقمَ من عبادِهِ الظّالمينَ بما شاء.
قال المؤلف رحمه الله: وكَذَلِكَ قَولُه تعالى: ﴿اللهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ﴾ [سورة البقرة] أَيْ يُجَازِيْهِم عَلَى اسْتِهزَائِهِم.
الشرح: هذه الآية ﴿اللهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (15) نَزَلَت في المنافقينَ لأنهم كانوا لما يجتمعونَ بأمثالِهم يتكلَّمونَ بِبُغضِ الإسلامِ وكراهيتِهِ، الله أخبرنا أنه يجازيهم بما يليقُ بهم وهذه المجازاةُ سَمَّاهَا استهزاءً. والمنافقونَ هم الذين يكرهونَ الإسلامَ في قلوبِهِم ويتظاهرونَ بالإسلامِ أمامَ المسلمين، ويعملونَ أعمالَ المسلمين ولكن قلوبُهُم فيها شكٌّ أو إنكار.
تنبيهٌ مهمٌ: من قالَ يجوزُ تسميةُ الله ناسيًا وماكرًا ومستهزئًا كَفَرَ لأنهُ استخفَّ بالله، أما إذا قال على وجهِ المقابلَةِ فليسَ فيه تنقيصٌ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُ﴾ [سورة ءال عمران/54]، وقولِهِ ﴿نَسُواْ اللهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [سورة التوبة/67]، أما من استحلَّ قولَ يا ماكرُ ارزقني ونحو ذلك فهذا يكفرُ، وكذا يكفُرُ من يُسمّي الله المضلَّ لأنه جَعَلَهُ اسمًا لله كالرّحمنِ فيكونُ معنى كلامِهِ يجوزُ أن نقولَ يا مضلُّ أَعِنّي.
أما قولُ يا جبّارُ ارزقني لا يدلُّ على نقصٍ في حقّ الله، وكذلك يا متكبّرُ لا يدلُّ على نقص، أما الذي يدلُّ على النقصِ فهوَ مثل أن يقال في حقّ الله يا مخادعُ أو يا ناسي أو يا مستهزئ أو يا ماكرُ.
أما إذا قلنا يا طاهرُ عن الله فيجوزُ على قول لأن معناهُ المنزَّهُ عن النّقائصِ قالَ بجوازِ تسميةِ الله الطاهرَ بعضُ الأشاعرةِ لكونِهِ وصفًا لا يُوهِمُ نقصًا لله، لكنَّ الإمامَ الأشعريَّ يمنَعُ من ذلك قال: “لا يجوزُ تسميةُ الله إلا بما وَرَدَ في الكتابِ والسّنةِ الصحيحةِ أو الإجماعِ”، وهذا هو المعتمدُ، قال الأشعريُّ: “فلا يجوزُ وصفُ الله بالرُّوح”، وذَكَرَ مثل ذلك أبو منصور البغداديُّ وقال: “لا مجالَ للقياسِ في أسماءِ الله وإنما يُراعَى فيها الشرعُ والتوقيفُ” وقال: “وليسَ في أفعالِهِ – يعني الله – ما هو على وزنِ فاعَلَ بفتح العين ولا يُطلقُ ذلك في أفعالِهِ لأن المفاعَلَةَ تقتضي الشّركةَ في الفعلِ إلا في أمثلةٍ نادرةٍ – يعني في اللغة – لا يُقاسُ عليها، فإن أضيفَ الفعلُ إلى غيرِهِ جازَ إطلاقهُ في بعضِ المواضع كقولهِ تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللهَ﴾ [سورة البقرة/9] ولكن لا يتجاوز به ما وَرَدَ به النصُّ، فلا يقالُ خَادَعَ الله لأن النصَّ وَرَدَ بالمضارعِ من هذا الفعلِ دون الماضي”، وقال: “ولم يَرد في أسماءِ الله ما هوَ على وَزنِ فِعَال، ولكن يجوزُ أن يُقالَ فلانٌ في جِوَارِ ربّهِ وَجُوَارِ ربّهِ لغتانِ إذا كان ملازمًا لطاعَتِهِ”، ذكر ذلك في كتابهِ “تفسير الأسماء والصفات”.
فيفهَمُ من قولِ الأشعري “فلا يجوز وَصفُ الله بالروحِ” بُطلانُ قولِ “يا روح” مرادًا به الله، فَليُحذَر كما تقدمَ ما في كتابِ قوت القلوب من إيرادِ ذلكَ في ذِكرٍ سِيقَ هناكَ، فإن الروحَ ليس وصفًا بل هو اسمٌ جامدٌ وفيه إيهامُ النقصِ لأن الروح جسم لطيف والجسم اللطيف أحد نوعي الجسم. وكذلكَ لا يجوزُ تسميةُ الله بالقوّةِ كما فَعلَ سيّدُ قطب وكأنه اقتدى بكلامِ بعضِ الملاحدةِ الذين يقولونَ “إن للعالمِ قوةً مدبّرةً” ويعنونَ أن الله هوَ هذه القوة، ولعلَّ هذا مما اكتسبَهُ منهم حينَ كان مع الشيوعيةِ إحدى عشرة سنَة كما اعترف هو في بعض مؤلفاته وهو كتاب “لماذا أعدموني”، وكذلكَ تسميةُ سيد قطب لله بالعقلِ المدبّرِ لأنَّ العقلَ صفةٌ من صفاتِ البشرِ والجن والملائكة، وهذه التّسميةُ تدخُلُ تحتَ قولِ الإمام أبي جعفرٍ الطحاوي في كتابِهِ الذي ألفّهُ لبيانِ ما عليه أهلُ السنة: “ومن وصفَ الله بمعنًى من معاني البشر فقد كَفَرَ”، وكذلك ما في كتابِ محمد سعيد البوطي من تسميةِ الله بالعلَّةِ الكبرى والسببِ الأوَّلِ والواسِطَةِ والمَصدَرِ والمَنبَعِ وذلكَ مذكورٌ في كتابِهِ كبرى اليقينياتِ الكونية وذلكَ نوعٌ من الإلحادِ، قال الإمامُ رُكنُ الإسلامِ عليٌّ السُّغديُّ: “من سَمَّى الله علّةً أو سببًا كَفَرَ”.
ويكفي في الزّجرِ عن ذلكَ قولُ الله تعالى: ﴿وَللهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ﴾ (180) ، فمذهبُ أهلِ السنة أن السَّبَبَ والمُسبَّبَ خَلقٌ لله تعالى، وتسميةُ الله بالعلَّةِ أشدُّ قُبحًا من تسميتِهِ بالسببِ لأن العلَّةَ في اللغةِ المرض ونحوه والله أزليٌّ أبديٌّ ذاتًا وصفاتٍ، فما أبعَدَ هذا الكلامَ من كلامِ مَن مَارَسَ كُتُبَ عقائِدِ أهلِ السنةِ فحالُهُ كحالِ من لم يُعَرّج عليها بالمرَّةِ.
وأما قولُهُ تعالى: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [سورة الجاثية/34] فقد ذُكرَ على وجهِ المقابلةِ ومعناهُ تَرَكنَاكُم مِن رَحمَتِنَا كما أنتم تَرَكتُم طاعةَ الله في الدنيا بالإيمانِ به.
وكذلكَ لا يجوزُ أن يُؤخَذَ من قولِ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً﴾ الآية [سورة البقرة/26] جوازُ تسميةِ الله بالمستحيى، ومعنى الآية أننا لا نترك استحياءً كما يتركُ البشرُ الشىءَ استحياءً، معناه أنَّ الله لا يُحِبُّ تركَ إظهارِ الحَقّ فلا يتركُهُ للاستحياءِ كما يَفعَلُ الخلقُ، وهذا مستحيلٌ على الله.
وكذلكَ لا يجوزُ أن يُستَخرَجَ اسمُ المستحي لله من الحديثِ الذي رواه الترمذي: “إنَّ الله حييٌّ كريمٌ يَستحي إذا رَفَعَ الرجلُ إليه يديهِ أن يَردّهما صِفرًا خائبتين” معناه لا يُخَيّبُ، إما أن يعطيَهُ الثَّوابَ أو يعطيَهُ ما طَلَبَ، ومعنى: “رَفَعَهُمَا إليه” أي إلى جِهَةِ مَهبِطِ الرّحمةِ وهي السماءُ.
قال المؤلف رحمه الله: واعلَم أنَّ العُلمَاءَ يقولونَ: نؤمِنُ بإثْباتِ ما وَرَدَ في القُرءَانِ والحَديثِ الصَّحيحِ كالوَجْهِ واليَدِ والعَيْنِ والرّضَا والغَضَبِ وغَيْرِه علَى أنّها صِفَاتٌ يَعلَمُها الله لا علَى أنَّها جَوارِحُ وانْفِعالاتٌ كأَيْدِينا وَوُجُوهِنَا وعيُونِنَا وغَضَبِنا، فَإِنَّ الجَوَارِحَ مُسْتَحِيْلَةٌ علَى الله لِقَوْلِه تَعَالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ [سورة الشورى/11]، وقولِهِ: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (4).
قَالُوا لَو كَانَ لله عَيْنٌ بِمَعْنَى الجَارِحَةِ والجِسْمِ لَكَانَ لَهُ أَمْثَالٌ فَضْلًا عَنْ مِثْلٍ وَاحِدٍ ولَجَازَ عَلَيه ما يَجُوزُ على المُحْدَثَاتِ مِنَ المَوْتِ والفَناءِ والتَّغَيُّرِ والتَّطَور، ولَكَانَ ذَلِكَ خُرُوْجًا مِنْ مُقْتَضَى البُرْهَانِ العَقْلِيّ علَى اسْتِحَالَةِ التَّغَيُّرِ والتَّحوُّلِ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ علَى الله. ولا يَصِحُّ إهْمالُ العَقْلِ لأَنَّ الشَّرْعَ لا يَأْتِي إِلا بِمُجَوَّزَاتِ العَقْلِ أي إلا بما يقبَلُهُ العَقلُ لأَنَّه شَاهِدُ الشَّرْعِ، فَالعَقْلُ يَقْضِي بأَنَّ الجِسْمَ والجِسْمانِيَّاتِ أَي الأَحْوالَ العَارِضَةَ للجِسْم مُحْدَثَةٌ لا مَحَالَةَ وأَنّها مُحْتَاجَةٌ لِمُحْدِثٍ، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ المُتَّصِفُ بها لَهُ مُحْدِثٌ ولا تَصِحُّ الألُوهِيَّةُ لِمنْ يَحْتَاجُ إلى غَيْرِهِ، لأنَّ الدلائلَ العقليةَ على حدوثِ العالمِ طروءُ صفَاتٍ لم تكن عليهِ والتحولُ من حالٍ إلى حالٍ.
الشرح: قالَ العلماءُ: يصحُّ أن يقالَ لله يدٌ لا كأيدينا ووجهٌ لا كوجوهِنَا وعينٌ لا كأعيننا على معنى الصّفَةِ لا على معنى الجارحَةِ والجسم، ولا يصحُّ أن يقالَ الله جالسٌ لا كجلوسِنَا لأنَّ ذلك لم يَرِد لا في القرءانِ ولا في الحديثِ ولا عن الأئمةِ، والجلوسُ لا يوصَفُ به إلا المخلوقُ، قال أهل السنة: “ما أطلقَ الله على نفسِهِ أطلقناهُ عليهِ وما لا فلا”، وقالَ العلماءُ: لا تَثْبتُ الصفة لله إلا بالقرءانِ أو الحديثِ الثابتِ المُتَّفَقِ عليهِ، أما الحديثُ الذي في بعضِ رواتِهِ طعنٌ وجَرحٌ فلا يُحتجُّ به لإثباتِ الصفةِ لله، وكذلكَ لا تَثبُتُ الصفةُ لله بكلامِ صحابيّ أو تابعيّ.
أما الصفاتُ الثلاثَ عشرة لو لم تَرد في القرءانِ والحديثِ بالعقلِ تَثبُتُ، أما ما سوى هذه الصفات فما وَرَدَ فيه النصُّ نُثبِتُهُ لله مع التنزيهِ، كاليدِ والوجهِ والعينِ فَنُثبِتُهَا صفاتٍ لله لا جوارحَ فإنها وَرَدَت في القرءانِ، ولو لم تَرِد في الشرعِ ما كان يجوزُ لنا إثباتُهَا لله.
فبناءً على هذا لو أنكرَ إنسانٌ صفةً من صفاتِ الله الثلاثَ عشرةَ نُكَفّرُهُ لو كان قريبَ عهدٍ بإسلامٍ لأنَّ هذهِ الصفات تَثبُتُ بالعقلِ ولو لم يَعلَم بورودِهَا في الشرعِ.
أما الوجهُ واليدُ والعينُ إذا إنسانٌ أنكرَ واحدةً منها لا نُكَفّرهُ إلا إذا كانَ اطَّلَعَ في القرءانِ عليها ومَع ذلكَ أنكَرَهَا فعندَها نُكَفّرُهُ، أي إن أنكرَ أصلَ الإضافةِ مع تنزيهِ الله عن الجوارحِ بَعدَ أن اطَّلَعَ في القرءانِ على ذلكَ فهذا يُكَفَّرُ. فالعينُ تأتي بمعنى الحفظِ كما في قولِهِ تعالى: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [سورة القمر/14]، وقَولِه: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (39) [سورة طه] أي على حفظي، واليدُ تأتي بمعنى القدرةِ والقدرةُ هي القوةُ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [سورة الذاريات/47]، وتأتي بمعنى العَهدِ كما في قولِهِ تعالى: ﴿يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [سورة الفتح/10] أي عَهدُ الله فوقَ عُهودِهِم أي ثَبَتَ عليهم عَهدُ الله لأن معاهدَتَهم للرسولِ تحتَ شجرةِ الرضوانِ في الحديبيةِ على أن لا يَفِرُّوا معاهدةٌ لله تبارك وتعالى لأن الله تعالى هو الذي أَمَرَ نبيَّهُ بهذهِ المبايَعَةِ.
وأما قولُهُ تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء﴾ [سورة المائدة/64] فمعناهُ غنيٌّ واسِعُ الكَرَمِ.
والله تعالى يَغضَبُ ويَرضَى لا كأحدٍ من الوَرَى كما نَطَقَ به القرءانُ بقولِهِ تعالى: ﴿رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ﴾ [سورة المائدة/119] وفي حقّ الكفَّارِ ﴿وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ﴾ [سورة الفتح/6]، والأصلُ أن الله تعالى يُوصَفُ بما وَصَفَ به نَفسَهُ في كتابهِ العزيزِ وبما صحَّ أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم وصفَهُ به من غيرِ أن يكونَ لأحدٍ شركةٌ مع الله تعالى لا في ذاتِهِ ولا في صفاتِهِ.
ثم الغَضَبُ بالنّسبةِ للخَلقِ تغيُّرٌ يحصُلُ عند غليانِ الدَّمِ في القلبِ بإرادةِ إيصالِ الضَّررِ إلى المغضوبِ عليهِ. والغضبُ إذا وُصِفَ الله به يكونُ بمعنى الغايةِ أي إرادة الانتقامِ، وإرادةُ الانتقامِ أزليَّةٌ هذا المعروفُ عندَ الأشاعرةِ في عباراتِهم، وإذا وُصِفَ المخلوقُ بالغضبِ يُوصَفُ باعتبارِ المَبْدَإ وهو التّغيُّرُ أي الانفعالُ النَّفسانيُّ.
والرّضَا عبارةٌ عن إرادةِ إنعامِهِ على عبادِهِ أو عن نفسِ إنعامِهِ عليهم وهذا هو معنى الرَّحمةِ أيضًا، وليست رحمته رقَّة القلبِ. وأما ما وَرَدَ في حديثِ الشفاعةِ الذي رواهُ مسلمٌ من أن ءادمَ وغيرَهُ يقولونَ يومَ القيامة: “إن الله قد غَضِبَ اليومَ غضبًا لم يغضَب مثله قبلهُ ولا يغضَب بعدَهُ مثله” فهذا يُقصَدُ بهِ أَثَرُ الغضبِ ليس الغضب الذي هو صفةٌ ذاتيّةٌ لله.
وقد كان السَّلف إذا أرادوا اختصارَ العبارةِ يقولونَ الله يغضَبُ ويرضَى بلا كيفٍ، مالكُ بن أنسٍ واللَّيثُ بن سعدٍ وسفيانُ الثَّوريُّ والأوزاعيُّ هؤلاء لما يذكرونَ الصّفات التي وَرَدَت في حَقّ الله تعالى ممَّا يَتَوَهَّمُ بعضُ الناس أنها كصفاتِ المخلوقينَ لِقِصَرِ أفهَامِهم، كانوا رضي الله عنهم يقولون: “بلا كيفٍ”. أما الخلفُ وبعضُ السَّلفِ أوَّلوا فيقولون رِضَا الله إرادتُهُ الرَّحمَة وغضبُهُ إرادتُهُ الانتقَام، أَرجَعوا الصّفتَينِ إلى الإرادةِ، وكِلَا القولينِ صحيحٌ.
سَبَبُ نُزُولِ الإخْلاصِ
قال المؤلف رحمه الله: سَبَبُ نُزُولِ الإخْلاصِ.
قَالَت اليَهُودُ للرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: صِفْ لَنَا رَبَّكَ قَدْ كَانَ سُؤالهُم تَعَنُّتًا (أي عِنَادًا) لا حُبًّا للعِلْم واسْتِرْشَادًا بِه، فَأنْزَلَ الله سُوْرَة الإِخْلاصِ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ (1) أَي الذي لا يَقْبَلُ التَّعَدُّدَ والكَثْرَةَ ولَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ في الذَّاتِ أَو الصّفَاتِ أَو الأَفْعَالِ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ صِفَةٌ كَصِفَاتِه، بَلْ قُدْرَتُه تَعَالى قُدْرَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْدِرُ بِهَا عَلَى كُلّ شَىءٍ وعِلْمُهُ وَاحِدٌ يَعْلَمُ به كُلَّ شَىءٍ.
الشرح: قالَ الله تعالى: ﴿فَلاَ تَضْرِبُواْ للهِ الأَمْثَالَ﴾ [سورة النحل/74] أي لا تُشَبّهوهُ بخلقِهِ، فقدرَةُ الله قدرةٌ واحدةٌ يَقدِرُ بها على كلّ شىءٍ هي أزليَّةٌ أبديَّةٌ ليست متعدّدةً بتعدُّدِ الأشياءِ بل قدرةٌ واحدةٌ خَلَقَ بها كلَّ الحادثاتِ، وكذلك عِلمُ الله واحدٌ أزليٌّ أبديٌّ يعلمُ به كلَّ شىءٍ، يعلمُ به الأزليَّ كذاتِهِ وصفاتِهِ ويعلمُ به الحادثاتِ أيضًا لأنَّ علمَ الله شاملٌ للأزلي والحادِثِ، أما قدرتُهُ شاملةٌ للحادثِ، أما الأزليُّ فلا تتعلَّقُ به القدرَةُ.
قال المؤلف رحمه الله: قولُهُ تعالى ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ (2) أي الذي تَفتَقِرُ إِليه جَمِيْعُ المَخلُوقَاتِ، معَ استِغْنَائِه عنْ كُلّ مَوْجُودٍ.
الشرح: الله تعالى مستغنٍ عن كلّ شىءٍ وكلُّ شىءٍ يحتَاجُ إليه فَيَقصدُهُ العبادُ عند الشّدَّةِ هذا معنى الصَّمد، وهكذا نُفَسّرُهُ، وفي اللّغةِ الصَّمَدُ السَّيدُ المَقصودُ، الشَّخص الذي هو سَيّدٌ أي عالي القَدرِ في الناسِ معتبر فيهم هذا في اللغةِ يُسمَّى صمدًا، لذلك الصَّمدُ ليسَ من أسماءِ الله الخاصَّةِ به بل يجوزُ تسميةُ غيره به، فإذا إنسانٌ سمَّى ابنَهُ الصَّمد ليسَ حرامًا.
قال المؤلف رحمه الله: والذي يُقْصَدُ عندَ الشّدَّةِ بجَميعِ أنْواعِها ولا يَجْتَلِبُ بخَلْقِه نَفْعًا لِنَفْسِه ولا يَدْفَعُ بِهمْ عَن نَفْسِه ضرًّا.
الشرح: معنى ذلكَ أن الله لا ينتفعُ بخلقِهِ، ولا يجتَلبُ نفعًا منهم لنفسِهِ ولا يدفَعُ ضررًا بهم عن نفسه فهم لا ينفعونَهُ ولا يضرُّونَهُ، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (56) ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ﴾ (57) ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (58) [سورة الذاريات]، فقولُه تعالى: ﴿إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (56) معناهُ إلا لآمُرَهُم بعبادَتي.
وليُعلَم أنَّ الله لا يَخلُقُ شيئًا عَبثًا، ومن اعتقدَ أن الله يخلُقُ شيئًا عبثًا بلا حِكمةٍ فقد كَفَرَ كالذي يقولُ إن الله لما خَلَقَ فلانًا أرادَ أن يَملأَ بهِ الفَرَاغَ.
قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ (3) نَفْيٌ لِلْمَادّيَّةِ والانْحِلالِ وَهُوَ أَنْ يَنْحَلَّ مِنْهُ شَىءٌ أَوْ أَنْ يَحُلَّ هُوَ في شَىءٍ.
الشرح: أي أنهُ ليسَ أبًا ولا ابنًا، فقوله ﴿ لَمْ يَلِدْ ﴾ (3) يُعطي هذا المعنى أي أنه لا يَنحَلُّ منه شىءٌ أي لا يجوزُ أن ينفصِلَ منهُ شىءٌ كما ينفصلُ عن الرَّجلِ ولده، وقولُه ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ (3) يُعطي أنهُ لا يَحُلُّ هو في شىءٍ.
قال المؤلف رحمه الله: وَمَا وَرَدَ في كتاب “مَوْلِدِ العَرُوسِ” مِنْ أنَّ الله تَعالى قَبَضَ قَبْضَةً مِن نُورِ وجْهِهِ فَقَالَ لها كُوْنِي مُحمَّدًا فَكَانَتْ مُحمَّدًا فَهذِه مِنَ الأَبَاطِيلِ المَدْسُوسَةِ، وحُكْمُ مَنْ يَعْتَقِدُ أنَّ مُحمَّدًا صلى الله عليه وسلم جُزْءٌ مِنَ الله تَعَالى التَّكْفِيرُ قَطْعًا، وكَذَلِكَ الذي يَعْتَقِدُ في المَسِيحِ أَنَّه جُزْءٌ منَ الله.
الشرح: هذا من الأباطيلِ التي أدخَلَهَا بعضُ الناسِ على الإسلامِ، لأنَّ هذهِ الكلمة توهم أن الله له أجزاء وهو منزَّهٌ عن أن يكون له بعض وجزء وعن أن ينحل فيه شىء. ومن الاعتقاداتِ الفاسدةِ الكفريّةِ اعتقادُ أن الرسولَ جزءٌ من الله، وكم كَفَرَ من الناسِ بسببِ هذا الكتاب المسمَّى “مولد العروس”، وقائل هذا كالذي يقول إن المسيح جزء من الله روح منفصل من الله فهذا كافر وهذا كافر. قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ [سورة الزخرف/15].
قال المؤلف رحمه الله: وليسَ هذا الكتاب لابنِ الجَوزيّ رحمه الله، ولم يَنسِبْهُ إليهِ إلا المُستَشرِق بُروكلمَان.
الشرح: كتابُ مولِدِ العروسِ ليسَ من تأليفِ ابن الجوزيّ الذي كان محدّثًا فقيهًا مفسّرًا أُعطيَ باعًا قويًّا في الوعظِ كان من قوَّةِ وعظِهِ إذا تكلَّمَ يُحرّكُ القلوبَ، وقد أسلَمَ على يدهِ بسبب دروسِهِ ومواعظِهِ مائةُ ألفٍ، فهذا الكتابُ مُلصَقٌ بهِ. ومؤلفاتُ ابن الجوزي كثيرةٌ ذَكَرَها من تَرجموهُ، وقد نُسِبَت إلى عددٍ من العلماءِ سواه كُتُبٌ ليست لهم بل أصحابُها مجهولونَ.
وإنما نَسَبَ هذا الكتابَ الفاسِدَ لابن الجوزي رجلٌ أفرنجيٌّ كافِرٌ تَعَلَّمَ لغةَ العربِ وصارَ ينظُرُ في مؤلّفاتِ المسلمينَ ويقولُ من غير تحقيقٍ ودليلٍ هذا لفلانٍ، وقد عَمِلَ من المُجَلَّدَاتِ في ذلك عَدَدًا.
قال المؤلف رحمه الله: قولُهُ تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (4) أَيْ لا نَظِيْرَ لَهُ بِوَجْهٍ منَ الوُجُوهِ.
الشرح: أي أنَّ الله لا يشبه شيئًا بوجهٍ من الوجوهِ، وقولُه تعالى: ﴿كُفُوًا﴾ (4) يُقرأُ كُفُوًا وَيقرأُ كُفْوًا بتسكينِ الفاءِ على إحدى القراءاتِ.
الآياتُ المُحْكَمَاتُ والمُتَشَابِهَاتُ
قال المؤلف رحمه الله: الآياتُ المُحْكَمَاتُ والمُتَشَابِهَاتُ
لِفَهْم هَذا المَوضُوعِ كَما يَنْبَغِي يَجبُ مَعْرفَةُ أنَّ القرءانَ تُوجَدُ فِيْهِ ءايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وءايَاتٌ مُتَشَابِهاتٌ، قَالَ تَعَالى: ﴿هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ﴾ (7) [سورة ءال عمران].
الشرح: القرءانُ فيه ءاياتٌ محكماتٌ وفيه ءاياتٌ متشابهاتٌ، والمحكماتُ هي التي دِلالتُهَا على المرادِ واضحةٌ، والمتشابهةُ هي التي دِلالتُهَا على المرادِ غيرُ واضحةٍ، وقد ذمَّ الله تعالى الذين يتَّبعونَ ما تشابَهَ منه ابتغاءَ الفتنةِ أي الزَّيغِ أي ابتغَاء الإيقاعِ في الأمرِ المحظورِ لأن المشبّهَةَ غرضُهُم في جدالِهم أن يُوقعوا السُّنّيَّ في اعتقادِهم الباطِلِ، والذين في قلوبهِم زيغٌ هم أهلُ الأهواءِ كالمعتزِلةِ وغيرِهم. وقد حصلَ في زمنِ عمر بن الخطابِ رضي عنه أن رجلًا يقالُ له صَبِيغ كان يسألُ عن المتشابِهِ على وجهٍ يُخشَى منهُ الفتنةُ فضربَهُ سيّدنا عمرُ ثم نفاهُ وأَمَرَ أن لا يَختَلِطَ الناسُ بهِ.
وسمَّى الله تعالى المحكماتِ أمَّ الكتابِ أي أمَّ القرءانِ لأنها الأصلُ الذي تُرَدُّ إليها المتشابهاتُ، ثم المتشابهُ قسمانِ: أحدُهُمَا ما لا يعلمُهُ إلا الله كوجبةِ القيامةِ، والثَّاني يعلمُهُ الرَّاسخونَ في العلمِ كمعنى الاستواءِ المذكورِ في قولِهِ تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) فإن الرَّاسخينَ فسَّروهُ بالقَهرِ.
الآيَاتُ المُحْكَمَةُ
قال المؤلف رحمه الله: الآيَاتُ المُحْكَمَةُ: هِيَ مَا لا يَحْتمِلُ منَ التّأوِيْلِ بِحَسَبِ وَضْعِ اللُّغَةِ إلا وَجْهًا وَاحِدًا، أَوْ مَا عُرِفَ المُرادِ به بوُضُوْحٍ كقَولِه تَعَالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ (11) ، وقَولِه: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (4) ، وقَولِهِ: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّ﴾ (65) [سورة مريم].
الشرح: ليُعلَم أن الآيات القرءانيَّة أغلَبُهَا مُحكَمَةٌ، والآياتُ المحكمَةُ هي التي دلالتُهَا على المرادِ واضحةٌ، ويقالُ: هي ما لا يَحتَمِلُ من التَّأويلِ بحسبِ اللُّغةِ العربيَّةِ إلا وجهًا واحدًا كقوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (65) أي مِثلًا أي ليسَ له مثيلٌ ولا شبيهٌ، ولا يخالِفُ تقسيمَ الآياتِ إلى محكمٍ ومتشابهٍ قولُهُ تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءايَاتُهُ﴾ [سورة هود/1] وقولُه: ﴿كِتَابًا مُّتَشَابِهًا﴾ [سورة الزمر] لأن المرادَ بإحكامِهِ إتقانُهُ وعدمُ تطرُّقِ النَّقصِ والاختلافِ إليه، وبتشابُهِهِ كونه يشبِهُ بعضهُ بعضًا في الحقّ والصّدقِ والإعجازِ.
والآياتُ التي ذكرها المؤلّفُ هي أمثلةٌ للآياتِ المحكمةِ التي لا يجوزُ تأويلُها أي إخراجُها عن ظاهرِها لأن إخراجَ النّص عن ظاهرِهِ بغيرِ دليلٍ نقليّ أو عقليّ عبثٌ لا يجوزُ في كلام الله عزَّ وجلَّ ولا في كلامِ نبيّهِ كما قالَ الرَّازيُّ، وأما قولُهُ تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) وقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [سورة فاطر/10] فلا بدَّ من تأويلهما وَرَدّهِما إلى الآياتِ المحكماتِ، ولا يجوزُ تركُ التَّأويلِ والحملُ على الظّاهرِ لأنَّه يلزمُ من ذلكَ ضربُ القرءانِ بعضه ببعضٍ، وذلك لأن ظاهرَ قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) وقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (10) تحيز الله تعالى في جهةِ فوق، وقولُهُ تعالى: ﴿وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ (115) ظاهرهُ أن الله في أُفُقِ الأرضِ، وقوله تعالى في حق إبراهيمَ: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ (99) ظاهرهُ أن الله ساكِن فلسطين لأن إبراهيمَ كان أراد الذهاب إليها وهذه الآية أيضًا ظاهرُها أن الله تعالى في جهةِ تحت، فإن تَرَكنَا هذه الآيات على ظواهِرِهَا كانَ ذلك تناقضًا ولا يجوزُ وقوعُ التناقضِ في القرءانِ فَوَجَبَ تركُ الأخذِ بظواهرِ هذه الآيات والرجوعُ إلى ءاية ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ (11).
وأما من قال جهةُ فوق تليقُ بالله وجهةُ تحتٍ نقصٌ على الله فلذلك لا نؤولُ الآياتِ التي تَدُلُّ ظواهرُها على أنه في جهةِ فوق بل نؤوّلُ الآياتِ التي تدلُّ ظواهرها على أنه في جهةِ تحت فالجوابُ: أنَّ جهةَ فوق مسكنُ الملائكةِ وكذلكَ مدارُ النجومِ والشمسِ والقمرِ جهةُ فوق، وليسَ هؤلاءِ أفضل من الأنبياءِ الذين مَنشَؤُهم في جهةِ تحت وحياتُهم في جهةِ تحت إلى أن يموتوا فيُدفنوا فيها. والأنبياء أفضل من الملائكة لأن الله أسجد لآدم الملائكة فسجدوا له، والمسجود له أفضل من الساجد فبطل قولكم جهة فوق كمال لله وجهة التحت نقص على الله لأن الله لا يتشرف بشىء من خلقه، فلا يتشرف بالعرش ومن زعم ذلك جعل الله محتاجًا لغيره والاحتياج مستحيل على الله بل التحيز في جهة فوق أو غيرها نقص على الله لأنه يلزم من التحيز أن يكون له حد ومقدار والمقدار للمخلوق قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [سورة الرعد/8]. العرش له مقدار والذرة لها مقدار وكذلك ما بينهما من الأحجام والأجسام المختلفة. ثم إن المَلِكَ والسلطانَ قد يكونانِ يسكنانِ في بطنِ الوادي وَحُرَّاسُهُمَا يكونون على الأعالي، فهذا القياسُ الذي تعتبرهُ الوهابيةُ قياسٌ فاسدٌ لا يَلتَفِتُ إليه إلا من هو ضعيفُ العقلِ فاسدُ الفَهمِ، فمذهبُ أهلِ السنةِ الأشاعرةِ والماتريديةِ هو الصوابُ السّديدُ الموافِقُ للعقلِ والنقلِ، والحمدُ لله على ذلكَ.
الآياتُ المُتَشَابِهَةُ
قال المؤلف رحمه الله: الآياتُ المُتَشَابِهَةُ:
والمُتَشَابِهُ هُو مَا لَم تَتّضِح دِلالتُه أوْ يَحتَمِلُ أَوْجُهًا عَدِيْدَةً واحتَاجَ إلى النَّظَر لِحَمْلِهِ علَى الوَجْهِ المُطَابِقِ كقَولِه تَعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5).
الشرح: المتشابهُ هو الذي دِلالتُهُ على المرادِ غيرُ واضحةٍ، أو كان يحتمِلُ بحسبِ وضعِ اللغة العربيةِ أوجهًا عديدةً، واحتيج لمعرفةِ المعنى المرادِ منه لنظرِ أهلِ النَّظرِ والفهمِ الذين لهم درايةٌ بالنُّصوصِ ومعانيها ولهم درايةٌ بلغةِ العربِ فلا تخفى عليهم المعاني إذ ليس لكلّ إنسانٍ يقرأ القرءان أن يفسّرهُ.
وليس المرادُ بقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [سورة طه/5] أنه جالسٌ على العرشِ ولا أنه مستقرٌّ عليه ولا أن الله بإزاءِ العرشِ بل كلُّ هذا لا يليقُ بالله، نعتقدُ أن الله استوى استواءً على العرشِ يليقُ به ولا نعتقدُ بشىءٍ من هذه الأشياءِ الجلوسَ والاستقرارَ والمحاذاةَ.
قال المؤلف رحمه الله: وَقَوْلِه تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [سورة فاطر/10] أيْ أَنَّ الكَلِمَ الطَّيّبَ كَلا إلهَ إلا الله يَصْعَدُ إلى مَحَلّ كَرَامَتِه وهُوَ السَّمَاءُ، والعَمَلُ الصَّالِحُ يرفَعُه أي الكلمُ الطيبُ يرفَعُ العملَ الصالحَ وَهَذَا مُنْطَبِقٌ ومُنْسَجِمٌ مَعَ الآيَةِ المُحكَمَةِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ (11).
الشرح: هذا من المتشابهِ الذي يعلَمُ معناهُ الرَّاسخونَ، فالكلمُ الطَّيّبُ هو كلا إله إلا الله والعملُ الصّالحُ يشمَلُ كلَّ عملٍ صالحٍ يُتقرَّبُ به إلى الله كنحو الصلاةِ والصدقةِ وصلة الرحمِ، فالمعنى أن كلَّ ذلك يصعدُ إلى الله أي يتقبَّلُهُ، هذا ليسَ فيه أن الله له حيّزٌ يتحيّزُ فيه ويسكنُهُ.
فالسَّماءُ محلُّ كرامةِ الله أي المكان الذي هو مشرَّفٌّ عند الله لأنها مسكنُ الملائكةِ، هذا التَّفسيرُ موافق للآية المحكمة: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ (11).
قال المؤلف رحمه الله: فَتَفْسِيرُ الآيَاتِ المُتَشَابِهَةِ يَجبُ أنْ يُرَدَّ إلى الآيَاتِ المُحْكَمَةِ، هَذا في المُتَشَابِهِ الذي يَجُوزُ للعُلَماءِ أَنْ يَعْلَمُوهُ.
الشرح: معناهُ أن من أرادَ أن يُفسّرَ المتشابهَ يجبُ أن يكونَ موافقًا للآياتِ المحكماتِ كتفسيرِ الاستواءِ بالقهرِ فإنه موافقٌ للمحكماتِ، كذلك تفسيرُ ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (10) بمحلّ كرامتِهِ وهي السَّماءُ موافقٌ للمحكمات.
قال المؤلف رحمه الله: وأمّا المتشَابهُ الذي أُريدَ بقوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ﴾ [سورة ءال عمران/7] على قراءةِ الوَقفِ على لفظِ الجَلالةِ فهو ما كانَ مثلَ وجْبَةِ القيامةِ، وخروجِ الدجالِ على التّحديدِ، فلَيسَ مِن قَبيْلِ ءايةِ الاستواءِ.
الشرح: وجبةُ القيامةِ أي الوقت المحدَّدُ الذي تقعُ فيه القيامةُ. فوجبةُ القيامَةِ وخروجُ الدَّجَالِ لا يعلمُهُمَا على التحديدِ إلا الله، لا يعلمُهُمَا أحدٌ من الخلقِ لا الراسخونَ في العلمِ ولا غيرُهم بدليل قول الرسول لجبريل حين سأله عن الساعة أي القيامة “ما المسئول عنها بأعلم من السائل”، وهو جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان، فإذا كان جبريل وسيدنا محمد لا يعلمان ذلك فغيرهما أولى بأن لا يعلم. فتبينَ أن المتشابهَ قِسمَانِ قسمٌ لا يعلمُهُ إلا الله وقسمٌ يعلمهُ بعضُ من علّمَهُ الله من عبادِهِ. الذي لا يعلمه إلا الله مثل وجبة القيامة ذاك لا يعلمه أحد على التحديد إلا الله وكذلك خروج الدجال وأما المتشابهُ الذي يعلمُهُ بعضُ عبادِ الله فهو مثل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) ، وقوله: ﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (22) ونحو ذلك، هذا يعلمُهُ الله ويعلمُهُ بعضُ عبادِ الله لكن لا يُقطَعُ بأن مرادَ الله بالاستواءِ على العرشِ القهرُ إنما يُظَنُّ ظنًّا راجحًا. فالمذمومونَ الذين ذَمَّهم الله في القرءان بقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ﴾ [سورة ءال عمران/7] هم الذين يحاولونَ تحديدَ وقتِ قيامِ الساعةِ وخروجِ الدجالِ والذين يحاولون تفسيرَ القسمِ الآخرِ من المتشابِهِ على وجهٍ فاسدٍ كالتشبيهِ، كِلا الفريقين مذمومٌ، فالتأويلُ إذا كان على الوجهِ السَّائغِ شرعًا لا يُذَمُّ فاعِلُهُ بل يُمدَحُ. وإطلاقُ الوهابيةِ قولهم “التأويلُ تعطيلٌ وزيغٌ” كلامٌ باطلٌ، كيفَ وقد ثَبَتَ التأويلُ عن السلفِ الصالحِ كأحمد بن حنبل الذي تعتز به الوهابية مع أنهم مخالفون له في الاعتقاد وفي الأحكام، فقد ثبت عنه أنه أوَّل ﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (22) بمجىء القدرة أي ءاثار قدرة الله العظيمة مما يظهر يوم القيامة كخروج عُنُقٍ من جهنم ليراه الكفار فيفزعوا برؤيته وهم في موقف القيامة، وشهادة الأيدي والأرجل بما كسبه الكفار مع الختم على أفواههم. يعتقدون التشبيه الصريح لخالقهم ويدّعون أنهم على مذهب أحمد، فالمشبهة من الوهابية وسلفهم كابن حامد والزاغوني شاذون عن عقيدة أحمد فقد قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي عن سلف الوهابية في التشبيه كابن حامد هذا في إحدى ثلاث مؤلفات ألفها في إبطال التشبيه وهو كتاب أخبار الصفات ولما علم بكتابي هذا جماعة من الجهلة لم يعجبهم لأنهم ألفوا كلام رؤسائهم المجسمة وقالوا ليس هذا المذهب قلت ليس بمذهبكم ولا بمذهب من قلدتم من أشياخكم فقد نزهت مذهب الإمام أحمد ونفيت عنه كذب المنقولات وهذيان المعقولات غير مقلد فيما أعتقده. فكيف أترك بَهْرَجًا وأنا أنقضه وقال في موضع ءاخر من هذا الكتاب عن هؤلاء الذين يجسمون الله من الحنابلة إنهم شانوا المذهب اهـ. وما أبعدَ هؤلاء الحنابلة المجسمة عن أحمد رضي الله عنه فإنه كفّر من يقول الله جسم لا كالأجسام نقل ذلك عنه صاحب الخصال وهو حنبليّ. وقال وقد رأيتُ من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح وانتدب للتصنيف ثلاثة أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي وابن الزاغوني فصنفوا كتبًا شانوا بها المذهب فحملوا الصفات على مقتضى الحس فَسَمِعوا أن الله خلق ءادم على صورته فأثبتوا صورة ووجهًا زائدًا على الذات وعينين وفمًا ولهواتٍ وأضراسًا وجهة هي السحاب ويدين وأصابع وخِنْصِرًا وإبهامًا وصدرًا وفخِذًا وساقين ورجلين، وقالوا ما سمعنا ذكر الرأس، وقالوا أن يَمَسَّ ويُمَسَّ وأن يدني العبد من ذاته، وقال بعضهم ويتنفس، ثم هم يُرضون العوام بقولهم لا كما يعقل، وقد أخذوا بالظواهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى ولا إلى العلم بما توجبه الظواهر من سمات الحدوث ولم يقنعوا أن يقولوا صفة فعل حتى قالوا صفة ذات ثم لما أثبتوا بها صفات قالوا لا نحملها على ما توجبه اللغة مثل يدٍ على قدرة أو نقمة ولا مجيءٍ وإتيان على معنى برّ ولطف والساق على الشدة بل قالوا نحملها على ظاهرها والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين والشىء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن فإن صرف صارف حمل على المجاز وهم يتحرجون من التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام فقد فضحت التابع والمتبوع فقلت لهم: يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع وإمامكم الإمام الأكبر أحمد بن حنبل كان يقول وهو تحت السياط كيف أقول ما لم يُقَلْ فإياكم أن تبتدعوا في مذهبي ما ليس منه اهـ، إلى ءاخر ما قاله في هذا الكتاب. وهذا في الصحيفة التاسعة من كتابه أخبار الصفات.
ونقلَ البياضي الحَنفي في إشاراتِ المرامِ عن فتحِ القديرِ تكفير من يقول الله جسم لا كالأجسام بمجرد الإطلاق اهـ وفيها أن الآمِدي قال في بعضِ كتبهِ وهو المنائح: ومن وصَفَهُ تعالى بكونهِ جسمًا منهم من قال إنه جسمٌ أي موجودٌ لا كالأجسامِ كبعضِ الكراميةِ ومنهم من قال إنه على صورةِ شابّ أمرد ومنهم من قال على صورةِ شيخٍ أشمط وكلُّ ذلك كفرٌ وجهلٌ بالربّ ونسبةُ النقصِ الصريح إليه. تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا اهـ. وقال البياضي في الإشارات (ص/200): فمن قال لا أعرف ربي أفي السماء أم في الأرض فهو كافر اهـ، وقال: كذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض اهـ. وقال البياضي: إن القائلَ بالجسميةِ والجهةِ منكر وجود موجود سوى الأشياء التي يمكن الإشارة إليها حسًّا فهم منكرون لذات الإله المنزه عن ذلك فلزمهم الكفر لا محالة اهـ.
ثم إنهم أي الوهابية يناقضونَ أنفسَهم فهذا الذَّمُّ يرجعُ عليهم لأنهم يؤولونَ الآياتِ التي توهِمُ أن الله في جهةِ تحت، أما الآيات التي توهِمُ أن الله في جهةِ فوق يتركونَ تأويلَهَا ويحملونها على الظاهر.
فَيحسنُ أن يقالَ قراءةُ الوقفِ على لفظِ الجلالةِ تُحمَلُ على المتشابهِ الذي لا يعلمُهُ إلا الله، وقراءةُ الوصلِ تُحمَلُ على القِسمِ الذي يُطلِعُ الله بعضَ عبادِهِ على تأويلِهِ، ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ﴾ (7)، فلا تناقض بين القراءتين.
قال المؤلف رحمه الله: فَقَدْ وَرَدَ عنْهُ صلى الله عليه وسلم: “اعْمَلُوا بمُحْكَمِهِ وءامِنُوا بمُتَشَابِهِهِ” ضَعِيفٌ ضَعْفًا خَفِيفًا.
الشرح: معنى قوله: “اعملوا بمحكمه” أي القرءان، وقوله: “وءامنوا بمتشابهه” أي من غيرِ أن تتوهَّموا أن معانيها من معاني الأجسامِ وهو معنى قول العلماءِ عن الآياتِ المتشابهة: “أمرُّوها كما جَاءت بلا كيفٍ” رواه البيهقي في الأسماء والصفات.
والحِكمَةُ من الآياتِ المتشابهةِ أن يَبتليَ عبادَهُ حتى يكونَ للذي يحملها على محمِلِها أجرٌ عظيمٌ، ويرجِعُ المعنى إلى قولِه تعالى: ﴿يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء﴾ [سورة المدثر/31]، وقولِهِ تعالى عن القرءان: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [سورة البقرة/26]. فالقرءانُ ليسَ كلُّ الناسِ يهتدي بهِ إنما يهتدي بهِ من شَاءَ الله له الهُدَى.
قال المؤلف رحمه الله: قالَ المُحَدّثُ اللُّغَويُّ الفَقِيهُ الحَنَفِيُّ مُرتَضَى الزّبِيدِيُّ في شَرْحِه المُسَمَّى “إتْحافُ السَّادَةِ المتّقينَ” نَقْلًا عن كتَاب التَّذْكِرَةِ الشَّرْقِيّةِ لأبي نصرٍ القشيري ما نَصُّه: وأمَّا قَوْلُ الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ﴾ [سورة ءال عمران/7] إنمَّا يُريدُ بهِ وَقْتَ قِيَامِ السَّاعَةِ، فَإنّ المُشْرِكيْنَ سَأَلُوا النّبي صلى الله عليه وسلم عن السّاعةِ أيّانَ مُرْسَاها ومتَى وقُوعُها.
الشرح: أي أن المتشابهَ الذي لا يعلمُهُ إلا الله هو كوقتِ قيامِ السَّاعَةِ، وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ﴾ (7) معناهُ ذلكَ لا يعلمُهُ إلا الله، وقد تَقدَّمَ بيانُ ذلكَ.
قال المؤلف رحمه الله: فَالمُتَشَابِهُ إشَارَةٌ إلى عِلْم الغَيبِ، فلَيْسَ يَعْلَمُ عَواقِبَ الأمُورِ إلا الله عَزَّ وجَلَّ، ولهذا قَالَ: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ [سورة الأعراف/53] أيْ: هلْ ينظُرونَ إلا قيامَ السَّاعَةِ، وكيفَ يَسُوغُ لِقَائِلٍ أَن يَقُولَ في كتابِ الله تَعَالى مَا لا سَبِيْلَ لمخلُوقٍ إلى مَعرِفَتِهِ ولا يَعلَمُ تَأويْلَهُ إلا الله ألَيسَ هذَا مِنْ أعْظَمِ القَدْحِ في النّبُواتِ؟ وأنَّ النبيَّ ما عرَفَ تأويلَ ما وَردَ في صِفاتِ الله تعالى، ودعَا الخَلْقَ إلى عِلْمِ ما لا يُعلَمُ؟ الشرح: معناهُ لا يليقُ أن يقولَ قائلٌ في القرءانِ يوجَدُ ما لا سبيلَ لمخلوقٍ إلى معرفتِهِ ولا يعلمُ تأويلهُ إلا الله هذا من أعظمِ القدحِ في النُّبوَّاتِ يعني جرح في أمورِ النُّبوّاتِ، وفيه ما يتضمَّنُ أن النّبيَّ ما عرفَ تأويلَ ما وردَ في صفاتِ الله تعالى ودعا الخلقَ إلى علمِ ما لا يُعلَمُ أي أنه هو نفسهُ لا يعرفُ ودعا الناسَ إلى عِلمِ ما لا يُعلَمُ.
قال المؤلف رحمه الله: ألَيْسَ الله يَقُولُ: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ [سورة الشعراء/195] فإذًا علَى زَعْمِهم يَجِبُ أن يَقُولوا كَذَبَ حيثُ قال: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ (195) إذْ لم يكنْ مَعلُومًا عِنْدَهُم.
الشرح: معناهُ أن العربَ الذين جاءهم ليدعوهم إلى الإيمانِ بالقرءانِ سيقولونَ كيفَ يقولُ أُنزِلَ عليَّ بلسانٍ عربي مبينٍ أي ظاهرٍ ثم نحنُ لا نعرفُ، كيف صارَ إذًا مبينًا إن كان لا يعلمُ تأويلُ هذه الكلماتِ.
قال المؤلف رحمه الله: وإلا فأَينَ هذَا البَيَانُ وإذَا كانَ بلُغَةِ العَرَبِ فكيْفَ يَدَّعِي أنَّه مِمَّا لا تَعْلَمُه العَرَبُ لَمّا كانَ ذَلِكَ الشَّىءُ عَرَبيًّا، فَما قَوْلٌ في مَقَالٍ مآلُهُ إلى تَكْذِيبِ الرّبّ سُبْحانَه.
الشرح: معناهُ هذا يؤدّي إلى تكذيبِ الله في كلامِهِ.
قال المؤلف رحمه الله: ثُمّ كَانَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو النَّاسَ إلى عِبادَةِ الله تَعالى فلَو كَانَ في كلامِهِ وفيْما يُلْقِيه إلى أُمَّتِه شَىءٌ لا يَعْلَمُ تأْويْلَهُ إلا الله تَعالى لكَانَ لِلقَوْمِ أنْ يَقُولُوا بيّنْ لَنا أوَّلا مَنْ تَدْعُونَا إِليْهِ وَمَا الذي تَقُولُ فإنَّ الإيْمانَ بمَا لا يُعلَمُ أصْلُهُ غَيْرُ مُتأَتٍّ – أي لا يُمكِنُ – هذا مَعناهُ أنّ العربَ الذين أُرسِلَ إلَيهم كَانُوا قَالُوا له هذا لا يُمكِنُ. ونِسْبَةُ النّبي صلى الله عليه وسلم إلى أنّه دَعا إلى رَبّ مَوْصُوفٍ بصفَاتٍ لا تُعقَلُ أمرٌ عظِيمٌ لا يَتَخَيَّلُهُ مُسْلِمٌ.
الشرح: أي لا يُعقَلُ أن يدعوَ الرسولُ إلى الإيمانِ بربّ لا تُعقَلُ صفاتُهُ.
قال المؤلف رحمه الله: فَإِنَّ الجَهْلَ بالصّفَاتِ يُؤَدّي إلى الجَهْلِ بالمَوْصُوفِ.
الشرح: لو كانَ الله لا تُعلَمُ صفاتُهُ معناهُ أن الذَّاتَ أيضًا غيرُ معلومٍ.
قال المؤلف رحمه الله: والغَرَضُ أَنْ يَسْتَبِينَ مَنْ مَعَهُ مُسْكَةٌ من العَقْل أَنَّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: “استواؤُهُ صِفَةٌ ذَاتِيّةٌ لا يُعْقَلُ مَعنَاها، واليدُ صِفَةٌ ذَاتِيّةٌ لا يُعْقَل معناها، والقَدَمُ صِفَةٌ ذاتِيّةٌ لا يُعقَل مَعْنَاها” تمويهٌ ضِمْنَهُ تكييفٌ وتَشْبيهٌ ودُعاءٌ إلى الجَهْلِ وقَد وضَحَ الحقُّ لذِي عَينَيْنِ.
الشرح: معناهُ استواءُ الله على العرشِ ليسَ شيئًا معلومًا على هذا الرّأي الفاسِدِ، والقرءانُ مذكورٌ فيه أنه بلسانٍ عربيّ مبينٍ، وهذا لا يتَّفقُ مع هذا. وإذا قالَ قائلٌ اليدُ صفةٌ لله لا يُعقَلُ معناهَا والقَدمُ صفةٌ ذاتيةٌ لا يُعقلُ معناها يكون هذا تمويهًا، ومعنى قوله: “مُسكَةٌ من العَقْلِ” أي شىءٌ من العَقلِ.
قال المؤلف رحمه الله: ولَيْتَ شِعْرِي هذَا الذي يُنكِرُ التّأويلَ يَطَّرِدُ هَذَا الإنكارَ في كُلّ شىءٍ وفي كُلّ ءايَةٍ أمْ يَقْنَعُ بتَرْكِ التّأْويلِ في صِفَاتِ الله تَعَالى.
الشرح: معناهُ هذا الذي يُنكِرُ التأويلَ هلْ هوَ يُدْخِلُ هذا في كُلّ شَىءٍ وَفِي كُلّ ءايَةٍ أَمْ في صِفَاتِ الله فَقَطْ يَمْنَعُ ويَنْفِي؟ وقوله: “يَطَّرِدُ هذا الإنكار” معناه هل يعمم هذا الإنكار أم في مواضع يراها هو فقط.
قال المؤلف رحمه الله: فَإن امتَنَعَ مِنَ التّأْويْلِ أَصْلًا فَقَدْ أبْطَلَ الشَّريْعَةَ والعُلُومَ إذْ مَا مِنْ ءايةٍ (من الآيات التي اختُلِف فيها من حيثُ التأويلُ وتركُه) وخَبَرٍ إلا ويَحتاجُ إلى تَأويْلٍ وتَصَرُّفٍ في الكَلامِ (إلا المُحْكَمُ نَحْوُ قولِه تَعَالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ [سورة الحديد/3] ممّا وردَ في صفاتِ الله، وقولِه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [سورة المائدة/3] الآية مِمّا ورَدَ في الأَحْكَام)، لأَنَّ ثَمَّ أشْياءَ لا بُدَّ منْ تَأْوِيلِها لا خِلافَ بَيْنَ العُقَلاءِ فِيه إلا المُلْحِدَة الذينَ قَصْدُهُم التَّعْطيلُ للشَّرَائِعِ، والاعتقادُ لهذا يُؤدّي إلى إبطالِ ما هُوَ عليهِ من التمسكِ بالشرعِ بزعمِهِ.
الشرح: الذي يمنَعُ التّأويل مطلقًا أي في الصفاتِ وفي غيرِ الصفاتِ أبطَلَ الشّريعةَ لأنه لا بُدَّ من التّأويلِ كما في قولِهِ تعالى عن الرّيحِ: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [سورة الأحقاف/25] فهل تلك الريح دمَّرت السّموات والأرضَ؟ هل دَمَّرَت الجنةَ وجَهَنَّمَ؟ إنمَا دَمَّرَت الأشياءَ التي هي عَادةً يعيشونَ فيها. فمن هنا يُعلَمُ أن ثَمَّةَ نصوصًا لا بدَّ من تأويلِها ولا يجوزُ حَملُهَا على الظّاهرِ. فالذي يَدَّعي التّمسُّكَ بالشَّرعِ وينفي التّأويلَ يُنَاقِضُ نفسَهُ لأنَّ قوله بنفي التّأويلِ ينقضُ قولَهُ بالتَّمسُّكِ بالشَّريعةِ.
قال المؤلف رحمه الله: وإنْ قَالَ يَجُوزُ التّأْوِيلُ على الجُمْلَةِ (أي في بَعْضِ الأحْوالِ) إلا فيْما يتَعلَّقُ بالله وبِصفَاتِه فلا تأْويلَ فِيْهِ، فَهذا مَصِيْرٌ مِنْهُ إلى أنَّ مَا يَتَعلَّقُ بغيْرِ الله تَعالى يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ ومَا يتعَلَّقُ بالصَّانِعِ [أي الخَالِقِ] وصِفَاتِهِ يجِبُ التَّقَاصِي عَنْهُ – أي البُعْدُ عَنْهُ -. وهَذَا لا يَرْضَى به مُسْلِمٌ. وَسِرُّ الأَمْر أَنَّ هَؤلاءِ الذينَ يَمتَنِعُونَ عن التّأويلِ مُعتقِدُونَ حَقِيْقةَ التَّشْبِيهِ غَيْرَ أَنَّهُم يُدَلّسُونَ ويَقُولونَ لَه يَدٌ لا كَالأَيْدِي وقَدَمٌ لا كالأقْدَام واستِواءٌ بالذَّاتِ لا كَما نَعْقِلُ فيْما بَيْنَنَا، فَلْيَقُل المُحَقّقُ هذَا كلامٌ لا بُدَّ مِن استِبْيَانٍ، قَولُكُم نُجرِي الأَمْرَ على الظَّاهِرِ ولا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ تنَاقُضٌ.
الشرح: فليَقُل المُحَققُ يعني أهلَ الحقّ أهلَ الفهمِ، معناه قولُكم هذا فيه إشكالٌ إن قلتم نُجري الأمرَ على الظّاهِرِ فليَقُل الذي على الحَقّ لهؤلاءِ الضَّالينَ: هذا كلامٌ لا بدَّ من استبيانٍ فهل تُجرونَ الأمرَ على الظَّاهِرِ؟، وهؤلاء الذين يَمتَنعونَ عن التأويلِ وهم معتقدونَ التشبيهَ يُدَلّسونَ أي يُمَوّهونَ على الناسِ فيقولونَ باللسانِ: له يدٌ لا كالأيدي وَقَدَمٌ لا كالأقدامِ وفي الاعتقاد يعتقدونَ الجارحَةَ، ويقولونَ باللفظِ استواءُ الله استواءٌ بالذَّاتِ لا كما نَعقِلُ وفي الاعتقادِ يعتقدونَ الجسمَ الذي تَعرِفُهُ النفوسُ.
قال المؤلف رحمه الله: إنْ أجرَيتَ علَى الظَّاهِر فَظَاهِرُ السّيَاقِ في قَولِه تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾ [سورة القلم/42] هُوَ العُضْوُ المُشْتَمِلُ علَى الجِلدِ واللَّحمِ والعَظْمِ والعَصَبِ والمُخّ.
الشرح: معناهُ إن حَمَلتُم الآيةَ على ظاهِرِهَا فقد أثبتُّم لله هذا العضوَ الذي نَعرِفُهُ من أنفسِنَا، والمخُّ هوَ السائل الذي في دَاخِلِ العَظمِ.
قال المؤلف رحمه الله: فإنْ أخَذْتَ بهذَا الظَّاهِرِ والتَزَمْتَ بالإقْرَارِ بهذِهِ الأَعْضَاءِ فَهُو الكُفْرُ.
الشرح: الذي يعتقدُ في الله الجسمَ كافرٌ، ويقالُ لمن يقولُ: “نحنُ لا نُكَفّرُ ولو أثبتوا لله الأعضاءَ”: هَذا الإمامُ القشيريُّ مُتَقَدّمٌ وقد حَكَمَ عليهم بالكُفرِ.
ومعنى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (42) أي يكشفُ يومَ القيامةِ عن شدَّةٍ شديدةٍ وَهولٍ شَديدٍ، أي عن أمرٍ شديدٍ بالغٍ في الصُّعوبةِ، أما المشبّهَةُ يقولونَ ﴿عَن سَاقٍ﴾ (42) أي الله تعالى يكشِفُ عن ساقِهِ.
وقولُهُ تعالى ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ﴾ (42) هذا السُّجودُ سجودُ امتحانٍ حتى يتميَّزَ المؤمنونَ الذين كانوا يسجدونَ لله تعالى عن نيَّةٍ وإخلاصٍ من المنافقينَ الذين كانوا يَتَظَاهرونَ بالإسلامِ ولم يكونوا مسلمينَ إنما كانوا يسجدونَ في الدُّنيا مع المسلمينَ أحيانًا، أي حتى ينكشِفَ أمرُ هؤلاءِ وينفضحوا يأمُرُ الله الناسَ بالسُّجودِ، فالمؤمنونَ يسجدونَ وأما المنافقونَ فلا يستطيعونَ لأن ظهورَهُم لا تُطَاوِعُهُم على السُّجودِ فيفتضحون.
وأما قولُهُ تعالى: ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ [سورة القيامة/29] أي سَاق العبادِ بعضِهِم ببعضٍ أي يومَ القيامة من شدَّةِ الزَّحمَةِ.
قال المؤلف رحمه الله: وإنْ لَم يُمْكِنْكَ الأَخْذُ بها (أيْ إنْ كُنتَ لا تَقُولُ ذلِكَ) فَأَيْنَ الأَخْذ بالظَّاهِر. أَلَسْتَ قَدْ تَرَكْتَ الظَّاهِرَ وعَلِمْتَ تَقَدُّسَ الرَّبّ تعالَى عَمّا يُوْهِمُ الظَّاهِرُ فَكَيْفَ يَكُوْنُ أَخْذًا بالظَّاهِر، وإنْ قالَ الخَصْمُ هَذِه الظَّواهِرُ لا مَعْنَى لَها أصْلًا فَهُو حُكْمٌ بأَنَّها مُلْغَاةٌ، وَمَا كانَ في إبْلاغِها إلَيْنَا فائِدَةٌ وهِيَ هَدَرٌ وهذا مُحَالٌ.
الشرح: معنَى ذَلِكَ أنها لغوٌ، والقرءانُ كيفَ يكونُ لغوًا. وهَذا مُحَالٌ؟، وذلكَ معناهُ حُكمٌ بأنه ما كانَ في إبلاغِها إلينَا فائدةٌ وهي هَدَرٌ أي لا قيمة ولا اعتبارَ لها.
قال المؤلف رحمه الله: وفي لُغَةِ العَرَبِ مَا شِئْتَ منَ التَّجَوُّزِ والتَّوَسُّع في الخِطَابِ وكَانُوا يَعْرِفُونَ مَوَارِدَ الكَلامِ ويَفْهَمُونَ المَقَاصِدَ، فَمنْ تَجَافَى عن التّأوِيلِ فذَلِكَ لِقِلَّةِ فَهْمِهِ بالعَربِيَّةِ.
الشرح: أي مَن تَرَكَ التأويلَ التفصيليَّ والإجماليَّ وتمسَّكَ بالظاهِرِ هَلَكَ وخرجَ عن عقيدةِ المسلمينَ، أما الذي لا يحمِلُ هذه الآياتِ على الظواهرِ بل يقولُ لها معانٍ لا أعلَمُها تليقُ بالله غير هذه الظواهرِ مثلًا استواءُ الله على العرشِ له معنًى غير الجلوسِ وغير الاستقرارِ، غير استواءِ المخلوقينَ لكن لا أعلمُهُ فهذا سَلِمَ، وكذلكَ الذي يقولُ استواءُ الله على العرشِ قهرُهُ للعرشِ. فذاكَ تأويلٌ إجماليٌّ وهذا تأويلٌ تفصيليٌّ. وقولُهُ: “التَّجوُّز” أي ارْتكَابُ المَجَازِ في الخِطَابِ.
قال المؤلف رحمه الله: ومَنْ أحَاطَ بِطُرُقٍ مِنَ العَرَبِيَّةِ هَانَ عليْهِ مَدْرَكُ الحَقَائِقِ.
الشرح: أي مَن أَحَاطَ أي وَسعَت معرفَتهُ بالعربيةِ الأصليةِ التي نَزَلَ بها القرءانُ فإنهُ يَفهَمُ المعنَى المجازيَّ والمعنَى الحقيقيَّ. فمن عرفَ تمامَ لغةِ العربِ يفهَمُ أنه لا تُحمَلُ الآياتُ المتشابهةُ على الظاهِرِ، وهانَ عليهِ أن يعرفَ من أينَ تُعرَفُ الحقائِقُ.
قال المؤلف رحمه الله: وَقَدْ قِيلَ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (7) فَكَأَنَّهُ قَالَ والرّاسِخونَ في العِلْمِ أَيْضًا يَعْلَمُونَه وَيقولونَ ءَامَنَّا بِهِ.
الشرح: على قراءةِ تَركِ الوقفِ على لفظِ الجلالَةِ يعلمونَ ومعَ هذا يقولونَ ﴿ءامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [سورة ءال عمران/7] أي المحكماتُ من عند الله والمتشابهاتُ من عندِ الله، فالراسخون يعلمونَ أيضًا معنَى المتشابِهِ الذي ليسَ علمه خاصًّا بالله. أما المتشابه الذي علمُهُ خاصٌّ بالله هو كوقتِ خروجِ الدجالِ على التحديدِ من سنةِ كذا من شهرِ كذا في يومِ كذا في ساعةِ كذا، هذا لا يعلمُهُ إلا الله. والرَّاسخونَ في العلمِ هُمُ المتمكنونَ في العِلمِ، والوَقفُ على كَلمةِ ﴿الْعِلْمِ﴾ (7) على قراءةٍ، والقراءة الأخرى الوقفُ عندَ ﴿إِلاَّ اللهُ﴾ (7) فعندَ هؤلاءِ ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ (7) مُبتدأٌ خَبَرُهُ ﴿يَقُولُونَ﴾ (7).
قال المؤلف رحمه الله: فَإنَّ الإيمانَ بالشّىءِ إنَّما يُتَصَوَّرُ بَعْدَ العِلْمِ، أمَّا مَا لا يُعْلَمُ فالإيمانُ بهِ غَيرُ مُتَأَتّ، ولهذَا قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ في العِلْمِ. انتهى كلامُ الحافِظِ الزَّبيديّ مما نقله عن أبي النصرِ القشيريّ رحمه الله.
الشرح: يعني أن الشىءَ الذي لم يُعلَم بوجهٍ من الوجوهِ كيفَ يؤمنُ بهِ، ومعنى قوله: “غيرُ مُتَأَتّ” أي غيرُ مُمكِنٍ، أما ما عُلِمَ به يُؤمنُ بهِ ولو عُلِمَ من بعضِ الوجوهِ، مثلًا الذي يَعلَمُ أن استواءَ الله على العرشِ ليسَ على ظاهِرِهِ بل له معنًى ليس فيه شبهُ المخلوقينَ فهذا نوعٌ من العلمِ يُقالُ عَلِمَ وَءَامَنَ بهِ، كذلكَ الذي يؤوّلهُ تأويلًا تفصيليًّا فيقولُ الاستواءُ القهرُ هذا عَلِمَ بالتأويلِ التفصيليّ وءامنَ بهذا المتشابهِ أنه حَقٌّ وأنه مِن عندِ الله، أما لو قيلَ: الخلقُ لا يعلمونَ ما معنى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) وما أشبهَ ذلكَ، لا يعلمُهُ إلا الله هذا معناهُ أن القرءانَ نَزَلَ بما لا يعلمُهُ الذينَ أَرسَلَ الله النبيَّ إليهم فيكونُ معنى ذلكَ أن الله أرسلَ إليهم النبِيَّ بما لا يعلمونَ وهذا لا يليقُ بل يكفرُ قائلُ مثل هذا الكلامِ لأن الحجةَ تقومُ عليهم إذا بَلَّغَهمُ الرسولُ ما يُمكنُ أن يعلَموهُ.
قال المؤلف رحمه الله: فَهُنَا مَسلكَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ: الأوّلُ: مَسْلَكُ السَّلَفِ: وهُم أهْلُ القُرونِ الثّلاثَةِ الأُولى أي أكثرهم فإنَّهُم يُؤوّلونَها تأوِيْلًا إجْماليًّا بالإيمانِ بها واعتِقَادِ أنها ليسَت من صفاتِ الجسمِ بل أنَّ لَها مَعْنًى يَليقُ بجَلالِ الله وعظَمَتِه بلا تعْيِينٍ، بَلْ رَدُّوا تِلْكَ الآيَاتِ إلى الآياتِ المحكَمَةِ كقولِهِ تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ [سورة الشورى/11].
الشرح: السلفُ من كَانَ من أهلِ القرونِ الثّلاثةِ الأُولى قرن أتباعِ التَّابعينَ وقرن التّابعينَ وقرن الصَّحابةِ وهو قرن الرسولِ، هؤلاءِ يسمَّونَ السلفَ ومن جاءوا بعدَ ذلكَ يسمَّونَ الخلفَ، ومن العلماءِ من حَدَّ هذا بالمائتين والعشرين سنةً من مبعثِ الرّسولِ ومنهم من حَدَّ هذا بالمئاتِ الثَّلاثةِ الأولى. فالسّلفُ الغالبُ عليهم أن يؤوّلوا الآيات المتشابهة تأويلًا إجماليًّا بالإيمانِ بها واعتقادِ أن لها معاني تليقُ بجلالِ الله وعظمتِهِ ليست من صفاتِ المخلوقينَ بلا تعيين كآيةِ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5) ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (10) وحديثِ النزولِ بأن يقولوا بلا كيفٍ أو على ما يليق بالله أي من غير أن يكونَ بهيئةٍ من غير أن يكونَ كالجلوسِ والاستقرارِ والجوارحِ والطُّولِ والعرضِ والعمقِ والمساحَةِ والحركةِ والسكونِ والانفعالِ مما هو صفةٌ حادثةٌ. هذا مَسلكُ السّلفِ رَدُّوها من حيثُ الاعتقادُ إلى الآياتِ المحكمةِ كقوله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ (11) وتركوا تعيينَ معنًى معيَّنٍ لها مع نفي تشبيهِ الله بخلقِهِ. قال في فتح الباري فيعتقد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والسكون والتحول والحلول ليس كمثله شىء اهـ.
فائدة: تاريخُ المسلمين يبتدئ من هجرةِ الرسولِ من مكةَ إلى المدينةِ – بعدما نزلَ عليه الوحيُ مكثَ ثلاثَ عشرةَ سنة بمكةَ ثم جاءَ إلى المدينةِ من هناك بدءوا التأريخ.
قال المؤلف رحمه الله: وهُو كمَا قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ رضيَ الله عنه: “ءامنْتُ بما جَاءَ عن الله على مُرادِ الله وبما جَاءَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على مُرادِ رَسُولِ الله” يعني رضي الله عنه لا علَى ما قد تذهَبُ إليه الأوْهَامُ والظُّنُونُ من المَعاني الحِسّيَّةِ الجِسْمِيَّةِ التي لا تَجُوزُ في حَقّ الله تعالى.
الشرح: كلامُ الشَّافعيّ يؤيّدُ ما ذَهَب إليه أغلبُ السَّلَفِ، يعني لا تُحمَلُ هذه الآيات والأحاديث على المعنى الذي يُؤدّي إلى تجسيمِ الله بل نقولُ: إن الله أرادَ بذلكَ من المعاني ما أرَادَ.
قال المؤلف رحمه الله: ثم نفيُ التأويلِ التفصيلي عن السلفِ كما زعمَ بعضٌ مَردُودٌ بما في صَحيحِ البُخَاريّ في كِتابِ تَفْسير القُرءانِ وعِبارتُه هُناكَ: “سورةُ القصَص” ﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾ [سورة القصص/88] “إلا مُلْكَهُ ويقال ما يتقرب به إليه” ا.هـ. فملكُ الله صفةٌ من صفاتِهِ الأزليةِ ليس كالملكِ الذي يعطيهِ للمَخلوقينَ.
الشرح: البخاريُّ من السّلفِ وقد فَسَّرَ قولَ الله: ﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾ [سورة القصص/88] فقال: “إلا ملكه” أي إلا سلطانَهُ، ملكُ الله أزليٌّ أبديٌّ لا يفنَى، أما ملكُ غيرِهِ يفنَى، ملكُ الملوكِ الكفَّارِ كنمرود وفرعونَ الذين أعطاهُم الله تبارك وتعالى هذا الملك الذي هوَ غير أبدي يفنَى وملكُ أحبابِ الله كسليمانَ وذي القرنين يفنَى أما ملكُ الله صفةٌ من صفاتِهِ.
ومعنى ما يتقرب به إليه أي الأعمال الصالحة فإنها تبقى. قال تعالى ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ﴾ الآية [سورة مريم/76]. وليُعلَم أنَّ هذا التأويلَ قالَ بهِ قبلَ البخاري سفيان الثوري في تفسيرِهِ.
تنبيهٌ: الجاري في اصطلاحِ الفقهاءِ أن يُقالَ المِلك بالكسرِ إذا أريدَ به ما يحقُّ للشخصِ أن يتصرفَ فيهِ دونَ غيرِهِ، أما الملكُ فيضافُ إلى الله بمعنى أن له التَّصرف المطلق ويضافُ إلى البشرِ في حقّ من عندهُ التّصرّف في شئونِ الناسِ على العمومِ. فالحاصلُ أن ملكَ الله صفةٌ له مأخوذةٌ من اسمهِ المَلِكِ، فمُلكهُ أزليٌّ أبديٌّ.
قال المؤلف رحمه الله: وَفيهِ غَيرُ هَذَا المَوْضِعِ كتَأْوِيلِ الضَّحِكِ الوَارِدِ في الحَدِيثِ بالرَّحْمَةِ.
الشرح: يعني أنَّ البخاريَّ أوَّلَ بعضَ الآيات غير الآيات المذكورةِ ففيهِ تأويلُ ءاية ﴿مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ ءاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [سورة هود/56] أي “في ملكِهِ وسلطانِهِ” أوَّلَ الأخذَ بناصيةِ الدَّوَابّ بالتصرفِ بالملكِ والسلطانِ لأن المعنى الظاهر لا يليقُ بالله وهو إمساكُ نواصي الدَّواب بالجَسّ واللمسِ، فالله لا يَجُسُّ ولا يَمَسُّ، وأما من الحديثِ فقد أوَّلَ الضَّحِكَ الواردَ في حق الله بالرحمةِ، قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: “قال – الخطابي – وقد تأوّل البخاري الضحك في موضع ءاخر على معنى الرحمة وهو قريب، وتأويله على معنى الرضا أقرب” اهـ.
قال المؤلف رحمه الله: وصَحَّ أَيْضًا التَّأْويلُ التَّفصيليُّ عَن الإمام أحمَدَ وهُوَ منَ السَّلَفِ فَقد ثبَتَ عنْه أنَّه قالَ في قَولِهِ تعالى: ﴿وَجَاء رَبُّكَ﴾ [سورة الفجر/22] إنما جَاءَتْ قُدْرتُه، صَحَّحَ سَنَدَهُ الحافِظُ البَيْهقيُّ الذي قالَ فِيهِ الحافِظُ صَلاحُ الدّينِ العَلائيُّ: “لَم يَأْتِ بَعْدَ البَيْهقِيّ والدَّارَقُطنِيّ مِثْلُهمَا ولا من يُقارِبُهُما”. أما قولُ البيهقيّ ذلك ففي كتابِ مَناقبِ أحمدَ، وأمَّا قَولُ الحافِظِ أبي سَعيدٍ العَلائيّ في البَيهقيّ والدّارَقُطنيّ فذلكَ في كِتَابِه “الوَشْيُ المُعْلَمُ”، وأَمَّا الحَافِظُ أَبو سَعِيدٍ فَهُو الذي يَقُولُ فِيه الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: “شَيْخُ مَشَايخِنا” (وكان من أهل القرن السابع الهجري).
الشرح: ومعنى قوله إنما جاءت قدرتُهُ في تأويلِ الآية أي الأمور العظيمة التي خلقَهَا الله تعالى ليومِ القيامةِ هذه الأمورُ هي أَثَرُ القدرةِ، بقدرةِ الله تأتي حينَ يحضرُ المَلَكُ أي الملائكة صفوفًا لعظمِ ذلكَ اليوم حتى يحيطوا بالإنسِ والجنّ، ولا أحد يستطيعُ أن يخرجَ من هذا المكانِ إلا بسلطانٍ أي بإذنٍ من الله وحجَّةٍ، فَمَن أَذِنَ الله لهُ يستطيعُ أن يفارِقَ هذا المكانَ. ذلكَ اليوم تظهرُ أمورٌ عظيمةٌ، جهنَّمُ التي مسافَتُها بعيدةٌ تحتَ الأرضِ السّابعةِ ذلكَ اليوم سبعونَ ألفًا من الملائكةِ يَجرُّون عُنُقًا منها حتى يراه الكفار فيفزعوا وكلُّ مَلَكٍ بيدهِ سلسلةٌ مربوطةٌ بجهنَّم وكلُّ واحدٍ منهم في القوَّةِ يزيدُ على قوَّةِ البشرِ، فإنهم يجرّونَ هذا العنق ليراه الناسُ في الموقِفِ، وهم في الموقفِ ينظرونَ إليه ثم يردُّ إلى مكانِه، هذا شىءٌ واحدٌ من كثيرٍ من أهوالِ القيامَةِ.
ومعنى كلام الحافظِ العلائي عن البيهقيّ والدارقطني أنّه لم يأتِ من يساويهِمَا ولا من يُقَاربُهما في علمِ الحديثِ. والبيهقيُّ رحمَهُ الله توفيَ في منتصفِ القرنِ الخامسِ الهجري تقريبًا وكان معروفًا بجلالتِهِ في علمِ الحديثِ ورسوخِ قدمِهِ في معرفةِ الأحكامِ الشرعيةِ والزّهدِ والورعِ، كانَ محدّثَ عصرِهِ.
قال المؤلف رحمه الله: وهُنَاكَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَماءِ ذَكَرُوا في تآلِيْفِهم أنَّ أحْمدَ أوَّلَ، مِنْهُمُ الحافِظُ عبدُ الرحمنِ بنُ الجَوزِيّ الذي هُو أحَدُ أسَاطِينِ المَذْهَبِ الحنبليّ لكَثْرةِ اطّلاعِهِ عَلى نُصُوصِ المذهَبِ وأحوالِ أحْمدَ.
الشرح: الحافظُ ابن الجوزي توفي في أواخرِ القرنِ السادسِ وكانَ على مذهبِ الإمام أحمد وهو بين أهلِ المذهبِ الحنبلي مشهورٌ كبيرٌ فيهم وهوَ من أساطينِ المذهبِ أي من أعمدةِ المذهبِ.
قال المؤلف رحمه الله: وَقَد بَيَّنَ أَبُو نَصْرٍ القُشَيْريُّ رَحمَهُ الله الشَّنَاعَةَ التي تَلْزَمُ نُفَاةَ التّأوِيلِ، وأَبُو نَصْرٍ القُشَيْرِيُّ هُوَ الذي وصَفَهُ الحَافِظُ عَبدُ الرّزاقِ الطَّبْسِيُّ بإمَامِ الأَئِمَّةِ كَمَا نَقلَ ذَلِكَ الحَافِظُ ابنُ عَسَاكِرَ في كِتَابِه تَبْيِينُ كَذِبِ المفْتَري.
الثّاني مَسْلَكُ الخَلَفِ: وهم يُؤَوّلُونَها تَفْصِيلًا بتَعْيِينِ مَعَانٍ لَهَا مِمّا تَقْتَضِيهِ لُغَةُ العَرَبِ وَلا يَحْمِلُونَها علَى ظَوَاهِرِها أيْضًا كَالسَّلَفِ.
الشرح: السَّلَفُ والخلفُ متَّفقانِ على عدمِ الحملِ على الظَّاهرِ، هؤلاءِ بيَّنوا بقولهم بلا كيفٍ وأولئكَ قالوا استوَى أي قَهَرَ، ومن قالَ استولى فالمعنَى واحدٌ أي قهر، وكلا الفريقينِ لا يَحمِلُ الاستواءَ على الظَّاهِرِ، لكن هؤلاءِ عيَّنوا معنًى وأولئكَ لم يعيّنوا إنما قالوا بلا كيفٍ أي الاستواءَ الذي لا يُشبِهُ استواءَ المخلوقينَ.
قال المؤلف رحمه الله: ولا بَأْسَ بسُلُوكِهِ ولا سِيَّمَا عنْدَ الخَوفِ مِنْ تَزَلزُلِ العَقِيْدةِ حِفْظًا منَ التّشبِيهِ.
الشرح: السَّلفُ ليسوا كلهم كانوا ساكتينَ عن التأويلِ التفصيلي بتعيينِ معنًى خاصٍ بل بعضُهُم أوَّلَ تأويلًا تفصيليًّا.
وأما النُّزولُ المذكورُ في حديثِ “ينزلُ ربُّنا كلَّ ليلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنيا” فأحسنُ ما يُقالُ في ذلكَ هو نزولُ المَلَكِ بأمرِ الله فيُنادي مُبلغًا عن الله تلكَ الكلمات: “من ذا الذي يدعوني فأستجيبَ لهُ من ذا الذي يستغفرني فأغفرَ لهُ من ذا الذي يسألني فأُعطيَهُ” فيمكثُ المَلَكُ في السماءِ الدنيا من الثلثِ الأخيرِ إلى الفجرِ. أما من يقولُ ينزلُ بلا كيفٍ فهو حقٌّ، لأنه لما قالَ بلا كيفٍ نفى الحركةَ والانتقالَ من عُلْوٍ إلى سُفْلٍ.
قال المؤلف رحمه الله: مثْلُ قَولِه تَعالى في تَوبيخِ إبْليسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [سورة ص/75] فَيَجوزُ أن يُقَالَ المُرادُ باليَدَيْنِ العِنَايةُ والحِفْظُ.
الشرح: هذا تأويلٌ تفصيليٌّ ذَهَبَ إليه بعضُ الخلفِ فدلَّ قولُهُ تعالى: ﴿بِيَدَيَّ﴾ (75) على أن ءادم خُلِقَ مشرَّفًا مكرَّمًا بخلافِ إبليس، ولا يجوزُ أن نحملَ كلمةَ بيديَّ على معنى الجارحَةِ، لو كانت له جارحةٌ لكانَ مثلنا ولو كانَ مثلنا لما استطاعَ أن يخلُقَنَا لذلكَ نقولُ كما قالَ بعضُ الخَلَفِ أي خلقتُهُ بعنايتي بحفظي معناهُ على وجهِ الإكرامِ والتّعظيمِ لهُ، أي على وجهِ الخصوصيَّةِ خَلَقَ ءادمَ أي أرادَ له المقامَ العالي والخيرَ العظيمَ. أما إبليسُ ما خلقَهُ بعنايتِهِ لأنَّ الله عالمٌ في الأزل أنه خبيثٌ هذا الفرقُ بين إبليس وءادمَ.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة