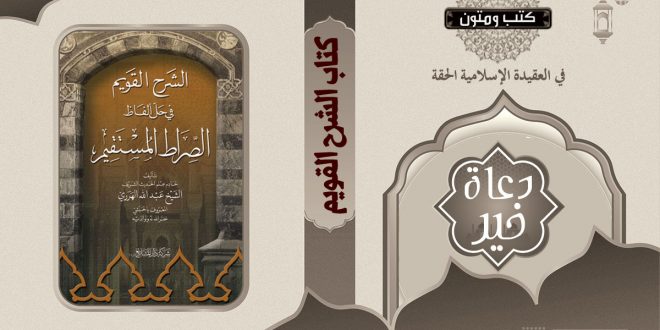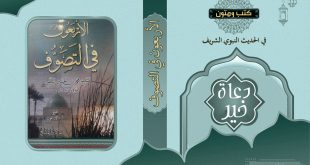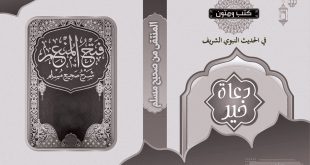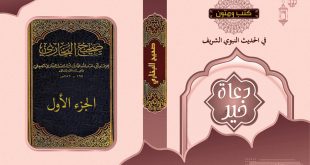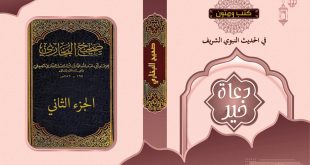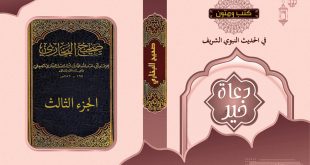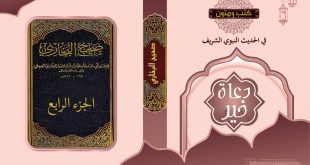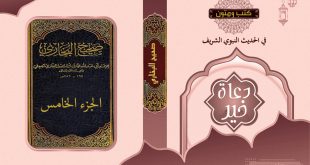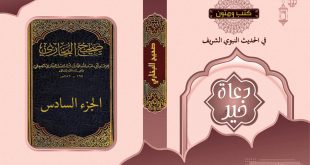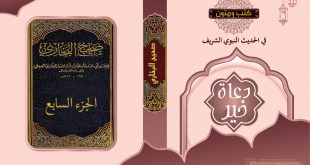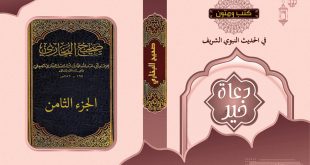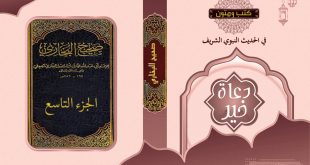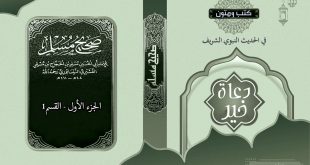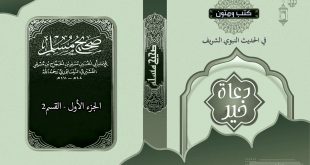الإرَادَةُ
قال المؤلف رحمه الله: الإرَادَةُ
اعْلَم أنَّ الإرادَةَ وهي المشِيْئَةُ واجبةٌ لله تَعالَى، وهي صِفَةٌ أَزلِيَّةٌ أبَديَّةٌ يُخَصّصُ الله بهَا الجَائِزَ العَقْليَّ بالوجُودِ بدَلَ العدَمِ، وبِصفَةٍ دُوْنَ أُخرَى وبِوَقتٍ دُوْنَ ءاخرَ.
الشرح: أن الإرادةَ صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاتِ الله أي ثابتةٌ لذاتِهِ يُخَصّصُ بها الممكِنَ العقليَّ بصفةٍ دون صفةٍ لأن الممكناتِ العقليَّةَ كانت معدومةً ثم دخلت في الوجودِ لتخصيصِ الله تعالى لها بوجودِهَا، إذ كان في العقلِ جائزًا أن لا توجَدَ فوجودُها بتخصيصِ الله تعالى فلولا تخصيصُ الله تعالى لمَا وُجِدَ من الممكناتِ العقليّة شىءٌ، فَيُعْلَمُ من ذلك أن الله تعالى خَصَّصَ كلَّ شىءٍ دَخَلَ في الوجودِ بوجودِهِ بدلَ أن يبقى في العدمِ وبالصّفةِ التي عليها دون غيرها، فتخصيصُ الإنسانِ بصورتِهِ وشكلِهِ الذي هو قائمٌ بتخصيصِ الله تعالى، لأنه كانَ في العقل جائزًا أن يكون الإنسانُ على غيرِ هذه الصفة وهذا الشكل، ثم تخصيصُ الإنسان بوجوده في الوقتِ الذي وُجِدَ فيه دون ما قبله وما بعده هو من الله تعالى، لأنه لو شاءَ لَجَعَلَ الإنسانَ أوَّلَ العالَمِ لكن الله تبارك وتعالى ما جعلَهُ أوَّلَ مخلوقٍ بل جعلَهُ ءاخرَ الخَلقِ باعتبارِ نوعِ وجنسِ الموجوداتِ، خلق الله ءادمَ ءاخرَ ساعةٍ من يومِ الجمعة بعد خلق السمهبهوات والأرض والبهائم والأشجار ونحو ذلك.
فالحاصلُ أن المشيئة معناها تخصيصُ الممكن ببعضِ الصّفاتِ دونَ بعضٍ، فالواحدُ منا يعلم أنه ما أَوجَدَ نفسَهُ على هذا الشَّكل ولا هو أوجدَ نفسَهُ في هذا الزَّمن الذي وُجِدَ فيه فَوَجَبَ أن يكون ذلك بتخصيصِ مخصّصٍ وهو الموجودُ الأزليُّ المسمَّى الله، والبرهان النَّقليُّ على وجوبِ الإرادةِ لله كثيرٌ من ذلك قوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [سورة هود/107] أي أنه تبارك وتعالى يُوجِدُ ويفعَلُ المكوَّناتِ بإرادتهِ الأزليَّةِ.
قَالَ المُؤَلِّفُ رحمه الله: وبُرْهَانُ وُجُوبِ الإرَادَةِ لله أَنَّه لَوْ لَم يَكُن مُرِيدًا لَم يُوْجَدْ شَىءٌ مِنْ هَذَا العَالَمِ، لأَنَّ العَالَم مُمْكنُ الوُجُودِ فَوُجُودُهُ لَيْسَ وَاجِبًا لِذَاتِه عَقْلًا والعَالَمُ مَوْجُودٌ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ مَا وُجِدَ إِلا بتَخْصِيصِ مُخصِّصٍ لوُجُودِهِ وتَرْجِيحه لَهُ على عَدَمِه، فثَبتَ أَنَّ الله مُرِيْدٌ شَاءٍ، ثُمَّ الإِرَادَةُ بِمَعْنَى المَشِيْئَةِ عِنْدَ أَهْلِ الحَقّ شَامِلَةٌ لأَعْمالِ العِبَادِ جَمِيعِها الخَيْرِ مِنْها والشَّرّ، فَكُلُّ مَا دَخَل في الوُجُود منْ أَعْمَالِ الشَّرّ والخَيْرِ ومِنْ كُفْرٍ أَو مَعَاصٍ أوْ طَاعَةٍ فَبمشِيئَةِ الله وقَعَ وحَصَلَ، وهَذا كَمالٌ في حَقّ الله تَعَالَى، لأَنَّ شُمُولَ القُدْرَةِ والمَشِيئَةِ لائِقٌ بجَلالِ الله، لأَنَّهُ لَو كانَ يَقَعُ في مُلْكِهِ مَا لا يَشَاءُ لَكانَ ذَلِكَ دَلِيلَ العَجْزِ والعَجْزُ مُسْتَحِيلٌ علَى الله. والمَشِيئَةُ تَابِعَةٌ للعِلْم أَي أَنَّهُ مَا عَلِمَ حُدُوْثَهُ فَقَدْ شَاءَ حُدُوْثَهُ وَمَا عَلِمَ أنَّه لا يكُونُ لَم يَشَأْ أنْ يكُونَ.
الشرح: أن الله شاءَ كلَّ ما يحصلُ من العباد من خيرٍ أو شرّ، فالله تعالى يحبُّ من أعمالِ العبادِ الحسناتِ ويكرهُ المعاصي وكلٌّ دَخَلَ في الوجودِ بتخصيصِ الله تعالى، لولا تخصيصُ الله تعالى للحسناتِ بالوجودِ ما وُجِدَت وكذلك الكفريَّاتُ والمعاصي لولا تخصيصُ الله تعالى لها بالوجود ما وُجِدَت. وليسَ خَلقُ القبيح قبيحًا من الله، وإرادةُ وجودِ القبيحِ ليس قبيحًا من الله، إنما القبيحُ فعلُهُ وإرادتُهُ من الخلق، كما أن خلق الله للخنزير ليس قبيحًا منه إنما الخنزير قبيحٌ لما فيه من الصفات القبيحةِ وكذلك خلق الله الفأرة وإرادته وجودها ليس قبيحًا من الله، وأما قوله تعالى: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ (26) فليس معناه أنه خالق للخيرِ دون الشر إنما اقتُصِرَ على ذكرِ الخير هنا للاكتفاء بذكرهِ عن ذكرِ الشرّ لأنه استقرَّ في عقيدةِ المؤمنينَ أن الله خالقُ كل شىء، والشىءُ يشمَلُ الخيرَ والشرَّ ويدلُ على ذلك ما ذكرَهُ الله تعالى قبلَ هذه الآية بقوله: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء﴾ [سورة ءال عمران/26] وقد أعطى المُلكَ لمؤمنين أتقياء وأعطى لكفّارٍ وأعطى لمسلمين فسقة، ولم يعطهم إلا بمشيئتِهِ وقدرتِهِ، فالله تعالى حكيمٌ في فعلِهِ منزّهٌ عن السَّفَهِ فهو خَلَقَ الأعمالَ السّفيهةَ والأشخاصَ السُّفهاءَ ولا يكون خلقُهُ لذلكَ منه سَفَهًا كما أن خلقَهُ للهوام السّامَّةِ والحشراتِ المؤذيةِ كالفأرِ لا يكونُ ذلك سَفَهًا منه تعالى.
قال المؤلف رحمه الله: ولَيْسَت المَشِيْئَةُ تَابِعَةً للأَمْرِ بِدَليْل أنَّ الله تَعَالى أمَرَ إبراهِيْمَ بذَبْحِ ولَدِهِ إسْماعيلَ ولَمْ يَشَأ لهُ ذَلِكَ.
فإِنْ قِيْلَ: كَيْفَ يأمُرُ بما لَم يَشَأْ وقُوْعَهُ؟ فَالجَوابُ: أَنَّهُ قَدْ يأمُرُ بِمَا لم يَشَأْ، كَمَا أَنَّهُ عَلِمَ بوقُوْعِ شَىءٍ مِنَ العَبْدِ ونَهَاهُ عنْ فِعْلِهِ.
الشرح: هذه المسئلةُ مُهِمٌّ بيانُها ومن هنا يُعلَمُ فسادُ قولِ بعضهم: “كلُّ شىءٍ بأمرِهِ” لأن الله لم يأمر بارتكاب المعاصي والكفرِ، وإنما الذي يصحُّ قولُهُ: إن كلَّ شىءٍ يحصُلُ فهو يحصُلُ بمشيئتِهِ وتقديرِهِ وعلمِهِ لكنَّ الخيرَ يحصُلُ بمشيئةِ الله وتقديرِهِ وعلمِهِ ومحبَّتِهِ ورضاهُ أما الشّرُّ فيحصُلُ بمشيئةِ الله وتقديرِهِ وعلمِهِ لا بمحبَّتِهِ ورضاهُ. ومن الدّليلِ على أن الأمرَ غيرُ المشيئةِ أن الله أمرَ إبراهيمَ عليه السّلامُ بالوحي المناميّ أن يذبَحَ ابنَهُ إسماعيلَ وقيل إسحاق فلما أرادَ تنفيذَ ما أُمِرَ به فَدَى الله تعالى إسماعيلَ بِكَبشٍ من الجنةِ جاءَ به جبريلُ فلم يَذبَح إبراهيمُ ابنَهُ إسماعيل، فلو كان الأمرُ بمعنى المشيئةِ لكانَ إبراهيمُ ذَبَحَ ابنَهُ إسماعيلَ.
القُدْرَةُ
قال المؤلف رحمه الله: القُدْرَةُ
يَجبُ لله تعالى القُدْرَةُ عَلى كُلّ شَىءٍ والمُرَادُ بالشَّىءِ هُنَا الجَائِزُ العَقْلِيُّ فَخَرجَ بذَلِكَ المُسْتَحِيلُ العَقْلِيُّ لأنّه غَيْرُ قَابِلٍ للوُجُودِ فَلَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِتَعَلُّقِ القُدْرَةِ.
الشرح: القدرةُ صفةٌ أزليَّةٌ ثابتةٌ لذاتِ الله تعالى ويصحُّ أن يقالَ قائمةٌ بذاتِ الله تعالى لأن المعنَى واحدٌ لكن لا يقالُ ثابِتةٌ في ذاتِ الله فإن صفات الله تعالى ليست حالة فيه ولا هي بعضه ولا يقال إنها مثله ولا يقال إنها شبيهة به. وقدرةُ الله يتأتَّى بها الإيجادُ والإعدامُ أي يوجِدُ بها المعدومَ من العدمِ ويُعدِمُ بها الموجودَ. والبرهانُ العقليُّ على وجوبها لله تعالى هو أنه لو لم يكن قادرًا لكانَ عاجزًا ولو كان عاجزًا لم يُوجَد شىءٌ من المخلوقات، والمخلوقاتُ موجودةٌ بالمشاهدةِ، والعجزُ نقصٌ والنَّقصُ مستحيلٌ على الله، إذ من شرطِ الإلهِ الكمالُ. وأما البرهانُ النّقليُّ فقد وَرَدَ ذِكرُ صفةِ القدرةِ لله تعالى في القرءان الكريم في عدَّةِ مواضِعَ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [سورة الذاريات/58] والقوَّةُ هي القدرةُ ولا يجوز التعبير عن الله بالقوة كقول سيد قطب في تفسيره القوة الخالقة، وهذا إلحاد لأنه جعل الله صفة وقد تبع في هذا بعض الملحدين الأوروبيين، ومثل هذا قوله في تفسيره إرادة القوة الخالقة، فليحذر من تقليده في ذلك. وقولِه تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ [سورة التغابن/1] والمرادُ بالشَّىءِ هنا الممكناتُ العقليّةُ، والممكنُ العقليُّ ما يصحُّ وجودُهُ تارةً وعدمُهُ تارةً أخرى.
فلا تتعلَّقُ القدرةُ بالواجِبِ العقليّ كذاتِ الله وصفاتِهِ، ولا بالمستحيلِ العقليّ أي ما لا يقبلُ الوجود، لذلك يمتنعُ أن يقالَ هل الله قادرٌ على أن يخلُقَ مثلَهُ أو على أن يُعدِمَ نفسَهُ فلا يقالُ إنه عاجزٌ عن ذلك ولا يقال قادرٌ على ذلك ولكن يقالُ: قدرةُ الله لا تتعلَّقُ بالمستحيلاتِ العقليَّةِ.
قال المؤلف رحمه الله: وخَالَفَ في ذَلك ابنُ حَزْمٍ فقالَ: “إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ قادِرٌ أنْ يَتّخِذَ ولَدًا، إِذْ لَوْ لم يَقْدِرْ عَلَيْه لكَانَ عَاجِزًا”، وهَذَا الذي قَالَهُ غَيْرُ لازِم لأَنَّ اتّخَاذَ الوَلَدِ مُحَالٌ عَلى الله والمُحَالُ العَقْلِيُّ لا يَدْخُلُ تَحْتَ القُدْرةِ، وعَدَمُ تَعَلُّقِ القُدْرةِ بالشَّىءِ تَارَةً يَكُونُ لِقُصُوْرهَا عَنْهُ وذَلِكَ في المَخْلُوقِ، وتارَةً يَكونُ لِعَدَم قَبُولِ ذلكَ الشّىءِ الدّخولَ في الوُجُودِ أي حُدوث الوجود لِكَوْنِهِ مُسْتَحيْلًا عَقْلِيًّا وتارةً يكون لعدَم قبُولِ ذلك الشّىء العدَمَ لكونه واجبًا عقليًّا. أما المستحيلُ العقليُّ فعدمُ قَبولِهِ الدخولَ في الوجودِ ظاهرٌ وَأَمَّا الواجبُ العقليُّ فَلا يقبلُ حدوثَ الوجودِ لأنَّ وجودَهُ أَزليٌّ، فرقٌ بينَ الوجودِ وبينَ الدخولِ في الوجود، فالوجودُ يشمَلُ الوجودَ الأزليَّ والوجودَ الحادثَ وكلٌّ منهما يُسمّى وجودًا. أما الدخولُ في الوجودِ فَهو الوجودُ الحادثُ. فالواجبُ العقليُّ الله وصفاتُه، فالله واجبٌ عقليٌّ وجودُه أزليٌّ وصفاتُه أزليّةٌ ولا يُقال لله ولا لصفاتِهِ داخلٌ في الوجودِ لأنَّ وجودَهما أزليٌّ، فقولُنا إنَّ الواجبَ العقليَّ لا يقبلُ الدخولَ في الوجودِ صحيحٌ لكن يقصُر عنه أفهامُ المُبتدئينَ في العقيدةِ، أَمّا عِندَ مَن مَارسَ فَهي واضحةُ المُرادِ.
الشرح: كلامُ ابن حزمٍ هذا كفرٌ والعياذُ بالله لأن معنى كلامِهِ أنه يجوزُ أن يكونَ الأزليُّ حَادثًا لأن الذي ينحلُّ منه شىءٌ يكون حادثًا مخلوقًا والله ليس كذلك، فلا يقالُ إن الله قادرٌ على أن يتَّخِذَ ولدًا ولا يقال إنه عاجزٌ عن ذلك بل يكفرُ من قالَ ذلك، كما لا يقال عن الحجر عالمٌ ولا جاهل لأنَّ مصحح العلم والجهل الحياةُ. ولا يكون هذا من باب الجمع بين النقيضين ولا نفيهما فلا يكون مخالفًا لقاعدة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في محل واحد.
وقولهُ: “وَعدَمُ تعلُّقِ القدرةِ بالشَّىءِ تارةً يكون لِقُصورِهَا عنهُ وذلك في المخلوق” فمرادُهُ به مثلًا كما إذا قلنا الإنسانُ عاجزٌ عن أن يخلُقَ شيئًا بمعنى إبرازِهِ من العدمِ إلى الوجودِ وذلك لأن قدرتَهُ قاصرةٌ عن ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: والعَجْزُ هُوَ الأَوَّلُ المَنْفِيُّ عَنِ قُدْرَتِهِ تَعَالى لا الثّانِي، فَلا يَجُوزُ أنْ يُقَالَ إنَّ الله قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ ولا عَاجِزٌ.
الشرح: المرادُ بذلك نفيُ العجزِ عن قدرةِ الله فيما يتعلَّقُ بالممكنِ العقليّ، وقولُه “لا الثّاني” فليسَ المرادُ به أنه يقالُ إن الله عاجزٌ عن كذا أو كذا وإنما مرادُهُ به أنه إن قيلَ مثلًا هل يقدِرُ الله على أن يخلُقَ مثلَهُ أن يقال في الجواب: قدرةُ الله لا تتعلَّقُ بالمستحيلاتِ العقليَّةِ، فلا يقالُ إنه قادرٌ على ذلك ولا عاجزٌ عنه.
قال المؤلف رحمه الله: قَالَ بَعْضُهُم: كَما لا يُقَالُ عن الحَجَر عَالِمٌ ولا جَاهِلٌ، وكَذَلِكَ يُجَابُ علَى قَولِ بَعْض المُلحدينَ: “هل الله قَادِرٌ علَى أنْ يَخْلُقَ مِثْلَه” وهَذا فِيهِ تجوِيزُ المُحَالِ العَقْلِيّ، وبَيانُ ذَلِكَ أنَّ الله أزَلِيٌّ ولَوْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ لَكانَ أزَلِيًّا، والأَزَلِيُّ لا يُخْلَقُ لأنه موجودٌ فكيف يُخْلَقُ الموجود.
الشرح: الإلهُ من شرطهِ أن يكون أزليًّا أي وجودُه أزليًّا ليسَ له ابتداءٌ فلا يقال هل الله يخلقُ مثلَه لأنه تناقُضٌ. فكلامُ هذا السائل ينحَلُّ هكذا هل يَخلقُ الأزليُّ أزليًّا مثلَه، والأزليُّ لا يقالُ فيه يُخلَق لأنه ما سبقه العدم. وهذا السؤالُ دليلٌ على سخافةِ عَقلِ سائِلِهِ.
العِلمُ
قال المؤلف رحمه الله: العِلمُ
اعلَم أَنَّ عِلْمَ الله قَدِيْمٌ أزَليٌّ كَما أَنَّ ذَاتَه أزَليٌّ، فلَم يزَلْ عالِمًا بذَاتِه وصِفَاتِه وَما يُحْدِثُه من مَخلُوقَاتِه، فَلا يتّصِفُ بعِلْم حَادثٍ لأنَّه لَو جَازَ اتّصَافُه بالحَوادِث لانْتَفَى عَنْهُ القِدمُ لأَنَّ مَا كانَ مَحَلًّا للحَوادِثِ لا بُدَّ أنْ يكُوْنَ حَادِثًا.
الشرح: العلمُ صفةٌ أزليَّةٌ أبديّةٌ ثابتةٌ لله تعالى، والله تعالى ليسَ جوهرًا يَحُلّ به العَرَضُ، فعِلمُنَا عَرَضٌ يحُلُّ بأجسامنا ويستحيلُ ذلك على الله تعالى، والله تعالى يَعلَمُ بعلمِهِ الأزليّ كلَّ شىءٍ، يعلمُ ما كانَ وما يكونُ وما لا يكونُ، ولا يقبلُ علمُهُ الزيادةَ ولا النُّقصَانَ فهو سبحانه وتعالى محيطٌ علمًا بالكائناتِ التي تَحدُثُ إلى ما لا نهاية له، حتى ما يَحدُثُ في الدَّارِ الآخرةِ التي لا انقطاعَ لها يعلَمُ ذلك جملةً وتفصيلًا، قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطًا﴾ [سورة النساء/126]. وعِلمُ الله تعالى أعمُّ من الإرادةِ والقدرةِ، فالإرادةُ والقدرةُ تتعلَّقَانِ بالممكناتِ العقليَّةِ أما علمُهُ يتعلَّقُ بالممكناتِ العقليَّةِ والمستحيلاتِ وبالواجبِ العقليّ.
وأما قولُهُ تعالى: ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء﴾ [سورة البقرة/255] فمعناهُ أن أهلَ السَّموات وهم الملائكةُ وأهل الأرضِ من أنبياءَ وأولياءَ فضلًا عن غيرِهم لا يحيطونَ بشىءٍ من علمِهِ أي معلومه إلا بما شاءَ أي إلا بالقدرِ الذي شاء الله أن يعلموه، هذا الذي يحيطونَ به.
أما قولُ الله تعالى: ﴿قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ﴾ [سورة النمل/65] فالمنفيُّ عن الخلقِ علمُ جميعِ الغيبِ أما بعضُ الغيب فإن الله يُطلِعُ عليه بعضَ البشر وهم الأنبياءُ والأولياءُ والملائكةُ، وأما من ادعى أن الرسولَ يعلمُ كلَّ ما يعلَمُهُ الله فقد سوَّى الرسولَ بالله وذلك كُفرٌ. ولا فرق بين من يقول الرسول يعلم كل ما يعلم الله من باب العطاء أي أن الله أعطاه ذلك ومن يقول إنه يعلم كل ما يعلمه الله من غير أن يعطيه الله ذلك وكلا الاعتقادين كفر من أبشع الكفر لأن الله تعالى لا يصح عقلًا ولا شرعًا أن يعطي أحدًا من خلقه جميع ما يعلمه، لأن معنى إن النبي يعلم كل ما يعلم الله من باب العطاء أن الله تعالى يساوي خلقه بنفسه وهذا مستحيل. فهذا القائل كأنه يقول الله يجعل بعض خلقه مثله والعياذ بالله. وكيف خفي على بعض الناس فساده فتجرءوا بل صاروا يرون هذا من جواهر العلم، فلو قيل لهؤلاء فعلى قولكم هذا يصح أن يجعل الله الرسول قادرًا على كل شىء الله قادر عليه فماذا يقولون. حسبنا الله. وهذا من الغلو الذي نهانا الله عنه ورسوله. وهؤلاء يزعمون أن هذا من قوة تعظيم الرسول ومحبته. وهؤلاء لهم وجود في فرقة تنتسب إلى التصوف في الهند.
وأما قولُه تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) [سورة الجن] فلا حجة فيه لمن يقول إن الرسل يطلعهم الله على جميع غيبه كهذه الفرقة المذكورة إنما معناهُ أن الذي ارتضاهُ الله من رسولٍ يجعلُ له رصدًا أي حفظةً يحفظونه من بينِ يديهِ ومن خلفِهِ من الشيطانِ، “فإلا” هنا ليست استثنائيةً بل هي بمعنى “لكن”، فيُفهَمُ من الآيةِ أن عِلمَ الغيبِ جميعه خاصٌّ بالله تعالى فلا يتطرقُ إليه الاستثناءُ فتكونُ الإضافَةُ في قوله تعالى ﴿عَلَى غَيْبِهِ﴾ (26) للعمومِ والشمولِ من بابِ قول الأصوليين المفردُ المضافُ للعمومِ، فيكونُ معنى غيبه أي جميع غيبه، وليس المعنى أن الله يُطلعُ على غيبِهِ من ارتضى من رسولٍ فإن من المقرَّرِ بينَ الموحّدين أن الله تعالى لا يساويه خلقُه بصفةٍ من صفاتِهِ، ومن صفاتِهِ العلمُ بكل شىءٍ قال تعالى: ﴿وهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ [سورة الأنعام/101] والعجب كيف يستدل بعض الناس بهذه الآية على علم الرسل ببعض الغيب إنما الذي فيها أن الله هو العالم بكل الغيب، ولكن الرسل يجعل الله لهم حرسًا من الملائكة يحفظونهم. وأما اطلاع بعض خواص عباد الله من أنبياء وملائكة وأولياء البشر على بعض الغيب فمأخوذ من غير هذه الآية كحديث “اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله”. فلو كان يصحُّ لغيرِهِ تعالى العلم بكل شىء لم يكن لله تعالى تمدُّحٌ بوصفِهِ نفسه بالعلم بكل شىء، فمن يقول إن الرسولَ يعلَمُ بكل شىء يعلمه الله جَعَلَ الرسولَ مساويًا لله في صفةِ العلمِ فيكونُ كمن قالَ الرسولُ قادرٌ على كل شىء وكمن قالَ الرسولُ مريدٌ لكل شىءٍ سواءٌ قالَ هذا القائل إن الرسولَ عالمٌ بكل شىء بإعلامِ الله لهُ أو لا فلا مَخْلَصَ له من الكفرِ.
ومما يُرَدُّ به على هؤلاءِ قولُهُ تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ﴾ [سورة الأنعام/59]، وقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [سورة الأنعام/73] فإنّ الله تبارَكَ وتعالى تمدَّحَ بإحاطتِهِ بالغيبِ والشهادةِ علمًا.
ومما يُرَدُّ به على هؤلاء أيضًا قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [سورة الأحقاف/9] فإذا كانَ الرسولُ بنصّ هذه الآيةِ لا يعلَمُ جميعَ تفاصيلِ ما يفعلهُ الله به وبأمتِهِ، فكيفَ يتجرأُ متجرئ على قولِ إن الرسولَ يعلمُ بكل شىء، وقد روى البخاريُّ في الجامع حديثًا بمعنى هذه الآية وهو ما وَرَدَ في شأنِ عثمان بن مَظعون، فقائلُ هذه المقالة قد غلا الغُلوَّ الذي نَهَى الله ورسولُهُ عنه قالَ الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ﴾ [سورة المائدة/77]، وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “إياكم والغلوَّ فإن الغلو أهلَكَ من كَانَ قبلَكم” رواه ابن حبان، وقد صحَّ أن الرسولَ صلى الله عليه وسلم قال: “لا ترفعوني فوقَ منزلتي”.
وروى البخاريُّ في الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “إنكم محشورونَ حفاةً عُرَاةً غُرلا ثم قرأ ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (104) وأولُ من يُكسى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخذُ بهم ذات الشمالِ فأقولُ هؤلاء أصحابي فيقالُ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدّينَ على أعقابِهِم منذ فارقتهم، فأقول سُحقًا سحقًا أقول كما قالَ العبدُ الصَّالح ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ (117) إلى قوله ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (118).
ومن أعجب ما ظَهَرَ من هؤلاءِ الغُلاةِ لما قيلَ لأحدهم: كيفَ تقولُ الرسولُ يعلَمُ كلَّ شىءٍ يعلمُهُ الله وقد أرسلَ سبعينَ من أصحابِهِ إلى قبيلةٍ ليعلّموهم الدّين فاعترضَتهُم بعضُ القبائل فَحَصَدوهم، فلو كانَ يعلَمُ أنه يحصُلُ لهم هذا هل كانَ يرسلهم؟ فقال: نعم يُرسلهم مع عِلمِهِ بذلكَ. وهذا الحديثُ رواهُ البخاريُّ وغيرُهُ.
ومثلُ هذا الغالي في شدةِ الغلوّ رجلٌ كانَ يدَّعي أنه شيخُ أربعِ طُرُقٍ فقالَ: الرسولُ هو المرادُ بهذه الآية: ﴿هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ (3) وهذا مِن أَكفَرِ الكفرِ لأنه جَعَلَ الرسولَ الذي هو خَلقٌ من خَلقِ الله أزليًّا أبديًّا لأن الأوّلَ هو الذي ليسَ لوجودِهِ بدايةٌ وهو الله بصفاتِهِ فقط.
قال المؤلّفُ رحمه الله: وَمَا أَوْهَمَ تَجَدُّدَ العِلْمِ لله تَعَالَى مِنَ الآيَاتِ القُرْءانِيَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [سورة الأنفال/66] فَلَيْسَ المُرَادُ بِه ذَلِكَ، وقَولُه: ﴿وَعَلِمَ﴾ (66) لَيْسَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ: ﴿الآنَ﴾ (66) بل المَعْنَى أَنَّهُ تَعالى خَفَّفَ عَنْكُم الآنَ لأَنَّه عَلِمَ بِعِلْمِهِ السَّابِقِ في الأَزَلِ أَنَّهُ يَكُونُ فِيكُم ضَعْفٌ.
الشرح: هذه الآيةُ معناها أنه نُسِخَ ما كان واجبًا عليهم من مقاوَمَةِ واحدٍ من المسلمينَ لأضعافٍ كثيرةٍ من الكفَّارِ بإيجابِ مقاومَةِ واحدٍ لاثنينِ من الكفَّارِ رحمةً بهم للضَّعفِ الذي فيهم.
قال المؤلف رحمه الله: وكَذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [سورة محمد/31] مَعْنَاهُ ولَنَبْلُوَنَّكُم حَتَّى نُمَيّزَ أي نُظْهِرَ للخَلْقِ مَنْ يُجَاهِدُ ويَصْبِرُ مِنْ غَيْرِهم، وكَانَ الله عَالِمًا قَبْل كَما نَقَلَ البُخَارِيُّ ذَلِكَ عَنْ أبي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بنِ المُثَنَّى، وَهَذَا شَبِيْهٌ بِقَوْلِه تَعَالى: ﴿لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [سورة الأنفال/37].
الشرح: أن الله تعالى يبتلي عبادَهُ بما شَاءَ من البلايا حتى يُظهِرَ ويُميزَ لعبادِهِ من هو الصَّادِقُ المجاهِدُ في سبيل الله الذي يصبِرُ على المشقَّاتِ مع إخلاصِ النّيةِ لله تعالى ومن هو غيرُ الصّادِقِ الذي لا يصبِرُ.
وكذلك قولُهُ تعالى: ﴿لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ (37) فليس معناهُ أن الله لم يكن عالمًا من هو الخبيثُ ومن هو الطَّيّبُ ثم عَلِمَ بل المعنى لِيُظهِرَ لعبادِهِ من هو الخبيثُ ومن هو الطَّيّبُ.
وأما الدّليلُ العقليُّ على صفةِ العلمِ فهو أنه تعالى لو لم يكن عالمًا لكانَ جاهلًا والجهلُ نقصٌ والله منزَّهٌ عن النَّقص، وأما من حيث النَّقلُ فالنّصوصُ كثيرةٌ منها قولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ [سورة الحديد/3].
الحَيَاةُ
قال المؤلف رحمه الله: الحَيَاةُ
يَجِبُ لله تَعَالَى الحَيَاةُ، فَهُوَ حَيٌّ لا كالأَحْياء، إِذْ حَيَاتُهُ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ لَيْسَت بِرُوْحٍ وَدَمٍ. والدَّلِيلُ علَى وُجُوبِ حَيَاتِه وجُودُ هَذا العَالَمِ، فَلَوْ لَم يَكُنْ حَيًّا لَم يُوْجَدْ شَىءٌ مِنَ العَالَم، لَكِنَّ وُجُودَ العَالَمِ ثَابِتٌ بالحِسّ والضَّرُوْرَةِ بِلا شَك.
الشرح: البرهانُ النّقليُّ على هذه الصّفةِ ءاياتٌ منها قولُه تعالى: ﴿اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيّ﴾ [سورة البقرة/255] والحياةُ في حقّ الله تعالى صفةٌ أزليَّةٌ أبديَّةٌ ليست كحياةِ غيرِهِ بروحٍ ولحمٍ ودمٍ، ولو لم يكن الله حيًّا لم يُوجَد شىءٌ من هذا العالم لأن من ليس حيًّا لا يتَّصفُ بالقدرةِ والإرادةِ والعلمِ ولو كانَ الله تعالى غيرَ متَّصفٍ بهذه الصّفاتِ لكان متَّصفًا بالضّدّ وذلك نقصٌ والله منزَّهٌ عن النَّقصِ.
الوَحْدانيّةُ
قال المؤلف رحمه الله: الوَحْدانيّةُ
مَعْنى الوَحْدانِيّةِ أنَّه لَيْسَ ذَاتًا مُؤَلَّفًا من أَجْزَاءٍ، فَلا يُوْجَدُ ذاتٌ مِثْلُ ذَاتِه ولَيْسَ لغيرهِ صفةٌ كصفتِهِ أو فعلٌ كفعلِهِ وليسَ المُرَادُ بوَحْدَانِيَّتِه وَحْدَانِيَّةَ العَدَدِ إذ الوَاحِدُ في العَدَدِ لَه نِصْفٌ وأَجْزَاءٌ أَيْضًا، بَل المُرَادُ أَنَّه لا شبيه لَه.
الشرح: معنى الوحدانيَّةِ أن الله ليسَ له ثانٍ، وليسَ مركَّبًا مؤلَّفًا من أجزاءٍ كالأجسامِ، فالعرشُ وما دونَهُ من الأجرامِ مؤلَّفٌ من أجزاءٍ فيستحيلُ أن يكونَ بينَهُ وبينَ الله مناسبةٌ ومشابهةٌ كما يستحيلُ على الله تعالى أن يكونَ بينَهُ وبينَ شىءٍ من سائرِ خلقِهِ مناسبةٌ ومشابهةٌ، فلا نظيرَ له تعالى في ذاتِهِ ولا في صفاتِهِ ولا في أفعالِهِ.
قال المؤلف رحمه الله: وَبُرهَانُ وَحْدانِيَّتِه هو أَنَّهُ لا بُدَّ للصَّانِعِ مِنْ أَن يَكُونَ حَيًّا قَادِرًا عَالِمًا مُرِيدًا مُخْتَارًا، فَإِذَا ثَبَتَ وَصْفُ الصَّانِعِ بِمَا ذَكَرنَاهُ قُلْنَا لَوْ كَانَ لِلْعَالَم صَانِعَانِ وَجَبَ أَنْ يَكونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَيًّا قَادِرًا عَالِمًا مُرِيْدًا مُخْتَارًا وَالمُخْتَارَانِ يَجُوزُ اخْتِلافُهُمَا في الاخْتِيَارِ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما غَيْرُ مُجْبَرٍ عَلَى مُوَافَقَةِ الآخَرِ في اخْتِيَارِه، وإلا لكانا مَجبُورَيْن والمجبُورُ لا يكونُ إلهًا، فإِذَا صَحَّ هَذا فَلو أرَاد أحَدُهُما خِلافَ مُرَادِ الآخَرِ في شَىءٍ كأَنْ أَرادَ أحدُهما حَياةَ شخْصٍ وأرادَ الآخرُ مَوتَه لَمْ يَخْلُ مِنْ أنْ يَتِمَّ مُرادُهُما أوْ لا يَتِمَّ مُرادُهُما أَوْ يتِمَّ مُرَادُ أَحَدِهِما وَلا يَتِمَّ مُرادُ الآخَرِ، وَمُحَالٌ تَمَامُ مُرَادَيْهِما لتَضَادّهِما أي إنْ أرَادَ أَحَدهُما حَياةَ شخص وأرادَ الآخرُ مَوتَه يَسْتحيلُ أنْ يكونَ هَذا الشّخصُ حَيًّا وميّتًا في ءانٍ وَاحِدٍ، وإنْ لم يَتِمَّ مُرَادُهُما فَهُمَا عَاجِزَان والعَاجِزُ لا يكُونُ إِلهًا، وإِنْ تَمَّ مُرَادُ أحَدِهما ولَم يَتِمَّ مُرَادُ الآخَرِ فَإِنَّ الذي لَم يَتِمَّ مُرَادُهُ عَاجِزٌ وَلا يَكُونُ العَاجِزُ إلهًا ولا قَدِيْمًا، وهَذِهِ الدّلالة مَعْروفَةٌ عِنْدَ المُوَحّدِين تُسَمَّى بدلالَةِ التَّمَانُعِ.
قَالَ تَعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءالِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا﴾ [سورة الأنبياء/22].
الشرح: معنى الوحدانيَّةِ أن الله تبارك وتعالى ليسَ له ثانٍ وليس مركبًّا مؤلَّفًا كالأجسامِ، والدليلُ العقليُّ على وحدانيَّةِ الله هو أنه تبارك وتعالى لو لم يكن واحدًا وكان متعددًا لم يكن العالم منتظمًا لكن العالم منتظمٌ فوجَبَ أن الله تعالى واحدٌ، وصانِعُ العالمِ لو لم يكن حيًّا قادرًا عالمًا مريدًا مختارًا لكان متَّصفًا بنقيض هذه الصّفاتِ، فلو لم يكن حيًّا لكان ميّتًا، ولو لم يكن قادرًا لكان عاجزًا، ولو لم يكن عالمًا لكان جاهلًا، ولو لم يكن مريدًا مختارًا لكان مضطرًّا مجبورًا ومن كان كذلك لا يكونُ إلهًا.
وأما الدَّليلُ النَّقليُّ على هذه الصّفةِ فآياتٌ منها قولُه تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ﴿1﴾، وقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءالِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا﴾ ﴿22﴾ ، ومن الأحاديثِ ما رواه البخاريُّ أنه صلى الله عليه وسلم: “كان إذا تَعَارَّ من اللّيلِ -ه أي استيقظَ – قال: لا إلهَ إلا الله الواحدُ القهَّارُ ربُّ السَّموات والأرضِ وما بينهما العزيزُ الغفَّارُ”.
ومعنى قولهِ تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا﴾ ﴿22﴾ أي لو كانَ لهما، هنا “في” بمعنى اللام أي للأرضِ والسَّماءِ، ﴿ءالِهَةٌ إِلاَّ اللهُ﴾ ﴿22﴾ أي غيرُ الله ﴿لَفَسَدَتَا﴾ ﴿22﴾ أي السَّمواتُ والأرض أي ما كانتا تستمران على انتظام.
وقد أدخلت في دين الله الحشوية المُحْدَثون وهم الوهابيةُ بدعةً جديدة لم يقلها المسلمون وهي قولهم توحيد الألوهية وحده لا يكفي للإيمان بل لا بد من توحيد الربوبية وهذا ضد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها”. جعل الرسول اعتراف العبد بتفريد الله بالألوهية وبوصف رسول الله بالرسالة كافيًا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نطق الكافر بهذا يحكم بإسلامه وإيمانه، ثم يأمره بالصلاة قبل غيرها من أمور الدين للحديث الذي رواه البيهقي في كتابه الاعتقاد وهؤلاء عملوا دينًا جديدًا وهو عدم الاكتفاء بالأمرين المذكورين وهذا من غباوتهم فإن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية بدليل أنه جاء في سؤال القبر حديثان حديث بلفظ الشهادة وحديث بلفظ الله ربي وهذا دليل على أن شهادة أن لا إله إلا الله شهادة بربوبية الله. وما أعظم مصيبة المسلمين بهذه الفرقة.
القِيَامُ بالنَّفْسِ
قال المؤلف رحمه الله: القِيَامُ بالنَّفْسِ
اعْلَم أَنَّ مَعْنَى قِيَامِه بنَفْسِه هُوَ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ كُلّ مَا سِوَاهُ فَلا يَحْتَاجُ إِلى مُخَصّصٍ لَهُ بالوُجُوْدِ لأَنَّ الاحْتِيَاجَ إِلى الغَيْرِ يُنَافِي قِدَمَهُ وَقَدْ ثَبَتَ وُجُوْبُ قِدَمِهِ وبَقَائِهِ.
الشرح: أن الله تعالى مستغنٍ عن كلّ ما سواهُ فلا يَحتاجُ إلى أحدٍ من خلقِهِ إذ الاحتياجُ للغير علامةُ الحدوثِ والله منزّهٌ عن ذلك، والله لا ينتفعُ بطاعةِ الطّائعينَ ولا ينضرُّ بعصيانِ العُصاةِ، وكلُّ شىءٍ سوى الله محتاجٌ إلى الله لا يستغني عن الله طَرفَةَ عينٍ.
المخَالفَةُ للحَوادِثِ
قال المؤلف رحمه الله: المخَالفَةُ للحَوادِثِ
يَجِبُ لله تَعالى أنْ يكونَ مُخَالِفًا للحَوادِثِ بِمَعْنى أَنَّهُ لا يُشْبِهُ شَيئًا من خَلْقِه فلَيْسَ هُوَ بِجَوْهَرٍ يَشْغَلُ حَيّزًا ولا عَرَضٍ، والجَوْهَرُ مَا لَهُ تَحيُّزٌ وقِيَامٌ بِذَاتِه كالأَجْسَام، والعَرَضُ مَا لا يَقُومُ بِنَفْسِهِ وإِنَّما يَقُوْمُ بِغَيْرِهِ كالحَرَكَةِ والسُّكُونِ والاجْتِمَاع والافْتِرَاقِ والألْوَانِ والطُّعُوْمِ والرَّوَائِح، ولِذَلِكَ قَالَ الإمَامُ أبُو حَنِيفَةَ في بعضِ رسائلِهِ في علمِ الكلامِ: “أَنَّى يُشْبِهُ الخَالِقُ مَخْلُوقَهُ” مَعناهُ لا يصحُّ عقلًا ولا نقلًا أن يُشْبِهَ الخَالِقُ مَخْلُوقَه، وقال أبو سُلَيمَانَ الخَطَّابِيُّ: “إِنَّ الذي يَجبُ عَلَيْنَا وعلَى كُلّ مُسْلِم أَنْ يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُوْرَةٍ وَلا هَيْئَةٍ فإنَّ الصُّوْرَةَ تَقْتضي الكَيْفِيَّةَ وهي عن الله وعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفيَّةٌ” رَواهُ عنه البَيْهَقِيُّ في الأَسْماءِ والصّفَاتِ.
الشرح: أن معنى مخالفةِ الله للحوادثِ أنه لا يشبهُ المخلوقات، وهذه الصّفةُ من الصّفاتِ السَّلبيَّةِ الخمسةِ أي التي تدلُّ على نفي ما لا يليقُ بالله. والدَّليلُ العقليُّ على ذلك أنه لو كان يشبهُ شيئًا من خلقِهِ لجازَ عليه ما يجوزُ على الخلقِ من التّغيُّرِ والتَّطوُّرِ والعجزِ والضعفِ والصحةِ والمرضِ ولو جازَ عليه ذلك لاحتاجَ إلى من يغيّره من حال إلى حال والمحتاجُ إلى غيره لا يكون إلهاً فَوَجَبَ أنه لا يشبهُ شيئًا، والبرهانُ النَّقليُّ لوجوبِ مخالفتِهِ تعالى للحوادثِ ءاياتٌ منها قولُهُ تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ (11) وهو أوضحُ دليلٍ نقليّ في ذلك جَاءَ في القرءان، لأنَّ هذه الآية تُفهِمُ التَّنزيهَ الكلّيَّ لأن الله تبارك وتعالى ذَكَرَ فيها لفظ شىءٍ في سياقِ النَّفي، والنَّكرةُ إذا أوردت في سياقِ النَّفي فهي للشُّمولِ، فالله تبارك وتعالى نفَى بهذه الجملة عن نفسه مشابهةَ الأجرامِ والأجسامِ والأعراضِ فهو تبارك وتعالى كما لا يشبهُ ذوي الأرواح من إنسٍ وجنّ وملائكةٍ وغيرِهم لا يشبهُ الجمادات من الأجرامِ العلويَّةِ والسُّفليَّةِ، فالله تبارك وتعالى لم يقيّد نفي الشَّبهِ عنه في هذه الآية بنوعٍ من أنواعِ الحوادثِ بل شَمَلَ نفي مشابهتهِ لكلّ أفرادِ الحادثات، ويشمل نفي مشابهةِ الله لخلقه تنزيهه تعالى عن الكمّيَّةِ والكيفيَّةِ، فالكمّيَّةُ هي مقدارُ الجِرمِ فهو تبارك وتعالى ليس كالجرمِ الذي يدخله المقدارُ والمساحةُ والحدُّ فهو ليس بمحدودٍ ذي مقدارٍ ومسافةٍ ومن قال في الله تعالى إن له حدًّا فقد شبَّهَهُ بخلقِهِ لأن كل الأجرام لها حدٌّ إما حدٌّ صغير وإما حدٌّ كبير وذلك ينافي الألوهيَّة، والله تبارك وتعالى لو كانَ ذا حدّ ومقدارٍ لاحتاجَ إلى من جعلَهُ بذلك الحدّ والمقدارِ كما تحتاجُ الأجرامُ إلى من جعلها بحدودِها ومقاديرِها لأن الشَّىءَ لا يخلقُ نفسَهُ على مقدارِهِ، ولا يصحُّ في العقل أن يكونَ هو جَعَلَ نفسَهُ بذلك الحدّ، والمحتاجُ إلى غيرِهِ لا يكون إلهًا لأن من شرطِ الإلهِ الاستغناءَ عن كلّ شىءٍ.
قال المؤلف رحمه الله: وقَدْ تُطْلَقُ الكَيْفِيَّةُ بِمَعْنَى الحَقِيقَةِ كَمَا فِي قَوْلِ بَعْضِهِم:
كَيْفِيَّةُ المَرْءِ لَيْسَ المَرْءُ يُدْرِكُهَا ***** فَكيْفَ كَيْفِيَّة الجَبَّارِ في القِدَمِ
ومُرَادُ هَذَا القَائِلِ الحَقِيقَةُ. وهذا البيتُ ذكرَهُ الزركشيُّ وابن الجوزيّ وغيرُهُما.
الشرح: معنى هذا البيت أن الإنسانَ إذا كانَ لا يحيطُ عِلمًا بكلّ ما فيه وكذا حقيقتُهُ لا يحيطُ بها علمًا، فكيفَ يحيطُ علمًا بحقيقةِ الجبَّارِ الأزليّ الذي لا يُشبهُ العَالَم؟ معناهُ أنه لا يحيطُ علمًا بالله لأنه لا يَعرِفُ الله على الحقيقةِ إلا الله.
قال المؤلف رحمه الله: وقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيّ: “وَمَنْ وَصَفَ الله بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي البَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ”. وهوَ مِنْ أَهْلِ القَرْنِ الثَّالِثِ، فَهُوَ دَاخِلٌ في حَدِيثِ: “خَيْرُ القُرُونِ قَرْني ثُمَّ الذيْنَ يَلُونَهُم ثُمَّ الذيْنَ يَلُونَهُم” رواهُ الترمذيُّ، والقرنُ المرادُ به مائة سنة كما قالَ ذلكَ الحافظُ أبو القاسِمِ بنُ عساكرَ في كتابهِ تَبيين كذبِ المفتري الذي ألَّفهُ في التنويهِ بأبي الحسنِ الأشعري رضيَ الله عنه.
الشرح: هذا الحديثُ معناه من حيث الإجمالُ وليس معناهُ كلُّ من كان من أهل القرونِ الثَّلاثة الأولى هو خيرٌ ممَّن جاءَ بعدَه بل كانَ فيمن جاءَ بعد ذلك من هو خيرٌ من بعضِ من كان فيها أي من بعضِ الأفرادِ لأن الصَّحابةَ لم يكونوا كلُّهم أولياء، والفضلُ عندَ الله بالتَّقوى ليسَ بالنَّسبِ ونحوِ ذلك، قالَ الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [سورة الحجرات/13]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أولى الناسِ بي المتقونَ من كانوا وحيثُ كانوا” رواه ابن حبان وصحَّحَهُ. ولا منافاة بين هذا الحديثِ وبين حديث: “خيرُ القرونِ قرني ثم الذين يَلُونهم ثم الذين يَلُونهم” فإن حديثَ ابن حبَّانَ فيه الحكمُ على الأفرادِ، وحديثَ الترمذي: “خير القرون” إلى ءاخره الحكمُ فيه من حيث الجملةُ فيقال باعتبار الإجمالِ الصحابةُ خيرُ هذه الأمّةِ لأن فيهم من لا يلحقه بعلوّ مرتبتِهِ أحدٌ ممن جاءَ بعدَهم وأما من حيثُ الحكمُ على الأفرادِ فبعضُ أفرادِ الصحابةِ أقلُّ درجةً ممن جاءَ بعدَهم، فكيف يُساوَى بين صحابي قالَ الرسولُ فيه لمّا ماتَ في الغزو معهُ وكان موكَّلًا بِثَقَلِ النبي خادمًا له: “هُوَ في النّار” فنظروا فَوَجدوا معَهُ شَملةً سرقها من الغنيمةِ وبينَ عمر بن عبد العزيز، فهل يجوز أن يقال إن هذا أفضلُ من عمرَ بن عبد العزيز لأنه لم يرَ الرسول. فما أشدَّ فساد قولِ من قال إن كلَّ فردٍ من أفرادِ الصحابةِ خيرٌ ممن جَاءَ بعدَهُم.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة