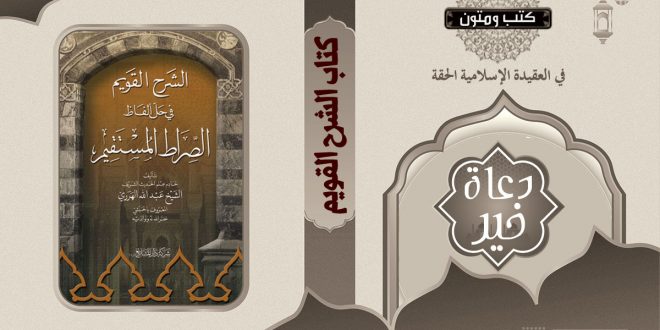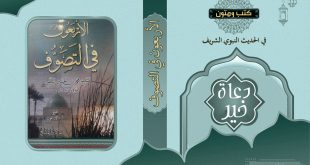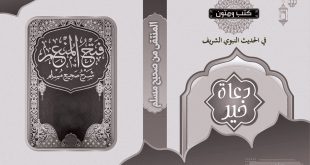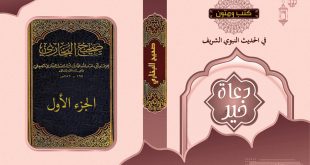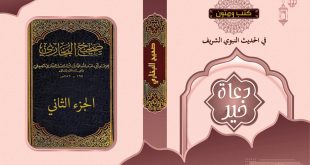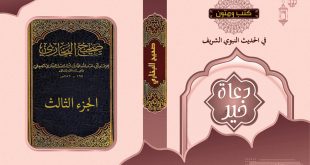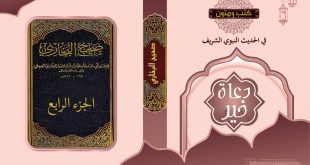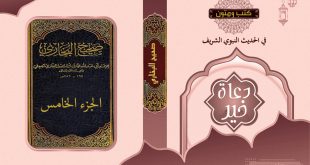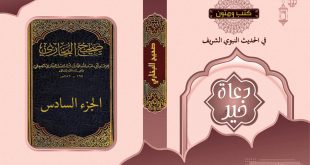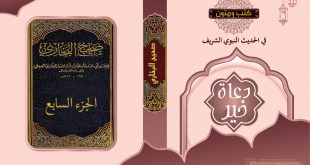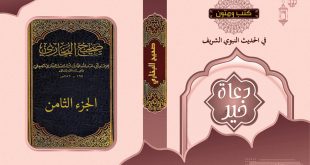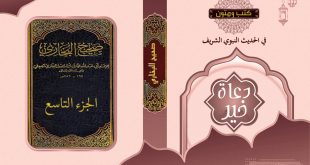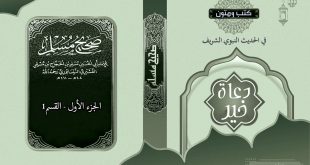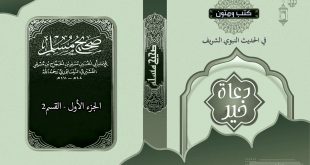الوقاية من النار
قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {6}﴾ [سورة التحريم]. وجَاءَ في تَفْسِيرِ الآيةِ أنَّ الله يَأْمُرُ المُؤمِنينَ أنْ يَقُوا أَنْفُسَهم وأهْلَهُم النّارَ التي وَقُودُها الناسُ والحجارةُ بتَعلُّم الأمُور الدِّينيةِ، وتَعلِيم أهلِيهِم ذَلِكَ، أي مَعْرِفَةِ ما فَرضَ الله فِعلَه أو اجتِنابَه أي الواجِبَاتِ والمُحرّماتِ وذَلِكَ كَي لا يَقَعَ في التَّشبِيهِ والتَّمثِيلِ والكُفرِ والضَّلالِ.
الشرح: قولُه تعالى ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ {6}﴾ مَعناهُ جَنّبوا أنفسَكُم النارَ التي وَقودُها الناسُ والحجارةُ فإن الأرضَ بعد أن يُحَاسَبَ الناسُ عليها تُرمى في جهنمَ لتزيدَها وقودًا وكذلك الشمسُ تُرمى في جهنم بعد أن يُطمَسَ نورُهَا وكذلك القمرُ، وأما قولُه تعالى:﴿عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ {6}﴾ فمعنى غلاظٌ أنهم لا يَرحمون الكافرَ، ومعنى شِداد أي أقوياءُ. وأما قوله تعالى ﴿لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {6}﴾ فذلك لأن الملائكةَ مجبولونَ على طاعةِ الله أي لا يختارون إلا الطاعةَ بمشيئة الله، وكلٌّ منهم يقومُ بما أُمِرَ به بلا تقصيرٍ، فالملائكةُ لهم وظائفُ منهم من هو موكَّلٌ بالمطر ومنهم من هو موكَّلٌ بالنباتِ ومنهم من هو موكَّلٌ بالريحِ ومنهم من هو موكَّلٌ بالجبالِ إلى غيرِ ذلك من الوظائف.
قال المؤلف رحمه الله: ذَلِكَ لأَنَّهُ من يُشَبّهُ الله تعَالى بشَىءٍ ما لمْ تَصِحَّ عِبَادَتُه، لأنَّه يَعبدُ شيئًا تَخيّلَه وتَوهَّمَه في مخيّلَتِه وأوْهامِه، قال أبو حامد الغزاليُّ: “لا تَصِحُّ العِبَادَةُ إلا بَعْدَ مَعْرِفَةِ المَعْبُودِ”.
الشرح: أن الذي يَعبُدُ شيئًا تخيَّلَه وتوهَّمَهُ في مخيّلتِهِ فعبادتُهُ باطلةٌ لأن وهمَ الإنسان يدورُ حولَ ما أَلِفَهُ، فإن وهمَنَا أَلِفَ الشىءَ المحسوسَ الذي له حدٌّ وشكلٌ ولونٌ وحيّز إما فوق أو تحت والله كان موجودًا قبل الفوق والتحت بلا جهة ولا مكان لأن الجهات والأماكن خلقت بعد أن لم تكن موجودة حتى هذا الفراغ الذي فيه العرش والشمس والقمر والنجوم لم يكن موجودًا قبل أن يخلقه الله، فالعبرةُ والاعتبارُ بالعقلِ لا بالوهمِ.
مَا جَاءَ في بَدءِ الخلْقِ
قال المؤلف رحمه الله: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَمَا سُئِلَ عَن بَدءِ الأمرِ: “كَانَ الله وَلَم يَكُنْ شَىءٌ غَيْرُهُ وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ، وكَتبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَىءٍ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمواتِ والأَرْضَ” رَوَاهُ البُخَارِيُّ. أَجَابَ الرّسولُ صلى الله عليه وسلم علَى هَذا السُّؤالِ بأنَّ الله لا بدَايةَ لِوُجودِه (أي أزليٌّ) ولا أزليَّ سِوَاه، وَبِعبارَةٍ أُخْرَى فَفِي الأَزَلِ لَم يكُنْ إلا الله تعَالى، والله تعَالى خَالقُ كُلّ شَىءٍ، أي مخرِجُه من العدم إلى الوجود.
الشرح: السائل هم أناس من أهل اليمن قالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان فأجابَهم وأفادَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأهم مما سألوا عنه. فقولُه: “كان الله” أي في الأزل، وقولُه: “ولم يكن شىء غيره” أي أنه لا أزليَّ سواه لأنه في الأزل لم يكن ماءٌ ولا هواءٌ ولا نورٌ ولا مكانٌ ولا ظلامٌ ولا ليل ولا نهار، وقوله: “وكان عرشه على الماء” أي وُجِدَ عرشُهُ على الماء أي أن الماءَ خُلِقَ قبلَ العرش ثم خُلِقَ العرشُ وبوجودِ الماءِ وُجِدَ الزمانُ والمكانُ أما قبل ذلك لم يكن زمان ولا مكان. فيُعلَمُ من هذا أن الماءَ والعرشَ هما أوَّلُ المخلوقات من الأشياء المحسوسة، أما من غير المحسوسة فالزمان والمكان وجدا بوجود الماء، والعرشُ سريرٌ كبيرٌ له أربعةُ قوائم ليس كسريرنا يحملُه أربعةٌ من الملائكة.
فالماءُ أصلٌ لغيره وهو خُلِقَ من غير أصلٍ، فبدايةُ العالم من غير مادةٍ، ولا يحيلُ العقل وجودَ أصلِ العالم من العدم من غير مادةٍ. فكان الأُولى في الحديثِ للأزلية أما كان الثانية في قوله: “وكان عرشه على الماء” فهي للحدوث.
فمن هنا يُعلَمُ فسادُ قولِ من يقول إن نورَ محمدٍ خُلِقَ قبل كلّ شىءٍ، فالذي يعتقدُ أن الله خَلَقَ نورَ محمدٍ قبل كلّ الأشياء لا يُكفَّر لكنه يُغَلَّطُ لمخالفته ثلاثةَ أحاديثَ ثابتةٍ، وكذلك الذي يعتقد أن روحَ محمدٍ خُلِقَ من نورٍ لا يكفَّر، لكن من يعتقد أن جَسَدَ محمدٍ خُلِقَ من نورٍ فهو كافر لتكذيبه القرءان قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ {110}﴾ [سورة الكهف].
والقولُ بأن حديثَ جابرٍ المفتعلَ والذي فيه: “أوّل ما خلقَ الله نورُ نبيّك يا جابر خلقَهُ الله من نوره قبل الأشياء” صحَّ كشفًا لا معنى له لأن الكشفَ الذي يخالفُ حديثَ رسول الله لا عبرة به فقد قال علماء الأصول: “إلهام الوليّ ليس بحجَّةٍ”، لأن كشفَ الوليّ قد يُخطئ.
وهذا الحديثُ ركيكٌ، والركاكةُ قال علماءُ الحديث إنها دليلُ الوضعِ لأن الرسول لا يتكلمُ بكلام ركيكِ المعنى، وذلك لأن في الجملة الأولى: “أولُ ما خلق الله تعالى نور نبيك” جعلَ نور النبي أول العالم والمخلوقات على الإطلاق ثم هذه الجملة: “خلقه الله من نوره قبل الأشياء” إن اعتُبِرَ أن معنى من نوره أي نور مخلوق لله على أن الإضافةَ إضافة المُلك إلى المالك ليست إضافة صفةٍ إلى موصوفٍ يكون المعنى أن أولَ المخلوقات نورٌ خلقَهُ الله ثم خَلَقَ منه نور محمد فهذا يناقض الجملة الأولى، لأن الجملةَ الأولى تَدُلُّ على أن نورَ محمدٍ أولُ المخلوقاتِ على الإطلاق، وهذه الجملةُ “خلقه الله من نوره قبل الأشياء” تدلُّ على أن أولَ المخلوقاتِ نورٌ خُلِقَ منه نورُ محمد، فيكون نور محمد متأخرًا عن ذلك النور في الوجود فلا يصح على هذا قول: “نور محمد أول المخلوقات على الإطلاق”.
وأما إن اعتُبِرت الإضافةُ التي في نوره إضافة الصفة إلى الموصوفِ فالبليةُ أشدُّ وأكبرُ لأنه يكون المعنى أن سيدَنا محمدًا جزءٌ من صفةِ الله وهذا إثبات البعضية لله وذلك كفر، والله تعالى منزهٌ عن البعضيةِ والتركيبِ والتجزؤ. فيكون على التقديرِ الثاني إثبات التبعض لله وذلك ينافي التوحيد، لأن الله واحدٌ ذاتًا وصفاتٍ لم ينحلَّ منه شىءٌ ولا ينحلُّ هو من شىء غيره، فلا تكون صفاته صفةً لغيره، بل صفاتُهُ لا هي عينُ الذات ولا هي غيرُ الذات ولا تكون أصلًا لغيرها، كما قررَ علماءُ التوحيد في مؤلفاتهم.
وقد ذكرَ الشيخُ عبد الغني النابلسي أن من اعتقدَ أن الله انحلَّ منه شىءٌ أو انحلَّ هو من شىءٍ فهو كافرٌ وإن زعمَ أنه مسلمٌ. فاعتقادُ أن الرسولَ جزءٌ من نورٍ هو من ذات الله كاعتقادِ النصارى أن المسيحَ هو جزء من ذات الله، ومن المعلوم أن كلامَ الرسول لا ينقض بعضه بعضًا، وهذا الحديثُ الجملةُ الثانيةُ منه تَنقُضُ الأولى، فالرسولُ منزّهٌ عن أن ينطقَ بمثله، فبهذا سَقَطَ الاحتجاجُ بهذا الحديثِ على دعوى أن أوّلَ المخلوقاتِ على الإطلاق نورُ محمدٍ.
ثم إن هذا الحديثَ لم يصححهُ أحدٌ من الحفاظ، بل قالَ الحافظ السيوطي إنه لا يثبت، وأما إيرادُ الزرقاني وابن حجر الهيتمي وغيرهما كمحمد بن أبي بكر الأشخر في شرح بهجة المحافل وصاحبِ المواهبِ اللدنية له ونسبتهم هذا الحديثَ إلى عبد الرزاق لا يُفيدُ أن هذا الحديثَ صحيحٌ أو حسنٌ، على أنه لم يقل أحدٌ من هؤلاء إن الحديثَ صحيحٌ أو حسنٌ إنما أوردوه ناسبينَ له إلى مصنَّفِ عبدِ الرزاق فليس في ذلك حجة، ثم عبدُ الرزاق قال في تفسيره عند قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء {7}﴾ [سورة هود]: هما بدءُ الخَلقِ قبلَ خَلقِ السموات والأرضِ، وهذا يُبعِدُ أن يكونَ عبد الرزاق ذكرَ في المصنف هذا الحديثَ الركيكَ، وهؤلاء صاحبُ المواهب اللدنية ومن ذُكِرَ معه ليس أحدٌ منهم من الحفاظِ.
ثم إن هذا الحديثَ يُعَارِضُ حديثين صحيحينِ أحدُهما حديثُ أبي هريرة قال: قلتُ: يا رسول الله إني إذا رأيتُك طابَت نفسي وقرَّت عيني فأنبئني عن كل شىءٍ، قال: “إن الله تعالى خَلَقَ كل شىءٍ من الماءِ”. فكان سؤالُ أبي هريرة عن أوَّلِ العالمِ وأصلِه الذي لم يكن قبله شىء من المخلوقات الذي خُلِقَت منه المخلوقات كلها فأجابَ الرسولُ بأنه الماء، وهذا الحديثُ أخرجَهُ ابن حبانَ وصححهُ.
والحديثُ الآخَرُ حديث جماعةٍ من أبناءِ الصحابةِ عن ءابائهم عن رسول الله: “إن الله لم يَخلُق شيئًا مما خَلَقَ قبلَ الماءِ”. أوردَهُ الحافظ ابن حجر على أنه صحيحٌ أو حَسَنٌ عنده وذلك في شَرحِ البخاري في كتاب بدء الخلق عند ذكرِ حديث: “كانَ الله ولم يكن شىءٌ غيرُهُ وكانَ عرشُهُ على الماءِ”.
ثم إنه ليسَ الفضل في تَقَدُّمِ الوجودِ أي وجود الخلق بعضه على بعض، بل الفضلُ بتفضيلِ الله، فالماءُ مع ثبوتِ أوّليتِهِ لا يقال إنه أفضل المخلوقات، وأما الرسولُ عليه السلام فهو أفضلُ المخلوقاتِ من غير أن يكونَ أول المخلوقات لا جسمه ولا نوره، فالأمر كما قال البوصيريُّ:
فمبلغُ العلم فيه أنه بشرٌ ***** وأنه خيرُ خلق الله كلهم
فأي فضل في قول هؤلاء نور الرسول هو أول الخلق منه خلق كل شىء. أيُّ فضل في هذا.
ويَلتَحِقُ بهذا الحديثِ الموضوعِ ما يقوله بعضُ المؤذنين في بلادِ الشامِ عَقِبَ الأذانِ بصوتٍ عالٍ: “الصلاةُ والسلام عليك يا أولَ خلق الله وخاتم رسل الله”، فلو قالوا: “الصلاةُ والسلامُ عليك يا خاتم رسل الله” كان صوابًا.
ومن الباطلِ المخالِفِ للنصّ القرءاني والحديثي قول بعض المنشدين المصريين: “ربّي خلق طه من نور” لأن هذا ظاهرُ المخالفةِ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء {7}﴾ [سورة الكهف] مع قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا {54}﴾ [سورة الفرقان] الآية.
فالحاصلُ أن العبرَةَ في التصحيحِ والتضعيفِ أن يكونَ من حافظٍ أي أن يَنُصَّ حافظٌ على أن هذا الحديثَ صحيحٌ أو أن يذكر حافظٌ في كتابه أنه يقتصرُ فيه على الصحيحِ كالحافظِ سعيد بن السكن الذي ألّفَ كتابًا اشترط فيه الاقتصار على الصحيحِ سماهُ السنن الصّحاح.
وهذه القاعدةُ ذَكَرَهَا الحافظُ السيوطي في ألفيّتِهِ في مصطلحِ الحديثِ فقال ما نصه:
وخذهُ حيث حافظٌ عليه نصّ ***** أو من مصنفٍ بجمعهِ يُخَصّ
يعني أن الحديثَ الصحيحَ يُعرَفُ أنه صحيحٌ بنص حافظٍ على صحتِهِ أو بأن تجدَهُ في كتابٍ ألّفه حافظٌ واشترط أنه لا يذكر في كتابه هذا إلا الصحيح.
وأما غيرُ الحفاظِ فلا عبرةَ بتصحيحهم ولا بتضعيفهم، فحديثُ أوّليةِ النورِ المحمدي لم يصححه حافظٌ من الحفاظِ لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولم يُذكَر في كتابٍ اشترطَ فيه مؤلّفه الحافظُ أن لا يذكُرَ في مؤلَّفِهِ إلا الصحيح.
وأما مجردُ ذكر حديثٍ في كتاب مؤلفه حافظٌ فليس دليلًا على صحته، فهذا الإمام أحمد بن حنبلٍ رضي الله عنه شيخُ الحفاظ ذَكَرَ في كتابه ءالافًا من الأحاديثِ الثابتةِ الصحيحةِ وءالافًا من الضعافِ بل تَكَلَّمَ الحافظُ زين الدين العراقي على أربعة عشر حديثًا مما في المسند ووصفها بأنها موضوعة، فإذا كان هذا حالَ مسند الإمام شيخ الحفاظ أحمد بن حنبل فماذا يكونُ مؤلفات من هو دونه. فالذين ذكروا حديث: “أوّل ما خلق الله نور نبيّك يا جابر” من المتأخرين كثيرٌ لكن كثرتهم لا تُفيدهم شيئًا لأنهم لم يبلغوا درجةَ الحافظ إنما بعضهم محدثون لهم إلمامٌ بالحديث وبعضهم ليسوا من المحدّثين بالمرة مثل الشيخ يوسف النبهاني فإنه ذَكَرَ في بعض مؤلفاتِهِ أنه ليسَ عالمًا فضلًا عن المُحدّثيةِ وأدخلَ في كتابه أربعين الأربعين لأجل هذا ولضعفه في هذا العلمِ الأربعين الودعانيّة المحكوم عليها عند المحدّثين بأنها موضوعةٌ، وهذا لقلةِ اطلاعِهِ في هذا العلمِ خَفِيَ عليهِ ذلك.
وأما دعوى بعض الذين كتبوا في تأييدِ هذا الحديثِ أن السيوطيَّ ما ضعَّفهُ إنما ضعَّفَ إسنادَهُ فلا ينافي ذلك ثبوته في نفسِهِ من جهة أخرى، فعبارتُهُ في قوتِ المغتذي تأبى ذلك لأن نصَّ عبارته فيه: “وأما حديثُ أوّليّةِ النورِ المحمدي فلا يثبت”، فقد أضافَ نفي الثبوت إلى الحديث نفسه ولم يذكر هنا الإسناد.
وأما دعوى بعض من كَتَبَ في تأييدِ هذا الحديثِ أن هذا الحديثَ يَدخُلُ في قول المحدّثين: “الحديثُ الضعيفُ من جهةِ الإسناد إذا تلقته الأمةُ بالقبول فهو صحيحٌ لغيره” فلا ينطبقُ هذا الحديثُ على ذلك لأن مرادهم بالأمةِ المجتهدونَ وذلك كحديثِ البحرِ: “هو الطهورُ ماؤهُ الحِلُّ ميتَتُهُ”، وحديثِ: “نهى رسولُ الله عن بيعِ الكالئ بالكالئ”، فإن الأئمة المجتهدين الأربعة وغيرهم قائلون بمعناه، وأينَ حديث أوّلية النور المحمدي من هذا الحديث فإنه ليسَ له ذِكرٌ عند الأئمةِ المجتهدين لا بالنفي ولا بالإثباتِ ولا رواه أحدٌ منهم في كتبه، فجملةُ الذين ذكروا هذا الحديث في مؤلفاتهم على وجهِ الإقرار ليس فيهم حافظ، ومن كان منهم من الحفاظِ وهو السيوطيُّ فعبارتُهُ لا تفيدُ أنه متلقّى بالقبول، فكيف يُجعَلُ هذا الحديث من قبيلِ الحديثين المذكورَين اللذين تلقتهما الأئمةُ المجتهدون من السلفِ والخلفِ بالقَبولِ وتلقتهما أتباعهم بالقبول. ولن يستطيع هؤلاء أن يثبتوا عن إمام من الأئمة أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد أو غيرهم أنهم ذكروا هذا الحديث ولا عن أحد من أتباعهم الذين هم مجتهدون في المذهب كالجصاص، وشمس الأئمة السرخسي عند الحنفية، والبيهقي عند الشافعية، واللخميّ عند المالكية، وأبي الوفاء ابن عقيل في الحنابلة، فكيف يلحق هذا الحديث الموضوع بحديث البحر “هو الطهور ماؤه والحل ميتته” الذي عرفه الأئمة المجتهدون وعملوا به مع ضعف إسناده. فالذين ذكروا حديث “أول ما خلق الله تعالى” ليس فيهم واحد من أهل الترجيح في المذهب فضلًا عن أن يكون فيهم أصحاب الوجوه الذين هم مجتهدون في المذهب، فأين الثرى وأين الثريا.
ثم إن هذا الحديث تَنفِرُ الكفارُ عند سَمَاعِهِ من بعض المسلمين نفورًا زائدًا على نفورهم الأصلي، فلقد ذَكَرَ لي رجلٌ يدعى أبا علي ياسين من أهل الشام أن نصرانيًّا قال له: كيف تقولون أنتم محمدٌ ءاخرُ الأنبياءِ وتقولون إنه أولُ خلق الله؟ قال: فلم أردّ جوابًا، وذلك لأن هذا الكافر يسمَعُ في بعض بلاد الشام المؤذنينَ على المآذن يرددون هذه الكلمة بعد الأذان: الصلاةُ والسلامُ عليك يا أولَ خلقِ الله وخاتَمَ رُسُلِ الله. ثم إن معيارَ الأفضلية ليس الأسبقية في الوجود بل الأفضلية بتفضيل الله، فالله تعالى يفضّلُ ما شاءَ من خلقه على ما شاءَ، الله تعالى جَعَلَ سيدنا محمّدًا أفضلَ خلقِهِ على الإطلاق وأكثرَهم بركةً مع أنه ءاخر الأنبياء وجودًا صلى الله عليه صلاةً يقضي بها حاجاتنا ويفرّج بها كُرُبَاتنا ويكفينا بها شَرَّ أعدائنا وسَلَمَّ عليه وعلى ءالهِ سلامًا كثيرًا.
ثم إنه ينبغي الاستدلال بحديثٍ ءاخَر يصحُّ أن يُعَدَّ حديثًا ثالثًا للدلالة على أن الماءَ هو أول العالم وهو حديث عمران بن حصين الذي أخرجه البخاريُّ وغيرُه أن أناسًا من أهل اليمن أتوا إلى رسول الله فقالوا: جئنا نسألك عن بَدء هذا الأمر، قال: “كانَ الله ولم يكن شىءٌ غيرُهُ وكان عرشُهُ على الماءِ”، فقوله صلى الله عليه وسلم: “كانَ الله ولم يكن شىءٌ غيره” إثباتٌ لأزلية الله، وقوله: “وكان عرشُهُ على الماء” معناه أن هذين أولُ المخلوقات، وأما الماءُ فعلى وجهِ الإطلاق وأما العرشُ فبالنسبة لما بعده كما أفادَ ذلك قوله عليه السلام: “على الماء” وذلك يدل على تأخرِ العرشِ عن هذا الأصل.
فالحديثان الأولان لا حاجةَ إلى تأويلهما لأجل حديثٍ غير ثابتٍ بل هو حديثٌ موضوعٌ لركاكته، ولا حاجةَ لما ذكره بعضٌ من حملِ حديث: “أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر” على الأوليةِ المطلقة لِغَرَضِ إثباتِ أوليةِ النورِ المحمدي. ثم إن التشبثَ بقولِ إن نور محمد أول المخلوقات على الإطلاق نوعٌ من الغلو وقد نَهَى الله ورسولُهُ عن الغلو. ومن العجب العجاب أن بعض المُعْتَقَدِين قال إن مدة مرض أيوب عليه السلام كانت شهرين، وهذا خلاف الحديث الصحيح عن رسول الله أن بلاء أيوب كان ثمانية عشر عامًا، رواه ابن حبان وصححه. فماذا يقول هؤلاء فيما قاله مريد الشيخ عبد العزيز الدباغ في كتابه الذي ألفه في ترجمة الشيخ الدباغ المسمى الإبريز: إن الشيخ الدباغ قال كان بلاء أيوب شهرين، فماذا يقول هؤلاء الغلاة في وصف المشايخ أكلام رسول الله هو صواب أم كلام الشيخ الدباغ الذي حكاه عنه مريده، وما أكثر الهالكين باعتقادهم أن كلام مشايخهم حق لا خطأ فيه بالمرة، وليعلم هؤلاء ما صح عن سيدنا عمر رضي الله عنه الذي هو أفضل أولياء أمة محمد بعد أبي بكر لا يلحقه في الدرجة من أتى بعده من الأولياء أنه قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر وذلك أنه قرر أنه إن زاد أحد في المهر على أربعمائة درهم أنه يأخذه ويضعه في بيت المال فقالت امرأة فقيهة: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين إن الله يقول ﴿وَءاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا {20}﴾ [سورة النساء] فصَعِدَ عمرُ المنبر فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وقد ثبت أنه كان متمكنًا في الكشف.
ومن الغلو المشابه لهذا اعتقادُ كثيرٍ من الناسِ أن الوليَّ لا يخطئ في شىءٍ من أمرِ الدين بل ولا في شىءٍ من إلهامه وهذا خلافُ حديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في الأوسط: “ما مِن أحدٍ منكم إلا يؤخذُ من قولِهِ ويُترَكُ غير رسول الله”، فالولي مهما عَلت مرتبته يُخطئ في بعض المسائل الفرعية إلا في أصولِ العقيدة ونحو ذلك، وعلى هذا كبارُ القوم قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: “إذا عَلِمَ المريدُ من الشيخِ الخطأَ فلينبهه فإن رَجَعَ وإلا فليكن مع الشرع”، وقال الشيخ أحمدُ الرفاعي رضي الله عنه: “سَلّم للقومِ أحوالَهم ما لم يخالفوا الشريعة فإذا خالفوا الشرعَ فَكُن مع الشرعِ”.
فيجبُ تحذيرُ هؤلاء المتشبثين بكل ما يُنسَبُ إلى الأولياءِ مما صح عنهم مما هو خطأٌ ومما لم يصح عنهم وذلك أكثر، ويحتجون لهذا الفهم الفاسدِ بقول القائل:
“وكن عندَهُ كالميت عند مُغَسّلٍ ***** يُقَلّبهُ كيما يشاء ويفعل”
ويظنونَ أن معناه أنه يجبُ اتباعُ الشيخ الكامل في كل شىء ولو في الخطإ فهؤلاءِ الجهلةُ ساووا الولي بالنبي.
والحديثُ المذكور حسَّنهُ الحافظُ العراقيُّ، وهو صريحٌ في أن كل فرد من أفرادِ الأمةِ خواصّهَا وعوامِّها لا بد أن يكون بعض قولهم صحيحًا وبعض غير صحيح فلا يُستثنى منهم أحد.
وهناك قاعدةٌ أصوليةٌ تؤيدُ ما ذكرنا وهي: “أن النصَّ لا يؤوّل إلا لدليلٍ سمعي ثابتٍ أو دليلٍ عقلي قاطِعٍ”، قال علماءُ الأصول: لا يجوزُ تأويلُ النص لغيرِ ذلك وإن ذلك عَبَثٌ والنصوص تُصَانُ عن العَبَثِ، ذكر ذلك كثيرٌ كصاحب المحصول، فبعدَ هذا يبطل تأويل المؤولين لحديثِ أولية الماءِ بأن أوليتَهُ نسبيةٌ لتأييدِ قولهم إن أول ما خلق الله نور محمد.
أما تأويلُ حديث أولية القلمِ للتوفيقِ بينه وبينَ حديثِ أولية الماء فذلك حقٌّ وصوابٌ لأن كلا الحديثين ثابتٌ وفي هذا مقنع للمتدبرِ المُنصِفِ.
فائدةٌ: وَرَدَ في حديثٍ صحَّحه بعضُهم وضعَّفهُ ءاخرون أن الله تعالى قال لآدم: “لولا محمّدٌ ما خلقتُكَ” رواه الحاكم وغيرُه، ومعناه خَلقتُ الدنيا لأظهِرَ محمدًا صَفوتها أي أشرف الخلق، فيُفهَمُ من هذا أنه يصحُّ أن يُقالَ إن محمّدًا هو سببُ وجودِ الدّنيا وهذا تشريفٌ.
وأما قولُهُ عليه الصلاة والسّلام: “وَكَتَبَ في الذكر كلَّ شىءٍ” أي أمرَ الله القلمَ الأعلى بأن يكتُبَ على اللوحِ المحفوظِ ما كانَ وما يكون إلى يوم القيامة، والقلمُ واللوحُ جِرمانِ عظيمانِ علويّانِ ليسا كأقلامنا وألواحنا. وقد وردَ أن القلمَ الأعلى من نورٍ لكن ليس ثابتًا ومعناه يُشبهُ النّور، لأن النّورَ لم يُخلَق في ذلك الوقت ولا الظَّلام. واللوحُ وَرَدَ في وصفهِ أنه من دُرّةٍ بيضاءَ حَافَتَاهُ ياقوتةٌ حمراءُ ومساحته مسيرة خمسمائة عام.
وقوله “ثم خَلَقَ السموات والأرض” معناه أن السموات والأرضَ خُلِقت بعد هذه الأشياء الأربعةِ وذلك بعد خمسين ألف سنة لحديث مسلم: “إن الله كَتَبَ مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة”، والسموات وهي سبعٌ والأرضونَ وهي سبعٌ، وكل سماء منفصلة عن الأخرى بفراغٍ واسعٍ وكل أرض منفصلة عن الأخرى بفراغ واسعٍ، وكل واحدةٍ فوق الأخرى. خُلِقَت في ستّة أيّام وكلُّ يوم من هذه الأيام قَدرُ ألف سنةٍ بتقدير أيّامنا هذه. فلا يَقُل قائلٌ خَلَقَ الله العالمَ في ستَّة أيَّامٍ إنما يُقَالُ خَلَقَ الله السموات والأرضَ وما بينهما في ستةِ أيامٍ كما جاءَ في القرءانِ.
فإن قيلَ: لمَ خَلَقَ الله السموات والأرض في ستَّة أيّامٍ ولم يخلقها في أقلَّ من ذلك فالجوابُ أن يقال: ليعلّمَنَا التّأنّيَ في الأمورِ.
قال المؤلف رحمه الله: ومَعنَى خلقَ كلَّ شَىءٍ أَنّه أخْرجَ جَميعَ الموجُوداتِ منَ العدَمِ إلى الوجُودِ.
الشرح: مَعنَى ذلكَ أنّ الله هو مُحْدِثُ كلّ شَىءٍ منَ العَدمِ إلى الوُجودِ، ولا يُضافُ الخَلْقُ بهذا المَعْنى إلا لله.
قال المؤلف رحمه الله: والله تعَالى حَيٌّ لا يَموتُ، لأنَّهُ لا نهايةَ لوجُودِهِ (أي أبديٌّ)، فلا يطْرأُ عليه العَدَمُ إذ لَوْ وُجِدَ بعدَ عَدَمٍ لاسْتَحالَ عَلَيهِ القِدَمُ (أي الأزليّةُ).
وحكمُ مَن يَقُولُ: “الله خَلَقَ الخَلْقَ فَمن خَلَقَ الله” التكفِيْرُ قَطْعًا لأنَّه نَسَبَ إلى الله تَعالى العَدَمَ قبلَ الوُجودِ، ولا يُقالُ ذلكَ إلا في الحَوادِثِ أي المَخلُوقاتِ، فَالله تَعالى واجِب الوُجُودِ (أي لا يُتَصَوّرُ في العَقْلِ عَدَمُه)، فَلَيسَ وجودُه كوُجُودِنا الحَادثِ لأنَّ وجُودَنا بإيجادِهِ تَعَالى وكُلُّ ما سِوى الله جَائِزُ الوجودِ (أي يُمكِنُ عقلًا وجُودُه بَعْدَ عَدَمٍ وإعْدامُه بعدَ وجُودِه) بالنَّظَرِ لذَاتِه في حُكْمِ العَقْلِ.
الشرح: روى مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يزالُ الناسُ يتساءلونَ حتى يقال: هذا، خَلَقَ الله الخَلقَ فمن خَلَقَ الله، فمن وَجَدَ من ذلك فليقل: ءامنتُ بالله ورُسُلِهِ” ففي هذا الحديث دواءٌ لما يُخالجُ كثيرًا من النُّفوس ويتحدَّثُ به كثيرٌ من الناس فيما بينهم وقد حَصَلَ ما تحدَّث به رسول الله في الحديث، وقولهم: من خَلَقَ الله هو سؤالُ المحالِ وذلك أن الذي تقتضيه البراهينُ العقليَّةُ والنُّصوصُ القرءانيَّةُ أن صانعَ العالم يجب أن يكون أزليًّا فيستحيل أن يكون له خالقٌ، ثم الأزليُّ لا يكون إلا أبديًّا أي أن الذي لم يسبقه عدمٌ لا يلحقُهُ عدمٌ، فبين الخالقيَّةِ والمخلوقيَّةِ اختلافٌ ظاهرٌ. فإن كان هذا خطورًا يخطُر في البال فعلاجُه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحُوَ عن هذا بغيره أي يَشغَلَ فكرَهُ بغيره ويدفَعَهُ بما هو المعتقدُ الصَّحيحُ وليقل: ءامنت بالله ورسلِهِ أو ءامنت بالله وبرسلِهِ فإن هذا ينفعه في قطعِ هذا الخاطر.
والخاطرُ هو ما لا تَملِكُ منعَهُ من أن يَرِدَ على قلبك ويتميّزُ بكونه بلا إرادةٍ، وأما الشَّكُّ فبإرادةٍ.
قال المؤلف رحمه الله: واعْلَم أنَّ أقْسَامَ المَوْجودِ ثَلاثَةٌ الأوَّلُ: أزَليٌّ أَبدِيٌّ وهوَ الله تعالى فقط أي لا بدايةَ ولا نِهايةَ لوجودِهِ.
الشرح: سُئِلَ أبو حنيفةَ رضي الله عنه عن الله فقال: “كانَ كما هو ويكونُ على ما كان” ذكره في إحدى رسائله الخمس، فقوله: “كان كما هو” فيه إثباتُ الأزليَّةِ وقوله: “ويكون على ما كان” فيه إثبات الأبديَّة. فالله تعالى لا بداية لوجودِهِ لأنه أزليٌّ وبثبوتِ القِدَمِ له عقلًا وجبَ له البقاءُ لأنه لو أمكن أن يلحقَهُ العدمُ لانتفى عنه القدمُ وانتفاءُ القِدَمِ عنه مستحيلٌ فانتفى عنه إمكان الفناءِ فهو الباقي لذاته.
ويجبُ القِدَمُ أيضًا لصفاتِهِ لأنه لو لم تكن صفاتُهُ أزليّةً بل كانت تَحدُثُ في الذّات لكان ذلك موجِبًا لحدوث الذّات، فَعُلِمَ من ذلك أنه لا يطرأُ على الله صفةٌ لم تكن في الأزل، ولا يتجدَّدُ له علمٌ ولا إرادةٌ ولا قدرةٌ ولا حياةٌ ولا سمعٌ ولا بصرٌ أيضًا، لا زيادةَ ولا نقصانَ في صفاته لأن الذي يزيدُ وينقصُ فهو حادثٌ مخلوقٌ، فعلمُهُ تعالى لا يزيدُ ولا ينقصُ وكذلك سائرُ صفاته.
ولقد زَاغَ أحمدُ بن تيمية فقال بوجودِ المخلوقِ مع الله في الأزل وقال إنه تحدُثُ في ذات الله صفات فتحدثُ له إرادةٌ بعد إرادةٍ وكلامٌ بعد كلامٍ ولم يدرِ أن حدوثَ الصّفاتِ في الذاتِ يوجِبُ كون الذات حادثًا، فهو في قوله إنه لم يزل مع الله مخلوق قَلَّدَ فيه الفلاسفة، ولقد كَذَبَ من قال في وصفه إنه لسانُ المتكلّمين على مذهبِ السلفِ وهو في الحقيقة مبتدعٌ في الاعتقادِ وفي الأحكامِ، وقد خَرَقَ الإجماعَ في مسائل عديدة في الطلاقِ وغيرِهِ كما قال الحافظُ أبو زُرعَةَ العراقي.
قال المؤلف رحمه الله: وحكمُ من يقولُ إنَّ هناكَ شَيئًا أزَليًّا سِوى الله التكفيرُ قَطعًا ولذلك كفَرت الفَلاسِفَةُ باعتقادِهِمُ السَّفِيهِ أنَّ العالَم قَديمٌ أزَليٌّ لأنَّ الأزَلِيَّةَ لا تَصِحُّ إلا لله تَعالى فقط.
الشرح: من اعتقدَ أن العالمَ أزليٌّ لا بدايةَ له وأنه لم يزل موجودًا مع الله بمادَّته وصورتِهِ أو بمادَّته فقط كابن تيمية فهو كافر، قال الزَّركشيُّ في كتابه تشنيف المسامع: “وهذا العالمُ بجملتِهِ عُلويُّه وسُفليُّه وجواهِرُهُ وأعراضُهُ محدَثٌ بمادَّتِهِ وصورتِهِ، كان عدمًا فصار موجودًا وعليه إجماع أهل المِلل، ولم يخالف إلا الفلاسفةُ ومنهم الفارابيُّ وابن سينا قالوا: إنه قديمٌ بمادَّته وصورته وقيل قديمُ المادّةِ محدَثُ الصورة”، ثم قال: “وضلَّلهم المسلمون وكفَّروهم”. انتهى، ويعني بذلك أن هذا كفرٌ بإجماع علماء الإسلام. ابن تيمية تبع المُحْدَثِينَ من الفلاسفة.
قال المؤلف رحمه الله: والثَّانِي: أَبديٌّ لا أَزَليٌّ أي أنَّ لهُ بدايةً ولا نِهايةَ لهُ وهُو الجنّةُ والنارُ فَهما مَخلوقَتان أي لَهُما بدايةٌ إلا أنَّه لا نِهايَة لَهُما أي أبدِيَّتانِ فَلا يَطرأُ علَيهِما خَرابٌ أو فَناءٌ لِمشيْئَةِ الله بَقاءَهُما، أمَّا مِن حَيْثُ ذَاتُهما فَيجوزُ عَليْهِما الفَناءُ عَقْلًا.
الشرح: أن الجنةَ والنارَ بقاؤهما ليس بالذاتِ بل لأن الله شاءَ بقاءهما، فالجنةُ باعتبار ذاتِها يجوز عليها الفناءُ وكذلك النارُ باعتبار ذاتِها يجوز عليها الفناءُ بخلاف الناسِ والملائكةِ والجن فإنهم يفنَون لأن الله لم يشأ بقاءهم، فَعُلِمَ بذلك أنه لا باقي بذاتِهِ إلا الله. وبهذا يندفع استشكال بعض الناس لبقاء الجنة والنار حيث توهم أن في ذلك تشريكًا لهما مع الله. يقال لهم لا يلزم من ذلك المشاركة لأن بقاء الله واجب أي لا يقبل العقل خلافه وأما بقاء الجنة والنار ليس بقاء واجبًا عقليًّا إنما هو من الجائزات العقلية لكن وجب لهما البقاء من حيث حكم الله تعالى ببقائهما، وذلك كإثبات الوجود لله وللعالم فإننا نقول الله موجود والعالم موجود لكن لا يلزم من هذا مشاركة العالم لله في الوجود لأن وجود الله ذاتي لا موجود بذاته إلا الله أما وجود العالم فليس ذاتيًّا بل بإيجاد الله فلا مشاركة. وما أحسن قول الشيخ محي الدين بن عربي لا موجود بذاته إلا الله وما أبشع قول بعض جهلة المتصوفة لا موجود إلا الله.
كذلك قولنا الله حي قادر مريد سميع بصير عالم متكلم باق فليس هناك مشاركة بينه وبين خلقه فإن حياة الله أزلية أبدية أما حياة غيره فليست كذلك، وكذلك يقال في بقية الصفات فلا يكون هذا مشاركة ومماثلة إنما هذا اتفاق في التعبير نعبّر عن الله بأنه موجود ونعبّر عن العالم بأنه موجود ولاموافقة في المعنى. أما إطلاق لفظ التخلق بأخلاق الله فينبغي تجنبه وقد ورد في هذا خبران لا أصل لهما أحدهما تخلقوا بأخلاق الله والآخر السخاء خُلُق الله الأعظم، فلا يجوز وصف الله بالخُلُق ولا يجوز نسبة الخبرين إلى الرسول.
قال المؤلف رحمه الله: الثّالثُ: لا أزَليٌّ ولا أبَدِيٌّ أي أنَّ لَهُ بِدايةً ولَه نِهايةً وهو كُلُّ مَا في هَذِهِ الدُّنيا مِنَ السموات السَّبْعِ والأَرْضِ فَلا بدَّ مِن فَنائِهما وفَناءِ مَا فِيْهما مِنْ إنْسٍ وجِنّ ومَلائِكَةٍ.
الشرح: يعني أن كلَّ ما في السموات والأرض وما فيها من إنسٍ وجنّ وملائكةٍ وبهائمَ وغيرِها يفنى قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ {26}﴾ [سورة الرحمن] أي أن كلَّ من على الأرض يفنى، وفناء البشر معناه مفارقَةُ أرواحِهم لأجسادِهم. فالآية نصٌّ في فناءِ من على وجه الأرض وأما فناءُ أهلِ السموات فهو يُفهم من قول الله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ {27}﴾ [سورة الرحمن]، ومعنى الوجه هنا الذات أي يبقى الله.
قال المؤلف رحمه الله: واعلَم أَنَّه جَرتْ عَادةُ العُلَماءِ عَلى ذِكْر أنَّ الحُكْمَ العَقْليَّ يَنْقَسِمُ إلى ثَلاثَةٍ: الوُجُوبُ والاسْتِحَالةُ والجَوازُ، وقَالوا: الوَاجِبُ: مَا لا يُتَصَوَّرُ عدمُه وهو الله وصفاتُه.
الشرح: الله تعالى ذاتُهُ واجبُ الوجود ويقال له واجبٌ عقليٌّ، وكذلك صفاتُه أي أن العقلَ يُحَتّمُ وجودَهُ ولا يقبَلُ انتفاءَهُ.
قال المؤلف رحمه الله: والمُسْتَحِيلُ: مَا لا يُتَصَوَّرُ في العَقْلِ وجُودُهُ، وقَدْ يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بالمُمْتَنِع.
الشرح: أما المستحيلُ العقليُّ فهو كالشَّريكِ لله تعالى والعجزِ والجهلِ بالنّسبة إلى الله، فكلّ ما لا يجوزُ على الله فهو مستحيلٌ عقليٌّ. ومن المستحيلِ العقليّ كونُ الحادِثِ أزليًّا.
أما المستحيلُ العادي فيصح وجوده عقلًا لكن عادةً لا يصحُّ كوجود جَبَلٍ من زئبق، فهذا لا يحصلُ في الدنيا على حَسَبِ العادة.
قال المؤلف رحمه الله: والجائزُ: ما يُتَصَورُ في العَقْلِ وجُودُه وعدَمُه ولذَلكَ يَصفونَ الله بالوَاجِبِ الوجود.
الشرح: ما يتصَوَّر في العقل وجودُهُ وعدمُهُ يقال له: الجائزُ العقليُّ ويقال له الممكنُ العقليُّ أي يُمكِنُ وجودُه بعد عدمٍ وإعدامُهُ بعد وجودِهِ بالنَّظرِ لذاته في حكمِ العقلِ، وهو هذا العالم.
قِدَمُ الله لَيسَ زَمَانيًّا
قال المؤلف رحمه الله: قِدَمُ الله لَيسَ زَمَانيًّا
الشرح: معنى هذه العبارةِ أن الله لا يَجري عليه زمانٌ أي لا بدايةَ لوجودِهِ لأن الزمان حادث.
قال المؤلف رحمه الله: الله تعالى كانَ قبلَ الزَّمانِ وقبلَ المكانِ، وقبلَ الظُّلُماتِ وقبلَ النُّورِ، فَهُو تَعالى لَيسَ مِنْ قَبِيلِ العَالَم الكَثِيْفِ كالأَرْضِ، والحَجَرِ، والكَواكِبِ، والنَّبَاتِ والإنْسَانِ، ولَيْسَ مِن قَبِيل العَالَمِ اللّطِيْفِ كالنُّورِ، والرُّوحِ، والهَواءِ، والجِنّ، والمَلائِكَةِ لمخَالفتِه للحَوادِثِ، أي لمخَالَفَتِهِ جَمِيعَ المَخلوقاتِ.
فإنْ قِيلَ: أَلَيسَ مِن أسمائِه اللّطِيفُ؟ فالجَوابُ: أنّ مَعْنَى اللّطِيفِ الذي هُوَ اسمٌ لله: الرَّحِيمُ بعبادِه أو الذي احتَجبَ عَن الأَوْهَامِ فلا تُدْرِكُهُ.
الشرح: الله تعالى لا تَبلُغُهُ الأوهامُ أي لا تبلغُهُ تصوُّراتُ العبادِ لأن الإنسانَ وَهمُهُ يدورُ حولَ ما أَلِفَهُ من الشَّىءِ المحسوسِ الذي له حدٌّ وشكلٌ وهيأةٌ والله ليس كذلك، لذلك نُهينا عن التفكُّرِ في ذاتِ الله وأُمِرنا بالتَّفكرِ في مخلوقاتِهِ لأن التفكر في مخلوقاتِهِ يقوّي اليقينَ.
قال المؤلف رحمه الله: فَلا نَظِيْرَ لَهُ تَعَالَى أي لا مَثِيْلَ لَه ولا شَبِيْهَ في ذاتِه ولا في صِفَاتِه ولا في فِعْلِه، لأَنَّهُ لَو كانَ مُمَاثِلًا لمخلُوقَاتِه بوجه من الوجُوه كالحجمِ والحركةِ والسكونِ ونحوِ ذلك لَم يكُنْ خَالِقًا لَها.
الشرح: ذاتُ الله معناه حقيقةُ الله الذي لا يشبهُ الحقائقَ، فذات الله لا يشبهُ ذواتِ المخلوقينَ وصفاتُه لا تشبه صفاتِ المخلوقين لأن صفات الله أزليّةٌ وصفاتِ المخلوقين حادثةٌ يجوز عليها التّطورُ والتّغيرُ، فلا يتَّصفُ الله بصفةٍ لم يكن متّصفًا بها في الأزل.
والله تعالى يفعلُ بمعنى الإخراجِ من العدمِ إلى الوجودِ ولا فاعلَ على هذا الوجهِ إلا الله، فالله تعالى يفعل فعلًا بقدرته الأزليَّة وبتكوينِهِ الأزليّ بلا مباشرةٍ ولا مماسَّةٍ لشىءٍ وعلى هذا البخاري حيث قال في كتاب التوحيد: “والفعل صفته في الأزل والمفعول مكوَّنٌ محدَث” اهـ وهو موافق لما عليه الماتريدية وبعض قدماء الأشاعرة من أزلية صفات الفعل كصفات الذات ورجحه الحافظ ابن حجر. والله تعالى هو الذي فعلُه لا يتخلَّفُ أثَرُهُ إذا شاءَ حصولَ شىءٍ إثرَ مزاولةِ المخلوق شيئًا حصلَ لا محالة.
قال المؤلف رحمه الله: فَالله تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَن الاتّصَافِ بالحَوادِثِ، وكَذَلِكَ صِفَاتُ الله تَعَالَى هِيَ قَدِيْمَةٌ أي أزَلِيَّةٌ. ولأَهَمّيَّةِ هَذا البَحْثِ قالَ الإمَامُ أبو حَنِيفَة: “مَنْ قالَ بِحدُوثِ صِفاتِ الله، أو شَكَّ، أوْ تَوقَّفَ، فهو كافرٌ”، ذَكَرهُ في كِتابِ الوَصِيَّةِ.
الشرح: أن الذي يقولُ عن صفاتِ الله لعلها أزليَّةٌ ولعلها ليست كذلك أو يقول لا أقول إنها أزليَّةٌ ولا أقولُ إنها غير أزليَّةٍ فهو كافرٌ.
قال المؤلف رحمه الله: وقَالَ الطّحَاويُّ: ومَن وصَفَ الله بمَعْنًى من مَعاني البَشَرِ فَقَد كَفَر.
الشرح: أن الذي يَصِفُ الله بصفةٍ من صفاتِ البشر فهو كافرٌ، وأوّل صفاتِ البشرِ هي الحدوثُ أي الوجودُ بعد عدمٍ، وصفاتُ البشرِ كثيرةٌ منها الجلوسُ والاتّصالُ والانفصالُ والحركةُ والسكونُ والانفعالُ والتَّنقُّلُ من عُلوٍ إلى سُفلٍ والتحيز في المكان والجهة وغيرُ ذلك. وليس من وَصْفِ الله بمعاني البشر أن يقال إن الله متكلمٌ بكلامٍ أزلي ليس حرفًا ولا صوتًا، وإنه يَرى برؤيةٍ أزليّةٍ بغير حَدَقَةٍ، وإنه يسمَعُ بسمعٍ أزليّ ليس بأذنٍ وءالةٍ لأن هذا ليس إلا توافقًا في اللفظ.
قال المؤلف رحمه الله: تَنزيهُ الله عَن المَكَانِ وتَصْحيحُ وجُودِه بلا مكانٍ عَقْلًا والله تعَالى غَنِيٌّ عن العَالمينَ أي مُسْتَغنٍ عَن كُلّ ما سِوَاهُ أَزَلا وأَبَدًا فَلا يَحْتَاجُ إلى مَكَانٍ يتحيز فيه أو شَىءٍ يَحُلُّ به أو إلى جِهَةٍ لأنه ليس كشىءٍ منَ الأشياء ليس حجمًا كثيفًا ولا حجمًا لطيفًا والتحيزُ من صفاتِ الجسمِ الكثيفِ واللطيفِ فالجسمُ الكثيفُ والجسمُ اللطيفُ متحيزٌ في جهةٍ ومكانٍ قال الله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ {33}﴾ [سورة الأنبياء] فأثبتَ الله تعالى لكل من الأربعة التحيز في فلكه وهو المدار.
الشرح: من صفات الإله أنه مستغنٍ عن كلّ ما سواه، وكلُّ ما سواهُ محتاجٌ إليه، ومن كان محتاجًا إلى مكان يستقرُّ أو يتحيّزُ فيه فإنه ليس إلهًا. وقد قال عليٌّ رضي الله عنه: “من زعمَ أن إلهنا محدودٌ فقد جَهِلَ الخالقَ المعبودَ” رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء. ومعنى كلامه أن الله ليس له حجمٌ صغيرٌ ولا كبيرٌ، ليس كأصغر حجم وهو الجزء الذي لا يتجزّأُ، ولا كأكبر حجم كالعرش وليس حجمًا أكبر من العرش ولا كما بين أصغر حجم وأكبر حجم قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ {8}﴾ [سورة الرعد] فالله منزهٌ عن المقدار أي الحدّ والكميّةِ، فمن قال إنه حجمٌ كبيرٌ بقدر العرش أو كحجمِ الإنسان فقد خالفَ الآية، كما أنه خالف قوله تعالى:﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ [سورة الشورى] لأنه لو كان له حجمٌ لكان له أمثالٌ لا تُحصى ولو كان متحيّزًا في جهة فوق لكان له أمثالٌ لا تُحصى، فالجهاتُ كلُّها بالنسبةِ لذات الله على حدّ سواءٍ ولذلك يُوصَفُ الله بالقريبِ فلو كان متحيّزًا فوق العرش لكان بعيدًا ولم يكن قريبًا. قال الإمامُ زين العابدين رضي الله عنه عليُّ بن الحسين في الصَّحيفة السَّجَّاديَّة: “سبحانك أنتَ الله لا إله إلا أنتَ لا يحويكَ مكانٌ لا تُحَسُّ ولا تُمَسُّ ولا تُجَسُّ”، رواه الحافظ محمد مرتضى الزبيديُّ في كتاب إتحاف السادة المتقين بالإسناد المتصل منه إلى زين العابدين.
في تَنزِيهِ الله عن المَكَانِ والحَيّزِ والجِهَة
قال المؤلف رحمه الله: ويَكفِي في تَنزِيهِ الله عن المَكَانِ والحَيّزِ والجِهَةِ قَولُه تَعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ [سورة الشورى] لأنه لَو كَانَ لَه مَكانٌ لَكَانَ لَهُ أَمثَالٌ وأبعَادٌ طُولٌ وعَرْضٌ وعُمْقٌ، ومَنْ كَانَ كذَلِكَ كَانَ مُحْدَثًا مُحْتَاجًا لِمَنْ حَدَّهُ بِهَذَا الطُّولِ وبِهَذَا العَرْضِ وبِهَذَا العُمْقِ، هذَا الدليلُ منَ القُرءانِ. أمَّا مِنَ الحَدِيثِ فما رَواه البُخَارِيُّ وابنُ الجارودِ والبَيْهقيُّ بالإسْنادِ الصَّحِيحِ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: “كانَ الله ولَم يكن شَىءٌ غَيرُهُ”، ومَعناهُ أنَّ الله لم يَزَلْ مَوْجُودًا في الأَزَلِ لَيسَ مَعَهُ غيرُه لا مَاءٌ ولا هَواءٌ ولا أَرْضٌ ولا سَماءٌ ولا كُرْسيٌّ ولا عَرْشٌ ولا إنْسٌ ولا جِنٌّ ولا مَلائِكَةٌ ولا زَمَانٌ ولا مَكانٌ ولا جِهاتٌ، فَهُو تَعَالَى مَوجُودٌ قَبْلَ المَكَانِ بِلا مَكَانٍ، وهُو الّذي خَلَقَ المَكَانَ فَلَيسَ بِحَاجَةٍ إلَيهِ، وهَذا ما يُسْتَفادُ منَ الحدِيثِ المَذْكُورِ.
وقالَ البيهقيُّ في كتابِه “الأسماءُ والصّفَاتُ”: “اسْتَدَلَّ بَعْضُ أصْحَابِنا في نَفْي المَكَانِ عَنْهُ بِقَولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم: “أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَىءٌ وأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شىءٌ”، وإذَا لَم يَكُن فوقَهُ شَىءٌ وَلا دُونَهُ شَىءٌ لَم يَكُن فِي مَكَانٍ” اهـ. وهَذَا الحَدِيثُ فِيه الرّدُّ أَيضًا عَلى القَائِلينَ بالجِهَةِ في حَقّهِ تَعَالَى.
الشرح: الله تعالى ظاهرٌ من حيثُ الدَّلائلُ العقليّةُ التي قامت على وجودِهِ وقدرتِهِ وعلمِهِ وإرادتِهِ لأنه ما من شىءٍ إلا وهو يدلُّ دلالةً عقليةً على وجود الله كما قال أبو العتاهية:
فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الإلَـــــــــهُ ***** أم كَيفَ يَجحدُه الجاحِدُ
وفي كلّ شَىءٍ لهُ ءايةٌ ***** تَدُلُّ عَلى أنَّهُ واحِدُ
وَفي كلّ تَحرِيكةٍ ءايةٌ ***** وَفي كُلّ تَسْكِيْنَةٍ شاهدُ
ومعناها أن جميعَ الكائنات وحركاتِها وسكناتِها تدلُّ دلالةً عقليَّةً على وجودِ الله تعالى وكأنَّها تَنطِقُ نُطقًا بذلك، فما كان منها نُطقًا كالملائكةِ والمؤمنين من الإنس والجنّ فتلكَ شهادةٌ حسيَّةٌ، وأما ما لا ينطِقُ منها حسًّا فهي شهادةٌ معنويَّة كأن لسانَ حالِها يَنطِقُ ويقول أنا من صُنعِ حكيمٍ عليمٍ قادرٍ مريدٍ منزَّهٍ عن النَّقص هو الله. والجمادات قد تنطق بالنطق الذي يفهمه البشر بالشهادة لوجود الله وتقديسه كالطعام الذي سبَّح في يد رسول الله وكتسبيح السُّبحة في يد أبي مسلم الخَولاني كان يسبِّح بها ثم نام فصارت السُّبحة تدور على ذراعه تقول سبحانك يا مُنبت النبات ويا دائم الثبات. رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. وحصل لامرأة في عرسال أنها كانت ذات مساء في الكرم فسمعت الكرم يقول الله الله. ومعنى دائم الثبات دائم الوجود ليس معناه السكون.
وأما الباطِنُ من أسماء الله فمعناهُ على ما قال بعض العلماءِ: الذي يعلَمُ حقائقَ الأمورِ، وبعضهم قال: الذي لا تدركُهُ الأوهامُ أي لا تَبلُغُهُ تصَوُّراتُ العباد.
أما حقيقةُ الله فلا يصلُ إليه أحدٌ مهما شَغَلَ فِكرَه، فلذلك نُهينا عن التَّفكُّرِ في ذاتِ الله وأُمرنا بالتَّفكُّر في مخلوقاتِهِ، فليتفكَّرِ الإنسان منا في نفسه كيف يدخُلُ الطعامُ والشراب من مَدخلٍ واحدٍ ثم يخرجان من مخرجين مختلفَين، وفي غير ذلك من صفاتِ ذاته، فبهذا التفكُّرِ يصلُ إلى معرفة أنه أوجدَهُ مُوجِدٌ لا يشبهُهُ بوجهٍ من الوجوهِ أي أنه ليس حجمًا ولا متَّصفًا بصفات الحجم. فمثل هذا التَّفكُّرِ في مصنوعات الله واجبٌ أمرنا الله تبارك وتعالى به، أما التَّفكُّرُ في ذاتِ الله أي إعمالُ الفكر لتوهمه وتخيله فهو محرَّمٌ لأنك لا تصلُ إلى نتيجةٍ لأنه موجودٌ لا كالموجودات.
قال المؤلف رحمه الله: وقَد قَالَ عليٌّ رضيَ الله عنه: “كانَ الله ولا مكانَ وهوَ الآنَ على ما عليْهِ كَانَ” رواهُ أبو منْصُورٍ البَغْدَادِيُّ.
الشرح: “كان الله” أي في الأزلِ “ولا مكانَ” أي ولم يكن مكان “وهو الآن” أي بعد أن خلقَ المكانَ “على ما عليه كانَ” أي لم يزل موجودًا بلا مكانٍ لأنه لا يجوزُ عليه التغيُّرُ والتّطوُّرُ والانتقالُ من حالٍ إلى حالٍ.
قال المؤلف رحمه الله: ولَيْسَ مِحْورُ الاعْتِقَادِ علَى الوَهْمِ بَل عَلَى ما يَقْتَضِيهِ العَقْلُ الصَّحِيحُ السَّلِيمُ الذي هُوَ شَاهِدٌ للشَّرْعِ، وذَلِكَ أن المحدودَ محتاجٌ إلى من حدَّه بذلكَ الحدّ فلا يكُون إلهًا.
الشرح: الوهمُ والتخيُّلُ قد يجتمعان من حيثُ المعنى، ومِحورُ اعتقادِ المسلم ليس على الوهمِ لأن الوهمَ يحكُمُ على ما لم يشاهده بحكم ما شاهدَه فيحكُم بأن الله موجودٌ بمكانٍ، أما العقلُ السليمُ فيقضي بأن الله موجودٌ بلا مكانٍ. ومحورُ اعتقاد المسلم على العقلِ السليم ليس على الوهمِ لأن العقلَ لا يَرُدُّ ذلك بل يقبلُه ويسلّمُ به والوهمُ يتصوَّرُ أشياءَ لا حقيقة لها ومثال ذلك لو نظرَ إنسانٌ إلى البحر عند الغروب وهمُهُ يقول له إن السماءَ ملتصقةٌ بالبحر وإن الشمسَ تنزلُ في البحر لكن الواقعَ غيرُ ذلك، فنحن ننظر إلى العقلِ ولا ننظر إلى الوهمِ. وإذا قال المشبّهةُ كيف يُقالُ الله ليس متَّصلًا بالعالم ولا منفصلًا عنه هذا لا يقبلُهُ العقلُ، يقال لهم: العقلُ يقبلُهُ لكنَّ الوهمَ لا يتصوَّرُهُ، كما لا يتصوَّرُ الوهمُ عدمَ النور والظلام معًا في ءان واحد قبل أن يخلقا لأنهما خلقا بعد خلق الماء والعرش والقلم واللوح كما دل على ذلك حديث عمران بن الحصين “كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شىء”. فإن قوله صلى الله عليه وسلم “وكتب في الذكر كل شىء” يريد به القلم الأعلى واللوح المحفوظ. دل هذا الحديث على أن هؤلاء الأربعة أول المخلوقات، فيفهم من ذلك أنه لم يخلق النور والظلام إلا بعد هؤلاء الأربعة. فأي عقل يفهم حقيقة ذلك؟! ومع كون ذلك غير مفهوم للإنسان نؤمن به لأن الله تعالى أخبر بذلك بقوله ﴿الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ {1}﴾ [سورة الأنعام].
قال المؤلف رحمه الله: فَكَمَا صَحَّ وجُودُ الله تَعَالَى بِلا مَكَانٍ وَجِهَةٍ قَبْلَ خَلْقِ الأَمَاكِنِ والجِهَاتِ فَكَذَلِكَ يَصِحُّ وجُودُهُ بَعْدَ خَلْقِ الأَمَاكِنِ بِلا مَكَانٍ وجِهَةٍ، وهَذَا لا يكونُ نَفيًا لِوجُودِهِ تَعَالى كما زعمت المشبّهةُ والوهابيّةُ وهم الدُّعاةُ إلى التّجسيمِ في هذا العصرِ.
الشرح: أما الدليلُ العقليُّ على تنزيهِ الله عن المكان فهو أنه تعالى لو استقرَّ على مكانٍ أو حاذى مكانًا لم يَخلُ أن يكونَ بقدر المكانِ أو أصغرَ منه أو أكبرَ منه، فلو كان مثلَ المكانِ لكان له شكلُ المكانِ إن كان ذلك المكانُ مربّعًا أو مثلَّثًا أو غيرَهما من الأشكال فيكون محتاجًا إلى مخصصٍ خَصَّصَهُ بأحدِ هذه الأشكالِ وهذا عجزٌ، ولو كان أكبرَ من المكان لأدَّى ذلك إلى التوهمِ أن الله متجزّئ بأن يكون جزءٌ منه في مكانٍ والزائدُ خارج المكان واعتقاد هذا كفرٌ أيضًا، ولو كان أصغرَ من المكان لكان ذلك حصرًا له وهذا لا يليقُ بالله تعالى. فمحالٌ أن يكون الله مثلَ المكان أو أكبرَ من المكانِ أو أصغرَ من المكانِ وما أدّى إلى المحالِ محالٌ.
قال المؤلف رحمه الله: وحُكْمُ مَن يَقُولُ: “إنَّ الله تَعالى في كُلّ مَكَانٍ أَو في جَمِيع الأَمَاكِنِ” التَّكْفِيْرُ إذَا كَانَ يَفهَم من هَذِهِ العِبَارَةِ أنَّ الله بذاتِهِ مُنْبَثٌّ أوْ حَالٌّ في الأَمَاكِنِ، أَمَّا إِذَا كَانَ يَفْهَمُ مِنْ هَذِهِ العِبَارَةِ أَنَّهُ تَعَالى مُسَيطِرٌ عَلَى كُلّ شَىءٍ وعَالِمٌ بكُلّ شَىءٍ فلا يكفُرُ، وهَذَا قَصْدُ كَثِيْرٍ مِمَّن يَلْهَجُ بِهَاتَيْن الكَلِمَتَينِ، ويَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُمَا على كُلّ حَالٍ، لأنهما ليستا صادرتين عن السّلَف بل عن المعتزلة ثم استعملهما جهلَةُ العَوامّ.
الشرح: أن هذا مذهب الجهمية كانَ جهمُ بن صفوانَ يقول عن الله تعالى هُوَ هذا الهواءُ وعلى كلّ شىء فكفَّرَهُ المسلمونَ وقُتِلَ بحكمِ الرّدَّة، أما من قالَ الله في كلّ مكانٍ على معنى الإحاطةِ بالعلم والتَّدبيرِ فلا نكفّره. وأما قوله تعالى:﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطًا {126}﴾ [سورة النساء] فليس معناه أن الله محيطٌ بالعالم كإحاطةِ الحُقَّةِ بما فيها إنما معناه إحاطةُ العلمِ والقدرةِ أي أنه لا يَخرُجُ شَىءٌ عن قدرةِ الله وعلمِهِ.
قال المؤلف رحمه الله: ونَرفَعُ الأَيدِيَ في الدُّعاءِ للسَّمَاءِ لأَنَّها مَهْبِطُ الرَّحمَاتِ والبَركاتِ ولَيْسَ لأَنَّ الله مَوجودٌ بِذَاتِهِ في السَّمَاءِ، كَما أنّنَا نَسْتَقْبِلُ الكَعْبَة الشَّرِيْفَة في الصَّلاةِ لأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَنَا بِذَلِكَ وَلَيْسَ لأَنَّ لَهَا مِيزَةً وخُصوصِيَّةً بسُكْنى الله فيها.
الشرح: نَرفَعُ أيديَنا في الدّعاءِ إلى السّماءِ لأن السماءَ قبلةُ الدُّعاء كما أن الكعبةَ قِبلةُ الصلاةِ أي تَنزِل علينا البركةُ والرحمةُ منها لأن السماءَ مهبطُ الرّحماتِ قال تعالى ﴿وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ {22}﴾ [سورة الذاريات]. وأما مدُّ اليدين فمعناه استنزالُ الرَّحمةِ والله لا يُخيبُ القاصدين بحقّ، فهذا الداعي الذي دعا الله تعالى وكان مادًّا يديهِ إلى السماءِ ليستنزلَ الرَّحمات من الله تعالى فإذا مَسَحَ بعد إنهاءِ الدعاءِ باليدين وجهَه معنى ذلك أن هذه اليد نَزَلَت عليها رحماتٌ وبمسحِهِ وجهَهُ بهما أصابت هذه الرَّحماتُ وجهَهُ.
قال المؤلف رحمه الله: ويكْفُر من يَعتقدُ التّحيُّزَ لله تَعالى، أوْ يَعتقِدُ أنَّ الله شَىءٌ كالهَواءِ أوْ كالنُّورِ يَملأُ مكَانًا أو غُرفةً أو مَسْجدًا ويُرَدُّ على المعتقدِين أنَّ الله متحيزٌ في جهةِ العلوِ ويقولون لذلك تُرفعُ الأيدي عند الدعاء بما ثَبتَ عن الرسولِ أنه استَسْقَى أي طلَبَ المطَرَ وجعلَ بَطْنَ كفَّيهِ إلى الأرضِ وظاهرَهُمَا إلى السماءِ وبأنه صلى الله عليه وسلم نهَى المصلي أن يرفعَ رأسَهُ إلى السماءِ، ولو كان الله متحيزًا في جهةِ العلوِ كما تظنُّ المشبهةُ ما نهانا عن رفعِ أبصارِنا في الصلاةِ إلى السماءِ، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه المسبحة عند قول “إلا الله” في التحيات ويحنيها قليلًا فلو كان الأمرُ كما تقولُ المشبهةُ ما كان يحنيها بل يرفعُها إلى السماءِ وكلُّ هذا ثابتٌ حديثًا عند المحدِّثين. فماذا تفعلُ المشبهةُ والوهابيةُ؟! ونسمّي المسَاجِدَ بُيوتَ الله لا لأنَّ الله يَسكنُها بل لأنَّها أمَاكنُ مُعَدَّة لذكرِ الله وعبادتِهِ، ويقالُ في العرشِ إنه جرمٌ أعدَّه الله ليَطوفَ به الملائكةُ كما يطوف المؤمنونَ في الأرض بالكعبةِ.
وكَذلكَ يكفُر من يَقولُ: (الله يَسكنُ قلوبَ أوليائِه) إنْ كانَ يَفْهَمُ منه الحُلُولَ.
الشرح: القسمُ الأولُ واضحُ المعنى وقد تقدم شرحُهُ، أما العبارةُ الأخيرة فهي من كلامِ جهلةِ المتصوّفةِ وهذا كفرٌ، لكن إن كانَ يفهمُ من هذه العبارة أن حب الله سَاكِنُ قلوبهم فلا يكفُر. وأما الحيّزُ فهو ما يشغلُهُ الجسمُ من الفراغ، فالحيّزُ هو المكانُ، إن كان جسمًا صلبًا كالأرض وإن كان فراغًا فإن العرش والنجوم والشمس والقمر متحيزات في الفراغ وكذلك السموات السبع والأرض غيرَ أن الشمس والقمر يسبحان كل منهما في مدار بخلاف العرش والسموات فإنها ساكنات، فإن القرءان خص الشمس والقمر والليل والنهار بالسَّبح وذلك في هذه الآية ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ {33}﴾ [سورة الأنبياء].
قال المؤلف رحمه الله: ولَيسَ المَقْصودُ بالمِعراجِ وصُولَ الرسولِ إلى مكانٍ يَنْتَهِي وجُودُ الله تَعَالى إِلَيهِ ويَكْفُر مَن اعْتَقدَ ذلكَ، إِنّمَا القَصْدُ منَ المِعْراجِ هُو تَشْريفُ الرّسولِ صلى الله عليه وسلم بإطْلاعِه علَى عَجَائِبَ في العَالَمِ العُلْوِيّ، وتَعظِيمُ مكَانتِه ورُؤْيتُه لِلذَّاتِ المُقَدَّسِ بفُؤَادِه منْ غَيرِ أن يكُونَ الذَّاتُ في مكَانٍ وإنما المكانُ للرسولِ.
الشرح: ليس المقصودُ بالمعراجِ أن الرسولَ وَصَلَ إلى مكانٍ حيثُ الله تعالى متحيّزٌ فيه لأن الله تعالى لا يجوزُ عليه عقلًا التَّحيُّز في مكانٍ والاستقرارُ فيه سواءٌ كان المكانُ عُلويًّا أو سُفليًّا إنما المقصودُ بالمعراجِ هو تشريفُ الرسول.
قال المؤلف رحمه الله: وأمَّا قولُه تَعَالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى {8} فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى {9}﴾ [سورة النجم] فَالمَقصُودُ بِهَذِهِ الآيةِ جِبْرِيلُ عَلَيْه السَّلامُ حَيْثُ رَءاهُ الرسول صلى الله عليه وسلم بمكةَ بمكانٍ يقالُ له أجيادٌ وله سِتُّمائَةِ جَنَاحٍ سادًّا عُظْمُ خَلْقِه مَا بَيْنَ الأُفُقِ، كَما رَءاهُ مَرّةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهى، كَما قالَ تَعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءاهُ نَزْلَةً أُخْرَى {13} عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى {14}﴾ [سورة النجم].
الشرح: معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى {8} فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى {9}﴾ [سورة النجم] أن جبريلَ عليه السلام اقتربَ من سيدنا محمدٍ فتدلى إليه فكانَ ما بينهما من المسافةِ بمقدارِ ذِرَاعينِ بل أقربَ، وقد تدلَّى جبريلُ عليه السلام إلى محمد ودَنَا منه فَرَحًا به.
وليس الأمرُ كما يفتري بعضُ الناس أن الله تعالى دَنَا بذاتِهِ من محمدٍ فكان بين محمدٍ وبين الله كما بين الحاجِبِ والحاجِبِ أو قدرَ ذراعين لأن إثباتَ المسافةِ لله تعالى إثباتٌ للمكانِ وهو من صفاتِ الخلق، أما الخالقُ فهو موجودٌ بلا كيفٍ ولا مكانٍ، لا يكون بينه وبين خلقِهِ مسافةٌ فالعرشُ الذي هو أعلى المخلوقات والفرشُ الذي هو منتهى المخلوقاتِ في الجهةِ السُّفلى على حدٍّ سواءٍ بالنسبة إلى ذات الله. فلا يجوزُ اعتقادُ القُربِ المكاني الذي هو قربٌ بالمسافة في حقّ الله تعالى، وإنما يمتازُ العرشُ وما يليه من السموات بكونه مسكَنَ الملائكة الذين لا يعصونَ الله ما أَمَرَهُم وبفضائلَ أخرى، أما بالنّسبةِ إلى ذات الله فليسَ العرشُ قريبًا من الله بالمسافة قربًا يجعلُهُ بعيدًا من الفرش. فقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءاهُ نَزْلَةً أُخْرَى {13} عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى {14}﴾ أي اجتمع مرةً ثانيةً بجبريل هناك، لأن جبريلَ لا يتجاوز سِدرةَ المنتهى، فإنَّ جبريلَ سفيرٌ بين الله وبين أنبيائه وبين ملائكة السموات السبع، فهو الذي يبلّغ الوحي للملائكةِ وللأنبياءِ لأنه يسمع كلام الله الذي ليس حرفًا ولا صوتًا بل كلام أزليّ أبدي ليس فيه تقطع ليس شيئًا يسبق بعضه بعضًا ويتأخر بعضه عن بعض كالكلام الصوتيّ. والأحاديث التي فيها نسبة الصوت إلى الله ردَّها الحافظ أبو المكارم، سردها وضعّفها بعلل في جزء خاص ألَّفه لهذا الغرض.
وأما الحديثُ الذي رواه البخاري في صحيحه: “وَدَنَا الجبارُ ربُّ العزة فتدلّى حتى كانَ منه قاب قوسين أو أدنى” فهذه الروايةُ طعنَ فيها بعض الحفاظ كعبد الحق وغيرِه، وقال بعضهم: ليس دنوًّا حسيًّا وإنما هو مزيد إكرامٍ وتقريبٍ في الدرجات، وأما حملُهُ على الظاهرِ فكل أهل السنة يردُّونه بل يجعلونَ ذلك تشبيهًا لله بخلقه كما ذكرَ ذلك الحافظُ ابن حجر العسقلانيُّ في شرح البخاري.
قال المؤلف رحمه الله: وأمّا ما في مسلم من أن رجلًا جاءَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسألهُ عن جاريةٍ لهُ قال: قلتُ: يا رسولَ الله أفلا أعتِقُها، قال: ائتني بها، فأتاهُ بها فقالَ لها: أينَ الله، قالت: في السماءِ، قال: مَن أنا، قالت: أنتَ رسولُ الله، قال: أعتِقْها فإنّها مؤمنةٌ. فليسَ بصحيحٍ لأمرينِ: للاضطرابِ لأنّه رُويَ بهذا اللفظ وبلفظِ: مَن رَبُّك، فقالت: الله، وبلفظ: أينَ الله، فأشارت إلى السّماءِ، وبلفظ: أتشهَدينَ أن لا إله إلا الله، قالت: نعم، قال: أتشهدينَ أنّي رسولُ الله، قالت: نعم.
والأمرُ الثَّاني: أن رواية أين الله مخالفةٌ للأصولِ لأنَّ من أصولِ الشريعةِ أن الشخصَ لا يُحكَمُ له بقولِ “الله في السماءِ” بالإسلامِ لأنَّ هذا القولَ مشتَركٌ بين اليهودِ والنّصارَى وغيرِهم وإنّما الأصلُ المعروفُ في شريعةِ الله ما جاءَ في الحديثِ المتواتر: “أمرتُ أن أقاتلَ النّاسَ حتّى يشهَدُوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسولُ الله”.
ولفظُ روايةِ مالكٍ: أتشهدينَ، موافقٌ للأصول.
فإن قيلَ: كيف تكونُ روايةُ مسلم: أينَ الله، فقالت: في السماءِ، إلى ءاخره مردودةً مع إخراج مسلمٍ لهُ في كتابهِ وكلُّ ما رواهُ مسلمٌ موسومٌ بالصّحّةِ، فالجوابُ: أن عدَدًا من أحاديثِ مسلمٍ ردَّها علماءُ الحديثِ وذكرَها المحدّثونَ في كتبهم كحديث أن الرسولَ قال لرجُلٍ: إنَّ أبي وأبَاكَ في النّار، وحديث إنه يُعطى كل مسلم يومَ القيامَةِ فِداءً لهُ مِنَ اليهودِ والنصارَى، وكذلكَ حديث أنسٍ: صَليتُ خلفَ رسولِ الله وأبي بكرٍ وعمرَ فكانوا لا يذكرونَ بسم الله الرحمن الرحيمِ. فأمَّا الأولُ ضَعَّفَهُ الحافظُ السيوطيُّ، والثاني رَدَّهُ البخاريُّ، والثالثُ ضَعَّفَهُ الشافعيُّ وعدد من الحفاظ.
فهذا الحديثُ على ظاهرِهِ باطلٌ لمعارضَتِهِ الحديثَ المتواترَ المذكورَ وما خالفَ المتواترَ فهو باطلٌ إن لم يقبل التأويلَ. اتفقَ على ذلك المحدِّثونَ والأصوليُّونَ لكن بعض العلماءِ أوَّلُوهُ على هذا الوجهِ قالوا معنى أينَ الله سؤال عن تعظيمِها لله وقولها في السماءِ عالي القدرِ جدًّا أما أخذه على ظاهره من أن الله ساكن السماء فهو باطلٌ مردودٌ وقد تقررَ في عِلمِ مصطلحِ الحديثِ أنَّ ما خالفَ المتواتر باطلٌ إن لم يقبل التأويل فإن ظاهرَه ظاهرُ الفساد فإن ظاهرَه أنَّ الكافرَ إذا قالَ الله في السماءِ يُحكم لهُ بالإيمانِ.
وحمل المُشبهة رواية مسلم على ظاهرهَا فَضَلُّوا ولا يُنجيهم منَ الضلالِ قولُهم إننا نحملُ كلمةَ في السماءِ بمعنى إنهُ فوقَ العرشِ لأنهم يكونونَ بذلكَ أثبتوا لهُ مِثلًا وهوَ الكتابُ الذي كَتَبَ الله فيه إن رَحمَتي سَبَقَت غَضبي فوقَ العرشِ فيكونونَ أثبتوا المُمَاثَلَةَ بينَ الله وبينَ ذلكَ الكتاب لأنهم جعلوا الله وذلكَ الكتاب مستقرَّيْنِ فوقَ العرش فيكونونَ كذبوا قولَ الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ {11}﴾ وهذا الحديثُ رواهُ ابن حبانَ بلفظ “مرفوع فوقَ العرشِ”، وأما روايةُ البخاري فهي “موضوع فوقَ العرشِ”، وقد حَملَ بعضُ الناسِ فوقَ بمعنى تحت وهو مردودٌ بروايةِ ابنِ حبانَ “مرفوع فوق العرش” فإنه لا يَصحُّ تأويلُ فوقَ فيه بتحت. ثم على اعتقادِهم هذا يلزمُ أن يكونَ الله محاذيًا للعرشِ بقدرِ العرشِ أو أوسَعَ منهُ أو أصغرَ، وكلُّ ما جَرَى عليهِ التّقديرُ حَادِثٌ محتاجٌ إلى من جَعَلَهُ على ذلكَ المقدارِ، والعرشُ لا مناسبةَ بينهُ وبينَ الله كما أنه لا مناسبةَ بينهُ وبينَ شىءٍ من خَلقِهِ، ولا يتشرَّفُ الله بشىءٍ من خلقِهِ ولا ينتفعُ بشىءٍ من خلقِه. وقولُ المشبهةِ الله قاعدٌ على العرشِ شَتمٌ لله لأن القعودَ من صفةِ البشرِ والبهائمِ والجِنّ والحشرات وكلُّ وَصفٍ من صفاتِ المخلوقِ وُصِفَ الله به شَتمٌ لهُ، قالَ الحافظُ الفقيهُ اللغويُّ مرتضى الزبيديُّ: “مَن جَعَلَ الله تعالى مُقَدَّرًا بِمقدَارٍ كَفَرَ” أي لأنهُ جعلَهُ ذا كميةٍ وحجمٍ والحجمُ والكميةُ من موجبَاتِ الحُدوثِ، وهل عرفنا أن الشمس حادثةٌ مخلوقةٌ من جهةِ العقلِ إلا لأن لها حَجمًا، ولو كانَ لله تعالى حجمٌ لكانَ مِثلًا للشمسِ في الحجميَّةِ ولو كانَ كذلكَ ما كانَ يستحقُّ الألوهيةَ كَما أن الشمسَ لا تستحقُّ الألوهية. فلو طَالَبَ هؤلاءِ المشبهةَ عابدُ الشمسِ بدليلٍ عقليّ على استحقاقِ الله الألوهية وعدم استحقاقِ الشمسِ الألوهية لم يكن عندَهم دليلٌ، وغَايَةُ ما يستطيعونَ أن يقولوا قالَ الله تعالى: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ {62}﴾ ، فإن قالوا ذلكَ لعابدِ الشمسِ يقولُ لهم عابدُ الشمسِ: أنا لا أؤمنُ بكتابكم أعطوني دليلًا عقليًّا على أن الشمسَ لا تستحقُّ الألوهيةَ فهنا ينقطعونَ.
فلا يوجدُ فوقَ العرش شىءٌ حيٌّ يسكنه إنما يوجدُ كتابٌ فوقَ العرشِ مكتوبٌ فيه: “إنَّ رحمتي سَبَقَت غَضبي” أي أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، الملائكة من مظاهر الرحمة وهم أكثرُ عددًا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجار، والجنة من مظاهر الرحمة وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات.
وكونُ ذلك الكتابِ فوقَ العرشِ ثابتٌ أخرجَ حديثهُ البخاريُّ والنسائيُّ في السننِ الكبرى وغيرُهما، ولفظ روايةِ ابن حبّانَ: “لمَّا خلقَ الله الخلقَ كتبَ في كتابٍ يكتبُهُ على نفسِهِ وهو مرفوعٌ فوقَ العرشِ إن رحمتي تَغلبُ غَضَبي”.
فإن حاوَلَ محاوِلٌ أن يؤوّلَ “فوق” بمعنى دون قيلَ لهُ: تأويلُ النصوصِ لا يجوزُ إلا بدليلٍ نقليّ ثابتٍ أو عقليّ قاطِعٍ وليس عندهم شىءٌ من هذين، ولا دليلَ على لزومِ التأويلِ في هذا الحديثِ، كيفَ وقد قالَ بعضُ العلماءِ إن اللوحَ المحفوظَ فوقَ العرشِ لأنه لم يَرد نصٌّ صريحٌ بأنه فوق العرشِ ولا بأنه تحتَ العرشِ فبقي الأمرُ على الاحتمالِ أي احتمالِ أن اللوحَ المحفوظ فوقَ العرشِ واحتمالِ أنه تحتَ العرشِ، فَعَلى قولهِ إنهُ فوقَ العرشِ يكون جعلَ اللوحَ المحفوظَ معادِلا لله أي أن يكونَ الله بمحاذاةِ قسمٍ منَ العرشِ واللوحُ بمحاذاةِ قسمٍ مِنَ العرش وهذا تشبيهٌ لهُ بخلقِهِ لأن محاذاةَ شىءٍ لشىءٍ مِن صفاتِ المخلوقِ. ومما يدل على أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقيةً حقيقيةً لا تحتمل التأويل الحديث الذي رواه النسائيُّ في السنن الكبرى: “إنَّ الله كتَب كتابًا قبل أن يخلُقَ السموات والأرض بألفي سنة فهوَ عندَهُ على العرشِ وإنه أنزلَ من ذلك الكتاب ءايتين ختم بهما سورة البقرةِ”، وفي لفظ لمسلم: “فهو موضوعٌ عندهُ” فهذا صريحٌ في أنَّ ذلكَ الكتاب فوقَ العرشِ فوقيةً حقيقيةً لا تحتَمِلُ التأويلَ.
وكلمةُ “عندَ” للتشريفِ ليسَ لإثباتِ تحيزِ الله فوقَ العرشِ لأنَّ “عندَ” تُستعمَلُ لغيرِ المكانِ قالَ الله تعالى: [سورة هود] إنّما تدلُّ “عندَ” هنا أنَّ ذلكَ بعلمِ الله وليسَ المعنى أنَّ تلكَ الحجارة مجاورةٌ لله تعالى في المكَان. فمَن يحتجُّ بمجرّدِ كلمةِ عند لإثباتِ المكانِ والتَّقارُبِ بينَ الله وبينَ خلقِهِ فهوَ من أجهَل الجاهلينَ، وهل يقولُ عاقلٌ إنَّ تلكَ الحجارةَ التي أنزلها الله على أولئكَ الكفرةِ نَزَلَت مِنَ العرشِ إليهم وكانت مكوّمَةً بمكان في جنبِ الله فوقَ العرشِ على زعمِهم.
الشرح: حديثُ الجاريةِ مضطربٌ سندًا ومتنًا لا يصحُّ عن رسول الله، ولا يليقُ برسولِ الله أن يقالَ عنه إنه حَكَمَ على الجاريةِ السّوداءِ بالإسلامِ لمجردِ قولها الله في السماء، فإن من أراد الدخولَ في الإسلام يدخل فيه بالنّطق بالشّهادتين وليسَ بقول الله في السماء. أما المشبّهةُ فقد حملوا حديثَ الجاريةِ على غيرِ مرادِ الرسول. والمعنى الحقيقيُّ لهذا الحديث عند من اعتبره صحيحًا لا يخالفُ تنزيهَ الله عن المكانِ والحدّ والأعضاءِ. وقد ورَد هذا الحديث بعدَّةِ ألفاظٍ منها أن رجلًا جاء فقال: يا رسول الله إن لي جاريةً ترعى لي غنمًا فجاءَ ذاتَ يومٍ ذئبٌ فأكلَ شاةً فغضبتُ فَصَكَكتُهَا _ أي ضربتها على وجهها _ قال: أريدُ أن أُعتقها إن كانت مؤمنةً فقال: “ائتني بها”، فَأتى بها فقال لها الرسول: “أين الله”، ومعناه ما اعتقادُكِ في الله من التَّعظيم ومن العلوّ ورِفعَةِ القَدرِ، لأن أينَ تأتي للسؤالِ عن المكانِ وهو الأكثرُ وتأتي للسّؤالِ عن القَدْرِ.
وأما قولُ الجارية: “في السماء”، وفي روايةٍ: “فأشارت إلى السماء”، أرادت به أنه رفيعُ القَدرِ جدًّا، وقد فَهِمَ الرسولُ ذلكَ من كلامها أي على تقدير صحة تلك الرواية. أي هذا عند من صحح هذا الحديث من أهل السنة.
ونقولُ للمشبهة: لو كانَ الأمرُ كما تدَّعونَ من حَملِ ءاية ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى {5}﴾ [سورة طه] على ظاهرِها وحملِ حديثِ الجاريةِ على ظاهرِهِ لتناقَضَ القرءانُ بعضُهُ مع بعضٍ والحديثُ بعضُه مع بعضٍ، فما تقولون في قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {115}﴾ [سورة البقرة] فإما أن تجعلوا القرءانَ مناقضًا بعضُه لبعضٍ والحديثَ مناقضًا بعضُهُ لبعضٍ فهذا اعترافٌ بكفركم لأن القرءانَ يُنزَّهُ عن المناقضةِ وحديثُ الرسول كذلك، وإن أوَّلتم ءاية ولم تأوّلوا ءايةَ الاستواءِ فهذا تحكُّمٌ أي قولٌ بلا دليلٍ. ومن حديثِ الجاريةِ الذي مرَّ ذكرهُ يُعلَم أن الشخصَ إذا قالَ: “الله في السماء” وقَصَدَ أنه عالي القدرِ جدًّا لا يكفَّرُ لأن هذا حاله مثلُ حالِ الجارية السَّوداءِ أي على تقدير صحة تلك الرواية، أما إذا قالَ الله موجودٌ بذاتِهِ في السماءِ هذا فيه إثباتُ التَّحيزِ وهو كُفرٌ.
وحديث الجارية فيه معارضة للحديث المتواتر: “أمرتُ أن أُقَاتِلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله”. وهو من أصحّ الصحيحِ، ووجهُ المعارضَةِ أن حديثَ الجاريةِ فيه الاكتفاءُ بقول “الله في السماء” للحكم على قائله بالإسلام، وحديث ابن عمر رضي الله عنه: “حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله” فيه التصريحُ بأنه لا بُدَّ للدخولِ في الإسلام من النطقِ بالشهادتين، فحديث الجارية لا يقوى لمقاومة هذا الحديث لأن فيه اضطرابًا في روايته ولأنه مما انفرد مسلم به. وكذلك هناكَ عدة أحاديث صحاحٌ لا اختلافَ فيها ولا علة تناقضُ حديثَ الجارية فكيف يؤخذ بظاهرِهِ ويُعرضُ عن تلك الأحاديثِ الصّحاح، فلولا أن المشبهةَ لها هوًى في تجسيمِ الله وتحييزه في السماءِ كما هو معتقدُ اليهودِ والنصارى لما تشبَّثوا به ولذلك يَرَونَهُ أقوى شبهة يجتذبونَ به ضعفاءَ الفَهم إلى عقيدتهم عقيدةِ التجسيم، فكيف يَخفى على ذي لبّ أن عقيدةَ تحيزِ الله في السماء منافيةٌ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ {11}﴾ ، فإنه على ذلك يلزمُ أن يكونَ لله أمثالٌ كثيرٌ فالسموات السبعُ مشحونةٌ بالملائكة وما فوقها فيها ملائكةٌ حافون من حول العرش لا يعلمُ عددَهم إلا الله وفوقَ العرشِ ذلك الكتابُ الذي كُتِبَ فيه: “إن رحمتي سَبَقَت غضبي”، فباعتقادهم هذا أثبتوا لله أمثالا لا تُحصى فتبينَ بذلك أنهم مخالفون لهذه الآية.
ولا يَسلم من إثباتِ الأمثالِ لله إلا من نَزَّهَ الله عن التحيّز في المكانِ والجهةِ مطلقًا.
قال المؤلف رحمه الله: وقَد رَوى البُخَارِيُّ أنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: “إِذَا كَانَ أحَدُكُم في صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْصُقَنَّ في قِبْلَتِهِ ولا عَنْ يَمِيْنِهِ فَإنَّ رَبَّه بَيْنَه وبَيْنَ قِبْلَتِهِ”، وهذا الحديثُ أقْوى إسْنادًا منْ حَدِيثِ الجَارِيَةِ.
الشرح: مناجاةُ الله معناه الإقبالُ على الله بدعائِهِ وتمجيدِهِ، والمعنى أن المصلّي تجرَّدَ لمخاطبة ربّه انقطعَ عن مخاطبةِ الناسِ لمخاطبة الله، فليس من الأدبِ مع الله أن يَبصُقَ أمامَ وجهِهِ، وليس معناهُ أن الله هو بذاتِهِ تِلقَاءَ وجهِهِ.
وأما قولُهُ عليه الصلاة والسلام: “فإن ربَّهُ بينَهُ وبين قِبلَتِهِ”، أي رحمةُ ربّه أمامَهُ، أي الرحمة الخاصة التي تنزلُ على المصلين.
قال المؤلف رحمه الله: وأَخْرَجَ البُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبي مُوسَى الأشْعَرِيِّ أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: “ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم فإنَّكُم لا تَدْعُوْنَ أصَمَّ ولا غَائِبًا، إنكم تَدْعُونَ سَمِيْعًا قَرِيبًا، والذي تدعونَهُ أقْربُ إلى أحَدِكُم مِن عُنُقِ رَاحِلَةِ أحدِكُم”.
الشرح: هذا الحديثُ يُستفادُ منه فوائدُ منها أن الاجتماعَ على ذِكرِ الله كان في زمنِ الصّحابةِ، فقد كانوا في سفرٍ فوصلوا إلى وادي خيبر فصاروا يُهلّلونَ ويُكبّرونَ بصوتٍ مرتفعٍ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقةً عليهم: “اربَعُوا على أنفسكم” أي هَوّنوا على أنفسكم ولا تُجهدوها برفعِ الصّوتِ كثيرًا، “فإنكم لا تدعونَ أصمَّ ولا غائبًا” أي الله تعالى يسمعُ بسمعِهِ الأزليّ كلَّ المسموعاتِ قويةً كانت أم ضعيفةً في أي مكانٍ كانت، وأما قوله “ولا غائبًا” فمعناه أنه لا يخفى عليه شىء، وقوله: “إنكم تدعون سميعًا قريبًا والذي تدعونَهُ أقربُ إلى أحدِكم من عنقِ رَاحلةِ أحدكم”، ليس معناهُ القربَ بالمسافة لأن ذلك مستحيلٌ على الله فالعرشُ والفرشُ الذي هو أسفلُ العالم بالنّسبة إلى ذاتِ الله على حدّ سواءٍ ليس أحدُهما أقربَ من الآخر إلى الله بالمسافة، وإنما معناه أن الله أعلمُ بالعبد من نفسه وأن الله مطَّلعٌ على أحوالِ عباده لا يخفى عليه شىء.
ثم إنه يلزمُ على ما ذهبتم إليه من حَملِ النصوص التي ظاهرها أن الله متحيزٌ في جهة فوق على ظاهرها كونُ الله تعالى غائبًا لا قريبًا لأن بين العرشِ وبين المؤمنين الذين يذكرونَ الله في الأرض مسافةً تقرُبُ من مسيرةِ خمسين ألف سنة وفي خلال هذه المسافة أجرامٌ صلبةٌ وهي أجرامُ السموات وجِرمُ الكرسي، فلا يصحُّ على مُوجَبِ معتقدكم قول رسولِ الله إنه قريبٌ بل يكون غائبًا، أما على قولِ أهل السنة فكونه قريبًا لا إشكالَ فيه، فما أشدَّ فسادَ عقيدةٍ تؤدّي إلى هذا.
قال المؤلف رحمه الله: فَيقالُ للمعتَرِضِ: إذَا أخَذْتَ حَدِيثَ الجَارِيَةِ علَى ظَاهِره وهذين الحدِيثَينِ عَلى ظَاهِرهما لَبَطَلَ زَعْمُكَ أنَّ الله في السَّماءِ وإنْ أوَّلْتَ هذين الحَدِيثَيْنِ ولَم تُؤَوِّلْ حَدِيثَ الجَارِيَةِ فَهَذَا تَحكُّمٌ _ أي قَوْلٌ بِلا دَلِيل _، ويَصْدُقُ عَلَيْكَ قَولُ الله في اليَهُودِ ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ {85}﴾ [سورة البقرة]. وكَذَلِكَ مَاذا تَقُولُ في قَولِه تَعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ {115}﴾ [سورة البقرة] فَإنْ أَوَّلْتَه فَلِمَ لا تُؤَوّلُ حَدِيثَ الجاريةِ. وقَد جَاءَ في تَفسِيرِ هَذِهِ الآيةِ عنْ مُجاهِدٍ تِلميذِ ابنِ عَبَّاسٍ: “قِبْلَةُ الله”، فَفَسَّرَ الوَجْهَ بِالْقِبْلَةِ، أيْ لِصَلاةِ النَّفْلِ في السَّفَرِ عَلى الرَّاحِلَةِ.
الشرح: معنى فثمَّ وجهُ الله أي فهناكَ قبلةُ الله أي أن الله تعالى رخَّصَ لكم في صلاةِ النفلِ في السَّفر أن تتوجَّهوا إلى الجهةِ التي تذهبون إليها هذا لمن هو راكبٌ الدابة، وفي بعض المذاهبِ حتى الماشي الذي يصلي صلاةَ النفل وهو في طريقه يقرأ الفاتحةَ.
قال المؤلف رحمه الله: وأَمَّا الحَدِيثُ الذِي رَواهُ التّرْمذِيُّ وهُوَ: “الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُم الرحمن ارْحَمُوا مَنْ في الأرْضِ يَرْحَمْكُم منْ في السَّمَاءِ”، وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى “يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ”، فَهَذِهِ الرّوَايَةُ تُفَسّرُ الرّوايَةَ الأُوْلَى لأنَّ خَير مَا يُفسَّرُ بهِ الحَدِيْثُ الوارِدُ بالواردِ كَما قَالَ الحَافِظُ العِراقيُّ في ألفِيَّتِهِ: وخيرُ ما فسّرتَه بالواردِ. ثمّ المرادُ بأهْلِ السَّماءِ المَلائِكةُ، ذَكَرَ ذلكَ الحَافِظُ العِراقيُّ في أمَالِيّه عَقِيبَ هَذَا الحدِيثِ، ونص عبارته: وَاسْتدلَّ بقَوْلِه: “أَهْلُ السَّمَاءِ” عَلَى أنَّ المُرَادَ بِقَوله تعالى في الآية: ﴿ءأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء {16}﴾ الملائِكَةُ” اهـ، لأنه لا يقال لله “أَهْلُ السَّمَاءِ”. و”مَنْ” تَصلُح للمُفرَد وللجَمْع فلا حجّةَ لهم في الآية، ويقال مثلُ ذلك في الآيةِ التي تَليْها وهي: ﴿أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا {17}﴾ فـ “مَن” في هذه الآيةِ أيضًا أهلُ السماءِ، فإن الله يسلطُ على الكفارِ الملائكة إذا أرادَ أن يُحِل عليهم عقوبَتَه في الدنيا كما أنهم في الآخرةِ هم الموكلونَ بتسليطِ العقوبةِ على الكفارِ لأنهم خزنَةُ جهنم وهم يَجرُّونَ عنُقًا من جهنمَ إلى الموقفِ ليرتاعَ الكفارُ برؤيتهِ. وتلكَ الروايةُ التي أوردَها الحافظُ العراقيُّ في أماليّه هكذا لفظُها: “الراحمونَ يرحمهُم الرحيمُ ارحموا أهلَ الأرضِ يرحَمْكُم أهلُ السماءِ”.
الشرح: روايةُ “أهلُ السماء” إسنادُها حسنٌ، ولا يجوز أن يقال عن الله أهلُ السماء فتُحمَل روايةُ “من في السماء” على أن المراد بها أهلُ السماء أي الملائكةُ، وكذلك يُحمَلُ قولُه تعالى: ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ {16}﴾ [سورة الملك] على الملائكة، ومعروفٌ في النَّحو إفرادُ ضميرِ الجمعِ قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ {25}﴾ [سورة الأنعام] وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ {42}﴾ [سورة يونس] وقال تعالى: ﴿وَمِنهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ {43}﴾ [سورة يونس]، فالذي يُفسّر ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ {16}﴾ أي على السماء، نقول له: إن قلتَ الله في السماء أي على السماء فالجواب: العلوُّ يأتي للعلوّ الحسّي والعلوّ المعنويّ فإن أردتَ العلوَّ المعنويَّ أي رفيعَ القدر جدًّا فلا بأس، وإن أردتَ العلوَّ الحسّي فقد كفرتَ لأنَّ الذي يكونُ في جهةٍ يكونُ محدودًا والمحدودُ بحاجةٍ لمن حدَّهُ بهذا الحدّ والمحتاجُ إلى شىءٍ لا يكون إلهًا.
ويُردُّ عليهم بإيراد الآية: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللهُ {68}﴾ [سورة الزمر] فيقال لهم: هل تزعمون أن الله يُصعَقُ، وكذا يُردُّ عليهم بإيراد الآية: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ {104}﴾ [سورة الأنبياء].
وأما قولُهُ عليه السلام: “ارحموا من في الأرض” معناه بإرشادِهم إلى الخيرِ بتعليمِهِم أمورَ الدّينِ الضّروريّة التي هي سببٌ لإنقاذهم من النّار وبإطعامِ جائعِهِم وكِسوةِ عاريهم ونحوِ ذلك. وأما قوله عليه السلام: “يرحمكم أهل السماء”، فأهلُ السماء هم الملائكةُ وهم يرحمون من في الأرض أي أن الله يأمُرُهُم بأن يستغفروا للمؤمنين، ويُنزِلون لهم المطرَ ويَنفحونهم بنفحاتِ خيرٍ ويُمِدُّونهم بمددِ خيرٍ وبركةٍ، ويحفظونهم على حسبِ ما يأمُرُهُم الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله: ثُمّ لَو كَانَ الله سَاكِنَ السَّمَاءِ كَما يَزْعمُ البَعْضُ لَكانَ الله يُزَاحِمُ الملائِكةَ وهَذا مُحالٌ، فَقَد ثَبَتَ حَديثُ أنّه: “ما في السموات مَوْضِعُ أَرْبَعِ أصَابِعَ إِلا وفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أوْ رَاكِعٌ أو سَاجِدٌ”.
الشرح: هذا الحديثُ رواه التّرمذيُّ وفيه دليلٌ على أنه يستحيلُ على الله أن يكونَ ساكنَ السماء وإلا لكانَ مساويًا للملائكةِ مزاحمًا لهم.
قال المؤلف رحمه الله: وكَذَلِكَ الحَديثُ الذي رَواهُ البُخَاريُّ ومُسْلِمٌ عَن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ أنَّ الرّسولَ صلى الله عليه وسلم قال: “ألا تأْمَنُوني وأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِ يَأْتيني خَبرُ مَن في السَّمَاءِ صَبَاحَ مَسَاءَ” فالمقْصُودُ بِه الملائِكةُ أَيضًا، وإِنْ أُرِيد بِه الله فَمعْنَاهُ الذي هُوَ رَفِيعُ القَدْرِ جدًّا.
الشرح: قوله: “وأنا أمينُ من في السماء” أي مؤتَمَنٌ مُصَدَّقٌ عند الملائكةِ، ومعناه يعتقدون أنه أمينٌ صادقٌ في إبلاغِ الوحي.
قال المؤلف رحمه الله: وأَمَّا حَدِيْثُ زَيْنبَ بنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النّبي صلى الله عليه وسلم أنَّها كَانَت تقُولُ لنساءِ الرسولِ: “زَوّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي الله منْ فَوقِ سَبْعِ سَمواتٍ” فَمعْنَاهُ أَنَّ تَزوّجَ النّبيّ بِها مُسَجَّلٌ في اللّوحِ المحفُوظِ وهذه كتابةٌ خاصةٌ بزينبَ ليست الكتابة العامة، الكتابةُ العامةُ لكلّ شخصٍ فكلُّ زواجٍ يحصلُ إلى نهايةِ الدنيا مسجلٌ، واللّوحُ فَوقَ السموات السَّبْعِ.
الشرح: هذا الحديثُ رواه البخاريُّ والبيهقيُّ وفيه بيانُ أن زينبَ تزوَّجها النّبيُّ بالوحي من غير وليّ وشاهدين.
قال المؤلف رحمه الله: وأَمَّا الحَدِيثُ الذي فِيه: “والذي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ فَتَأْبى عَلَيْه إلا كَانَ الذي في السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا…” الحدِيث، فَيُحمَلُ أيضًا عَلى الملائِكةِ بدَلِيلِ الرّوَايَةِ الثّانِيةِ الصَّحِيحَةِ وَالتي هِي أَشْهَرُ مِنْ هَذِهِ وَهي: “لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتى تُصْبِحَ”، رَوَاهَا ابن حبّان وغيرُه.
الشرح: الرّوايةُ الأولى رواها البخاريُّ ومسلمٌ ويُفهَمُ منها أن المرأة إذا لم يكن لها عذرٌ شرعيٌّ كالحيضِ والنّفاسِ أو كانت مريضةً يضرُّها الجماعُ لا يجوز لها أن تمنَعَ زوجَها من مجامعتها متى ما أرادَ وإلا كانت فاسقةً ملعونةً مسخوطًا عليها من الملائكة.
قال المؤلف رحمه الله: وأَمَّا حَدِيثُ أَبي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: “رَبَّنَا الذي في السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ” فَلَم يَصِحَّ بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ كَمَا حَكَم عَلَيْهِ الحافظ ابنُ الجَوْزِيّ، وَلَوْ صَحَّ فَأَمرُهُ كما مَرَّ في حَدِيثِ الجارِيَةِ.
الشرح: هذا الحديثُ رواه أبو داودَ ولو صحَّ لكانَ معناهُ الذي هو رفيعُ القدرِ جدًّا.
قال المؤلف رحمه الله: وأمَّا حَدِيثُ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ الله عَلى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمواتِه، وسَمواتُه فَوْقَ أَرَاضِيْهِ مِثْلَ القُبّةِ” فَلَم يُدْخِلْهُ البُخَارِيّ في الصَّحِيحِ فَلا حُجَّةَ فِيهِ، وَفي إسْنادِهِ مَنْ هُوَ ضَعِيفٌ لا يُحْتَجُّ بِه، ذَكَرَه ابنُ الجَوْزِيّ وغَيْرُهُ.
وكَذَلِكَ مَا رَواهُ في كتَابه “خَلْقُ أَفْعَالِ العِبَادِ” عَن ابنِ عَبّاسٍ أنّهُ قالَ: “لمّا كَلَّم الله مُوسَى كانَ نِدَاؤهُ في السَّمَاءِ وكَانَ الله في السَّماءِ”، فَهُوَ غَيرُ ثَابِتٍ فَلا يُحتَجُّ بِه”.
وأَمَّا القَوْلُ المَنْسُوبُ لِمَالكٍ وهُو قَولُ: “الله في السَّمَاءِ وعِلْمُه في كُلّ مَكَانٍ لا يَخْلُو مِنْهُ شَىء” فَهُو غَيْرُ ثَابتٍ أَيْضًا عَن مَالِكٍ غَيْرُ مُسْنَدٍ عَنْه، وأَبُو دَاودَ لم يُسنِده إليه بالإسناد الصحيح بل ذكره في كتابِهِ المَراسِيلُ، ومُجَرَّدُ الرّوَايَةِ لا يَكُونُ إثْبَاتًا.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة