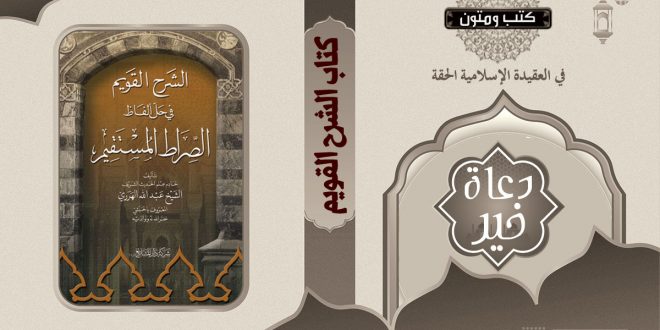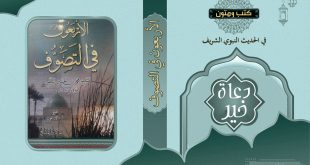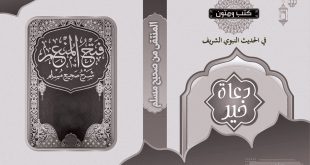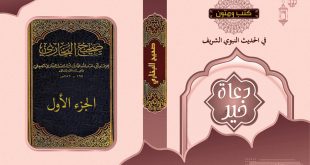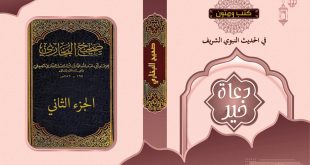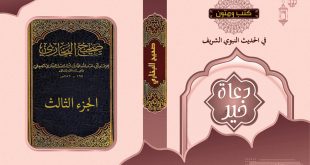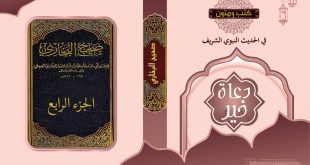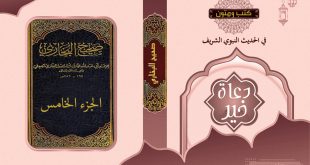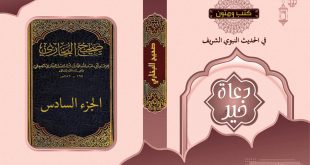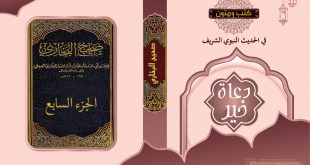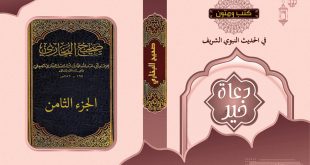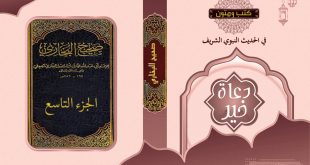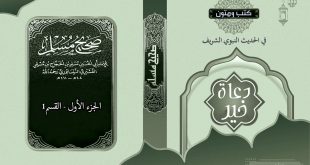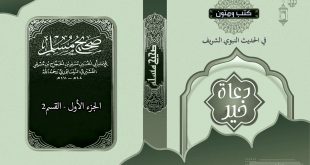بيانُ أقسامِ الكفرِ
واعلم يا أخي المسلم أن هناكَ اعتقاداتٍ وأفعالا وأقوالا تنقضُ الشهادتين وتوقِعُ في الكفرِ لأن الكفرَ ثلاثةُ أنواع: كفرٌ اعتقاديٌّ وكفرٌ فعليٌّ وكفرٌ لفظيٌّ،
وذلك باتفاقِ المذاهبِ الأربعة كالنووي وابن المُقري من الشافعيةِ وابن عابدين من الحنفيةِ والبُهُوتي من الحنابلةِ والشيخ محمد عِلَّيش من المالكيةِ وغيرِهم فلينظرها من شاءَ. وكذلك غيرُ علماءِ المذاهبِ الأربعةِ من المجتهدينَ الماضينَ كالأوزاعيّ فإنه كان مجتهدًا له مذهبٌ كان يُعْمَلُ به ثم انقرضَ أتباعُهُ.
الشرح: أن مما استدَل به أهلُ الحق على أن الكفرَ ثلاثةُ أقسامٍ ءايات منها قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ {74}﴾ [سورة التوبة] فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قوليٌّ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا {15}﴾ [سورة الحجرات] فهذه الآية يُفهم منها أن الكفرَ منه اعتقاديٌّ لأن الارتيابَ أي الشك يكونُ بالقلبِ، وقوله تعالى: ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ {37}﴾ [سورة فصلت] يُفهم منه أن الكفرَ منه فعليٌّ، وهذه المسئلةُ إجماعيةٌ اتفقَ عليها علماءُ المذاهبِ الأربعةِ.
وكلٌّ من الثلاثةِ كفرٌ بمفردِهِ فالكفرُ القوليُّ كفرٌ ولو لم يقترن به اعتقادٌ ولا فعلٌ، والكفرُ الفِعليُّ كفرٌ ولو لم يقترن به اعتقادٌ وانشراحُ الصّدر به ولا قول، والكفرُ الاعتقادي كفرٌ ولو لم يقترن به قولٌ ولا فعلٌ. وإنما يُشترطُ للقولِ الكفري انشراحُ الصدرِ في المُكرَهِ على قولِ الكفرِ بالقتلِ ونحوِهِ. فالمكرهُ هو الذي لا يكفُرُ لِمجردِ القول بعد أن أكره إلا أن يشرحَ صدرَه بما يقولُه فعندئذٍ يكفرُ، لأن المسلمَ المكره على قولِ الكفرِ إن قال كلمة الكفر لإنقاذِ نفسه مما هددَهُ به الكفارُ وقلبهُ غير منشرح بما يقوله فلا يُحكَمُ بكفرِهِ، وأما إن تغيَّر خاطرهُ بعد الإكراهِ فشرحَ صدرَهُ بقولِ الكفر كفر، وهذا معنى قول الله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {106}﴾ [سورة النحل] فألغى هذا الحكم الشّرعي الذي اتفقَ عليه علماءُ الإسلامِ وجاءت به هذه الآية أشخاصٌ من أهلِ هذا العصر أحدهم سيد سابق في كتابه فقه السُّنة وحسن قاطرجي وشخص من ءال هضيبي في كتابٍ سماه “دعاة لا قضاة” وشخص سوريٌّ من ءال الإدلبي. فليحذر هؤلاء فهؤلاء حرَّفوا شرعَ الله وخالفوا حكَّامَ المسلمين من الخلفاءِ ونوّابِهم فإنهم لم يكونوا يقولون الشخص الذي تكلمَ بكلمةِ الكفرِ والردةِ عند تقديمه إليهم للحكمِ عليه هل كنتَ شارحًا صدركَ بما قلتَ من قول الكفرِ بل كانوا يجرونَ عليه حكمَ الرّدة بمجرّدِ اعترافه أو شهادةِ شاهدين عليه بأنه قال كلمة كذا من الكفر. وهذه كتبُ التواريخ الإسلامية تشهَدُ بذلك في الوقائع التي ذكرت فيها كواقعةِ قتل الحلاج فإنه أُصدرَ عليه حكمُ الردة لقوله أنا الحقُّ أي أنا الله ونحوِ ذلك من كلمات الرّدة، فأصدرَ القاضي أبو عمر المالكي في بغداد أيام الخليفة المُقتَدر بالله حكمًا عليه فقطعت يداهُ ورجلاهُ ثم قطعت رقبته ثم أُحرقت جثتهُ ثم ذُرَّ رمادُهُ في دِجلة، وهذا التشديدُ عليه ليرتدعَ أتباعه لأنه كان له أتباع عُرفوا بالحلّاجيّةِ. وكان الإمامُ الجنيدُ رضي الله عنه سيدُ الطائفة الصوفية تَفَرَّسَ فيه بما ءَالَ إليه أمرُه لأنه قال للحلّاج: “لقد فَتَحتَ في الإسلامِ ثُغرةً لا يَسُدُّها إلا رأسُك”.
وجهلة المتصوفةِ خالفوا سيدَ الصوفية الجنيد فصاروا يهَوّنون أمرَ النطق بكلمات الردة ممن ينتسب إلى التصوّف فلا يكفّرون أحدًا منهم لقولِ أنا الله أو أنا الحقُّ، أو قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمُ جميعَ ما يعلمه الله، أو إن الله يَحُل في الأشخاصِ، أو إن الله كان واحدًا ثم صار كثيرًا فيزعمون أن العالمَ أجزاءٌ منَ الله.
أما الصوفيةُ الحقيقيونَ فهم بريئونَ منهم، فهؤلاءِ في وادٍ وأولئكَ في وادٍ ءاخر. بل قال الإمام الجنيد رضي الله عنه: لو كنت حاكمًا لضربت عنق من سمعته يقول لا موجود إلا الله.
ومن شأن هؤلاءِ أعني جهلة المتصوفة أن يقولوا إذا نُقلَ عن أحدِهم كلمة كفر “يؤوَّل” ولو كانت مما لا يقبل التأويل وهؤلاء من أبعدِ خلق الله عن علم الدين، فإن علماءَ الإسلام متفقونَ على أن التأويلَ البعيدَ لا يُقبل إنما التأويلُ يُقبَلُ إذا كان قريبًا قال ذلك الإمامُ الكبير حَبيبُ بنُ رَبيع المالكيُّ وإمام الحرمين الشافعيُّ والشيخ الإمام تقيُّ الدّين السُّبكي، ونُقِلَ معنى هذا عن الإمام محمدِ بن الحسن الشيباني صاحبِ أبي حنيفة.
بيان: هذه الكلمة لا موجود إلا الله أحدَثَها ملاحدةُ المتصوّفةِ الذين يعتقدونَ وَحدَةَ الوجودِ ثم بعضُ العوام من المسلمين صاروا يقولونها من غير فهمٍ لمعناها ويظنونَ أن معناها أن الله هو المسيطرُ على كل شىء فهؤلاءِ لا يكفرون لأنهم يقولونها ولا يفهمون معناها الكفري. وأمثالُ هذا كثيرٌ منها قولُ بعض الملاحدةِ عن الله هو الكُلُّ، وقولهم ما في الوجودِ إلا الله، عَصمَنا الله من ذلك. وهذه الكلمة لا موجود إلا الله وقول ما في الوجود إلا الله وأمثالهما كانت في الفلاسفة اليونانيين. كانوا يرون أن جملة العالم هو الله بما فيه من ذوي الروح والجماد حتى قال بعض الشاذلية اليشرطية لبعض الناس الذين حضروا مجالسهم أنت الله وهذا الجدار الله.
الكفرُ الاعتقاديُِّ
قال المؤلف رحمه الله: الكفرُ الاعتقاديُّ مكانُهُ القلبُ كنفيِ صفةٍ من صفاتِ الله تعالى الواجبةِ له إجماعًا كوجودهِ وكونهِ قادرًا وكونهِ سميعًا بصيرًا أو اعتقادِ أنه نورٌ بمعنى الضوءِ أو أنه روحٌ، قال الشيخُ عبدُ الغنيّ النابلسيّ: مَن اعتقدَ أن الله ملأ السموات والأرضَ أو أنه جسمٌ قاعدٌ فوقَ العرشِ فهو كافرٌ وإن زعمَ أنه مسلمٌ.
الشرح: أنَّ من نَفَى وجودَ الله بقلبه فهو كافرٌ، وكذلكَ من اعتقد أن الله غير قادر على كل شىء أو شكَّ في قدرته على كل شىء. فلا يُعذرُ أحدٌ في الجهل بقدرة الله ونحوها من صفاته مهما بلغَ الجهلُ بصاحبه. وأما إذا قالَ قائلٌ الله نور فلا يُعترضُ عليه إلا إذا كان يعتقد أنه نورٌ بمعنى الضوء عندئذ يكفر، أما إذا قال الله نور ولم يُفهم ماذا يقصد فلا يكفّر، ولا يُقال له حرام أن تقولَ هذا لأنه وَرَدَ في تَعدَادِ أسماءِ الله الحسنى عند البيهقي وغيرِه.
وكذلك وَرَدَ في بعض روايات تَعْدَادِ أسماءِ الله المُنير وهو تفسيرٌ لاسم الله النّور.
الكفرُ الفعليُّ
قال المؤلف رحمه الله: الكفرُ الفعليُّ: كإلقاءِ المصحفِ في القاذوراتِ قال ابنُ عابدينَ: ولو لم يقصد الاستخفافَ، لأن فعلَه يدلُّ على الاستخفافِ. أو أوراقِ العلومِ الشرعيةِ، أو أيّ ورقةٍ عليها اسمٌ من أسماءِ الله تعالى معَ العلمِ بوجودِ الاسمِ فيها.
الشرح: قالَ بعض العلماء: إذا رمى اسمَ الله في القاذورات على وجهِ الاستخفافِ كفرَ، أما إذا لم يكن على وجهِ الاستخفافِ فلا يكون ردّةً وهذا في غير المصحفِ فإنَّ رَميه في القاذوراتِ كفرٌ لأنه يدُلُّ على الاستخفافِ، وقال المالكيةُ في كتبهم تركُ ورقة في القاذورات مكتوبٌ فيها قرءانٌ استخفافًا ردةٌ وكفرٌ، أما الذي يتركها ليس للاستخفاف بها بل يعتقد أن لها حُرمة لكن تركها تكاسلًا فإنه لا يكفر ولكنه أَثِم إثمًا كبيرًا، وهذا الذي قاله المالكيةُ يوافقُ عليه سائرُ أهل المذاهب الأخرى لكنّ المالكية نصوا عليه أمَّا الآخرونَ فلم ينصُّوا عليه فيما أعْلَمُ لكن قواعدُهم توافقُ على ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: ومن عَلَّقَ شِعَارَ الكفرِ على نفسِهِ من غير ضرورةٍ فإن كان بنيةِ التبرّكِ أو التّعظيمِ أو الاستحلالِ كان مُرتدًّا.
الشرح: أما إن عَلَّقَهُ لا بنيةِ إحدى هذه المذكورات فلا يكفرُ لكنه أَثِمَ إثمًا كبيرًا.
الكفرُ القوليُّ
قال المؤلف رحمه الله: الكفرُ القوليُّ: كمن يشتم الله تعالى بقوله والعياذُ بالله من الكفر: أختَ ربك، أو ابنَ الله، يقعُ الكفر هنا ولو لم يعتقد أن لله أختًا أو ابنًا.
الشرح: ويدلُّ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “قال الله تعالى: شتمني ابنُ ءادمَ ولم يكن لهُ ذلكَ” وفَسّرَ ذلك بقوله: “وأما شتمُهُ إيّاي فقَولُه: اتخَذَ الله وَلدًا” رواه البخاري.
قال المؤلف رحمه الله: ولو نادى مسلمٌ مسلمًا ءاخرَ بقوله: يا كافرُ بلا تأويلٍ كفرَ القائلُ لأنه سمّى الإسلامَ كفرًا.
الشرح: يَدُلُّ على ذلك ما رواه البخاريُّ في الصحيح وغيرُه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: “من رمى مُسلمًا بالكفر أو قال عَدُوَّ الله إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال”، وفي لفظ لهذا الحديث: “إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدُهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه”، فقد حَذَّرنا رسولُ الله في هذا الحديث من أن نقولَ لمسلم: كافر، أو عدوَّ الله، وبيّن لنا أن من قال ذلك لمسلم يعود عليه وبَالُ هذه الكلمة، أما من قالَ لمسلم يا عدو الله أو أنت عدو الله بسببٍ شرعي فليس عليه حَرَجٌ، أي ليس فيه معصية. وإن كانَ قالَ له ذلك متأوّلا بنوع تأويل فلا يكفر، والتأويلُ معناه أنه اعتمدَ على سببٍ في ذلك الشخص ظنّه مخرجًا من الإسلام وهو في الحقيقة ليس مُخرجًا من الإسلام، وكان له في ذلك نوعُ شُبهة أي التباسٍ فإن المكفّر هنا لا يكفر كما أن المكفَّر لم يكفر، ومثالُ ذلكَ رجلٌ بلغه أن فلانًا انتحرَ فقال ماتَ كافرًا والعياذ بالله، فهذا المكفّر إن كان جاهلًا يظن أن الانتحارَ وحدَهُ كفرٌ ولا يعرفُ أن الانتحارَ بمجردِهِ ليس كفرًا لم يكفر لأن له تأويلًا.
ومن التأويلِ أيضًا أن يفعل هذا المسلم فِعلًا يشبهُ فِعلَ الكفارِ فيظُن به أنه لا يحب الإسلام أو لا يعتقدُ الإسلام فكفَّرَه بناءً على هذا الظن، لما رأى منه من فعلٍ خبيثٍ أو قولٍ خبيثٍ.
ثم إنه يوجد مسئلةٌ نفيسة ينبغي بيانُها ألا وهي أنه لا يكفُر من لم يكفّر من وَقَعَ في بعض أنواع الكفر إنما يكفرُ من لم يكفّر من وَقَعَ في بعضِ الأنواعِ الأخرى من الكفر، لأن الكفرَ نوعان: نوعٌ ظاهرٌ ليس فيه خِلافٌ بأنه كفر بين الأئمة وبأن من فعله فقد كَفَرَ فمن لم يُكفر فاعله يكفر. فالكفرُ الذي من لم يكفّر صاحبه يكفرُ هو كسبّ الله أو الأنبياءِ أو احتقار دين الإسلامِ أو إنكارِ البعثِ بعد الموتِ أو الثوابِ أو العقابِ هذا من شكَّ في كفره يكفُرُ.
والنوعُ الآخَرُ هو الكفر الذي هو كفرٌ لكنه إذا إنسان لم يكفّر من حصلَ منه ذلك الكفر لا يكفر مع أن هذا كفرٌ كما أنّ ذاكَ كفرٌ لكنَّ من لم يكفر هذا الذي ارتكبَ نوعًا من أنواع الكفرِ لا يكفر، مثال ذلك: لو سبَّ شخصٌ عَزرائيل فإنه يكفرُ وأما من شكَّ في كفرهِ فلا يكفرُ إن لم يكن عن عنادٍ، لأنه يخفى على كثير من الناس كرامةُ عَزرائيل، أما من كان يعرف أنه كأولئك الكبار كجبريل وكان يعتقد أن الذي سبه يعرف ذلك ومع ذلك لم يكفره فإنه يكفر. وأمّا الذي يشُك في كفرِ ساب جبريل فيكفر فإنّ كُفرَ هذا لا يَخفى على العوامّ فضلًا عن الخواصّ.
فيُعلَمُ من هذا أن هذه الكلمة التي يردّدُها بعض الناسِ ليست قاعدة فانبذوها وحذّروا منها لأنه لا يصحُّ أن تقال، وهذه الكلمة هي: “من لم يكفّر كافرًا كَفَرَ”. هذه الكلمة لا تقال لأن الكفر نوعان نوع شأنه أنه من لم يكفّر فاعله يكفر ونوع لا يكفّر من تردّد هل هذا كفر أم لا. مثال ذلك ما تقدم أنه لو سبّ شخص عزرائيل فإنه يكفر وأما من شك في كفره فلا يكفر إن لم يكن عن عنادٍ، وأمّا الذي يشك في كفر ساب جبريل فيكفر فإنّ كفر هذا لا يخفى على العوام فضلًا عن الخواص. فالكفر الذي من لم يكفّر صاحبه يكفر هو كسبّ الله أو الأنبياء أو احتقار دين الإسلام أو إنكار البعث بعد الموت أو الثواب أو العقاب فإن هذا من شك في كفره يكفر.
قال المؤلف رحمه الله: ويكفرُ من يقولُ للمسلمِ يا يهوديُّ أو أمثَالها منَ العباراتِ بنيّةِ أنّه ليسَ بمسلمٍ إلا إذا قَصَدَ أنّه يشبهُ اليهودَ فلا يكفُر.
الشرح: إن كان هناك شىءٌ ظنَّ من أجله أنه كَفَرَ فقال له يا كافرُ لا نكفره كأن كانَ يراهُ يجالسُ الكفّارَ ويوادُّهم ويخالطُهم أو يوافِقُهم في كثيرٍ من أمورِهم فقال له أنتَ كافرٌ ظنًّا منه أنه يعتقد اعتقادهم أو أنه يستحسن دينهم.
قال المؤلف رحمه الله: ولو قالَ شخصٌ لزوجتِهِ (أنتِ أحبُّ إليَّ من الله) أو (أعبدُك) كفرَ إن كان يَفهم منها العبادةَ التي هي خاصّةٌ لله تعالى.
الشرح: هذا اللفظُ صريحٌ في الكفر لأنَّ الله يجبُ محبّته أكثر من كلّ شىء، فمن أحبَّ شيئًا أكثر من الله فقد كَفَرَ. وأما من قالَ لزوجته أعبدك وكان يَفهمُ منها أحبُّك محبَّةً شديدةً فهذا لا نكفّرهُ.
ما يستثنى من ألفاظ الكفرِ القولي
يُستثنَى من الكفرِ اللفظي: حالةُ سبقِ اللسانِ: أي أن يتكلمَ بشىءٍ من ذلكَ من غيرِ إرادةٍ بَل جَرى على لسانِه ولم يقصدْ أن يقولَه بالمَرَّةِ.
وحالةُ غيبوبةِ العَقل: أي عَدَمِ صَحو العقلِ.
وحالةُ الإكراه: فمن نطقَ بالكفرِ بلسانِه مُكرهًا بالقتل ونحوِه وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمانِ فلا يكفرُ قال تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ (106)﴾ الآية [سورة النحل].
حَالةُ الحكايةِ لكفرِ الغَير: فلا يَكفر الحاكي كُفْرَ غيره على غير وجه الرّضَى والاستحسانِ، ومستندُنا في استثناءِ مسئلةِ الحكايةِ قولُ الله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ (30)﴾ [سورة التوبة]، ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ (64)﴾[سورة المائدة].
ثم الحكايةُ المانِعَةُ لكفرِ حاكي الكفرِ إمّا أن تكونَ في أوّلِ الكلمةِ التي يحكيها عمّن تكلم بكفرٍ، أو بعدَ ذكره الكلمةَ عقبَها وقد كان ناويًا أن يأتي بأداةِ الحكايةِ قبلَ أن يقولَ كلمة الكفرِ، فلو قال: المسيحُ ابنُ الله قولُ النصارى، أو قالته النصارى فهي حكاية مانعةٌ للكفرِ عن الحاكي.
وحالةُ كونِ الشخصِ متأوّلا باجتهاده في فهمِ الشرع: فإنه لا يكفرُ المتأوّلُ إلا إذا كان تأوُّله في القطعيّات فأخطأ فإنّه لا يُعذَر كتأوُّل الذين قالوا بِقِدَم العالَم وأزليته كابن تيمية1 . وأما مثالُ من لا يكفر ممّن تأوَّل فهو كتأوُّل الذين منعوا الزكاةَ في عهدِ أبي بكر بأن الزكاةَ وجبَت في عهدِ الرسول لأن صلاتَهُ كانت عليهم سَكَنًا لهم وطُهرَةً ـ أي رحمةً وطمأنينة ـ وأن ذلك انقطعَ بموته فإنّ الصحابةَ لم يكفّروهم لذلك لأنّ هؤلاء فهموا من قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (103)﴾ [سورة التوبة] أن المرادَ من قوله خذ أي يا محمدُ الزكاةَ لتكون إذا دفعوها إليكَ سَكَنًا لهم، وأن هذا لا يحصلُ بعد وفاتِهِ فلا يجبُ عليهم دفعُهَا لأنه قد ماتَ وهو المأمورُ بأخذها منهم، ولم يفهموا أن الحكمَ عامٌّ في حالِ حياتهِ وبعد موتهِ وإنما قاتَلَهُم أبو بكرٍ كما قاتلَ المرتدينَ الذينَ اتبعُوا مسيلمةَ الكذاب في دعواهُ النُّبوَّةَ لأنه ما كان يُمكنهُ أن يأخذَ منهُم قَهْرًا بدونِ قتالٍ لأنهم كانوا ذَوِي قوة فاضطرَّ إلى القتالِ. وكذلك الذين فسّروا قول الله تعالى:﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (91)﴾ بأنّه تخييرٌ وليس تحريمًا للخمرِ فشربوها لأن عُمرَ ما كفّرهم وإنما قال: “اجلدوهم ثمانينَ ثمانينَ، ثم إن عادوا فاقتلُوهُم” اهـ. رواهُ ابنُ أبي شيبة2 .
إنَّما كفَّروا الآخرينَ الذين ارتدّوا عن الإسلامِ لتصديقهم لمسيلمةَ الكذَّاب الذي ادَّعى الرّسالةَ فمقاتلتُهم لهؤلاءِ الذين تأوّلوا منعَ الزكاةِ على هذا الوجهِ كان لأخذِ الحقّ الواجبِ عليهم في أموالهم، وذلك كقتالِ البُغاة فإنّهم لا يقاتلون لكفرِهم بل يقاتلونَ لردّهم إلى طاعةِ الخليفةِ، كالذين قاتلَهُم سيّدنا علي في الوقائعِ الثلاثِ: وقعةِ الجمل ووقعةِ صفين مع معاوية، ووقعةِ النَّهروان مع الخوارج، على أنَّ من الخوارجِ صنفًا هم كفَّارٌ حقيقةً فأولئكَ لهم حكمُهم الخاصُّ.
قالَ الحافظُ أبو زُرعة العِراقيُّ في نُكَتِهِ3 : “وقال شيخنا البُلقينيُّ: ينبغي أن يُقال بلا تأويلٍ ليَخرُجَ البغاةُ والخوارجُ الذين يستحلّونَ دماءَ أهلِ العَدْلِ وأموالَهُم ويعتقدونَ تحريمَ دمائِهم على أهلِ العَدْلِ، والذين أنكروا وجوبَ الزكاةِ عليهم بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالتّأويلِ فإنّ الصحابةَ رضي الله عنهم لم يكفّروهم” اهـ. وهذا شاهدٌ من منقولِ المذهبِ لمسئلةِ التّأويلِ بالاجتهادِ.
ومما يشهدُ من المنقولِ في مسئلةِ الاجتهاد بالتأوّلِ وحكايةِ الكفرِ قولُ شمس الدين الرمليّ في شرحِهِ على منهاج الطالبينَ في أوائلِ كتابِ الرّدّةِ في شرح قولِ النووي: الردّةُ قطعُ الإسلام بنيّةٍ أو قولِ كفرٍ ما نَصُّه 4: “فلا أثَر لسَبْقِ لسانٍ أو إكراهٍ واجتهادٍ وحكايةِ كُفْرٍ”.
وقولُ المُحَشّي ـ أي صاحب الحاشية على الشرح ـ نور الدين علي الشَّبرامَلّسي المتوفَى سنة ألف وسبعٍ وثمانين عند قولِ الرملي: “واجتهادٍ” ما نَصُّه5 : “أي لا مطلقًا كما هو ظاهرٌ لِمَا سيأتي من نحوِ كُفرِ القائلينَ بقِدَم العالَم مع أنّه بالاجتهادِ والاستدلالِ”. قال المُحَشِّي الآخَرُ على الرمليّ أحمدُ بنُ عبدِ الرزاق المعروفُ بالمَغربي الرّشيدي المتوفَّى سنة ألفٍ وستّ وتسعين قولُه6 : “واجتهادٍ” أي فيما لم يقُم الدليلُ القاطعُ على خلافِهِ بدليلِ كفرِ نحو القائلينَ بقِدَم العالَم مع أنّه بالاجتهادِ اهـ، ومن هنا يُعلم أنه ليس كلُّ متأوّلٍ يمنَعُ عنه تأويلُه التكفيرَ، فليجعلْ طالبُ العلم قولَ الرشيديّ المذكورَ فيما لم يَقُمْ دليلٌ قاطعٌ على ذُكْرٍ ـ يعني أن يكون مستحضرًا لهذه الكلمة في قلبه لأنها مهمَّة ـ، لأن التأوُّلَ مع قيامِ الدليلِ القاطعِ لا يمنَعُ التكفيرَ عن صاحبِهِ.
وقولُنا في الخوارج باستثناءِ بعضهم منَ الذين لم يكفَّروا لثبوتِ ما يقتضي التكفيرَ في بعضهم كما يؤيّدُه قولُ بعضِ الصحابةِ الذين رَوَوْا أحاديثَ الخوارج.
وأمّا ما يُروَى عن سيّدنا علي من أنه قال7 : “إخوانُنا بغَوا علينا” فليسَ فيه حجّةٌ للحُكْم على جميعهم بالإسلام، لأنه لم يثبت إسنادًا عن عليّ، وقد قطَعَ الحافظُ المجتهدُ ابنُ جريرٍ الطبريُّ بتكفيرهم وغيرُه8 ، وحملَ ذلك على اختلافِ أحوالِ الخوارج بأنّ منهم من وصَل إلى حدّ الكفر ومنهم مَن لم يَصِلْ، وهذه المسئلةُ بعضُهم عبَّر عنها بالاجتهاد وبعضُهم عبَّر عنها بالتأويلِ، فممّن عبَّر بالتأويل الحافظُ الفقيهُ الشافعيُّ سراجُ الدين البُلقينيُّ الذي قال فيه صاحبُ القاموس9 : “علامَةُ الدُّنْيا”، وعَبّرَ بعضُ شُرّاحِ10 منهاج الطالبينَ بالاجتهادِ وكِلْتا العبارتَين لا بُدَّ لهما من قَيْدٍ ملحوظٍ.
ومن هنا يُعلمُ أنه ليسَ كلُّ متأوّلٍ يَمنعُ عنه تأويلُه التكفيرَ، فلا يظنَّ ظانٌّ أن ذلك مطلقٌ لأنّ الإطلاقَ في ذلك انحلالٌ ومروقٌ من الدين. ألا ترى أن كثيرًا من المنتسبينَ إلى الإسلام المشتغلينَ بالفلسفةِ مَرَقوا من الدين باعتقادهم القولَ بأزلية العالم اجتهادًا منهم ومع ذلك أجمع المسلمونَ على تكفيرهم كما ذكر ذلك المحدّثُ الفقيه بدرُ الدينِ الزركشيُّ في شرح جمع الجوامع فإنه قال بعد أن ذكرَ الفريقينِ منهُم الفريقَ القائل بأزليةِ العالم بمادته وصورته والفريقَ القائلَ بأزلية العالم بمادتهِ أي بجنسهِ فقط ما نصّه11 : “اتّفقَ المسلمونَ على تَضليلِهم وتكفيرِهم”.
وكذلك المرجئة القائلون بأنه لا يضرُّ مع الإيمان ذنبٌ كما لا تنفع مع الكفر حسنةٌ إنما قالوا ذلك اجتهادًا وتأويلاً12 لبعض النصوص على غير وجهها فلم يُعذَروا، وكذلك ضلَّ فِرَقٌ غيرُهم وهم منتسبونَ إلى الإسلامِ كان زيغُهم بطريقِ الاجتهادِ بالتأويلِ نسألُ الله الثباتَ على الحق.
قاعدة: اللفظُ الذي له مَعنيانِ أحدُهما نوعٌ من أنواع الكفرِ والآخر ليسَ كفرًا، وكان المعنى الذي هو كفرٌ ظاهرًا لكن ليسَ صريحًا، لا يُكفَّر قائلُه حتى يُعرَفَ منه أيّ المعنيينِ أرادَ، فإن قال أردتُ المعنى الكفريَّ حُكِم عليه بالكفرِ وأجري عليه أحكامُ الردّة وإلا فلا يُحكمُ عليه بالكفرِ؛ وكذلكَ إن كانَ اللفظُ له معانٍ كثيرةٌ وكان كلُّ معانيهِ كفرًا وكان معنًى واحدٌ منها غيرَ كُفر لا يكفّرُ إلا أن يُعرَفَ منه إرادةُ المعنى الكفريّ، وهذا هو الذي ذكَرهُ بعضُ العلماء الحنفيّينَ في كتبهم، أما ما دام جازمًا بأنه ما حصل منه كفرٌ لكن يَرِد على بالهِ خلافُ ذلك فلا يجبُ عليه أن يتشهدَ ولا يجبُ عليه تجديد النكاحِ عندئذ. وأما ما يقولُه بعضُ الناسِ من أنه إذا كان في الكلمةِ تسعةٌ وتسعون قولا بالتكفيرِ وقولٌ واحدٌ بتركِ التكفيرِ أُخِذ بتركِ التكفيرِ فلا معنى له، ولا يصحُّ نسبَةُ ذلك إلى مالكٍ ولا إلى أبي حنيفة كما نسب سيدُ سابق13 شبهَ ذلك إلى مالكٍ وهو شائِعٌ على ألسنةِ بعض العصريّين فليتَّقُوا الله.
قالَ العلماءُ: أما الصريحُ أي الذي ليسَ له إلا معنًى واحدٌ يقتضي التكفيرَ فيُحكم على قائلِه بالكفرِ كقول أنا الله حتّى لَو صَدَرَ هذا اللفظُ من وليّ في حالةِ غيبةِ عقلِه يُعَزَّرُ ولو لم يكن هُوَ مكلَّفًا تلك الساعة قال ذلك عزُّ الدين بنُ عبدِ السلام14 ، وذلكَ لأن التعزيرَ يؤثّرُ فيمن غابَ عقلُه كما يؤَثّرُ في الصّاحي العاقل وكما يؤثّرُ في البهائم فإنها إذا جَمحَت فضُرِبَت تكفُّ عن جموحها مع أنها ليست بعاقلة. كذلك الوليُّ الذي نطقَ بالكفرِ في حالِ الغَيبة عندما يُضرب أو يُصرخ عليه يكفُّ للزّاجر الطبيعي. على أن الوليَّ لا يصدرُ منه كفرٌ في حالِ حضورِ عقلِه إلا أن يسبقَ لسانه لأن الوليَّ محفوظٌ من الكفرِ بخلاف المعصيةِ الكبيرةِ أو الصغيرةِ فإن ذلك يجوزُ على الولي لكن لا يستمر عليه بل يتوبُ عن قُربٍ. وقد يحصلُ من الولي معصية كبيرة قبل موتهِ بقليلٍ لكن لا يموت إلا وقد تابَ كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما فإنهما خرجا على أميرِ المؤمنينَ علي رضي الله عنه بوقوفهِما مع الذينَ قاتلوهُ في البصرةِ فذكَّر عليٌّ كُلا منهما حديثًا، أمَّا الزبير فقال له: ألم يقُل لكَ رسولُ الله “إنك لتقاتلَنَّ عليًّا وأنت ظالمٌ له” 15 فقال نسيتُ، فذهبَ منصرفًا عن قتالهِ ثم لحقهُ في طريقهِ رجلٌ من جيشِ عليّ فقتَلَهُ. فتابَ بتذكير علي له فلم يَمُتْ إلا تائبًا. وأما طلحةُ فقال له عليّ: ألم يَقُلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم “مَن كنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاهُ” 16 فذهبَ منصرفًا فضربَهُ مروانُ بنُ الحَكَمِ فقتلَهُ، وهو أيضًا تابَ وندِمَ عند ذكرِ علي له هذا الحديث. فكلٌّ منهما ما ماتَ إلا تائبًا. وكِلا الحديثينِ صحيحٌ بل الحديث الثانِي متواترٌ 17. وقد ذكرَ الإمامُ أبو الحسنِ الأشعري أن طلحةَ والزبيرَ مغفورٌ لهما لأجلِ البشارةِ التي بشَّرَهما رسولُ الله بها مع ثمانيةٍ ءاخرين في مجلسٍ واحدٍ فهذا من الإمامِ أبي الحسنِ الأشعري إثباتٌ أنهما أَثِمَا.
وكذلك قالَ في حق عائشةَ لأجلِ أنها مبشرةٌ أيضًا وكانت ندِمَتْ نَدمًا شديدًا مِن وقوفِها في المقاتلين لعلي حتى كانت عندما تذكُر سَيرَها إلى البصرةِ ووقوفَها مع المقاتلين لعلي تبكي بكاءً شديدًا يبتلُّ من دموعِها خمارها. وهذا متواترٌ أيضًا. وقال في غيرهِما من مقاتلي علي من أهل وقعة الجمَلِ ومن أهل صفينَ الذين قاتلوا مع معاوية عليًّا “مجوَّز غفرانه والعفو عنه” كما نقل ذلك الإمامُ أبو بكر بنُ فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتابهِ مجرد مقالات الأشعري 18، وابن فورك تلميذ تلميذ أبي الحسن الأشعري وهو أبو الحسن الباهلي رضي الله عنهم. وما يظنُّ بعضُ الجهَلة من أنَّ الوليَّ لا يقعُ في معصيةٍ فهو جهلٌ فظيعٌ. فهؤلاء الثلاثةُ طلحةُ والزبيرُ وعائشة من أكابرِ الأولياءِ.
قالَ إمامُ الحرمين الجُوينيُّ19 : “اتفقَ الأصوليونَ على أنّ من نطقَ بكلمةِ الرّدةِ ـ أي الكفر ـ وزعَمَ أنّه أضمرَ توريةً كُفّرَ ظاهرًا وباطِنًا” وأقرّهم على ذلك أي فلا ينفعهُ التأويلُ البعيدُ كالذي يقولُ: (يلعن رسول الله) ويقول قصدي برسولِ الله الصّواعق.
وقَدْ عَدَّ كثيرٌ من الفُقَهاءِ كالفَقيهِ الحنفيّ بَدْرِ الرَّشيدِ20 وهو قريبٌ من القرنِ الثامِنِ الهجريّ أشْياءَ كثيرةً فينبغي الاطّلاعُ عليها فإنَّ منْ لم يعرفِ الشرَّ يَقَعْ فيهِ فليُحْذَرْ، فقد ثبتَ عنْ أحدِ الصحابةِ أنَّهُ أخَذَ لسَانَهُ وخاطبَه: يا لِسَانُ قلْ خيرًا تَغْنَمْ، واسْكُتْ عن شرّ تَسْلَم، من قَبْلِ أن تَندمَ، إنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: “أكثرُ خطايا ابنِ ءادَمَ منْ لسانِهِ”21 ، ومِنْ هذه الخطايا الكفرُ والكبائرُ.
وفي حديثٍ ءاخرَ للرسولِ صلى الله عليه وسلم “إنّ العبدَ ليتكلّمُ بالكلِمَةِ ما يَتَبيَّنُ فيها يهوي بِهَا في النَّارِ أَبْعَدَ مما بينَ المشْرِق والمَغْرِبِ” رواه البخاريُّ ومسلمٌ من حديثِ أبي هريرة22.
——————
1 ) الموافقة (2/75)، المنهاج (1/83)، نقد مراتب الإجماع (ص/168)، الفتاوى (6/300)، مجموعة تفسير (/12-13).
2 ) المصنف (5/503)، وتاريخ ابن عساكر (24/390)، وسنن النسائي (3/252): كتاب الحد في الخمر: باب (2).
3 ) حاشية الرملي على شرح روض الطالب (4/117).
4 ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/414).
5 ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/414).
6 ) حاشية المغربي على نهاية المحتاج (7/414).
7 ) رواه البيهقي في سننه (8/173).
8 ) كالقاضي عياض والقرطبي انظر فتح الباري (12/300) وقد عزاه إلى الطبري في تهذيبه.
9 ) القاموس المحيط (ص/1524).
10 ) نهاية المحتاج (7/402).
11 ) تشنيف المسامع (4/70).
12 ) فإنهم تأولوا هذه الآية: ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلا الكَفُورَ (17)﴾ حملوها على أن معناها لا عقوبة في الآخرة إلا على الكافر. وهذا التأول لا ينفعهم.
13 ) فقه السنة (2/453).
14 ) حاشية الجمل (7/568).
15 ) رواه الحاكم في المستدرك (3/366). قال الحاكم “حديث صحيح” ووافقه المذهبي.
16 ) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الترمذي: “حديث حسن صحيح”.
17 ) فيض القدير (6/218).
18 ) مجرد مقالات الأشعري (ص/188).
19 ) عزاه في الزواجر إلى إمام الحرمين (1/32).
20 ) انظر رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات.
21 ) رواه البطراني في المعجم الكبير (10/197) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي “ورجاله رجال الصحيح”.
22 ) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان، أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق: باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار.
تنبيه
ثم هنا فائدةٌ مهمةٌ وهي أنه إذا شخصٌ حصلت منه مسئلة ولم يدر حكمها فتشهدَ للاحتياط للخلاصِ منها إن كان فيها كفر ثم تبين له أن فيها كفرًا فإن كان هذا الكفر ليس من الكفرِ الصريحِ كسبّ الله نفعَهُ هذا التشهد إن كانَ عالمًا بما يُعرَف به الكفر، وأما إن كان هذا الكفر من الكفرِ الصريح فلا بد له من أن يتشهد جزمًا للخلاصِ من الكفر.
وأما تعزيرُ الولي الغائب بالوَجدِ مثلًا فيكون بحبسِهِ عن الناس وعَزلِهِ عنهم ونحو ذلك وذلك من قِبَل الخليفةِ حتى لا ينفتِنَ به بعض الناس؛ ويَصرف عليهم من بيت المال نفقاتهم هذا إن لم يكن له مال ولا من تجب نفقته عليه من والد أو ولد ولا يترك الناس يختلطون بهم لأن هذا من جملةِ المصالح العامة، فقد قال الفقهاء: إذا عرف شخص بالإصابةِ بالعين فالإمامُ أي الخليفة عليه أن يراعيَ المصلحة العامة وذلك بحجزه عن الناس فلا يتركه يختلطُ بهم لئلا يستمر ضررُهُ للناس بالإصابةِ بالعين. وما يحصلُ من الكلام الكفري من هذا الولي حالة غيبة عقلِهِ لا يُكتَبُ عليه لأن الولي معصومٌ من الكفر، لأن من صارَ من أحبابِ الله لا ينقلبُ بعد ذلك عدُوًّا له. الولي لو كان في حالة غيبوبة عقله وصدر منه كلام فاسد يُزجر بالحبس والانتهار والضرب لأنه لو كان تلك الساعة غائب العقل يؤثر فيه الضرب والزجر. الحمار الذي ليس له عقل إذا أساء التصرف إذا صرخنا عليه أو ضربناه يكف ويغيّر هيأته كذلك هذا الولي لا يُترَك.
قال المؤلف رحمه الله: قالَ إمامُ الحرمين الجُوينيُّ: اتفقَ الأصوليونَ على أنّ من نطقَ بكلمةِ الرّدةِ _ أي الكفر _ وزعَمَ أنّه أضمرَ توريةً كُفّرَ ظاهرًا وباطِنًا وأقرّهم على ذلك أي فلا ينفعهُ التأويلُ البعيدُ كالذي يقولُ: (يلعن رسول الله) ويقول قصدي برسولِ الله الصّواعق.
الشرح: هذا القول ذَكَرَهُ إمامُ الحرمين عبدُ الملك الجويني في كتاب الإرشاد ومعناه أن من نَطَقَ باللفظ الصريحِ بالكفر وَزَعَمَ أنه أضمرَ توريةً أي تأويلًا بعيدًا لا يُقبَل منه بل يكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا. أما التأويل القريبُ إن أبداه الشخصُ إن كان صادقًا في دعواه ينفعه.
وهذا دليلٌ على أنه لا يؤوَّلُ كل لفظٍ منحرف وإنما يؤوَّلُ ما كان تأويلُهُ قريبًا، وأما ما كان صريحًا في المعنى الفاسد فلا يؤوّلُ، فالحذرَ من هؤلاء الذين يؤوّلونَ الصريحَ لمن يفهم معناه. وقولُ إمام الحرمين المذكور محمولٌ على التوريةِ التي لا يحتملها اللفظ، أما التوريةُ التي يحتمِلُها اللفظُ فإنها تنفَع بالتأويل، فليُعلم ذلك. فمن التوريةِ البعيدةِ التي لا يحتمِلُهَا اللفظُ قولُ بعض جهلةِ المتصوفةِ:
كفرتُ بدين الله والكفر واجبٌ ***** لديّ وعند المسلمينَ حرام
ينسبونَ هذا للحلاجِ ويستحسنونه، وكذا قول بعضهم:
وما الكلب والخنزيرُ إلا إلهنا ***** وما الله إلا راهبٌ في كنيستي
ويقولون في تأويله إذا أُنكِرَ عليهم قولهم إلهنا معناه إلى الأرض أي الكلب والخنزير مرجِعهم إلى التّراب.
وأيضًا قولُ بعضِهم:
ألا بالذكر تزداد الذنوب ***** وتنطمس البصائر والقلوبُ
فقد قالَ بعض من لقيتُهُ من المتعسفين: يؤوَّلُ بأنه أرادَ الذّكرَ مع الغفلة.
وكذا قول بعضهم: وجودُكَ ذنب لا يقاسُ به ذنبُ، إلى أمثالٍ لهذه الكلمات وهي كثيرة. وهؤلاء بعضهم ملاحدةٌ يُظهرون الإسلام ولا يعتقدونه مع دعوى التصوّفِ، وبعضهم من شدةِ الجهل يظنون أن هذا صوابٌ، فهؤلاء ضررهم على بعض المسلمين أشدُّ من ضررِ الكفار المُعلنين الذين لا ينتسبون إلى الإسلام كالمجوسِ والبوذيّين.
قال المؤلف رحمه الله: وقَدْ عَدَّ كثيرٌ من الفُقَهاءِ كالفَقيهِ الحنفيّ بَدْرِ الرَّشيدِ وهو قريبٌ من القرنِ الثامِنِ الهجريّ أشْياءَ كثيرةً فينبغي الاطّلاعُ عليها فإنَّ منْ لم يعرفِ الشرَّ يَقَعْ فيهِ فليُحْذَرْ، فقد ثبتَ عنْ أحدِ الصحابةِ أنَّهُ أخَذَ لسَانَهُ وخاطبَه: يا لِسَانُ قلْ خيرًا تَغْنَمْ، واسْكُتْ عن شرّ تَسْلَم، من قَبْلِ أن تَندمَ، إنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: “أكثرُ خطايا ابنِ ءادَمَ منْ لسانِهِ”، ومِنْ هذه الخطايا الكفرُ والكبائرُ.
الشرح: معنى الحديثِ أن من قالَ من الكلامِ ما هو خيرٌ كذكر الله وأفضلُه التّهليلُ كسب ثوابًا، وأن من أمسكَ لسانَه عما فيه معصيةٌ فقد حَفِظَ نفسه وسَلِمَ لأن من لم يحفظ لسانَه فقد عرَّض نفسه للهلاك لأن أكثر المهالِكِ سَببها اللسانُ، فإن ماتَ وهو على هذه الحال فإنه يندَمُ يومَ لا ينفع النّدم.
قال المؤلف رحمه الله: وفي حديثٍ ءاخرَ للرسولِ صلى الله عليه وسلم “إنّ العبدَ ليتكلّمُ بالكلِمَةِ ما يَتَبيَّنُ فيها يهوي بِهَا في النَّارِ أَبْعَدَ مما بينَ المشْرِق والمَغْرِبِ” رواه البخاريُّ ومسلمٌ من حديثِ أبي هريرة.
الشرح: معنى حديث الشيخَين أن الإنسانَ قد يتكلمُ بكلمةٍ لا يرى أن فيها ذنبًا ولا يراها ضارة له يستوجِبُ بها النزولَ إلى قعرِ جهنمَ كما تدل على ذلك رواية الترمذي من غير فرقٍ بين أن يكون منشرحَ البالِ أو غيرَ منشرحٍ، وقعرُ جهنمَ مسافةُ سبعين عامًا وذلك محلُّ الكفار لا يصلُهُ عصاة المسلمين. وقد عُلِمَ أن المسافة التي توصلُ إلى قعر جهنم هي هذه من الحديث الذي فيه أنه بينما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إذ سَمِعُوا وجبةً أي صوتًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تَدْرونَ ما هذا” قالوا: الله ورسوله أعلم قال: “هذا حجرٌ رُمِيَ به في النارِ منذ سبعينَ خريفًا فهو يهوي في النارِ الآن حتى انتهى إلى قَعْرِها” رواه مسلم.
ثم إن العلماء اختلفوا في بعض الأشياء هل هي كفر أم لا، فقال بعض إنها كفر وقال بعض إنها ليست كفرًا. هؤلاء العلماء بعضهم مجتهد اجتهادًا مطلقًا وبعضهم مجتهدون في المذهب وهاك البيان. قال في فتاوى قاضيخان ما نصه: رجل صلى إلى غير القبلة متعمدًا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر وإن أصاب القبلة، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى، وكذا إذا صلى في الثوب النجس أو بغير طهارة، وبعض المشايخ قالوا إن فعل ذلك بتأويل قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ {115}﴾ [سورة البقرة] لا يكون كافرًا، وقال مشايخ بخارا منهم القاضي الإمام أبو عليّ السُّغدي وشمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: لو صلى إلى غير القبلة لا يكفر وكذا إذا صلى في الثوب النجس لأن الصلاة إلى غير القبلة جائزة حالة الاختيار وهو التطوع على الدابة ومن العلماء من جوّز الصلاة في الثوب النجس فلا يحكم بكفره، أما إذا صلى بغير الطهارة متعمدًا فإنه يصير كافرًا، وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يكون زنديقًا لأن أحدًا لم يجوّز الصلاة بغير طهارة فيكون استخفافًا بالله تعالى اهـ والقول الصحيح الذي يوافق قواعد مذهب الشافعي ومالك وغيرهما أنه لا يكفر وليس يلزم منه الاستخفاف بالدين.
فائدةٌ مُهِمَّةٌ
قال المؤلف رحمه الله:
فائدةٌ مُهِمَّةٌ
حكمُ من يأتي بإِحدى أنواع هَذِهِ الكُفريّاتِ هو أن تَحْبَطَ أَعْمالُهُ الصالحةُ وحسنَاتُه جميعُهَا، فلا تُحسَبُ له ذرّةٌ من حَسَنَةٍ كانَ سَبَقَ لَهُ أن عَملهَا من صَدقةٍ أو حَجّ أو صيام أو صَلاةٍ ونَحْوِهَا. إنَّما تُحسَبُ له الحسناتُ الجديدَةُ التي يقومُ بها بَعْدَ تَجديد إيمانِه قال تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ {5}﴾ [سورة المائدة].
الشرح: أنَّ الشخصَ إذا كان مسلمًا ثم صدَرَ منه كفرٌ فإن أعماله الصالحة تحبَط كلُّها فيخسرُ حسناتِهِ السابقة كلها من صلاةٍ أو صيام أو صدقةٍ أو غير ذلك من وجوهِ الخير لقوله تعالى:﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ {5}﴾ فإن رجع إلى الإسلام لم ترجع إليه حسناته التي خسرها، وأما ذنوبُهُ التي عملها في أثناء الردة وقبل ذلك فإنها لا تُمحَى عنه برجوعه إلى الإسلام وإنما الذي يُغفَر له بذلك هو الكفرُ لا غيرُ، بخلاف الكافرِ الأصلي فإن ذنوبَه تُمحى بإسلامه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الإسلامُ يَهْدِمُ ما قبلَه” رواه مسلم. أما حسناتُهُ التي كان عمِلَها قبل إسلامه فلا تُكتَبُ له بعد أن يسلم، وهذا هو القول الصحيح ومن قال بأن حسناته تعود له فهو غالط لكن لا يكفّر إن كان ممن يخفى عليه الحكم.
قال المؤلف رحمه الله: وإذَا قالَ أستغفرُ الله قبلَ أنْ يُجَدّدَ إيْمانَه بقولِه أشْهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمدًا رَسُولُ الله وهو على حالَتِهِ هَذِهِ فَلا يَزيدُهُ قولُه أستَغْفِرُ الله إلا إثْمًا وكُفْرًا، لأنَّهُ يكذّبُ قولَ الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ {34}﴾ [سورة محمد]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا {168} إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا {169}﴾ [سورة النساء].
الشرح: أن من كَفَرَ ثم قال أستغفرُ الله قبل أن يرجعَ إلى الإسلام بالشهادتين لا ينفعُهُ ذلك شيئًا بل يزدَادُ إثمًا وكفرًا لأنه يطلب المغفرة وهو على الكفر والله تعالى لا يغفر كفر الكافر وذنوبَه وهو على كفره، ومن صَدَرَ منه كفرٌ ثم تشهد على سبيل العادةِ من غير الإقلاع عن الكفر ومن غيرِ أن يعتقدَ أنه كَفَرَ لا ينتفعُ بذلك ولا يرجعُ إلى الإسلام حتى يُقلعَ عن الكفر فيتشهدَ بنية الدخول في الإسلام وهذا هو الحقُّ الذي عليه علماء الإسلام بالاتفاق فإن من هو مُقيمٌ على الكفر لا ينفعه التشهدُ ولو تكرر منه مائةَ مرة.
قال المؤلف رحمه الله: روى ابن حبانَ عن عِمران بنِ الحُصَيْن: أتى رسولَ الله رجلٌ فقال يا محمدُ، عبدُ المطلب خيرٌ لقومِهِ منك كان يُطعمُهُم الكبدَ والسَّنَام وأنت تَنحَرُهم فقال رسولُ الله ما شاء الله _ معناه رد عليه _، فلما أرادَ أن ينصرفَ قالَ: ما أقولُ، قال: “قل اللهم قِني شرَّ نفسِي واعزِم لي على أرْشَدِ أمري” فانطلق الرجلُ ولم يكنْ أسلمَ، ثم قال لرسول الله إني أتيتُكَ فقلتُ علّمني فقلْتَ: قُل اللهم قني شرَّ نفسي واعزِمْ لي على أرْشَدِ أمري، فما أقولُ الآن حينَ أسلَمْتُ قال: “قل اللهمَّ قني شرَّ نفسي واعزِم لي على أرْشدِ أمري اللهمّ اغفر لي ما أسررتُ وما أعلنْتُ وما عَمَدتُ وما أخطأتُ وما جَهِلْتُ”.
الشرح: قوله أتى رجلٌ إلى رسول الله أي رجلٌ من المشركين، وأما السَّنَام فهو سَنَام الإبل وهو طعامٌ فاخِرٌ عند العرب، وقوله “وأنت تنحَرُهم” أي تقتُلهم في الجهاد، وقوله فقال رسول الله ما شاء الله معناه أن الرسول ردَّ عليه بما شاء الله له من الكلام. ثم إن هذا الحديث الصحيح فيه دليلٌ على أن الإنسان ما دامَ كافرًا لا يجوز له أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي لأنه لو كان ذلك جائزًا لكانَ الرسول علمَه من الأول الاستغفار اللفظي ولكنه لم يعلمه الاستغفار اللفظي إلا بعد أن أسلمَ. فإن قال قائل أليسَ كان نوحٌ يقول لقومه الذين هم على عبادةِ الأوثان:﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا {10}﴾ [سورة نوح] فالجواب أن قوله ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ {10}﴾ أي اطلبوا مغفرةَ الله بالدخولِ في الإسلام بتركِ عبادةِ الأصنام والإيمانِ بالله وحده والإيمانِ بي أني نبي الله، وكذلك الاستغفارُ في مواضع أخرى في القرءان معناه طلب الغفران بالدخول في الإسلام لأن الإسلامَ يمحو الله به الكفر، قال تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ {38} } [سورة الأنفال] وليس المرادُ في تلك المواضع قولَ أستغفر الله أو ربّ اغفر لي أو نحو ذلك. وهذه الآية نص صريح في أن الكافر الأصلي والمسلم الذي كفر بقولِ كفرٍ أو فعلِ كفرٍ أو اعتقادٍ كفريٍ إن رجع عنه فدخل في الإسلام يغفر له لا وسيلة غير ذلك فإن كان كافرًا أصليًّا يغفر له كل ذنوبه الكفر وما سواه وإن كان مسلمًا ارتد يغفر له كفره فقط.
تنبيهٌ مهم: في تحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب: قال الشوبري في تجريده حاشية الرملي الكبير ما نصه: “وجزمَ ابن عبد السلام في الأمالي والغزاليُّ بتحريم الدعاءِ للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميعِ الذنوب وبعدمِ دخولهم النار، لأنَّا نقطعُ بخبر الله تعالى وخبرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يدخل النار. وأما الدعاءُ بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ {28}﴾ [سورة نوح] ونحو ذلك فإنه وردَ بصيغةِ الفعل في سياق الإثبات، وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكراتٌ، ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلًا”.ا.هـ. وكذا ذكر الرملي في شرح المنهاج، فليس معنى الآية اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم.
وهذا الدعاءُ أي بعدم دخول أحدٍ من أهل الإسلام النارَ فيه ردٌّ للنصوص، وردُّ النصوص كُفرٌ كما قال النسفي في عقيدته المشهورة، وقد قال أبو جعفر الطحاوي: “والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام”، وهذه عقيدة المرجئة، وهم من الكافرين من أهل الأهواء وذلك لقولهم لا يضرّ مع الإسلام ذنب كما لا تنفع مع الكفر حسنة.
تنبيه: إذا شخصٌ وقع في كفريةٍ ثم لما تعلم عَرَفَ أنها كفرٌ ولم يتذكر أنه قالها فصارَ يتلفظُ بالشهادتين في صلاتِهِ وخارجها من دون استحضارٍ لما حصل منه قبلُ ولو تذكر هذه المدةَ لتشهدَ للخلاص ثم بعد أيامٍ تذكر أنه قالها وقبل ذلك لم يتشهد قطُّ للخلاص من كفرٍ وقَع فيه لأنه لم يذكر أنه حصل منه فشهادتُهُ التي تشهدَها على سبيلِ العادة تكفيه، لأنه كان أراد البُعدَ من الكفر.
قال المؤلف رحمه الله: ومن أحكامِ الردةِ أن يَنفَسِخَ نكاحُ زوجتِهِ أي عقدُ الزواج الشرعي فتكونُ العلاقةُ بين الزوجين بعد كفرهِ علاقةً غيرَ شرعيةٍ فجماعُهُ لها زنى، ولا فرقَ بين أن يكفرَ الزوجُ وبين أن تكفُرَ الزوجة.
الشرح: أنَّ الردةَ يترتَّبُ عليها أحكامٌ عديدة منها أن المرتدَّ يفسدُ صيامُهُ وتيمُّمه ونكاحُهُ قبل الدخول وكذا بعده إن لم يرجع إلى الإسلام في العدة، ولا يصحُّ عقدُ نكاحِهِ لا على مسلمةٍ ولا كافرةٍ ولو مرتدة مثله. ولا فَرق في حكم انفساخ العقد بين أن يرتدَّ الزوجُ أو ترتد الزوجةُ، ولو ارتد أحدُهما وعرف الآخر بذلك ثم حصلَ جماعٌ بينهما فهو زنًى منهما وكلاهما ءاثمٌ والولد من هذا الزنى لا يُنسبُ إلى الرجل، وأما إن لم يعرف الثاني فالإثمُ على المرتد منهما فقط.
تنبيه: الكفارُ الأصليون نكاحُهُم فيما بينهم نكاحٌ وزناهم زنى فلذلك نقولُ خالدُ بن الوليد وعمرُ بن الخطاب فَنَنسِبُ كلًّا منهما إلى أبيه مع أنهما وُلِدا وأبواهما مشركان في الجاهلية.
عَودٌ إلى تقسيمِ الكُفرِ لزيادةِ فائدة
قال المؤلف رحمه الله: عَودٌ إلى تقسيمِ الكُفرِ لزيادةِ فائدة.
واعلم أن الكفرَ ثلاثةُ أبوابٍ: إمّا تشبيهٌ، أو تكذيبٌ، أو تعطيلٌ الشرح: أن أبوابَ الكفر ثلاثةٌ تشبيهٌ أي تشبيهُ الله بخلقه، وتكذيبٌ أي للشرع، وتعطيلٌ أي نفيُ وجود الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله: أحدُها التشبيهُ: أي تشبيهُ الله بخلْقِه كمن يصفُه بالحدوثِ أو الفناءِ أو الجسمِ أو اللونِ أو الشكلِ أو الكمّية أي مِقدار الحَجْم، أما ما ورَد في الحديثِ “إن الله جميلٌ” فليس معناهُ جميلَ الشكلِ وإنّما معناهُ جميلُ الصّفاتِ أو محسنٌ.
الشرح: أن من وَقَعَ في التشبيه فَعَبدَ صورةً ما أو خيالا تخيله يكون بذلك من الكافرين الخارجين عن مِلةِ المسلمين وإن زَعَمَ أنه منهم. لأن الذي يشبّهُ الله بخلقه يكون مكذبًا ل_ “لا إله إلا الله” معنًى ولو قالها لفظًا. ومعنى إن الله جميلُ الصفات أي صفاتُهُ كاملةٌ، وقوله “أو محسن” أي يُحسِنُ لعباده ويتكرمُ عليهم بِنِعَمِهِ. وأما الحديثُ الذي رواه الترمذي وهو: “إنّ الله نظيفٌ يحبُّ النّظافة” فمعناه مُنَزَّهٌ عن السُّوءِ والنَّقصِ، وقوله: “يحبُّ النظافة” أي يحب لعبادِهِ نظافةَ الخُلُقِ والعَمَلِ والثوب والبدن.
قال المؤلف رحمه الله: ثانيها التكذيبُ: أي تكذيبُ ما وردَ في القرءانِ الكريم أو ما جاءَ به الرسولُ صلى الله عليه وسلم على وجهٍ ثابتٍ وكان مما عُلِم من الدين بالضرورةِ كاعتقادِ فَنَاءِ الجنّةِ والنار، أو أن الجنةَ لذاتٌ غيرُ حسّيةٍ، وأنّ النارَ ءالامٌ معنويّةٌ، أو إنكارِ بعثِ الأجسادِ والأرواح معًا أو إنكارِ وجوب الصلاةِ أو الصيامِ أو الزكاةِ، أو اعتقادِ تحريمِ الطّلاق أو تحليلِ الخمرِ وغيرِ ذلك ممّا ثبتَ بالقطعِ وظهرَ بين المسلمين.
الشرح: أنَّ من أنواعِ الكفر والعياذُ بالله كُفرَ التكذيب ويكونُ بتكذيب ما جاءَ به القرءان مما هو ظاهر بين المسلمين كتحليل لحم الخنزير أو بردّ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأن هذا الأمر مما جاءَ به محمدٌ عليه الصلاة والسلام، فمن جَحَدَ خبر القرءان وما قد ثبتَ عنده أن رسولَ الله جاء به فهو كافرٌ لا شك في ذلك، وأما إن سَمِعَ حديثًا يُوهِمُ ظاهره أن لله جوارحَ فأنكرَهُ جهلًا منه فإنه لا يكفر وذلك كأن سَمِعَ حديث: “ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبَّه فإذا أحببته كنتُ سمعَه الذي يسمع به وبصرَه الذي يبصر به ويدَه التي يبطش بها ورجلَه التي يمشي بها” فأنكره ظنًّا منه أنه مُفترى على الرسول وأن فيه إثبات الجوارح لله فإنه لا يكفر. وهذا الحديثُ معناه أحفظ له سَمعَهُ وبصرَهُ ويدَهُ ورجلَهُ، وقال بعضهم: أي أعطيه قوةً غريبةً في سمعِهِ وبصرِهِ ويدِهِ ورجلِهِ.
ومن كُفرِ التكذيبِ أيضًا اعتقادُ فناءِ الجنةِ والنارِ أو إحداهما وهو كفرٌ بالإجماعِ، ومثله في الحكم من يعتقدُ أن الجنةَ لذّاتها معنويةٌ فقط أو أن النار ليس فيها ءالامٌ حسيةٌ لأن هذا إنكار لنصوص الشرعِ الصريحة المتواترةِ المعروفة بين المسلمين العلماء والعوام. ومن الدليل على أن الجنةَ فيها لذات حسيةٌ ءاياتٌ منها قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {43}﴾ [سورة الحاقة]، ومن الدليل على أن النارَ فيها ءالامٌ حسيةٌ ءاياتٌ منها قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ {56}﴾ [سورة النساء].
ومن التكذيبِ للشرع إنكار بعثِ الأرواحِ والأجسادِ معًا فإن اعتقد مُعتَقِدٌ أن الأرواحَ تُبعَثُ فقط دون الأجساد فإنه يكفر والعياذ بالله تعالى، والنصوصُ الصريحةُ ببعثِ الأجسادِ كثيرةٌ منها قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ {104}﴾ [سورة الأنبياء] وهذا الأمر معلومٌ عند الجاهل والعالم من المسلمين. ومن الكفر إنكارُ أي أمرٍ معلوم من الدين بالضرورة كإنكار وجوبِ الصلاةِ والصيامِ والزكاةِ، ونقَل القاضي عياض في الشفا الإجماعَ على تكفير من أنكرَ وجوبَ الصلوات الخمس وعددَ ركعاتها وسجداتها. وكذا الحكم فيمن يعتقد تحريمَ الطلاقِ على الإطلاق فإن فسادَ هذا ظاهرٌ بين عامة المسلمين وعلمائهم، ومثله حكمُ من أحلَّ شُربَ الخمرِ فقد أجمعَ على تحريمها الأئمةُ من عهد صحابةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه وانتشر هذا الحكم وشُهِرَ حتى بين من يشربها من الأمة ولذلك جَزَمَ العلماءُ بتكفير من أحلَّ شربَها مطلقًا، وخالفَ في ذلك وشذَّ رَعاعٌ مرادهم هدمُ الدين وإفسادُ الشرع وإشاعةُ الفواحش والرذائل فزعموا أن ليس في القرءان نصوصٌ على تحريم الخمر بل غاية ما جاء فيه قولُه تعالى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ﴿فَاجْتَنِبُوهُ {90}﴾ وغرضهم بهذا الكلام المُمَوَّهِ التوصُّل إلى إباحة الخمر، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {90} إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {91}﴾ [سورة المائدة]، فقوله ﴿فَاجْتَنِبُوهُ {90}﴾مع قوله ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {91}﴾ يُفهِمان التحريمَ الشديدَ ولهذا قال عمر لما سمعها: “انتَهَيْنا انتَهيْنا” رواه الترمذي وغيره، وأراقَ المسلمونَ لمَّا نزلت ءاية التحريم الخمرَ حتى جرت في شوارع المدينة.
قال المؤلف رحمه الله: وهذا بخلافِ من يَعتقدُ بوجوبِ الصلاةِ عليه مثلًا لكنه لا يصلي فإنه يكونُ عاصيًا لا كافرًا كمن يعتقدُ عَدمَ وجوبِها عليهِ.
الشرح: هذا مذهبُ أهلِ السنة والجماعة أن مرتكبَ الكبيرةِ لا يكفر إذا لم يستحلها.
قال المؤلف رحمه الله: ثالثُها التعطيلُ: أي نفيُ وجودِ الله وهو أشدُّ الكفرِ.
الشرح: كالشيوعيةِ النافين لوجودِهِ تعالى وهذا أشدُّ الكفرِ على الإطلاقِ. وكذلك كفر الوَحدة المطلقة وكفر الحلول.
قال المؤلف رحمه الله: وحكمُ من يُشبّهُ الله تعالى بخلقِهِ التكفيرُ قطعًا.
الشرح: أن مَن يشبهُ الله تعالى بخلقه فهو كافرٌ من غير شك وذلك أن المشبّهَ لا يعبُدُ الله تعالى وإنما يعبُدُ صورةً تخيلها وتوهمها ومن عَبَدَ غير الله فلا يكون مسلمًا.
قال المؤلف رحمه الله: والسَّبِيلُ إلى صَرفِ التَّشبِيهِ اتباعُ هذِهِ القَاعِدَةِ القَاطِعَةِ: “مَهْما تَصَوَّرتَ ببَالِكَ فَالله بِخِلافِ ذَلِكَ” وَهِيَ مُجمَعٌ عَلَيها عِندَ أهلِ الحَقّ، وهي مَأخُوذَةٌ مِن قَولِهِ تَعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ {11}﴾ [سورة الشورى].
الشرح: أن السبيلَ لِصَرفِ التشبيهِ والمحافظةِ على التنزيهِ هو اتباعُ قولِ ذي النونِ المصري: “مَهْمَا تَصَوَّرتَ بِبَالِكَ فالله بِخِلافِ ذلِكَ” رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، لأن ما يتصوره الإنسانُ بباله خيالٌ ومِثَالٌ والله منزهٌ عن ذلك، فهذه قاعدةٌ مجمعٌ عليها عند أهلِ الحق مأخوذةٌ من قولِ الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ {11}﴾ [سورة الشورى].
وهذه العبارةُ ينقُلُها الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسنادٍ متصلٍ إلى ذي النون المصري واسمه ثَوبان بن إبراهيم وهو من الصوفيةِ الصادقين الأكابِرِ ممن جمع بين العلم والعمل، تلقى الحديث من الإمام مالك وغيره، وأفاضَ الله على قلبه جواهِرَ الحِكَمِ، وهذا القولُ نقلَهُ أيضًا أبو الفضل التميميُّ الحنبليّ عن الإمامِ أحمدَ رضي الله عنه.
وفي معنى ذلك ما رواه أبو القاسم الأنصاري من أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: “لا فكرةَ في الرَّبّ” أي أن الله لا يُدرِكُهُ الوَهمُ لأن الوَهمَ يُدرِكُ الأشياءَ التي لها وجودٌ في هذه الدنيا كالإنسانِ والغمامِ والمطرِ والشجرِ والضوء وما أشبَه ذلك. فيُفهَمُ من هذا أن الله لا يجوز تَصَوُّرُهُ بكيفيةٍ وشكلٍ ومِقدارٍ ومساحةٍ ولونٍ وكلّ ما هو من صفاتِ الخلق.
وكذلك يُفهَمُ من قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى {42}﴾ [سورة النجم] أنه لا تُدرِكُهُ تصورَاتُ العبادِ وأوهامُهُم.
قال المؤلف رحمه الله: ومُلاحَظَةُ مَا رُويَ عن الصّدّيقِ (شِعرٌ من البَسِيْط) العَجْزُ عَنْ دَرَكِ الإدْرَاكِ إدْرَاكُ والبَحثُ عنْ ذَاتِه كُفرٌ وإشراكُ الشرح: معنى ما روي عن أبي بكر الصديق أن الإنسانَ إذا عَرَفَ الله تعالى بأنه موجودٌ لا كالموجوداتِ واعتقدَ أنه لا يُمكِنُ تصويرهُ في النفسِ واقتصرَ على هذا واعترفَ بالعجزِ عن إدراكِهِ أي عن معرفةِ حقيقتِهِ ولم يبحث عن ذاتِ الله للوصولِ إلى حقيقةِ الله فهذا إيمانٌ، وهذا يقال عنه عَرَفَ الله وإنه سَلِمَ من التشبيه، أما الذي لا يكتفي بذلك ويريدُ بزعمه أن يَعرفَ حقيقته ويبحثَ عن ذاته ولا يكتفي بهذا العجز فيتصورهُ كالإنسانِ أو ككتلةٍ نورانيةٍ أو يتصوره حجمًا مستقرًّا فوق العرش أو نحو ذلك فهذا كَفَرَ بالله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله: وقولِ بَعْضِهم: لا يَعْرفُ الله على الحقِيقَةِ إلا الله تعالى. ومَعرِفتُنا نحنُ بالله تَعالى لَيْسَتْ عَلى سَبِيْلِ الإحَاطَةِ بلْ بمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ لله تَعَالى كوُجُوبِ القِدَم لَهُ، وتَنْزيهِهِ عَمَّا يَستحيلُ علَيه تَعالى كاسْتِحالةِ الشّريكِ لهُ وما يجوزُ في حقّه تعالى كَخلْقِ شَىءٍ وتركِه.
الشرح: أن معرفَتَنَا بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة إذ لا يَعرِفُ أحدٌ من الخَلقِ الله تعالى على الحقيقةِ حتى الأنبياء والأولياء لا يعرفون الله تعالى بالإحاطةِ وإنما الله تعالى عالمٌ بذاته على الحقيقة وبما يُحدِثُهُ من مخلوقاته، ومعرفَتُنَا نحن بالله إنما هي بمعرفةِ ما يجبُ لله من الصفاتِ كالعلمِ والقدرةِ والإرادةِ والقِدَمِ، ومعرفةِ ما يستحيلُ في حقه تعالى كالعجزِ والحجمِ والشريكِ، ومعرفةِ ما يجوزُ في حقه سبحانه كإيجادِ شىءٍ وإعدامِهِ، فالله تعالى يجوزُ أن يَخلُقَ ما يشاءُ ويَترُكَ ما يشاءُ أي لا يخلقه.
قال المؤلف رحمه الله: قالَ الإمامُ الرفاعيُّ: “غايةُ المعْرفةِ بالله الإيقانُ بوجُودِه تعالى بلا كيفٍ ولا مَكانٍ”.
الشرح: أنَّ أقصى ما يَصِلُ إليه العبدُ من المعرفةِ بالله الإيقانُ أي الاعتقادُ الجَازِمُ الذي لا شَكَّ فيه بوجودِ الله تعالى بلا كيفٍ ولا مكانٍ، فقولُه بلا كيفٍ صريحٌ في نفي الجسمِ والحيّزِ والشَّكلِ والحركةِ والسُّكونِ والاتّصَالِ والانفصالِ والقعودِ إذ كلُّ ذلك شىءٌ غيرُهُ والله منزَّهٌ عنه. فالكيفُ يَشمَلُ كلَّ ما كان من صفاتِ المخلوقين، فمن أيقَنَ بأن الله موجودٌ بلا كيفٍ ولا مكانٍ فقد وَصَلَ إلى غايةِ ما يَبلُغُ الإنسانُ من معرفةِ الله.
فائدةٌ
قال المؤلف رحمه الله: قَالَ الغَزَاليُّ في إحيَاءِ علوم الدّين: إنَّهُ (أي الله) أَزَليٌّ لَيسَ لوجُودِه أوَّلٌ وليسَ لوجُودِهِ ءاخِرٌ. وإنّه ليسَ بجَوهر يَتَحيَّزُ بَل يَتَعالى ويَتَقَدَّسُ عن مُنَاسَبَةِ الحوادِثِ وإنَّه لَيسَ بِجِسم مُؤَلّفٍ مِن جَواهِرَ، وَلَو جَازَ أنْ يُعتَقدَ أنَّ صانِعَ العَالَم جِسمٌ لَجازَ أنْ تُعتَقدَ الأُلوهيّةُ للشَّمْسِ والقَمرِ أو لشَىءٍ ءاخرَ من أقسَامِ الأجسَام فإذًا لا يُشْبهُ شَيئًا ولا يُشبِهُه شىءٌ بل هوَ الحيُّ القيّومُ الذي ليس كَمثْلهِ شَىءٌ وأنَّى يُشْبهُ المَخْلوقُ خالقَه والمُقَدَّرُ مُقدّرَه والمصَوَّرُ مُصَوّرَهُ.
الشرح: العالَمُ جَوَاهرُ وأعْرَاضٌ، والجوهرُ عند علماءِ اللغة أصلُ الشىء وهو ما لَهُ تحيُّزٌ وقيامٌ بذاتِه كالأَجسَامِ فما له حجمٌ كثيفٌ كالعرش والشجر والحجر والسموات والأرض والإنسان والنبات أو لطيفٌ كالريحِ والنورِ والروح والجن والملائكة يقال له جوهرٌ. والجوهرُ إما مركَّبٌ وإما مُفرَدٌ فالمفردُ هو الجوهرُ الفَردُ، والمركبُ ما تَرَكَّبَ من جوهرين فأكثر.
وأما العَرَضُ فهو صفاتُ الجوهرِ كحركةِ الجسمِ وسكونِهِ والبرودةِ والحرارةِ والتحيز في مكان وجهة، فالنارُ جوهرٌ وحرارتُها عَرَضٌ والريحُ جوهرٌ وحرارتُها أو برودَتُها عرضٌ. وأصغرُ الأشياء يقال له الجوهرُ الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ من تناهيه في القلة، والجسمُ ما تركَّبَ من جوهرين فأكثر بأن ينضم إليه جوهر ءاخر فيصير قابلًا للقسمة، فالله تعالى لا يُشبه ذلك كُلَّه بل يتنزهُ عن مشابهةِ الحوادثِ، وليس له حدٌّ والدليلُ على ذلك أن الحدَّ هو مقدارُ الجِرم، فمقدارُ الجسدِ يقال له الحدُّ والشمسُ لها حدٌّ وهي مع عُظم نفعِها مسخَّرةٌ لغيرها والله هو خالقها لأن الشمسَ لا تصلُحُ أن تكون مدبّرةً للعالم لأن لها حجمًا ومقدارًا وجهةً ومكانًا، فلو كانت الألوهيةُ تصحُّ للأجسامِ لصحت للشمسِ والقمرِ وغيرِ ذلك، ولو كانت الألوهية تصح لشىء من الأجسام لكانت الشمس أولى بالألوهية لكثرة منافعها وحسن لونها مما هو محسوس لكل الخلق. فكلُّ ما له حيّزٌ يستحيلُ أن يكون إلهًا، والتحيّزُ هو أخذُ مقدارٍ من الفراغِ، فالنورُ يأخذ مسافة والظلام يأخذ مسافة، والريح كذلك، فالله تعالى بما أنه ليس حجمًا كثيفًا ولا لطيفًا لا يجوزُ في حقّه أن يأخذَ قدرًا من الفراغ. فلو قال أحد عبدة الشمس الملحدينَ لمسلم: أنت تقول إن ديني هو الصحيحُ وتقول عنّي إن ديني باطلٌ فأينَ الدليلُ، فإن قال له هذا المسلمُ قالَ الله تعالى: ﴿أَفِي اللهِ شَكٌّ {10}﴾ [سورة إبراهيم] يقول الملحدُ: أنا لا أؤمنُ بكتابِكَ أعطني دليلًا عقليًّا، فإن كان هذا المسلمُ يفهمُ الدليلَ العقليَّ والدليلَ النقليَّ على وجهه يقول: هذه الشمسُ لها هيئةٌ وشكلٌ وحدودٌ والشىءُ المحدودُ يحتاجُ إلى حادّ حدَّهُ بهذا الحدّ، ثم هي متطورةٌ والمتطورُ يحتاجُ إلى مُطَورٍ له فهذه لا تصلُحُ عقلًا أن تكون إلهًا كما أنت تزعُمُ، وأما ديني فحقٌّ لأن ديني يقولُ إن صانعَ العالم لا يشبهُهُ بوجهٍ من الوجوه منزهٌ عن الحدّ والمكانِ والشكلِ والكيفيةِ منزهٌ عن كلّ ما في هذا العالمِ من صفةٍ، فلذلك ديني هو الصحيحُ الذي يقبلُهُ العقل فيكون هذا المسلم قطع بهذا الدليل العقلي عابد الشمس وأدحض دعواه. أما الذي يقولُ الله ساكنٌ في السماء فبأيّ دليلٍ يدفَعُ كلامَ هذا الذي يعبُدُ الشمسَ، يقول له ذاك: أنتَ تقول إن معبودي ساكنٌ في السماء وأنا أقول إن معبودي الشمسُ في الفضاءِ وقد يدعي أنها في سماءٍ من السموات والشمسُ منفعَتُها ظاهرةٌ تنفعُ الهواءَ والنباتَ والإنسانَ، وأنت تعبُدُ شيئًا متحيزًا متوهَّمًا وأنا أعبدُ شَيئًا متحيزًا متحقق الوجود مشاهدًا يراه كل الخلق ويرون منفعته وأما هذا الذي أنت تعبده لا نراه ولا أنت رأيته ولا أحسسنا له بمنفعة، فلماذا تجعلُ الحقَّ في دينِكَ وتجعلُ ديني مخالفًا للحقّ فذاك المشبّهُ كالوهابي الذي يعتقد أن الله جسدٌ قاعدٌ فوقَ العرش لا يكونُ عندَهُ جوابٌ.
قال المؤلف رحمه الله: فليسَ هذَا الكلامَ الذي عابَه العلماءُ وإنّما عابَ السلفُ كلامَ المُبتدِعَةِ في الاعتقادِ كالمشبهةِ والمعتزلةِ والخوارجِ وسائرِ الفرقِ التي شذت عما كان عليه الرسولُ والصحابةُ الذين افترقوا إلى اثنتينِ وسبعينَ فرقة كما أخبرَ الرسولُ بذلك في حديثهِ الصحيحِ الثابتِ الذي رواه ابنُ حبانَ بإسنادهِ إلى معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إحدى وسبعينَ فرقة وافترقت النصارى على اثنتينِ وسبعينَ فرقة وستفترقُ أمتي إلى ثلاث وسبعينَ فرقة كلُّهم في النارِ إلا واحدة وهي الجماعة _ أي السواد الأعظم _. وأما علمُ الكلامِ الذي يشتغلون به أهلُ السنةِ من الأشاعرةِ والماتريديةِ فقد عُمل به من قبل الأشعري والماتريدي كأبي حنيفةَ فإن له خمسَ رسائل في ذلك والإمام الشافعي كان يتقنهُ حتى إنه قال: أتقنَّا ذاك قبل هذا، أي أتقنَّا علمَ الكلامِ قبل الفقهِ.
الشرح: علمُ التوحيد هو العلمُ الذي يُعرفُ به ما يجوزُ على الله وما يليقُ به وما لا يجوزُ عليه وما يجبُ له من أن يُعرَف في حقه سبحانه وتعالى، ولذلك سماهُ أبو حنيفة الفِقهَ الأكبرَ إيذانًا وإعلامًا بأنه هو الفِقهُ الذي هو أشرفُ وأفضلُ من غيره.
فليسَ هذا هو علم الكلام الذي ذَمَّهُ العلماءُ وإنما ذموا كلامَ أهلِ الأهواءِ أهلِ الضلالِ المنشقين عن أهل السنة كعقيدةِ الخوارج والمعتزلة والمُرجِئَةِ وغيرِهم من الفِرَقِ المخالفينَ لأهل السنة فإن لهم مقالاتٍ يجادلون عليها ليوهموا الناسَ أن ما هم عليه هو الحقُّ وأن ما عليه أهلُ السنةِ باطلٌ. وهذا هو الذي عَنَاهُ الشافعيُّ بقوله الذي رواه عنه الإمامُ المجتهدُ الحافظُ أبو بكر بن المنذر: “لأن يَلقَى الله العبدُ بكل ذنبٍ ما عدا الشرك خيرٌ من أن يلقاهُ بشىءٍ من الأهواءِ”. ومعنى قوله: “الأهواء” أي العقائد التي مالَ إليها المخالفونَ لأهل السنة فإن لهم مؤلفات ولا سيما المعتزلة، وكذلك المشبهةُ الذين يعتقدونَ أن الله جسم وأنه متصفٌ بالحركةِ والسكونِ والنزولِ والصعودِ إلى غيرِ ذلك من صفاتِ الأجسامِ، وكلمةُ الأهواء جمع هوى والهوى ما تميلُ إليه النفسُ من الباطلِ. أما علمُ الكلام الذي يُعرَفُ به أدلةُ الرد على المخالفين فهو فرضُ كفايةٍ فيجبُ أن يقومَ بذلك من تَحصُلُ بهِ الكفايةُ لأن هذا من بابِ إزالةِ المُنكَر، وهذا من أفرضِ الفروضِ لأنه حفظٌ لأصولِ عقيدةِ أهلِ السنة.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة