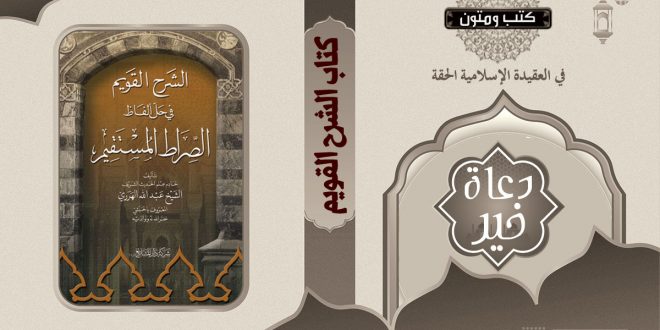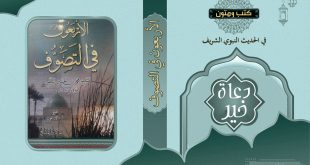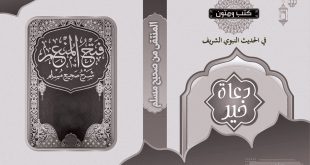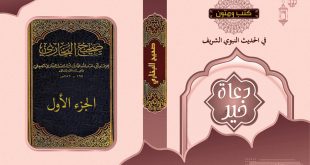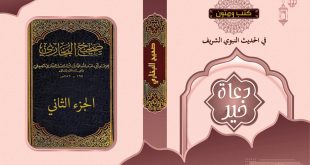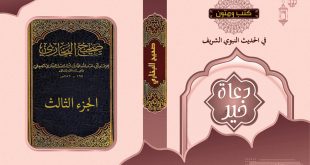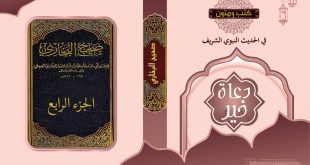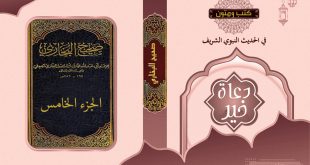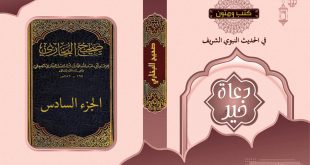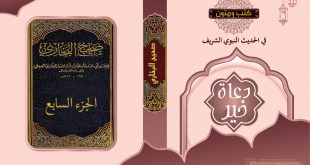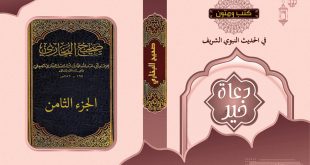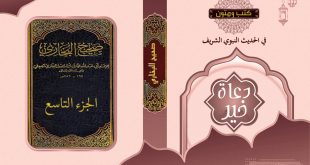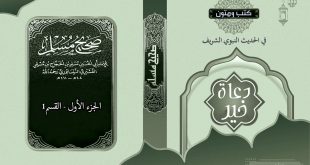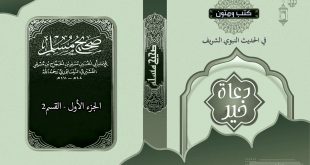المعجزةُ
قال المؤلف رحمه الله: المعجزةُ
اعلم أنَّ السَّبيلَ إلى معرفةِ النَّبي المُعجزةُ.
الشرح: بالمعجزةِ يُعرفُ النَّبي فما من نَبيّ إلا وكانت لهُ معجزةٌ، ومعنى المعجزة العلامةُ الشاهدَةُ التي تَشهَدُ أن هذا الإنسانَ الذي يقول عن نفسِه إنه نبيُّ الله أنّه نبيٌّ وأنه صادِقٌ، وقد أعطي نبيُّنَا محمد من المعجزاتِ أكثر من غيرِه حتى قيل إن المعجزات التي حَصَلَت في حال حياتِهِ بين الألفِ والثلاثةِ ءالافٍ عددًا، وأعظمُ المعجزاتِ معجزةُ القرءانِ الكريمِ، وقد قالَ الشافعيُّ رضي الله عنه: ما أعطَى الله نبيًّا معجزةً إلا وأعطى محمَّدًا مثلَها أو أعظمَ منها. فمن لم يتعلَّم شيئًا من معجزاتِ الرسولِ يكونُ مقصّرًا تقصيرًا كبيرًا.
قال المؤلّف رحمه الله: وهي أمرٌ خارِقٌ للعادةِ.
الشرح: أي هي أمرٌ مخالفٌ ومناقضٌ للعادَةِ.
قال المؤلف رحمه الله:يأتي على وَفْقِ دَعْوَى من ادَّعَوا النُّبوة.
الشرح: أي هذا الأمرُ الخارقُ يوافِقُ دعوى ذلك النَّبي، فما لم يكن موافقًا للدَّعوى لا يسمَّى معجزةً كالذي حَصَلَ لمسيلمةَ الكذَّابِ الذي ادَّعى النبوةَ من أنّه مسحَ على وجهِ رجلٍ أعور فعمِيَت العينُ الأخرى، فإن هذا الذي حَصَلَ مناقضٌ لدعواهُ وليس موافقًا.
قال المؤلف رحمه الله: سَالِمٌ مِنَ المُعَارَضَةِ بالمِثلِ.
الشرح: أي لا يستطيعُ المكذّبونَ أن يفعلُوا مثله، فإذا ادَّعى رجلٌ أنّه نبيٌّ وقارنَ دعواهُ خارقٌ ثمّ ادّعى ءاخر أنَّ المدَّعِي ليس بنبيٍ وأظهرَ خارقًا مثله دلَّ على أن الأوَّل ليس بنبيّ.
تنبيهٌ مهم: المعجزةُ ليس من شرطِها أن تكونَ مقرونةً بالتَّحدّي وإنّما من شرطِها أن تكونَ صالحةً للتَّحدّي.
قال المؤلّف رحمه الله: فما كانَ من الأمورِ عجيبًا ولم يكن خارقًا للعادةِ فليس بمعجزةٍ. وكذلكَ ما كانَ خارقًا لكنّه لم يقترن بدعوَى النّبوةِ كالخوارقِ التي تظهرُ على أيدي الأولياءِ أتباعِ الأنبياءِ فإنَّهُ ليسَ بمعجزةٍ بل يُسَمَّى كرامةً.
الشرح: الذي يتّبعُ النَّبي بصدقٍ اتباعًا تامًّا يؤدّي الواجبات ويجتنبُ المحرَّمات ويُكثِرُ من النوافلِ، الأمرُ الخارقُ الذي يظهرُ على يدِه يقالُ له كرامةٌ ولا يقالُ له معجزةٌ لأنَّ الوليَّ لا يدَّعي أنّه نبيٌّ وإلا لما حصلت له هذه الخوارقُ، وكلُّ كرامةٍ تحصُلُ لهذا الوليّ فهي معجزةٌ للنَّبي الذي يتّبعهُ.
قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ليسَ من المعجزةِ ما يُستَطاعُ معارضَتُهُ بالمثلِ كالسّحرِ فإنّهُ يُعارَضُ بسِحْرٍ مثلِه.
الشرح: السّحرُ لا يُسمَّى معجزةً لأنّ السّحرَ يستطيعُ أن يعملَ ساحرٌ ءاخر مثلهُ، أمّا المعجزةُ لا يستطيعُ المعارضونَ أن يفعلوا مثلها، أمّا غير المعارضينَ من أتباع الأنبياءِ كالأولياءِ هؤلاءِ يستطيعونَ أن يُظهروا أمرًا يُشبِهُ المعجزةَ، لأنَّ هؤلاءِ لا يُعارِضونَ النبيَّ بل يصدّقونَهُ ويتّبعونهُ.
قال المؤلف رحمه الله: والمعجزةُ قِسْمَانِ: قسمٌ يقعُ بعدَ اقتراحٍ مِنَ الناسِ على الذي ادَّعَى النّبوةَ، وقسمٌ يقعُ مِن غيرِ اقتراحٍ.
الشرح: بعضُ الأنبياءِ معجزاتهم تظهَرُ لما يطلبُ منهم النّاسُ الذين أرسِلوا إليهم، وبعضٌ من دونِ اقتراحٍ يظهرُ على أيديهم من دونِ أن يَطلبَ منهم أحدٌ.
قال المؤلّف رحمه الله: فالأَوّلُ نحوُ ناقةِ صالحٍ التي خَرَجَت من الصَّخرةِ. اقترحَ قومُه عليهِ ذلكَ بقولِهم: إن كنتَ نبيًّا مبعُوثًا إلينا لِنُؤمِنَ بكَ فأخرجْ لنا من هذه الصَّخرةِ ناقةً وفصيلَها فأخرجَ لهم ناقةً معَها فصِيلُها (أي ولدها) فاندهَشُوا فآمنوا به.
الشرح: إنَّ ممّا جاءَ في قصّةِ قومِ صالحٍ أنهم طلبوا من نبي الله صالحٍ أن يظهرَ لهم معجزةً وهي أن يُخرجَ لهم ناقةً معها ولدها من الصخرةِ فأخرجَ لهم ثم حذَّرهم أن يتعرَّضوا لها، وكان ممّا امتحن بهِ قوم صالحٍ أن جعلَ اليوم الذي تَرِد فيه ناقة صالحٍ الماء لا تَرِد مواشيهم الماء، وكانت هذه الناقةُ تكفيهم بحليبها في هذا اليوم، فتآمَرَ تسْعة أشخاصٍ منهم على أن يقتلوها فَقَتَلوها وبعدَ ثلاثةِ أيَّام نَزَلَ بهم العذابُ فَمَحَاهُم، قال تعالى: {فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [سورة فصلت/17].
قال المؤلّف رحمه الله: لأنّهُ لو كَانَ كاذبًا في قولِهِ إنَّ الله أرسلَهُ لم يأتِ بهذا الأمرِ العجيبِ الخارقِ للعادةِ الذي لم يَستطع أحدٌ من النَّاسِ أن يعارضَهُ بمثلِ ما أتى به، فَثَبَتَت الحُجَّةُ علَيْهِم. ولا يَسَعُهُم إلا الإذعانُ والتَّصديقُ لأنَّ العقلَ يُوجبُ تصدِيقَ من أتَى بمثلِ هذا الأمرِ الذي لا يُسْتَطاعُ معارضَتُهُ بالمثل مِن قِبَلِ المعارضينَ. فمن لم يُذعِنْ وعاندَ يُعَدُّ مُهْدِرًا لقِيمةِ البُرهانِ العقليّ.
من المعجزاتِ التي حصلَتْ لِمَنْ قَبْلَ سيّدِنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ومن أمثِلَةِ المعجزاتِ التي حَصَلَتْ لمن قبلَ محمَّدٍ عدَمُ تأثيرِ النّار العظيمةِ على إبراهيمَ حيثُ لم تُحْرِقْهُ ولا ثيابَهُ.
الشرح: سيدنا إبراهيمُ عليه السلام أرادَ منه قومُهُ أن يتركَ دينَهُ الذي هوَ عليه ويتَّبع دينَهم الباطل لعبادةِ غير الله فأبى فأضرموا له نارًا عظيمةً ما استطاعوا من قُوَّتها أن يقتربوا منها فقذفوهُ إليها بالمنجنيقِ ولكنَّ الله عزَّ وجلَّ سَلَّمهُ فكانت النارُ بردًا وسلامًا عليهِ فلم تحرقهُ ولا ثيابهُ وإنّما أَحرَقَت القيدَ الذي قَيَّدوهُ بهِ.
قال المؤلّف رحمه الله: ومنها انقلابُ عَصَا موسَى ثُعبانًا حَقيقيًّا ثم عودُها إلى حالتِها بعدَ أن اعترفَ السحَرةُ الذين أحضرَهُم فِرعونُ لمعارضتِه وأذعَنُوا فآمنوا بالله وكفروا بفرعونَ واعترَفُوا لموسى بأنَّهُ صادِقٌ فيما جَاءَ بهِ.
الشرح: مِن المعجزاتِ العظيمةِ التي حَصَلَت لسيّدنا موسى عليه السلام انقلابُ عصاهُ ثعبانًا حقيقيًّا، وذلك لما تحدَّى فرعونُ سيّدنا موسى، فجمعَ فرعونُ سبعينَ ساحرًا من كبارِ السّحرةِ الذين عندَهُ، فألْقوا الحبالَ التي في أيديهم فَخُيّلَ للناسِ أنّها حيّاتٌ تسْعى، فألقَى سيّدنا موسى بعصاهُ فانقلَبَ العَصَا ثعبانًا حقيقيًّا أكلَ تلكَ الحبال التي رماها السّحرةُ، فعرف السحرةُ أن هذا ليسَ من قبيلِ السّحْرِ وإنّما هو أمرٌ خارقٌ للعادَةِ لا يستطيعونَ معارضتهُ بالمِثل، فقالوا: ءامنَّا بربّ موسى وهارون، فَغَضبَ فرعونُ لأنهم ءامنوا قبلَ أن يأذنَ لهم وتركوا ما كانوا عليه فأضرَمَ لهم نارًا عظيمةً فلم يرجعوا عن الإيمانِ برب موسى وهارون فَقَتَلَهم.
قال المؤلّف رحمه الله: ومنها ما ظَهَرَ للمسيحِ من إحياءِ الموتَى وذلك لا يُسْتَطاعُ مُعارضَتُه بالمِثلِ فلم تسْتَطِعِ اليَهودُ الذين كانوا مُولَعِينَ بتكذيبهِ وحَريصينَ على الافتراءِ عليه أن يعارِضُوهُ بالمِثلِ. وقد أتى أيضًا بعجيبَةٍ أخرى عظيمةٍ وهي إبراءُ الأكْمَهِ فلم يستطِعْ أحَدٌ من أهلِ عصرِهِ معارضَتَهُ بالمِثلِ مع تَوفُّرِ الطِبّ في ذلك العصرِ. فذلك دليلٌ على صِدْقِهِ في كلّ ما يُخبِرُ به من وجوبِ عبادَةِ الخالقِ وحدَهُ من غيرِ إشراكٍ بهِ ووجوبِ متابعتِه في الأعمالِ التي يأمُرُهم بها.
الشرح: سيدنا عيسى عليه السلام من المعجزاتِ التي ظَهَرَت على يديهِ إحياءُ الموتى، والذي حَصَلَ أنهُ كانَ ملكٌ من الملوكِ محمولٌ على النَّعشِ يذهبونَ بهِ فَدَعَا الله تعالى سيدُنا المسيحُ عليه السلام أن يحييَه فأحياهُ الله، رأى اليهودُ ذلكَ ومع ذلكَ قالوا له أنتَ ساحرٌ.
وكذلكَ كانَ من معجزاتِهِ عليه السلام إبراءُ الأكمهِ أي الذي وُلِدَ أعمى، فقد كانَ يؤتى لهُ بالأعمى فيمسحُ لهُ على وجهِهِ بيدهِ الشريفةِ فيتعافى.
وكلُّ هذه المعجزات التي ذكرنَاها تدلُّ على صِدقِ هؤلاءِ الأنبياءِ وما جاءوا بهِ من وجوبِ الإيمانِ بالله وعبادتِهِ وحدهُ من غير إشراكٍ بهِ ووجوبِ طاعتِهم فيما يأمرونَ النَّاسَ بهِ. فَظَهَرَ بطلانُ قول بعضِ الملحدينَ في هذا العصر إن ما أتى به محمدٌ وعيسى من المعجزاتِ هو تخديرٌ لأفكارِ الناسِ وإنما هو من قبيلِ السحرِ، وبطلانُ هذا ظاهرٌ لأن السحرَ يعارَضُ بالمِثلِ وهذا الذي يظهرُه الله على أيدي الأنبياءِ من الخوارقِ لا يُعَارَضُ بالمِثلِ من قبيلِ السحرةِ، إنّما كلامُ هذا الملحدِ تمويهٌ على ضعفاءِ العقولِ لأن هؤلاء العوام لا يعرفونَ المعنى الفَارِقَ بين السحرِ والمعجزةِ.
من معجزاتِه صلى الله عليه وسلم
قال المؤلّف رحمه الله: من معجزاتِه صلى الله عليه وسلم
وأمّا محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فمِن معجزاتِهِ صلى الله عليه وعلى جميعِ إخوانِه الأنبياءِ: حنِيْنُ الجِذْعِ، وَذَلِكَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَسْتَنِدُ حينَ يَخطُبُ إلى جِذْعِ نَخْلٍ في مسجِده قبلَ أن يُعمَلَ له المنبرُ، فلمَّا عُمِلَ له المِنْبَرُ صَعِدَ صلى الله عليه وسلم عليه فبدأَ بالخُطبَةِ وهو قائمٌ على المنبرِ فحَنَّ الجِذْعُ حتّى سمِعَ حنِينَه مَنْ في المسجد، فنزلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فالتزَمَهُ – أي ضَمَّه واعتنقَه – فسَكَتَ.
الشرح: هذا الجذعُ الذي حَنَّ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم الله خَلَقَ فيهِ الإدراكَ والمحبَّةَ والشّوقَ لرسولِ الله فَحَنَّ من شدّةِ الشَّوقِ وكان هذا الجذعُ في قِبلَةِ المسجدِ.
وحديثُ حنينِ الجذعِ هذا متواترٌ كما أنَّ القرءانَ متواترٌ وهذه من أعجبِ المعجزاتِ ويصحُّ لقائلٍ أن يقولَ إنّها أعجبُ من إحياءِ الموتى الذي حَصَلَ للمسيحِ لأنَّ إحياءَ الموتى يتضمَّنُ رجوعَ هؤلاءِ الأشخاصِ إلى مِثلِ ما كانوا عليهِ قبل أن يموتوا، أما الخشبُ فهو من الجَمَادِ الذي لم يكن من عادتِهِ أن يتكلَّمَ بإرادةٍ فهو أعجبُ، هذا من أظهرِ المعجزاتِ.
قال المؤلّف رحمه الله: ومن معجزاتِهِ صلى الله عليه وسلم إنطَاقُ العَجْماءِ أي البهيمةِ. روى الإمامُ أحمدُ والبيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ من حديثِ يَعْلَى بنِ مُرَّةَ الثَّقَفيّ قال: بينما نسيرُ معَ النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرَّ بنا بعيرٌ يُسْنَى عليه فلمَّا رءاهُ البعيرُ جَرْجَرَ فوضَعَ جِرانَهُ فوقَفَ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أينَ صاحبُ هذا البعيرِ؟ فجاءَهُ فقالَ: بِعنِيْهِ، فقال: بل نَهبُهُ لكَ يا رسولَ الله وإنَّه لأهلِ بيتٍ ما لَهُمْ مَعِيشةٌ غيرُه، فقال النبيُّ: “أمّا ما ذكرتَ من أمرِه فإنّه شكَا كثرةَ العملِ وقِلَّة العَلفِ فأحْسِنُوا إليه”.
وأخرجَ ابنُ شاهينَ في دلائلِ النبوَّةِ عن عبدِ الله بنِ جعفرٍ قال: “أردَفَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم خلفَهُ فَدَخَلَ حائطَ رجلٍ من الأنْصارِ فإذا جَمَلٌ فلمّا رأى النَّبي صلى الله عليه وسلم حَنَّ فذرَفَتْ عيْنَاهُ فأتاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فمسَحَ ذفَراتِه فسَكنَ، ثمَّ قالَ: من ربُّ هذا الجملِ؟ فجاءَ فتًى من الأنصار، فقالَ: هذا لي، فقالَ: ألا تَتَّقي الله في هذه البهيمةِ التي ملَّكَكَ الله إيَّاها فإنَّه شَكَا إليَّ أنّكَ تُجيعُهُ وتُدْئِبُه”. وهو حديثٌ صحيحٌ كما قالَ المحدّثُ مُرْتضى الزبيديُّ في شرحِ إحياءِ علومِ الدّين.
ومنها تفجُّرُ الماءِ من بينِ أصابعِهِ بالمشاهدةِ في عدَّةِ مواطِنَ في مشاهِدَ عظيمةٍ وَرَدَتْ من طرُقٍ كثيرةٍ يُفيدُ مجموعُها العِلْمَ القطعيَّ المستفادَ من التَّواترِ المعنويّ ولم يَحصُلْ لغيرِ نبيّنا حيثُ نبعَ من عَظْمِهِ وعصَبِهِ ولَحمِهِ ودَمِهِ وهو أبْلَغُ من تفجُّرِ المياهِ من الحجرِ الذي ضرَبَهُ موسَى لأنّ خروجَ الماءِ من الحجارةِ معهودٌ بخلافِهِ من بين اللحمِ والدَّمِ. رواهُ جابرٌ وأنسٌ وابنُ مسعودٍ وابنُ عبّاسٍ وأبو ليلى الأنصاريُّ وأبو رافعٍ.
وقَد أخْرجَ الشَّيخانِ من حديث أنسٍ بِلَفْظِ: “رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقد حانَتْ صَلاةُ العَصْرِ والتمَسَ الوَضُوءَ فلَم يَجِدُوهُ فأُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بوَضُوءٍ فَوَضَعَ يدَهُ في ذلكَ الإناءِ فأمَرَ النَّاسَ أن يتوضَّؤوا فرأيتُ الماءَ يَنْبُعُ من بَيْنِ أصَابعِهِ فَتوضَّأَ النَّاسُ حتَّى توضَّؤوا منْ عِنْدِ ءاخِرِهم”. وفي روايةٍ للبُخاريّ قالَ الرَّاوِي لأَنَسٍ: كَم كُنْتُم؟ قَالَ: ثلاثَمِائةٍ.
ورَوى البُخاريُّ ومُسْلمٌ من حَديثِ جَابرٍ أيضًا: “عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحدَيْبِيَةِ وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ يدَيْه رَكْوةٌ يتَوضَّأُ مِنْها فَجَهَشَ النّاسُ فَقالَ: مَا لَكُمْ؟ فَقالوا: يَا رسُولَ الله ليسَ عندَنا ما نتَوضَّأُ بهِ ولا ما نَشْرَبُه إِلا ما بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوضَع يدَهُ في الرَّكْوةِ فَجعلَ الماءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أصَابِعِهِ كأمْثالِ العيُونِ، فشَرِبْنا وتَوضَّأْنا، فَقيْلَ: كَمْ كُنْتُم؟ قالَ: لَو كُنّا مائةَ ألفٍ لكَفَانا كُنّا خَمْسَ عشْرَة مائةً”.
والتَّحقيقُ أنَّ الماءَ كَانَ يَنْبُعُ مِنْ نَفْسِ اللّحمِ الكائِنِ في الأصابعِ وبهِ صرَّحَ النّوويُّ في شَرح مسلمٍ ويؤيّدُهُ قَولُ جَابرٍ: “فَرأيتُ الماءَ يَخْرُجُ”، وفي رِوَايةٍ “يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أصَابِعهِ”.
ومن مُعجزاتِه: ردُّ عَينِ قتادَةَ بعدَ انقِلاعِهَا فقَد روى البَيهقيُّ في الدّلائلِ عن قَتادَةَ بنِ النُّعمانِ أنّه أُصيبَت عَيْنُه يَومَ بَدرٍ فسَالَت حَدَقَتُه على وجْنَتِه فأرادُوا أنْ يقْطَعُوها فسَألُوا رسُول الله فَقالَ: لا، فدَعَا بهِ فغَمزَ حدَقَتَهُ براحَتِه، فكَانَ لا يَدْرِي أيَّ عيْنَيهِ أُصِيْبَت. اهـ.
وفي هَاتينِ المعجِزَتينِ قالَ بَعضُ المادِحينَ شِعْرًا من البَسِيطِ: إنْ كانَ مُوسَى سَقَى الأَسْباطَ من حَجَرٍ فإنَّ في الكفّ مَعْنًى ليسَ في الحجَرِ إنْ كانَ عيْسَى بَرَا الأَعْمَى بدَعوتِه فكمْ براحَتِه قدْ ردَّ مِنْ بَصَرِ الشرح: خروجُ الماءِ بين أصابعِ النّبي نظير ما أعطَى الله لموسى، فإنهُ لمّا جاءَ من أرض مصرَ مع عددٍ كبيرٍ من بني إسرائيلَ وهو قاصدٌ القدس قبل أن يصل إلى القدسِ بقيَ زمانًا في أرضٍ هي قبل القدسِ بمسافةٍ قصيرةٍ، هناك احتاجوا إلى الماءِ في تلك الأرضِ فأوحى الله إلى موسى: ﴿أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ [سورة الأعراف/160] فضربَ الحجرَ بعصاهُ فانبجَسَت من الحجرِ اثنتا عشرة عينًا، فوزَّعَ موسى هذه العيون التي خرجت من هذا الحجرِ الذي ضربَهُ بعصاهُ على الأسباط أي على القبائلِ التي كانت معهُ من بني إسرائيلَ المسلمين الذين هم من ذرّيةِ يعقوبَ وهو إسرائيل، فصاروا يأخذونَ من هذا الحجرِ ما يحتاجونَ إليه من الماءِ، ثمّ يمسكُ هذا الحجر ثم يفجّر ماءً بعدَ ذلكَ أيضًا ثم يمسكُ وهكذا ظلّوا زمانًا على هذه الحالِ.
الإسراء والمعراج
قال المؤلف رحمه الله: ومن مُعْجزاتِه تَسْبيحُ الطَّعَامِ في يَده أخْرجَ البُخاريُّ من حَديثِ ابنِ مَسْعُودٍ قالَ: “كنَّا نأكلُ معَ النّبي صلى الله عليه وسلم الطَّعامَ ونَحنُ نَسْمعُ تَسْبيحَ الطَّعام”. وهَذه المعجزاتُ الثّلاثُ أعجَبُ من إحْياءِ الموتَى الذي هو أحَدُ مُعْجِزاتِ المسِيحِ.
ومن مُعْجِزاتِه صلى الله عليه وسلم الإِسْراءُ والمِعْراجُ.
الإسْراءُ ثَبتَ بنَصّ القُرءانِ والحديثِ الصَّحيح فيَجبُ الإيمانُ بأنَّه صلى الله عليه وسلم أسْرَى الله به ليلًا من مكةَ إلى المسجدِ الأقصى.
الشرح: أجْمعَ أهلُ الحقّ من السّلفِ والخلفِ ومحدّثينَ ومتكلّمينَ ومفسّرينَ وعلماء وفقهاءَ على أنَّ الإسراءَ كانَ بالجسدِ والروحِ وفي اليقظةِ، وهذا هو الحقُّ، وهو قولُ ابن عبّاسٍ وجابرٍ وأنسٍ وعمرَ وحذيفةَ وغيرِهم، وقد قال العلماء: “إنَّ من أنكرَ الإسراءَ فقد كَذّبَ القرءانَ ومن كَذَّبَ القرءانَ فقد كَفَرَ”.
قال المؤلف رحمه الله: وأمَّا المعْراجُ فقدْ ثبتَ بنَصّ الأحَاديثِ. وأمَّا القرءانُ فلم ينُصَّ عليهِ نصًّا صَريحًا لا يَحتمِلُ تأويْلًا لكنَّهُ وردَ فيه مَا يَكَادُ يَكُونُ نَصًّا صَرِيحًا.
الشرح: المعراجُ لم يَرد في القرءانِ بنصّ صريحٍ لا يحتملُ التأويلَ إنّما وَرَدَ في القرءانِ ما يَدلُّ على المعراجِ لكنه ليس نصًّا صريحًا كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءاهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ (13) ﴿عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ (14) ﴿عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ (15) فمن فَهِمَ أن سدرةَ المنتهى في السماءِ ومع ذلك أَنكَرَ المعراجَ كَفَرَ، وأمّا إذا كانَ لا يعرفُ ولم يفهم ذلكَ من القرءانِ ولا اعتقدَ أن المسلمين هذا اعتقادهم فلا يَكفُرُ.
قال المؤلف رحمه الله: فالإسْراءُ قَد جاءَ فيه قَولُه تَعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءايَاتِنَا﴾ [سورة الإسراء/1].
الشرح: السَّبح في اللّغةِ التّباعُدُ، ومعنى سبِّح الله تعالى أي بَعِّدْهُ ونَزِّهْهُ عمّا لا يليقُ به من شَبَهِ المخلوقاتِ وصفاتِهم كالحجمِ اللطيفِ والحجمِ الكثيفِ وصفاتِهما كالألوانِ والحركاتِ والسّكناتِ والمقاديرِ كالصّغَرِ والكِبرِ والتّحيزِ في الجهةِ والمكانِ لأن كلّ ذلكَ نَزَّهَ الله نفسَهُ عنه بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ [سورة الشورى/11] فلو كانَ له حجمٌ كبيرٌ أو صغيرٌ لكانَ له أمثالٌ كثيرٌ.
وقولُهُ ﴿بِعَبْدِهِ﴾ (1) أي بمحمّد، قيل: لما وَصَلَ محمّدٌ عليه الصلاةُ والسّلامُ إلى الدَّرجاتِ العاليةِ والمراتِبِ الرّفيعةِ في المعراجِ أوحَى الله سبحانه إليه: يا محمّدُ بماذا أُشرّفُكَ، قال: بأن تنسبني إلى نَفسِكَ بالعبوديّةِ، فأنزلَ الله قوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ (1)، معناهُ أنّ هذه النسبة نسبة النَّبي إلى ربّهِ بوصفِ العبوديّةِ غايةُ الشَّرَفِ للرّسولِ لأنّ عبادَ الله كثيرٌ فَلِمَ خَصَّهُ في هذه الآية بالذّكرِ، ذلكَ لتخصيصِهِ بالشَّرَفِ الأعظمِ.
وقوله تعالى: ﴿لَيْلاً﴾ (1) نصب على الظَّرفِ. فإن قيلَ: فلماذا أتبَعَ بذكرِ الليلِ؟ قلنا: أرادَ بقولِهِ ﴿لَيْلاً﴾ (1) بلفظِ التّأكيدِ تقليلَ مدّةِ الإسراءِ فإنّهُ أُسرِيَ بهِ في بعضِ اللّيلِ من مكَّةَ إلى الشّامِ.
وأمّا المسجدُ الحَرَامُ فهو هذا الذي بمكَّةَ فقد سُمّيَ بذلكَ لحُرمَتِهِ أي لِشَرَفِهِ على سَائرِ المَساجدِ لأنّه خُصَّ بأحكامٍ ليست لغيرِهِ، ومضاعفةُ الأجرِ فيه أكثر مما في غيرِهِ إلى أضعافٍ كثيرةٍ جدًّا.
وأمّا المسجدُ الأقصَى فقد سُمّيَ بذلكَ لِبُعدِ المسافةِ بينهُ وبينَ المسجدِ الحرامِ.
وأمّا قولُهُ تعالى: ﴿الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ (1) قيلَ لأنّهُ مَقَرُّ الأنبياءِ ومهبطُ الملائكةِ، ولذلكَ قالَ إبراهيمُ عليه السلام ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [سورة الصافات/99] أي إلى حيث وَجَّهني ربّي إلى مكانٍ أمرني الله أن أذهبَ إليه، أي إلى بَرّ الشَّامِ لأنه عرفَ بتعريفِ الله إيّاهُ أن الشامَ مهبطُ الرحماتِ وأن أكثر الوحي يكونُ بالشامِ وأن أكثرَ الأنبياءِ كانوا بها، ولأن فلسطين ليست تحتَ حُكمِ النمرودِ، فَيستطيعُ أن يعبدَ الله فيها من غيرِ تشويشٍ، ومن غير أذًى يَلحقهُ، فانتقل من بلدِهِ العراق إلى فلسطين ثم بعدَ زمانٍ ذَهَبَ إلى مكّةَ، وترك سرّيّتَهُ هاجر وابنَهُ إسماعيل هناكَ ودَعَا الله تعالى أن يرزقَ أهلَ مكة من الثَّمراتِ فاستجابَ الله دعاءَهُ لأن مكَّةَ وادٍ ليس بها زرعٌ، فأمرَ اج جبريلَ أن ينقُلَ جبلَ الطّائفِ من برّ الشامِ إلى هناكَ فقلعَهُ جبريلُ ووضعَهُ هناك، وهذا الجبلُ فيهِ عنبٌ من أجودِ العنبِ وفيه الرمّانُ وفيه غير ذلك، وهواؤُهُ لطيفٌ جدًّا، وهو مصطافُ أهل مكَّةَ، ذكر ذلك الأزرقيُّ في كتابِ أخبارِ مكَّةَ، وهو كتابٌ جليلُ الفوائِدِ.
وأمّا قولُهُ تعالى: ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ ءايَاتِنَا﴾ (1) أي ما رأى تلكَ الليلة من العجائِبِ والآياتِ التي تدلُّ على قدرةِ الله.
وقد أسرَى الله تعالى بسيّدنا محمَّدٍ من مكَّة ليلًا إلى بيتِ المقدسِ، وقبلَ أن يصلَ إلى بيتِ المقدسِ مَرَّ بهِ جبريلُ على أرضِ المدينةِ وهذا قبلَ الهجرةِ إليها.
وهو بمكّةَ جاءَهُ جبريلُ ليلًا فَفَتَحَ سقفَ بيتِهِ ولم يهبِط عليهم لا ترابٌ ولا حجرٌ ولا شىءٌ، وكانَ النَّبيُّ نائمًا حينَهَا في بيتِ بنتِ عَمّه أمّ هانئ بنتِ أبي طالبٍ أخت عليّ بن أبي طَالبٍ في حيّ اسمهُ أجياد بين عَمّهِ حمزة وجعفر بن أبي طالبٍ فأيقَظَهُ جبريلُ ثم ذَهَبَ بهِ إلى المسجدِ الحَرامِ ثمّ أركبَهُ على البراقِ خلفَهُ وانطلقَ بهِ فوصلا إلى أرضِ المدينةِ فقالَ له جبريلُ: انزل فَنَزَلَ فقالَ له صلّ ركعتينِ فصلَّى ركعتينِ، ثم فَعَلَ مثل ذلك بطورِ سيناء حيثُ كانَ موسى لما سَمِعَ كلامَ الله، ثم انطلقَ فَوَصَلَ إلى مديَنَ وهي بلدُ نبيّ الله شعيبٍ فقالَ له انزل فَصَلّ ركعتينِ فَفَعَلَ، ثم مثل ذلكَ فَعَلَ في بيت لحمٍ حيثُ وُلِدَ عيسى ابن مريم عليه السّلام، ولمَّا وَصَلَ بيتَ المقدسِ صلّى بالأنبياءِ إمامًا، الله جَمَعهم له هناكَ كلهم تشريفًا له، بَعَثَهم الله وقد كانوا ماتوا قبلَ ذلك إلا عيسى فلم يكن ممن ماتَ بل كان في السماءِ حيًّا. ثم الله تبارك وتعالى زَادَ نبيَّهُ تشريفًا بأن رَفَعَ ثمانية من الأنبياءِ هم ءادمُ وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيمُ إلى السموات فاستقبلوه في السمواتِ، كما يأتي بيان ذلك في حديثِ أنسٍ ثمّ إنَّ جبريلَ عليه السّلام كانَ قد أخذَ النَّبيَّ قبلَ ذلك ووصلَ به إلى المسجدِ الحرامِ عند الكعبةِ حيث شقَّ صدرهُ من غير أن يحسَّ بألمٍ وغُسلَ بماءِ زمزمَ ثمّ جاءَ بطَسْتٍ من ذهبٍ ممتلئ حكمةً وإيمانًا فأفرَغها في صدرِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه سرَّ الحكمة والإيمان ثم أعادَهُ مثلما كانَ وذلك حتّى يتحمّلَ مشاهدةَ عجائب خلقِ الله، وكذلك شُقَّ صدر النَّبي لما كانَ صغيرًا وأخرجَ من قلبِهِ علقة سوداءُ هي حظُّ الشيطانِ من ابنِ ءادمَ حتَّى يظلّ طول عمرهِ محفوظًا من شرّ الشّيطانِ.
ومن عجائِبِ ما رَأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الإسراءِ ما رواهُ الطبرانيُّ والبزَّارُ من أنّه في أثناءِ سيرِهِ مع جبريل من مكةَ إلى بيتِ المقدس رأى الدُّنيا بصورةِ عجوزٍ، ورأى إبليسَ متنحيًا عن الطَّريقِ، ورأى المجاهدينَ في سبيلِ الله يزرعونَ ويحصدونَ في يومينِ، ورأى خطباء الفتنةِ الذين يدعونَ للضّلالِ والفسادِ تُقرضُ ألسنتُهُم وشفاهُهُم بمقاريضَ أي بمقصّاتٍ من نارٍ.
ورأى كيف يكونُ حال الذي يتكلمُ بالكلمةِ الفاسدةِ، وحال الذين لا يؤدّونَ الزّكاةَ، وحال تاركي الصّلاةِ، والزناة، والذين لا يؤدّونَ الأمانةَ، وءاكلي الرّبا، وءاكلي أموال اليَتَامى، وشاربي الخَمرِ، والذين يمشونَ بالغيبةِ، وشمَّ رائحةً طيّبةً من قبرِ ماشطة بنت فرعونَ وكانت مؤمنةً صالحةً وجاءَ في قصّتِهَا أنّها بينَما كانت تمشطُ رأسَ بنت فرعون سَقَطَ المشطُ من يدِها فقالت: بسمِ الله، فسألتها بنتُ فرعون: أَوَلَكِ ربٌّ إلهٌ غير أبي، فقالت الماشطةُ: ربّي وربُّ أبيكِ هو الله، فقالت: أ أخبر أبي بذلك، قالت: أخبريهِ، فأخبرتهُ فطلبَ منها الرّجوعَ عن دينها، فأبت، فحمَّى لها ماءً حتّى صارَ شديدَ الحرارةِ، متناهيًا في الحرارةِ، فألقى فيه أولادَها واحدًا بعد واحدٍ، ثمَّ لما جاءَ الدَّورُ إلى طفلٍ كانت ترضعُهُ تقاعَسَت، أي صارَ فيها كأنّها تَتَرَاجَعُ، ازداد خوفُها وانزعاجُها وقَلَقُهَا، فأَنطَقَ الله تعالى الرّضيعَ فقالَ: “يا أمّاهُ اصبري فإنّ عذابَ الآخرةِ أشدُّ من عذابِ الدّنيا فلا تتقاعسي فإنّكِ على الحَقّ” فتجالدَت فرمَى الطّفلَ، فقالت لفرعون: لي عندكَ طلبٌ أن تجمعَ العظامَ وتدفنها، فقالَ: لَكِ ذلكَ، ثمّ ألقاهَا فيه.
ثمَّ نصبَ المعراج والمعراجُ مرقاةٌ شبهُ السُّلَّمِ فَعَرَجَ بها النَّبيُّ إلى السّماءِ، وهذه المرقاةُ درجةٌ منها من فضّةٍ والأخرى من ذهبٍ، ثم استفتَحَ جبريلُ بابَ السّماءِ فقيل: من أنتَ؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن مَعَكَ؟ قال: محمّدٌ، قيل: وقد بُعِثَ إليهِ، قال: قد بُعِثَ إليهِ، وليس سؤال المَلَكِ عن سيدنا محمدٍ بقولِهِ: “وقد بُعِثَ إليه” لأنّه لم يكن قد عَلِمَ بِبِعثَتِهِ بل كانَ أَمرُ مبعثِهِ قد اشتهر في الملإ الأعلى، قيل إنّما هو لزيادةِ التأكُّدِ، وقيل: إن السؤالَ معناهُ هل بُعِثَ إليه للعروجِ. فرأى صلى الله عليه وسلم في السّماءِ الأولى ءادمَ، وفي الثانية رأى عيسى ويحيى، وفي الثالثةِ رأى يوسفَ، قال عليه الصلاة والسّلام في وصفه يوسف: “قد أُعطِيَ شَطرَ الحُسنِ” رواه مسلم، يعني نصف الجمالِ الذي وُزّعَ بين البشرِ، وفي الرابعةِ رأى إدريسَ، وفي الخامسةِ رأى هارون، وفي السّادسةِ رأى موسى، وفي السّابعةِ رأى إبراهيم وكان يُشبِهُ سيّدنا محمّدًا من حيثُ الخلقةُ. ثمّ رأى سِدرَةَ المُنتهى وهي شجرةٌ عظيمةٌ وبها من الحُسنِ ما لا يستطيعُ أحدٌ من خَلقِ الله أن يصفَهُ، من حُسنِ هذهِ الشّجرةِ وَجَدَها يَغشَاهَا فراشٌ من ذهبٍ أوراقُهَا كآذانِ الفيلةِ وثمارُها كالقِلالِ، والقلالُ جَمعُ قلَّةٍ وهي الجَرَّةُ العظيمةُ، أصلُها في السّادسةِ وتمتدُّ إلى السّابعةِ وإلى ما فوقَ ذلك، ثم سارَ سيّدُنا محمدٌ وحدَهُ حتّى وصلَ إلى مكانٍ يسمعُ فيه صريفَ الأقلامِ التي تنسخ بها الملائكةُ في صحفِها من اللوحِ المحفوظِ، ثم هناكَ أزالَ الله عنه الحجابَ الذي يمنَعُ من سماعِ كلامِ الله الذي ليس حرفًا ولا صوتًا فأسمعَهُ كلامه.
قال المؤلف رحمه الله: فإنْ قيلَ: قولُه ﴿وَلَقَدْ رَءاهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ (13) يحتَمِلُ أن يكونَ رؤيةً منامِيَّةً، قلْنَا: هذَا تأويلٌ ولا يَسُوغُ تأْويلُ النَّصّ أي إخراجُهُ عن ظَاهرِهِ لغيرِ دليلٍ عَقليّ قاطِعٍ أو سَمْعِيّ ثابتٍ كما قالَهُ الرَّازِيُّ في “المحْصُولِ” وغيرُهُ من الأصوليينَ. ولَيْسَ هنَا دليلٌ على ذلكَ.
الشرح: رأى محمّدٌ صلى الله عليه وسلم جبريلَ عليه السلام على صورتِهِ الأصليّةِ مرّةً أخرى أي مرّة ثانية عند سِدْرةِ المنتهى وهذا فيه إشارةٌ إلى المعراجِ لأن سدرةَ المنتهى أصلُها في السماءِ السادسةِ وتمتدُّ إلى السّابعةِ وإلى ما فَوقَ ذلك، ولكنَّ القرءانَ لم ينُصّ على المعراجِ نصًّا صريحًا لا يحتملُ تأويلًا لذلك قالَ بعضُ العلماءِ: من أنكرَ الإسراءَ كَفَرَ ومن أنكرَ المعراجَ لا يكفُرُ، لأن دليلَ المعراجِ ليس كدليلِ الإسراءِ دليلُ الإسراءِ أقوى. فإن قيل قولُهُ: ﴿وَلَقَدْ رَءاهُ﴾ (13) يحتملُ أن يكونَ رؤيةً مناميّةً، قلنا: هذا تأويلٌ ولا يجوزُ تأويلُ النصّ أي إخراجُهُ عن ظاهرِهِ لغيرِ دليلٍ عقليّ قاطعٍ أو سمعيّ ثابتٍ، والسَّمعيُّ ما كان قرءانًا أو حديثًا لأن طريقَهُ السمعُ، أمّا الدليلُ العقليُّ فيكونُ بالنظرِ الصحيحِ بالعقلِ. فلا يجوزُ لنا أن نؤوّلَ ءايةً أو حديثًا إلا بدليلٍ عقلي قطعيّ أو بدليلٍ سَمعي ثابتٍ أي صحيحٍ.
قال المؤلف رحمه الله: وقَد روى مُسْلمٌ عن أنس بن مَالكٍ رضيَ الله عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أُتِيتُ بالبُراقِ وهوَ دابَّةٌ أبيَضُ طَويلٌ فَوقَ الحمارِ ودُوْنَ البَغْلِ يضَعُ حافِرَهُ عندَ منتَهَى طرْفِهِ، قالَ: فركِبْتُه حتّى أتيتُ بيتَ المقْدِسِ فَربَطتُهُ بالحلَقَةِ التي يَربِطُ بها الأنبياءُ، قال: ثم دخَلْتُ المسجِدَ فَصلَّيتُ فيه ركْعتينِ، ثمَّ خَرجْتُ فجاءَني جبريلُ عليه السلام بإناءٍ من خَمرٍوإنَاءٍ منْ لَبَنٍ فاختَرتُ اللّبَنَ، فقالَ جبريلُ عليه السلامُ: “اختَرْتَ الفِطْرَةَ قال: ثمّ عَرَجَ بنَا إلى السَّماءِ….”، إلى ءاخِرِ الحديثِ.
وفي الحديثِ دَليلٌ على أنَّ الإسْراءَ والمعْراجَ كانَا في ليلةٍ واحدةٍ برُوْحِهِ وجَسَدِهِ يقَظَةً إذْ لم يَقلْ أحَدٌ إنَّهُ وَصَلَ إلى بَيْتِ المقْدِسِ ثُمَّ نَامَ.
أما رُؤْيةُ النبي لرَبّه ليلة المعراج فقد رَوَى الطَّبرانيُّ في المُعْجَمِ الأَوْسطِ بإسْنادٍ قَويّ كما قالَ الحافظُ ابن حجر عن ابنِ عَبّاسٍ رضي الله عنْهما: “رأَى محمَّدٌ ربَّهُ مَرّتينِ”، وروى ابنُ خُزَيْمةَ بإسْنادٍ قَوِيّ: “رأَى محمَّدٌ رَبَّهُ”، وَالمرادُ أنَّه رءاهُ بقَلْبِهِ بدَليلِ حَديثِ مُسْلمٍ من طَريقِ أبي العاليةِ عن ابنِ عَبَّاسٍ في قولِهِ تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (11) ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى﴾ (12) ﴿وَلَقَدْ رَءاهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ (13) [سورة النجم]، قال: “رَأَى رَبَّهُ بفؤادِه مرَّتينِ”.
تَنْبِيهٌ: قالَ الغَزاليُّ في إحياءِ علومِ الدّينِ: “الصَّحيحُ أنَّ النّبيَّ لم يرَ ربَّهُ لَيلَةَ المعْراجِ”، ومرادُه أنه لم يرَهُ بِعَيْنِه إذْ لم يَثبُتْ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ رأيْتُه بعَيْني ولا أنَّ أحدًا من الصَّحابةِ أو التّابعينَ أو أتْباعِهم قال: رءاهُ بعَيْنَي رأسِه.
الشرح: الله تعالى أزالَ عن قلبِ النَّبي صلى الله عليه وسلم الحجابَ فرأى الله تعالى بقلبِهِ أي جَعَلَ الله له قوّةَ الرّؤيا والنَّظر بقلبِهِ، فرأى الرسولُ ربَّهُ بقلبِهِ ولم يرهُ بعينِهِ لأنَّ الله لا يُرَى في الدُّنيا بالعينِ ولو كانَ يراهُ أحدٌ بالعينِ لكانَ رءاهُ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا” رواه مسلم، كما يُفهَمُ ذلكَ أيضًا من قولِهِ تعالى لِسيدنا موسى: ﴿لَن تَرَانِي﴾ (143) . وقد رُوِيَ أنّهُ قيلَ لرسولِ الله: هل رأيتَ ربَّكَ ليلةَ المعراجِ فقال: “سبحانَ الله سبحانَ الله رأيتُهُ بفؤادي وما رأيتُهُ بعيني” وهذا ضعيف لم يثبت. وقالَ الإمامُ مالكٌ رضي الله عنه: “لا يُرَى الباقي بالعينِ الفانيةِ وإنَّما يُرَى بالعينِ الباقيةِ في الآخرةِ” أي أنَّ عيونَ أهلِ الجنةِ لا يلحقُهَا الفناءُ لأنّهم لا يموتونَ أبدَ الآبدينَ.
وأمّا قولُ بعضِ أهلِ السّنةِ أنّه صلى الله عليه وسلم رأى ربَّهُ ليلةَ المعراجِ بعيني رأسِهِ فهذا قولٌ ضعيفٌ ومن قاله لا يبدَّعُ ولا يفسَّقُ لأنّه قالَ به جَمعٌ من السّلفِ الصّالحينَ، فمن قالَ بذلكَ يُقالُ له: هذا القولُ مرجوحٌ والقولُ الرَّاجِحُ أنّه رءاهُ بفؤادِهِ أي بقلبِهِ لا بعينَيهِ كما ثَبتَ ذلك عن أبي ذرّ الغفاريّ رضي الله عنه قال: “رءاهُ بقلبِهِ ولم يرهُ بعينِهِ”، ونحنُ على هذا القول.
تكميل: حديث ماشطة بنت فرعون صحيح رواه ابن حبان وصححه.
وجْهُ دِلالةِ المعجِزةِ على صِدْقِ النَّبي صلى الله عليه وسلم
قال المؤلف رحمه الله: وجْهُ دِلالةِ المعجِزةِ على صِدْقِ النَّبي صلى الله عليه وسلم
الأَمرُ الخارقُ الذي يَظهرُ على يدِ من ادَّعَوا النُّبُوَّةَ مع التَّحدي مع عدَمِ معارضَتِه بالمِثلِ نازِلٌ مَنْزِلَةَ قَولِ الله صدَقَ عَبْدِي في كُلّ مَا يُبَلّغُ عنّي، أي لولا أنَّه صادِقٌ في دَعْواهُ لما أظْهَرَ الله لَهُ هذه المعْجِزةَ، فكأنَّ الله تعالى قالَ صَدَقَ عبْدِي هذا الذي ادّعى النُّبُوة في دَعْواهُ لأَنّي أظْهَرتُ له هذه المعجزةَ، لأنَّ الذي يُصَدّقُ الكاذِبَ كاذبٌ، والله يَسْتحيلُ عليه الكَذبُ. فدَلَّ ذلكَ على أنَّ الله إنَّما خلَقَهُ لتَصْديقه، إذْ كلُّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ أَنّ إحْياءَ الموتى وقلبَ العَصا ثُعْبانًا وإخْراجَ نَاقةٍ من صَخْرةٍ صَمَّاءَ لَيسَ بمعْتادٍ.
الشرح: معنى قوله “نازلٌ منزلة قول الله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني”، أي كأنَّ الله تعالى قَالَ صَدقَ عَبدي مُوسَى في كلّ ما يُبلّغُ عنّي، صدَق عبدي عيْسى في كلّ ما يُبلّغُ عنّي، صَدقَ عبدي محمّدٌ في كلّ ما يبلّغُ عنِّي.
السَّبيلُ إلى العلْمِ بالمعْجِزةِ بالقَطْعِ واليَقِينِ
قال المؤلف رحمه الله: السَّبيلُ إلى العلْمِ بالمعْجِزةِ بالقَطْعِ واليَقِينِ
العلمُ بالمعجزاتِ يحصُلُ: بالمشاهدةِ لمن شَاهَدوها، وببلوغِ خَبَرِهَا بطريقِ التَّواتُرِ في حَقّ من لم يَشهَدهَا، وذلك كعِلمِنَا بالبلدانِ النَّائيةِ والحوادثِ التَّاريخيّةِ الثّابتةِ الواقعةِ لمن قَبلنا من الملوكِ والأُمَمِ، والخبرُ المتواترُ يقومُ مقامَ المشاهدةِ، فَوَجَبَ الإذعانُ لمن أتى بها عقلًا كما أنَّهُ واجبٌ شرعًا.
الشرح: المعجزةُ تدلُّ على صدقِ الأنبياءِ في كلّ ما جاؤوا به وهي دليلٌ على صِدقهم شرعًا وعقلًا، أمّا العلمُ بثبوتِ المعجزاتِ فَيُعلَمُ بطريقِ العلمِ اليقينيّ لأنّها جَاءت بخبرِ التَّواتُرِ، وخبرُ التواتُرِ لا يكونُ إلا صدقًا.
والخبرُ المتواترُ هو أن يُخبِرَ عددٌ كثيرٌ عن جمعٍ كثيرٍ بحادثةٍ قوليّةٍ أو فعليّةٍ بحيثُ لا يُمكِنُ عادةً أن يتواطؤا على الكذبِ، كالأخبارِ المتواترةِ بين النّاسِ عن وجودِ فرعونَ فيما مَضَى، وكالأخبارِ عن وجودِ بلدانٍ نائيةٍ نحن ما شاهدناها، والأخبارِ عن إنسانٍ اسمه لينين وَضَعَ كذا وكذا من المَبَادِئ، فيقالُ للمعتَرِضِ: فكما أنتَ صَدَّقتَ بهذا نحنُ صَدَّقنا بالمعجزاتِ، أمّا أن تؤمنَ بخبرِ لينين مع أنّكَ لم تَرَهُ ولا تؤمنَ بأنَّ النّبيَّ حَصَلَ لهُ كذا فهذا تحكُّمٌ ليسَ مجاراةً للواقِعِ بل أنتَ شاذٌّ مكابِرٌ.
وقد اختُلِفَ في حَدّ التّواترِ على أقوالٍ والمعتمدُ أن لا نحدّدَ عددًا بل نقولُ جَمعٌ يستحيلُ تواطؤهم على الكذبِ عادةً في أمرٍ حسّيّ شُوهِدَ بالمعايَنَةِ.
ثمّ يُقالُ للمعتَرِضِ: معجزاتُ الأنبياءِ ثابتةٌ مع أنّنا لم نشاهدهم فإذًا يجبُ علينا أن نصدّقَهُم بمَا جاءوا به، وتكذيبُكُم للأنبياءِ مردودٌ عليكم لأنّكم تُكَذّبونَ ولا تستطيعونَ أن تأتوا بما أَتَوا به. أخبارُ الأنبياءِ التّاريخُ سَجَّلَهَا، نحنُ من أيّامِ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم تواتَرَ إلينا خبرُ نبعِ الماءِ من بينِ أصابعِ النّبي وخبر حنينِ الجذعِ وغير ذلكَ من المعجزاتِ، فالخبرُ المتواترُ مثل المشاهدَةِ لمن لم يشاهِد لأنَّ أصلَهُ مشاهدةٌ.
تنبيهٌ: شرطُ المتواترِ أن تكونَ تلك الكثرةُ في الطبقةِ الأولى التي شاهدَت والتي تليها ثم التي تليها، وهذا التواترُ لم يحصل بالقولِ في خبرِ أن المسيحَ قُتِلَ وصُلِبَ بل لم يحصل هذا العددُ في الطبقةِ الأولى، والطبقةُ الأولى هي الأصلُ لأنه إن لم يحصل هذا العددُ في الطبقةِ الأولى ثم حَصَلَ فيما بعدَ ذلكَ لا يُعَدُّ متواترًا، ومن هذا القبيلِ خَبَرُ قَتلِ المسيحِ وصلبِهِ عليهِ السلامُ.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة