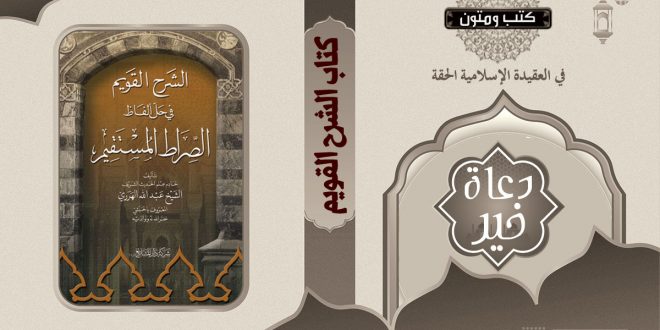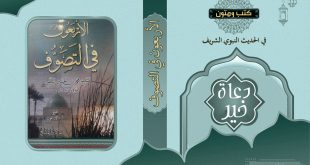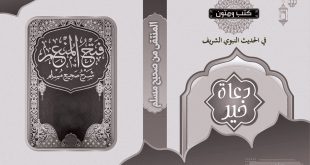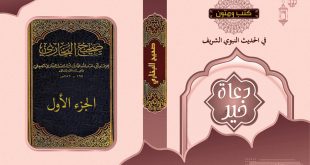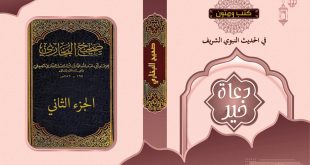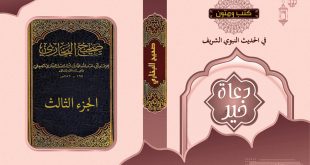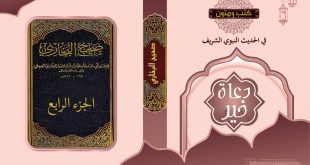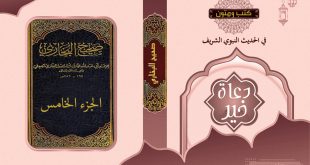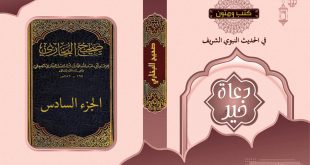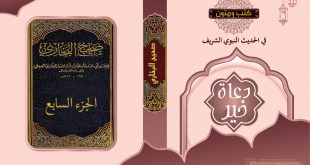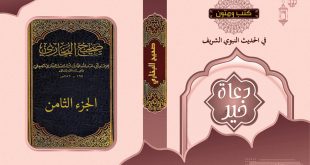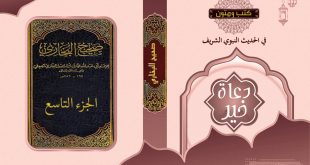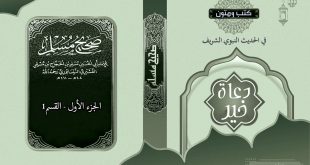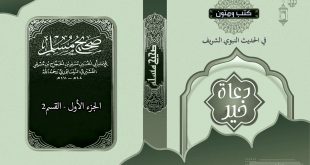النُّبُوَّةُ
قال المؤلف رحمه الله: النُّبُوَّةُ
اشتِقاقُها من النّبَإ أي الخبَرِ لأنّ النُّبُوّةَ إخْبارٌ عن الله، أو من النَّبْوَةِ وهي الرّفْعَةُ، فالنَّبيُّ على الأوّلِ فعِيلٌ بمعنى فاعلٍ لأنَّهُ يُخبِرُ عن الله بما يُوْحَى إليه، أو فعِيلٌ بمعنى مفعولٍ أي مُخْبَرٌ عن الله أي يُخبِرُهُ المَلَكُ عن الله، فالنبوَّةُ جائزةٌ عقلًا ليست مستحيلةً.
الشرح: النَّبأُ معناهُ الخَبَرُ، أمّا النَّبوةُ معناها الارتفاعُ، فلفظُ النبي إمَّا مشتقٌّ من النبإ أي الخبرِ أي الإخبارِ أو من النَّبوةِ أي الارتفاعِ وكلاهما صحيحٌ، إن قلنا من النبإ أي الإخبارِ فمعناه أن الأنبياءَ يُخبرونَ عن الله، وإن قلنا النبيُّ مأخوذ من النَّبوةِ أي الارتفاعِ فمعناه الأنبياءُ درجاتُهُم مرتفعةٌ عاليةٌ.
قال المؤلف رحمه الله: وإنَّ الله تعالى بعثَ الأنبياءَ رحمةً للعبادِ إذْ ليسَ في العقلِ ما يُستَغْنَى به عنهم لأنّ العقلَ لا يَسْتَقِلُّ بمعرفةِ الأشْياءِ المنْجِيَةِ في الآخرةِ.
الشرح: العقلُ وحدَهُ لا يكفي للنَّجاةِ. الكفّارُ فيهم عقلٌ طبيعيٌّ لكن مع ذلك هم من أهلِ النّارِ لأنهم لم يشكروا المنعم وهو الله فإن شكر المنعم لا يكون إلا بالإيمان به وبرسوله الذي أرسله ليتبعه الناس. الكافر مهما أحسن إلى الناس وأعان الفقراء والملهوفين لا يكون شاكرًا لله الذي خلقه ومنّ عليه بالعقل والشكر الذي فرضه الله على عباده ورضيه لهم ليس قولَ الشكرُ لله ولذلك هذه الكلمة الشكرُ لله ليست من الأذكار الواردة الواجبة أما الحمد لله فهو وارد في القرءان يقال في الصلوات الخمس على الوجوب لأنه جزء من الفاتحة التي قراءتها واجبة. أما الشكر لله فهو من كلمات الذكر المشروعة على الاستحباب فلو عاش العبد المؤمن ولم يقل في عمره الشكر لله فهو شاكر إن اتقى الله تعالى. لذلك من الحكمة بعثة الأنبياء، الأنبياءُ هم الذين يعلّمونَ النّاسَ ما يُنجي في الآخرةِ وما يُهْلك في الآخرةِ.
قال المؤلف رحمه الله: ففي بِعْثَة الأنبياءِ مصلحةٌ ضروريّةٌ لحاجتِهم لذلكَ، فالله متفضّلٌ بها على عبادِهِ فهيَ سَفَارةٌ بين الحقّ تعالى وبين الخَلْقِ.
الشرح: بعثةُ الأنبياءِ مصلحةٌ ضروريّةٌ للعبادِ، الله تعالى تكرَّمَ على العبادِ بأن أرسلَ إليهم أنبياء، هذا فضلٌ منه ولو لم يرسل الأنبياءَ لم يكن ظالمًا.
وليُعلَم أن النبوّةَ خاصّةٌ بالذّكورِ من البشرِ فلا نبيّة في النساءِ كما قال جمهورُ العلماءِ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ﴾ [سورة النحل/43] فهذه الآيةُ فيها دليلُ اختصاصِ الرّسالةِ بالذّكورِ وهم من الإنسِ فقط.
وليُعلَم أنَّ جبريلَ هو الذي ينزلُ بالوحي على الأنبياءِ في أكثرِ الأوقاتِ وفي بعض الأحيانِ قد ينزل غيرُهُ، والوحيُ إمَّا أن يكون بواسطةِ مَلَكٍ أو بسماعِ كلامِ الله الأزلي أو بالإفاضَةِ على قلبِ النَّبي.
الفَرقُ بين الأنبياءِ والرُّسُلِ
قال المؤلف رحمه الله: الفَرقُ بين الأنبياءِ والرُّسُلِ
اعلم أن النبيَّ والرَّسولَ يشتركانِ في الوَحي، فكلٌّ قد أوْحَى الله إليه بشرعٍ يَعْمَلُ به لتبليغِه للنّاسِ، غيرَ أنّ الرسولَ يأتي بنسخِ بعضِ شرعِ مَن قبلَه أو بِشَرْعٍ جديدٍ.
الشرح: الرسولُ ينزلُ عليه الوحيُ بشرعٍ يعملُ به ويُوحَى إليهِ بنسخِ بعضِ شرعِ من قبلَهُ، أي بنسخِ بعضِ الأحكامِ التي كانت في زمنِ الرّسولِ الذي قبلَهُ أو ينزل عليه حكمٌ جديدٌ لم ينزل على من قبلهُ من الأنبياءِ، هذا يقالُ له رسولٌ، أمّا الذي لم ينزل عليه شىءٌ جديدٌ إلا أن يعمَلَ بشريعةِ الرسولِ الذي قبلَهُ كأن أُمِرَ فقيلَ له بلِّغ شريعةَ موسى مثلًا، فهذا يقالُ له نبيٌّ ولا يقالُ له رسولٌ.
وقد وردَ أن عددَ الأنبياءِ مائةٌ وأربعةٌ وعشرونَ ألف نبي فيهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا أخرجَهُ ابنُ حبان وصَحَّحَهُ، أوّلهم سيدُنا ءادمُ وءاخرهم سيدنا محمد وخيارُهم محمدٌ ثم إبراهيمُ ثم موسى ثم عيسى ثم نوحٌ صلواتُ الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما حديث: “لا تُخَيّروا بين الأنبياء” رواه البخاري ومسلم، فمعناه لا تدخلوا في التفضيل بآرائكم لأن التفضيل بين الأنبياء بالرأي لا يجوز إنما التفضيل بالوحي فمن أخبر الله تعالى أنهم أفضل من غيرهم من الأنبياء فهم الأفضلون أما نحن بآرائنا لا نفضّل.
قال المؤلف رحمه الله: والنَّبيُّ غيرُ الرّسولِ يُوحَى إليه ليتّبعَ شرعَ رسولٍ قبلَهُ ليُبلّغَهُ.
الشرح: هذا الفرقُ بين النبي والرسولِ هو الصحيحُ وأما ما ذَكَرَهُ بعضُ المتأخرينَ في مؤلفاتهم من أن النبيَّ من أوحيَ إليه بشرعٍ ولم يؤمر بتبليغِهِ فهو فاسدٌ بعيدٌ من معنى النبوةِ فليُحذَر، وهذا التفسيرُ الصحيحُ ذكرَهُ كثيرٌ كالإمامِ الجليلِ شيخِ الشافعيةِ والأشاعرةِ أبي منصورٍ البغدادي والقونوي شارحِ الطحاويةِ والمُناويّ.
قال المؤلف رحمه الله: فلذلكَ قالَ العلماء: “كلُّ رسولٍ نبيٌّ وليس كلُّ نبيٍّ رسولا”، ثمّ أيضًا يفترقان في أنّ الرّسالةَ يوصَفُ بها المَلَكُ والبشرُ والنبوةَ لا تكونُ إلا في البشرِ.
الشرح: الرّسلُ أفضلُ من الأنبياءِ غيرِ الرّسلِ فكلُّ من كانَ رسولا نبيٌّ وليس كلُّ من كانَ نبيًّا رسولًا، ثم الرّسالةُ يوصَفُ بها المَلَكُ والبَشَرُ أمّا النّبوّةُ فلا تكونُ إلا في البشرِ، الملائكةُ فيهم رسلٌ منهم جبريلُ عليه السلام فهو رسولٌ من الملائكةِ كذلك يوجدُ غيرُهُ يرسلهُ الله إلى الملائكةِ ليبلّغَ الوحيَ، الله تعالى يأمرهم بأن يبلّغوا طائفةً من الملائكةِ بأمرٍ، قالَ الله تعالى: ﴿اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ﴾ [سورة الحج/75] الله يختارُ من بين الملائكةِ رسلًا ومن بين البشرِ رسلًا فجبريلُ سفيرٌ بينَ الله وبين الأنبياءِ والرُّسلِ مِنَ البشرِ وبينَ الله وبينَ الملائكةِ أيضًا.
ما يجبُ للأنبياءِ وما يستحيلُ عليهم
قال المؤلف رحمه الله: ما يجبُ للأنبياءِ وما يستحيلُ عليهم
يجبُ للأنبياءِ الصّدْقُ ويستحيلُ عليهم الكَذبُ، وتجِبُ لهمُ الفَطَانَةُ ويستحيلُ عليهمُ البَلادَةُ والغَباوةُ، وتجبُ لهم الأمَانَةُ.
فالأنبياءُ سالمونَ من الكفرِ والكبائرِ وصغائرِ الخِسَّةِ وهذه هي العِصْمَةُ الواجبةُ لهم، ويستحيلُ عليهم الخيانةُ ويجبُ لهم الصّيانةُ فيستحيلُ عليهم الرَّذالَةُ والسَّفاهةُ والجُبنُ وكلُّ ما ينفّر عن قبول الدعوة منهم.
الشرح: يجبُ للأنبياءِ الصّدقُ ويستحيلُ عليهم الكَذِبُ وقد كانَ سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم معروفًا بين أهل مكّةَ بالأمينِ لما عُرِفَ به من الصّدقِ والأمانةِ والنزاهةِ، لم تجرّب عليه كذبة قَطّ كلّ المدة التي قَضَاهَا قبلَ أن ينزلَ عليه الوحيُ وهي أربعونَ سنة، فالكذبُ نقصٌ يُنافي منصبَ النبوّةِ.
ويجبُ للأنبياءِ الفَطانةُ أي الذَّكاءُ فكلُّهم كانوا أذكياءَ فطناءَ أصحابَ عقولٍ كاملةٍ قويّةِ الفهمِ. ويستحيلُ عليهم البلادةُ والغباوةُ فليسَ فيهم بليدٌ أي من هو ضعيفُ الفَهمِ لا يفهمُ الكلامَ بسرعةٍ إلا بعد أن يُكرَّرَ عليه عدّةَ مرّاتٍ ولا مَن هو ضعيفٌ عن إقامةِ الحُجَّةِ لمن يعارضهُ بالبَيانِ وليس فيهم من هو غبيٌّ أي فهمُهُ ضعيفٌ، لأنهم لو كانوا أغبياءَ لَنَفَرَ النّاسُ منهم لغباوتهم، والله حكيمٌ لا يفعلُ ذلك، فإنّهم أُرسلوا ليبلّغوا الناسَ مصالحَ ءاخرتِهم ودنياهم، والبلادةُ تنافي هذا المطلوبَ منهم.
ويجبُ للأنبياءِ الأمانةُ فيستحيلُ عليهم الخيانةُ في الأقوالِ والأفعالِ والأحوالِ فإذا استنصحهم شخصٌ لا يكذبونَ عليه فيوهمونَهُ خلاف الحقيقةِ وإذا وَضَعَ عندهم شخصٌ شيئًا لا يضيعونَهُ.
والأنبياءُ سالمونَ من الكفرِ والكبائرِ وصغائرِ الخسَّةِ أي التي تدلُّ على دناءةِ النفسِ كسرقةِ حبَّةِ عنبٍ قبلَ النبوّةِ وبعدَها وهذه هي العصمةُ الواجبةُ لهم، ويجوزُ عليهم ما سوَى ذلك من المعاصي لكن ينبَّهونَ فورًا للتوبةِ قبل أن يقتديَ بهم فيها غيرهم. وبهذا يجابُ عما قالهُ بعضُ المتأخرينَ من الأشاعرةِ كالسنوسيّ في كتبه الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى، وابن عاشر من المالكية، حيث أوجبوا للأنبياءِ العصمةَ من الحرامِ والمكروهِ محتجينَ بأنه لو كانَ يحصلُ منهم معصيةٌ ما أو مكروهٌ لانقلبت المعصيةُ والمكروهُ طاعةً لأننا مأمورونَ بالاقتداءِ بهم، يقال: إنَّ ذلكَ يندفعُ بما ذُكِرَ أن الله تعالى يُلهِمُهُم التوبةَ من ذلكَ قبل أن يقتديَ بهم أحدٌ وبذلكَ يزولُ المحذورُ.
ويدلُّ على جوازِ حصولِ ذلك منهم قولُهُ تعالى: ﴿وَعَصَى ءادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [سورة طه/121]، وءاياتٌ أخرى كقولِهِ تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [سورة محمد/19].
تنبيه: يجب الحذر من قول بعض الناس إن ءادم كان مأمورًا باطنًا بالأكل من الشجرة منهيًا ظاهرًا كما في حاشية الصاويّ على الدردير، وهذا كلام لا معنى له. كيف يجتمع الأمر والنهي في شىء واحد.
وممَّا يجبُ للأنبياءِ الصّيانةُ فيستحيلُ عليهم الرّذالةُ كاختلاسِ النَّظَرِ إلى الأجنبيّةِ بشهوةٍ وكسرقةِ حبّةِ عنبٍ، وكذلك يستحيلُ عليهم السفاهَةُ كالذي يقولُ ألفاظًا شنيعةً، وكذلكَ يستحيلُ عليهم الجُبنُ فالأنبياءُ هم أشجعُ خلقِ الله، وقد قالَ بعضُ الصّحابةِ: “كنَّا إذا حَمِيَ الوَطيسُ في المعركةِ نحتمي برسولِ الله صلى الله عليه وسلم”، فقد أعطَى الله نبيَّنَا قوّةَ أربعينَ رجلًا من الأشدّاءِ.
عصمةُ الأنبياءِ فضلٌ من الله ولطفٌ بهم ولكن على وجهٍ يبقى اختيارُهم بعدَ العصمةِ في الإقدامِ على الطاعةِ والامتناعِ عن المعصيةِ وإلى هذا القول مالَ الشيخُ أبو منصور الماتريديُّ، وهو القولُ السّديدُ وعليه الاعتمادُ إذ لولا ذلكَ لكانوا مجبورينَ في أفعالِهم ومن كانَ مجبورًا على فعلِ الطَّاعَةِ والامتناعِ عن المعصيةِ لا يكون مأجورًا في فعلِهِ وتركِهِ.
وأمّا قولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ [سورة يوسف/24] فقد قيلَ فيه نحو خمس تأويلات وأحسنُ ما قيلَ في ذلكَ أن يقالَ: قولُهُ تعالى:﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ (24) مربوطٌ بما بعدَه بـ ﴿لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ (24) فيكونُ على هذا التفسير ما همَّ يوسف بالمرّةِ لأنَّه رأى البرهانَ، أمَّا لو لم ير البرهانَ لهمَّ، والبرهانُ هو العصمةُ أي أنّه أُلهِمَ أن الأنبياءَ معصومونَ عن مثل هذا الشىء وأنّه سيؤتى النّبوةَ فلم يهمّ، هذا أحسنُ ما قيلَ في تفسيرِ هذه الآية.
والخلاصَةُ أنّ الأنبياءَ لا يقعونَ في الزّنى ولا يهمّونَ بهِ. وقال بعض علماء المغاربة معنى “ولقد همت به” أي همت بأن تدفعه ليزني بها وهمّ يوسف بدفعها ليخلص منها وهذا التفسير شبيه بما ذكر ءانفًا.
تنبيْهٌ مُهِمٌّ
إنَّ ممَّا يجبُ للأنبياءِ التّبليغَ فكلُّ الأنبياءِ مأمورونَ بالتّبليغِ وقد دلَّ على ذلك قولُهُ تعالى في سورة الحجّ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ (52).
فمعنى تمنَّى في هذه الآيةِ دعا قومَهُ، ومعنَى ألقى الشّيطانُ في أمنيّته أي يزيد الشيطانُ على ما قالوه ما لم يقولوه ليوهموا غيرَهم أن الأنبياءَ قالوا ذلكَ الكلام الفاسد، وليس معناهُ أن الشيطانَ يتكلَّمُ على لسانِ النبي فقد قال الفخرُ الرّازيُّ: يكفرُ من قالَ إن الشّيطانَ أجرَى كلامًا على لسانِ النّبي هو مدحُ الأوثانِ الثلاثةِ اللات والعُزى ومناة بهذه العبارة: تلكَ الغرانيقُ العُلى وإنَّ شفاعَتهُنّ لتُرتَجى، إذْ يستحيلُ أن يمكّنَ الله الشيطانَ من أن يجري على لسانِ نبيّهِ مدحَ الأوثانِ، وإيضاحُ هذه القضيةِ أن الرسولَ كان يقرأُ ذاتَ يومٍ سورةَ النجمِ فلمّا بَلَغَ91! ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى﴾ (19) ﴿وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى﴾ (20) انتهزَ الشيطانُ وقفةَ رسولِ الله وسكتتَهُ فأسمَعَ الشيطانُ المشركينَ الذين كانوا بقربِ النبي مُوهمًا لهم أنه صوت النبي هذه الجملةَ “تلكَ الغرانيقُ العُلى وإن شفاعتهن لتُرتَجى” فَفَرِحَ المشركونَ وقالوا ما ذكرَ محمدٌ ءالهتنا قبلَ اليومِ بخيرٍ فجاء جبريل فقال له هذا ليس من القرءان فحزن الرسول فأنزل الله هذه الآية تسلية له ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ ءايَاتِهِ﴾ (52) . والصحيح أن الله أنزل الآية المذكورة ءانفًا لتكذيبهم فقوله تعالى: ﴿فَيَنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ (52) أي يكشِفُ الله ويبيّنُ أنه ليس من الأنبياء، وذلك ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ ليتَميَّزَ من يتَّبِعُ ما يقوله الشيطانُ ومن لا يتّبعُ فيهلك هذا ويسعد هذا.
وليسَ في قولِ النبي صلى الله عليه وسلم: “كانَ النبيُّ يرسَلُ إلى قومِهِ وأُرسلتُ إلى الناسِ كافَّةً” أنَّ من سوى نبيّنا محمد لم يجب عليهِ أن يبلّغَ مَن هم مِن سوى قومِهِ إنّما المعنَى أن الأنبياءَ غير نبيّنا أرسلوا إلى أقوامهم أي أنَّ النَّصَّ لهم كانَ أن يبلّغوا قومَهم ليس معناه أنهم لا يبلّغون سوى قومهم لأن الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عنِ المنكرِ واجبٌ على كل من استطاعَ من أفرادِ المكلفين وذلك في حقّ الأنبياءِ أَوكَدُ.
وليُعلَم أن كلَّ الأنبياءِ فصحاءُ فليس فيهم أرتّ وهو الذي يكونُ في لسانِه عقدة وحبسة ويعجل في كلامِهِ فلا يطاوعهُ لسانهُ، ولا تَأتَاءُ ولا ألثغ، وأمّا الألثغُ فهو الذي يُصَيّرُ الراءَ غينًا أو لامًا والسّينَ ثاءً وأنّه يستحيلُ عليهم سبقُ اللسانِ في الشَّرعيّاتِ والعاديّات، لأنّه لو جازَ عليهم لارتفعت الثّقةُ في صحّةِ ما يقولونه ولقالَ قائلٌ لما يبلغهُ كلامٌ عن النبي “ما يدرينا أنّه يكون قالهُ على وجهِ سَبقِ اللسانِ”، فلا يحصلُ من النّبي أن يصدرَ منه كلامٌ غيرُ الذي أرادَ قوله، أو أن يصدرَ منه كلامٌ ما أرادَ قوله بالمرّةِ كما يحصُلُ لمن يتكلم وهو نائمٌ. وأمّا النّسيانُ الجائزُ عليهم فهو كالسّلامِ من ركعتينِ كما حَصَلَ مع الرسولِ ممّا وَرَدَ من أنّه قيلَ لرسولِ الله: أَقُصِرَت الصلاةُ يا رسول الله أم نُسّيتَ، قال: “كلُّ ذلكَ لم يكن”، ثم سأل أصحابه: “أَصَدَقَ ذو اليَدَينِ” – وهو السائل – فقالوا: نعم، فقامَ فأتى بالرّكعتينِ. رواه مسلم.
وممّا يستحيلُ على الأنبياءِ أيضًا الجُنونُ، وأمّا الإغماءُ فيجوزُ عليهم، فقد كان يُغمَى على رسولِ الله من شدّةِ الألمِ في مرضِ وفاتِهِ ثمّ يصبُّ عليهِ الماءُ فيُفيقُ.
وممّا يستحيلُ عليهم تأثيرُ السّحرِ في عقولِهم فلا يجوزُ أن يُعتَقَدَ أنَّ الرسولَ أثَّر السّحرُ في عقلِهِ وإن كان قالَهُ من قالَهُ. وأما تأثير السحر على جسد النبي فقد قال بعض العلماء أنه جائز فقد ورد أن يهوديًّا عمل السحر لرسول الله فتألم الرسول من أثر ذلك. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم. الخوف الطبيعي موجود فيهم وذلك مثل النفور من الحية فإن طبيعة الإنسان تقتضي الهرب من الحية وما أشبه ذلك مثل التخوف من تكالب الكفار عليهم حتى يقتلوه فإن ذلك جائز عليهم. ولكن لا يقال عن النبي هرب لأن هرب يشعر بالجبن أما إذا قيل هاجر فرارًا من الكفار أي من أذى الكفار فلا يشعر بالجبن بل ذلك جائز ما فيه نقص.
قال المؤلّف رحمه الله: وكذلك يَستحيلُ عليهم كلُّ مرَضٍ مُنَفّرٍ. فمن نسبَ إليهِمُ الكذبَ أو الخيانةَ أو الرَّذالةَ أو السَّفاهةَ أو الجُبْنَ أو نحوَ ذلك فقد كَفَرَ.
الشرح: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “ما بَعَثَ الله نبيًّا إلا حسنَ الوجهِ حسنَ الصَّوتِ وإن نبيَّكم أحسنُهُم وجهًا وأحسنُهُم صوتًا” رواه الترمذي.
فالأنبياءُ كلُّهم كانوا ذوي حُسنٍ وجَمالٍ فلا يجوزُ عليهم المرضُ الذي ينفّرُ الناسَ منهم، الله تعالى لا يسلّطُ عليهم هذه الأمراض، أمّا المرضُ المؤلِمُ الشّديدُ حتّى لو كان يحصلُ منه الإغماءُ أي الغَشْيُ يجوزُ عليهم، وأمّا الأمراضُ المنفّرةُ فلا تجوزُ على الأنبياءِ، هذا أيّوبُ عليه السّلام الذي ابتلاهُ الله بلاءً شديدًا استمرَّ ثمانيةَ عشرَ عامًا وفَقَدَ مالَهُ وأهلَهُ ثم عافاهُ الله وأغناهُ ورزقَهُ الكثيرَ من الأولادِ، بعضُ الناس الجهّالِ يفترونَ عليه ويقولونَ إن الدّودَ أكلَ جسمَهُ فكانَ الدّودُ يتساقَطُ ثم يأخذُ الدّودةَ ويعيدُها إلى مكانها من جسمِهِ ويقول: “يا مخلوقةَ ربّي كُلي من رزقِكِ الذي رَزَقَكِ”، نعوذُ بالله هذا ضلالٌ مبينٌ.
وأمّا نبيُّ الله موسى عليه السّلامُ الذي تأَثَّر لسانُهُ بالجمرةِ التي تناولَها ووضعَهَا في فمِهِ حينَ كانَ طفلًا أمامَ فرعونَ لحكمةٍ، ما تركت تلك الجمرةُ في لسانِهِ أن يكونَ كلامُهُ غير مُفهمٍ للنّاس إنما كانت عقدة خفيفة بل كانَ كلامُهُ مُفهمًا لا يبدلُ حرفًا بحرفٍ بل يتكلَّمُ على الصَّوابِ لكن كانَ فيه عقدةٌ خفيفةٌ أي بطءٌ من أثر تلكَ الجمرةِ ثمّ دَعا الله تعالى لما نَزَلَ عليه الوحي قال: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي﴾ (27) ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (28) [سورة طه] فأذهَبَهَا الله عنهُ.
الحاصلُ أنَّ أنبياءَ الله كلَّهم أصحابُ خلقةٍ سويّةٍ لم يكن فيهم ذو عاهةٍ في خلقتِهِ ولم يكن فيهم أعرج ولا كسيحٌ ولا أعمى إنّما يعقوبُ من شدّةِ بكائِهِ على يوسفَ ابيضّت عيناهُ من شدّةِ الحُزنِ فعمى ثم ردَّ الله تعالى عليه بصرَهُ لما أرسلَ يوسف بقميصهِ من مصرَ إلى مدينَ وهي البلدة التي فيها أبوه فشمَّ يعقوبُ ريح يوسف في هذا القميص، الله تعالى جعلَهُ يشمُّ ريحَ يوسفَ فارتدَّ بصيرًا هو لم يكن أعمَى من أصلِ الخلقةِ ولا كانَ به عمًى قبلَ هذه المصيبة التي أصابتهُ بفَقْد ابنه يوسفَ. فالنبيُّ في البدءِ أوّل ما ينزلُ عليه الوحيُ لا بدَّ أن يكونَ بصيرًا، ثمّ بعد ذلكَ يجوزُ أن يعمَى لمدّةٍ كما حَصَلَ لنبيّ الله يعقوبَ عليه السلام.
وأمّا الذي يقولُ إنّ ءادمَ عليه السلام كان متوحّشًا قصيرَ القامَةِ شبيهًا بالقردِ فهو كافرٌ، وكذلكَ من قالَ إنه كانَ يمشي في الأرضِ عُريانًا كالبهائم لأن في ذلك تكذيبًا للقرءان، قال تعالى في سورة التين:﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (1) ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ (2) ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ﴾ (3) ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (4) [سورة التين] أي في أحسن صورةٍ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إنّ ءادم كان طوله ستين ذراعًا وعرضه سبعة وافر الشعر”.
فقولُ بعضِ الملحدينَ في العصورِ الأخيرةِ إن أوّلَ البشرِ كانَ على صورةِ القردِ تكذيبٌ للآية المذكورةِ وللحديثِ الصحيحِ: “كَانَ ءادمُ ستينَ ذراعًا طولا في سبعة أذرعٍ عَرضًا” رواه أحمد.
تنبيه: لا يجوزُ أن يقالَ إنّ فعلَ اللّواطِ مشتقٌّ من اسمِ نبيّ الله لوطٍ، وقد ذَكَرَ الفقيه المحدث الأصولي بدرُ الدين الزركشيُّ في كتابِ تشنيفِ المسامعِ ما نصه: “أن الأفعالَ مشتقةٌ من المصادِرِ على الصحيحِ، والأفعالُ أصلٌ للصّفاتِ المشتقّةِ منها فتكونُ المصادِرُ أصلًا لها أيضًا” اهـ.
وقال أبو منصور اللغوي: “وكلُّ أسماءِ الأنبياءِ أعجميّةٌ إلا أربعةً: ءادم وصالح وشعيب ومحمد” اهـ. وهذا خلافُ ما جاء في الصحيحِ، ففي صحيح ابن حبانَ من حديثِ أبي ذرٍّ أن الرسولَ عليه السلام قال: “أربعةٌ من الأنبياءِ من العربِ هودٌ وصالحٌ وشعيبٌ ومحمدٌ” وظاهرُ الحديثِ أن أسماء غير الأربعة أعجمية ويمكننا تأويلُ الحديثِ على أن المرادَ به أن الأربعةَ عربٌ ومن سواهم لا يسمون عربًا من حيث الجنسيةُ وعلى هذا لا يعارض كون لفظ ءادم عربيًّا. وكيف يمضي هذا الزمن الطويل من ءادم إلى لوط من غير أن تكون اللغة العربية وهي أول لغة تكلم بها ءادم وعلمها أبناءه كلغاتٍ غيرها فيها فعل اللواط بل كان أولاد ءادم ومن بعدهم يعرفون كلمة لاط بتصاريفها كما كانوا يعرفون كلمة الزنى وتصاريفها، وقائل هذا كالذي يقول إن البشر ما كانوا يعرفون كلمة الزنى وتصاريفها حتى مضى على البشر زمان طويل، وكيف يكون هود وصالح اللذان هما مبعوثان إلى العرب لغتهما ولغة من أرسلا إليه خالية عن هذه الكلمة فلا يغترَّ بأن هذه المقالة الشنيعة مذكورة في كتاب لسان العرب وشرح القاموس وليس لهما حجة إلا تقليد الليث في ذلك. وقد زيّف هذه المقالة من أئمة اللغة الزجاج.
وهي أول لغة تكلم بها ءادم فلا يجوزُ أن يُقالَ إن لوطًا مشتقٌّ من اللواطِ لأن اللواطَ لفظٌ عربيٌّ وهو مصدَرُ لاطَ، ولوط اسمٌ أعجميٌّ فكيفَ يدّعي مدَّعٍ أنه مشتقٌّ من اللواطِ، وكذلك عكسُهُ وهو القولُ بأن اللواطَ مأخوذٌ من لوطٍ، فلفظُ اللواطِ كانَ قبلَ قومِ لوطٍ لأنَّ اللغةَ العربيةَ لغةٌ قديمةٌ حتى قال بعض العلماءِ: إن أولَ لغةٍ تكلَّمَ بها ءادمُ هي العربية، ويشهَدُ لذلك ما وَرَدَ في الصحيح: “أن ءادمَ عَطَسَ فقالَ: الحمدُ لله”، وإنما قومُ لوطٍ هم أولُ من فَعَلَ تلكَ الفعلةَ الشنيعةَ، أما اللفظُ كانَ موضوعًا بين المتكلمينَ باللغةِ العربيةِ قبلَ لوط وهم قومُ عادٍ، وليس في قولِ الله تعالى إخبارًا عن قولِ لوط لقومِهِ: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأعراف/80] أن لفظَ اللواطِ لم يكن قبل ذلكَ وإنما معناهُ أنَّ فعلَ تلك الفاحشةِ لم يسبقهم بها قبلهم غيرهم، فوَضعُ الكلمةِ يَتَقَّدَمُ على العملِ بهِ، واللواطُ هكذا اللفظُ سابقٌ لكن التَّنفيذ ما حَصَلَ إلا في قومِ لوطٍ، أما من غيرِ بني ءادم فإبليس هو أوَّلُ من لاطَ، لاطَ بنفسِهِ كما قالَ الذين ألَّفوا في الأوائلِ: “أوَّلُ من لاطَ إبليسُ” ذكره السيوطيُّ وغيرُهُ، وذلك بإدخالِ ذَكَرِهِ في دُبُرِهِ ولعلهُ هو عَلَّمَ قومَ لوط. ولا يقاسُ الاشتقاقُ على المعربِ فالمعربُ لا يُسمى اشتقاقًا فهو شىءٌ والاشتقاقُ شىءٌ ءاخر فنقولُ في المعرب: نقل لغةٍ أعجميةٍ إلى العربيةِ ولم يستعملوهُ على أنهُ عربيٌّ، فأسماءُ الأعيانِ نُقِلَ عددٌ منهم والعربُ استعملتها استعمالا، وليسَ هناكَ أنه اشتقَّ هذا من هذا، فرقٌ بعيدٌ بين المعربِ والاشتقاقِ.
ثم إن الله تعالى صَانَ الأنبياءَ من المُنفّراتِ كَكونِ أساميهم من الأسماءِ القبيحةِ الشنيعةِ وأخلاقِهم من الأخلاقِ القبيحةِ، فمن نَسَبَ إليهم اسمًا شنيعًا بشعًا فقد انتَقَصَهم، فكيف استساغَ بعضُ اللغويينَ القولَ بأن لوطًا مأخوذٌ من اللواطِ، وهذه المقالةُ باطلةٌ شنيعةٌ لغةً وشرعًا، فليُحذَر كلام من قالَ ذلكَ من اللغويّينَ، فليحذر من تقليدِ هؤلاءِ، وكيف خَفِيَ على من قالَ تلكَ المقالة أن الأفعالَ وأسماءَ الأفعالِ وأسماءَ الفاعلين والصفةَ المُشَبَّهَةَ وأَفعلَ التّفضيلِ كل ذلكَ مشتقٌّ من المصدَرِ، قال أبو القاسم الحريريُّ في ملحةِ الإعراب: والمَصدرُ الأصلُ وأيُّ أصلِ ومنهُ يا صاحِ اشتقاقُ الفعلِ فكيف استجازوا أن يكونَ اسم هذا النبي الكريمِ مشتقًّا من اللواطِ، أو أن يكونَ اللواطُ مشتقًّا منه، الله تعالى عصم الأنبياء من أن تكون أسماؤهم خبيثة أو مشتقة من خبيث أو يشتق منها خبيث، ولا يخفَى على المتأمّلِ أن قول هؤلاءِ لا ينطبقُ على أنواعِ الاشتقاقِ الثلاثةِ التي بيَّنَهَا العلماءُ في محلّها.
وقد صحَّ أن الرسولَ قال: “ما بعثَ الله نبيًّا إلا حسن الوجهِ حسنَ الصوتِ” رواه الترمذي، فإذا كانَ الأنبياءُ هكذا يتعيّنُ أن تكونَ أساميهم حسنةً، وما نقلهُ الأزهريُّ عن الليثِ من أن الناسَ اشتقّوا من اسمِ لوطٍ فعلًا لمن فَعلَ اللواطَ لا يتفقُ مع ما قالهُ الأزهريُّ من أنَّ ما سوى الأسماءِ الأربعةِ من أسماءِ الأنبياءِ عجميّةٌ، فلا اعتمادَ عليهِ.
وأما قول الناسِ لمن يفعل تلكَ الفعلة لوطيٌّ فإنّما هو نسبةٌ إلى قومِ لوطٍ وليس إلى لوطٍ نفسِهِ، عملًا بالقاعدةِ العربيةِ في النّسبةِ من أنّهم إذا نسبوا شيئًا إلى اللفظِ المركَّبِ من مضافٍ ومضافٍ إليه يذكرونَ لفظَ المضافِ إليه فيقولونَ في عبدِ القيسِ فلانٌ قيسيٌّ ولا يفهمونَ منهُ إلا القبيلة، وكذلك قولُ لوطيٌّ، ثم هذه ليست من العباراتِ المستحسنةِ فإن أُريدَ اللفظُ عند النسبةِ يُقال فلانٌ اللواطي أو فلانٌ اللائط.
هذا وقول الليثِ إن الناسَ اشتقّوا من اسم لوطٍ فعلًا لمن فعلَ اللواطَ ليس صريحًا في أن هذا اشتقاقٌ صحيحٌ لغةً فلعلّ مرادهُ أن هذه نسبة غير معتبرةٍ وإنّما بعضُ الكفّارِ فعلوا ذلك ولا يريدُ بذلك تصحيحَ اشتقاقِ ذلكَ الفعل من اسمِ لوطٍ عليه السلام.
والحاصلُ أن ما ذُكِرَ من اشتقاقِ لاطَ ونحوه من اسمِ لوط ليسَ في شىء من الاشتقاقِ المُصطلحِ عليه عند اللغويينَ، لأن الاشتقاقَ المصطلح عليه عندهم شرطُهُ أن يكونَ المشتَقّ والمشتَقّ منهُ من لغةِ العربِ لقولهم في تعريفهِ: “ردُّ لفظٍ إلى لفظٍ ءاخرَ لمناسبةٍ بينهما مع تقسيمهم أنواعهُ الثلاثة إلى أمثلةٍ من اللغةِ العربيةِ حيث مثَّلوا للاشتقاقِ الصّغيرِ بحلبٍ وحَلَبَ وللوسط بضَرْبٍ وضَارِبٍ وللأكبر بثلبٍ وثلمٍ وما أشبَهَ ذلكَ، ولوطٌ عليه السلامُ هو ابن أخي إبراهيمَ عليه السلام وهما ليسا عربيَّينِ بالاتّفَاقِ.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة