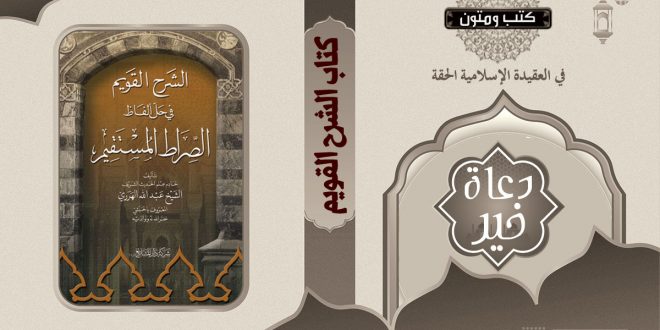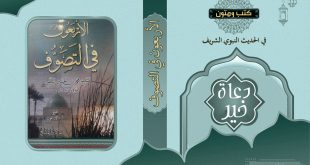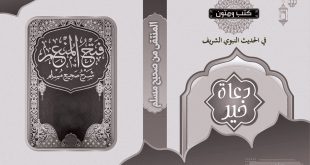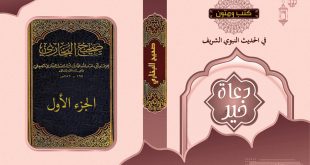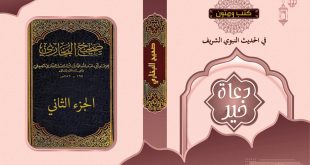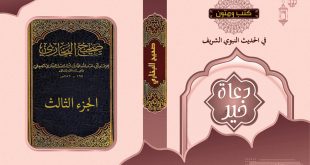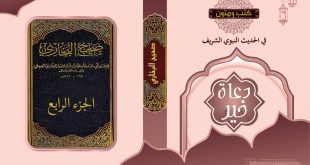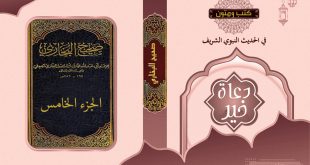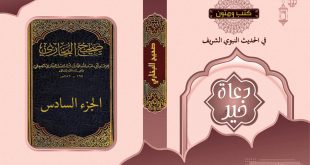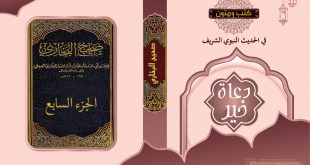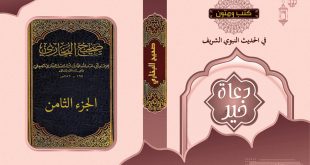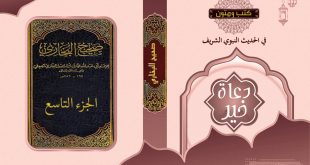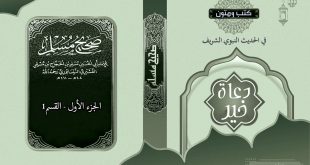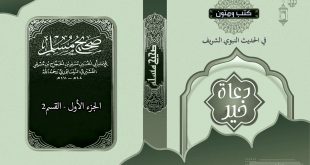رِسَالَةٌ مُهِمَّةٌ في الرّدِ عَلى المعتَزِلَةِ
روى البيهقيُّ عن سيّدنا الحسين بن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنهما أنّه قال: والله ما قالت القدريّةُ بقولِ الله ولا بقولِ الملائكةِ ولا بقول النبيّينَ ولا بقولِ أهلِ الجنّةِ ولا بقولِ أهلِ النّارِ ولا بقولِ صاحبِهِم إبليس، فقالَ الناس: تُفسّرُهُ لنا يا ابن رسولِ الله، فقال: “قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء﴾ [سورة يونس/25]”. فالمعتزلةُ خالفوا الله تعالى في قولهِ هذا لأنّهم قالوا والعياذُ بالله العبدُ خَلقَ الحسنات وعملَها فصارَ فرضًا على الله أن يدخلَهُ الجنّةَ، وليس إدخاله للعبادِ الجنّة فضلًا منه، معناهُ على زعمهم أنَّ الله مديونٌ للعبادِ لأنّهم خلقوا هذه الحسنات فهو ملزمٌ بأن يدخلهم الجنّةَ، والصوابُ أن الله تعالى فضلًا منه يُدخلُ المؤمنينَ الجنةَ لأنّه هو الذي خَلقَهم وهو الذي ألهمَهُم أعمالَ الخيرِ وهو الذي خلقَ فيهم هذه الجوارحَ وهو الذي خلقَ فيهم العقلَ الذي ميّزوا به بين الحقّ والباطلِ والحسنِ والقبيحِ، وهو الذي خلقَ هذه الجنّةَ، فإدخالُ الصّالحينَ الجنّةَ ليس فرضًا على الله، ليسوا ممتنينَ على الله بل هو الممتنُّ عليهم، هذا معنى كلام سيّدنا الحسين رضي الله عنه، كذلك الله تبارك وتعالى لمّا قالَ ﴿وَيَهْدِي مَن يَشَاء﴾ (25) أفهَمَنَا أنّه لا يهتدي أحدٌ إلا بمشيئتِهِ الأزليّةِ، والمعتزلةُ ينفونَ عن الله الصّفَات، عندهم الله تعالى لا يُقالُ لهُ إرادةٌ له علمٌ له سمعٌ له بصرٌ له كلامٌ، وإنّما يقولونَ هو قادرٌ بذاتِهِ عالمٌ بذاتِهِ وأحيانًا يقولون عالمٌ لذاتِهِ قادر لذاته لا بعلمٍ وقدرةٍ، خالفوا الآية بأكثر من وجهٍ كما قالَ سيّدنا الحسين رضي الله عنه.
وقد خالفت المعتزلة الآية ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة التكوير/29]، لأنّهم قالوا نحن بإرادتنا نخلقُ المعاصيَ والشُّرورَ، قالوا الله ما له تصرّفٌ في ذلكَ، والله أخبرنا أنَّ العبادَ لا تحصلُ منهم مشيئةٌ إلا أن يشاءَ الله في الأزلِ أن يشاؤوا، فالمعتزلةُ خالفوا الآية.
وخالفوا قولَ الله تعالى: ﴿سَنُقْرِؤُكَ فَلا تَنسَى﴾ (6) ﴿إِلاَّ مَا شَاء اللهُ﴾ (7) [سورة الأعلى]. فهذه الآيةُ أيضًا فيها دليلٌ على أنَّ أعمالَ القلوب من الخَلقِ بمشيئةِ الله، لأنّ الله تعالى أخبرنا عن سيّدنا محمّدٍ أنّه يَنسَى إن شَاءَ الله نسيانَهُ، أمّا ما لم يشإ الله تعالى أن ينسى شيئًا ممَّا أنزل عليه من القرءانِ لا ينسى، ففي قوله: ﴿إِلاَّ مَا شَاء اللهُ﴾ (7) دليلٌ على أنَّ القلبَ ما بين إصبعينِ من أصابعِ الرّحمنِ كما وَرَدَ في حديثِ أبي هريرة: “إنَّ قلوب بني ءادم كلها بين إصبعين من أصابع الرّحمن كقلبٍ واحدٍ” رواه مسلم، ومعناه هو المتصرّفُ فيها هو يقلّبُها كيف يشاءُ، فما لهؤلاءِ التَّائهينَ بعد أن أخبرنا الله تعالى أنَّ القلوبَ هو يقلّبها يقولونَ إنَّ العبدَ هو يخلقُ أفعالَ نفسِهِ مشيئته وحركاته وسكناته، وأوّلُ من فَتَحَ هذا البابَ ممّن يدّعي الإسلامَ المعتزلةُ فأضلّوا كثيرًا من النّاسِ، كانَ في أيّامِ السَّلفِ أناسٌ بحسبِ الظَّاهِرِ أحوالُهم حسنةٌ طيّبةٌ فَتَنَهم رجلٌ من المعتزلةِ فَضَلّوا.
وأمّا مخالفتُهُم للملائكةِ فقد قالت الملائكةُ: ﴿قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [سورة البقرة/32]. معناه العلمُ الذي فينا أنتَ تخلقُهُ يا الله، وكذلك سائرُ أعمالنا الباطنيَّة والظّاهريَّة لا تكونُ إلا بمشيئةِ الله وخلقِهِ، أمّا المعتزلةُ قالوا علومُنَا وإدراكاتُنَا نحنُ نخلُقُهَا.
وأمّا مخالفَتهم للنَّبيّينَ فقد قالَ النَّبيّونَ: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ رَبُّنَا﴾ [سورة الأعراف/89] بعضُ أنبياءِ الله تعالى قالَ في مقامِ التَّبرُّىءِ من المشركينَ وأعمالِهم نحنُ ليسَ لنا أن نعودَ في مِلَّتِكُم، معناهُ نحنُ أنقذَنا الله من أن نكونَ في مِلّتِكم، أي حَمَانا الله من أن نَدخُلَ فيها ونعتقدَها كما أنتم تعتقدُونَها، ﴿إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ﴾ (89) معناهُ أمّا لو شاءَ الله تعالى في الأزلِ أن نَتَّبِعَكم لَتَبِعنَاكُم، لكن ما شاءَ ذلك فلا نتبعكم.
وقالَ تعالى حكايةً عن نوح عليه السَّلامُ: ﴿وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ﴾ [سورة هود/34] هنا نوحٌ أثبتَ لله تبارك وتعالى المشيئةَ لأعمالِ العبادِ خيرِها وشَرّها، أي أنَّ الطَّاعات من عبادِهِ تحصلُ بمشيئتِهِ وأنَّ معاصيهم تحصلُ بمشيئتِهِ.
وأمّا مخالفتُهم لأهلِ الجَنَّةِ فأهلُ الجنّةِ قالوا: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللهُ﴾ [سورة الأعراف/43]. اعترفوا بأنَّ هذه الأعمال الصَّالحة التي استحقّوا بها هذا النّعيمَ المقيمَ ليس إلا بمشيئةِ الله وخلقِهِ فيهم، ولولا أنّ الله خَلَقَ فيهم ذلك ما دخلوا هذه الجنّةَ ولا نالوا هذا النَّعيمَ. المعتزلةُ خالفت فقالت نحنُ خَلَقنَا إيمانَنَا وأعمالَنَا الصَّالحة فلذلكَ صارَ على الله فرضًا لازمًا أن يُثيبَنَا.
وأمّا مخالفَتُهم لأهلِ النَّارِ فقد قالَ أهلُ النَّارِ: ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ [سورة المؤمنون/106].
هذا الكلامُ أيضًا فيه اعترافٌ ضمنِيٌّ بأنَّ الله تبارك وتعالى شَاءَ وخَلَقَ فيهم الضَّلالَ الذي استحقّوا به هذه النَّار.
وأمّا مخالفَتُهُم لإبليس فقد قالَ أخوهم إبليسُ: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [سورة الأعراف/16]، فمعنى كلام إبليس يا ربّ لأنَّك أغويتَني أي كتبتَ عليَّ الغَوايةَ أي أن أضلَّ باختياري ضَلَلتُ، أنا أقعدُ لبني ءادمَ صراطكَ المستقيمَ أي لأخرِجَهُم وأُبعِدَهم منه، هذا إبليس صارَ أفقهَ من المعتزلةِ لأنَّه عَرَفَ أنَّ الله هو خالقُ الغَوايةِ والضَّلالةِ فيمن ضلّوا من عبادِ الله، وأنّهم ليسوا مستقلّينَ عن مشيئةِ الله وتخليقِهِ أي لا يعملونَ شيئًا من غيرِ أن تسبِقَ مشيئةٌ من الله في الأزلِ في ذلكَ الذي يحصلُ منهم.
ومثلُ هذا الكلام رواهُ البيهقيُّ عن سفيانَ بن عيينةَ الذي هو من الأئمَّةِ المجتهدينَ الذين أخذَ الشَّافعيُّ وغيرُهُ عنهم أحاديث نبويّةً بالأسانيدِ لأنّه كان محدثًا أكبرَ سنًّا من الشَّافعيّ.
الدَّليلُ العَقْليُّ على فَسَاد قَولِ المعتَزِلةِ
قال المؤلف رحمه الله: الدَّليلُ العَقْليُّ على فَسَاد قَولِ المعتَزِلةِ بأنَّ العبدَ يَخلُقُ أفْعالَهُ
قَالَ أَهْلُ الحقّ: “امتَنَع خَلْقُ العَبدِ لفِعْلِه لعُمُومِ قُدْرَةِ الله تَعالى وإرادَتِه وعِلْمِه”.
الشرح: الدَّليلُ على أنَّ العبدَ لا يخلُقُ أفعالَهُ هو أنَّ قدرةَ الله عامَّةٌ وإرادتَهُ عامّةٌ فكيفَ لا يكونُ عملُ العبدِ مخلوقًا لله، فالمعتزلةُ تقولُ الله ما له تصرُّفٌ في العبادِ إنَّما هم يخلقونَ أعمالَهم الاختيارية أي التي يعملونها عَمدًا، وكلامُهم هذا مردودٌ، يقال لهم: قدرةُ الله عامَّةٌ شاملَةٌ وإرادتُهُ عامَّةٌ شاملَةٌ فكيف تكونُ خاصّةً بالأجسامِ دونَ أعمالِ العبادِ الاختياريّة، هذا لا يقبلُهُ العقلُ، لأنَّ معنى كلامكم هذا أنَّه يوجَدُ شىءٌ خصَّ قدرةَ الله عن أن تكونَ شاملةً لكلّ شىءٍ، وهذا معناهُ أنَّ الله محكومٌ لغيرِهِ، جعلتم له مُخَصّصًا خَصَّصَهُ ببعضِ الممكناتِ العقليةِ دونَ بعضٍ وكلُّ شىءٍ له مُخَصّصٌ محتاجٌ لذلكَ المُخَصّص، إذًا على قولِكم الله له مُخَصّصٌ والذي له مُخَصّصٌ مُحدَثٌ، والله منزّهٌ عن الحدوثِ، فَبَطَلَ قولكم.
فلمَّا كانت قدرةُ الله شاملةً لكلّ ممكنٍ عقليّ وإرادتُهُ كذلك وعلمُهُ كذلك وَجَبَ أن يكونَ كلّ ممكنٍ عقليّ واقعًا بتخليقِ الله وتكوينِهِ، ومن ذلكَ أفعال العبادِ الاختياريّةُ يجبُ عقلًا دخولُها في ذلكَ أي أن تكونَ مخلوقةً له لا للعبادِ، لأنّه لو كانَ شىءٌ منها بخلقِ غيرِهِ مع كونها من الممكنِ العقليّ لَلَزِمَ من ذلك أن يكونَ لله تعالى مانعٌ منعَهُ من خَلقِ ذلكَ العمل، خَصَّصَهُ عن خلقِ هذه الأعمال وجَعَلَها بخلقِ غيرِهِ تعالى، وذلك يؤدّي إلى نسبةِ العجزِ إلى الله، ولكانَ يلزم أيضًا أن يكونَ ذلك المخصّصُ إلهًا ءاخرَ، وتعدُّدُ الإلهِ محالٌ بالبرهانِ العقليّ.
ولنا هنا عبارةٌ أخرى هي أنّه لو كانت أعمالُ العبادِ الاختياريّة بِخَلقِ العبادِ لا بخلقِ الله لاقتضى ذلك وجودَ مُخصّصٍ خَصَّصَ الله تعالى بذلك وَتَعَلَّقَ المُخَصّصُ بذاتِ الله تعالى، ويلزمُ منه أنّ هناكَ فاعلًا بالإرادةِ يمنعُ الله تعالى عن بعضِ الممكناتِ، وبيانُ ذلك أنّ الممكناتِ العقليّة إمّا أجسامٌ وجواهر وإمّا أعمالٌ وصفاتٌ حادثةٌ فلو كانت قدرةُ الله غير شاملةٍ للجميعِ وكانت مقتصرةً على الأعيانِ والجواهرِ والأعراضِ والأعمالِ الاضطراريّةِ دونَ الأعمالِ الاختياريّةِ لكان لله مُخصّصٌ يُخَصّصُ قدرتَهُ ببعض الممكناتِ العقليّةِ دونَ بعضٍ، وفي ذلك نسبةُ القُصورِ إلى قدرةِ الله تعالى، ويستحيلُ أن تكونَ قدرةُ الله قاصرةً على بعض الممكناتِ دون بعضٍ لأنّ في ذلك نسبة النّقصِ إلى الله والنّقصُ عليه محالٌ، ويلزم ممّا ذَهَبَ إليه المعتزلة أنّ الله له مُمَانِعٌ يمنعُهُ عن بعضِ الممكناتِ دونَ بعضٍ وذلك عجزٌ والعجزُ عليه محالٌ.
ويأتي على قولِ المخالفينَ المحال الذي نفاهُ أهلُ الحَقّ وهو تعدُّدُ الإلهِ وما أدَّى إلى المحالِ محالٌ.
قال المؤلف رحمه الله: وبَيانُ الدَّليل علَى ذَلكَ أنَّ قُدرَةَ الله عامَّةٌ وعلمه عام وإرادَته عامة فإنَّ نِسْبَتَها إلى الممكناتِ نِسْبَةٌ واحدَةٌ.
الشرح: نسبةُ قدرةِ الله إلى الممكناتِ العقليّة واحدةٌ، أي نسبةُ قدرةِ الله إلى أجسامِنَا ونسبةُ قدرةِ الله إلى أعمالِنَا واحدةٌ، يقالُ لهم: كيف جَعَلتم قدرةَ الله خاصّةً بأجسامِنَا فقط دونَ أعمالِنَا؟
قال المؤلف رحمه الله: فإنَّ وجُودَ الممكنِ العَقليّ إنَّما احْتاجَ إلى القَادرِ من حَيثُ إمْكانُه وحدُوثُه.
الشرح: يقالُ لهم وجودُ الممكنِ العقليّ كيف احتاجَ إلى الإلهِ، أليسَ لأنّه ممكنٌ عقليٌّ حادثٌ وكلُّ حادِثٍ له مُحدِثٌ؟، أليسَ من هذه الجهة احتاجَ إلى الله؟ فإذًا كلُّ جائزٍ عقليّ كلُّ ممكنٍ عقليّ تتعلَّقُ به قدرة الله، فالله هو الخالقُ لكلّ ممكنٍ عقليّ وأعمالُنَا من الممكناتِ العقليّةِ.
ويقالُ لهم: أعمالُنَا حركاتنَا وسكناتنا التي نقصدُهَا ونتعمَّدهَا من الممكنِ العقليّ هي أم هي من المستحيلِ أم هي من الواجبِ العقليّ؟ يقولونَ: من الممكن العقليّ، فيقالُ لهم: إذًا الممكنُ العقليُّ يجبُ أن يكونَ متعلَّقًا لقدرةِ الله تعالى، يجِبُ أن تكونَ قدرةُ الله متعلقةً بهِ أي شاملةً له، فلا يجوزُ أن نجعلَ قدرةَ الله متعلّقةً ببعضِ الممكناتِ العقلية دون بعضٍ.
قال المؤلف رحمه الله: فَلَو تَخصَّصَت صِفَاتُه هَذه ببَعضِ الممكِنَاتِ للَزِمَ اتّصَافُه تَعالَى بنَقِيضِ تِلكَ الصّفاتِ من الجهلِ والعَجْزِ وذَلكَ نَقْصٌ والنَّقْصُ علَيه مُحَالٌ.
الشرح: لو كانت قدرةُ الله لا تشملُ جميع الممكناتِ العقليّةِ لكانت قاصرةً على بعضها دون بعضٍ ولاقتضى ذلك أن يكونَ له شىءٌ خَصَّصَ قدرةَ الله ببعضِ الممكناتِ العقليّة دونَ بعضٍ، وهذا معناهُ أنَّ الله محتاجٌ إلى غيرِهِ وهذا محالٌ على الله لا يجوزُ، فَبَطَلَ قولكم.
يقالُ لهم: لو كانَ الله تعالى لا يخلقُ أعمالَ العبادِ الاختياريّة ويخلقُ ما سوى ذلك لاقتضى ذلك أن يكونَ لله مُخصّصٌ يخَصّصه بشىءٍ دونَ شىءٍ وذلك يؤدّي إلى العجزِ والمغلوبيّةِ وقد ثَبَتَ أن لا إله غيرهُ بالبرهانِ العقليّ.
قال المؤلف رحمه الله: ولاقْتَضَى تَخَصُّصُها مُخَصّصًا وتَعَلَّقَ المخَصّصُ بذَاتِ الوَاجِبِ الوُجُودِ وصِفَاتِه وذلكَ مُحالٌ.
الشرح: معناهُ لو لم تكن قدرة الله متعلقة بكل الممكنات العقلية لكانَ لله شىء يؤثّرُ فيه، فلو كانَ كما يقولونَ قدرةُ الله تعالى قاصرة على بعض الممكناتِ العقليّة دون بعضٍ أي لو كانت قاصرةً على أجسامِنا دونَ أعمالِنَا لاقتضى ذلك شيئًا خَصَّصَ قدرةَ الله، وكانَ ذلكَ يقتضي تَعَلُّقَ المُخَصّصِ بذاتِ الله تعالى وهذا لا يجوزُ لأنّه محالٌ عقليٌّ.
قال المؤلف رحمه الله: فَإذًا ثَبتَ عمُومُ صِفَاتِه.
الشرح: عمومُ قدرةِ الله وإرادته ثَبَتَ، الله خالقٌ لكلّ أعمالِنَا الاختياريّة وغيرِ الاختياريّة، وخصومُنَا يوافقونَنَا في غيرِ الاختياريّة كحركاتِ النَّائم وحركةِ المُرتَعِشِ، هذه عندَنا وعندَهم مخلوقةٌ لله، أمّا الحركةُ الإراديّةُ فهذه عندَهم ما دَخَلَت تحتَ القدرةِ، هم يقولونَ هذه العبدُ يخلُقُهَا وهذا باطلٌ، العبدُ لا يَخلُقُ شيئًا لا الحركة الاختياريّة ولا الحركة الاضطراريّة، هذا مذهبُ أهلِ الحَقّ من السلفِ والخَلَفِ.
قال المؤلف رحمه الله: فلَو أرادَ الله تعالى إيجادَ حادِثٍ وأرادَ العبدُ خلافَهُ ونَفذَ مُرادُ العَبْدِ دُونَ مُرادِ الله للَزِمَ المحالُ المفْروضُ في إثباتِ إلهَينِ، وتَعدُّدُ الإلهِ محالٌ بالبُرهانِ، فما أدَّى إلى المحالِ محالٌ.
الشرح: يعني أنّه لو كانت قدرةُ الله متعلّقةً ببعضِ الممكناتِ دونَ بعضٍ كما تقولُ المعتزلةُ لَلَزِمَ المحالُ المفروضُ في إثباتِ إلهين فما أدَّى إلى المحالِ محالٌ، لو كانَ الله تعالى اثنين أو أكثر يلزمُ من ذلكَ شىءٌ لا يقبلُهُ العقلُ وهو أنَّه لو فُرِضَ أنَّ أحدَهما أرادَ أن يُوجَدَ شىء والآخرَ أرادَ أن لا يُوجَدَ فإن نَفَذَ مرادُ هذا ولم يَنْفُذ مرادُ ذاكَ فالذي لم ينفذ مرادُهُ صارَ عاجزًا، والعاجزُ لا يَصلُحُ لأن يكون إلهًا، فَبَطَلَ تعدُّدُ الإله، وَبَطَلَ قولُهم بأنَّ قدرةَ الله تعالى لا تشمَلُ أعمالَ العبادِ الاختياريّة.
إثباتُ أنَّ الأسْبابَ العَادِيّةَ لا تُؤثّرُ علَى الحقِيْقَةِ وإِنّما المؤَثّرُ الحقِيقيُّ هوَ الله
قال المؤلف رحمه الله: إثباتُ أنَّ الأسْبابَ العَادِيّةَ لا تُؤثّرُ علَى الحقِيْقَةِ وإِنّما المؤَثّرُ الحقِيقيُّ هوَ الله.
ذكَر الحاكمُ صَاحِبُ المسْتَدْرَكِ في تَاريخِ نَيْسَابُورَ قالَ: سَمِعتُ أبا زكرِيّا يَحيى بنَ محمّدٍ العنبرِيَّ يقولُ: سَمِعتُ أبَا عِيْسى بنَ محمّدِ بنِ عِيْسَى الطَّهْمَانيَّ المَروَرّوذِي يَقولُ: إنَّ الله تباركَ وتَعالى يُظْهِرُ ما شاءَ إذَا شاءَ من الآيَاتِ والعِبَرِ في بَرِيَّتِه.
الشرح: الله تعالى يُظهِرُ ما شاءَ في بريّتِهِ أي خلقِهِ من الآياتِ أي العلاماتِ التي تدلُّ على صِدقِ الإسلامِ والعِبَرَ أي ما يُعتَبَرُ بهِ أي ما يؤخذُ منه قوّةُ عقيدةِ الإيمانِ.
قال رحمه الله: فيَزِيدُ الإسْلامَ بها عِزًّا وقُوَّةً ويُؤيّدُ ما أُنزل من الهُدَى والبيّناتِ ويُنشِئُ أعْلامَ النُّبُوَّةِ ويُوضِحُ دِلالة الرّسالةِ ويُوثِقُ عُرَى الإسلامِ.
الشرح: قولُه: “أعلام النبوة” أي دلائل النبوَّةِ، والعُرَى معناهُ الحبل لمَّا يكونُ في وسطِهِ عقدٌ.
قال رحمه الله: ويُثْبِتُ حَقائقَ الإيْمانِ مَنًّا مِنهُ على أوْليائه وزِيَادَةً في البُرهَانِ لهم وحُجَّةً على من عَاندَ في طاعتِه وألْحَدَ في دِينِه لِيَهلِكَ من هلَكَ عَن بيّنَةٍ ويَحْيا من حَيَّ عن بيّنَةٍ فلَهُ الحمدُ لا إلَه إلا هوَ ذُو الحُجَّةِ البَالِغَةِ والعزّ القَاهِرِ. والطَّوْلِ البَاهِر.
وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ نبيّ الرَّحْمةِ ورَسُولِ الهُدَى وعلى ءالهِ الطَّاهرينَ السَّلامُ ورحْمةُ الله وبَركَاتُه.
وإنَّ مِمّا أدْرَكْنا عِيَانًا وشَاهَدْناهُ في زماننا وأحَطْنا عِلْمًا به فَزادَنا يَقِينًا في دِينِنا وتَصْديقًا لِمَا جَاءَ بِه نبِيُّنا ودَعا إليه منَ الحقّ فرَغَّب فِيه مِنَ الجِهادِ مِنْ فَضِيلَةِ الشُهَداء وبَلَّغَ عن الله عزَّ وجَلَّ فِيهمْ إذْ يَقُولُ جَلَّ ثَناؤه “, ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ ﴿169﴾ ﴿فَرِحِينَ﴾ (170) [سورة ءال عمران].
إنّي ورَدْتُ في سَنةِ ثمانٍ وثلاثينَ ومائَتينِ مَدِيْنةً منْ مَدائِنِ خُوارِزْمَ تُدْعَى هَزَارَاسْبْ وهي في غَرْبي وَادِي جَيْحُونَ ومنْها إلى المدِيْنَةِ العُظْمَى مسَافَةُ نِصْفِ يَوم وخُبّرْتُ أنَّ بها امْرأَةً من نسَاءِ الشُّهَداءِ رَأت رؤيَةً كأنَّها أُطعِمَت في مَنامِها شَيْئًا فَهي لا تأْكُلُ شيئًا ولا تَشْربُ مُنْذُ عَهْدِ أبي العبّاسِ بنِ طاهِرٍ والِي خُراسَانَ وكانَ توفّي قبلَ ذلكَ بثمانِ سنينَ رَضِيَ الله عنه ثمّ مَرَرْتُ بتلكَ المدينةِ سنَة اثنَتَينِ وأرْبعينَ ومائتين فَرأيتُها وحدَّثَتْني بحديْثها فلَم أسْتَقْصِ علَيْها لحدَاثَةِ سِنّي ثُمَّ إنّي عُدْتُ إلى خُوَارِزْمَ في ءاخِرِ سنة اثنَتينِ وخمسينَ ومائتَين فرأيتُها باقِيةً ووَجَدْتُ حَديثَها شَائعًا مسْتَفِيضًا. وهذِه المدينَةُ على مَدْرَجَةِ القوافِلِ وكانَ الكَثيرُ ممَّن يَنْزِلُها إذَا بلغَهُم قِصّتها أحَبُّوا أن ينْظروا إليها فلا يَسألونَ عنها رجُلًا ولا امرأةً ولا غُلامًا إلا عَرفَها ودَلَّ علَيها فلَمَّا وافَيتُ النَّاحِيَةَ طلَبتُها فوجَدْتُها غائبةً على عِدّةِ فراسِخَ فمضَيتُ في أثرِها مِنْ قَرْيةٍ إلى قَرْيَةٍ فأَدْرَكْتُها بَيْنَ قريَتَيْنِ تمشِي مِشيَةً قويّةً فإذَا هي امرأةٌ نَصَفٌ جَيّدَةُ القَامَةِ حسَنَةُ الثّدِيَّةِ ظَاهِرةُ الدَّمِ مُتَورّدَةُ الخَدَّينِ ذَكِيَّةُ الفُؤَادِ فَسَايَرتْني وأنَا رَاكِبٌ، فعَرَضْتُ علَيها مَرْكَبًا فلمْ تركَبْهُ وأقبَلَت تمشِي مَعي بِقُوَّةٍ.
وكانَ حضرَ مَجلسي قَومٌ من التُّجَّار والدَّهَاقين وفيهم فَقِيهٌ يُسَمَّى محمدَ بنَ حَمْدَوَيْه الحارِثيَّ وقَد كتبَ عنْه مُوسى ابنُ هارونَ البزَّارُ بمكّةَ وكَهْلٌ لَهُ عبادةٌ وروايةٌ للحَديث، وشَابٌّ حسَنٌ يُسَمَّى عبدَ الله بنَ عَبْدِ الرّحمنِ، وكَان يُحلّفُ أصْحابَ المظَالم بنَاحيَتِه فَسَأَلْتُهم عَنها فأحْسَنُوا الثَّنَاء علَيها وقَالُوا عنْها خَيرًا وقَالوا إنَّ أمرَها ظاهِرٌ عندَنا فلَيْسَ فِينا مَن يخْتلِفُ فيها، قال المسَمَّى عبدَ الله بنَ عَبدِ الرحمن: أنَا أسمَعُ حدِيثَها منذُ أيّامِ الحدَاثَةِ ونَشأتُ والنّاسُ يتفَاوضُون في خبَرها وقد فَرَّغتُ بالي لَها وشَغَلتُ نَفْسِيَ بالاسْتِقْصاءِ علَيها فلَم أرَ إلا سَتْرًا وعَفافًا ولَم أعْثُرْ لَها على كَذِبٍ في دَعْواها ولا حِيْلَةٍ في التَّلبيسِ، وذَكَر أنَّ مَن كَانَ يَلي خُوَارِزْمَ من العُمّالِ كانوا فيما خَلا يَستَحضِرونَها ويَحصُرُوْنها الشّهرَ والشّهْرينِ والأكْثرَ في بيتٍ يُغلِقُونَ عليها ويُوَكّلُونَ من يُراعِيْهَا فلا يَرونَها تأكُلُ ولا تَشْربُ، ولا يجِدُون لَها أثرَ بولٍ ولا غائطٍ فَيبَرُّونَها ويَكسُونَها ويُخْلُونَ سَبيلَها فَلَمّا تَواطَأ أهْلُ النَّاحيةِ على تَصْدِيقها قَصَصْتُها عن حَدِيثها وسَألتُها عن اسمِها وشَأنِها كُلّه، فذكَرَتْ أنَّ اسمَها رَحمَةُ بنتُ إبْراهيمَ وأنَّه كانَ لَها زَوجٌ نَجّارٌ فَقيرٌ مَعاشُه مِن عَملِ يَدِه، يأتِيْه رِزقُه يَومًا فَيَومًا لا فَضْلَ في كَسْبِه عن قُوتِ أهْلِه، وأنَّها وَلَدَتْ لَهُ عِدَّةَ أوْلادٍ، وجَاء الأقْطَعُ ملِكُ الكفّارِ إلى القَريةِ فعبَرَ الوَاديَ عِنْدَ جُمُودِه إلَينا في زُهاءِ ثلاثَةِ ءالافِ فَارسٍ وأهْلُ خُوَارِزْم يَدْعُونَهُ كَسْرَى. قَالَ أبُو العبَّاسِ: والأَقْطَعُ هَذا كانَ كافِرًا غاشِمًا شَديدَ العَداوةِ للمُسْلمينَ قَدْ أثّرَ على أهْلِ الثّغُورِ وألَحَّ على أهْلِ خُوارِزْمَ بالسَّبْي والقَتْل والغَاراتِ وكَان وُلاةُ خُراسَانَ يتأَلَّفُونَه وأشباهَهُ من عُظَماءِ الأعَاجِمِ ليَكُفُّوا غاراتِهمْ عن الرَّعِيَّةِ ويَحقِنُوا دِمَاءَ المسلمِيْنَ فيَبْعَثُونَ إلى كُلّ واحدٍ منْهُم بأَمْوالٍ وألْطَافٍ كَثيْرةٍ وأنْواع من فَاخِرِ الثّيابِ وإنَّ هذَا الكافِرَ اسْتاءَ في بَعضِ السّنيْنَ على السُّلْطانِ، ولا أدْري لِمَ ذاكَ، هل استَبطَأ المبارَّ عَن وقْتِها أم استَقَلَّ ما بُعِثَ إلَيه في جَنْبِ مَا بُعِثَ إلى نُظَرائِه من الملُوكِ فأقْبَلَ في جنُودِه واستَعْرضَ الطرُقَ فَعَاثَ وأفْسَدَ وقتَلَ ومَثَّلَ فعَجزَ عَنْه خيُولُ خُوارِزْم، وبَلغَ خبرهُ أبَا العبّاسِ عبدَ الله بنَ طَاهرٍ رحمه الله، فأنْهَضَ إليهِ أربَعةً من القُوّادِ: طاهِرَ بنَ إبراهيمَ بنِ مالكٍ، ويعقوبَ بنَ مَنصُورِ بنِ طَلحةَ، ومِيكالَ مَولى طَاهرٍ، وهَارُونَ العَارِضَ وشحَنَ البلَدَ بالعساكرِ والأسْلحةِ ورتّبَهُم في أرْبَاعِ البلَدِ كلٌّ في رُبْعٍ، فَحَمَوا الحرِيْمَ بإذنِ الله تعالى، ثمَّ إنَّ وادي جَيحُونَ وهو الذي في أعْلَى نَهْرِ بَلْخٍ جَمَدَ لما اشتَدَّ البَرْدُ، وهو وادٍ عظِيمٌ شَدِيدُ الطُّغْيانِ كَثِيرُ الآفَاقِ وإذا امتَدَّ كانَ عَرْضُهُ نَحْوًا من فَرسَخٍ وإذَا جَمَدَ انطَبَقَ فلَم يُوصَلْ منه إلى شَىءٍ حتَّى يُحْفَرَ فِيه كَما تُحفَرُ الآبَارُ في الصُّخُورِ وقَدْ رأَيتُ كِثَفَ الجَمَدِ عَشَرَةَ أشْبارٍ، وأُخبِرْتُ أنَّه كانَ فيما مَضى يزِيدُ على عِشرينَ شِبْرًا وإذَا هُو انْطبَقَ صَارَ الجمَدُ جِسْرًا لأهْلِ البلَدِ تَسِيْرُ عليهِ العَساكِرُ والعَجَلُ والقَوافِلُ فيَنْتظِمُ ما بَين الشَّاطِئيْنِ، ورُبَّما دامَ الجمَدُ مائةً وعِشْرينَ يومًا، وإذا قلَّ البَرْدُ في عَامٍ بَقيَ سَبْعِيْنَ يَوْمًا إلى نَحْوِ ثلاثَةِ أشْهُر. قالتِ المرأةُ: فَعَبَرَ الكافِرُ في خَيْلِه إلى بَابِ الحِصْنِ وقد تَحصَّنَ النّاسُ وضَمُّوا أمْتِعَتَهُم وصَحِبُوا المسلمينَ وأضَرُّوا بهم فحُصِرَ مِنْ ذلِكَ أهلُ النَّاحيةِ وأرَادُوا الخروجَ فَمنعَهُمُ العَامِلُ دونَ أن تَتوافَى عسَاكرُ السُّلطانِ وتَتلاحَقَ المتطوّعَةُ، فشَدَّ طائفةٌ من شُبَّانِ النَّاسِ وأَحْداثِهم فَتقَارَبُوا مِنَ السُّورِ بما أطاقُوا حَمْلَه من السّلاحِ فَلَمَّا أصْحَرُوا كَرَّ الكفَّارُ علَيهم وصَارَ المسْلمونَ في مِثلِ الحرَجَةِ فتَحصَّنُوا واتَّخَذُوا دَارةً يُحَاربُونَ من وَرائِها وانْقطَعَ ما بينَهُم وبَيْن الحِصْنِ وبَعُدَت المعُونَةُ عنهُم فَحارَبُوا كأشَدّ حَرْبٍ وثَبتُوا حتَّى تَقطَّعَت الأَوْتارُ والقسِيُّ وأدرَكَهُمُ التّعَبُ ومَسَّهُمُ الجوعُ والعَطَشُ وقُتِلَ مُعْظَمُهم وأُثْخِنَ البَاقُونَ بالجِراحَات.
ولما جَنَّ عَلَيهمُ الليلُ تَحاجَزَ الفَريْقانِ قالَتِ المرأةُ: ورُفِعَتِ النّارُ على المنَاظِرِ سَاعةَ عُبُورِ الكَافرِ، فاتّصَلَ الخبَرُ بالجُرْجَانِيّةِ وهي مَدِينةٌ عَظيمةٌ في قاصِيَةِ خُوَارِزْمَ، وكانَ مِيكالُ مَوْلَى طَاهرٍ بِهَا في عَسْكَرٍ فَخَفَّ في الطّلبِ هَيْبَةً للأميْرِ أبي العبّاسِ عبدِ الله بنِِ طَاهرٍ رحمه الله، وركَضَ إلى هَزَاراسْبْ في يَومٍ ولَيلةٍ أربعينَ فرسَخًا بفَراسِخِ خُوارِزْمَ وفِيْها فَضلٌ كثِيرٌ على فراسِخِ خُراسَانَ.
وغَدا الكَافرُ لِلفَرَاغ مِنْ أَمْر أولئِكَ النَّفَرِ فبَينَما هُمْ كذلكَ إذ ارتفَعتْ لهُمُ الأعلامُ السُّودُ وسَمِعُوا أصْواتَ الطّبُولِ فأَفْرَجُوا عن القَوْم، ووَافَى مِيكالُ مَوْضِعَ المعْركةِ فَوارَى القَتْلَى وحَمَلَ الجرْحَى.
قالَتِ المرأةُ: وأُدْخِلَ الحِصْنَ علَينا عَشِيَّةَ ذَلكَ زُهاءُ أربَعمائةِ جَنَازةٍ، فلمْ تبْقَ دارٌ إلا حُمِلَ إليها قتيلٌ وعَمَّتِ المصِيبةُ وارْتجَّتِ النَّاحِيةُ بالبُكاءِ.
قالت: ووُضِعَ زَوْجي بَيْنَ يدَيَّ قَتيلًا فأَدْرَكَني من الجزَع والهلَعِ علَيهِ ما يُدْرِكُ المرأة الشّابّة على زَوْجِها أبي الأَوْلادِ، وكانَت لَنا عِيَالٌ.
قالتْ: فاجْتَمع النّساءُ من قَرابَاتي والجِيرانُ يُسْعِدْنَني على البكاءِ، وجَاءَ الصّبْيانُ وهمْ أطْفالٌ لا يَعْقِلُونَ من الأَمْرِ شيئًا يَطْلبونَ الخبْزَ وليسَ عِنْدِي فَضِقْتُ صَدْرًا بأَمْري ثمّ إنّي سَمِعْتُ أَذانَ المغْربِ فَفَزِعْتُ إلى الصّلاةِ فصَلَّيتُ ما قَضَى لي ربّي ثُمّ سَجَدْتُ أَدْعُو وأتَضَرَّعُ إلى الله تَعالى وأسأَلهُ الصَّبْرَ وأن يَجْبُرَ يُتْمَ صِبياني فذهب بيَ النّومُ في سجودي فَرأيتُ في مَنامي كأَنّي في أَرْض حَسْناءَ ذَاتِ حِجَارةٍ وأنَا أطْلُبُ زَوْجِي، فنَاداني رَجُلٌ: إلى أينَ أيّتُها الحُرّةُ؟ قلتُ: أطلُبُ زَوجِي، فقالَ: خُذِي ذَاتَ اليَمينِ، فرُفِعَ لي أرضٌ سَهْلَةٌ طيّبةُ الرّيّ ظَاهِرةُ العُشْبِ وإذَا قصُورٌ وأَبنيَةٌ لا أحْفَظُ أنْ أصِفَها ولَمْ أَرَ مِثْلَها وإذا أنْهارٌ تَجْري علَى وجْهِ الأَرْضِ بغَيْرِ أخَاديدَ ليسَ لها حَافّاتٌ، فانْتَهيْتُ إلى قَوم جلُوسٍ حَلَقًا حَلَقًا علَيْهمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ قَدْ عَلاهُمُ النُّورُ، فإذَا هُم الذينَ قُتِلُوا في المعركةِ يأْكُلونَ على موائدَ بينَ أيدِيْهم فجعَلْتُ أتخلَّلُهم وأتصَفَّحُ وجُوْهَهُم لألقَى زَوْجي لكِنَّه هوَ يَنْظُرُنِي، فنَادَاني: يا رَحْمَةُ! فيَمَّمْتُ الصَّوْتَ فَإذَا به في مِثْلِ حَالِ من رَأيتُ من الشُهداءِ، وجهُهُ مثلُ القمَرِ ليلةَ البَدْرِ وهوَ يأكلُ معَ رُفقةٍ لَه قُتِلُوا يَومئذٍ معَهُ، فَقالَ لأَصْحابِه: إنَّ هذهِ البائِسَةَ جَائعةٌ مُنْذُ اليومَ أفَتأذَنُونَ لي أنْ أُنَاوِلَها شَيئًا تأْكُلُه؟ فأَذِنُوا لَهُ، فنَاوَلَنِي كِسْرةَ خُبزٍ. قالت: وأنا أعْلَمُ حينئذٍ أنّه خبزٌ ولكن لا أدري كيْفَ يُخْبَزُ، هو أشدُّ بياضًا من الثَّلجِ واللّبنِ وأحلى من العَسلِ والسُّكرِ وأليَنُ من الزُّبْدِ والسَّمْنِ، فأكَلْتُه فلمّا استقرَّ في جوفي قال: اذهبي كفاكِ الله مَؤُونَةَ الطّعامِ والشّرابِ ما حيِيتِ في الدّنيا، فانتَبهْتُ من نَومي شَبْعَى رَيَّا لا أحتاجُ إلى طَعامٍ ولا شرابٍ وما ذُقتُها منذُ ذلكَ إلى يَومي هَذا ولا شَيئًا يأكلُه الناسُ. وقالَ أبو العبّاسِ: وكانت تَحْضُرُنا وكُنّا نأكلُ فتتنَحَّى وتأْخذُ على أنْفِها تَزعُمُ أنّها تتأذَّى من رائحةِ الطَّعامِ، فسأَلتُها: أتتغَذَّى بشَىءٍ أو تَشربُ شيئًا غيرَ الماءِ؟ فقالتْ: لا، فسألتُها: هل يَخرجُ منها ريحٌ أو أذًى كما يَخرُجُ مِنَ النّاسِ؟ قالت: لا عَهْدَ لي بالأذَى منذُ ذلكَ الزّمانِ، قلتُ: والحيضُ؟ أظنُّها قالت: انقطعَ بانقطاعِ الطُّعْمِ، قلتُ: هل تحتاجينَ حاجَةَ النساءِ إلى الرّجالِ قالتْ: أمَا تستحي منّي تسألُني عنْ مِثل هذا، قلتُ: إنّي لعَلّي أُحَدّثُ النّاسَ عنكِ ولا بدّ أن أستَقْصِيَ، قالت: لا أحتاجُ، قلتُ: فتنامينَ؟ قالتْ: نعَم أطيَبَ نومٍ، قلتُ: فما ترَينَ في منامِكِ؟ قالت: مِثلَما ترَوْنَ، قلتُ: فتَجِدينَ لفَقْدِ الطّعامِ وَهْنًا؟ قالتْ: ما أحْسَسْتُ بجوعٍ منذ طَعِمْتُ ذلك الطعامَ، وكانت تقبَلُ الصَّدَقةَ فقلتُ لها: ما تَصْنَعينَ بها، قالت: أكْتَسي وأكسُو ولَدِي، قلتُ: فهلْ تجدينَ البردَ وتتأذَّينَ بالحرّ؟ قالَتْ: نَعَم، قلتُ: يُدرِكُكِ اللُّغوبُ إذا مشَيتِ؟ قالت: نعَم ألَسْتُ منَ البشرِ، قلتُ: فتتوضَّئِيْنَ للصّلاةِ؟ قالت: نعم، قلتُ: لِمَ؟ قالَت: أمرَني الفقهاءُ بذلكَ، قلتُ: إنَّهم أفْتَوْها على حَديثِ: “لا وضوءَ إلا من حَدَثٍ أو نومٍ”، وذكَرتْ لي أنَّ بطنَها لاصِقٌ بظَهْرِها، فأمَرْتُ امرأةً من نسائِنا فنظَرَتْ (أي إلى غير العورة) فإذا بطنُها كمَا وصَفَتْ وإذا قد اتّخَذَتْ كِيْسًا فضَمَّتِ القُطْنَ وشَدَّتْهُ على بَطنِها كي لا ينقصِفَ ظهرُها إذا مشَت، ثمّ لم أزل أختلِفُ إلى هزَاراسْبْ بينَ السّنتين والثّلاثِ فتَحضُرُني فأعيدُ مسألتَها فلا تَزيدُ ولا تَنْقُصُ، وعَرَضْتُ كلامَها على عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمنِ الفَقيهِ، فقالَ: أنا أسمَعُ هذا الكلامَ منذُ نشأتُ فلا أجِدُ من يدفَعُهُ أو يَزْعُمُ أنّه سَمِعَ أنّها تأكلُ أو تَشْرَبُ أو تتَغوَّطُ. انتهى.
فهذه القِصَّةُ فيها أن لا تَلازُمَ عقلِيٌّ بين فِقْدانِ الأَكْلِ وبينَ المرَضِ وذَهابِ الصّحَّةِ وانْهِدام البُنْيَةِ وكذلكَ سائرُ الأسْبابِ العَاديّةِ يصِحُّ عقلًا أن تتخلَّفَ مفعولاتُها وأن الأشْياءَ بمشيئةِ الله تعالى، وأنَّ الشُّهداءَ لهم حَياةٌ برْزخِيَّةٌ فسُبْحانَ القَدِيرِ على كلِّ شىءٍ.
الشرح: هذه القصّةُ تفيدُنا أنّه لا تلازمَ عقلي بين الأسبابِ ومسبَّباتِها من حيثُ الذَّاتُ، إنّما هي أسبابٌ يخلُقُ الله تعالى عندَها المُسَبَّبات، يخلقُ الله تعالى عند الأكلِ الشّبعَ وعندَ الشُّربِ الرّيَّ وقد لا يخلقُ الشّبعَ والرّيَّ عند الأكلِ والشّربِ، جائزٌ عقلًا أن لا يخلقَ الشّبعَ بعدَ الأكلِ والرّيَّ بعد الشّربِ، هذا يجوزُ وهذا يجوزُ. كذلك تفيدنا أنّه قد يحصُلُ ضررٌ بخلقِ الله بتركِ الأكلِ والشّربِ وقد لا يحصلُ، هذه المرأةُ تركت الأكلَ والشربَ زمانًا طويلًا فلم تَنضَرَّ، وأكثرُ النّاسِ إذا تَرَكوا الأكلَ والشُّربَ لأيّامٍ معدودةٍ خمسة أو ستّةِ أيام يموتونَ من الجوعِ، فيعلَمُ من ذلكَ أن هذه الأسباب لا تخلُقُ شيئًا، الأكلُ لا يخلُقُ الشبعَ وتركُ الأكلِ لا يخلقُ الضَّررَ، الله هو الذي يخلقُ الشّبعَ عندَ الأكلِ ويخلُقُ الضّرَر عندَ تركِ الأكلِ إن شاء. وكذلكَ النّارُ إذا مسّت شيئًا يخلقُ الله الإحراقَ عند مماسّةِ ذلكَ الشىء للنارِ وقد لا يخلقُ الله ذلك، كلٌّ على حسبِ مشيئة الله الأزليّةِ، فهذا سيّدنا إبراهيمُ الخليلُ عليه السلام رماهُ قومُهُ في النّارِ العظيمةِ فلم تحرقهُ ولا ثيابهُ وإنّما أحرقت القيدَ الذي قيّدوه بهِ وكانت النارُ عليه بردًا وسلامًا، وكذلك حَصَلَ لأبي مسلمٍ الخولانيّ رضي الله عنه لما رماهُ الأسودُ العنسيُّ في النّارِ فلم تحرقهُ، وكذلكَ حَصَلَ لكثيرينَ من هذه الأمّةِ بعدَ ذلك من رفاعيّةٍ وقادريّةٍ وغيرِهم. كلُّ هذا فيه دلائل على أنَّ الأسبابَ لا تخلقُ مسبّباتها فالدّواء لا يخلقُ الشّفاءَ كم من مرضى يأخذونَ دواءً لعلّةٍ واحدةٍ فهذا يتعافى والآخر لا يتعافى، وقد قالَ أحدُ شعراءِ الأندلسِ في القرنِ السّابعِ الهجري واسمه يعقوب بن جابر المنجنيقيّ:
قُل لمن يدَّعي الفَخَارَ دَع الفَخـ ***** رَ لذي الكبرياءِ والجبروتِ
نسج داودَ لم يُفِد ليلةَ الغَا ***** رِ وكانَ الفخارُ للعنكبوتِ
وبقاءُ السَّمَندِ في لهبِ النَّا ***** رِ مزيل فضيلةَ اليَاقوتِ
وكذاكَ النّعامُ يلتقِمُ الجَمـ ***** رَ وما الجمرُ للنَّعامِ بقُوتِ
معناه قل للمتفاخر المتبجّح اترك الكبرياء والفضل لله تعالى، الله تعالى هو يفضل بعض خلقه على بعض، الفخر يأتي بمعنى الفضل والفخارُ كذلك.
والكبرياء معناه قريب من معنى العظمة ليس عين العظمة.
ونسجُ داودَ عليه السلام هو دروع الحديدِ، الله ألانَ له الحديدَ فكان يصنعُ بيديهِ دروعَ الحديدِ، وليلة الغار أي ليلة كانَ النبيّ مع صاحبهِ أبي بكرٍ في الغارِ ولحقَ بهما المشركون.
وأمّا السَّمَندُ فهو حيوانٌ يَدخُلُ النَّارَ ينام فيها فلا تؤثّرُ فيه وكانوا إذا أرادوا تنظيفَ جلدِهِ رموه في النارِ فيحترقُ ما سواهُ، وهو حيوانٌ نادرُ الوجودِ كان يوجدُ منه في بلادِ الصّينِ. ومعناهُ أنَّ الياقوتَ حجرٌ فلا يعجب الإنسان إذا لم تؤثّر فيه النارُ كما يعجب من عدمِ تأثيرها في السّمندلِ الذي هو من لحمٍ ودمٍ، كذلك ذَكَرَ كيف تأكل النعام الجمر الأحمر وتستمرئه مع أنَّ النّعامَ من لحمٍ ودمٍ، فسبحانَ القدير على كلّ شىءٍ.
ثمّ إنَّ هذه القصّة التي حصلت لهذه المرأة أيضًا فيها دلالةٌ على أنّ الشّهداءَ لهم حياةٌ برزخيّةٌ أي في مدّةِ القبرِ إلى قيامِ السّاعةِ، أبدانُهم لها حياةٌ وإن كان الذي ينظرُ إليها كهيئةِ جسمِ شخصٍ نائمٍ لكن هي فيها حياة، الشّهيدُ لما يُفتَحُ قبرُهُ فيُنظَرُ إليه يُرى كهيئةِ رجلٍ نائم، مع ذلك نحنُ نقولُ فيه حياةٌ، روحُهُ التي في الجنّةِ متّصلةٌ بِهِ ويحسُّ بلذّةِ الطّعامِ والشّرابِ الذي يأكلهُ الرّوحُ في الجنّةِ، يصلُ إليه فيظلُّ فيه دمٌ، لو بعدَ ألف سنة جُرِحَ يطلع منهُ دمٌ.
هذا إن كانت عقيدتُهُ صحيحةً ونيّتهُ صحيحةً فقاتلَ الكفَّارَ فقتلوهُ، أمّا إذا كانت العقيدة فاسدةً يكون كغيره، بعد نحو ثلاثة أيّامٍ ينتفخُ ويطلعُ من أنفِهِ سائل، رطوبة كريهة منتنة ثم يأكلهُ التّرابُ، وكذلك يحصُلُ لمن كانت نيتُهُ فاسدةً لمن قاتلَ ليقولَ الناس عنه شجاعٌ، ليس تقرّبًا إلى الله فقط.
تَنْبِيْهٌ مُهِمٌّ
قال المؤلف رحمه الله: تَنْبِيْهٌ مُهِمٌّ
لا يُعْفَى الجاهِلُ ممّا ذكرناهُ من الأصولِ، ولا يُعْذَرُ فيما يقَعُ منه منَ الكُفْرِ لعدَمِ اهتمامِهِ بالدّيْن.
الشرح: الجاهلُ إذا كانَ لا يعرفُ أنَّ سبَّ الله كفرٌ فسبَّ الله لا يقال هذا معذورٌ لا يكفرُ لأنّه جَهِلَ الحكمَ، لا يعذرُ أحدٌ بالكفرِ بسببِ جهلِهِ هكذا قال المالكيّةُ كالقاضي عياض وابنِ حجرٍ من الشافعيةِ وكذا الحنفية، بل قالَ بعض الحنفيةِ والقولُ بأن من تكلمَ بالكفرِ عامدًا لكن يجهلُ الحكمَ إنه يعذرُ خلاف الصحيح أي قولٌ لا يعتَبَرُ فهو كالعَدَمِ.
وحكمُ غير سبّ الله من سائرِ أنواعِ الكفرِ كحكمِ سبّ الله وذلك كسبّ الرّسولِ والملائكةِ والكتبِ السّماويةِ ودينِ الله الإسلامِ مع اعتقاد أو بغير اعتقاد لا فرق بين من يقول هذه الكلمات عن اعتقاد وبين من يقولها مزحًا أو تقية إلا المكره فإن المكره بالقتل على أن ينطق بكلمة الكفر أو على فعل الكفر كالسجود للصنم ودوس المصحف بالقدم لا يكفر. والعبرة في الكلمات الكفرية بكون الناطق بها يفهم المعنى الذي هو كفر فلا يشترط أن يكون قاصدًا للمعنى أو غير قاصد كالذي حصل لرجل في الشام كان مع زملائه في دائرة من دوائر الحكومة فرأوا رجلًا أعمى مقبلًا فقال أحدهم قال الله تعالى إذا رأيت الأعمى فَكُبَّهُ لست أكرم من ربه. قال ذلك ليضحك زملاءه وهو لا يعتقد أن هذا قرءان. وكثير من الجهلة يقولون مثل هذا ولا يظنون فيه معصية فضلًا عن أن يروه كفرًا.
قال المؤلف رحمه الله: ولو كان الجهْلُ يُسْقِطُ المؤاخَذَةَ لكانَ الجهلُ خَيْرًا من العلم وهذا خِلافُ قولِه تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة الزمر/9]، إلا أنَّ من كانَ قريبَ عهدٍ بإسلامٍ ونحوَه لا يكفرُ بإنكارِ فرضيَّةِ الصلاةِ وتحريمِ الخمرِ ونحوِ ذلك إن لم يكن سَمِعَ أن هذا دين الإسلامِ.
الشرح: هذا معناهُ أن الجهلَ لو كانَ يُسقِطُ العقوبةَ في الآخرةِ على الإطلاق لكان الجهلُ خيرًا للنّاسِ، ولكنَّ الأمرَ ليس كذلك بدليلِ الآيةِ التي ذكرناها. الله تعالى فَضَّلَ الذين يعلمونَ على الذين لا يعلمونَ فلو كانَ الجاهلُ يُعذَرُ لجهلِهِ على الإطلاق لكانَ الجهلُ أفضل للنّاسِ. إلا أنه إذا أنكر شخصٌ أمرًا من أمورِ الدين ولم يعلم أنه من أمورِ الدين مما هو غير معلومٍ من الدين بالضرورةِ لا يكفَّرُ منكرهُ بل يعلَّمُ ثم إن عادَ فأنكرَ يكفَّرُ، حتى لو دخلَ رجلٌ في الإسلامِ ومضت عليه مدةٌ ولم يعلم قبل دخولِهِ أن الزنى حرامٌ عندَ المسلمينَ ولم يسمع فجرَى على لسانِهِ استحلالُ الزنى لا يكفّرُ بل يعلَّمُ أن الزنى في دينِ الله حرامٌ، فإن عادَ فأنكرَ أو شكَّ كفّرَ، وعلى هذا يقاسُ كثيرٌ من الأمورِ. وكذلكَ لو لم يسمع شخصٌ وُلِدَ بين أبوينِ مسلمينِ وعاشَ ولم يسمع بأنه في دينِ الإسلامِ تجبُ خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ فأنكرَ وجوبَها فظنَّ أنها ليست واجبة فلا يكفَّرُ بل يعلَّمُ، يقالُ له إن في دينِ الإسلامِ خمسَ صلواتٍ كتبهنَّ الله على العبادِ ثم إن أنكرَ بعدَ ذلك يُحكَمُ عليه بالردّةِ فيُطَالَبُ بالعودةِ إلى الإسلامِ بالنطقِ بالشهادتينِ فمن كان حاله هذا فهو كالكافرِ الذي أسلمَ من قريبٍ.
تنبيهٌ
في بيان مَنِ الذي يُعَدُّ مثلَ قريب عهدٍ بإسلام
اعلم رحمَك الله أن الذي يُعدُّ مثل قريب عهدٍ بإسلامٍ هو الذي لم يعلّمهُ أهلهُ ولا غيرهم أمورَ الدين إلا الشهادتين وعاشَ على ذلك زمانًا طويلًا أو قصيرًا فهذا إذا أنكرَ شيئًا من أمورِ الدين التي هي ظاهرة بينَ المسلمينَ لا يكفَّرُ بل يعلَّمُ، فالذي هو بعيدٌ عن معرفةِ سماعِ الأحكامِ الشّرعيّةِ ولو كانَ يعيشُ بين المسلمينَ هذا الذي يقالُ له مثل قريبِ عهدٍ بإسلامٍ، ليس الذي تَخفى عليه مسئلةٌ ومرَّت لهُ نظائرُها كالذين سَمعوا كثيرًا من الأحكامِ الشّرعيّةِ ممّا هو شبيهُ هذه المسئلةِ فهذا لا يُعدُّ مثل قريب عهدٍ بإسلام، إنّما شبيه قريب العهدِ بالإسلامِ هو الذي عاشَ بين المسلمينَ وهو لا يتعلَّم معهم شيئًا وهو من أبوين مسلمين.
فالذي تعلَّم كثيرًا ممّا يشبهُ هذه المسئلة ومع هذا جَهِلَهَا هذا لا يُعَدُّ مثل قريب عهدٍ بإسلام.
أمّا بعضُ الأشياءِ التي ليست ممّا يفهمُ من النظائرِ فهذهِ إن جَهِلَهَا الشخصُ يُعذَرُ ولو كانَ دارسًا زمانًا واسعًا لعلمِ الدّين لأنّه ما سَمِعَ بها. مثلًا: شخصٌ ما سَمِعَ بأنّ نبيًّا من الأنبياءِ اسمه إلياس وهو مَضَى عليه زمانٌ طويلٌ، ولا قرأَ في القرءانِ اسم إلياس بينَ الأنبياء فهذا لو كان دَرَسَ عدَّة كتبٍ وتلقَّى من المشايخِ هذا لا يكفَّرُ، لأنَّ مثل هذه المسئلة لا يعلم بالقياسِ إلا بالسَّماع.
وكذلك لو قرأَ بعضُهم في القرءانِ أن إلياسَ نبيٌّ ثمّ نَسِيَ فَنَفَى نبوَّتَهُ فهذا أيضًا لا يكفَّرُ.
وقد مرّ أن ذكرنا أن الذي ينكر صفة من صفات الله التي تعرف بالعقل لو لم يرد بها نص قرءاني ولا حديثي كقدرة الله وإرادته ووحدانيته وحياته ومخالفته للمخلوقات أي لا يشبهها بوجه من الوجوه وأنه سميع وأنه بصير وأنه عالم وأنه متكلم واستغنائه عن كل شىء وقِدمه أي أنه أزلي لم يسبق وجوده العدم كغيره وبقائه أي لا يجوز عليه العدم لا يعذر أحد بالجهل بذلك لو كان قريب عهد بإسلام لم يسمع بشىء من أمور الدين إلا أنه علم أن الله ربه لا إله غيره وأن محمدًا رسوله وصدقَ الأنبياءِ وأمانتَهم وفسادَ دينٍ غير دين الإسلام.
قال المؤلف رحمه الله: والفرضُ الأولُ في حقّ الأهلِ تعليمُهُمْ أصولَ العقيدةِ كيْلا يقَعُوا في الكفرِ بجهلهِم بالعقيدةِ فإن اعتقدوا أنَّ الله جِسْمٌ نورانِيٌّ أبيَضُ فاستمَرُّوا بعدَ البلوغ على ذلكَ فماتوا عليه خُلّدوا في النارِ نتيجةَ اعتقاداتِهمُ الفاسدةِ.
الشرح: أهمُّ ما يجبُ تعليمه للأهلِ هو معرفةُ الله ورسولِه لأنَّ الأهلَ من أطفالٍ وغيرِهم إن تُركوا من غير تعليمهم أصول العقيدةِ من غيرِ تعليمِهم أن الله منزّهٌ عن الشكلِ والحَدّ والطولِ والعرضِ واللونِ والتحيّزِ في المكانِ وكل ما هو من صفاتِ المخلوقينَ قد يعتقدونَ اعتقادًا فاسدًا فيَهلكونَ، فإن تركنا الطفلَ بلا تعليمٍ قد يعتقدُ أنَّ الله شىءٌ من قبيلِ النورِ الأبيضِ أو شىءٌ أزرقُ كلونِ السماءِ أو أنه جسمٌ ساكنُ السّماءِ فيخرجُ من الدنيا وهو جاهلٌ بخالقِهِ فإن بَلَغَ على هذا الاعتقادِ وماتَ عليه كانَ من أهلِ النّارِ، لذلك صارَ أولى ما يُعلّم الأهلُ الولد العقيدةَ، يعلّمونه أن الله موجودٌ بلا مكانٍ لأنه كان قبل المكان بلا مكان كان قبل وجود العرش والسموات والأرض وجهة فوق وجهة تحت وجهة يمين وجهة شمال وجهة أمام وجهة خلف وقبل وجود الفراغ والضوء والظلام وأنَّه لا شبيهَ له وأنّه لا يُتصوَّرُ في العقولِ والأذهانِ لأنّه لا مثلَ له ولا شبيهَ وأنّه هو الذي يستحقُّ العبادةَ ولا خالقَ لشىءٍ سواهُ وأنّه عالمٌ بكلّ شىءٍ قادرٌ على كلّ شىءٍ ونحو ذلك، ثم يُعلّمُ الصلوات الخمس والصيامَ صيام رمضان وأنّه فرضٌ على كلّ مكلّفٍ قادرٍ على الصيامِ، ثم يُقالُ له السرقةُ حرامٌ والزّنى حرامٌ واللّواطُ حرامٌ والظّلمُ حرامٌ والكذبُ حرامٌ وضربُ المسلمينَ وسبُّهم بغيرِ حقّ حرامٌ وما أشبهَ ذلكَ.
قال المؤلف رحمه الله: قال الفُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ: “لا يغُرَّنَّكَ كثرَةُ الهالكين”، فهل هذا الجهلُ في العقيدةِ هو نتيجةُ محبَّةِ الأهلِ لأبنائهم؟ الشرح: الفضيلُ كانَ من أكابرِ السلفِ من الأتقياءِ الأولياءِ العلماءِ الزاهدينَ المعروفين بالعلمِ والعمَلِ كان في المائةِ الثانيةِ من الهجرةِ في زمنِ الشافعي، أخذَ العلمَ من مالِكٍ رضي الله عنه، وقد ثبتَ عن الفضيل رضي الله عنه هذا القول: “لا يغرَّنَّكَ كثرةُ الهالكينَ” معناهُ لا تنظر إلى كثرةِ من يتخبَّطُ بالمعاصي والجهلِ فتقول أكثرُ الناس ضالّونَ فتضلّ معهم، اتركهم فيما ضَلّوا فيه واستعمِل عقلَكَ الذي هو نعمةٌ عظيمةٌ به تميّزُ بينَ القبيحِ والحسنِ لتكون مع النَّاجينَ، اترك أكثرَ البشرِ ولا تمشِ معهم في الضلالِ واسلُك سبيلَ الصالحينَ ولو قَلُّوا.
قال المؤلف رحمه الله: وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات/56] وجاءَ في تفسير الآيةِ: أي وما خلَقَ الله الجِنَّ والإنْسَ إلا ليأمُرَهم بعبادته.
الشرح: هذه الآية ليس معناها أن الله تعالى شاءَ للجميعِ أن يكونوا مؤمنينَ كما تقولُ المعتزلةُ، الله أمرَ الجميعَ بالعبادةِ لكن ما شاءَ للجميعِ أن يكونوا عابدينَ له، والدليلُ على ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [سورة السجدة/13] وغيرها من الآيات وأما قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ [سورة الإسراء/23] أي أمرَ الله ألا تعبدوا إلا إيّاهُ ليسَ معناهُ شاءَ أن يكونَ الجميعُ عابدينَ لهُ، بل أمرَ الجميعَ أن يعبدوه. والعبادةُ هي نهايةُ التذلُّلِ.
قال المؤلف رحمه الله: وبعدَ أَن جاءَنا الهُدَى وهو الرّسولُ صلى الله عليه وسلم وقامَت علينا الحجَّةُ به فلا عُذْرَ لنا، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [سورة الإسراء/15].
الشرح: هذه الآية فيها دليلٌ على أنَّ الله تعالى لا يُعَذّبُ الذينَ لم يسمعوا بدعوةِ الإسلامِ التي جاءَ بها الأنبياءُ، لا يعذّبهم لا عذابَ استئصالٍ في الدنيا ولا عذابًا في الآخرةِ بنار جهنَّمَ، وبهذه الآية احتجَّ الأشاعرةُ فقالوا من لم تبلغْهُ دعوةُ نبيّ من الأنبياءِ ثمّ ماتَ فلا يعذَّبُ لو عاشَ يعبد الوَثَنَ، وقال أبو حنيفةَ: لا يُعذَرُ أحدٌ بالجهلِ بخالقِهِ، معناهُ العقلُ وحدَهُ يكفي فمن لم يسمعْ بدعوةِ الأنبياءِ يكفيهِ العقلُ وحْدَهُ ممّا يراهُ من خَلقِ السمواتِ والأرضِ وخلقِ نفسِهِ. ليس له عذرٌ إن لم يؤمن باج. وقال الأشاعرة المراد بهذه الآية عذاب الاستئصال في الدنيا ليس عذاب الآخرة. عذابُ الاستئصالِ معناهُ العذابُ الكاسِحُ مثل عذابِ قومِ نوحٍ وهو الغَرَقُ.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة