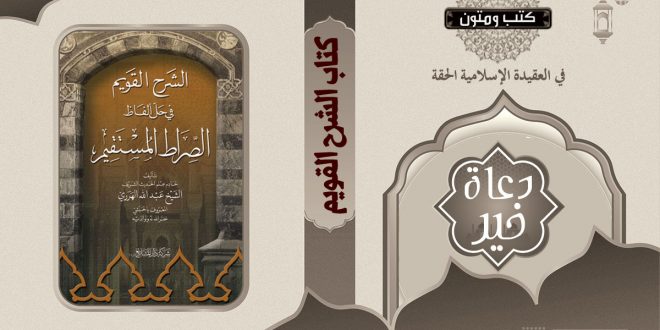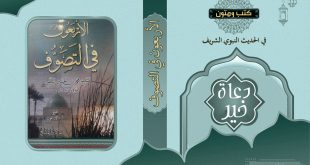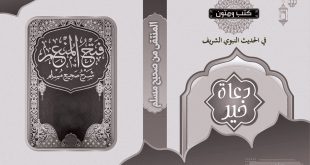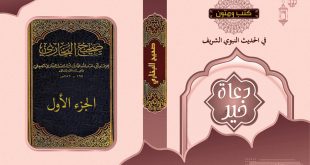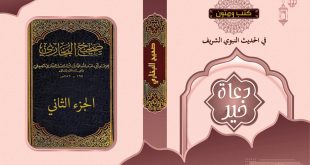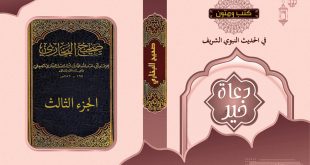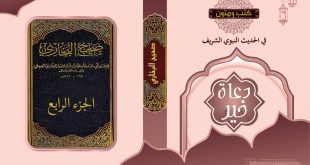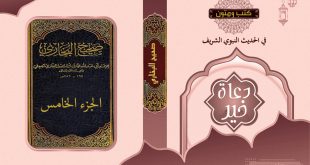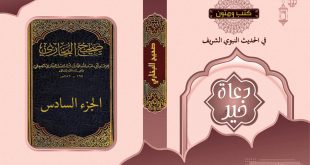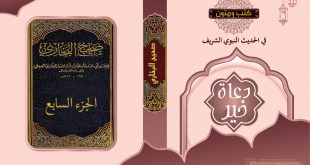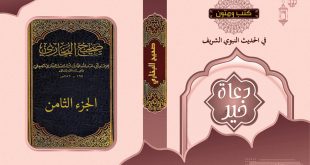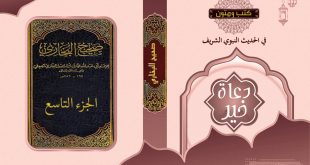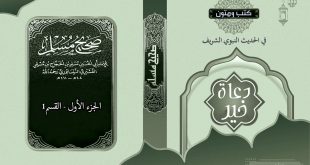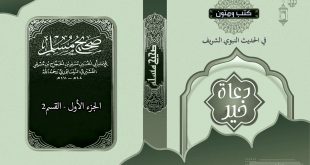بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى ءاله الطاهرين وصحابته الطيبين.
بسمِ الله أي أبتدئ باسم الله، ولفظُ الجلالةِ الله عَلَمٌ للذاتِ المقدَّسِ المستحق لنهايةِ التعظيمِ وغايةِ الخضوعِ ومعناهُ من له الإلهيةُ وهي القدرة على الاختراع أي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، والرحمن معناه الكثيرُ الرحمة بالمؤمنينَ والكافرينَ في الدنيا وبالمؤمنينَ في الآخرةِ، أما الرحيمُ فمعناه الكثيرُ الرحمةِ بالمؤمنين.
قال المؤلف رحمَهُ الله: الصراطُ المستقيمُ.
الشرح: أي هذا بيانٌ للصراطِ المستقيمِ أي للطَّريقِ الحقّ.
قال المؤلف رحمهُ الله: الحمدُ لله.
الشرح: الحمدُ معناه الثناءُ باللسان على الجميلِ الاختياريّ على جهةِ التبجيلِ والتعظيمِ. ومعنى الجميل الاختياري أي الشىء الذي أنعمَ بهِ على عبادِهِ من غيرِ وجوبٍ عليه.
قال المؤلف رحمَهُ الله: والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله.
الشرح: الصلاةُ هنا معناها التعظيمُ أي نطلبُ من الله تعالى أن يزيدَ سيدنا محمدًا تعظيمًا، وأما السلامُ فمعناهُ الأمانُ أي نطلبُ من الله لرسولِهِ الأمانَ ممَّا يخافه على أمتهِ.
قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ {18}﴾ [سورة الحشر].
الشرح: أي لينظُرِ المرءُ ما يُعِدُّ ويقدِّمُ لآخرته من العملِ الصّالح، والآخرةُ ينفعُ فيها تقوى الله . والتَّقوى هي أداءُ الواجباتِ واجتنابُ المحرماتِ، ومن جملةِ الواجباتِ تعلّمُ العلم الشَّرعيّ، فلا يكونُ العبدُ من المتَّقين ما لم يتعلَّم ما فَرَضَ الله على عبادِهِ معرفتَهُ من علمِ دينه، فلا يكون مثل هذا متَّقيًا مهما أتعبَ نفسَهُ في العباداتِ وجاهدَ نفسَهُ بتحملِ مشقَّاتِ العبادةِ وكفِّها عن هواها.
وأكثرُ المتصوّفة اليومَ لا يطلبونَ العلمَ الشرعيَّ إلى القدر الكافي إنَّما يميلون إلى الإكثار من الذّكر فهؤلاءِ لا يصيرون من أولياءِ الله الصالحينَ مهما تَعِبُوا ومهما صحِبُوا أولياءَ الله وخدَموهم إلا إذا أتتهم نفحةٌ فيتعلمونَ ويَجِدُّون في العمل، فهؤلاءِ من أهل العنايةِ، وأمَّا الذين بَقوا على ما هم عليه من الجهلِ وظنُّوا أنهم يصلونَ إلى الله بالذّكر ومحبّةِ الأولياءِ فهؤلاءِ مخدوعونَ.
وقولُه تعالى: ﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ {18}﴾ فيه دليلٌ على محاسبةِ العبدِ نفسَهُ، ومعنى الغدِ هو الآخرةُ.
قال المؤلف رحمه الله: وقالَ عليٌّ رضي الله عنهُ وكَرَّمَ وجهَهُ: “اليومَ العَملُ وغَدًا الحسابُ”، رواهُ البُخَاريُّ في كتابِ الرِّقاق.
الشرح: قولُ: “كرَّم وجهه” عن سيّدنا عليّ استحدثَهُ الناسُ بعد مائةِ سنةٍ أو أكثرَ من وفاةِ علي ولا بأسَ بقوله وقولِ عليه السَّلام. وليس قول “كرَّم الله وجهه” خاصًّا بسيدنا علي لأنه لم يسجد لصنم كما يظنُّ بعضُ الناس بل يوجَدُ غيرُهُ في الصحابةِ مَن لم يسجد لصنم كعبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهما وفيهم من ولد ضمن الكعبة كما ولد عليٌّ في الكعبة فإن حكيم بن حِزام ولد في الكعبة.
وتمامُ الروايةِ التي رُوِيَت عن سيدنا علي: “ارتحلت الدُّنيا وهي مدبرةٌ وارتحلتِ الآخرةُ وهي مقبلةٌ فكونوا من أبناءِ الآخرةِ ولا تكونوا من أبناءِ الدُّنيا، اليومَ العملُ ولا حسابَ وغدًا الحسابُ ولا عَمَل”.
ومعنى قوله: “ارتحلتِ الدُّنيا” أي سارت الدُّنيا، ومعنى “مدبرةٌ” أي الدُّنيا سائرةٌ إلى الانقطاعِ والآخرةُ سارت مقبلةً فالدنيا دارُ العمل، والآخرةُ دار الجَزَاءِ على العملِ، دارُ الحسابِ وليست دارَ العملِ. والرّقاقُ كتابٌ مخصوصٌ في أواخرِ الجامعِ المُسنَدِ للبخاري.
أعظَمُ حُقوقِ الله على عِبَادِه
اعلم أنَّ أعظمَ حقوقِ الله تعالى على عبادِهِ هوَ توحيدُه تعالى وأن لا يُشرَك به شىءٌ، لأنَّ الإشراكَ بالله هوَ أَكبرُ ذنبٍ يقترِفُه العبدُ وهوَ الذَّنبُ الذي لا يغفرُه الله ويَغفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لمن يَشاءُ. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {48}﴾ [سورة النساء].
الشرح: معرفةُ الله تعالى مع إفرادِهِ بالعبادةِ أي نهايةِ التذلُّلِ هو أعظمُ حقوقِ الله على عبادِهِ، وأكبرُ ذنبٍ يقترفُهُ العبدُ هو الكفرُ وهو على نوعين: كفرٌ شركٌ وكفرٌ غيرُ شركٍ، فكلُّ شركٍ كفرٌ وليس كلُّ كفرٍ شركًا، لذلك كان أعظمُ حقوقِ الله على عبادِهِ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا.
والكفر أكبر الظلم قال الله تعالى ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فظلم الكافر بكفره أعظم من قتل المسلم ءالاف الآلاف من المسلمين من غير استحلال لقتلهم.
وقد أخبرَ الله تعالى أنه يغفِرُ كلَّ الذنوبِ لمن شاءَ من عبادِهِ المسلمين المتجنّبين للكفرِ بنوعيه الإشراكِ بالله تعالى الذي هو عبادةُ غيرِه والكفرِ الذي ليسَ فيه إشراكٌ كتكذيبِ الرَّسولِ والاستخفافِ بالله أو برسولِهِ مع توحيدِ الله تعالى وتنزيهِهِ. وممّا يدلُّ على ذلكَ أيضًا قوله عليه الصلاة والسلامُ: “إنَّ الله ليَغفِر لعبدِهِ ما لم يقعِ الحجابُ” قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسولَ الله؟ قال: “أن تموتَ النفسُ وهي مشركَةٌ” رواه أحمد وابن حبان وصححه.
فالكفرُ بجميعِ أنواعِهِ هو الذنبُ الذي لا يغفرُهُ الله أي لمن استمرَّ عليه إلى الموتِ أو إلى حالةِ اليأسِ من الحياةِ برؤيةِ مَلَكِ الموتِ وملائكةِ العذابِ أو إدراكِ الغرقِ بحيث أيقن بالهلاك ونحوِهِ فذاكَ مُلحَقٌ بالموتِ.
فالحاصلُ أنَّ الكفرَ لا يُغفَرُ إلا بالإسلام في الوقتِ الذي يكونُ مقبولا فيه، فمن أسلمَ بعد الوقتِ الذي يُقبَلُ فيه فلا يمحو إسلامُهُ كفرَهُ. فالكفرُ هو أعظمُ الذنوبِ وبعده قتلُ النفس التي حرَّم الله إلا بالحقّ، وأمّا قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ {191}﴾ [سورة البقرة] أي الشّرك أشدُّ من القتلِ، فالشركُ هو أعظمُ الظلم لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ {13}﴾ [سورة لقمان]، وقوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ {254}﴾ ومعناه أكبرُ الظّلمِ هو الكفر.
قال المؤلفُ رحمهُ الله: وكذلكَ جميعُ أنواعِ الكُفرِ لا يَغفرُها الله لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ {34}﴾ [سورة محمد].
الشرح: هذه الآية فيها النّصُّ على أنَّ من ماتَ كافرًا لا يَغفِرُ الله له، وهذا يؤخَذُ من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ {34}﴾ لأنَّ هذا قَيدٌ لعدَمِ المغفرةِ لهم.
ومعنى ﴿وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ {34}﴾ أي ومَنَعوا الناسَ من الدّخولِ في الإسلامِ، وليس هذا شرطًا للحرمَانِ من المغفرةِ بل الكافرُ محرومٌ من المغفرةِ إن منَعَ الناسَ من الإسلامِ أو لم يمنع بل ولو ساعد المسلمين في إدخال الناس في دينهم، لكنَّ الكافرَ الذي يصدُّ الناسَ من الإسلامِ أشدُّ ذنبًا من الكافرِ الذي يكفرُ بنفسِهِ ولا يصدُّ غيرَه عن الإيمان.
قال المؤلف رحمَهُ الله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من شهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ وأنّ محمدًا عبدُه ورسولُه وأنَّ عيسى عبدُ الله ورسولُه وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه والجنةَ حقٌّ والنارَ حقٌّ أدخَلَهُ الله الجنةَ على ما كانَ منَ العملِ”، رواه البخاري ومسلم.
الشرح: هذا الحديثُ الصحيحُ اتفق على إخراجهِ البخاريُّ ومسلمٌ في كتابَيهما المعروفَين بين الأمّةِ الإسلامية، ومعناه يتضمَّنُ أنَّ الإنسانَ إذا ماتَ وهو يشهدُ أن لا إله إلا الله وتجنَّبَ عبادةَ غيرِه وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، ويشهد أنَّ عيسى عبدُ الله ورسولُه وكلمتُهُ ألقَاها إلى مريمَ وروحٌ منه ويشهَدُ أن الجنةَ حقٌّ وأنّ النارَ حقٌّ _ أي موجودتان _ يُدخِلُه الله الجنةَ على ما كان من العملِ أي ولو كانَ من أهل الكبائر.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: “وكلمته ألقَاها إلى مريمَ” أنَّ المسيحَ بشارةُ الله لمريمَ التي بشَّرتها بها الملائكةُ بأمره قبل أن تحمِلَ به، فإنَّ المَلَكَ جبريلَ بشَّرها به، قال لها أنا رسولٌ من الله لأعطيَك غلامًا زكيًّا أي طيّبًا.
وقوله صلى الله عليه وسلم: “وروحٌ منه” معناه أن روحَ المسيحِ روحٌ صادرةٌ من الله تعالى خلقًا وتكوينًا، أي روحُهُ روحٌ مشرَّفٌ كريمٌ على الله، وإلا فجميعُ الأرواح صادرةٌ من الله تعالى تكوينًا لا فرقَ في ذلك بين روح وروحٍ وكلمة “روح منه” ليس معناها أن المسيح عيسى جزء من الله إنما معناها روح وجدت بإيجاد الله أي الله أوجدها من العدم ليس معناها أنه جزء من الله كما ادعى بعض ملوك النصارى احتج بهذه الآية على أن المسيح جزء من الله فرد عليه القاضي أبو بكر الباقلاني بهذه الآية: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ {13}﴾ [سورة الجاثية] فسكت ذلك الملك لأن كلمة ﴿مِّنْهُ {13}﴾ في النصَّين موجودة، فكما أنها لا تدل في الآية على أن ما في السموات وما في الأرض جزء من الله كذلك لا تدل كلمة ﴿مِّنْهُ {13}﴾ في ءاية ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ {171}﴾ على أن روح عيسى جزء من الله.
ومعنى الآية الثانية أنّ الله تعالى سخَّر لبني ءادمَ ما في السموات وما في الأرضِ جميعًا منه أي أنَّ جميع ما في السموات وما في الأرضِ من الله خلقًا وتكوينًا وليس المعنى أنها أجزاءٌ منه تعالى. فالملائكةُ مسخَّرونَ لبني ءادمَ بحفظهم لهم وغيرِ ذلك كإنزالِ المطرِ وإرسالِ الرّياحِ التي ينتفعون بها والدعاءِ لهم أي للمؤمنين من بني ءادمَ خاصّة.
وقوله عليه الصلاة والسلام: “والجنَّةَ حقٌّ والنَّارَ حقٌّ” معناه أنَّهما موجودتان وباقيتان وأنّهما دارَا جزاءٍ، فالجنّةُ دارُ جزاءٍ للمؤمنين والنارُ دارُ جزاءٍ للكافرين.
قال المؤلف رحمَهُ الله: وفي حديثٍ ءاخَر: “فإنَّ الله حرَّمَ على النار من قالَ لا إله إلا الله يبتغي بذلكَ وجهَ الله” رواه البخاري.
الشرح: المعنى أنّ الله تعالى حرَّمَ على النَّار أي الدوامَ فيها إلى الأبدِ من قالَ لا إله إلا الله يبتغي بذلكَ وجهَ الله أي إن قال ذلكَ معتقدًا في قلبه لا منافقًا ليُرضيَ المسلمينَ وهو في قلبهِ غيرُ راضٍ بالإسلامِ إمّا بشَكّه في الوحدانيَّةِ أو بتكذيبهِ في قلبهِ محمَّدًا صلى الله عليه وسلم.
ومعنى “يبتغي بذلكَ وجهَ الله” أي يبتغي القُرب إلى الله تبارك وتعالى ليس لمراءاة الناس بدون اعتقاد. والوجه في لغةِ العرب يأتي بمعانٍ عديدة منها القصد كما قال الشاعر:
أستغفرُ الله ذنبًا لستُ مُحصِيَه ***** ربَّ العبادِ إليه الوَجْهُ والعمَلُ
أي القصد. وكذلك ورد حديث رواه ابنُ حبان وغيرُه وهذا لفظ ابن حبان: “المرأة عورةٌ فإذا خرجت استشرفها الشيطانُ وأقربُ ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها” ومعنى وجه الله هنا طاعة الله.
ومن اعتقد أن الوجهَ إذا أضيفَ إلى الله في القرءانِ أو في الحديثِ معناه الجسد الذي هو مركَّب على البدنِ فهو لم يعرف ربَّهُ لأن هذه هيئة الإنسانِ والملائكةِ والجن والبهائمِ فكيف يكونُ خالقُ العالَم مثلَهم. فالله ليس حجمًا بالمرة، لا هو حجم لطيف ولا هو حجم كثيف لأن العالم حجم كثيف وحجم لطيف. ثم هذا الحجم له صفات حركة وسكون وتغير ولون وانفعال وتحيز في المكان والجهة والله تعالى ليس كذلك إنما هو موجود غير متحيز في الجهات والأماكن لأنه كان موجودًا قبلها ولو لم يكن كذلك لكان له أمثال في خلقه.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: ويجبُ قرنُ الإيمانِ برسالةِ محمدٍ بشهادةِ أن لا إله إلا الله وذلك أقلُّ شىءٍ يحصلُ به النجاةُ من الخلودِ الأبديّ في النارِ.
الشرح: أن اعتقاد أن لا إله إلا الله وحدَه لا يكفي ما لم يُقرن باعتقادِ أنَّ محمدًا رسولُ الله، فالجمعُ بين الشَّهادتين ضَروريٌّ للنَّجاةِ من الخلودِ الأبدي في النارِ. والمرادُ بهذا الحديثِ الذي مرَّ ءانفًا وما أشبَهَهُ من الأحاديثِ التي لم يُذكر فيها شهادةُ أن محمدًا رسولُ الله ما يشمَل الشَّهادةَ الأخرى لأنَّ ذكرَ الشَّهادةِ الأولى صارَ في عُرفِ الشَّرعِ ملحوظًا فيه الشهادةُ الثانيةُ وهي شهادةُ أنّ محمدًا رسولُ الله، وليس المعنيُّ بهذا الحديثِ وشبهِهِ أنَّ الاقتصارَ على شهادةِ أن لا إله إلا الله بدون الشَّهادةِ الأخرى يكفي للنَّجاةِ من الخلودِ الأبديِّ في النارِ بل لا بدَّ من الجمع بينَ الشهادتين وذلك بدليلِ قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا {13}﴾ [سورة الفتح] فتُحمَلُ هذه الأحاديثُ على ما يُوافِقُ هذه الآية، فحديثُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي مناقضًا للقرءانِ، ومن توهَّم خلافَ ذلك فهو لقُصُورِ فَهمِهِ وشدَّةِ جهلِهِ.
معنَى الشَّهادتينِ
قال المؤلف رحمَهُ الله: معنَى الشَّهادتينِ.
الشرح: أي أنَّ هذا بيانُ معنى الشهادتين.
قال المؤلف رحمَهُ الله: فمعنَى شهادةِ أَنْ لا إله إلا الله إجمالا أعترفُ بلساني وأعتقدُ وأذعن بقلبي أَنَّ المعبودَ بحقٍّ هوَ الله تعالى فقط.
الشرح: أن معنى لا إله إلا الله إجمالا أي من غير تفصيلٍ اعترافٌ مع الاعتقادِ والإذعان بأنَّه لا يستحقُّ الألوهيةَ أحدٌ إلا الله أي لا يستحق أحدٌ غاية الخشوع والخضوع إلا هو، والإله في أصلِ اللغةِ المعبودُ بحقّ ثم استعملَهُ المشركونَ لما يعبدونهُ من دونِ الله.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: ومعنَى شهادةِ أنّ محمّدًا رسولُ الله أعترفُ بلساني وأُذعِنُ بقلبي أنَّ سيّدنَا محمَّدًا صلى الله عليه وسلم مرسَلٌ من عندِ الله إلى كافَّةِ العالمينَ من إنسٍ وجِنٍّ.
الشرح: أُذعِنُ بمعنى أعتقدُ لأنَّ الاعترافَ وحدَهُ من دون اعتقادٍ لا يكفي، فالمعرفةُ إذا اقترنَ بها الإذعانُ أي رضا النَّفسِ بالشىء الذي عرفَتهُ هي الإيمانُ الذي هو مقبولٌ عندَ الله. وأما المعرفةُ وحدَها فلا تكفي لأن الله تعالى أخبرَ عن اليهود أنهم كانوا يعرفون محمدًا أنه نبي فقال تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ {146}﴾ [سورة البقرة] لكن لم تُذعِن نفوسُهُم فلذلكَ كانوا يكذّبونهُ بألسنتهم مع علمهم بأنه نبي لأن التوراةَ التي أُنزلت على موسى فيها الإخبار بأن محمدًا رسولُ الله لكنَّ التوراةَ والإنجيلَ حُرّفا لفظًا بعد أن حُرّفا معنًى.
وقوله: “مرسلٌ من عند الله إلى كافَّة العالمين من إنسٍ وجنٍّ” فالعالمونَ هنا هم الإنسُ والجنُّ بدليل قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا {1}﴾ [سورة الفرقان]، فالمعنى أنَّه مرسلٌ إلى كافةِ الإنسِ من عُربٍ وعجَم وإلى كافَّةِ الجنّ.
قالَ المؤلفُ رحمَهُ الله: صادقٌ في كلِّ ما يبَلِّغُه عن الله تعالى لِيُؤمِنُوا بشَريعَتِه ويتَّبِعُوه.
الشرح: يجب الإيمانُ بأنَّ سيّدنا محمدًا صادقٌ في كلِّ ما جاءَ به سواءٌ كانَ ممَّا أخبرَ به عن الأمور التي ستحدثُ في المستقبلِ كأمورِ الآخرةِ أو أمورِ الأممِ السَّابقة أو تحليلِ شىءٍ أو تحريمِهِ.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: والمرادُ بالشّهادتينِ نفيُ الألوهيةِ عمَّا سوَى الله وإثباتُها لله تعالى. معَ الإقرارِ برسالةِ سيدِنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
الشرح: هذه العبارةُ فيها نفيُ أن يكون شىءٌ سوى الله يستحقُّ العبادةَ، وفيها إثباتُ أنَّ الله وحدَهُ هو الذي يستحقُّ العبادةَ أي مع الاعتراف والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي معرفة معنى العبادة على ما هو المراد في الكتاب والسنة، فإن كثيرًا من الناس يجهلون ذلك وهم الوهابية ويظنون أن قول الشخص يا محمد أو يا رسول الله أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني أو يا علي أو يا حسن أو يا حسين ونحو ذلك عبادة للرسول ولمن ذُكِرُوا فعلى زعمهم هو كافر بندائه للرسول ولمن ذكر بعده وهذا من أجهل الجهل، فنداء غير الله من رسول أو ولي في حياته أو بعد مماته ليس عبادة لغير الله إنما العبادة كما شرح علماء اللغة غاية التذلل.
هؤلاء المسلمون الذين يقولون يا رسول الله عند الضيق أو الفرح ما تذللوا للرسول غاية التذلل إنما يعظمون الرسول تعظيمًا، ثم قد يقصدون مع ذلك أن يفرج الله عنهم الكرب أو يقضي لهم حاجاتهم إكرامًا للرسول والأولياء بما لهم عند الله من الكرامة. فإذا كان قول يا فلان لملِك من الملوك أو نحوه في وجهه ليساعده في حاجته التي يريدها أو ليدفع عنه ما يزعجه ويؤذيه جائزًا ليس عبادة له فكيف يكون إذا حصل هذا لأهل القبور أو للأحياء الذين هم غير حاضرين عبادة لهم. فاعتقاد الوهابية هذا منشؤه الجهل بمعنى العبادة أليس ثبت عن رسول الله أنه علَّم بعض أمته أن يقول في غير حضرته يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي ففعل ذلك الشخص وهو رجل أعمى أراد أن يكشف الله بصره في غير حضرة الرسول ثم عاد إلى الرسول وهو في مكانه وقد أبصر. ثم الصحابي الذي كان عند الرسول تلك الساعة علَّم شخصًا في زمن عثمان ابن عفان كانت له حاجة عند عثمان فما كان يلتفت إليه لشغل باله ففعل الرجل مثل فعل ذلك الأعمى ثم جاء إلى عثمان فقضى له حاجته.
ثم لم يزل المسلمون يذكرون هذا الحديث ويعملون به إلى يومنا هذا وأودعه حفاظ الحديث كتبهم الحافظُ الطبراني والحافظ الترمذي من المتقدمين والحافظ النووي والحافظ ابن الجزري وغيرهم من المتأخرين ذكروه في مؤلفاتهم فالوهابية بقولهم إن هذا شرك وكفر يكونون كفَّروا هؤلاء الحفاظ الذين أودعوا كتبهم هذا الحديث ليُعمل به فنعوذ بالله من فساد الفهم.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: قال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا {13}﴾ [سورة الفتح].
الشرح: هذه الآية فيها دليلٌ على ما مرَّ من أنَّ الإيمان بمحمدٍ لا بدَّ منه لصحة الإيمانِ أي لكون العبد مؤمنًا عند الله بحيثُ إنَّ من شكَّ في ذلك أو أنكرَ فهو كافرٌ لأنَّه عاندَ القرءانَ. وهذه الآية أيضًا تُعطي أنَّ من ءامنَ بالله ورسولِهِ ثم لم يعمل شيئًا من الفرائض ليس بكافرٍ وأنَّه ليس خالدًا في النَّار، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّا أَعْتَدْنَا {13}﴾ أي هيَّأنا ﴿لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا {13}﴾ أي نارَ جهنَّمَ لكفرهم. وذلك لقوله تعالى ﴿وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا {13}﴾ حيث دلت هذه الآية على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد كافر ولو كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل لأن القرءان سماهم أهل الكتاب وسماهم كافرين لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. والتوراة والإنجيل المنزّلان فيهما الأمر بالإيمان بمحمد غير أن هؤلاء المنتسبين إليهما لم يعملوا بالكتابين ولو عملوا بهما لاتبعوا محمدًا لأن الكتابين حرّفا تحريفًا بالغًا وحذف منهما ذكر الإيمان بمحمد، والآن لم يبق بين البشر إلا المحرَّف، ولأجل انتساب اليهود إلى التوراة والنصارى إلى الإنجيل انتسابًا باللفظ سماهم القرءان أهل الكتاب وكفَّرهم قال الله تعالى ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ {70}﴾ [سورة ءال عمران].
ومن الدليل على كفر أهل الكتاب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ {6}﴾ [سورة البينة] أي شر الخلق. وبعض الناس الجهال يقولون القرءان يقول من أهل الكتاب معناه ليسوا كلهم كفارًا وهذا جهل باللغة لأنّ “مِنْ” هذه بيانية وليست للتبعيض معناه الكفار إن كانوا من أهل الكتاب وإن كانوا مشركين من غير أهل الكتاب هم شر الخلق.
قال المؤلف رحمَهُ الله: فهذه الآيةُ صريحةٌ في تكفيرِ من لم يؤمن بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم فمن نازعَ في هذا الموضوعِ يكونُ قد عاندَ القرءانَ ومن عاندَ القرءانَ كَفرَ.
الشرح: أنَّ من خالفَ في هذا الموضوع فأنكرَ الإيمان بمحمدٍ فهو كافرٌ. فمن ظن أن الإنسان يكون مؤمنًا من أهل الجنة من غير إيمان بمحمد فهو كافر كما أنه من كان في زمان عيسى أو زمان موسى أو غيرهما من الأنبياء إذا كذب أحدًا منهم واعترف بوجود الله ولم يعبد غيره فهو كافر لأن الله أرسل هؤلاء ليُصَدَّقوا ويُتَّبَعوا فتكذيبهم تكذيب الله.
قال المؤلف رحمَهُ الله: وأجمعَ الفقهاءُ الإسلاميّونَ على تكفيرِ من دانَ بغيرِ الإسلامِ. وعلَى تكفيرِ من لم يكفِّرْهُ أو شَكَّ أو توقَّفَ كأن يقولَ أنا لا أقولُ إنَّه كافرٌ أو غيرُ كافر.
الشرح: أن من اتخذ لنفسه دينًا غير دين الإسلام فهو كافر، ومن تردّد في تكفيره أي في تكفير من لا يَدينُ بالإسلام بل يدينُ بغيرِهِ من يهوديَّةٍ أو مجوسيَّةٍ أو غيرِ ذلك يكفُر، وكذلك الذي يقول لعلَّه كافرٌ ولعلَّه غير كافرٍ ولو كانَ هذا الشخصُ ممَّن يدَّعي الإسلام لفظًا، بل ولو اعتقدَ هذا الشخص وظنَّ أنَّه مسلمٌ، فإنكارُ كفرِهِ والتَّردُّدُ في كفرِهِ كفرٌ.
قال المؤلف رحمَهُ الله: واعلَم باستيقانٍ أنَّهُ لا يصحُّ الإيمانُ والإسلامُ ولا تُقبلُ الأعمالُ الصالحةُ بدونِ الشهادتينِ بلفظِ أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أنّ محمَّدًا رسولُ الله أو ما في معناهما ولو بغَيرِ اللغةِ العربيةِ. ويكفي لصحةِ الإسلامِ النطقُ مرَّةً في العُمُرِ ويبقى وجوبُها في كلِّ صلاةٍ لصِحَّةِ الصَّلاةِ، هذا فيمن كانَ على غيرِ الإسلامِ ثمَّ أرادَ الدخولَ في الإسلامِ.
الشرح: قوله: “واعلم باستيقان” أي جازمًا بلا شكٍ أنَّه لا يصحُّ الإيمانُ والإسلامُ ولا تُقبلُ الأعمالُ الصالحةُ بدون النّطقِ بالشهادتين بلفظ أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أنّ محمَّدًا رسول الله، ولا يُشترَطُ خصوصُ هذا اللفظِ بل يكفي ما يُعطي معناهُمَا كقولِ لا ربَّ إلا الله محمدٌ نبيُّ الله، وكذلك لو نَطَقَ بما يُعطي معناهما بغير اللّغةِ العربيةِ، وهذَا النُّطقُ يكفي مرَّةً واحدةً في العمرِ لصحةِ الإسلامِ هذا فيمن كان على غير الإسلامِ ثم أرادَ الدخولَ في الإسلامِ، وبعد تلك المرَّةِ يبقى وُجوبُها في كلّ صلاةٍ لصحةِ الصلاةِ.
ثم إن الأعمالَ الصالحة لا تكونُ مقبولةً عند الله بدون الإيمان، والدليلُ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا {124}﴾ [سورة النساء].
قال المؤلف رحمَهُ الله: وأمَّا من نشَأَ على الإسلامِ وكانَ يعتقدُ الشَّهَادتينِ فلا يُشترط في حَقّه النُّطقُ بهما بل هو مسلمٌ لو لَم يَنطِق.
الشرح: من نشأَ على الإسلامِ بين أبوين مسلمين ما دامَ اعتقادُهُ على معنى الشَّهادتين فهو مسلمٌ مؤمنٌ ولو لم ينطِق بهما بلسانِهِ حتى ماتَ، لكنه يكون عاصيًا مرتكبًا للكبيرةِ لأنه لم ينطق بهما بعد البلوغِ.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: وقالَ صلى الله عليه وسلم: “قالَ الله تَعالى: وما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشىءٍ أحبَّ إليَّ مما افتَرضتُ عليه” حديث قدسيٌّ رواه البخاريُّ.
وأفضلُ وأوّلُ فرضٍ هوَ الإيمانُ بالله ورسولِه.
الشرح: الحديثُ القدسيُّ هو الحديثُ الذي صَدَّرَه رسول الله بقالَ الله أو يقول الله أو بما في معنى ذلك، أما الحديثُ النبويُّ فما صَدَّره الصحابي بقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديثِ بيانُ أن أعظمَ ما يُتقرَّبُ به إلى الله هو أداءُ فرائضِ الله وقد قال بعض الأكابر: “من شغلَهُ الفرضُ عن النَّفل فهو معذورٌ ومن شغلَهُ النفلُ عن الفرض فهو مغرورٌ” ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، فالعملُ بالفرض يُقرّبُ إلى الله أكثرَ من العملِ بالنوافلِ، فعليكم بتقديمِ الفرضِ على النَّفلِ عملًا بالقاعدةِ المذكورةِ، وأفضلُ الأعمالِ على الإطلاقِ هو الإيمانُ بالله ورسولِهِ.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: واعتقادُ أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي ما لَم يُقرن باعتقادِ أنَّ محمدًا رسولُ الله قالَ تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ {32}﴾ [سورة ءال عمران] أي لا يُحِبُّ الله من تولَّى عن الإيمانِ بالله والرسولِ لكفرهم والمراد بطاعة الله والرسول في هذه الآية الإيمان بهما.
الشرح: معنى ﴿قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ{32}﴾ أي بالإيمان بهما ﴿فإِن تَوَلَّوْاْ {32}﴾ أي أعرضوا عن ذلك ﴿فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ {32}﴾ أي فهم كفَّارٌ لا يحبُّهم الله ولو أحبَّهم لرزقَهُم الإيمانَ بالله ورسوله محمد.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: فهذَا دليلٌ على أنَّ من لم يؤمن بالله ورسولِه محمدٍ صلى الله عليه وسلم فهُوَ كافرٌ وأنَّ الله تَعالى لا يُحِبُّه لكُفرِه فمن قالَ إنَّ الله يحبُّ المؤمنينَ والكافرينَ لأنه خلقَ الجميعَ فقد كذَّبَ القرءانَ فيقالُ لَهُ الله خلَقَ الجميعَ لكن لا يُحِبُّ الكُلَّ.
الشرح: الله خَلَقَ المسلمينَ والكافرين لكنه لا يحبُّ سوى المسلمين.
الفَرضُ على كلِّ مكلَّف
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: الفَرضُ على كلِّ مكلَّفٍ
واعلم أنَّ النطقَ بالشهادَتين بعدَ البلوغ فرضٌ على كلِّ مكلَّفٍ مرَّةً واحدةً في عُمرِه بنيَّةِ الفرضِ عندَ المَالكيةِ لأنَّهُم لا يُوجبونَ التَّحيّاتِ في الصَّلاةِ إنّما هم يعتبرونَها سنَّةً وعندَ غيرهم كالشافعيةِ والحنَابلةِ تجبُ في كلِّ صلاةٍ لصحةِ الصلاةِ.
الشرح: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله ضروريةٌ في كلِّ صلاةٍ عند الشافعيةِ والحنابلةِ أما عند المالكيةِ فهي عندهم سنّةٌ مؤكدةٌ على أحد القولين في المذهب المالكي، والسنةُ المؤكدةُ هي ما كانَ يُواظِبُ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي عندهم أن يرفَعَ رأسَهُ وينتظرَ بقدر “السلامُ عليكم” ثم يقول: “السَّلام عليكم”. فيُفهم من هذا أن المالكيةَ يُوجبونَ النطقَ بالشهادتينِ مرَّة واحدة بعد البلوغِ بنيةِ الفرضِ لأنهم لا يوجبونها في الصلاةِ.
لا دينَ صحيحٌ إلا الإسلامُ
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: الدينُ الحقُّ عندَ الله الإسلامُ قالَ تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {85}﴾ [سورة ءال عمران].
الشرح: أنَّ الذي يطلبُ دينًا غير الإسلام يدينُ به فلن يقبلَهُ الله منه، فالدينُ الصحيحُ عندَ الله هو الإسلام، وليس معناه أنه لا يُسَمَّى ما سوى الإسلامِ دينًا بل يُقالُ دينُ اليهود ودينُ المجوس لكنه دينٌ باطلٌ، وقد أمرَ الله تعالى الرسولَ أن يقول ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ {6}﴾ [سورة الكافرون] أي أنا ما أزالُ على ديني الذي هو حقٌّ وأنتم لكم دينكُم الباطلُ فعليكم أن تتركوهُ.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: وقالَ تَعالى أيضًا: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ {19}﴾ [سورة ءال عمران].
الشرح: أي أنّ الدِّينَ الصحيحَ الذي ارتضاهُ الله لعباده من البشر والجن والملائكة الإسلامُ لا غيرُ وما سواهُ من الأديانِ فهو باطلٌ. وهو الدين الذي كان عليه البشر، ءادم وأولاده ما كانوا يدينون إلا بالإسلام إنما نشأ الكفر بعد ذلك قال الله تعالى ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً {213}﴾ [سورة البقرة] أي كلهم على الإسلام ثم اختلف البشر بقي بعضهم على الإسلام وكفر بعض فدان بغير الإسلام، ثم لما اختلفوا بعث الله النبيين ليبشروا من أسلم بالجنة وينذروا من كفر بالعذاب في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً {213}﴾ أي كلهم على الإسلام فاختلفوا ﴿فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ {213}﴾.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: فكُلُّ الأنبياءِ مسلمونَ فمن كانَ متَّبعًا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلمٌ موسويٌّ، ومن كانَ متَّبعًا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهوَ مسلمٌ عيسويٌّ، ويَصحُّ أن يُقالَ لمن اتَّبعَ محمدًا صلى الله عليه وسلم مسلمٌ محمديٌّ.
الشرح: أنَّ الأنبياءَ جميعَهم دينُهم الإسلامُ فكان ءادمُ على الإسلام وكذلك الأنبياءُ بعده إلى نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا كلُّهم يعبدونَ الله ولا يشركون به شيئًا، فمن كان في زمن موسى صلى الله عليه وسلم فآمنَ بالله ربًّا وصدّقَ برسالةِ موسى فهو مسلمٌ موسويٌّ أي من أَتباعِ موسى، وكذلكَ الأمر فيمن كانَ في أيام عيسى فآمنَ بالله وصدَّق بعيسى فهو مسلمٌ عيسويٌّ . ومعنى مسلمٌ محمديٌّ أي مسلمٌ متَّبع محمدًا فيما جاء به من توحيدِ الله وتصديقِ الأنبياءِ والإيمانِ بوجودِ الملائكة المكْرَمين والإيمانِ بالكتبِ السماويةِ والإيمانِ باليومِ الآخرِ الذي يُجازى فيه العباد المؤمنون بأعمالهم بإدخالهم الجنةَ والكافرون بإدخالهم جهنم، وأن الجنةَ فيها نعيمٌ محسوسٌ وجهنمَ فيها ءالامٌ محسوسةٌ، وأنه لا خالقَ للأجسامِ ولا لشىء من الحركاتِ والسَّكنات إلا الله. فكلُّ الأنبياء جاءوا بهذا لا يختلفون في هذا إنما تختلفُ الأحكامُ التي أنزلَها الله عليهم وذلك لأن الله تعالى فرض على أنبياءِ بني إسرائيل وأممِهم صلاتين وأنزلَ على بعض الأنبياء خمسين صلاةً، وأوجبَ فيما أوجبَ على بعض أن يدفعوا ربعَ أموالهم زكاةً، وأنزلَ على بعضٍ تَحتُّم قتل القاتل، وأنزلَ على ءادمَ تحليلَ زواج الأخِ بأخته التي هي توأمةُ أخيهِ الآخر، وكلٌّ يجبُ العملُ به في شريعةِ ذلك النبي، والله تعالى يُغيرُ الأحكامَ التي كانت في شرع نبيّ سبقَهُ وهو العليمُ بمصالح عبادِهِ، والمصالحُ تختلفُ باختلافِ الأزمانِ والأحوالِ.
وكل نبي في زمانهِ يجبُ التقيدُ به في الإيمان والأحكام التي أنزلت عليه فلما جاءَ سيدنا محمد ءاخرُهم أنزَل الله عليه أحكامًا لم تكن في شرائع من قبله من الأنبياءِ كالصلاةِ في الأماكنِ التي هُيئت للصلاة وغيرها ولم يكن ذلك في شرعِ من قبله من الأنبياءِ بل كان مفروضًا عليهم أن يُصلوا في أماكن مخصوصة هُيئت للصلاة وهي المساجد باللغة العربية، وكان لتلك الأماكن عند أولئك اسم غير المسجد وكان أولئك لا تقبل صلاتهم إلا في مساجدهم ولا تصح صلاتهم في بيوتهم ولا في متاجرهم ولا في مزارعهم ولا في البرية والغابة، إلا أن بني إسرائيل المسلمين هدم فرعون مساجدهم فأذن الله لهم أن يصلُّوا في بيوتهم، وأنزلَ على سيدنا محمد التيمّمَ بالترابِ عند فَقدِ الماءِ أو العجزِ عن استعماله ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله بل كانوا يتوضئون ويصلّون فإن لم يجدوا ما يتوضئونَ به توقّفوا عن الصلاةِ حتى يجدوا الماءَ.
قصةٌ غريبةٌ فيها دلالة على أن سيدنا عيسى عليه السلام أوصى باتّباعِ محمدٍ إذا ظَهَرَ: خَرَجَ من اليمن أربعة أشخاصٍ قاصدين مكَّة فأدرَكَهم الليلُ في البرية فنزلوا في بعض الليل في أرض فناموا إلا جَعْدَ بن قيس المُرادي فسمعَ هاتفًا لا يرى شخصه يقول:
ألا أيها الركبُ المعرّسُ بلّغُوا ***** إذا ما وصلتم للحطيم وزمزَما
محمدًا المبعوثَ منا تحيَّةً ***** تشَيّعُه من حيثُ سار ويَمَّما
وقولوا له إنّا لدينكَ شِيعةٌ ***** بذلك أوصانا المسيحُ ابنُ مريما
فهذا الهاتفُ جنيٌّ مؤمنٌ أدركَ عيسى قبل رفعه إلى السماءِ وءامنَ به وسمِعَ منه وصيته بالإيمان بمحمدٍ إذا ظَهَرَ واتباعه، فلما وصلوا إلى مكةَ سألَ أهلَ مكة عن محمدٍ فاجتمعَ به فآمنَ به وأسلمَ وذلكَ كانَ في أول بعثةِ محمدٍ قبل أن ينتشرَ خبرُهُ في الجزيرةِ العربيةِ، ومعنى المعرّس أي المسافرُ الذي ينزِلُ في ءاخرِ الليل ليستريحَ.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: والإسلامُ هو الدّينُ الذي رضيَهُ الله لعبادهِ وأمرَنا باتّباعِهِ.
الشرح: أن الإسلامَ هو الدينُ الذي أحبَّهُ الله لعبادِهِ وأمرَنا باتباعِهِ.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: ولا يُسمَّى الله مسلمًا كما تلفظَ به بعضُ الجهالِ.
الشرح: الله تعالى لا يجوزُ أن يُسمَّى مسلمًا فليسَ من أسمائه تعالى مُسْلم بل اسمه السلامُ أي السالمُ من كلّ نقصٍ وعيبٍ. المسلم معناه المنقادُ، الله لا يَنقادُ بل يُنقادُ له، فلا يقال له مسلم. ولا يجوز تسمية الله إلا بما جاء في القرءان أو في حديث رسول الله الثابت أو أجمعت عليه الأمة، فتسمية بعض الناس الله تعالى سببًا وعلة كفر كما قال الإمام العلامة ركن الإسلام عليّ السُّغدي من أكابر الحنفية. ولا يجوز تسميته روحًا لأن الروح مخلوقة. فتسمية الله سببًا وعلة وروحًا كفر. ومن ذلك ما استحدثه بعض جهلة المتصوفة فسمَّوا الله الخَمَّار والعياذ بالله.
قال المؤلف رحمَهُ الله: فقديمًا كان البشرُ جميعُهم على دينٍ واحدٍ هو الإسلامُ.
الشرح: أنَّ البشرَ في زمنِ ءادم كانوا كلّهم على الإسلامِ لم يكن بينهم كافرٌ. هو علَّم أولاده الدين كما علَّمهم أصول المعيشة وعمل لهم الدينار والدرهم وغير ذلك من أصول المعيشة، فصلى الله على نبينا محمد وعلى ءادم وسائر الأنبياء وسلم.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: وإنّما حدثَ الشركُ والكفرُ بالله تعالى بعد النبي إدريس.
الشرح: أنه حَدَثَ الكفرُ بعد ءادمَ بألف سنةٍ وذلك بعد وفاةِ إدريس. فأوّلُ الأنبياءِ ءادمُ ثم ابنه شيثٌ ثم إدريس.
قال المؤلف رحمَهُ الله: فكان نوحٌ أوّلَ نبيٍ أُرسِلَ إلى الكفارِ يدعو إلى عبادةِ الله الواحدِ الذي لا شريكَ له.
الشرح: أنه بعدَ وفاة إدريس عليه السلام حَصَلَ الشركُ بين الناس واستمروا على هذا زمانًا إلى أن بعثَ الله نوحًا يدعوهم إلى الإسلام. فبينَ إدريسَ ونوحٍ عليهما السلام ألفُ سنةٍ وتلك الفترةُ تُسمى الجاهليةَ الأولى، فبهذا يكون نوحٌ عليه السلام هو أولَ نبيّ أُرسِلَ إلى الكفارِ يدعوهم إلى الإسلامِ. فآدم من جملة الأنبياء الذين من أنكر نبوتهم يكفر، فكما أن من أنكر نبوة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يكفر كذلك يكفر من أنكر نبوة ءادم، كما نقل ابن حزم الإجماع على نبوة ءادم، بل هو نبي رسول كما ورد ذلك في حديث أبي ذر الذي أخرجه ابن حبان وصححه وأقره الحافظ ابن حجر، ولا معنى لإنكار الوهابية رسالة ءادم ولعل بعضهم ينكر نبوته ولا حجة لهم في حديث الشفاعة الذي فيه أن الناس يأتون ءادم ليشفع لهم ثم نوحًا فيقولون لنوح أنت أول الرسل اشفع لنا إلى ربك، رواه البخاري وغيره، لأن معناه أنت أول الرسل إلى قومه المنتشرين في الأرض لأن الأنبياء الذين بعده كان النبي يرسل إلى قومه كما حكى الله عن عيسى أنه قال ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم {6}﴾ [سورة الصف] فقد خالفت الوهابية في قولها هذا قول الله تعالى ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً {213}﴾ قال ابن عباس: أي كلهم على الإسلام، فماذا تقول الوهابية عن ءادم وأولاده أتقول إنهم كانوا يعيشون عيشة البهائم لا يعرفون ما يأتون وما يذرون! وكفاهم هذا خزيًا.
قال المؤلف رحمَهُ الله: وقد حذَّرَ الله جميعَ الرُّسُلِ مِن بعدهِ منَ الشركِ.
الشرح: تحذيرُ الرسلِ من الشركِ المقصودُ به تحذيرُ أمَمِهم لأن الأنبياءَ معصومونَ من الشركِ.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: فقام سيدُنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديدِ الدعوةِ إلى الإسلام بعد أنِ انقطعَ فيما بينَ الناسِ في الأرضِ مؤيَّدًا بالمعجزاتِ الدَّالَّةِ على نبوتِهِ.
الشرح: أنه لما نَزَلَ الوحيُ على النبي لم يكن بين البشرِ على الأرضِ مسلمٌ غيرُهُ فعربُ الجزيرة العربية كانوا يعبدون الأوثانَ، وأهلُ فارس كانوا يعبدون النارَ، وسائرُ أهل الأرضِ كانت لهم أصنامٌ أو أشياء أخرى يعبدونها، فقامَ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلامِ مؤيَّدًا بمعجزاتٍ تدُلّ على نبوتِهِ فهو مجدّدُ الدعوةِ.
قال المؤلف رحمَهُ الله: فَدَخَلَ البعضُ في الإسلامِ.
الشرح: كالجعدِ بنِ قيسٍ المُراديّ الذي أسلمَ بسببِ ما سمعَهُ من الجنيّ الذي كان في أيام كان عيسى على وجه الأرض ودعا إلى الإسلام إلى أن أدرك زمان محمد فآمن بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما وسلم.
قال المؤلف رحمَهُ الله: وجَحَدَ بنبوتِهِ أهلُ الضلالِ الذين منهم مَن كان مشركًا قبلًا كفرقةٍ من اليهودِ عَبَدَت عُزيرًا فازدادُوا كفرًا إلى كفرهم.
الشرح: قوله: “جَحَدَ” أي أنكرَ، وأما عُزَيرٌ فهو رجلٌ من الصالحين وقد قال بعض العلماء بنبوّتِهِ.
قال المؤلف رحمَهُ الله: وءامنَ به بعضُ أهلِ الكتابِ اليهودِ والنصارى كعبدِ الله بن سلامٍ عالم اليهودِ بالمدينةِ، وأصحَمةَ النّجاشيّ ملكِ الحبشةِ وكان نصرانيًّا ثم اتَّبعَ الرسولَ اتباعًا كاملًا وماتَ في حياةِ رسولِ الله وصلَّى عليه الرسولُ صلاةَ الغائبِ يومَ ماتَ. أوحى الله إليه بموتِهِ. ثم كان يُرى على قبرهِ في الليالي نورٌ وهذا دليلٌ أنه صارَ مسلمًا كاملًا وليًّا مِن أولياءِ الله رضيَ الله عنه.
الشرح: أن مِن الذين ءامنوا من أهل الكتابِ عالمَ اليهودِ بالمدينةِ عبدَ الله ابنَ سلامٍ وهو من المبشّرين بالجنة. ومنهم النجاشيُّ الذي عاشَ بعد إِسلامه سبعَ سنواتٍ، ولما ماتَ قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: “ماتَ اليومَ رجلٌ صالحٌ، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة” رواه البخاري. وأصحمة اسم النجاشيّ. قال المؤلف رحمَهُ الله: والمبدأُ الإسلاميُّ الجامعُ لجميعِ أهلِ الإسلامِ عبادةُ الله وحدَه.
الشرح: المبدَأُ أي الأساسُ الجامعُ لجميع أهل الإسلام من لَدُن ءادمَ إلى يوم القيامةِ هو الإيمانُ بالله وحدَهُ أي أن لا يُشرَك به شىء، ثم هؤلاء لا يصحُّ إيمانُهُم إلا أن يؤمنوا بنبيّ عَصرِهِم. هذا المبدأ جمع أهل الإسلام كلهم، هذا المعنى يشملهم لأنهم كلهم يعبدون الله وحده.
حُكمُ من يَدَّعي الإسلامَ لفظًا وهو مناقضٌ للإسلامِ معنًى
قال المؤلف رحمَهُ الله: حُكمُ من يَدَّعي الإسلامَ لفظًا وهو مناقضٌ للإسلامِ معنًى.
الشرح: أي أن هذا بيان حكمِ من يزعمُ الإسلامَ بلسانِهِ وهو مخالفٌ للإسلامِ في الحقيقةِ باعتقادِ أو قول أو فعل ما ينافيه.
قال المؤلف رحمَهُ الله: هناكَ طوائف عديدة كَذَّبت الإسلامَ معنًى ولو انتموا للإسلام بقولهم الشهادتين أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمدًا رسولُ الله وصلوا وصاموا لأنّهم ناقضوا الشهادتين باعتقادِ ما ينافيهما فإنّهم خرجوا من التوحيدِ بعبادتهم لغيرِ الله فهم كفَّارٌ ليسوا مسلمينَ كالذين يعتقدونَ ألوهيّةَ علي بن أبي طالبٍ أو الخَضِرِ أو الحاكمِ بأمرِ الله وغيرِهم أو بما في حكمِ ذلكَ منَ القولِ والفعلِ.
الشرح: يعني أن هناكَ أناسًا يدَّعون الإسلامَ وهم فِرقٌ متعدّدةٌ ثم يناقضون الإسلامَ فهؤلاء ليسوا بمسلمين مؤمنين، مثال ذلك أن أحدهم يقولُ لفظًا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يعبُدُ شيئًا من خَلقِ الله كأناسٍ يعبدون عليًّا وهو الخليفةُ الراشدُ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأناسٍ يعبدونَ الخضر وهو نبيٌّ على القولِ الراجحِ، وأناسٍ يعتقدونَ الألوهيّةَ للحاكمِ بأمرِ الله الذي كانَ في القاهرةِ يعبُدُ الشياطينَ يختلي ويعبد في خلَواته الرُّوحانيين أي الجن.
قال المؤلف رحمَهُ الله: وحُكمُ من يجحدُ الشهادتين التكفيرُ قطعًا ومأواه جهنّمُ خالدًا فيها أبدًا لا ينقطعُ في الآخرة عنه العذابُ إلى ما لا نهايةَ له وما هو بخارجٍ من النارِ.
الشرح: أن مَن يُنكِرُ معنى الشهادتين فهو كافرٌ قطعًا بلا شك، والكافرُ إذا دَخَلَ جهنّمَ في الآخرة فلا يخرجُ منها أبدًا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا {64} خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا {65}﴾ [سورة الأحزاب]. وفي هذه المسألة خَالَفَ جَهمٌ وابنُ تيمية، وكان ابن تيمية قبلَ أن يقولَ هذا كفَّرَ جهمًا لقوله بفناءِ الجنةِ والنارِ ثم شارَكَهُ ابنُ تيمية في نصفِ عقيدتِهِ فقال بفناء النار فهو أخو جهم.
قال المؤلف رحمَهُ الله: ومن أدَّى أعظمَ حقوقِ الله بتوحيدِهِ تعالى أي ترك الإشراكِ به شيئًا وتصديق رسولِهِ صلى الله عليه وسلم لا يخلدُ في نارِ جهنّم خلودًا أبديًّا وإن دخلَها بمعاصيه ومآله في النهايةِ على أيّ حالٍ كان الخروج من النّار ودخول الجنّةِ بعد أن يكون قد نالَ العقابَ الذي يستحقُّ إن لم يَعفُ الله عنه.
الشرح: أنَّ الذي أدّى أعظمَ حقوقِ الله وهو الإيمانُ بالله ورسولِهِ واجتنبَ الكفرَ هذا إن ماتَ لا يخلَّدُ في النارِ إن دَخَلَهَا مهما كانت ذنوبُه ولا بدَّ أن يدخلَ الجنّةَ بعد أن يعاقَبَ بذنوبه التي كان اقترفها، هذا إن لم يغفِر الله له ذنوبه، فحُكمُ المسلم العاصي الذي ماتَ قبل التوبةِ أنه تحت المشيئةِ إما أن يعذّبه الله ثم يدخله الجنةَ وإما أن يعفو عنه.
قال المؤلف رحمَهُ الله: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “يخرجُ من النّارِ من قالَ لا إله إلا الله وفي قلبهِ وزن ذَرّةٍ من إيمانٍ” رواه البخاريُّ.
الشرح: أي أن من ماتَ وفي قلبهِ وزن ذرّةٍ من إيمانٍ أي أقل الإيمان لا بدَّ أن يخرجَ من النارِ وإن دَخَلَها بمعاصيه. والذَّرُّ هو الذي مثل الغبارِ يُرَى لما يدخل نورُ الشمس من الكَوّةِ، ويُطلَقُ على النملِ الأحمرِ الصغيرِ، وإذا أردت المفرَدَ قلتَ ذرّةٌ ويقال للجمعِ ذرٌّ.
قال المؤلف رحمَهُ الله: وأمّا الذي قامَ بتوحيدهِ تعالى واجتنبَ معاصيه وقامَ بأوامره فيدخل الجنّة بلا عذابٍ حيث النعيمُ المقيمُ الخالدُ.
الشرح: أن الذي ءامنَ بالله عزَّ وجل ونزَّهَهُ عن مشابهةِ خلقِهِ وأدى الفرائضَ واجتنبَ المحرماتِ فهو التقي الذي مآلهُ يومَ القيامة أن يدخل الجنةَ لا يَلقَى جوعًا ولا عطشًا ولا نكدًا في القبر ولا في الآخرة بل يدخل الجنةَ حيث النعيمُ المقيمُ، فيكون مأواهُ الذي لا يخرجُ منه.
قال المؤلفُ رحمَهُ الله: بِدلالة الحديث القدسي الذي رواهُ أبو هريرة قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عزَّ وجلَّ: “أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سَمِعَت ولا خَطَرَ على قلبِ بشر”. وقال أبو هريرة: “إقرؤا إن شئتم قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {17}﴾ [سورة السجدة] رواهُ البخاري في الصحيحِ.
الشرح: قوله تعالى ﴿قُرَّةِ أَعْيُنٍ {17}﴾ أي شىء تقَرُّ به أعينهم أي تفرح به مما لم يُطلِع الله عليه ملائكته ولا أنبياءه، فالنعيمُ الخاصُّ المعدُّ للصالحين لم يرهُ الرسولُ ولا الملائكةُ ولا خُزَّانُ الجنةِ الموظفونَ هناك، وقد فُسّرت الآيةُ بهذا الذي جاءَ في هذا الحديثِ القدسي.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة