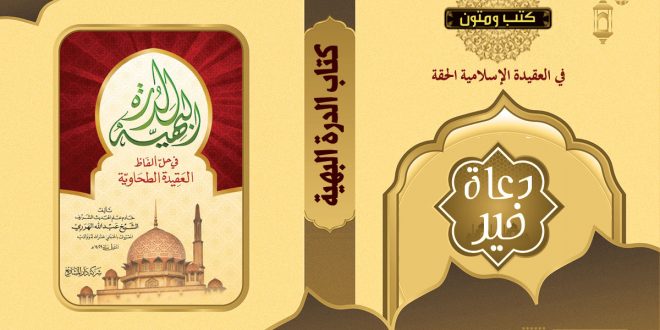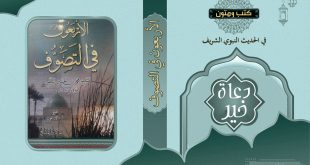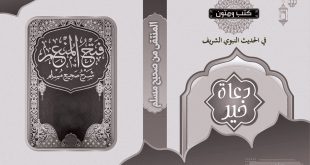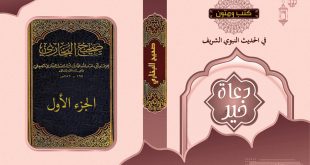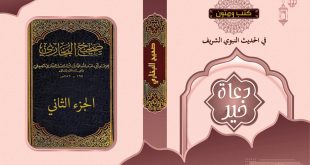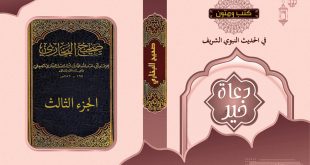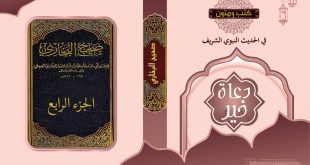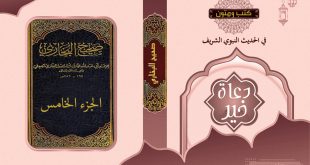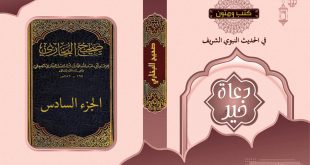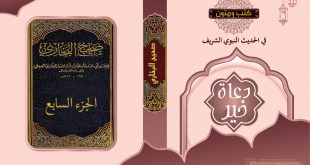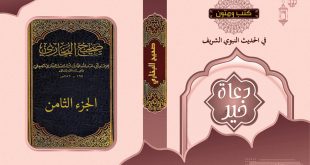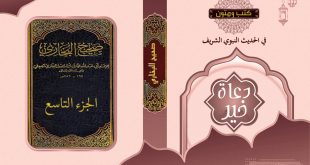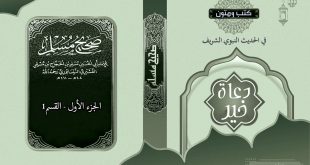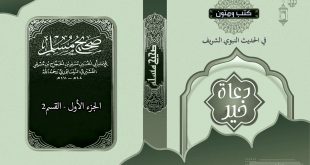بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحَمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ والصلاةُ والسَّلامُ على مُحَمَّدٍ الأمينِ، وعلى ءالِه وأصحابهِ الطاهرينَ.
هذا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهلِ السُّنَّةِ وهُمُ ٱلَّذِينَ وَافَقُوا سُنَّةَ ٱلنَّبِيِّ أَيْ شَرِيْعَةَ النَّبِيِّ أَيِ الْقُرْءَانَ وَالْحَدِيْثَ، وَٱلشَّرِيعَةُ هِيَ ٱلْعَقِيدَةُ وٱلأَحْكَامُ. وَالجَمَاعَةِ وهُمُ ٱلَّذِينَ وَافَقُوا جَمَاعَةَ ٱلْمُسْلِمِينَ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ المِلَّةِ أيْ على ما ذَهَبَ إليْهِ فُقَهَاءُ ٱلأُمَّةِ، وَٱلْمِلَّةُ: هِيَ مِلَّةُ ٱلإِسْلامِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمانِ بنِ ثَابِتٍ الكُوفِيِّ وَهُوَ صَاحِبُ الْمَذْهَب وُلِدَ سَنَةَ ثَمانينَ مِنَ ٱلْهِجرَةِ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بنِ إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيِّ وُلِدَ سَنَةَ مِائَةٍ وَثَلاثَةَ عَشَرَ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ مِائَةٍ وَٱثنَيْنِ وَثَمَانِينَ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ. أَخَذَ ٱلعِلْمَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ صَارَ مُجتَهِدًا، كَانَ قَاضِيًا أَيَّامَ هَارُونَ ٱلرَّشِيدِ، وَأَبِي عَبدِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الشَّيبَانِيِّ وُلِدَ بِوَاسِط سَنَةَ مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَثَلاثِينَ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ وَتُوفِّيَ سَنَةَ مِائَةٍ وَتِسْعٍ وَثَمَانِينَ. هو إمام مجتهد كَانَ تِلمِيذَ أَبِي حَنيفَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنهُ ثُمَّ طَلَعَ فِي ٱلعِلْمِ بَحْرًا، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيهِم أَجمعينَ وَما يَعتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وهو علمُ التوحيدِ الذي هو أَساسُ قواعدِ عقائدِ الإسلامِ وهو أشرفُ العلُومِ، وَيدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ العَالَمِينَ أي ما يَتَّخِذُونَهُ دِينًا ويَطلبُونَ بهِ الجزاءَ من اللهِ مالكِ العالَمِينَ.
القول في التوحيد
الحَمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ والصلاةُ والسَّلامُ على مُحَمَّدٍ الأمينِ، وعلى ءالِه وأصحابهِ الطاهرينَ.
نَقُولُ في تَوحِيدِ اللهِ وهو إفرادُ اللهِ تعالَى بالعبادةِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وهو خلقُ قدرةِ الطاعةِ في العبدِ. فاللهُ تباركَ وتعالى هو الذي تَفَضَّلَ علينَا وتَكَرَّمَ بأنْ جَعَلَنَا على هذهِ الحالِ ولولاَ خَلَقَ اللهُ فِينَا ذَلكَ أي النطقَ والاعتقادَ والإذعانَ ما حَصَلَ، وهذا فيهِ تسليمٌ للهِ تباركَ وتعالى بأنَّهُ لا يَحصلُ لعبدٍ شىءٌ من الخيرِ إلا بعونِ اللهِ، إلا بتوفيقِ اللهِ. إِنَّ اللهَ وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ فالْوَاحِد في حَقِّ اللهِ تعالى فُسِّرَ بِأَنَّهُ الَّذِي لا شَرِيكَ لَهُ في ذاتِهِ ولا في صِفَاتِهِ وَلا في أفْعَالِهِ، ولا شَىءَ مِثلُهُ أي لا يُوجَدُ شَىءٌ يُمَاثِلُهُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ أَوْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَلا شَىءَ يُعْجِزُهُ هذا وصف بكمال القدرة لأن وجود كلِّ موجودٍ سواهُ بإيجاده، فمحالٌ أن يُعجزَه شىء، فإنَّ العجز نقصٌ والنقصُ على الله مستحيل، وَلا إِلهَ غَيرُهُ هذا نفيٌ للألوهيةِ عن كلِّ معبودٍ سوى اللهِ إذ الإلهُ في اللغةِ هو المعبودُ بحقٍ.
القول في صفات الله تعالى وتنـزيهه
قَدِيمٌ بِلا ابتِدَاءٍ لأنه لو كان حادثًا لافتقر إلى محدث هذا معنى القديمِ إذا أُطلِقَ على اللهِ ويُرادِفُهُ الأَزليُّ، دَائِمٌ بِلا انتِهَاءٍ هَذِهِ عِبارةٌ عن بقائهِ تعالى لِيُعْلَمَ أَنَّ دَوَامَهُ تَعَالَى لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِٱلزَّمَانِ، لا يَفْنَى وَلا يَبِيدُ أي لا يهلك، قَالَ بَعْضُهُم: “جَمَعُوا بَيْنَ ٱللَّفْظَيْنِ تَأْكِيْدًا لِدَوَامِ بَقَائِهِ تَعَالَى”، وَلا يَكونُ إلا ما يُريدُ أي لا يَدخلُ في الوجودِ منَ الأعيانِ مهْمَا صَغُرَتْ إلا بإرادتِهِ ومَشِيئتِهِ، لا تَبلُغُهُ الأوهَامُ أي تَصَوُّرَاتُ ٱلْعِبَادِ، فَالإنسانُ وَهْمُهُ يَدُورُ حولَ مَا أَلِفَهُ مِنَ الشَّىءِ المحسُوسِ الَّذِي لَهُ حَدٌّ وشَكْلٌ ولَوْنٌ واللهُ تعالى ليسَ كذلكَ، وَلا تُدرِكُهُ الأَفهَامُ أي لا تُحِيطُ بهِ العُقُول، فَحَقِيْقَةُ ٱلْلَّهِ لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مَهْمَا شَغَلَ فِكْرَهُ، وَلا يُشبِهُ الأَنَامَ أي الخلْق. حيٌّ لا يَمُوتُ فالحيُّ في حقِّ اللهِ تعالى يُفَسَّرُ بأنَّه المتَّصِفُ بِالحيَاةِ الَّتِي هيَ أزلِيَّةٌ أبديةٌ قَيُّومٌ لا يَنَامُ معناهُ الدائمُ الّذي لا يَزولُ، خَالِقٌ بِلا حَاجةٍ أي أَحْدَثَ العالم من غيرِ أنْ يَكُونَ لَهُ احتياجٌ إليهِ لجَلْبِ منفعةٍ لنفسِهِ أَوْ دَفْعِ مَضرَّةٍ عنْ نفسِهِ، رَازِقٌ بِلا مُؤنَةٍ فهو تَعَالى يُوصِلُ إلى العِبادِ أرْزَاقَهُم منْ غيرِ أنْ تَلْحَقَهُ كُلْفةٌ ومشقَّةٌ مُمِيتٌ للأحياءِ مِنْ عبادِهِ بِلا مَخَافَةٍ أي لا لِخَوْفٍ منْ أنْ يلْحَقَهُ ضَرَرٌ، بَاعِثٌ للأمواتِ بلا مَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ. مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا أي كان موصوفًا بهذه الصفات قَبلَ خلقِهِ أي مخلوقاته، لَمْ يَزْدَدْ بِكَونِهِمْ أي بكون المخلوقات شَيئًا لَم يَكنْ قَبلَهُمْ أي قبل المخلوقات مِنْ صِفَتِهِ معناه ما زاد في صفات الله بعد خلق الخلائق شىء لم يكن في صفاته قبل خلقهم بل صفاته أزلية. وَكَما كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لا يَزَالُ عَلَيْها أَبَدِيًّا. لَيسَ بَعدَ خَلقِ الخَلقِ استَفَادَ اسمَ الخَالِقِ وَلا بإِحدَاثِهِ البرِيَّةَ استَفَادَ اسمَ البَارِئِ فهُوَ تباركَ وتعالى خَالِقٌ قبلَ حُدُوثِ الخلْقِ وبارِئٌ قبلَ حُدوثِ البريةِ لَهُ مَعنَى الرُّبُوبِيَّةِ وَلا مَربُوبَ وَمَعنَى الخَالِقِ وَلا مَخلُوقَ أي أنَّ اللهَ تعالى كانَ مُتَّصِفًا بالخالقيّةِ والرُّبُوبِيَّةِ قبلَ وجودِ المخلوقينَ والمرْبُوبِينَ، هذا تأكيد لِما ذُكر أولاً، فإنه تعالى “خالق” و”رب” قبل وجود المخلوق والمربوب. وَكَمَا أَنَّهُ مُحيِي المَوتَى بَعدَمَا أَحيَا استَحَقَّ هذا الاسمَ قَبلَ إحيائِهِم المعنى أنَّ اللهَ تباركَ وتعالى كانَ متَّصِفًا بالإحياءِ قبلَ حدوثِ الخلقِ ثم أَجرَى عليهِمُ الحياةَ التي هي حادثةٌ، كَذَلِكَ استَحَقَّ اسمَ الخَالِقِ قَبلَ إِنشَائِهِم أيْ أنه مستحقٌّ للاتِّصافِ بمعنى الخالقِ قبلَ إنشاءِ الخلقِ، ذَلِكَ إشارةٌ إلى جميعِ ما تقَدَّمَ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ صفاتِه مثل الإحياءِ والإماتةِ وغيرِها بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ أيْ في كلِّ ما يقبلُ الدخولَ في الوجودِ، وَكُلُّ شَىءٍ سواه إلَيهِ فَقِيرٌ أي مفتقر إليه في وجوده وبقائه وَكُلُّ أَمرٍ عَلَيهِ يَسِيرٌ لا يلحقُه في إيجادِه مشقة، لا يَحتَاجُ إلى شَىءٍ لأن الحاجة نقص والنقص على الله محال لَيسَ كَمِثلِهِ شَىءٌ هذا تنـزيه، نفي ما لا يليق بالله عن الله. أما وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ إثباتُ ما يليقُ باللهِ، السمعُ صفةٌ لائقةٌ والبصرُ كذلكَ. بعدَ أَن ذكر أنه لا يُشبهُ شيئًا ذكرَ أنهُ سَميعٌ وأنه بصير حتى لا يُتوهمَ أن سَمعَهُ كسمعِ غيرِه وبصرَه كبصرِ غيرِه. فمن اعتقدَ أنَّ اللهَ جسمٌ كثيفٌ أو لطيفٌ لم يعرِف الله فهو جاهلٌ بخالقِه. خَلَقَ الخَلقَ بِعِلْمِهِ المعنى أنَّ اللهَ تباركَ وتعالى خلَقَ الخلْقَ على حسَبِ عِلْمِه الأزليِّ وتقديرِه الأزليِّ وَقَدَّرَ لَهُم أَقدَارًا أي وقَدَّرَ سبحانَه مقاديرَ الخلقِ منَ الخيرِ والشَّرِّ والطَّاعةِ والمعصيةِ والرِّزقِ والسَّعادةِ والشَّقاوةِ ونحوِ ذلكَ وضَرَبَ لَهُم ءاجالا أي قدَّرَ ءاجالَ الخلائقِ، فإن الأجل المضروب لكل واحد منهم مبرم لا يحتمل التقدم والتأخر ولَم يَخفَ عَلَيهِ شَىءٌ مما حَدثَ ومما يحدُثُ إلى ما لا نهايةَ لهُ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُم، وَعَلِمَ مَا هُم عَامِلُونَ قَبلَ أَنْ يَخلُقَهُم فالمخلوقاتُ التي خلقَها فدخلَتْ في الوجودِ والتي ستُخلَقُ ولم تدخلْ في الوجودِ بعدُ كلٌّ بعِلمِه الأزليِّ الذي هو عِلْمٌ واحدٌ شاملٌ يتعلقُ بسائرِ المُمْكِناتِ العقليةِ وبالواجبِ العقليِّ وبالمستحيلِ العقليِّ. وَأَمَرَهُم أيِ اللهُ تعالى أمرَ العبادَ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُم عَن مَعصِيَتِهِ تحقيقًا لمعنى الابتلاءِ لأن أوامر الله تعالى ونواهيَه لابتلاء العباد واختبارهم ليظهر لنا المطيع من العاصي على حسب ما سبق به علمه، وَكُلُّ شَىءٍ يَجرِي بِتَقدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وهي تخصيصُ الْمُمْكِنِ العقليِّ ببعضِ ما يجوزُ عليهِ دونَ بعضٍ، وَمَشِيئَتُهُ تَنفُذُ لأن في نفاذ مشيئةِ غير اللهِ وعدمِ نفاذ مشيئتِه أمارة عجزه حيثُ جرى في ملكه ما لم يشأ وهو على الله محال لا مشيئةَ للعبادِ إلا ما شَاء لَهُم أي إلا أنْ يشاءَ دخولَها في الوجودِ، لأنَّ مشيئةَ العبادِ منْ جملةِ الحادثاتِ، فَمَا شَاء لَهُم كَانَ وَمَا لَم يَشَأ لَمْ يَكُن، يَهدي مَن يَشَاءُ أي أنَّ اللهَ يخلقُ الاهتداءَ فيمَنْ يشاءُ مِنْ عبادِه وَيَعصِمُ أَيْ يَحْفَظُهُ وَيَمْنَعُهُ عَنْ مَعَاصِيْهِ ويُعَافي أَيْ يُعَافِيْهِ فِي نَفْسِهِ وَدِيْنِهِ فَضلاً مِنْهُ تَعَالَى لاَ لاِسْتِحْقَاقِ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، وَيُضِلُّ مَن يشاءُ وَيَخذُلُ أَيْ يَتْرُكُ عَوْنَهُ وَنُصْرَتَهُ وَيَبتَلي عَبْدَهُ فِي نَفْسِهِ وَدِيْنِهِ عدلاً مِنْهُ لاَ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَكُلُّهُمْ يَتقلَّبونَ في مَشِيئتِهِ يعني أنَّ العبادَ يَتصرفونَ بمشيئةِ اللهِ تباركَ وتعالى بَينَ فَضلِهِ وَعَدلِهِ فإنْ تَصرَّفُوا بالخيرِ فبفضلِ اللهِ تعالى، وإنْ تَصرَّفُوا في المعاصي والشرورِ فبعدلِ اللهِ تباركَ وتعالى. وَهُوَ أي اللهُ تباركَ وتعالى مُتَعَالٍ مُنَزَّهٌ عنِ الأَضدادِ أي عمَّن يتصرفُ تصرفًا يريدُ أنْ يغلبَ اللهَ به على زعمِهِ لأنَّ كلَّ شىءٍ في قَبضتِه، وكلَّ شىءٍ مِلكُه وَالأندادِ أي الأمثالِ، لأنَّ كلَّ شىءٍ في قَبضتِه، وكلَّ شىءٍ مِلكُه، لا رَادَّ لِقَضَائِهِ أيْ لا أحدَ يردُّ قضاءَ اللهِ تباركَ وتعالى، وَلا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ أيْ لا أحدَ يجعلُ حكمَه باطلاً، وَلا غَالِبَ لأمرِهِ أي لا يَغلِبُ أمرَ اللهِ غالبٌ، ءامَنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ أي صدَّقنا تَصْدِيقًا جَازِمًا وَأَيقَنَّا إِيْمَانًا لا تَرَدُّدَ فِيهِ أَنَّ كُلاً مِنْ عِندِهِ أي أنَّ كلَّ شىءٍ دخلَ في الوجودِ فإنما حصلَ بعلمِ اللهِ الأزليِّ وتقديرِه وقضائِه.
القول في النبوة
وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَبدُهُ المُصطَفى وَنَبِيُّهُ المُجتَبَى وَرَسُولُهُ المُرتَضَى، لَما فَرَغَ من إثبات وحدانيةِ اللهِ وصفاتِه شرعَ في إثبات نبوة سيد المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. وقوله “وإن محمدًا” معطوف على قوله “إن الله واحد” والتقدير: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد إلى ءاخره وإن محمدًا عبده المصطفى. والمصطفى والمجتبى معناهما واحدٌ وهو المختار وفيهما زيادةُ مدحٍ على المرتضى. فيجبُ الإيمانُ بأنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عبدُ اللهِ ورسولُه وَإنَّهُ خَاتَمُ الأنبِيَاءِ أي ءاخِرُ الأنبياءِ وإمامُ الأتقياءِ أَيْ إِنَّهُ يَكُونُ مُقَدَّمَهُمْ يَوْمَ القِيَــامَةِ وسيِّدُ المُرسَلينَ أَيْ أَفضَلُهُم وَحَبيبُ رَبِّ العَالَمِينَ أَيْ مَحبُوبُهُ. وَكُلُّ دَعوَى نُبُوَّةٍ بَعدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوًى أيْ أنَّ مَنِ ادَّعَى النبوةَ بعدَه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فدَعوَاهُ باطلةٌ وَهُوَ المَبعُوثُ إلى عَامَّةِ الجِنِّ وَكَافَّةِ الوَرَى بِالحَقِّ وَالهُدَى وَبِالنُّورِ والضِّياءِ يعني أنَّ سيِّدَنا مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مرسَلٌ إلى الإنسِ والجنِّ.
القول في كلام الله تعالى
وإنَّ القُرءانَ كلامُ اللهِ فقوله: “وإن القرءان كلام الله”هو عطف على قوله: “إن الله واحد”والتقدير: نقول معتقدين إن الله واحد وإن محمدًا عبده المصطفى وإن القرءان كلام الله، مِنهُ بَدَا أيْ ظهرَ أيْ إنزالاً على نبيِّهِ، وليسَ المرادُ منْ كلمةِ “بَدَا” أنهُ خرجَ منهُ تَلَفُّظًا كمَا يخرجُ كلامُ أحدِنا منْ لسانِهِ تلفُّظًا كما تقولُ المشبهةُ، بلا كَيفِيَّةٍ قَولاً أيْ ليسَ بحرفٍ ولا صوتٍ لأنَّ الحرفَ والصوتَ كيفيةٌ منَ الكيفياتِ وَأَنزَلَهُ عَلى رَسُولِهِ محمد صلى الله عليه وسلم وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ الصحابة المُؤمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا أي كونه كلام الله تعالى، وَأَيقَنُوا أي علموا باليقين أَنَّهُ كَلامُ الله تَعالى بالحَقِيقَةِ لَيسَ بِمَخلُوقٍ كَكَلامِ البَرِيَّةِ لأن القرءان يطلق على الكلام الذاتيّ الذي ليس هو بحرفٍ ولا صوتٍ ولا لغةٍ عربية ولا غيرها كما يطلق على اللفظ المنـزَّل الذي يقرؤه المؤمنون، فمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أنَّه كلامُ البَشَرِ أي أنَّه مِنْ تأليفِ بشرٍ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللهُ وعَابَهُ وأَوعَدَهُ بسَقَرَ أي بعذاب النار حيثُ قالَ تعالى: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾(26) [سورة المدثر]. فلمَّا أَوعَدَ اللهُ بسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: ﴿إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ البَشَرِ﴾ (25) [سورة المدثر] عَلِمنَا وَأَيقَنَّا أَنَّهُ قَولُ خَالِقِ البَشَرِ ولا يُشبِهُ قَولَ البَشَرِ، وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بِمعنًى مِن مَعاني البَشَرِ فَقَد كَفَرَ أيْ أنَّ مَنْ وصفَ اللهَ بوصفٍ مِنْ أوصافِ البشرِ المحدَثةِ قولاً أوِ اعتقادًا فهوَ كافرٌ لأنَّه كذَّبَ قولَه تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾. فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا أَي من تأمل في هذه المعاني اعتَبَرَ بِالكُفَّارِ الْمُستَحِقِّينَ لِسَقَر وَعَنْ مِثْلِ قَولِ الكُفَّارِ انزَجرَ لِئَلا يَلزَمَهُ مَا لَزِمَهُم مِنَ العَذَابِ. وَعَلِمَ أنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيسَ كَالبَشَرِ فإن صفاته قديمة أزلية أبدية قائمة بذاته وصفات البشر حادثة.
القول في الرؤية
والرؤْيةُ حَقٌّ ثابتة يجبُ الإيمانُ بِها لأهْلِ الجَنَّةِ أي للمؤمنينَ في الآخِرةِ بِغَيرِ إحاطَةٍ أي يَرَونَهُ مِن دُونِ أَنْ يَحُدُّوهُ، مِنْ دُونِ أَنْ يُحِيطُوا بِهِ لأنَّ الإحاطةَ بهِ مستحيلةٌ، وَلا كَيفيَّةٍ أي مِنْ دُونِ أَنْ يُدرِكُوا لَهُ شَكلاً وَلا هَيئَةً لأَنَّهُ مَوجُودٌ لا يَشبِهُ شَيئًا مِنَ الْمَوْجُودَاتِ كَمَا نَطَقَ أي جاء بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ معناه تَرى ربَّها ذلكَ اليوم، وهذهِ الوجوهُ عبارةٌ عنِ المؤمنينَ وَتَفسِيرُهُ عَلى مَا أرَادَهُ اللهُ تَعَالى معنًى بكلامِه وَعَلِمَهُ أيْ على حسَبِ ما عَلِمَ اللهُ. وَكُلُّ مَا جَاءَ في ذلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الثابتِ الصَّحيحِ عَنِ الرَّسُولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَهُوَ كما قالَ وَمَعنَاهُ على ما أرادَ عليه الصلاة والسلام لا نَدخُلُ في ذلكَ مُتَأوِّلينَ بِآرائِنَا أي بلا دليلٍ عقليٍّ قطعيٍّ ولا دليلٍ سمعيٍّ ثابتٍ وَلا مُتَوَهِّمِين بِأهوائِنَا يعني أنه لاَ يدخلُ في ذلك متصوِّرًا بوهمِهِ فإنهُ مَا سَلِمَ في دِيْنِهِ إلا مَنْ سَلَّمَ للهِ عَزَّ وجَلَّ ولرسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فالسَّلامةُ في التَّسليمِ للهِ ولرسولِه أيِ اعتقادِ أنَّ ما جاءَ في الشرعِ منْ أمورِ الدِّينِ فهو على حسَبِ ما أرادَ اللهُ تعالى ورسولُه أي ليس مبنيًا على التوهم والتصور وَرَدَّ عِلمَ ما اشتَبَهَ عليهِ فَهمُه منَ الأمورِ المتعلقةِ بالآخرةِ وغيرِها إلى عَالِمِهِ أي يَرجعُ بهِ إلى أهلِ العلمِ الراسخينَ. وَلا تَثبُتُ قَدَمٌ في الإِسْلامِ إلا على ظَهرِ التَّسْليمِ والاستِسْلامِ لأن الإسلام هو الانقياد ولا يتحقق إلا بالتسليم وهو الرِّضى بما جاءَ عنِ اللهِ تعالى والاستسلامِ وهو الانقيادُ للشرعِ أيْ قَبولُ ما جاءَ فيهِ منَ العقائدِ والأحكامِ وترك الاعتراض على أحكامه وحكمه. فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ معناهُ أنَّ منْ طلبَ أنْ يَعلمَ ما مُنعَ عنهُ علمُهُ وَلَمْ يَقنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ أيْ مطلوبُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِي المَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الإِيمانِ إذْ خلوصُ العبد مشروطٌ بتسليمِ ذلكَ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَالإِقْرارِ وَالإِنْكارِ موسوِسًا تائهًا شاكًّا زائغًا مائلاً عنِ الحقِّ إلى الباطلِ لا مؤمنًا مصدِّقًا ولا جاحدًا مكذِّبًا فيكونُ مضطربًا مؤمنًا ببعضٍ وكافرًا ببعضٍ، لا كالكافرِ المعلنِ كفرَه ولا كالمؤمنِ الذي صَدَقَ في الإيمانِ وءامنَ عنْ حقيقةٍ. ولا يصِحُّ الإِيمانُ بالرؤيةِ لأهلِ دارِ السَّلامِ لمنِ اعتبرَها منْهُم بوَهْمٍ أو تَأَوَّلهَا بفهم معناه مَنِ اعتبرَ الرؤيةَ على غيرِ الوجهِ المشروحِ المتقدِّمِ ذكرُهُ الذي هو معتقدُ أهلِ السنةِ والجماعةِ فهو غيرُ مصدِّقٍ بهِ كمَا أُمِرَ. وقولُه: “دارِ السلامِ” اسمٌ للجَنَّةِ، وجميعُ طبقاتِها يَشملُه هذا الاسمُ. إذْ كانَ تأويلُ الرؤيةِ وتأويلُ كلِّ معنًى يضافُ إلى الرُّبوبيَّةِ بتركِ التَّأويلِ الذي هو بعيدٌ عنِ الحقِّ والإصابةِ، ولا يعني التأويلَ الذي يفعلُه أهلُ السُّنةِ إنْ كانَ إجماليًّا أو كان تفصيليًّا، ويُقوِّي كونَ مُرادِ الطَّحاويِّ بنفيِ التأويلِ ليسَ مُطلقَ التَّأويلِ قولُه في مسألةِ الكلامِ: “منهُ بَدَا بِلا كيفيَّةٍ قَوْلاً” لأنَّ هذا تأويلٌ. ولزومِ التَّسليمِ وعليهِ دِينُ المسلمينَ. وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشبِيهَ أي أن من لم يجتنب نفي الرؤية التي أثبتها الشرع ولم يجتنب التشبيه الذي هو خلاف العقل والنقل زَلَّ عن الحق ووقع في الباطل وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ أي فَقَدَ وحُرِمَ التنْزِيهَ أي تنْزيهَ اللهِ عنِ مشابهةِ خَلْقِهِ. فَإنّ رَبَّنا جَلَّ وَعَلا مَوصُوفٌ بِصِفاتِ الوَحْدَانِيَّة التي تَنفِي عنِ اللهِ تعالى المشابهةَ لغيرِه مَنعُوتٌ بِنُعُوتِ الفَرْدَانِيَّةِ والوَحدانيةُ والفَردانيةُ مترادِفانِ، وَإِنَّمَا عبَّرَ بالعِبارةِ الثانيةِ لتأكيدِ العبارةِ الأُولى. لَيسَ في مَعنَاهُ أَحَدٌ مِنَ البَرِيّةِ أيْ ليسَ في صفاتِه تعالى أحدٌ منَ الخلقِ، وَتَعَالَى عَنِ الحُدُودِ أيْ أنَّ اللهَ تعالى ليسَ لهُ حدٌّ والحدُّ معناه نهايةُ الشىءِ، فلا يجوزُ عليهِ الحدودُ والمِساحةُ والمِقدارُ، فنفيُ الحدِّ عنهُ عبارةٌ عنْ نَفيِ الحجمِ، والغاياتِ النِّهايات وهذا مِنْ صِفاتِ الأجسامِ، والأركانِ الجوانب، والأَعضاءِ جمعُ عُضْوٍ وذلك مِنْ خَصائصِ الأجسامِ، والأدواتِ أيِ الأجزاءِ الصغيرة كالْلَّهَاةِ. لا تَحوِيهِ الجِهاتُ السِّتُّ أيْ لا تُحيطُ بهِ الجهاتُ السِّتُّ وهيَ فوقُ وتحتُ ويمينٌ وشِمالٌ وأمامٌ وخَلْفٌ كسائر المبتدعات أي المخلوقات، لأنَّ هذهِ لا تصِحُّ إلا لِمَنْ هو جِرْمٌ. فاللهُ سبحانَه وتعالى ليسَ داخلَ العَالَمِ وليسَ خارجَهُ وليسَ مُتَّصِلاً بهِ أو منفصِلاً عنه، لأنَّه لوْ كانَ كذلكَ لَكانَ لهُ أمثالٌ لا تُحْصَى، وهو سبحانَه نفَى عنْ نفسِه المماثلةَ لشىءٍ بقولِه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ﴾(11).
القول في الإسراء والمعراج
والمِعْرَاجُ الذي هو الصعودُ إلى السَّمواتِ السَّبْعِ وما شاءَ اللهُ مِنَ العُلَى حَقٌّ يجبُ الإيمانُ بهِ في حقِّ رسولِ اللهِ. وقدْ أُسْرِيَ بالنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أي ذُهِبَ بهِ ليلاً منَ المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأَقصَى وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ في اليَقَظَةِ عَقِيبَ الإسراءِ إلى السَّمَاءِ ثُمَّ إلى حَيْثُ شَاءَ اللهُ مِنَ العُلى تشريفًا له، وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه وأَكْرَمَهُ اللهُ بِما شَاءَ وَأَوحى إلَيهِ مَا أَوْحى ﴿مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (11)، وقد استدَلَ الجمهورُ منْ أهلِ الحقِّ بهذه الآية على أنَّ النَّبيَّ رَأَى ربَّه بقلبِه تلكَ الليلةَ لا بعينِه، كما ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: “رَءَاهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ” رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في الآخِرَةِ والأُوْلى.
القول في الحوض والشفاعة
والحَوضُ الذي أَكرَمَهُ اللهُ تَعَالى بهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ غِيَاثًا لأُمَّتِهِ إنقاذًا لِمَنْ كانَ عطِشًا منْ أُمَّتِهِ في القيامةِ، لأَنَّ النَّاسَ عندما يَشْتَدُّ عَطَشُهُم عندما تَدنُو الشَّمْسُ مِنْهُم وَيَعْظُمُ كَربُهُم فَيَمُرُّوْنَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ غِيَاثًا عِندَ مَسَاسِ الْحَاجَةِ فِي كُرُبَاتِ الْمَوْقِفِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وقوله حَقٌّ أي يجبُ الإيمانُ بالحَوضِ الذي يَشربُ منهُ المؤمنونَ يومَ القيامةِ. والشَّفَاعَةُ التي هي سؤالُ الخيرِ منَ اللهِ تباركَ وتعالى ادَّخَرَها النَّبِيُّ لَهُمْ أي لأُمَّتِه فهيحَقٌّ يجبُ الإيمانُ بها كَمَا رُويَ في الأخبارِ الثابتة عنه، فإن الرسولَ يَطْلُبُ يومَ القيامةِ منْ ربِّه إنقاذَ خَلْقٍ كثيرٍ منْ أُمَّتِهِ منَ النارِ بعدَ أنْ دَخَلُوها لبعضِهِم وبِعَدَمِ دُخولِها لبعضٍ ءاخَرينَ .
القول في الميثاق
والمِيثَاقُ الذي أَخَذَهُ اللهُ تعالى مِنْ ءادَمَ والذي شَمَلَ الأنبياءَ وذُريَّتِه أي ذريةِ ءادمَ فهوَ اعترافُهم بعدَ أنِ استخرَجَ الأرواحَ مِنْ ظهرِ ءادمَ بعدما نَزلَ إلى الأرضِ فصوَّرَهُم وخلقَ فيهمُ المعرفةَ والإدراكَ بأنَّه لا إلهَ لهمْ إلاَّ اللهُ، فجميعُ ذُريَّةِ ءادمَ اعترفُوا ذلك اليوم، فهذا الميثاق حَقٌّ يجب الإيمان به.
القول في القدر
وَقَد عَلِمَ اللهُ تَعالى فِيما لَم يَزَلْ أي بعلمه الأزلي عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ وَعَدَدَ مَنْ يَدخُلُ النارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وهذا فيه بيانُ إحاطةِ عِلْمِ اللهِ بِمَنْ يَدخلُ الجنةَ تفصيلاً ومَنْ يدخلُ النارَ تفصيلاً، فَلا يُزادُ في ذلِكَ العَدَدِ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُ، وَكَذلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوه ويستحيلُ أنْ لاَ يَعلَمَ ما يَكُونُ منْ مخلوقاتِه قبلَ وجودِهِم إذْ ذاكَ جهلٌ والجهلُ في حقِّ القديمِ محالٌ، فَثَبَتَ سَبْقُ عِلْمِهِ في الأزلِ بما يكونُ منْ مخلوقاتِه، وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ فإن مَنْ قُدِّر أنَّهُ منْ أهلِ الجنةِ قُدِّرَ له ما يُقَرِّبُهُ إليها منْ قولٍ وعملٍ وَوُفِّقَ لذلك، ومن قُدِّرَ أنه منْ أهلِ النارِ قُدِّرَ له خِلافُ ذلك فأَتَى بأعمالِ أهلِ النارِ وأصرَّ عليها وَالأَعْمَالُ بِالْخَواتِيمِ أيْ أنَّ الجَزاءَ يكونُ على ما يُخْتَمُ به للعبدِ منَ العملِ، وَالسَّعيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالى فَمَنْ خُتِمَ له بعملِ أهلِ السَّعادةِ فهو سعيدٌ، وهو مَنْ خَلَقَ اللهُ تبارك وتعالى فيه الإيمانَ والطَّاعةَ فَجَرَى ذلك على يَدِهِ وماتَ عليه وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالى فمَنْ خُتِمَ له بعملِ أهلِ الشَّقاوةِ فهو شقيٌّ، وهو مَنْ خَلَقَ اللهُ تبارك وتعالى فيه الشَّرَّ فأجراهُ على يدِه وماتَ عليهِ. وَأَصلُ القَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالى في خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أيْ أنَّ ذلك مَستورٌ عنِ العبادِ، فلذلك نُهِيْنَا عنِ الخوضِ فيه، وإنَّمَا الأمرُ الذي ينبغي في أمرِ القَدَرِ معرفةُ معناه وتفسيرِه، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ في ذلِكَ أي في طلب الوقوف على الحكمة التي كتمها الله عن الخلق ذَرِيعَةُ الخِذْلانِ وَسُلَّمُ الحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ لأنه من يَتَتَبَّعُ ذلك فهو علامةٌ أنه مَخْذُولٌ أيْ محرومٌ فَالحَذَرَ كُلَّ الحَذَرِ مِنْ ذلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً وادْفَعُوا عنْ أنفسِكُمْ مُحَاوَلةَ الاطِّلاَعِ على طلب ما حجب عن العباد حتى مِنْ طريقِ الوَسْوَسَةِ، فَلْيَشْغَلِ الإنسانُ قلبَه بما يَحْجُزُهُ عنْ ذلك فَإنَّ اللهَ تَعَالى طَوَى عِلْمَ القَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ أيْ عنْ طَلَبِهِ لأنه أمر لا سبيل إلى معرفته كَمَا قَالَ تَعَالى في كِتَابِهِ: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (23) [سورة الأنبياء]، فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الكِتَابِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الكِتَابِ كانَ منَ الكافرينَ فَهذِهِ جُمْلَةُ مَا يَحتَاجُ إلَيهِ مَن هُوَ مُنوَّرٌ قَلبُهُ منْ أَوْلياءِ اللهِ تَعَالى وفي هذا إشارةٌ إلى جميعِ ما تَقَدَّمَ مِمَّا يجبُ اعتقادُهُ والعملُ به وإلى أنَّ مَنْ حَوَى ذلك وعَمِلَ بهِ فقدْ نَوَّرَ اللهُ قلبَهُ قال الله تعالى: {أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربه} وَهِيَ دَرَجَةُ الرّاسِخِينَ في العِلْمِ أيِ المتمكِّنِينَ في العِلْمِ، وهمُ الذين ثَبَتُوا فيهِ وتمكَّنُوا لأنَّ العِلمَ عِلْمانِ: عِلمٌ في الخَلْقِ مَوْجُودٌ وهو ما جَعلَ اللهُ سبيلاً للعبادِ إليهِ، وَعِلْمٌ في الخَلْقِ مَفْقُودٌ وهو ما استأثرَ اللهُ بهِ ولَمْ يَجعلْ للخلقِ سبيلاً إليه. فعِلمُ العقائدِ والأحكامِ وعِلْمُ ما يُنتفَعُ بهِ في المعيشةِ هو مِمَّا جَعلَ اللهُ للخَلْقِ سبيلاً إليهِ، وأمَّا مَا استأثرَ اللهُ بهِ كعِلْمِ وَجْبَةِ القِيامةِ فذلكَ هو العِلْمُ المفقودُ للعِبادِ، فإنكارُ العِلْمِ الموجودِ كُفرٌ كإنكارِ السُّوفِسْطَائِيةِ وُجُودَ الأشياءِ، فهم ينكرون حقائق الأشياء ويقولون: “نتخيّل فقط”، فما نعتقده من حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض وغيرِ ذلك ليس تخيلاً بل هي حقيقة موجودة، وادِّعاءُ العِلْمِ المفقودِ كُفرٌ فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ يَعرِفُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ على التّحديدِ كَفَرَ. ولا يَثبُتُ الإِيمانُ إلا بقَبولِ العِلْمِ الموجودِ وتَرْكِ طَلَبِ العِلْمِ المفقودِ. وَنُؤْمِنُ بِاللَّوحِ وهو عِبارةٌ عنْ جِرْمٍ عُلْوِيّ لَيسَ كَأَلْوَاحِنَا والقَلَمِ وهو جِرْمٌ عُلْوِيٌّ لَيسَ كَأَقْلاَمِنَا خُلِقَ قَبْلَ اللَّوْحِ وَنؤمن بِجَمِيعِ مَا فِيهِ أي في اللوح قَدْ رُقِمَ لأن الله أخبر بذلك قال تعالى: {وَكُلَّ شَىءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِين} فعِلْمُ اللهِ غيْرُ مُتناهٍ، أمَّا المكتوبُ في اللَّوحِ المحفوظِ شىءٌ مُتناهٍ، واللَّوحُ ليسَ فيهِ تفاصيلُ ما يقعُ في الآخرةِ لأنَّ هذا شىءٌ لا نهايةَ لهُ. فَلَوِ اجتَمَعَ الخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَىءٍ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيهِ، ولوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى شَىءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ تَعَالى فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ كما وَرَدَ فِيمَا صحَّ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بعضِ أحاديثِهِ، جَفَّ القَلَمُ بمَا هُو كَائِنٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ أيْ أنَّ القَلَمَ قدْ فَرَغَ مِنْ كِتابةِ ذلكَ. وَمَا أَخْطَأَ العبدَ لمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ لأنَّ عِلْمَ اللهِ سَبقَ بذلكَ ولا يَتغيرُ عِلْمُ اللهِ، لأنَّ تغيرَ العِلْمِ جَهْلٌ والجهلُ مستحيلٌ على اللهِ، فما سَبقَ في علمِ اللهِ أنه لا يُصيبُ العبدَ فمحالٌ أنْ يُصيبَه ذلكَ، وما سَبقَ في علمِ اللهِ أنه يُصيبُ العبدَ فمحالٌ أنْ يُخطئَهُ. وَيجبُ عَلَى العَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أنَّ اللهَ قَدْ سَبَقَ عِلمُهُ في كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدَّرَ ذلِكَ تَقْدِيرًا مُحكَمًا مُبرَمًا لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلا مُعَقِّبٌ وَلا مُزِيلٌ ولا مُغَيِّرٌ وَلا مُحَوِّلٌ ولا نَاقِصٌ وَلا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ في سَمَاواتِه وَأرْضِهِ وهذا تصريح بإثبات أزلية علم الله تعالى ومشيئته وبإثبات القضاء والقدر بما هو كائن من خلقه وبتقدير كل شىء على ما تقتضيه حكمته بما خلقه من حسن وقبيح وخير وشر وطاعة ومعصية وغنى وفقر وَذلِكَ أي جميع ما سبق من العقائد المذكورة في القضاء والقدر وغيرهما مِنْ عَقْدِ الإِيمانِ وأُصُولِ المَعرِفَةِ والاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللهِ تَعَالى وَرُبُوبِيَّتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالى في كِتَابِهِ: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَىءٍ فقدّره تقديرًا﴾ (2) [سورة الفرقان]، وقالَ تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ (38) [سورة الأحزاب] والمرادُ بالأمرِ هنا ليسَ الأمرَ التكليفيَّ كالصلاةِ والصيامِ، إنما ما شاءَ اللهُ تعالى حصولَه ووقوعَه في الوجودِ منْ أعيانِ المخلوقاتِ أوْ منْ صفاتِهِم وحركاتِهِم وسكناتِهِم، فَوَيلٌ لِمَنْ صَارَ للهِ تَعَالَى في القَدَرِ خَصِيمًا فمن ينكر القدر فقد نازع الله فيما أثبته فصار خصيمًا له فيستحق الويل، وويل لمن أَحضَرَ للنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا لارتيابه فيما ثبت بالأدلة القطعية لمرض في قلبه، ولطلبه الوقوف على مضمون سر كتمه الله عن خلقه، لَقَدِ التَمَسَ بِوَهْمِهِ في فَحْصِ الغَيبِ سِرًّا كَتِيمًا وَعَادَ بِمَا قَالَ فيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا إذ الأفاك هو الكذاب والأثيم هو الفاجر كثير الإثم، وذلك بسبب إنكار ما ثبت من الأدلة القطعية. وهذا تصريحٌ بذمِّ مَنْ أنكرَ القَدَرَ، ومن أنكره فقد كفر.
القول في العرش والكرسي
وَالْعَرْشُ وَالكُرْسِيُّ حَقٌّ لأنَّ اللهَ نَصَّ عليهِما في القرءانِ قال الله تعالى: ﴿ربُ العرش العظيم﴾ وقال تعالى: ﴿وسع كرسيه السموات والأرض﴾. والعرشُ هو أعظمُ الأجسامِ منْ حيثُ المِساحةُ وهو سرير له أربع قوائم وأما الكُرسيُّ فهو تحتَه وهو بمثابةِ ما يَضَعُ راكِبُ السَّريرِ قَدَمَهُ، وهو صغيرٌ جدًّا بالنِّسبةِ للسَّريرِ وَهُوَ مُسْتَغنٍ عَنِ العَرْشِ وَمَا دُونَهُ فاللهُ تعالى ليسَ محمولاً بالعرشِ لأنَّ اللهَ لا يَمَسُّ ولا يُمَسُّ يَستحيلُ عليهِ ذلكَ، مُحِيطٌ بِكُل شَىءٍ بالعِلْمِ والغَلَبَةِ والسُّلطانِ لا كإحاطة الظرف بالمظروف لأن ذلك من خصائص الجسم والله منـزه عن ذلك، وَفَوقَهُ من حيث المكانة والقهر والغلبة لا من حيث المكان لأنَّ كلَّ شىءٍ تحتَ عِلْمِهِ وقدرتِه، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الإِحَاطَةِ خَلقَهُ فالخَلْقُ لا يُحيطُ أحدٌ مِنْهُمْ علمًا بكلِّ شىءٍ مِنَ المخلوقاتِ، وَنَقُولُ إنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبراهِيمَ خَلِيلاً لأن إبراهيم بلغ الغايةَ في حبِّ الله، وهو مقامٌ عالٍ، وَكَلَّم الله مُوسى تَكْلِيمًا إيمانًا وتَصدِيقًا وَتَسلِيمًا. وَنُؤمِنُ بالمَلائِكَةِ وهُمْ عِبَادٌ للهِ تعالى لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أمَرَهُمْ كَمَا أخبرَ سُبحانَهُ وَنؤمن بالنَّبيّينَ وهوَ أنَّ اللهَ ارتضاهُمْ للنُّبُوَّةِ واصطفاهُمْ وأكرمَهُمْ بالرسالةِ بَيْنَهُ وبينَ عبادِه بما يُوحَى إلَيهِم. ونؤمن بالكُتُبِ المُنَزَّلَةِ عَلَى المُرسَلِينَ بأنَّها مِنْ عندِ اللهِ تعالى وَنَشهَدُ أَنَّهُم كَانُوا عَلَى الحَقِّ المُبينِ.
القول في أهل القبلة
وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُعْتَرِفِينَ لأن مجرد التوجه إلى قبلتنا لا يدل على الإيمان ما لم يصدق النبي فيما جاء به من الشريعة ولَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقينَ غَيرَ مُنْكِرِينَ فلا نَقُولُ كَمَا تقولُ الخَوَارِجُ: “مَنِ ارتكبَ معصيةً فهوَ كافرٌ”، ولا كمَا تقولُ المُعْتَزِلَةُ: “مَنِ ارتكبَ كبيرةً لا يُسمَّى مُسْلِمًا ولا كافِرًا” ولا نقول بقولِ المُرْجِئَةِ “لا يَضُرُّ معَ الإيمانِ ذَنْبٌ”.
النهي عن التفكر في ذات الله
وَلا نَخُوضُ في اللهِ أيْ لا نُفَكِّرُ في ذاتِ اللهِ أي في حقيقته، لأنَّ التَّفَكُرَ في ذاتِ اللهِ يُؤَدِّي إلى الحَيْرَةِ والضَّلالِ وهو ممنوع لأن الفكر لا يصل إليه ويُؤَدِّي إلى تشبيهِ اللهِ بخلْقِه .
القول في المراء في الدين
وَلا نُمَارِي في دِينِ الله أيْ لا نُجادِلُ في دِينِ اللهِ جِدالاً نَهَى اللهُ تَباركَ وتَعالى عنهُ فَمَنْ عَرَفَ الحقَّ يُجَادِلُ لإحقاقِ الحقِّ أمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فلا يُمَارِي.
القول في القرءان
وَكذلك لا نُجَادِلُ في القُرءانِ أي لا نَحكُمُ في القُرءانِ بنَفْيِ شىءٍ يَحتمِلُ أنْ يكونَ منهُ ولا بإثباتِ شىءٍ مِنْ غيرِ عِلْمٍ أنَّهُ مِنْهُ وَنَشهَدُ أَنَّهُ أي القرءان كَلامُ رَبِّ العَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ جبريل فَعَلَّمَهُ سَيّدَ المُرْسَلِين مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أي علَّم جبريلُ محمدًا لقوله تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾، وَهُوَ كَلامُ اللهِ تَعَالى لا يُسَاوِيهِ شَىءٌ مِنْ كَلامِ المَخلُوقِينَ لأن كلامه تعالى صفة قائمة بذاته فكيف يكون كلام البشر الذي هو حادث مساويًا له؟! وَلا نَقُولُ بِخَلْقِهِ أيْ لا نقولُ القُرءانُ مخلوقٌ، فإنَّ القُرءانَ إذا أُريدَ بهِ الصِّفةُ الذَّاتيَّةُ التي ليستْ حرفًا ولا صَوتًا فظاهرٌ أنهُ غيرُ مخلوقٍ، أمَّا إنْ أُريدَ بهِ اللفظُ الْمُنَزَّلُ فيجبُ اعتقادُ أنهُ مخلوقٌ للهِ تعالى، لكنْ لفظًا لا يُقالُ -القُرءانُ مخلوقٌ- إلا لحاجةِ التَّعليمِ. وَلا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ وهُمْ مَنْ كانَ على ما كانَ عليهِ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والصحابةُ منَ العقائدِ، كما لا نخالفُ إجماعَ المجتهدِينَ.
القول في عدم تكفير المؤمن بالذنب ما لم يستحله
وَلا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ المؤمنين بِذَنبٍ مَا لَم يَسْتَحِلَّهُ فإذا استَحلَّ الذَّنبَ وكانَ ذلك الذنبُ معلومًا منَ الدِّينِ بالضرورةِ أنهُ ذنبٌ فهذا الذي يُكفَّرُ.
القول في الرد على المرجئة
وَلا نَقُولُ لا يَضُرُّ مَعَ الإِيمان ذَنبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ فإن هذا خِلافُ مذهبِ أهلِ السُّنَّةِ وفيهِ رَدٌّ للنصوصِ وهو كُفرٌ لأن النصوص والأحاديث الصحيحة قد دلَّت على تعذيب قسم من أصحاب الكبائر المؤمنين بقدر ذنوبهم. نَرجُو لِلمُحْسنينَ منَ المُؤْمِنِينَ أيْ مَنْ رَأَيْناهُ ظاهِرًا طائِعًا أَنْ يَعفُوَ عَنهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الجنَّةَ بلا عذابٍ برَحمَتِهِ، وَلا نَأْمَنُ عَلَيْهِم أي على المؤمنين ما يحبط عملهم من كفر أو نفاق أو ما يحبط ثواب عملهم من رياء وسمعة لأنهم غير معصومين عن ذلك. وَلا نَشهَدُ لَهُمْ بِالجَنَّةِ مِنْ تِلْقَاءِ أَنفسِنا، أمَّا مَنْ وردَ فيهِ النصُّ أنَّهُ مِنْ أهلِ الجَنَّةِ فنَشهدُ لهُ كأهلِ بَدْرٍ وأهلِ أُحُدٍ وأُناسٍ ءَاخَرينَ بَشَّرَهُمُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالجَنَّةِ وَنَستَغفِرُ لِمُسِيئِهِم أي منَ المسلمينَ كما نستغفر لأنفسنا وَنَخَافُ عَلَيهِم أنْ يُعذَّبوا بذنوبِهم إذا لَمْ يَتوبوا مِنْها لأن الله تعالى أوعد بالعقاب بِمخالفة أوامره وَلا نُقَنِّطُهُمْ أيِ المذنبِينَ العُصاةَ لا نَجْعُلُهُمْ ءَايِسِينَ منْ رحمةِ اللهِ، فنقولُ يجوزُ أنْ يُسَامِحَهُمُ اللهُ ويجوزُ أنْ يُعَذِّبَهُمْ.
باب القول في الأمن والإياس
وَالأَمْنُ والإِيَاسُ يَنقُلانِ عَنِ مِلَّةِ الإِسْلامِ فمن نَفَى عذابَ اللهِ لِلْعُصَاةِ فهذا أَمِنَ مكرَ اللهِ وكانَ منَ الكافرِينَ، وكذلكَ الآيِسُ مِنْ رحمةِ اللهِ الذي يعتقدُ أنَّ اللهَ لا يغفرُ الذنبَ للمسلمِ التائبِ فهو كافرٌ، هذا تفسيرُهُما عندَ الحنفيةِ. وسَبِيلُ الحَقِّ بَينَهُمَا أي بين الأمن والإياس لأهلِ القِبْلَةِ وهو الوقوف بين الخوف والرجاء.
باب القول في الردة
وَلا يَخرُجُ العَبْدُ مِنَ الإِيمانِ إلا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ فإذا قالَ قولاً يكونُ تكذيبًا لشرعِ اللهِ بعبارةٍ صريحةٍ هذا نعتبِرُهُ خارِجًا منْ دِينِ اللهِ، أوْ فعلَ فِعلاً هو في معنى التكذيبِ هذا أيضًا نعتبِرُه خارِجًا منَ الإيمانِ، وكذا إنِ اعتقدَ اعتقادًا يُخالِفُ عقيدةَ الإسلامِ.
القول في الإيمان
والإِيمانُ هُوَ الإِقرَارُ بالشهادتَينِ بِاللِّسَانِ وَالتَّصديقُ بِالجَنَانِ وهو القلب. وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَن رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ الشَّرعِ وَالبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ لأنه معصوم عن الكذب. وَالإِيمانُ وَاحدٌ لأن الإيمان عبارة عن التصديق بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وَأَهلُهُ في أَصْلِهِ سَوَاءٌ يعني أن إيمان أهل السماء من الملائكة وأهل الأرض من الإنس والجن في الأصل واحد وهو التصديق بوحدانية الله وإثبات صفاته وبكل ما يجب الإيمان به جملة، وجميع المكلفين في هذا على السواء والتَّفاضُلُ بَينَهُم بِالخَشْيَةِ والتُّقى ومُخَالَفَةِ الهَوَى وَمُلازَمَةِ الأَوْلى فمَنْ كانَ خاشِيًا للهِ تعالى تَقِيًّا مُخَالِفًا لِهَواهُ مُلازِمًا لِلأَوْلَى أيْ سالِكًا مَسْلَكَ الوَرَعِ هذا يزيدُ على غيرِه، أي يزيدُ إِيْمَانُه على إِيْمَانِ غيرِهِ من حيثُ الوصفُ، أمَّا مِنْ حيثُ الأصلُ فلا يزيدُ إيمانٌ على إيمانٍ. وَالمُؤمِنُونَ كُلُّهُم أَولِيَاءُ الرَّحمنِ يَدخلونَ في الوِلايةِ العامَّةِ أي حفظَهم الله من العذابِ الذي يعذِّبُ به الكفارَ وتولاهم برحمتِه، أمَّا الوِلايةُ الخاصةُ فهيَ لأهلِ الاستقامةِ فقطْ وَأَكْرَمُهُمْ عِندَ اللهِ أَطوَعُهُمْ وَأَتبَعُهُمْ لِلقُرءانِ واتِّباعُ القرءانِ دليل على الطاعة والتقوى. وَأصلُ الإِيمان هُوَ الإِيمَانُ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالى أيْ أنْ تُؤْمِنَ بالمقدورِ أي المخلوق خيرِه وشرِه وحُلْوِه ومُرِّه أنَّه مِنَ اللهِ أيْ أنَّه حصلَ منَ اللهِ بمشيئتِهِ وعِلْمِهِ، فهذهِ المذكوراتُ أهمُّ أمورِ الإيمان وأعظمُها وَنَحنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ بل نؤمنُ بجميعِ رسلِه وأنبيائِه وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ.
القول في أهل الكبائر
وَأَهلُ الكَبائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في النَّارِ لا يَخْلُدُونَ إذَا مَاتُوا وَهُمْ مؤمنون مُوَحِّدُونَ وَإنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبينَ بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللهَ أي مَاتُوا عَارفِينَ باللهِ ورسولِهِ مُؤْمِنِينَ مُذْعِنِيْنَ في قُلُوبِهِم بذلكَ، فهؤلاءِ لَوْ ماتوا بِلا توبةٍ لا يَخْلُدونَ في النار، وَمَنْ عُذِّبَ مِنْهُمْ لا بُدَّ أنْ يَخرُجَ منَ النارِ ويَدخلَ الجنةَ وَهُمْ في مَشِيئَتِه وَحُكْمِهِ إنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ كَمَا ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ في كِتَابِهِ: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (48) [سورة النساء]، وَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ في النَّارِ بِعَدْلِهِ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ الذين إمَّا أنْ يَكونُوا أنبياءَ، وإمَّا أنْ يَكُونوا علماءَ أتقياءَ، أو يَكُونوا بصفةٍ أُخْرَى كشهداءِ المعركةِ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إلى جَنَّتِهِ وذَلِكَ بأَنَّ اللهَ تَعَالى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، معناهُ أنَّ اللهَ حافظٌ أهلَ معرفتِه المؤمنينَ بهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ في الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الذين كَذَّبوا بهِ إمَّا بِنَفْيِ وجودِ اللهِ كالدَّهْرِيَّةِ وإمَّا بعبادةِ غيرِهِ وإمَّا بتكذيبِ رسولِهِ أَوْ نحوِ ذلكَ الذينَ خَابُوا مِنْ هِدايَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وِلايَتِهِ أيْ ما صارَ لَهُمْ حظٌّ مِنْ وِلايةِ اللهِ العامَّةَ هي الإسلامُ اللهُمَّ يا وَليَّ الإسلامِ وأهلِه ثَبِّتْنَا على الإسلامِ حَتى نَلقَاكَ به أيْ حتى نَمُوتَ. وَنَرَى جواز الصَّلاةِ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وهوَ التَّقِيُّ وَفَاجِرٍ وهوَ مَنْ كانَ مِنْ أهلِ الكبائرِ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ معَ الكراهةِ خلفَ الفاجرِ وَكما نعتقدُ وجوبَ الصلاةِ عَلَى مَن مَاتَ مِنهُمْ. وَلا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلا نَارًا أيْ لا نحكُمُ مِنْ تِلْقَاءِ أنفسِنا بأنَّ فلانًا منْ أهلِ الجنةِ وأنَّ فلانًا منْ أهلِ النارِ، إلاَّ مَنْ شَهِدَ له الشرعُ. وَلا نَشهَدُ عَلَيهمْ بِكُفرٍ أيْ لا نُكفِّرُ أحدًا وَلا نَحكُمُ على أحدٍ بِشِركٍ وَلا بِنِفَاقٍ بدونِ دليلٍ شرعيٍّ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَىءٌ مِن ذلِكَ إذ نحن نحكم بالظاهر وَنَذَرُ سرَائِرَهُمْ إلَى اللهِ تَعَالى أيْ نقولُ: اللهُ أعلمُ بما في قلوبِهِم، لأنَّ اللهَ هو المطَّلِعُ عليها دونَ العبادِ فوجبَ تفويضُ ذلكَ إليهِ. وَلا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أيْ لا يجوزُ قتلُ المسلِمِ البَرِّ والفاجرِ إلا مَنْ وَجَبَ عَلَيهِ السَّيفُ أي ثَبَتَ عليهِ القتلُ مثل الردة والقصاص والبغي.
القول في منع الخروج على أئمة المسلمين
وَلا نَرَى الخُروجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلاةِ أمُورِنَا أيْ يَحْرُمُ الخروجُ على السلطانِ الذي انعقدتْ بيعتُهُ الشرعيةُ، ولا نحارِبُهُم ولا نَخْلَعُهُم منَ الخلافةِ وإنْ جَارُوا أي ظلموا وإنَّمَا يُخرَجُ عليهِم إذا كَفَرُوا وَلا نَدْعُو عَلَيْهمْ دُعَاءً يُؤدِّي إلى تحريكِ فِتنةٍ ولا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِم معناهُ نطيعُهُمْ وإنْ كانوا جائرينَ فيما لا معصيةَ فيهِ. ونَرَى طَاعَتَهُم التي أَمَرَ اللهُ بها المؤمنِينَ لأُولِي الأمرِ مِنْ طاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَريضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعصِيَةٍ، وَنَدعُو لَهُم بِالصَّلاحِ والمعافاةِ أي أنْ يُصْلِحَهُمُ اللهُ ويُزيلَ عنهُم ما بِهِم منَ الجَوْرِ والظُّلْمِ بأنْ يتوبَ عليهِمْ. وَنَتْبَعُ السُّنَّةَ والجَمَاعَةَ وهمُ الذينَ يعتقدونَ عقيدةَ الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ وإنَّمَا سُمُّوا أهلَ السُّنَّةِ لأنَّهُمْ على سُنَّةِ رسولِ اللهِ. وَنَجتَنِبُ الشُّذُوذَ وهو الخروج عنِ الإجماعِ في المسائلِ الاجتهاديةِ التي اجتهدَ فيها أهلُ الاجتهادِ ونجتنب الخِلافَ والفُرْقَةَ وهو مخالفة مَنْ خالفَ ذلكَ بفِراقِهِمْ. وَنُحِبُّ أَهْلَ العَدْلِ وَالأَمَانَةِ وهم أهل السُّنَّةِ المتمسِّكِيْنَ بالعدلِ مِنْ وُلاةِ الأُمورِ وَنُبغِضُ أَهْلَ الجَوْرِ والخِيَانَةِ أهلَ الخلافِ والعِصيانِ وَنَقُولُ اللهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ أيِ الشىءُ الذي لا نَعْلَمُهُ نقولُ نُفَوِّضُ فيهِ العِلْمَ إلى اللهِ.
القول في المسح على الخفين
وَنَرَى المَسحَ عَلَى الخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ كما جَاءَ في الأَثَرِ فحديثُ المسحِ على الخُفَّيْنِ متواتِرٌ رواهُ عددٌ لا يُحْصَى مِنَ المحدِّثِينَ في مؤلفاتِهِم عنْ سبعينَ منْ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. وَالحَجُّ والجِهادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الأَمرِ مِنَ المُسْلِمِينَ وقد خصهما بالذكر تأكيدًا عليهما كي لا يُتركا بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ يعني معَ الإمامِ البَرِّ والفاجِرِ إلى قيامِ السَّاعَةِ لا يُبْطِلُهُمَا شَىءٌ وَلا يَنقُضُهُما ولا يفهم من كلام المصنف أن الإمام شرط في الحج والجهاد.
القول في الإيمان بالكرام الكاتبين
الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ هُمُ الْمَلائِكَةُ الَّذِينَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِكِتَابَةِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ قَالَ تَعَالَى ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [سُورَةَ الِانْفِطَار].
القول في عذاب القبر ونعيمه
وَيجبُ الإيمانُ بعذابِ القبرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهلاً أي للكفارِ وأهلِ الكبائرِ إلاَّ مَنْ رحمَهُ اللهُ تعالى منهُم ـ أيْ منْ أهلِ الكبائرِ ـ، وَنؤمِنُ بسُؤَالِ مُنكَرٍ وَنَكِيرٍ للبالغِينَ المكلَّفِينَ من هذهِ الأُمَّةِ فقطْ في قَبرِهِ عَنْ رَبّهِ وَدِينِهِ ونَبِيِّهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَعَنِ الصَّحابةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم ويُستَثْنَى الأنبياءُ وشهداءُ المعركةِ والأطفالُ فإنَّهُم لا يُسألونَ. والقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ ليسَ المرادُ بهِ أنَّ القبرَ يَصيرُ مثلَ الجنةِ سَوَاءً، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ معناه أنَّ فيهِ نَكَدًا، والنَّكَدُ أنواعٌ كثيرةٌ، وهذا تشبيهٌ مجازيٌّ، والتقديرُ القبرُ كروضةٍ منْ رياضِ الجنةِ أو كحُفْرَةٍ منْ حُفَرِ النارِ.
القول في البعث وجزاء الأعمال
وَيجبُ أن نُؤمِنُ بِالبَعثِ وهو بعثُ اللهِ تعالى الموتَى منَ القبورِ وَجَزَاءِ الأَعْمَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ لأنَّ الدُّنيا لا تَصلُحُ أنْ تكونَ دارَ الجزاءِ العامِّ لأنَّها جُعِلَتْ دار العملِ والآخِرةُ جُعلتْ دار الجزاءِ. وَالعَرْضِ على الله والحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الكِتَابِ أيْ يُعْرَضُ كتابُ المرءِ يومَ القيامةِ الذي كَتَبَتْهُ الملائكةُ على الله أسرعِ الحاسبِينَ فيُقالُ لهُ اقرأْ كتابَكَ، فيَرَى فيهِ أعمالَهُ والثَّوَابِ والعِقَابِ فقدْ تَضَمَّنَ ذلكَ قولُه:”وجزاءِ الأعمالِ” وأُعيدَ تأكيدًا ومبالغةً. والصِّراطِ لقولِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا﴾(71) [سورة مريم]، وقَدِ اخْتُلِفَ في تفسيرِ الوُرودِ، والصوابُ أنَّ الوُرودَ على وجهَينِ: ورودُ دخولٍ ووُرودُ عُبورٍ، فوُرودُ الدُّخولِ للكُفَّارِ ولبعضِ عُصاةِ المسلِمِينَ، ووُرودُ العبورِ للأتقياءِ. وَنؤمن بالمِيزَانِ أي ما يوزنُ عليه أعمالُ العباد للأخبارِ الواردةِ في ذلك.
القول في أن الجنة والنار مخلوقتان
والجَنَّةُ والنَّارُ مَخلوقَتَانِ لا تَفنَيَانِ أبَدًا ولا تَبيدَانِ وكذا أهلهما، والأبدية تنافي الفناء والزوال، كما يُفْهَمُ مِنْ كلامِهِ هذا ضلالُ مَنْ قالَ بفناءِ الجنةِ والنارِ. وإنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبلَ الخَلْقِ أيْ قبلَ البَشَرِ وليسَ معناهُ قبلَ كُلِّ شىءٍ خَلَقَ اللهُ الجنةَ والنارَ. وَيجبُ الإيمانُ بأنَّ اللهَ خَلَقَ لَهُمَا أي للجنةِ والنارِ أَهْلاً فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أدخلَهُ إلى الجَنَّةِ فَضْلاً مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُم أدخلَهُ إلى النَّارِ عَدلاً مِنْهُ ذلكَ لأنَّ الظُّلمَ التصرف في ملك الغير بما لا يرضى وهو تعالى يَتصرَّفُ في مُلْكِهِ ولَمْ يَتَصرَّفْ في مُلْكِ غيرِهِ، وَكُلٌّ منَ العبادِ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَصَائِرٌ إلى مَا خُلِقَ لَهُ أي لِمَا قدْ كَتبَهُ اللهُ تباركَ وتعالى لهُ في اللَّوْحِ.وَالخَيرُ والشَّرُّ مُقَدَّرَانِ بعِلْمِهِ ومشيئتِهِ عَلَى العِبَادِ معَ مَا جعلَهُ اللهُ في العبدِ منَ الاختيارِ.
القول في الاستطاعة
وَالاسْتِطَاعَةُ التي يَجِبُ بِها الفِعْلُ مِنْ نَحْوِ التَّوفِيقِ في الطاعاتِ وفي المعاصي تُسمَّى خِذلانًا الَّذي لا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ المَخلُوقُ بِهِ لأنّها من الله يُحْدِثُهَا مقرونةً بالفعلِ، فَهِيَ مَعَ الفعلِ يَتَحَقَّقُ بِها منَ العبدِ الفعلُ كحركة الإصبع مع حركة الخاتم ليكون العبد دائمًا مفتقرًا إلى توفيق الله ومشيئته وتأييده، وَأَمّا الاسْتطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالوُسْعِ والتَّمَكُّنِ وَسَلامَةِ الأَسْبَابِ فِي الآلاتِ الجوارح والأعضاء فَهِي قَبلَ الفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الخِطَابُ، وهِيَ كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ (286) [سورة البقرة]: أي وَلا يُكَلَّفُ العَبدُ بِمَا لَيسَ فِي وُسْعِهِ.
القول في أفعال العباد
وَأَفْعَالُ العِبَادِ كُلُّها خَلْقُ اللهِ وَكَسْبٌ مِنَ العِبَادِ فالأفعالُ الاختياريةُ تَقَعُ كَسْبًا للعبدِ وخَلْقًا منَ اللهِ تعالى، وَلَمْ يُكَلّفْهُمُ اللهُ تَعَالى إلاَّ مَا يُطِيقُونَ، وَلا يُطَيَّقُونَ أي لا يُلْزَمُونَ إلا مَا كَلَّفَهُم اللهُ بهِ، وليسَ معناها أنَّ العِبَادَ لا يَستطيعونَ أنْ يَفعلُوا سوى ما كَلَّفَهُمُ اللهُ بهِ، والواقعُ أنَّ العِبادَ قادِرونَ على أنْ يُخالفُوا ما كَلَّفَهُمُ اللهُ بهِ وذلكَ حَالُ أكثرِ البَشَرِ. وَهُوَ تَفْسِيرُ لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ نَقُولُ: لا حِيْلَةَ لأَحَدٍ وَلا حَرَكَةَ لأَحَدٍ وَلا تَحَوُّلَ لأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيةِ اللهِ إلاَّ بِمَعُونَةِ اللهِ أيْ إلاَّ بعِصمتِهِ وَلا قُوَّةَ لأَحَدٍ عَلَى إقَامَةِ طَاعَةِ اللهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيهَا إلاَّ بِتَوفِيقِ اللهِ فالعبدُ مُحتاجٌ إلى اللهِ في الأَمْرَيْنِ: في التَّحَفُّظِ عنِ المعاصِي والقُدْرَةِ والتَّمَكُّنِ على الطَّاعاتِ. وَكُلُّ شَىءٍ أيْ أنَّ كلَّ عملٍ يَعْمَلُهُ ابنُ ءادمَ وغيرَ ذلك مِمَّا يَدخُلُ في الوجودِ مِنْ أَعيانٍ وأعراضٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ فَلا يَحْصُلُ شىءٌ مِنَ العَالَمِ إلاَّ بهذهِ الصِّفاتِ الأَرْبَعِ غَلَبَتْ مَشِيئتُهُ المَشِيئَاتِ كُلَّهَا أيْ لا يَتَنَفَّذُ شىءٌ منْ مشيئاتِ العِبادِ إلاَّ أنْ يشاءَ اللهُ نُفُوذَها، وغَلَبَ قَضَاؤُهُ الحِيَلَ كُلَّها أي أنَّ حِيَلَ العِبادِ لا تُوصِلُ إلاَّ إلى ما قَضَى اللهُ تباركَ وتعالى، فَمَا لم يَقْضِ اللهُ تباركَ وتعالى، أيْ ما لم يَخْلُقْهُ، لا تَنْفُذُ الحِيَلُ فيهِ. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ويَدُلُّ على ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿فعالٌ لِمَا يُرِيد﴾، وَهُوَ غَيرُ ظَالِمٍ أَبَدًا تَقَدَّسَ أي تنـزَّهَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ أيْ ظُلْمٍ، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ أَيْ نَقْصٍ.
﴿لا يُسْأَلُ﴾ أي الله ﴿عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ﴾ أي العباد ﴿يُسْأَلُونَ﴾ عما يفعلون (23) [الأنبياء] وَفي دُعَاءِ الأَحيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنفَعَةٌ لِلأَمْوَاتِ من المسلِمِينَ بالإجماعِ، وكذلكَ قِراءَةُ القُرءانِ على القبرِ تَنفعُ الميِّتَ. وَاللهُ تَعَالى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِي الحَاجَاتِ فلَوْ لم يَستجبْ لم يَكُنْ ذلك ظُلْمًا، لكنَّه أَخبرَ بأنه يَستجيبُ فَلا يَتَخَلَّفُ كَلامُهُ، لكنَّه يَستجيبُ ما شاءَ أنْ يُعْطِيَهُ للعِبادِ وليسَ كُلَّ ما يَطْلُبُونَ. وَيَملِكُ كُلَّ شَىءٍ قال الله تعالى:{له ملك السموات والأرض} وَلا يَملِكُهُ شَىءٌ لأن المالك لا يصير مملوكًا، وَلا غِنَى عَنِ الله تَعَالى طَرفَةَ عَيْنٍ أي أنَّ كُلَّ شىءٍ يَحتاجُ إلى اللهِ تعالى لأنَّهُ هو الذي أَوجَدَهُ، وَمَنْ [زَعَمَ أَنَّهُ] اسْتَغنَى عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَد كَفَرَ لأن الافتقار صفة لازمة للعبد والغنى صفة للرب وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الحَيْنِ وهوَ الهَلاكُ، فإن الكافر مخلد في العذاب الشديد وأي هلاك أشد من هذا؟!.
القول في غضب الله ورضاه
واللهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى كَمَا نطَقَ بِهِ ٱلقُرْءَانُ لا كَأَحَدٍ مِنَ الوَرَى يعني أنه يَجِبُ إثباتُ صفةِ الغَضَبِ وصفةِ الرِّضَى للهِ معَ تَنْزِيهِهِ تعالى مِنْ أنْ يَكُونَ غضبُه ورِضاهُ تَأَثُّرًا، بَلْ هُمَا صِفَتانِ أَزلِّيتانِ قديمتانِ أَبَدِيَّتانِ.
القول في حب أصحاب رسول الله
وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهُم مَنْ لَقُوهُ مؤمنينَ بهِ في حياتِهِ على الوجهِ المتعارَفِ، ليسَ ما يَكُونُ بطريقِ خَرْقِ العادةِ، وَلا نُفْرِطُ في حُبِّ أَحَدٍ مِنهُمْ أيْ لا نَتجاوزُ الحدَّ في مَحَبَّةِ أَحَدٍ وَلا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أيْ لا نُخرِجُ أَحَدًا منهُم مِنْ حُكْمِ الصُّحبةِ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ ولا نَذْكُرُهُمْ إلا بِخَيرٍ هذا منْ حيثُ الإجمالُ أمَّا مِنْ حيثُ التفصيلُ فنَمْدَحُ ونَذُمُّ على حسَبِ ما يَقتضِيهِ الشرعُ وحُبُّهُمْ دِينٌ وإيمانٌ وإحْسانٌ وليسَ معناهُ أنه يُسَاوَى بينَ كُلِّ مَنْ ثَبَتَتْ لهُ الصُّحبةُ في المحبَّةِ والتعظيمِ والإجلالِ فذلكَ غيرُ المرادِ، وَبُغْضُهُمْ جميعًا كُفْرٌ ونِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ ولا يعني مِنْ ذلكَ أنَّ مَنْ أبغضَ واحِدًا يكونُ كافِرًا ولا سِيَّمَا إنْ كانَ بُغْضُهُ لبعضٍ لسببٍ شَرْعِيٍّ.
القول في الخلافة
وَنُثْبِتُ الخِلافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَوَّلاً لأَبي بَكْرٍ الصّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَفضِيلاً لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيع الأُمَّةِ ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أمَّا تفضيلُ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ على مَنْ بعدهما فبإجماعِ أهلِ الحقِّ، وأمَّا تفضيلُ عُثمانَ على عَلِيٍّ فهوَ ما عليهِ أكثرُ أهلِ السُّنَّةِ، فيُعْلَمُ منْ هذهِ العِبَارَةِ أنَّ أفضلَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عندَ اللهِ أبو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ وَهُمُ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالأَئِمَّةُ المُهْتَدُونَ وليس معناه حَصْرَ الخلافةِ الراشدةِ في الأربعةِ بَلِ الحسنُ بنُ عَلِيٍّ داخِلٌ في الخِلافةِ الراشدةِ وكذلكَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ يُسَمَّى خليفةً راشِدًا. وَإِنَّ العَشَرَةَ الذينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وَبَشَّرَهُمْ بِالجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالجَنَّةِ عَلَى مَا شَهدَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الحديثِ الذي رواهُ أبو داودَ وغيرُهُ وَقَولُهُ الحَقُّ وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ والزُّبَيرُ وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ وأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هذِهِ الأُمَّةِ أي أنه متمكن في صفة الأمانةِ وليسَ معناهُ لا يوجد غيرُهُ أمينٌ في الأمةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَمَنْ أَحْسَنَ القَوْلَ في أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِراتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ المقَدَّسِينَ المطهرين مِن كُلِّ رِجْسٍ وهو الشِّركُ فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ النِّفَاقِ.
القول في علماء السلف
وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الخَيرِ والأَثَرِ وَأَهْلُ الفِقْهِ وَالنَّظَرِ لا يُذْكَرُونَ إلاَّ بِالجَمِيلِ لأنهم ورثة الأنبياء ونقلة الشريعة، فهُم خُلفاءُ الرَّسولِ في تَبليغِ الشَّريعةِ إلى الناسِ فَوَجَبَ تَوقِيرُهُم وتَعظِيمُهُم واتِّباعُهُم، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيرِ السَّبِيلِ أي عدلَ عن سبيلِ الموالاةِ الدِّينيَّةِ، وذلكَ منْ علاماتِ النِّفاقِ والخِذلانِ، وذلكَ لأنَّهُم بصلاحِهِم صاروا أحبابَ اللهِ.
القول في تفضيل الأنبياء على الأولياء
ولا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الأَولِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَنَقُولُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَميعِ الأَوْلِيَاءِ وذلكَ لِقولِهِ تعالى: ﴿وَكُلاً فَضَّلْنَا عَلَى العَالَمِينَ﴾ (86) [سورة الأنعام] أي كلاًّ منَ الأنبياءِ الذينَ ذُكِرُوا فَضَّلْنَاهُ على العالَمِينَ وذلكَ مِنْ مَرْتَبَةِ النُّبُوَّةِ، ويُشاركُهُم في ذلكَ غيرُ المذكورِينَ لأنَّ الصِّفةَ التي فُضِّلُوا مِنْ أَجْلِها موجودةٌ في الجميعِ وهي النُّبُوَّةُ. وَنُؤمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ أي الأولياءُ وهُمُ المؤمنونَ المستقيمُونَ بطاعةِ اللهِ، والكرامةُ أمرٌ خارقٌ للعادةِ تَظهرُ على يَدِ الولي. وَنؤمن بما صَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ.
القول في أشراط الساعة
وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ الأشراطُ جمعُ شرطٍ بمعنى العلامةِ، ثمَّ الأشراطُ قِسمانِ: كُبرَى وهيَ عَشَرَةٌ، وما سِوَى ذلكَ يُقالُ لها الأشراطُ الصُّغْرَى. مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وهي أَوَّلُ هذهِ الأشراطِ الكبرى على ظاهرِ ما وردَ في مُسْلِمٍ، وَنُزُولِ عِيسى ابنِ مَرْيَمَ عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ السَّمَاءِ وهو مِنَ الأشراطِ الكُبْرَى. وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغرِبِهَا فقدْ جاءَ ذِكْرُهُ في البُخاريِّ ومُسْلِمٍ وَخُرُوجِ دَابَّةِ الأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا لأن النبي أخبر بِهذه الأشياء وهو صادق فيجب الإيمان بِما أخبر به.
القول في الكاهن والعراف
وَلا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وهو الذي يَتَعاطَى الإخبارَ عمَّا يَحْدُثُ في المستقبلِ اعتمادًا على صاحبٍ لهُ مِنَ الجِنِّ أوِ اعتمادًا على النَّجْمِ أوْ على مُقَدِّماتٍ وأسبابٍ اصْطَلَحُوا عليها وَلا عَرَّافًا وهوَ الذي يَتحدَّثُ عنِ الأُمورِ الخَفِيَّةِ مِمَّا حَصَلَ كالسَّرِقةِ والضَّائِعاتِ، فلا يجوزُ تصديقُ هذا ولا هذا وَلا نصدّق مَنْ يَدَّعِي شَيئًا يُخَالِفُ الكِتَابَ والسُّنَّةَ وَإجمَاعَ الأُمَّةِ وهوَ اتِّفاقُ المجتهدِينَ، لأن هذه الأدلة هي أصول الشرع.
القول في لزوم الجماعة
وَنَرَى الجَمَاعَة حَقًّا وَصَوَابًا يحتمل أن يكون مرادُهُ بالجماعةِ إجماع أهلِ الحقِّ في مسئلةٍ دِينيةٍ في الاعتقادِ أوِ الفروعِ ويَحتملُ أنْ يكونَ مرادُهُ بالجماعةِ طاعةَ الإمامِ الذي بَايَعَهُ المسلمُونَ، لأنَّ الخروجَ على الإمامِ الذي صَحَّتْ بَيْعَتُهُ منَ الكبائرِ والفُرْقَةَ وهي مخالفةَ الإجماعِ زَيْغًا وَعَذَابًا لأن مخالفة الإجماع زيغ أي ميل عن الطريق المستقيم وعذاب لأنه يوصل إلى العذاب وَدِينُ اللهِ في الأَرضِ والسَّمَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ دِينُ الإِسْلامِ أَيْ أنَّ الملائكةَ يَدِينونَ بالإسلامِ، وأنَّ المؤمنينَ مِنْ أهلِ الأرضِ مِنْ إنسٍ وجِنٍّ يَدِينونَ بالإسلامِ، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ﴾ (19) [سورة ءال عمران]، وقالَ تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾(3) [سورة المائدة] أيْ أنَّ الدِّينَ الصحيحَ المقبولَ عندَ اللهِ هوَ الإسلامُ وما سواهُ منَ الأديانِ باطلٌ، وَهُوَ أي دين الله بَيْنَ الغُلُوّ الذي هو مجاوزةُ الحدِّ الْمَجْعُولِ للعِبادِ في الدِّينِ والتَّقْصِيرِ الذي هوَ تَرْكُ الوُصولِ إلى حَدِّ المأمورِ، فدين الله متوسط بينهما وكلٌّ من الغلو والتقصير مذموم، وَبَينَ التَّشْبيهِ الذي هو تشبيهُ اللهِ بخلقِهِ وَالتَّعْطِيلِ الذي هو نَفْيُ وجودِ اللهِ أو صفاتِهِ وبَينَ الجَبْرِ الذي هو اعتقادُ أنَّ الإنسانَ لا فِعلَ لهُ والقَدَر الذي هو اعتقادُ أنَّ الإنسانَ يَخْلُقُ أفعالَهُ الاختياريةَ بقُدرةٍ خلقَهَا اللهُ فيهِ. وبينَ الأَمْنِ والإيَاسِ أي أنَّ الإسلامَ الذي هو دِينُ اللهِ هو أنْ يكونَ العبدُ بينَ الخوفِ والرَّجاءِ، فهوَ حقيقةُ العُبوديةِ.
فَهذا أي جميع ما ذكرنا من أول الكتاب إلى ها هنا دِينُنا وَاعتِقَادُنا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لأنه قد شهدت على صحة ما ذكرنا الأدلةُ المنقولة والبراهين المعقولة فيجب أن نعتقده ظاهرًا وباطنًا لأن المخالفة بين الظاهر والباطن من أوصاف المنافقين وهم في الدَّرْكِ الأسفل من النار وَنَحْنُ بُرَءَاءُ إلَى اللهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الذِي ذكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ لأن ما ذكره من أصول الدين من أول الكتاب إلى ءاخره وهو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين، ثابت بالمنقول والمعقول وهو الطريق الذي كان عليه النبي وأصحابه فيكون المخالف على مذهب أهل الهوى والبدعة فوجب التبري منه.
وَنَسأَلُ اللهَ تَعَالى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الإِيمانِ وَيَختِمَ لَنَا بِهِ وإنَّمَا سَأَلَ المؤلِّفُ الثَّباتَ على الدِّينِ لأنَّ ذلكَ مِنْ أَهَمِّ أُمورِ الدِّينِ، فالاعتبار بحسن الخاتمة وَيَعْصِمنَا مِنَ الأَهْوَاءِ المُخْتَلِفَةِ لأن أهل الأهواء المختلفة خالفوا الأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة الشرعية والعقلية وتعلقوا بأوهام وشبهات لا تصلح دليلاً بهوى أنفسهم وميلهم إلى الباطل والأهواءُ جمعُ هوى وهوَ الأمرُ الباطلُ الذي تَمِيلُ إليهِ النُّفوسُ ويعصمنا من الآراءِ المُتَفَرِّقَةِ وَالمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ مِثْلِ المُشَبهةِ والمُعتَزِلَةِ والجَهْمِيَّةِ وهيَ طائفةٌ منسوبةٌ إلى جَهْمِ بنِ صَفْوَانَ كانَ يقولُ: إنَّ اللهَ هوَ هذا الهواءُ معَ كُلِّ شىءٍ وعلى كُلِّ شىءٍ، وهو يقولُ بفناءِ الجنةِ والنارِ، وتَبِعَهُ ابنُ تَيمِيةَ الحَرَّانِيُّ في القَولِ بفناءِ النارِ والجَبْريَّةِ وَالقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ كالخوارج والمرجئة مِنَ الذينَ خَالفُوا السُّنَّةَ وَالجَمَاعَةَ وَحَالَفُوا الضَّلالَةَ. وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ هذا زيادةُ تأكيدٍ لِمَا تَقَدَّمَ. وَهُمْ عِندَنَا ضُلاَّلٌ وَأَرْدِياءٌ وَبِاللهِ العِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ أي الله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.
والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ خاتمِ الأنبياءِ والمرسلينَ، وعلى صحابتِهِ وأهلِ بيتِهِ الطاهرِينَ الطَّيِّبِينَ.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة