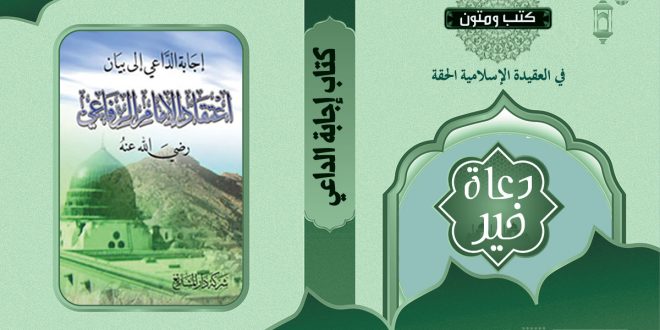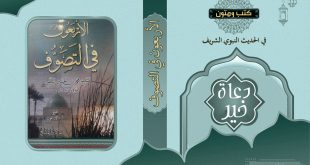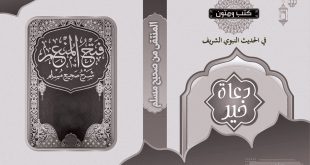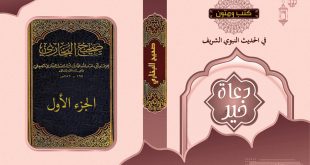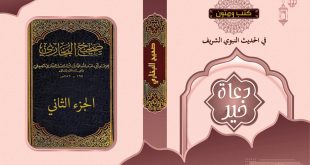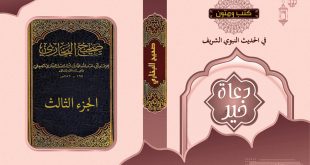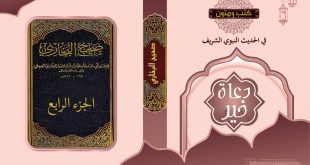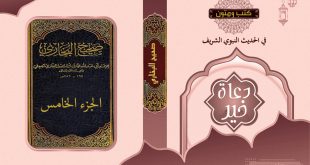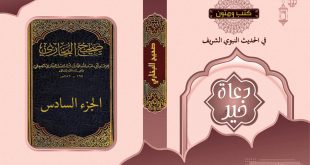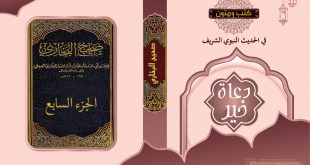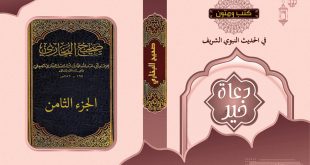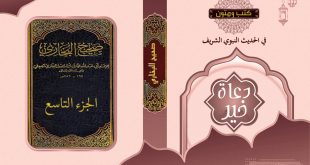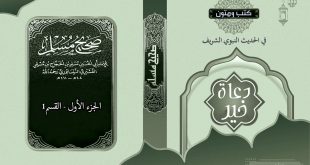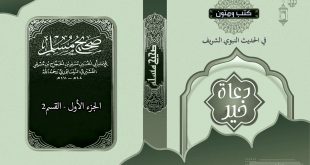بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمدُ للهِ العَزيزِ الجَبّارِ، خالِقِ الليلِ والنهارِ، وأشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عَبدُهُ ورَسولُهُ المختارُ، صلَّى اللهُ عليه وعلى ءالهِ وأصحابِهِ الأخيارِ، ما غابَتْ شمسٌ وطَلَعَ نَهار.
فَصلٌ في تَعريفِ التصوُّفِ وبَيانِ حالِ الصوفِيَّةِ
ليُعلَمْ أنَّ التصوفَ جَليلُ القَدرِ، عَظيمُ النفعِ، أنوارُهُ لامِعةٌ، وثِمارُهُ يانِعةٌ، فهوَ يُزكِّي النفسَ منَ الدَّنَسِ، ويُطهِّرُ الأنفاسَ من الأرجاسِ، ويوصِلُ الإنسانَ إلى مَرضاةِ الرَّحمنِ، وخُلاصتُهُ اتِّباعُ شَرعِ اللهِ، وتَسليمِ الأمورِ كلِّها للهِ، والالتِجاءُ في كلِّ الشئُونِ إليه مع الرضَى بالمقَدَّرِ، من غيرِ إهمالٍ في واجِبٍ ولا مُقاربَةٍ لمحظورٍ.
وقد اختُلِفَ في تَعريفِهِ فقيلَ: “التصوفُ الجدُّ في السلوكِ إلى مَلِكِ الملوكِ”، وقيلَ: “التصوفُ الموافقَةُ للحَقِّ”، وقيلَ: “إنما سمِّيتِ الصوفيةُ صوفيةً لصَفاءِ أسرارِها ونَقاءِ ءاثارِها”، وقالَ بِشرُ بنُ الحارِثِ: “الصوفِيُّ مَن صَفا قلبُهُ للهِ”.
وقد سُئِلَ الإمامُ أبو عَليٍ الروذباريُّ عن الصوفيِّ فقالَ: “مَن لَبِسَ الصوفَ على الصَّفا، وكانَتِ الدنْيا منه على القَفا، وسلَكَ مَنهاجَ المصطَفَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ”، وسئِلَ الإمامُ سهلُ بنُ عبدِ اللهِ التُّستَريُّ عن الصوفيِّ فأجابَ: “مَن صَفا عنِ الكَدَرِ، وامتَلأَ منَ الفِكرِ، واستَوَى عندَهُ الذهَبُ والمدَرُ”، وقالَ الشيخُ محمدُ ميّارّةُ المالِكيُّ في شرحِ المرشِدِ المعينِ: “وفي اشتِقاقِ التصوفِ أقوالٌ إذ حاصِلُهُ اتِّصافٌ بالمحامِدِ، وتَركٌ للأَوصافِ المذْمومَةِ، وقيلَ منَ الصَّفاءِ” اهـ.
وقيلَ غيرَ ذلك من الأقوالِ التي هي مَسطورةٌ في كتبِ القَومِ.
التصوف مبني على الكتاب والسنة
التصوَّفُ مَبنِيٌّ على الكتابِ والسنَّةِ كما قالَ سيِّدُ الطائِفَةِ الصوفيَّةِ الجُنَيدُ البَغدادِيُّ رضِيَ اللهُ عنه: “طريقُنا هذا مَضبوطٌ بالكِتابِ والسنَّةِ، إذ الطريقُ إلى اللهِ تَعالى مَسدودٌ على خَلقِهِ إلَّا على المقَتَفينَ ءاثارَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ” اهـ، وقالَ الشيخُ تاجُ الدينِ السُّبكيُّ: “ونَرَى أنَّ طريقَ الشيخِ الجُنيدِ وصَحبِهِ مقوَّمٌ”اهـ، وقالَ سَهلُ التُّستَريُّ رضِيَ اللهُ عنه: “أصولُ مَذهبِنا _ يَعني الصوفيَّةَ _ ثلاثةٌ: الاقتِداءُ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأخلاقِ والأفعالِ، والأكلُ منَ الحَلالِ، وإخلاصُ النيَّةِ في جميعِ الأفعالِ” اهـ، وقالَ الشيخُ أبو الحَسنِ الشاذِليِّ رضِيَ اللهُ عنه: “ليسَ هذا الطريقُ بالرهبانِيَّةِ ولا بأكلِ الشعيرِ والنخالَةِ، وإنَّما هو بالصبرِ على الأوامِرِ واليَقينِ في الهدايةِ قالَ تَعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [سورة السجدة/24] اهـ. وقالَ سيدُنا الإمامُ الكبيرُ أحمدُ الرفاعيُّ رضيَ اللهُ عنه للقُطبِ أبي إسحاقَ إبراهيمَ الأعزبِ رضيَ اللهُ عنه: “ما أخَذَ جدُّكَ طَريقًا للهِ إلَّا اتباعَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ مَن صحَّت صُحبتُهُ مع سِرِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّبعَ ءادابَهُ وأخلاقَهُ وشَريعتَهُ وسُنَّتَهُ، ومَن سقطَ من هذه الوجوهِ فقَد سلَكَ سبيلَ الهالِكين” اهـ، وقالَ أيضًا: “واعلَمْ أنَّ كلَّ طريقةٍ تخالفُ الشريعةَ فهيَ زَندقَةٌ” اهـ، وقالَ رضيَ اللهُ عنه أيضًا: “الصوفيُّ هو الفَقيهُ العاملُ بعِلمِه” اهـ.
وقد حكَى العارفُ باللهِ الشعرانيُّ في مقدمةِ كتابِهِ الطبقاتِ إجماعَ القومِ على أنَّه لا يصلحُ للتصدُّرِ في طريقِ الصوفيةِ إلَّا مَن تبحَّرَ في عِلمِ الشريعةِ وعلمِ مَنطوقِها ومَفهومِها وخاصِّها وعامِّها وناسِخِها ومَنسوخِها، وتبحَّرَ في لُغةِ العربِ حتى عرفَ مَجازاتِها واستِعاراتِها وغيرَ ذلك.
والحكمةُ في هذا الإجماعِ الذي حكاهُ الشعرانيُّ ظاهرةٌ لأنَّ الشخصَ إذا تصَدَّرَ للمَشيَخَةِ والإرشادِ اتخذَهُ المريدونَ قُدوةً لهم ومرجِعًا يرجعونَ إليه في مسائلِ دينِهِم، فإذا لم يكُنْ مُتقِنًا لعلمِ الشرعِ متَبحِّرًا فيه قد يُضِلُّ المريدينَ بفَتواهُ فيُحِلُّ لهم الحرامَ ويحرِّمُ عليهم الحلالَ وهو لا يشعرُ، أيضًا فإنَّ أغلبَ البِدعِ القَبيحةِ والخُرافاتِ إنما دخلَت في الطريقِ بسببِ كثيرٍ منَ المشايخِ الذين تصَدَّروا بغيرِ علمٍ ونصَّبوا أنفسَهُم للإرشادِ من غيرِ أن يكونوا مُستحقِّيَن لهذا المنصبِ الجليلِ، ولذلك تجِدُ الكثيرَ من المنتَسِبينَ إلى التصوفِ اليومَ وإلى طرقِ أهلِهِ قد أعماهُم الجهلَ فيظنّونَ أنَّهم بمجردِ أخذِهِم لطريقةٍ صوفيةٍ معينةٍ يرتَقونَ إلى أعالي الدرجاتِ، وبمجردِ قراءتِهِم للأورادِ يَصلونَ إلى مَقامِ الإرشادِ، وفي نفسِ الوقتِ يُهمِلونَ تعلُّمَ العلومِ الشرعيةِ الضروريةِ وتطبيقَها، فيتَخبَّطونَ في الجهلِ والفسادِ وهم يَحسَبونَ أنهم يُحسِنونَ صُنعًا، ويُدخِلونَ في طريقِ القومِ البدعَ الفاسدةَ والفَتاوى الشاذَّةَ والأقوالَ الضالَّةَ التي ما أنزلَ اللهُ بها من سُلطانٍ ويزعمونَ أنَّ هذا من الأسرارِ التي لا يَطلِعُ عليها إلا أهلُ الباطنِ ولا يفهَمُها أهلُ الشريعةِ الذين هم أهلُ الظاهرِ، وإذا قدَّمَ لهم شخصٌ نصيحةً يقولونَ: أنتُم أهلُ الظاهرِ ونحنُ أهلُ الباطنِ لا تَفهَمونَ هذا، فلذلك سمّاهُم أهلُ العلمِ والصوفيةُ الصادقونَ بالمتَصوِّفَةِ أي أدْعياءِ التصوفِ، ويكفِي في الردِّ عليهم قولُ الإمامِ الرفاعيِّ: “كلُّ طريقةٍ تخالفُ الشريعةَ فهي زَندقَةٌ”، وقالَ رضِيَ اللهُ عنه: “شَيِّدوا أركانَ هذه الطريقةِ المحمديةِ بإحياءِ السنَّةِ وإماتَةِ البِدعةِ” اهـ، وقالَ: “كلُّ الآدابِ مُنحصِرةٌ في مُتابعةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قولًا وفِعلًا وحالًا وخُلُقًا، فالصوفيُّ ءادابُهُ تدلُّ على مَقامِهِ، زِنوا أقوالَهُ وأفعالَهُ وأحوالَهُ وأخلاقَهُ بميزانِ الشرعِ” اهـ، وقال: “أيُّها الصوفيُّ لِمَ هذه البطالَة؟ صِرْ صوفِيًا حتى نقولَ لك: أيُّها الصوفيُّ” اهـ. وقال: “لا تقولوا كما يقولُ بعضُ المتصوفَةِ: نحنُ أهلُ الباطِنِ وهُم أهلُ الظاهِرِ، هذا الدينُ الجامِعُ باطنُهُ لُبُّ ظاهِرِهِ، وظاهِرُهُ ظَرفُ باطنِهِ لولا الظاهرُ لما بطنَ، لَولا الظاهرُ لما كانَ الباطنُ ولما صَحَّ، القلبُ لا يقومُ بِلا جسدٍ بل لولا الجسَدُ لفَسدَ، والقلبُ نورُ الجسدِ. هذا العلمُ الذي سماهُ بعضُهم بعلمِ الباطنِ هو إصلاحُ القلبِ” ثم قالَ: “فإذا تعيَّنَ لك أنَّ الباطنَ لُبُّ الظاهرِ والظاهرَ ظرفُ الباطنِ ولا فرقَ بينَهما ولا غَنًى لكِلَيهِما عن الآخَرِ، فقُلْ: نحنُ من أهلِ الظاهرِ وكأنَّك قلتَ ومن أهلِ الباطنِ. أيُّ حالةٍ باطنَةٍ للقَومِ لم يأمُرْ ظاهرُ الشرعِ بعَملِها؟ أيُّ حالةٍ ظاهرةٍ لم يأمُرْ ظاهرُ الشرعِ بإصلاحِ الباطنِ لَها” اهـ.
فعلَى ما ذكرَ يتبَيَّنُ أنَّ كلَّ بِدعةٍ تَراها في الطرقِ السائرةِ فلَكَ أن تَعرِضَ ما تراهُ وتسمَعُهُ فيها منَ البِدعِ القوليةِ أو الفعليةِ على قواعدِ الشرعِ فإن لم توافِقْهُ فانبُذْها، قالَ السيدُ أحمدُ الرفاعيُّ: “كلُّ حقيقةٍ ردَّتْها الشريعةُ فهيَ زَندقَةٌ، إذا رأيتُم شَخصًا تربَّعَ في الهواءِ فلا تلتَفِتوا إليه حتى تنظُروا حالَهُ عند الأمرِ والنهيِ” اهـ، أي يوزنُ أفعالُهُ وأقوالُهُ بميزانِ الشرعِ فإن لم يوافِقْها فيُترَكُ، وقال رضيَ اللهُ عنه: “سَلِّمْ للقَومِ أحوالَهم ما لَم يُخالِفوا الشرعَ، فإن خالَفوا الشرعَ فكُنْ مع الشرعِ” اهـ.
فصل في تحقيق معنى البدعة
البدعةُ مَعناها لُغةً: “ما أُحدِثَ على غيرِ مِثالٍ سابِقٍ”، وشَرعًا: “المحدَثُ الذي لم يَنُصَّ عليه القرءانُ الكريمُ ولا جاءَ في السنَّةِ المطهَّرةِ”.
وقد قسَّمَ العلماءُ البدعةَ إلى قِسمَينِ، رَوى البيهقيُّ في كتابِ مَناقبِ الشافعيِّ (1) بالإسنادِ المتصِلِ إلى الإمامِ الشافعيِّ رضيَ اللهُ عنه قالَ: “المحدَثاتُ منَ الأمورِ ضَربانِ، أحدُهما ما أُحدِثَ مما يخالِفُ كتابًا أو سُنَّةً أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه البدعةُ الضلالةُ، والثانيةُ: ما أحدِثَ من الخيرِ لا خِلافَ فيه لواحدٍ من هذا وهذه محدثةٌ غيرُ مَذمومَةٍ” اهـ.
قال النوويُّ في كتابِ تَهذيبِ الأسماءِ واللغاتِ (2) ما نصُّه: “البدعةُ بكَسرِ الباءِ في الشرعِ هي إحداثُ ما لم يكُنْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهي مُنقسِمةٌ إلى حسنةٍ وقبيحةٍ، قالَ الإمامُ الشيخُ المجمَعُ على إمامتِهِ وجلالَتِهِ وتمكُّنِهِ في أنواعِ العلومِ وبَراعتِهِ أبو محمدٍ عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ السلامِ رحمَهُ اللهُ ورضيَ عنه في ءاخرِ كتابِ القواعدِ: البدعةُ منقسِمةٌ إلى واجبةٍ، ومحرمةٍ، ومندوبةٍ، ومكروهةٍ، ومُباحةٍ، قال: والطريقُ في ذلك أن تُعرَضَ البدعةُ على قواعدِ الشريعةِ فإن دخَلَت في قواعدِ الإيجابِ فهي واجبةٌ، أو في قواعدِ التحريمِ فمحرمةٌ، أو الندبِ فمندوبةٌ، أو المكروهِ فمَكروهةٌ، أو المباحِ فمباحةٌ” اهـ، وقد ذكرَ هذا التقسيمَ عددٌ من العلماءِ والفقهاءِ من المذاهبِ الأربعةِ والمحدِّثينَ مِنهم الحافظُ ابنُ حجرٍ في فتحِ البارِي (3).
ويؤيِّدُ ما ذكَرنا ما رواهُ مسلمٌ في صحيحِهِ من حديثِ جريرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ رضيَ اللهُ عنه أنهُ قال: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: “مَن سَنَّ في الإسلامِ سنَّةً حسنةً فلَهُ أجرُها وأجرُ من عملَ بها بعدَه من غيرِ أن ينقُصَ من أجورِهِم شىءٌ، ومَن سَنَّ في الإسلامِ سُنةً سيئةً كان عليه وزرُها ووِزرُ مَن عمِلَ بها من بعدِهِ من غيرِ أن ينقصَ من أوزارِهِم شىءٌ”.
ومن البدعِ الحسنةِ الطرقُ التي أحدَثَها بعضُ الصالحينَ كالرفاعيةِ والقادريةِ وغيرِهِما من الطرقِ التي تبلغُ نحوَ أربعينَ طريقةً، وكلُّها طريقُها العملُ بالكتابِ والسنةِ، فهذهِ الطرقُ أصلُها بدعٌ حسنةٌ، ولكن شَذَّ بعضُ المنتسِبينَ إليها وهذا لا يَقدَحُ في أصلِها.
————-
(1) مناقب الشافعي 1/469.
(2) تهذيب الأسماء واللغات 3/22.
(3) فتح الباري 4/253.
التصوف مبني على الكتاب والسنة
لكونِ التصوفِ مَبنِيًّا على الكتابِ والسنةِ دخلَ فيه عظماءُ العلماءِ وانضَمَّ إلى زُمرةِ أهلِهِ فُحولٌ منَ الكُبراءِ كالحافظِ أبي نعيمٍ، والمحدثِ المؤرخِ أبي القاسِمِ النصراباذيِّ، وأبي عليٍ الروذباريِّ، وأبي العباسِ الدينوريِّ، وأبي حامدٍ الغزاليِّ، والقاضي بكارِ بنِ قُتيبةَ، والقاضِي رويمِ بنِ أحمدَ البغداديِّ، وأبي القاسمِ عبدِ الكريمِ بنِ هوازنَ القُشيريِّ الجامعِ بين الشريعةِ والحقيقةِ، والشيخِ الفقيهِ محمدِ بنِ خَفيفٍ الشيرازيِّ الشافعي، والحافظِ ذي المصنَّفاتِ في الحديثِ والرجالِ أبي الفضلِ محمدٍ المقدسيِّ، والشيخِ عزِّ الدينِ بنِ عبدِ السَّلامِ المالكيِّ، والحافظِ ابنِ الصلاحِ، والنوويِّ، وتقيِّ الدِّينِ السبكيِّ وابنِهِ تاجِ الدَّينِ السبكيِّ، وأبي الحسنِ الهكاريِّ، والفقيهِ نجمِ الدينِ الخبوشانيِّ الشافعيِّ، والفقيهِ المحققِ سراجِ الدينِ أبي حفصٍ عُمرَ المعروفِ بابنِ الملقنِ الشافعيِّ، والحافظِ جمالِ الدِّينِ محمدِ بنِ عليٍّ الصابونيِّ، والحافظِ شرفِ الدِّينِ أبي محمدٍ عبدِ المؤمنِ الدمياطيِّ، والحافظِ أبي طاهرٍ السّلفيِّ، والمسندِ المعمّرِ جمالِ الدِّينِ أبي المحاسِنِ يوسفَ الحنبليِّ، وقاضي القضاةِ شمسِ الدِّينِ أبي عبدِ اللهِ محمدٍ المقدسيِّ، والمفتِي شرفِ الدِّينِ أبي البركاتِ محمدٍ الجذاميِّ المالكيِّ، والإمامِ بهاءِ الدِّينِ أبي الحسنِ عليِّ بنِ أبي الفَضائلِ هبةَ اللهِ بنِ سلامةَ، والحافظِ أبي القاسمِ سليمانَ الطبرانيِّ صاحبِ المعاجِمِ المعروفةِ، والمفتِي جمالِ الدِّينِ محمدٍ المعروفِ بابنِ النقيبِ، وقاضِي القضاةِ الشيخِ عزِّ الدِّينِ عبدِ العزيزِ، ووالدِهِ قاضِي القضاةِ بدرِ الدِّينِ أبي عبدِ اللهِ محمدِ، ووالدِهِ شيخِ الإسلامِ برهانِ الدِّينِ ابراهيمَ بنِ سعدِ بنِ جماعةَ الكنانيِّ الشافعيِّ، والشيخِ أبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ الفراتِ، وقاضِي القضاةِ تقيِّ الدِّينِ أبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ الحُسينِ بنِ رزينَ الحَمويِّ الشافعيِّ، وشيخِ الإسلامِ صدرِ الدِّينِ أبي الحسنِ محمدِ، وشيخِ شيوخِ عصرِهِ عمادِ الدِّينِ أبي الفتحِ عمرَ، وشيخِ الإسلامِ مُعينِ الدِّينِ أبي عبدِ اللهِ محمدِ، والشيخِ المفسرِ النحويِّ أبي حيانَ الأندلُسيِّ، وقطبِ الدِّينِ القسطلانيِّ المشهورِ، والمفسرِ كمالِ الدِّينِ ابنِ النقيبِ، والحافظِ أبي موسَى المدينيِّ، والعلامةِ نجمِ الدِّينِ أبي النعمانِ بشيرِ بنِ أبي بكرٍ حامدٍ الجعبريِّ التبريزيِّ، والحافظِ جلالِ الدِّينِ السيوطيِّ، والشيخِ عبدِ الواحدِ بنِ عاشرٍ الأنصاريِّ المالكيِّ، والعلامةِ المحققِ الشيخِ أحمدَ بنِ المباركِ اللمطيِّ، وغيرِهِم خلقٌ كثيرٌ مما تضيقُ عن ذكرِهِم هذه الأسطرُ، فلا تجدُ عالِمًا كبيرًا ومُحققًا شهيرًا إلا ودخلَ في طريقِ القومِ والتمسَ بركتَهُم ونالَ الحظوةَ بسببِ الانتِسابِ إليهم، فمَن قرأَ تراجِمَ العلماءِ والمحدثينَ وتتبَّعَ سيرتَهُم واستَقصَى أخبارَهم أدركَ ذلك، ومَن أنكرَ ذلك فهو جاهلٌ مُتعنِّتٌ لا اعتدادَ بهِ ولا عبرةَ بما يقولُ.
ويكفِي في بيانِ فضلِ الصوفيةِ ما ذُكرَ عن الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ رضيَ اللهُ عنه أنه كانَ يقولُ لأبي حمزةَ الصوفيِّ: “ماذا تقولُ يا صوفيُّ” اهـ، فالصوفيُّ عند مَن يعرفُهُ هو العاملُ بالكتابِ والسنَّةِ يؤدِّي الواجباتِ ويجتنبُ المحرماتِ ويتركُ التنعُّمَ في المأكلِ والملبَسِ ونحوِ ذلك، فهذه الصفةُ في الحقيقةِ صفةُ الخلفاءِ الأربعةِ، فلذلك صنَّفَ الحافظُ أبو نعيمٍ كتابَهُ الضخمَ المسمَّى حِليَةَ الأولياءِ أرادَ به أن يميزَ الصوفيَّةَ المحققينَ من غيرِهِم لْمَّا كثُرَ في زمانِهِ الطعنُ من بعضِ الناسِ في الصوفيةِ، ودَعوَى التصوفِ مِن طائفةٍ أخرى هم خلافُ الصوفيةِ في المعنَى، فبَدأَ بذكرِ الخلفاءِ الأربعةِ، وقد صنَّفَ خلقٌ كثيرٌ منَ العلماءِ كُتبًا في هذا الشأنِ منها طبقاتُ الصوفيةِ للمحدِّثِ الحافظِ أبي عبدِ الرَّحمنِ محمدِ السلميِّ النيسابوريِّ، وطبقاتُ الصوفيةِ للحافظِ البارعِ أبي سعيدٍ النقاشِ الحنبليِّ، وطبقاتُ الصوفيةِ للحكيمِ الترمذيِّ، وطبقاتُ الصوفيةِ للحافظِ ابنِ الملقنِ الشافعيِّ وكل هؤلاءِ من أهلِ الحديثِ.
وقد أكثَرَ الحافظُ البيهقيُّ الروايةَ عن شيخِهِ أبي عليٍ الروذباريِّ أحدِ مَشاهيرِ الصوفيةِ الذي كانَ تلميذَ الجنيدِ رضيَ اللهُ عنه. قال الشيخُ منصورٌ البُهوتيُّ الحنبليُّ في كتابِهِ كشافِ القناعِ ما نصُّه: “ونقلَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ القلانسيُّ أنَّ الإمامَ أحمدَ قال عن الصوفيةِ _ أي الصادِقينَ _: لا أعلمُ أقوامًا أفضلَ مِنهم، قيلَ: إنهم يستمعونَ ويتَواجَدونَ، قال: دعوهُم يفرحونَ مع اللهِ ساعةً، قيل: فمِنهم من يموتُ ومنهم من يُغشَى عليه فقال: وبَدا لهُم منَ اللهِ ما لم يَكونوا يحتَسِبونَ ولعلَّ مرادَهُ سماعُ القرءانِ، وعذرهم لقوةِ الواردِ، قالَهُ في الفروعِ” اهـ. وصاحبُ الفروعِ هو شمسُ الدِّينِ بنُ مفلحٍ الحنبلِيُّ.
فيتَبينَ من هذا كلِّهِ أنَّ طرقَ أهلِ اللهِ كالرفاعيةِ والقادريةِ وسائرِ الطرقِ المستقيمةِ أُسِّسَتْ على وفقِ القرءانِ الكريمِ والحديثِ الشريفِ.
فصل في بيان فضل الطريقة الرفاعية
ليُعلمْ أنَّ الطريقةَ الرفاعيةَ هي أفضلُ الطرقِ، فهي كسائرِ الطرقِ الصحيحةِ تأمُرُ بالتمسُّكِ بالشريعةِ الإسلاميةِ وإصلاحِ الباطنِ ونبذِ البِدعِ السيئةِ، وللرفاعيةِ مزيةٌ على البقيةِ بمزيدِ تمَسُّكٍ بما ذكَرنا، فقد كانَ شيخُ هذه الطريقةِ الإمامُ أحمدُ الرفاعيُّ فقيهًا محدِّثًا شافعِيًا مُفسرًا أثنَى عليه الإمامُ أبو القاسمِ عبدُ الكريمِ الرافعيُّ إمامُ الشافعيةِ المعروفُ بِوفورِ العلمِ والزهدِ والكرامةِ، وغيرُهُ كالحافظِ السيوطِيِّ والديرينيِّ وغيرِهِم خلقٌ كثيرٌ. وقد ذكرَ الشيخُ عبدُ الوهابِ الشعرانيُّ أنَّ المشايخَ من أهلِ عَصرِهِ _ يعني الرفاعيَّ _ أجمَعوا على أنَّه أجلُّ المشايخِ قدرًا، ويقولُ الإمامُ الرافعيُّ: “وانتهَت إليه الرياسةُ في علومِ الشريعةِ وفنونِ القَومِ وخدمةِ الأئمةِ والفقهاءِ والملوكِ والخلفاءِ، وانعقدَ عليه إجماعُ الطوائفِ وقالَ بتقدُّمِهِ على جميعِ رجالِ عصرِهِ الموافقِ والمخالفِ” اهـ.
ومَن طالعَ كتبَ الإمامِ الرفاعيِّ رضيَ اللهُ عنه وجدَها مليئةً بالحَثِّ على التمسُّكِ بالشريعةِ والحضِّ على تعلمِ العلومِ الشرعيةِ، قال رضِيَ اللهُ عنه في كتابِهِ البرهانِ المؤيَّد: “أيْ سادَة عَظِّموا شأنَ الفقهاءِ والعلماءِ كتعظيمِ شأنِ الأولياءِ والعُرفاءِ فإنَّ الطريقَ واحدٌ، وهؤلاءِ وارِثُو ظاهرِ الشريعةِ وحملةُ أحكامِها الذين يعلِّمونَها للناسِ وبها يصِلُ الواصِلونَ إلى اللهِ، إذ لا فائدةَ بالسعيِ والعملِ على الطريقِ المغايرِ للشرعِ” اهـ. وقالَ: “أيْ سادَة تقولونَ قالَ الحارثُ، قالَ أبو يزيد، قال الحلّاجُ، ما هذا الحالُ قبل هذه الكلماتِ؟ قولوا: قالَ الشافعيُّ، قال مالكٌ، قال أحمدُ، قال نُعمانُ”، “شيِّدوا دَعائمَ الشريعةِ بالعلمِ والعملِ”، “أشياخُ الطريقةِ وفرسانُ مَيادينَ الحقيقةِ يقولونَ لكُم: خُذوا بأذيالِ العلماءِ”، “لا تَقطَعوا الوصلَةَ مع العلماءِ جالِسوهُم، خُذوا عنهم”، “اجعَلوا الأمرَ بالمعروفِ والنهيَّ عن المنكرِ دينَكُم”، “أيْ سادَة إنَّ نهايةَ طريقِ الصوفيةِ نهايةُ طريقِ الفقهاءِ، ونهايةَ طريقِ الفقهاءِ نهايةُ طريقِ الصوفيةِ”، “والطريقةُ هي الشريعةُ والشريعةُ هي الطريقةُ والفرقُ بينَهما لفظِيٌّ”، “وما أرَى الصوفيَّ إذا أنكَرَ حالَ الفقيهِ إلا ممكورًا، ولا الفقيهَ إذا أنكرَ حالَ الصوفيِّ إلا مَبعودًا”.
ومن مَزايا هذه الطريقةِ أيضًا مكافحةُ عقيدةِ الوحدةِ وعقيدةِ الحلولِ أكثر من غيرِها من الطرقِ، وقد أخذَ أهلُها ذلك عن شيخِ الطريقةِ الإمامِ الرفاعيِّ ثم اتَّبعَهُ كلُّ خلفاءِ طريقتِهِ إلى هذا العصرِ فلهُم بذلك فضلٌ على غيرِهِم، رَوى الإمامُ الحافظُ أبو القاسمِ الرافعيُّ رحمَهُ اللهُ عن الإمامِ الرفاعيِّ أنه قالَ: “لفظَتانِ ثُلمَتانِ بالدِّينِ، القولُ بالوحدةِ، والشطحُ المجاوزُ حَدَّ التحدثِ بالنعمةِ” اهـ، وقالَ أيضًا: “إيّاكَ والقولَ بالوحدةِ التي خاضَ بها بعضُ المتصوفةِ، إيّاكَ والشطحَ فإنَّ الحجابَ بالذنوبِ أولَى منَ الحجابِ بالكُفرِ ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [سورة النساء/48] اهـ.
وقالَ أحدُ خُلفائِهِ ممن كانَ في القرنِ الثالثَ عشرَ للهجرةِ ما نصُّه: “وحيثُ إنَّ القولَ بالوحدةِ المطلقةِ والحلولِ يؤدِّي إلى الكفرِ والعياذُ باللهِ تَعالى، والشطحاتِ والدَّعاوَى العريضةِ تؤدِّي إلى الفتنةِ وتُزلِقُ بقَدَمِ الرجلِ إلى النارِ فاجتِنابُها واجبٌ وتركُها ضربةُ لازِبٍ، وكل ذلك من طريقِ شيخِنا الإمامِ السيدِ أحمدَ الرفاعيِّ الحسينيِّ رضيَ اللهُ عنهُ وعنّا بِه، وبهذا أمرَ أتباعَهُ وأشياعَهُ، وحَثَّ على ذلك أصحابَهُ وأحزابَه” اهـ.
ومن مَزايا هذه الطريقةِ محاربةُ ومجانبةُ البدَعِ والمحدَثاتِ المذمومةِ في الدِّينِ، قال الإمامُ الرفاعيُّ فيما نقلَهُ الإمامُ الرافعيُّ عنه: “قد ءانَ أوانُ زوالِ هذه المجالسِ ألا فليُخبِرِ الحاضرُ الغائِبَ: مَنِ ابتدَعَ في الطريقِ وأحدثَ في الدينِ وقالَ بالوحدةِ، وكذَبَ مُتعالِيًا على الخلقِ، وشطَحَ مُتكلفًا، وتفكَّهَ بما نقلَ عن القومِ من الكلماتِ المجهولةِ لَدينا، وطابَ كاذِبًا، أو خَلا بامرأةٍ أجنبيةٍ بِلا حُجةٍ شرعيةٍ، وطمحَ نظرُهُ لأعراضِ المسلمينَ وأموالِهِم، وفرَّقَ بين الأولياءِ، وأبغَضَ مُسلمًا بلا وجهٍ شرعيٍ، وأعانَ ظالِمًا، وخذلَ مظلومًا، وكذَّبَ صادقًا، وصدَّقَ كاذبًا، وعملَ بأعمالِ السفهاءِ وقالَ بأقوالِهِم، فليسَ منِّي أنا بَرىءٌ منه في الدنْيا والآخرةِ” اهـ.
وقد اشتَهرَ أتباعُ الشيخِ أحمدَ الرفاعيِّ رضيَ اللهُ عنه بدُخولِ الأفرانِ الحامِيَةِ، ورقودِ بعضِهم في بعضِ جوانبِ الفُرنِ والخبازُ يخبزُ في الجانبِ الآخرِ، ودخولِهِم النارَ العظيمةَ ونحوِ ذلك وكلُّ ذلك يدُلُّ على عظيمِ فضلِ الإمامِ السيدِ أحمدَ الرفاعيِّ رضيَ اللهُ عنه، قالَ الشيخُ السيدُ أبو الهدَى الصياديُّ رحمَهُ اللهُ في كتابِهِ الطريقةِ الرفاعيةِ ما نصُّه: “توفيَ رضيَ اللهُ عنه في أمِّ عَبيدةَ بواسِطِ العراقِ سنةَ ثمانٍ وسبعينَ وخمسمائةٍ راضيًا مَرضِيًا نائبًا نبويّا، وقد جدَّدَ اللهُ به أمرَ الدينِ وأيَّدَ بمِنهاجِهِ مذهَبَ أهلِ الشرعِ المبينِ، وصانَ ببركةِ عزمِهِ وعزيمتِهِ في اللهِ عقائدَ المسلمينَ، وأبرَدَ لأتباعِهِ النيرانَ، وأزالَ لهم فاعليةَ السمومِ، وألانَ لهم الحديدَ، وأذلَّ لهم السباعَ والحيّاتِ والأفاعِي، وأخضعَ لهم طُغاةَ الجِنِّ” اهـ. قالَ المؤرخُ ابنُ خلكان: “ولأتباعِهِ أحوالٌ عجيبةٌ من أكلِ الحيّاتِ وهي حية والنزولِ في التنانِيرِ وهي تتضرمُ بالنارِ فيُطفِئونَها” اهـ. ومن الشاهدِ على ذلك ما جرَى بين الشيخِ تاجِ الدِّينِ الرفاعيِّ أحدِ المشايخِ العارِفينَ وبين هولاكو إذ دخلَ الشيخُ المذكورُ النارَ العظيمةَ هو ومُريدوهُ وما أصابَهم أذًى، وتكرَّرَتِ الحادثةُ مع ابنِ هولاكو الذي أسلَمَ وهو السلطانُ أحمدُ، وهذه القصةُ مشهورةٌ ذكرَها بعضُ المؤرخينَ منهُم الشيخُ كمالُ الدِّينِ محمدُ بنُ عليٍ السراجُ الرفاعيُّ القرشيُّ الشافعيُّ في كتابِهِ “تُفاحُ الأرواحِ”.
ومن مَزايا هذه الطريقةِ الحثُّ على التخلُّقِ بالأخلاقِ الكريمةِ والمزايا الحسنةِ، وقد اشتهرَ مشايخُ هذه الطريقةِ بمزيدِ التواضُعِ والانكِسارِ عن غيرِهِم من أهلِ الطرقِ، وهذا شأنُ شيخِ الطريقةِ الإمامِ الرفاعيِّ حيثُ يذكرُ أنهُ طرقَ كلَّ الأبوابِ فرأى على الكلِّ ازدِحامًا عظيمًا فجاءَ من بابِ الذلِّ والانكِسارِ فرءاهُ خالِيًا فعكَفَ عليه، وله كلمةٌ مشهورةٌ وهي: “رجالُ هذه الطائفةِ خيرٌ منِّي، أنا حميدُ اللاشِ، أنا اللاشُ اللاشُ” اهـ.
وقد وصفَهُ الإمامُ الرافعيُّ بقولِه: ” كانَ رضيَ اللهُ عنه مُتمكِّنًا في الدِّينِ سهلًا على المسلمينَ، صعبًا على الضالِّين، هَينًا لَينًا هَشًّا بَشًّا، لينَ العَريكةِ، حسنَ الخَلقِ، كريمَ الخُلقِ، حُلوَ المكالمةِ، لطيفَ المعاشرةِ، لا يملُّهُ جليسُهُ، ولا ينصرفُ عن مجالِسِهِ إلا لعبادَةٍ، حَمولًا للأذَى، وَفيًّا إذا عاهدَ، صَبورًا على المكارِهِ، جَوادًا من غيرِ إسرافٍ، مُتواضعًا” اهـ.
هؤلاءِ هُم الرفاعيةُ فمَن عرَفَهم عَرفهُم، ومَن جَهِلَهُم فليراجِعْ كتبَ الإمامِ الرفاعيِّ ومناقبَ خلفائِهِ وسيرَتَهُم، فإنَّهم أهلُ علمٍ ودينٍ، نفَعَنا اللهُ بهِم. وقد ذكرَ الحافظُ ابنُ الملقِنِ الشافعيُّ (1) في أواخرِ كتابِهِ طبقاتِ الأولياءِ قصيدةً في مدحِ الرفاعيةِ فقال:
إنَّ الرفاعيينَ أصحابَ الوَفا ***** والجودِ للعافي الملمِ المزملي
كَم فيهم مِن عارِفٍ ذِي همَّة ***** أو صادِقٍ عن عزمِهِ لم يفشَل
————-
(1) وهو مؤلفُ الكتابِ المشهورِ “البدرِ المنيرِ في تخريجِ أحاديثِ الشرحِ الكَبير”.
ترجمة الإمام الرفاعي (1) رضي الله عنه
اسمُهُ ونسَبُهُ:
هو الإمامُ العارفُ باللهِ الفَقيهُ الشافعيُّ الأشعريُّ الشيخُ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ يَحيى نقيب البَصرةِ المهاجِر من المغربِ ابنِ السيدِ ثابتِ بنِ الحازمِ وهو عليٌّ أبو الفوارسِ ابنُ السيدِ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ الحسنِ رفاعَةَ الهاشميِّ المكيِّ ابنِ السيدِ المهديِّ بنِ أبي القاسمِ محمدِ بنِ الحسنِ رئيسِ بغدادَ ابنِ السيدِ الحسينِ الرضِي ابنِ السيدِ أحمدَ الأكبرِ بنِ موسى الثاني بنِ إبراهيمَ المرتَضَى ابنِ الإمامِ موسَى الكاظِمِ ابنِ الإمامِ جعفرٍ الصادقِ ابنِ الإمامِ محمدٍ الباقِرِ ابنِ الإمامِ زينِ العابِدينَ عليٍّ الأصغرِ ابنِ الإمامِ الشهيدِ الحُسينِ ابنِ الإمامِ أميرِ المؤمنينَ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضيَ اللهُ عنه وعنهُم أجمَعين.
أما نسبُهُ لأمِّهِ فإنَّه يتصِلُ بالصحابيِّ الجليلِ أبي أيوبَ الأنصاريِّ، وأما نسَبُ أمِّهِ لأمِّها فإنهُ يتصِلُ بالسيدِ الإمامِ الحسينِ رضِيَ اللهُ عنه، قالَ الشيخُ الإمامُ عبدُ الكريمِ الرافعيُّ في سوادِ العَينين:
نسب قلادته الفخيمة ***** حتى الرسول فرائد وعصائم
وقالَ الشيخُ أحمدُ بنُ جلالٍ اللاريُّ في جلاءِ الصدَى:
نسب توارث كابر عن كابر ***** كالرمح أنبوب على أنبوب
وقد تشرَّفَ بذكرِ نسبِهِ الطاهرِ جَمٌّ غَفيرٌ من الأكابرِ ورصَّعوا بذكرِ سيادَتِهِ صفائحَ الدفاتِرِ، وأفرَدَ لنسبِهِ الشريفِ جمعٌ كبيرٌ منَ المشايخِ، وزيَّنَ بعضُهُم كتبَهُ بذِكرِ نسَبِهِ مِنهم: الشيخُ برهانُ الدِّينِ عليٌّ الحلبيُّ القاهريُّ صاحبُ السيرةِ النبويةِ، والحافظُ الزبيديُّ، والشيخُ عبدُ العزيزِ الديرينيُّ، والشريفُ النسّابَةُ نقيبُ النقباءِ شرفُ الدِّينِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحسينيُّ في مشكاةِ الأنوارِ، والنسابةُ ابنُ الأعرجِ الحسينيُّ في بحرِ الأنسابِ، والنسابةُ ابنُ ميمون نظامُ الدِّينِ الواسطيُّ في مشجرِهِ، والعلامةُ محمدُ الموصليُّ وغيرُهم خلقٌ كثيرٌ.
مولِدُهُ ونَشأتُهُ:
قَدِمَ أبوهُ العراقَ وسكنَ البطائحَ بقريةٍ اسمُها أمُّ عبيدَةَ، فتزوجَ بفاطمةَ أختِ القطبِ الشيخِ منصورٍ البطائحيِّ الزاهدِ ورُزِقَ منها أولادًا أعظمُهم قدرًا وأرفعُهُم ذِكرًا السيدُ أحمدُ الرفاعيُّ الكبيرُ.
ولِدَ رضِيَ اللهُ عنهُ في المحرَّمِ سنَةَ اثنَتَي عشرةَ وخمسمائةٍ ونشَأ في حِجرِ خالِهِ فأدَّبَهُ وهذَّبَهُ، وتلقَّى عن خالِهِ الطريقةَ وعِلمَ التصوُّفِ ولبسَ خِرقته وأخذَ عنه علومَ الشريعةِ، وتفَقَّهَ على الشيخِ أبي الفَضلِ عليٍّ الواسطيِّ المعروفِ بابنِ القارِي، وعن جماعةٍ من أعيانِ الواسِطيينَ منهم خالُهُ الصوفيُّ الشيخُ أبو بكرٍ الواسطيُّ شقيقُ الشيخِ منصورٍ المذكور. وانتَهت إليه الرياسةُ في علومِ الشريعةِ وفنونِ القومِ وانعقدَ عليه اجماعُ الطوائفِ، واعترفَ رجالُ وقتِهِ بعلُوِّ قدمِهِ ورفعةِ مَرتبَتِه.
ثناءُ العلماءِ علَيه:
أثنَى عليه الكثيرُ منَ العلماءِ والفقهاءِ والمحدِّثينَ، وأفرِدَتِ التآليفُ في ذكرِ مَناقبِهِ، وممَّن أثنَى عليه القاضِي أبو شجاعٍ الشافعيُّ صاحبُ المتنِ المشهورِ في الفِقهِ الشافعيِّ، فقد ذكَرَ الإمامُ الرافعيُّ ما نصُّه: “حدَّثَني الشيخُ الإمامُ أبو شجاعٍ الشافعيُّ فيما رواهُ قائِلًا: كانَ السيدُ أحمدُ الرفاعيُّ رضيَ اللهُ عنه عَلَمًا شامِخًا، وجبلًا راسِخًا، وعالِمًا جليلًا، محدِّثًا فَقيهًا، مُفسِّرًا ذا رواياتٍ عالياتٍ، وإجازاتٍ رَفيعاتٍ، قارئًا مُجَوِّدًا، حافِظًا مُجيدًا، حجةً رحلةً، مُتمَكنًا في الدينِ” إلى أن قالَ: “أعلمُ أهلِ عصرِهِ بكتابِ اللهِ وسنَّةِ رسولِهِ، وأعملُهُم بِها، بَحرًا من بحارِ الشرعِ، سَيفًا من سيوفِ اللهِ، وارِثًا أخلاقَ جدِّهِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ” اهـ.
وقالَ الشيخُ المؤرخُ أبو الحسنِ المعروفُ بابنِ الأثيرِ:
“وكانَ صالحًا ذا قَبولٍ عظيمٍ عند الناسِ، وعندَهُ من التلامذةِ ما لا يُحصَى” اهـ، ووصفَهُ المؤرخُ الفقيهُ صلاحُ الدينِ الصفدِيُّ بالزاهدِ الكبيرِ سلطانِ العارفينَ في زمانِه.
أما الذهبيُّ فقد افتَتحَ ترجمتَهُ بقولِه: “الإمامُ القُدوةُ العابدُ الزاهدُ، شيخُ العارِفينَ” اهـ وترجمَهُ ترجمةً حافلةً في تاريخِهِ، ووصفَهُ الإمامُ الجليلُ شافعيُّ عصرِهِ عبدُ الكريمِ الرافعيُّ بالشيخِ الأكملِ والغوثِ المبَجَّلِ، وقالَ الشيخُ المحدِّثُ الجليلُ عبدُ السميعِ الهاشميُّ الواسِطيُّ: “كان السيدُ أحمدُ ءايةً من ءاياتِ اللهِ” اهـ، وقال فيه شيخُهُ الشيخُ منصورٍ البَطائحِيُّ: “وزَنتُهُ بجميعِ أصحابِي وبي أيضًا فرجَحَنا جَميعًا” اهـ، وقال فيه العلَّامةُ الفقيهُ اللغويُّ صاحبُ القاموسِ المحيطِ:
أبا العَلمَينِ أنتَ الفردُ لكِن ***** إذا حُسِبَ الرجالُ فأنتَ حِزب
وقد بشَّرَ به قبلَ ولادَتِهِ أكابرُ الأولياءِ منهم الشيخُ الكبيرُ تاجُ العارفينَ أبو الوَفا، والشيخُ نَصرُ الهمامانيُّ، والشيخُ أحمدُ بنُ خميسٍ، والشيخُ أبو بكرٍ النجاريُّ الأنصاريُّ، والشيخُ منصورٌ البطائحيُّ وغيرُهم خلقٌ كثيرٌ.
وقد وصفَهُ المؤرخُ ابنُ خَلكانَ بقولِه: “كان رجُلًا صالحًا، فَقيهًا شافعيَ المذهَبِ” اهـ، وقال فيه المؤرخُ ابنُ العِمادِ: “الشيخُ الزاهدُ القُدوةُ” اهـ، وذكرَهُ ابنُ قاضِي شَهبةَ في طبقاتِ الشافعيةِ وعدَّهُ من فُقهائِهِم، وأدخَلَهُ كذلك الإمامُ الحجةُ المفسِّرُ الحافظُ المؤرخُ تاجُ الدينِ السبكِيُّ في عدادِ الفُقهاءِ الشافعيةِ فذَكرَهُ في طبقاتِ الشافعيةِ ووصفَهُ بقولِه: “الشيخُ الزاهِدُ الكبيرُ أحدُ أولياءِ اللهِ العارِفينَ والساداتِ المشمِّرينَ أهلِ الكراماتِ الباهِرات”. وممن أثنَى عليه أيضًا الشيخُ الوليُّ الكبيرُ الإمامُ الغوثُ عبدُ القادرِ الجِيلانيُّ رضيَ اللهُ عنه. وقال الشيخُ عبدُ الوهابِ الشعرانيُّ: “هو الغوثُ الأكبرُ والقُطبُ الأشهرُ أحدُ أركانِ الطريقِ وأئمةِ العارِفينَ الذين اجتمَعَتِ الأمَّةُ على إمامَتِهِم واعتِقادِهِم” اهـ.
تلاميذُهُ:
تخرَّجَ على يدَيهِ رضيَ اللهُ عنه الآلافٌ منَ التلامذةِ، وسلكَ عليه العديدُ من العلماءِ والفقهاءِ والمحدِّثينَ فانتَفعَ به خلقٌ كثيرٌ ولا نستَطيعُ إحصاءَهُم في هذه الورقاتِ فمَن منَّا يستطيعُ إحصاءَ النجومِ، وقد اتفَقَ المؤرخونَ ورجالُ الطبقاتِ وأصحابُ كتبِ الرقائقِ على ذلك. وممن تخرجَ على يدَيهِ الشيخُ الفقيهُ الشافعيُّ أبو شُجاعٍ صاحبُ المتنِ المشهورِ في الفِقهِ الشافعيِّ، والإمامُ المعمّرُ محمدُ بنُ عبدِ السميعِ الهاشميُّ الواسطيُّ، والشيخُ الحجةُ عمرُ أبو الفرجِ عزُّ الدينِ الفاروثيُّ الواسطيُّ، والفقيهُ بقيةُ الصالحينَ أبو زكريّا يحيى بنُ يوسفَ العسقلانيُّ الحنبليُّ، والإمامُ الكبيرُ أبو الفتحِ الواسِطيُّ، والشيخُ العارفُ أبو المعالي بدرٌ العاقوليُّ، والشيخُ الكبيرُ حسنُ القَطَنانيُّ المعروفُ بالشيخِ حسنِ الراعِي، والإمامُ الجليلُ جمالُ الدينِ الخطيبُ، والشيخُ الوليُّ الكبيرُ إبراهيمُ الأعزبُ الرفاعيُّ، والشيخُ يعقوبُ الكرازُ الواسطيُّ، والإمامُ العارفُ باللهِ حياةُ بنُ قيسٍ الحرانيُّ، والشيخُ العارفُ باللهِ إبراهيمُ بنُ محمدٍ بنِ إبراهيمَ الكازرونيُّ صاحبُ شِفاءِ الأسقامِ، والشيخُ الحجةُ عمادُ الدينِ الزَّنجيُّ، والشيخُ الفقيهُ عبدُ المحسنِ الواسِطيُّ ابنُ شيخِه عليٍّ الواسطيٍّ، والشيخُ تقيُّ الدينِ الواسطيُّ، والشيخُ صالحُ بنُ بكرانَ، والشيخُ منصورٌ البطائحيُّ الصغيرُ، والشيخُ جعفرُ الخزاعيُّ المغربيُّ، والشيخُ الوليُّ الشهيرُ سعدٌ البرزبانيُّ، والشيخُ أبو بكرٍ خطيبُ السعديةِ العلَّامةُ الشهيرُ، والشيخُ عليُّ بنُ نعيمٍ المشهور، والشيخُ عمرُ الهرويُّ، وأمثالُهُم كثيرٌ رضيَ اللهُ عنهُم أجمَعين.
وقد قيلَ في مَدحِهِ:
أبو العَلَمَينِ الغَوثُ ذو القدمِ التي ***** على إثرِها الأفرادُ للهِ تَذهَبُ
عصابتُهُ زُهر النجومِ وإنهم ***** متى غابَ منهم كَوكبٌ لاحَ كوكبُ
ما أُلِّفَ في حَقِّهِ:
ألَّفَ العديدُ منَ السادةِ العلماءِ كتبًا مُفردةً في الثناءِ عليه وذِكرِ مَحاسِنِهِ ومناقِبِهِ ونذكرُ مِنها “تِرياقُ المحبينَ في سيرةِ سلطانِ العارِفين” للحافِظِ تقيِّ الدينِ أبي الفرجِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ المحسِنِ الواسطيِّ الشافعيِّ مُحدِّثِ واسِطَ، و”النجمُ الساعِي في مَناقِبِ القطبِ الكبيرِ الرفاعيِّ” لأبي بكرِ بنِ عبدِ اللهِ العَيدَروسِ العدنيِّ، و”سوادُ العينينِ في مناقبِ الغوثِ أبي العلمينِ” للإمامِ الحافظِ عبدِ الكريمِ بنِ محمدٍ الرافعيِّ شافعيِّ عصرِهِ، و”غايةُ التحريرِ في نَسبِ قطبِ العصرِ وغَوثِ الزمانِ سيدِنا أحمدَ الرفاعيِّ” للشيخِ المفسرِ المحدثِ عبدِ العزيزِ الديرينيِّ الشافعيِّ، و”جَلاءُ الصدَى في مناقبِ إمامِ الهُدَى السيدِ أحمدَ الرفاعيِّ” للشيخِ أحمدَ بنِ جلالٍ اللاريِّ المصريِّ الحنفيِّ، و”الشرَفُ المحتمُ فيما مَنَّ اللهُ به على وليِّهِ السيدِ أحمدَ الرفاعيِّ مِن تَقبيلِ يَدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ” للحافظِ جلالِ الدينِ السيوطيِّ، و”رَوضةُ الناظِرينَ” للعارفِ باللهِ الوتريِّ، و”النفحةُ المسكيَّةُ” للحافِظِ الصوفيِّ عزِّ الدينِ أحمدَ الفاروثيِّ، و”الوظائِفُ الأحمديَّةُ” للشيخِ القطبِ أحمدَ عزِّ الدينِ الصيادِ، و”إجابةُ الداعِي في مَناقبِ الإمامِ الرفاعيِّ” للبرزَنجيِّ، و”شفاءُ الأسقامِ في سيرةِ غَوثِ الأنامِ” للشيخِ إبراهيمَ بنِ محمدٍ الكازرونيِّ، و”ربيعُ العاشِقينَ” للشيخِ جمالِ الدينِ الحداديِّ، و”الدرَّةُ الساميَةُ في معرفةِ فَضائلِ سُلوكِ الطريقةِ الرفاعيةِ” للشيخِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ خميسٍ الحضرميِّ، و”بُغيةُ الطالِبينَ” للحافظِ المتقِنِ قاسمِ بنِ أحمدَ الواسطيِّ الشافعيِّ، و”قُرَّةُ العَينِ في مناقبِ أبي العَلَمَينِ” للشيخِ الإمامِ العارفِ باللهِ تقيِّ الدينِ عليِّ بنِ المباركِ بنِ الحسنِ بنِ أحمدَ بنِ باسويهِ الواسطيِّ، وغيرَ ذلك منَ المؤلَّفاتِ.
مؤلَّفاتُهُ:
تركَ رضيَ اللهُ عنه العديدَ منَ المؤلفاتِ إلَّا أنَّ أكثرَها لم يَصِلْ إلينا وقد فُقدَت بعد دخولِ التَّتارِ إلى بغدادَ، ومن مؤلفاتِهِ نذكرُ ما يلِي:
1_ مَعاني بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، وهو كتابٌ في التفسيرِ على طريقةِ القَومِ.
2_ تفسيرُ سورةِ القَدرِ.
3 _ شرح ُكتابِ التنبيهِ للشيرازيِّ، في الفِقهِ الشافعِي.
4_ الطريقُ إلى اللهِ، في التصَوّف.
5_ البَهجةُ، في التصوَفِ.
6_ الحكمُ، في التصوفِ والمواعِظ.
7_ حالةُ أهلِ الحَقيقةِ مع اللهِ، وهو أربعونَ حَديثًا بالإسنادِ المتصِلِ ألقاها السيدُّ أحمدُ الرفاعيُّ في أربعينَ مَجلِسًا جمَعَها الفقيهُ الشافعيُّ أبو شجاعٍ الشافعي.
8 _ البرهانُ المؤيدُ، وهو من أشهرِ كتبِهِ، وقد وصفَهُ الإمامُ الرافعيُّ بقولِه: “هو الكتابُ الجليلُ الذي عزَّ شأنُ سَبكِهِ عن المثيلِ الذي جمعَهُ من مجالسِ وعظِهِ ودوَّنَهُ شيخُ الإسلامِ شرفُ الدينِ ابنُ الشيخِ عبدِ السميعِ الهاشميُّ العباسيُّ الواسطيُّ نفعَنا اللهُ بهم أجمَعينَ” اهـ.
وقد جمعَ كلماتِهِ الحكَميةَ المحدثُ الشيخُ عبدُ العظيمِ ابنُ عبدِ القَويِّ بنِ أحمدَ المنذريُّ في كتابٍ سمَّاهُ “المجالِسَ الأحمَديَةَ” أوردَ فيه ما قالَهُ سيدُنا أحمدُ الرفاعيُّ رضيَ اللهُ عنه في كلِّ مجلسٍ على الغالبِ بِعَينِه.
وكذا جمعَ الشيخُ إبراهيمُ الراوي الرفاعيُّ البغداديُّ كتابًا ذكرَ فيه أحزابَ وأورادَ السيدِ أحمدَ رضيَ اللهُ عنه وأسماهُ “كتابَ السيَرِ والمساعِي”.
وفاتُهُ:
توفيَ رضيَ اللهُ عنه ونفَعَنا به يومَ الخميسِ الثاني والعشرينَ من جمادَى الأولَى سنةَ ثمانٍ وسبعينَ وخمسمائةٍ في أمِّ عَبيدةَ، ودُفنَ في قبةِ جدِّهِ لأمِّهِ الشيخِ يَحيى الكبيرِ النجاريِّ الأنصاريِّ وله منَ العمرِ ستةٌ وستونَ سنةً وستةُ أشهرٍ وأيامٍ، وكانَ ءاخرُ كلامِهِ لا إلهَ إلَّا اللهُ محمَّدٌ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
أخلاقُهُ وسيرتُهُ:
كانَ رضيَ اللهُ عنه غنيَّ النفسِ، حسنَ المعاشرةِ، دائمَ الإطراقِ، كثيرَ الحِلمِ، كاتِمًا للسِّرِّ، حافظًا للعهدِ، كثيرَ الدعاءِ للمُسلمينَ، هَيّنًا لَيّنًا، يصِلُ مَن قطعَهُ، ويعطِي مَن منَعَهُ، ويَعفو عمَّن ظلَمَهُ، ويحسنُ مُجاورةَ مَن جاورَهُ، ويُطعِمُ الجائعَ، ويُكسِي العريانَ، ويعودُ المريضَ، ويشيِّعُ الجنائزَ، ويجالِسُ الفقراءَ، ويواكِلُ المساكينَ، ويصبرُ على الأذَى، ويبذُلُ المعروفَ، إن مُنِعَ صبَرَ، ويحثُّ على فعلِ الخيرِ ويُرشدُ إلى مكارمِ الأخلاقِ، ويقبلُ عُذرَ المعتذِرِ له، حزنُهُ أكثرُ من فرحِهِ، إذا مشَى في الطريقِ لا ينظرُ إلا موضِعَ قدَمِهِ، يأخذُ بأيدي العُمْي ويقودُهُم، ويتردَّدُ في الليلِ إلى أبوابِ المساكينِ، ويحملُ لهم الطعامَ ولا يعرِّفُهُم بنفسِهِ، كانَ لليتيمِ كالأبِ، وله مَناقبُ كثيرةٌ وهي كما قالَ الحافظُ المؤرخُ الحجةُ تاجُ الدينِ السبكيُّ: “لو أرَدنا استيعابَ فضائلِهِ لضاقَ الوقتُ”، وقالَ أيضًا: “ومَناقبُهُ أكثرُ من أن تُحصَرَ”.
ورَوى الرافعيُّ أيضًا بالإسنادِ أنَّ بِنتًا تُسمَّى فاطمةَ الحداديةَ وُلدَت حَدباءَ ولما كبرَت وءانَ أوانُ مَشيِها فإذا بِها عرجاءُ ثم سقطَ شعرُ رأسِها لعاهَةٍ، ففي يومٍ من الأيامِ حضرَ السيدُ أحمدُ الرفاعيُّ رضيَ اللهُ عنه الحداديةَ فاستقبلَهُ أهلُها والعرجاءُ فاطمةُ بينَ الناسِ مع النساءِ وبناتُ الحداديةِ يستَهزِئنَ بها، فلمّا أقبَلَت على سيدِنا أحمدَ قالَت: أي سيِّدي أنتَ شَيخي وشيخُ والدَتي وذُخرِي أشكُو إليكَ ما أنا فيه لعلَّ اللهَ ببركَةِ ولايتِكَ وقرابَتِكَ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُعافيَني مما أنا فيه فقَد زهقَت روحِي من استِهزاءِ بناتِ الحداديةِ، فأخذَتهُ الشفقةُ عليها وبِكَى رحمةً لحالِها ثم ناداها: ادنِي منِّي، فدَنَت منه فمَسَحَ بيدِهِ المباركةِ على رأسِها وظهرِها ورِجلَيها فنبَتَ بإذنِ اللهِ شَعرُها وذهَبَ احْدِيدابُها وتقوَّمَت رِجلاها وحَسُنَ حالُها.
سنَدُ الطريقةِ العَليَّةِ الرفاعيةِ
أخذَ رضيَ اللهُ عنه طريقةَ القومِ عن الشيخِ عليٍّ الواسطيِّ القاريِّ، وهو أخذَها عن الشيخِ أبي الفضلِ بنِ كافحٍ، عن الشيخِ غلامِ بنِ تَركانَ، عن الشيخِ أبي عليٍّ الروذباريِّ، عن الشيخِ عليٍّ العجميِّ، عن الشيخِ أبي بكرٍ الشبليِّ، عن الشيخِ أبي القاسمِ الجنيدِ البغداديِّ سيدِ الطائفَتَينِ، عن خالِهِ الشيخِ سَريٍّ السقطيِّ، عن الشيخِ أبي محفوظٍ معروفٍ الكرخيِّ، عن الشيخِ داودَ الطائيِّ، عن الشيخِ حبيبٍ العجَميِّ، عن الشيخِ الحسنِ البِصريِّ، عن سيدِنا ومَولانا أميرِ المؤمنينَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه وعنهُم أجمعينَ، عن النبيِّ الأعظمِ والرسولِ الأكرمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وأخذَ رضيَ اللهُ عنه أيضًا الطريقةَ ولبسَ الخرقةَ من خالِهِ الشيخِ منصورٍ البطائحيِّ المعروفِ بالبازِ الأشهَبِ، وهو أخذَ عن خالِهِ الشيخِ أبي منصورٍ الطيِّبِ، عن ابنِ عمِّهِ الشيخِ أبي سعيدٍ يحيى النجاريِّ الواسطيِّ الأنصاريِّ، عن الشيخِ أبي عليٍّ القرمزيِّ، عن الشيخِ أبي القاسمِ السندوسيِّ الكبيرِ، عن الشيخِ أبي محمدٍ رويمٍ البغداديِّ، عن الشيخِ الجُنيدِ البغداديِّ، عن الشيخِ سَريٍّ السقطيِّ، عن الشيخِ معروفٍ الكرخيِّ، عن الإمامِ عليِّ بنِ موسَى الرِّضا، عن أبيهِ الإمامِ موسَى الكاظِمِ، عن أبيهِ الإمامِ جعفرٍ الصادقِ، عن أبيهِ الإمامِ محمدٍ الباقرِ، عن أبيهِ الإمامِ عليٍّ زينِ العابدينَ، عن أبيهِ الإمامِ السبْطِ الشهيدِ الحُسينِ، عن أبيه الإمامِ أميرِ المؤمنينَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه وعنهُم أجمَعينَ، عن النبيِّ المصطَفَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
ولهذهِ الطريقةِ الجليلَةِ الرفاعيةِ فُروعٌ عظيمةٌ معروفةٌ في البلادِ الإسلاميةِ، ومآثرُ رجالِها شهيرةٌ، وبركاتُهُم كثيرةٌ، وقد صحَّ أنَّ خُلفاءَ السيدِ أحمدَ الرفاعيِّ رضيَ اللهُ عنه وخُلفاءَهُم بلَغَت عدَّتُهُم مائةً وثمانينَ ألفًا حالَ حياتِهِ نَفعَنا اللهُ بهِ وبهِم أجمَعينَ.
————-
(1) راجع ترجمته في : وفيات الأعيان 1/،171 الوافي بالوفيات 7/،219 سير الذهبي 21/،77 الكامل في التاريخ 11/،492 العبر 4/،233 شذرات الذهب 4/،259 مرءاة الزمان 8/،037 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/،5 طبقات الشافعية للسبكي 4/،14 النجوم الزاهرة 6/92.
إجابَةُ الداعِي
إلى بيانِ اعتِقادِ الإمامِ الرفاعِيِّ رضِيَ اللهُ عنهُ
التوحيدُ الذي أوضَحَهُ الشيخُ الكبيرُ ووَصَّى بهِ الْمُريدَ أنْ يَفهَمَهُ (1)
قالَ شيخُنا ومفزَعُنا السيدُ أحمدُ الرفاعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ على كرسيهِ في أمِّ عَبيدَةَ يومَ الجمعةِ سنةَ سبعينَ وخمسمائةٍ، وقد أحدَقَ به أصحابُه وأئمةُ العَصرِ رِضوانُ اللهِ عليهم أجمَعين:
طَريقِي عقيدةٌ طاهِرةٌ، وسَريرةٌ عامِرةٌ، والإِقبالُ على اللهِ لوجهِ اللهِ بتَركِ مَطامعِ الدنيا والآخرةِ، فلمّا أتمَّ مجلِسَهُ المباركَ قالَ له الشيخُ يَعقوبُ بنُ كراز: سيِّدي لو كتَبتَ لَنا كتابًا في العقيدةِ نُعوِّلُ عليهِ ويُعوِّلُ عليه أيضًا مُريدوكَ بعدَكَ، فأجابَهُ وأمَرَ بالدواةِ والقِرطاسِ، وقالَ: اكتُبوا:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
الحَمدُ للهِ الْمُبدِىءِ الْمُعيدِ الفَعّالِ لِما يريدُ ذِي العَرشِ المجيدِ، والبَطشِ الشديدِ، الهادِي صَفوةَ العَبيدِ إلى المنهَجِ الرشيدِ، والمسلَكِ السديدِ، الْمُنعِمِ علَيهِم بعد شَهادةِ التوحيدِ، بحِراسةِ عَقائدِهِم عن ظُلُماتِ التشكِيكِ والترديدِ، السائقِ لهم إلى اتِّباعِ رسولِهِ المصطَفَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، واقتِفاءِ صَحبِهِ الأكرَمينَ بالتأييدِ والتسديدِ، المتَجَلِّي (2) لهُم في ذاتِهِ وأفعالِهِ بمحاسنِ أوصافِهِ التي لا يُدركُها إلا مَن ألقَى السمعَ وهو شهيدٌ، الْمُعَرّفِ إيّاهُم أنهُ واحِدٌ لا شَريكَ له، فَردٌ لا مِثلَ له، صَمَدٌ لا ضِدَّ له، متَفرِّدٌ لا نِدَّ له.
وأنه قديمٌ لا أوّلَ له، أزليٌّ لا بِدايةَ له، مُستَمِرُّ الوجودِ لا ءاخِرَ له، أبَديٌّ لا نهايةَ له، قيومٌ لا انقِطاعَ له، دائمٌ لا انصِرامَ له، لم يزِلْ ولا يَزالُ مَوصوفًا بنُعوتِ الجَلالِ، لا يُقضَى عليه بالانقِضاءِ وَتَصَرُّمِ الآمالِ، وانقراضِ الآجالِ، بل هو الأوّلُ والآخرُ والظاهرُ والباطنُ.
وَأنَّهُ ليَس بجِسمٍ مُصَوَّرٍ، ولا جَوهرٍ مَحدودٍ مُقدَّرٍ، وأنه لا يُماثِلُ الأجسامَ لا في التقديرِ ولا في قَبولِ الانقِسامِ، وأنهُ ليسَ بجَوهَرٍ ولا تَحُلُّهُ الجواهِرُ، ولا بعَرَضٍ ولا تَحُلُّهُ الأعراضُ، لا يُمَاثِلُ مَوجودًا ولا يُمَاثِلُهُ موجودٌ، ليسَ كمِثلِهِ شَىءٌ ولا هوَ مثلُ شَىءٍ.
وأنهُ لا يَحُدُّهُ المِقْدارُ، ولا تَحويهِ الأقطارُ، ولا تَحيطُ به الجِهاتُ ولا تَكتَنِفُهُ السمَواتُ، وأنهُ مُستَوٍ على العرشِ على الوجهِ الذي قالَهُ وبالمعنَى الذي أرادَهُ، استِواءً مُنَزَّهًا عن الْمُماسَّةِ والاستِقرارِ والتمَكُّنِ والتحَوُّلِ والانتِقالِ، لا يحمِلُهُ العَرشُ، بلِ العَرشُ وحَملتُهُ مَحمولونَ بلُطفِ قُدرتِهِ، ومَقهورونَ في قَبضَتِهِ، وهو فوقَ العرشِ، وفوقَ كلِّ شىءٍ إلى تُخومِ الثرَى، فَوقيةً لا تزيدُهُ قُربًا إلى العرشِ والسماءِ، بل هو رفيعُ الدرجاتِ عن العرشِ كما أنهُ رفيعُ الدرجاتِ عن الثرَى، وهو مع ذلكَ قَريبٌ مِن كلِّ مَوجودٍ، وهو أقربُ إلى العبيدِ من حبلِ الوريدِ، فهوَ على كلِّ شىءٍ شهيدٌ، إذ لا يُمَاثِلُ قُرْبُهُ قربَ الأجسامِ، كما لا يُماثِلُ ذاتُهُ ذاتَ الأجسامِ.
وأنهُ لا يَحُلُّ في شَىءٍ ولا يَحُلُّ فيه شَىءٌ، تَعالى عن أن يَحويهِ مَكانٌ، كما تقَدَّسَ عن أن يَحُدَّهُ زمانٌ، بل كانَ قبلَ خَلقِ الزمانِ والمكانِ، وهو الآنَ على ما عَليهِ كانَ.
وأنهُ بائِنٌ بصِفاتِهِ عن خَلقِهِ ليسَ في ذاتِهِ سِواهُ، ولا في سِواهُ ذاتهُ (3).
وأنهُ مقدسٌ عن التَّغَيُّر والانتقالِ، لا تحلُّهُ الحوادِثُ، ولا تعتريهِ العوارِضُ، بل لا يزالُ في نعوتِ جلالِهِ مُنزهًا عن الزوالِ، وفي صفاتِ كمالِهِ مستَغنِيًا عن زيادةِ الاستِكمالِ.
وأنَّه في ذاتِهِ مَعلومُ الوجودِ بالعقولِ، مرئِيُّ الذاتِ بالأبصارِ، نعمةً منه ولطفًا بالأبرارِ في دار القَرَارِ، وإتمامًا للنعيمِ بالنظرِ إلى وجههِ الكريمِ.
وأنه حيٌّ قادرٌ، جبارٌ قاهرٌ، لا يعتَريهِ قُصُورٌ ولا عجزٌ، ولا تأخُذُه سِنةٌ ولا نومٌ، ولا يعارِضُهُ فناءٌ ولا موتٌ.
وأنَّه ذو الْمُلكِ والملكوتِ، والعزةِ والجبروتِ، له السلطانُ والقهرُ، والخلقُ والأمرُ، والسمواتُ مَطويّاتٌ بيمينِهِ، والخلائقُ مَقهورونَ في قبضتِهِ.
وأنه المتفردُ بالخلقِ والاختراعِ المتوحِدِ بالإِيجادِ والإِبداعِ، خلقَ الخلقَ وأعمالَهم، وقدَّر أرزاقَهم وءاجالَهم، لا يَشُذُّ عنه مَقدورٌ، ولا يَعزُبُ عن علمهِ مثقالُ ذرةٍ في الأرضِ ولا في السماءِ، بل يعلمُ دبيبَ النملةِ السوداءِ، على الصخرةِ الصماءِ، في الليلةِ الظَّلماءِ، ويُدرِكُ حركةَ الذَّرِّ في جَوِّ الهواءِ، ويعلمُ السرَّ وأخفَى، ويطَّلعُ على هواجِس الضمائرِ وخفيَّاتِ السرائرِ بعلمٍ قديمٍ أزليٍّ لم يزلْ مَوصوفًا بهِ في أزلِ الآزالِ، لا بِعِلمٍ مُتجَدِّدٍ حاصلٍ في ذاتِهِ بالحلولِ والانتِقالِ.
وأنه مُريدٌ للكائناتِ، مُدبرٌ للحادِثاتِ، فلا يَجري في الْمُلكِ والملكوتِ قليلٌ ولا كثيرٌ، صغيرٌ أو كبيرٌ، خيرٌ أو شرٌّ، نفعٌ أو ضُرٌّ، إيمانٌ أو كفرٌ، عِرفانٌ أو نُكْرٌ، فوزٌ أو خُسْرٌ، زِيادةٌ أو نُقصانٌ، طاعةٌ أو عصيانٌ، إلا بقضائِهِ وقدَرِهِ، وحُكمِهِ ومشيئتِهِ، لفتَة ناظرٍ، لا فلتةَ خاطِرٍ، بل هو المبدِىءُ المعيدُ، الفَعّالُ لما يريدُ، لا رادَّ لحكمِهِ، ولا مُعقِّبَ لقَضائِهِ، ولا مَهربَ لعبدٍ عن معصيتِهِ إلا بتوفيقِهِ ورحمتِهِ، ولا قوةَ له على طاعةٍ إلا بمحبتِهِ وإرادتِهِ، ولو اجتمعَ الإِنسُ والجنُّ والملائكةُ والشياطينُ على أن يحرِّكوا في العالمِ ذرةً أو يُسَكِّنوها دونَ إرادتِهِ ومشيئتِهِ لعَجزوا عن ذلك.
وأنَّ إرادتَهُ قائمةٌ بذاتِهِ في جملةِ صفاتِهِ، لم يزَلْ كذلك مَوصوفًا بها مُريدًا في أزلِهِ لِوجودِ الأشياءِ في أوقاتِها التي قَدَّرَها، فَوجِدَتْ في أوقاتِها كما أرادَهُ في أزلِهِ من غيرِ تقَدُّمٍ ولا تأخُّرٍ، بل وقَعَت على وَفقِ علمِهِ وإرادتِهِ من غيرِ تبدُّلٍ ولا تغَيُّرٍ، دبَّرَ الأمورَ لا بترتيبِ الأفكارِ وتربُّصِ زمانٍ، فلذَلك لم يشغَلْهُ شأنٌ عن شأنٍ.
وأنهُ سميعٌ بصيرٌ يسمعُ ويَرى، لا يَعزبُ عن سمعِهِ مَسموعٌ وإن خَفيَ، ولا يَغيبُ عن رؤيَتِهِ مَرئيٌّ وإن دَقَّ، ولا يَحجبُ سمْعَه بُعْدٌ، ولا يدفَعُ عن رؤيتِهِ ظلامٌ، يَرى من غيرِ حدقةٍ وأجفانٍ، ويَسمعُ من غيرِ أصمِخةٍ وءاذانٍ، كما يعلمُ بغيرِ قلبٍ، ويبطِشُ بغيرِ جارحةٍ، ويخلُقُ بغيرِ ءالةٍ، إذ لا تُشبِهُ صفاتُهُ صِفاتَ الخلقِ، كما لا يُشبِهُ ذاتُهُ ذوات الخلقِ.
وأنهُ مُتكلِّمٌ ءامِرٌ ناهٍ، واعِدٌ مُتوعِّدٌ، بكلامٍ أزلي قديمٍ قائمٍ بذاتِهِ، لا يُشبِهُ كلامَ الخلقِ، فليسَ بصَوتٍ يحدُثُ من انسِلالِ هواءٍ، واصطِكَاكِ أجرامٍ، ولا بحرفٍ يتقَطَّعُ بإطباقِ شفَةٍ أو تحريكِ لسانٍ.
وأنَّ القرءانَ والتوراةَ والإنجيلَ والزّبورَ كُتُبُهُ المنزَّلَةُ على رسلِهِ، وأنَّ القرءانَ مَقروءٌ بالألسُنِ، مكتوبٌ في المصاحِفِ، محفوظٌ في القلوبِ، وأنهُ مع ذلك قَديمٌ قائمٌ بذاتِ اللهِ، لا يقبَلُ الانفِصالَ والفِراقَ، بالانتِقالِ إلى القلوبِ والأوراقِ، وأنَّ موسَى سمعَ كلامَ اللهِ بغيرِ صوتٍ ولا حرفٍ، كما يَرى الأبرارُ ذاتَ اللهِ من غيرِ جَوهرٍ ولا عَرَضٍ.
وإِذا كَانَت له هذه الصفاتُ كانَ حَيًّا عالِمًا قادِرًا مُريدًا سميعًا بَصيرًا مُتكلمًا بالحياةِ والعلمِ والقدرةِ والإِرادةِ والسمْعِ والبصرِ والكلامِ لا بمجرَّدِ الذاتِ.
وأنهُ لا موجودَ سِواهُ إلَّا هوَ حادِثٌ بفعلِهِ، وفائِضٌ من عَدلِهِ، على أحسَنِ الوجوهِ وأكملِها، وأتمِّها وأعدَلِها.
وأنهُ حَكيمٌ في أفعالِهِ عادلٌ في أقضِيَتِهِ، لا يُقاسُ عدلُهُ بعدلِ العِبادِ، إذ العبدُ يُتصوَّرُ منه الظلمُ بتصرفِهِ في ملكِ غيرِهِ، ولا يُتصورُ الظلمُ من اللهِ تعالى فإنهُ لا يُصادِفُ لغيرِهِ مُلكًا حتى يكونَ تصرُّفُه فيه ظلمًا، فكلُّ ما سِواهُ من إنسٍ وجنٍ وشيطانٍ وملَكٍ وَسَماءٍ وأرضٍ وحيوانٍ ونباتٍ وجوهرٍ وعَرَضٍ ومُدرَكٍ ومحسوسٍ وحادثٍ اخترَعَهُ بقدرتِهِ بعد العدمِ اختِراعًا، وأنشأَهُ إنشاءً بعد أن لم يكُنْ شيئًا، إذ كانَ في الأزلِ موجودًا وحدَهُ، ولم يكنْ معَهُ غيرُهُ، فأحدَثَ الخلقَ بعدَهُ إظهارًا للقدرةِ، وتَحقيقًا لما سَبَقَ من إرادتِهِ، ولما حَقَّ في الأزلِ من كلمتِهِ، لا لافتقارِهِ إِليه وحاجتِهِ.
وأنه مُتفضِّلٌ بالخلقِ والاختِراعِ والتكليفِ لا عن وجوبٍ، ومُتطوّلٌ بالإِنعامِ والإصلاحِ لا عن لزومٍ، فله الفضلُ والإِحسانُ والنعمةُ والامتِنانُ، إذ كانَ قادرًا أن يَصُبَّ على عبادِهِ أنواعَ العذابِ، ويبتَليهِم بضُروبِ الآلامِ والأوصابِ، ولو فعلَ ذلك لكانَ عدلًا منه ولم يكُنْ قُبحًا ولا ظُلمًا.
وأنه يُثيبُ عبادَهُ على الطاعةِ بحكمِ الكَرَمِ والوَعدِ، لا بحُكمِ الاستِحقاقِ واللزومِ، إذ لا يجبُ عليه فعلٌ ولا يُتصورُ منه ظلمٌ، ولا يجِبُ لأحدٍ عليه حقٌ.
وأنَّ حقَّهُ في الطاعاتِ وجَبَ على الخلقِ بإِيجابِهِ على لِسانِ أنبيائِهِ، لا بمجردِ العقلِ، ولكنَّهُ بعَثَ الرسُلَ وأظهرَ صِدقَهُم بالمعجزاتِ الظاهرةِ فبلَّغوا أمرَهُ ونهيَهُ ووعدَه ووعيدَهُ، فوجبَ على الخلقِ تصديقُهُم فيما جاءوا به.
وأنهُ بعَثَ النبيَّ الأميَّ القُرشيَّ محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برسالتِهِ إلى كافَّةِ العربِ والعجمِ والجنِّ والإِنسِ، فنَسخَ شَرعُه الشرائعَ إلا ما قدَّرَهُ، وفضَّلَهُ على سائرِ الأنبياءِ، وجعلَهُ سيّدَ البشرِ، ومَنَعَ كمالَ الإِيمانِ بشهادةِ التوحيدِ وهي قولُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ما لم تَقترِنْ بها شهادةُ الرسولِ، وهي: محمدٌ رسولُ اللهِ، وألزمَ الخَلقَ بتَصديقِهِ في جميعِ ما أخبرَ عنه من أمرِ الدنْيا والآخرةِ.
وأنه لا يُقبَلُ إيمانُ عبدٍ حتى يُؤمِنَ بما أخبرَ عن حُصولِهِ بعد الموتِ، وأوّلُهُ سؤالُ مُنكرٍ ونَكيرٍ، وهما شَخصانِ مَهيبَانِ يُقعِدَانِ العبدَ في قبرِهِ سَويًّا ذا روحٍ وجسدٍ، فيَسألانِهِ عن التوحيدِ والرسالةِ، ويَقولانِ: مَن ربُّك وما دينُكَ ومَن نَبيُّكَ؟، وهما فتَّانا القَبرِ، وسُؤالُهما أوّلُ فِتنةٍ بعدَ الموتِ.
وأن يؤمِنَ بعذابِ القبرِ، وَأنه حقٌّ، وَحِكمةٌ وعَدلٌ، على الجسمِ والروحِ كما يشاءُ.
وأن يؤمِنَ بالميزانِ ذي الكفَّتَينِ واللسانِ، وصِفتُهُ في العِظَمِ أنهُ مثلُ طِبَاقِ السمواتِ والأرضِ، تُوزَنُ فيه الأعمالُ بقدرةِ اللهِ، وتتَّضِحُ يومَئذٍ مَثاقيلُ الذرِّ والخَردلِ، تَحقيقًا لإتمامِ العدلِ، وتُطرَحُ صَحائفُ الحَسناتِ في صورةٍ حسنةٍ في كفةِ النورِ فيثقُلُ بها الميزانُ على قَدرِ درجاتِها عندَهُ بفضلِ اللهِ، وتُطرَحُ صحائفُ السيّئاتِ في كفةِ الظُّلمةِ، فَيَخِفُّ بها الميزانُ بعدلِ اللهِ تَعالى.
وأن يؤمنَ بأنَّ الصراطَ حَقٌّ، وهو جِسرٌ مَمدودٌ على مَتنِ جَهنَّمَ أحَدُّ من السَّيفِ، وأدقُّ من الشعرِ، تَزِلُّ عنه أقدامُ الكافرينَ بحُكمِ اللهِ فتَهوي بهِم إلى النارِ ويثبُتُ عليه أقدامُ المؤمنينَ، فيُساقونَ إِلى دارِ القَرَارِ.
وأن يُؤمنَ بالحوضِ الموْرودِ، حوضِ سيدِنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَشربُ منه المؤمنونَ قبلَ دخولِ الجنةِ، وبعد جَوازِ الصِّراطِ، مَن شَربَ منه شربَةً لم يَظمأ بعدَها أبدًا، عرضُهُ مسيرةُ شهرٍ أشدّ بياضًا من اللبَنِ، وأحلَى من العَسلِ، حولَهُ أباريقُ عدَدُها عددُ نجومِ السماءِ، فيه ميزابانِ يُصبَّانِ منَ الكوثَر.
ويؤمنَ بالحِسابِ، وتَفاوتِ الخلقِ فيه إلى مُناقَشٍ في الحسابِ وإلى مُسَامَحٍ فيه، وإلى من يَدخُلِ الجنةَ بغيرِ حسابٍ، وهم المقرَّبونَ، فيَسألُ مَن يَشاءُ منَ الأنبياءِ (4) عن تبليغِ الرسالةِ، ومَن شاءَ منَ الكفارِ عن تكذيبِ المرسَلينَ، ويَسألُ المبتَدِعَةَ (5) عن السنَّةِ، ويَسألُ المسلمينَ عن الأعمالِ.
ويؤمنَ بإخراجِ الموَحِّدينَ منَ النارِ بعدَ الانتِقامِ، حتى لا يَبقَى في جَهنَّمَ مُوحِّدٌ بفضلِ اللهِ تَعالى.
ويؤمنَ بشفاعةِ الأنبياءِ، ثم الأولياءِ، ثم الشهداءِ، ثم سائرِ المؤمنينَ، كلٌّ على حسبِ جاهِهِ ومَنزلتِهِ عندَ اللهِ، ومَن بقِيَ من المؤمنينَ ولم يكُنْ له شفيعٌ أُخرِجَ بفَضلِ اللهِ، فلا يُخلَّدُ في النارِ مؤمنٌ، بل يخرجُ منها من كانَ في قلبِهِ مثقالُ ذرةٍ من الإِيمانِ.
وأن يعتقِدَ فَضلَ الصحابَةِ وترتيبَهم، وأن أفضلَ النّاسِ بعد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبو بكرٍ ثمَّ عُمرُ ثم عُثمانُ ثمّ عليٌّ رضوانُ اللهِ عليهِم أجمَعين. وأن يُحسِنَ الظَّنَّ بجميعِ الصحابَةِ (6) ويُثنِي علَيهم كما أثنَى اللهُ تَعالى ورسولُهُ علَيهم.
فكلُّ ذلك ما ورَدَت بهِ الأخبارُ، وشَهِدَت به الآثارُ. فمَن اعتقدَ جميعَ ذلك موقِنًا به كانَ من أهلِ الحقِّ وعِصابَةِ السنَّةِ، وفارقَ رَهطَ الضلالِ وحِزبَ البدعةِ، فنسألُ اللهَ تَعالى كمالَ اليَقينِ، والثباتَ في الدينِ، لنا ولكافةِ المسلمينَ، إنه أرحمُ الرَّاحمينَ انتهى.
————-
(1) هذا الفصلُ كلُّهُ مأخوذٌ من كتابِ “الدرَّةُ السامِيَةُ في معرفَةِ فَضائلِ سُلوكِ الطريقةِ الرفاعيَّةِ” للشيخِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ خميسٍ الحضرميِّ الرفاعيِّ، ص/25 _ 35، طبع الكتاب في مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة سنة 1356هـ = 1937ر.
(2) ) أي الذي ألهَمَهُم مَعانيَ أسمائِهِ وصفاتِهِ حتى عَرفوهُ على ما يَليقُ به، مع التعالِي عنِ الحُدوثِ والتحَوُّلِ من حالٍ إلى حالٍ، لأنهُ تباركَ وتعالى ظاهرٌ بدَلائلِ وجودِهِ وبقُدرتِهِ وحِكمَتِهِ وعِلمِهِ كما قالَ القائلُ:
وفي كلِّ شَىءٍ لهُ ءايَةٌ *** تدُلُّ علَى أنَّهُ واحِدُ
وإن كانَ سبحانَهُ وتَعالى على خِلافِ ما يخطرُ بالبالِ ويُتصور.
(3) أي أنَّ ذاتَهُ ليسَ مؤلفًا من أجزاءٍ كسائرِ الأجرامِ فإنَّ العرشَ وما دونَهُ ذو أجزاءٍ، والجزءُ الذي لا يتَجَزأُ من نهايةِ القِلةِ هو أصلُ المتَجزءاتِ المسمَّى عندَ الفَلاسفةِ بالهيُّولى، فإنَّها تَقولُ: الهيُّولى موجودٌ لا كميةَ لهُ ولا كيفيةَ وقد كذَبوا، وكما قالَ صاحبُ القاموسِ: “انهم وصَفوا الهيولى بصفَةِ البارِىءِ”، اللهُ تَعالى هو الذي لا كميةَ له ولا كيفيةَ ولا يكونُ أحدٌ سِواهُ كذلك، فيجبُ تَنزيهُهُ تَعالى عن الاتِّصالِ والانفِصالِ لأنَّ كُلًّا منَ الاتصالِ والانفصالِ يوجِبُ المماثَلةَ لغيرِهِ لأنَّ الجِرمَ لا يخلو أن يكونَ مُتصلًا بغَيرِهِ أو مُنفصِلًا عنه، فوجبَ تنزيهُ الربِّ سُبحانَهُ وتعالى عن ذلك عمَلًا بقولِهِ تَعالى: {لَيسَ كَمِثلِهِ شَىءٌ}، وقد ظنَّ بعضٌ لشدةِ غباوةِ عقولِهِم أنَّ هذا تعطيلٌ ونفيٌ لوجودِ اللهِ، فيُقالُ لهُم: أليسَ كانَ اللهُ مَوجودًا قبلَ وجودِ العالمِ، وهل كانَ يوصَفُ قبلَ وجودِ العالمِ باتِّصالٍ بالعالمِ أو بانفصالٍ عنه؟، فكَما صَحَّ وجودُهُ من غيرِ اتِّصالٍ بسِواهُ أو انفصالٍ قبلَ وجودِ العالمِ يصحُّ وجودُهُ بعد وجودِ العالمِ من غيرِ اتصالٍ أو انفصالٍ عن العالمِ، وقد نصَّ على ذلك جماعةٌ من أهلِ المذاهِبِ الأربعةِ كالإمامِ الكبيرِ أحدِ أصحابِ الوجوهِ في مذهبِ الإمامِ الشافعيِّ المتوَلّي، ثم تبِعَهُ النوويُّ وابنُ حجرٍ الهيتَميُّ، ومن المالكيةِ الإمامُ العالمُ سيدِي أبو عبدِ اللهِ ابنُ جلالٍ وبسطَ العبارةَ في ذلك بَسطًا شافِيًا، والعالمُ المشهورُ محمدُ بنُ احمدَ بنِ محمدِ مَيّارةَ، والإمامُ الكبيرُ أبو المعينِ النسفيُّ لسانُ الحنفيةِ في علمِ العقيدةِ ومقدمُهم، والقونويُّ الحنفيُّ شارحُ العقيدةِ الطحاويةِ، والإمامُ الحافظُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ الجوزيِّ الحنبليُّ، وهذه العبارةُ هي معنَى قولِ الإمامِ ذي النونِ المِصريِّ: “مَهما تصَورتَ ببالِكَ فاللهُ بخلافِ ذلك”، وفي طَيِّ هذهِ العبارةِ نَفيُ الكميَّةِ عن اللهِ لأنَّ بالَ الإنسانِ لا يتصَورُ إلَّا ما لهُ كميةٌ إن كانَت لطيفةً كالنورِ والظلامِ والريحِ، وإن كانَت كثيفةً كالجماداتِ والإنسانِ، والذي أهلَكَ المشبِّهَةَ المجسمةَ هو قياسُهُم للخالقِ بالمخلوقِ وحصرُهُم للوجودِ بما له كمِّيةٌ، فعندَهم لا يصحُّ الوجودُ إلا بالكميةِ وذلك لأنَّ الكميةَ توهِمُ الحدوثَ لأنَّ تخصُّصَ الشىءِ مَهما صَغُرَ ومَهما كَبُرَ بكميةٍ لا بُدَّ من مُخَصِّصٍ له بتلكَ الكميةِ، فبذَلك عرَفْنا أنَّ الشمسَ مع عظَمِ نفعِها لا تصلُحُ للألوهيةِ لأنَّ لَها كميةً فتَحتاجُ إلى مَن خصصَها بهذه الكميةِ، وكذلكَ غيرَها منَ الأجرامِ قالَ تَعالى: .{وكُلُّ شَىءٍ عِندَهُ بمِقدارٍ}.
(4) قولُ المؤلفِ: “فيَسألُ مَن يَشاءُ منَ الأنبياءِ” فيه إيهامٌ أنهُ لا يَسألُ جَميعَهم، قالَ اللهُ تَعالى (ولَنَسئَلَنَّ المرسَلينَ)، فالآيةُ فيها تَعميمٌ أي أنَّ كلَّ نَبيٍ يُسألُ، هذا ظاهرُ القُرءانِ، وهذا السؤالُ لإظهارِ شَرفِ الأنبياءِ.
(5) المرادُ بالمبتَدِعةِ المبتدعَةُ في الاعتِقادِ وهم أصحابُ الأهواءِ الذين ترَكوا عقيدةَ أهلِ السنَّةِ من الصحابةِ ومَنِ اتَّبعَهُم، وأخَذوا عقائدَ مُخالفةً لهم كعقيدةِ الخَوارجِ والمعتزلَة
(6) مُرادُهُ بذلك أنَّ كلَّ واحدٍ منهم فيه خيرٌ، وليسَ مُرادُهُ أنَّهم كلَّهم أتقياءُ صالحونَ بمرتبَةٍ واحدةٍ وأنه لا يقعُ أحدٌ منهم في ذنبٍ، فقد صَحَّ في الحديثِ الذي رَواهُ أحمدُ وابنُ حِبانَ وغيرُهُما أنَّ رجُلًا من الصحابةِ لما ماتَ وجَدوا في شَملتِهِ دينارَينِ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: “كَيَّتانِ”، ورَوى البخاريُّ وغيرُهُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في رجلٍ غَلَّ شملَةً ثم أصابَهُ سهمٌ فقتَلَه: “هوَ في النّارِ”، وقد ثَبتَ أنَّ منهم مَن شربَ الخمرَ ثم أُقيمَ عليه الحدُّ، ومنهم مَن أُقيمَ عليه حدُّ الزِّنى، ورَوى البخاريُّ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: “أنا فَرَطُكُم على الحوضِ ليُرفَعنَّ إليَّ رجالٌ منكُم حتى إذا أهويتُ لأُناوِلَهم اختُلِجوا دونِي، فأقولُ: أي رَبِّ أصحابِي، يقولُ: لا تَدري ما أحدَثوا بَعدَك”، وكذلك الذين قاتَلوا علِيًا رضيَ اللهُ عنه وخرجَوا عن طاعتِهِ فإنهُم يدخلونَ تحتَ الحديثِ الذي رواهُ مسلمٌ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: “مَن خرجَ منَ الطاعةِ وفارقَ الجماعةَ فماتَ ماتَ ميتَةً جاهِليةً”، وهذا ينطبِقُ على مُعاويةَ ومَن معهُ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ في التلخيصِ الحَبيرِ ما نصُّه: “قولُه _ أي الرافعي _: ثبتَ أنَّ أهلَ الجملِ وصِفينَ والنهروانِ بُغاةٌ، هو كما قالَ،ويدلُّ عليه حديثُ عليٍّ: أُمِرتُ بقِتالِ الناكِثينَ والقاسِطينَ والمارِقين” اهـ، وروَى الحافظُ البيهقيُّ في كتابِ الاعتِقادِ بالإسنادِ المتصلِ إلى محمدِ بنِ اسحاقَ يعنِي ابنَ خُزيمةَ قال: “وكلُّ مَن نازعَ أميرَ المؤمنينَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ في إمارتِهِ فهو باغٍ، على هذا عهِدتُ مشايخَنا، وبه قالَ ابنُ ادريسَ _ يَعني الشافعيَّ _ رحمَهُ اللهُ” اهـ، ويدلُّ على ما ذَكرنا الحديثُ الذي رَواهُ البخاريُّ: “وَيحَ عَمّارٍ تقتُلُهُ الفئةُ الباغيَةُ يدعوهُم إلى الجنةِ ويَدعونَهُ إلى النارِ”، فعمارٌ رضيَ اللهُ عنه كان مع عليٍّ داعيًا إلى الجنةِ، والمقاتِلونَ لعليٍّ دُعاةٌ إلى النارِ، ورَوى البيهقيُّ وابنُ أبي شيبةَ أنَّ عمارَ بنَ ياسرٍ قال: “لا تَقولوا كَفرَ أهلُ الشامِ ولكِن قولُوا فسَقوا أو ظلَموا”، وقد ثبتَ أنَّ معاويةَ قتَلَ حُجْرَ بنَ عديٍّ وهو من فُضلاءِ وأولياءِ الصحابةِ لأنهُ حَصَبَ الخطيبَ بالحصَى لأنهُ أطالَ في الخطبةِ، رواهُ الحاكمُ في المستدركِ، وثبتَ أيضًا أنَّ معاويةَ كانَ يأمرُ بسَبِّ عليٍّ، رواهُ مسلمٌ.
بعض أقواله
بعدَ أن ذكَرنا عقيدةَ الإمامِ أحمدَ الرفاعيِّ رضيَ اللهُ عنه أحبَبنا أن نُلحِقَ بها بعضَ أقوالِهِ في توحيدِ وتنزيهِ البارِىءِ سبحانَهُ وتَعالى، أخَذناها من كتابِهِ البُرهانِ المؤيَّدِ، ومن غيرِهِ منَ الكتبِ التي نُقِلَت عنه بالإسنادِ الصحيحِ.
يقولُ رضِيَ اللهُ عنه: “صُونوا عقائِدَكُم منَ التمَسُّكِ بظاهِرِ ما تَشابَهَ منَ الكتابِ والسنَّةِ، لأنَّ ذلك من أصولِ الكُفرِ، قالَ تَعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [سورة ءال عمران/7 ].
وقال: “فسَبيلُ المتَّقينَ من السلفِ تنزيهُ اللهِ تَعالى عمَّا دَلَّ عليه ظاهِرُهُ، وتَفويضُ مَعناهُ المرادِ منه إلى الحقِّ تَعالى وتقَدَّسَ، وبهذا سلامةُ الدينِ. سُئلَ بعضُ العارفينَ عن الخالقِ تقدَّسَت أسماؤُهُ فقالَ للسائلِ: إن سألتَ عن ذاتِهِ فليسَ كمثلِهِ شىءٌ، وإن سَألتَ عن صفاتِهِ فهوَ أحدٌ صَمدٌ لم يَلدْ ولم يولَدْ ولم يكُن له كُفوًا أحدٌ، وإن سألتَ عن اسمِهِ فهوَ اللهُ الذي لا إلهَ إلَّا هو عالمُ الغَيبِ والشهادةِ هو الرَّحمنُ الرَّحيمُ، وإن سألتَ عن فِعلِهِ فكلَّ يومٍ هو في شأنٍ. وقد جمعَ إمامُنا الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنه جميعَ ما قيلَ في التوحيدِ بقَولِه: “مَنِ انتهَضَ لمعرفةِ مُدبِّرِهِ فانتَهى إلى مَوجودٍ ينتَهِي إليه فِكرُهُ فهوَ مُشبِّهٌ، وإن اطمَأنَّ إلى العَدمِ الصِّرفِ فهو مُعطِّلٌ، وإن اطمأنَّ لموجودٍ واعترَفَ بالعَجزِ عن إدراكِهِ فهو مُوحِّدٌ”. أي سادَة: نزِّهوا اللهَ عن سِماتِ المحدَثينَ وصفاتِ المخلوقينَ، وطهِّروا عَقائدَكُم من تفسيرِ مَعنَى الاستِواءِ في حقِّهِ تَعالى بالاستِقرارِ كاستِواءِ الأجسامِ على الأجسامِ المستَلزِمَ للحُلولِ، تَعالى اللهُ عن ذلك.
وإيّاكُم والقولَ بالفوقيَّةِ والسفلِيةِ، والمكانِ واليدِ والعينِ بالجارحَةِ، والنزولِ والاتيانِ والانتِقالِ فإنَّ كلَّ ما جاءَ في الكتابِ والسنَّةِ مما يدُلُّ ظاهرُهُ على ما ذُكِرَ فقد جاءَ في الكتابِ والسنَّةِ مثلُهُ مما يؤيِّدُ المقصودَ، فما بقِيَ إلا ما قالَهُ صُلحاءُ السلفِ وهو الإيمانُ بظاهِرِ(1) كلِّ ذلك ورَدُّ عِلمِ المرادِ إلى اللهِ ورسولِهِ، مع تَنزيهِ البارىءِ تَعالى عن الكَيفِ وسِماتِ الحُدوثِ، وعلى ذلك درَجَ الأئمَّةُ” اهـ.
ثم قالَ: “ولكُم حملُ المتَشابِهِ على ما يوافِقُ أصلَ المحكَمِ لأنهُ أصلُ الكتابِ، والمتشابهُ لا يُعارِضُ المحكَمَ، سألَ رجلٌ الإمامَ مالِكًا بنَ أنسٍ رضيَ اللهُ عنه عن قولِهِ تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [سورة طه/5] فقالَ: “الاستِواءُ غيرُ مَجهولٍ (2)، والكيفُ غيرُ مَعقولٍ، والإيمانُ به واجِبٌ، والسؤالُ عنه بدعةٌ، وما أراكَ إلا مُبتدِعًا”، وأمَرَ به أن يُخرَجَ. وقال إمامُنا الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنه لما سئِلَ عن ذلك: “ءامنتُ بِلا تشبيهٍ، وصدَّقتُ بلا تَمثيلٍ، واتَّهمتُ نفسِي في الإدراكِ، وأمسَكتُ عنِ الخَوضِ فيه كلَّ الإمساكِ”. وقال الإمامُ أبو حنيفةَ رضيَ اللهُ عنه: “مَن قالَ لا أعرفُ اللهَ أَفي السماءِ هو أم في الأرضِ فقد كفرَ، لأنَّ هذا القولَ يوهِمُ أنَّ للحَقِّ مَكانًا، ومَن توهَّمَ أنَّ للحقِّ مَكانًا فهو مُشبِّهٌ”. وسُئلَ الإمامُ أحمدُ رضيَ اللهُ عنه عن الاستِواءِ فقال: “استَوَى كما أخبرَ لا كما يخطُرُ للبَشرِ”. وقالَ الإمامُ ابنُ الإمامِ جعفرُ الصادقُ عليه السَّلامُ: “مَن زعَمَ أنَّ اللهَ في شَىءٍ أو مِن شىءٍ أو على شىءٍ فقد أشرَكَ، إذ لَو كانَ على شىءٍ لكانَ محمولًا، ولو كانَ في شىءٍ لكانَ مَحصورًا، ولو كانَ مِن شىءٍ لكانَ مُحدَثًا” اهـ.
وقالَ رضيَ اللهُ عنه: “إذا قُلتُم: لا إلهَ إلَّا اللهُ فقولوها بالإخلاصِ الخالِصِ من الغَيريَّةِ، ومن خُطوراتِ التشبيهِ والكَيفيةِ، والتحتيةِ والفوقيةِ، والبُعديةِ والقُربيةِ” اهـ.
وقال رضيَ اللهُ عنه: “ينقلونَ عن الحلاجِ أنهُ قال: أنا الحقُّ، أخطَأَ بوَهمِهِ، لو كانَ على الحقِّ ما قالَ أنا الحقُّ، يذكُرونَ له شِعرًا يوهِمُ الوَحدةَ كلُّ ذلك ومثلُهُ باطلٌ، ما أُراهُ رجلًا واصِلًا أبدًا، ما أُراه شرِبَ، ما أُراهُ حضرَ، ما أُراه سمِعَ إلا رنَّةً أو طَنينًا فأخَذَهُ الوَهمُ من حالٍ إلى حالٍ، منِ ازدادَ قُربًا ولم يَزدَدْ خَوفًا فهو مَمكورٌ، إيّاكُم والقولَ بهذهِ الأقاويلِ، إن هيَ إلا أباطيلٌ، درجَ السلفُ على الحدودِ بلا تَجاوزٍ، باللهِ عليكُم هل يَتجاوزُ الحَدَّ إلا الجاهِلُ” اهـ.
وقال رضيَ اللهُ عنه: “أصِمُّوا أسماعَكُم عن علمِ الوحدةِ، وعلمِ الفلسَفةِ وما شاكَلَهُما، فإنَّ هذه العلومَ مزالقُ الأقدامِ إلى النارِ، حَمانا اللهُ وإيّاكُم، الظاهر الظاهر” اهـ.
وقال رضيَ اللهُ عنه: “واللهِ يا هذا ما ثمَّ اتصالٌ ولا انفِصالٌ، ولا حُلولٌ ولا انتِقالٌ، ولا حركةٌ ولا زوالٌ، ولا مماسَّةٌ ولا مجاورةٌ، ولا محاذاةٌ ولا مقابلةٌ، ولا مماثَلةٌ ولا مجانَسةٌ ولا مُشاكلةٌ، ولا تجسُّدٌ ولا تصورٌ ولا انفعالٌ، ولا تكونٌ ولا تغيرٌ، كلُّ هذه نعوتُ حدثِكَ، والحقُّ سبحانَهُ من وراءِ نُعوتِكَ وصِفاتِك، إذ هي مُبتدَعاتُهُ ومُخترعاتُهُ، فكيفَ يظهرُ بها أو فيها أو عَنها أو مِنها وبهِ ظهَرَت لا بها ظهَرَ (3)، وهو وراءَ الأشكالِ والمعاني والصورِ، وما بَطنَ فيها وما ظَهرَ، ولا أُدرِكَ بالفِكرِ ولا حُصِرَ في النظرِ(4)” اهـ.
وقالَ رضيَ اللهُ عنه أيضًا: “وهو واحدٌ في ذاتِهِ غيرُ مُتحيزٍ ولا مُنقسِمٌ، ولا حالٌّ ولا مُتحِدٌ” اهـ. ويقولُ في مَوضعٍ ءاخرَ: “فانتبِه أيُّها المغرورُ بظواهرِ الصورِ، فإنكَ منَ اللهِ سبحانَهُ على غَررٍ، وما انطَلَقتَ إليه ووَلَّيتَ نحوَهُ من ظاهرِ التشبيهِ والتجسيمِ يومَ يستظلُّ بمِنَّتِهِ من عذابِ اللهِ سبحانَهُ إذا سألَكَ عن معتقَدِك لا يظلُّكَ من عذابِهِ ولا يُنجيكَ من لهَبِ نارِه” اهـ.
ويقولُ عن صفاتِ اللهِ سبحانَهُ وتَعالى: “فهيَ لهُ لا هيَ هوَ، ولا هي غَيرُهُ” اهـ.
ونقلَ الإمامُ الجليلُ الرافعيُّ عن الثقاتِ من أصحابِهِ أنهُ كانَ يقولُ: “التوحيدُ وِجدانٌ عظيمٌ في القلبِ يمنعُ من التعطيلِ والتشبيهِ” اهـ.
وقال رضِيَ اللهُ عنه: “لَفظَتانِ ثُلمتانِ بالدينِ، القولُ بالوحدةِ، والشطحِ المجاوزِ حدَّ التحدُّثِ بالنعمَةِ” اهـ، وقالَ أيضًا: “إيّاك والقولَ بالوحدةِ التي خاضَ بها بعضُ المتصوفةِ، إيّاكَ والشطحَ فإنَّ الحِجابَ بالذنوبِ أولَى منَ الحجابِ بالكُفرِ ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾” اهـ.
هذه عقيدةُ الإمامِ الرفاعيِّ رضيَ اللهُ عنه التي هي عقيدةُ أهلِ السنَّةِ والجماعَة، وَسُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِه، والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين، وصَلَّى اللهُ علَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وعَلَى ءَالِهِ وصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِين.
————-
(1) مرادُ الإمامِ رضيَ اللهُ عنه بالإيمانِ بالظاهرِ التصديقُ بأنَّ هذه الألفاظَ منَ القرءانِ وأنَّ ما صحَّت الروايةُ بها عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فهيَ من كلامِ رسولِ اللهِ وليسَ مُرادُهُ رضيَ اللهُ عنه أنَّ مَعانيَها المعاني التي يتَبادَرُ الذهنُ إليها لأنَّ هذا خلافُ المقصودِ، ولأنَّ ذلك هو التشبيهُ لله بخَلقِهِ الذي نَهانا اللهُ عنه بقولِهِ: {ليسَ كمِثلِهِ شَىءٌ}. وقد صرَّحَ إمامُنا الرفاعيُّ بأنَّ اعتقادَ المعانِي الظاهرةِ لهذهِ الألفاظِ التي ورَدَت في المتشابِهِ بالصفاتِ منَ الكتابِ والسنَّةِ من أصولِ الكفرِ وذلك كاعتقادِ الوَجهِ المضافِ إلى اللهِ في القرءانِ بمعنَى الجزءِ المركَّبِ في الإنسانِ وغيرِهِ، والعينِ بمَعنى الجزءِ المركَّبِ في الإنسانِ وغيرِهِ، وكذا اليدِ، والمجيءِ الذي ورَدَ في قولِهِ تَعالى: {وجاءَ رَبُّكَ} بمَجيءِ الانتِقالِ الذي هوَ من صِفاتِ الإنسانِ والملائكَةِ وغيرِهِم، والنزولِ إلى السماءِ الدنيا كلَّ ليلةٍ بنُزولِ الانتِقالِ مِن عُلوٍ إلى سُفلٍ الذي هو صفةُ الملائكةِ وغيرِهِم منَ الخَلقِ، لأنَّ ذلك من أصولِ الكفرِ، وذلك الذي أوقعَ بيانَ بنَ سَمعانَ التميمِيَّ في القولِ بأنَّ الخَلقَ واللهَ يَفنَيانِ لكِن اللهَ تَعالى يَبقَى منه الوَجهُ بمَعنَى الجُزءِ المعهودِ في الخلقِ، وقد فهِمَ هذا الفَهمَ الفاسِدَ من قولِهِ تَعالى: {كُلُّ شَىءٍ هَالِكٌ إلَّا وَجْهَهُ}، وما قالَهُ الإمامُ الرفاعيُّ عينُ الصوابِ.
(2) أرادَ به أنهُ معلومٌ وُرودُهُ في القرءانِ، وليسَ مَعناهُ أنَّ الاستِواءَ هو الجلوسُ لكن كيفيَّتَهُ مَجهولةٌ كما تزعُمُ المشبهَةُ والمجسمَةُ.
(3) أي باللهِ تَعالى وُجِدَت، أي هو أوجَدَها وليسَ هي أوجَدَتِ اللهَ.
(4) أي لا يكونُ مَحصورًا بالاستِدلاليِّ العقليِّ، إنما غايةُ الاستِدلالِ العقليِّ الوصولُ إلى أنهُ مَوجودٌ لا يشبِهُ الموجوداتِ وهذا هو النظرُ الصحيحُ.
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة