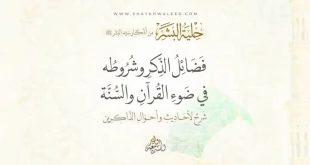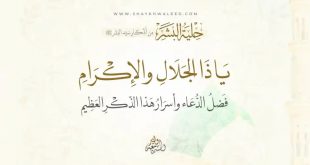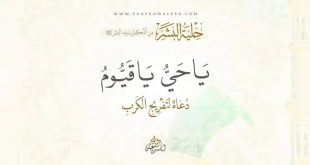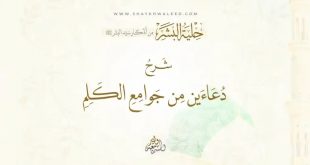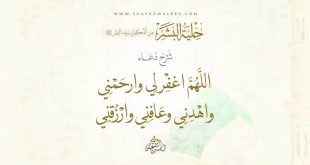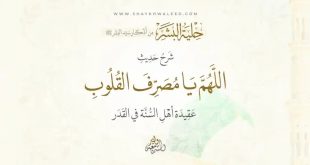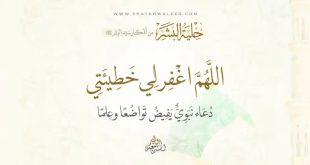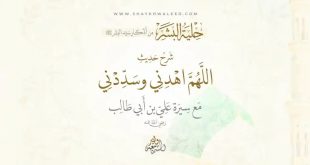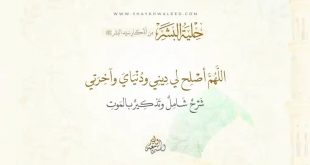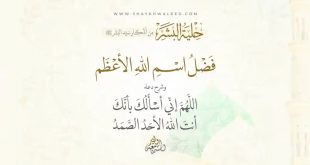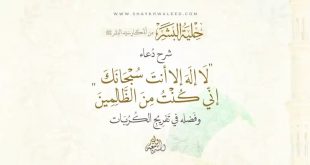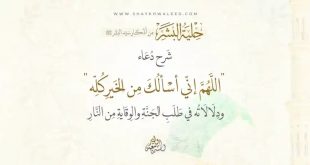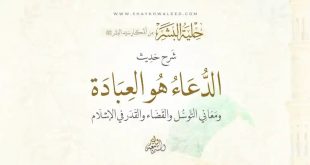المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ للَّهِ أَحْسَنِ الْخَالِقِينَ وَأَكْرَمِ الرَّازِقِينَ، مُكْرِمِ الْمُوَفَّقِينَ وَمُعَظِّمِ الصَّادِقِينَ، وَمُجِلِّ الْمُتَّقِينَ، وَمُذِلِّ الْمُنَافِقِينَ، أَحْمَدُهُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ، وَأُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الذَّاكِرِينَ، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ سَابِقِ الْمُبَكِّرِينَ، وَعَلَى عُمَرَ سَيِّدِ الآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكِرِينَ، وَعَلَى عُثْمَانَ الشَّهِيدِ بِأَيْدِي الْمَاكِرِينَ، وَعَلَى عَلِيٍّ إِمَامِ الْعُبَّادِ الْمُتَفَكِّرِينَ، وَعَلَى عَمِّهِ الْعَبَّاسِ أَبِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، صلاة تنجينا بها من هول يومِ الدّين، وتدخلنا بها الفردوس مع السالمين، أمّا بعد:
الحديث
وَرَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ ءَامَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِى أَنْتَ الْحَىُّ الَّذِى لا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ)).
الشرح والتعليق على هذا الحديث
رَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا هو عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ البَحْرُ أَبُو العَبَّاسِ الهَاشِمِيُّ حَبْرُ الأُمَّةِ، وَفَقِيْهُ العَصْرِ، وَإِمَامُ التَّفْسِيْرِ، أَبُو العَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ، ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ الأَمِيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
مَوْلِدُهُ: بِشِعْبِ بَنِي هَاشِمٍ، قَبْلَ عَامِ الهِجْرَةِ بِثَلاَثِ سِنِيْنَ. صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَ عَنْهُ وَقيل إنَّ الرُّوَاةَ عَنْهُ: قريبا المائَتَانِ، وَأُمُّهُ؛ هِيَ أُمُّ الفَضْلِ لُبَابَةُ بِنْتُ الحَارِثِ بنِ حَزْنِ الهِلاَلِيَّةُ، مِنْ هِلاَلِ بنِ عَامِرٍ.
وَلَهُ جَمَاعَةُ أَوْلاَدٍ؛ أَكْبَرُهُمُ: العَبَّاسُ وَبهِ كَانَ يُكْنَى، وَعَلِيٌّ أَبُو الخُلَفَاءِ – وَهُوَ أَصْغَرُهُم – وَالفَضْلُ، وَمُحَمَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللهِ، وَلُبَابَةُ، وَأَسْمَاءُ.
وَكَانَ وَسِيمًا، جَمِيْلًا، مَدِيدَ القَامَةِ، مَهِيبًا، كَامِلَ العَقْلِ، ذَكِيَّ النَّفْسِ، مِنْ رِجَالِ الكَمَالِ.
وجاء في صحيح البخاري عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ)).
وصحّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: ((اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ تَأْوِيْلَ القُرْآنِ)) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.
قَالَ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلابْنِ عَبَّاسٍ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً.
وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ المَخْزُوْمِيِّ.
وثبت أَنَّ عُمَرَ دَعَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَرَّبه، وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنِّيْ رَأَيتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاكَ يَوْمًا، فَمَسحَ رَأْسَكَ، وَتَفَلَ فِي فِيْكَ، وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ)) رواه الآجري في كتابه الشريعة.
مرة العَبَّاسَ بَعثَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ رَجُلاً، فَرَجَعَ، وَلَمْ يُكَلِّمْهُ. فَلَقِيَ العَبَّاسُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرْسَلتُ إِلَيْكَ ابْنِي، فَوَجَدَ عِنْدَكَ رَجُلًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُكَلِّمَهُ. فَقَالَ: ((يَا عَمِّ! تَدْرِي مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ))؟. قَالَ: لاَ. قَالَ: ((ذَاكَ جِبْرِيْلُ لَقِيَنِي، لَنْ يَمُوْتَ ابْنُكَ حَتَّى يَذْهَبَ بَصَرُهُ، وَيُؤْتَى عِلْمًا)).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَهَبَ النَّاسُ وَبَقِيَ النَّسْنَاسُ. قِيْلَ: مَا النَّسْنَاسُ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يُشْبِهُوْنَ النَّاسَ وَلَيْسُوا بِالنَّاسِ.
وروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: هَلُمَّ نَسْأَلْ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمُ اليَوْمَ كَثِيْرٌ.
فَقَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ، وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ مَنْ تَرَى؟ فَتَرَكَ ذَلِكَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى المَسْألَةِ، فَإِنْ كَانَ لَيبْلُغُنِي الحَدِيْثُ عَنِ الرَّجُلِ، فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ، فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، فَتَسْفِي الرِّيْحُ عَلَيَّ التُّرَابَ، فَيَخرجُ، فَيَرَانِي، فَيَقُوْلُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ! أَلاَ أَرْسَلتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ؟ فَأَقُوْلُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ، فَأَسْأَلَكَ. قَالَ: فَبَقِيَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ، فَقَالَ: هَذَا الفَتَى أَعقَلُ مِنِّي.
وصحّ عنه أنّه قال: إِنْ كُنْتُ لأَسْأَلُ عَنِ الأَمرِ الوَاحِدِ ثَلاَثِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال الحسن البصري: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الإِسْلاَمِ بِمَنْزِلٍ، وَكَانَ مِنَ القُرْآنِ بِمَنْزِلٍ، وَكَانَ يَقُومُ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا، فَيَقرَأُ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَيُفَسِّرُهُمَا آيَةً آيَةً.
وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا ذَكَرَهُ، قَالَ: ذَلِكَ فَتَى الكُهُولِ، لَهُ لِسَانٌ سَؤُولٌ، وَقَلْبٌ عَقُوْلٌ. وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَشِيرُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي الأَمْرِ إِذَا أَهَمَّه، وَيَقُوْلُ: غُصْ غَوَّاصُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ! إِنَّ عُمَرَ يُدنِيكَ، فَاحفَظْ عَنِّي ثَلاَثًا: لاَ تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرًّا، وَلاَ تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا، وَلاَ يُجَرِّبَنَّ عَلَيْكَ كَذِبًا.
وقال عبد الله بن مسعود: وَلَنِعْمَ تَرْجُمَانُ القُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ.
وكان كريما سخيا.
وجاء عَنْ حَبِيْبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيَّ أَتَى مُعَاوِيَةَ، فَشَكَا دَيْنًا، فَلَمْ يَرَ مِنْهُ مَا يُحِبُّ، فَقَدِمَ البَصْرَةَ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَفَرَّغَ لَهُ بَيْتَهُ، وَقَالَ: لأَصْنَعَنَّ بِكَ كَمَا صَنَعتَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ: كَمْ دَيْنُكَ؟ قَالَ: عِشْرُوْنَ أَلْفًا. فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، وَعِشْرِيْنَ مَمْلُوْكًا، وَكُلَّ مَا فِي البَيْتِ.
وَمِمَّا قَالَ حَسَّانٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
إِذَا مَا ابْنُ عَبَّاسٍ بَــــــدَا لَكَ وَجْهُهُ رَأَيْتَ لَـــهُ فِي كُـــلِّ أَقْـــوَالِهِ فَضْلاَ
إِذَا قَــــالَ لَـــمْ يَتْــــرُكْ مَقَالًا لِقَائِلٍ بِمُنْتَظَمَاتٍ لاَ تَرَى بَيْنَهَـــــا فَــصْلاَ
كَفَى وَشَفَى مَا فِي النُّفُوْسِ فَلَمْ يَدَعْ لِذِي أَرَبٍ فِي القَوْلِ جِدًّا وَلاَ هَــزْلاَ
وذهب بصره في آخر عمره رضي الله عنه وكان يقول:
إِنْ يَأْخُذِ اللهُ مِنْ عَيْنَيَّ نُورَهُمَـــــا فَفِي لِسَانِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نُــــــورُ
قَلْبِي ذَكِيٌّ، وَعَقْلِي غَيْرُ ذِي دَخَلٍ وَفِي فَمِي صَارِمٌ كَالسَّيْفِ مَأْثُورُ
وجاء أَنَّ ابْنَ الحَنَفِيَّةِ لَمَّا دُفِنَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: اليَوْمَ مَاتَ رَبَّانِيُّ هَذِهِ الأُمَّةِ.
وقال بعض التابعين: مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا خَرَجُوا بِنَعشِهِ، جَاءَ طيْرٌ عَظِيْمٌ أَبيضُ مِنْ قِبَلِ وَجٍّ حَتَّى خَالطَ أَكْفَانَهُ، ثُمَّ لَمْ يَرَوْهُ، فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ عِلْمُهُ. وقال بعضهم: مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَجَاءَ طَائِرٌ لَمْ يُرَ عَلَى خِلْقتِهِ، فَدَخَلَ نَعْشَهُ، ثُمَّ لَمْ يُرَ خَارِجًا مِنْهُ، فَلَمَّا دُفِنَ، تُلِيَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى شَفِيْرِ القَبْرِ، لاَ يُدْرَى مَنْ تَلاَهَا: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ [سورة الفجر/ الآية 27-28]. وقال بعض الحفاظ: فَهَذِهِ قَضِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ.
وتُوُفِّيَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَنَةَ ثَمَانٍ، أَوْ سَبْعٍ وَسِتِّيْنَ. وَقِيْلَ: عَاشَ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ سَنَةً.
و (مُسْنَدُهُ): أَلْفٌ وَسِتُّ مائَةٍ وَسِتُّوْنَ حَدِيثًا.
وَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي (الصَّحِيْحَيْنِ): خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ.
وَتَفَرَّدَ: البُخَارِيُّ لَهُ بِمائَةٍ وَعِشْرِيْنَ حَدِيثًا، وَتَفَرَّدَ: مُسْلِمٌ بِتِسْعَةِ أَحَادِيْثَ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ أي يا الله لَكَ أَيْ: لَا لِغَيْرِكَ أَسْلَمْتُ أَيِ: انْقِيَادًا ظَاهِرًا وَبِكَ ءَامَنْتُ أَيْ: تَصْدِيقًا بَاطِنًا، ليس معناه أن الإيمان والإسلام يختلفان عند الإطلاق فإنهما إذا أطلقا يراد منهما شيء واحد فالإيمان والإسلام متلازمان، فالمؤمن مسلم والمسلم مؤمن عند الإطلاق من حيث الشرع لا فرق بينهما، فلا يجوز أن يقال عن شخص إنه مؤمن وليس مسلما، بل المسلم مؤمن والمؤمن مسلم كما جاء في كتاب الله حيث قال عز وجل حكاية عن الملائكة الذين أرسلوا لقوم لوط عليه السلام: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [سورة الذاريات/ الآية 35-36] فوصف الخارجين منها مرة بأنهم مؤمنين ومرة بأنهم مسلمين، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ [سورة آل عمران/ الآية 20] وقال تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ [سورة البقرة/ الآية 137] فمؤدَّاهما واحد فهما شيء واحد لا فرق بينهما من حيث الإطلاق الشرعي، وكذلك فإن نقيضهما أي عكسهما واحد فنقيض الإيمان الكفر ونقيض الإسلام الكفر،
وكذلك قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يَكونُ إيمانٌ بلا إسلامٍ، وَلا إسلامٌ بِلا إيمان، فَهُما كالظَّهرِ مَع البطن.اهـ أي الإيمان والإسلام متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر كما لا ينفك الظهر عن البطن، والبطن عن الظهر.
أما من حيث اللغة فيوجد اختلاف في معناهما، فالإيمان لغة التصديق، قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ [سورة يوسف/ الآية 17] أي وما أنت بمصدق لنا.
والإسلام لغة يطلق على الاستسلام والخضوع، وفي هذا المعنى يقول عزّ وجلّ: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [سورة آل عمران/ الآية 83] أي استسلموا وخضعوا وليس المعنى أنهم كلهم مسلمين،
وفي معنى الإسلام والإيمان لغة يقول الله عزّ وجلّ: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [سورة الحجرات/ الآية 14]، قال أبو حيّان الأندلسي في النهر الماد من البحر المحيط ما نصه: “﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة قبيلة تجاور المدينة أظهروا الإسلام وقلوبهم دخلة إنما يحبون المغانم وعرض الدنيا فردّ الله عليهم بقوله: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ كذبهم الله تعالى في دعوى الإيمان وهذا في أعراب مخصوصين ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ وهو الانقياد والاستسلام ظاهرا، فلذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وجاء النفي بـ “لَمَّا” الدالّة على انتفاء الشىء إلى زمان الإخبار به” اهـ.
وقال القرطبي: وَمَعْنَى ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ أَيِ اسْتَسْلَمْنَا خَوْفَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ، وَهَذِهِ صِفَةُ الْمُنَافِقِينَ، لِأَنَّهُمْ أَسْلَمُوا فِي ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قُلُوبُهُمْ، وَحَقِيقَةُ الْإِيمَانِ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ.
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَيِ: اعْتَمَدْتُ فِي أُمُورِي أَوَّلًا وَآخِرًا، أَوْ مَعْنَاهُ أَسْلَمْتُ جَمِيعَ أُمُورِي لِتُدَبِّرَهَا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ نَفْعَهَا وَلَا ضُرَّهَا. وَالتَّوَكُّلُ: الِاعْتِمَادُ وَإِسْلَامُ الْأُمُورِ إِلَى الْمُتَوَكَّلِ عَلَيْهِ وَهُوَ شَأْنُ أَهْلِ الْإِيمَانِ،
فَالتَّوَكُّلُ انْفِعَالٌ قَلْبِيٌّ عَقْلِيٌّ يَتَوَجَّهُ بِهِ الْفَاعِلُ إِلَى اللَّهِ رَاجِيًا الْإِعَانَةَ وَمُسْتَعِيذًا مِنَ الْخَيْبَةِ وَالْعَوَائِقِ، وَرُبَّمَا رَافَقَهُ قَوْلٌ لِسَانِيٌّ وَهُوَ الدُّعَاءُ بِذَلِكَ.
وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [سورة آل عمران/ الآية 159] لِأَنَّ التَّوَكُّلَ عَلَامَةُ صِدْقِ الْإِيمَانِ، وَفِيهِ مُلَاحَظَةُ عَظَمَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ، وَاعْتِقَادُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَعَدَمُ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَهَذَا أَدَبٌ عَظِيمٌ مَعَ الْخَالِقِ يَدُلُّ عَلَى مَحَبَّةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فَلِذَلِكَ أحبّه الله.اهـ
والتَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ هُوَ الثِّقَةُ بِاللَّهِ وَالْإِيقَانُ بِأَنَّ قَضَاءَهُ مَاضٍ، وَاتِّبَاعُ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السّعي فيما لابد مِنْهُ مِنَ الْأَسْبَابِ مِنْ مَطْعَمٍ وَمَشْرَبٍ وَتَحَرُّزٍ مِنْ عَدُوٍّ وَإِعْدَادِ الْأَسْلِحَةِ وَاسْتِعْمَالِ مَا تَقْتَضِيهِ سُنَّةُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُعْتَادَةُ.
وَقالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [سورة الطلاق/ الآية 3] أي: كافِيهِ. أَيْ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَهُ كَفَاهُ مَا أَهَمَّهُ.
وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خَيْثَمٍ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وعد أَنَّ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَمَنْ آمَنَ بِهِ هَدَاهُ، وَمَنْ أَقْرَضَهُ جَازَاهُ، وَمَنْ وَثِقَ بِهِ نَجَّاهُ، وَمَنْ دَعَاهُ أَجَابَ دعاه. وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [سورة التغابن/ الآية 11]، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [سورة الطلاق/ الآية 3]، ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ﴾ [سورة التغابن/الآية 17]، ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [سورة آل عمران/ الآية 101]، ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [سورة البقرة/ الآية 186].
وقدْ روَى الحافظُ أبو نُعَيمٍ أنَّ رجلًا سألَ بعضَ الزهادِ مِنَ السلفِ: علَى أيِّ شيءٍ بَنَيْتَ أمرَكَ فِي التوكلِ؟ فقالَ: علَى أربعِ خصالٍ: عَلِمْتُ أنَّ رِزْقِي لَا يَأْكُلُهُ غَيْرِي فَاطْمَأَنَّتْ بهِ نَفْسِي، وعَلِمْتُ أنَّ عَمَلِي لَا يَعْمَلُهُ غَيْرِي فَأَنَا مَشْغُوْلٌ بِهِ، وَعَلِمْتُ أَنَّ الموتَ يَأْتِي بَغْتَةً فَأَنَا أُبَادِرُهُ، وَعَلِمْتُ أَنَّ اللهَ يَرَانِي فَأَنَا مُسْتَحٍ مِنْهُ.
وإنَّ لنَا قدوةً عظيمةً بِأنبياءِ اللهِ تعالَى فَهُمْ مَنْ نَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ التوكلَ علَى اللهِ عزَّ وجلَّ وخصوصًا مِنْ سيدِنَا محمدٍ ﷺ فقدْ دَعَى إلَى اللهِ عزَّ وجلَّ مَعَ تكالُبِ المشركينَ عليهِ وَنَصَرَهُ اللهُ وأَعْلَى ذِكْرَهُ وَرَفَعَ مَقَامَهُ، وكذَلكَ خليلُ اللهِ إبراهيمُ عليهِ السلامُ فقدْ صَنَعُوْا لَهُ الْمَنْجَنِيْقَ لِيَرْمُوهُ مِنْ مكانٍ بعيدٍ، فَأَخَذُوا يُقَيِّدُوْنَهُ وهوَ متوكلٌ علَى اللهِ حقَّ توكلِهِ، فَلَمَّا وَضَعُوْهُ فِي كَفَّةِ هذَا الْمَنْجَنِيْقِ مُقَيَّدًا كانَ يَقُولُ «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ» فَلَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ قَالَ بِلِسَانِ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللهِ «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل» أيْ نِعْمَ الموكولُ إليهِ أمرُنَا. فَلَمَّا أُلْقِيَ لَمْ تَحْرِقْهُ النَّارُ وَلَمْ تُصِبْهُ بِأَذًى وَلَا ثَيَابَهُ، لأنَّ النَّارَ لَا تُحْرِقُ بِذَاتِهَا وَطَبْعِهَا وَإِنَّمَا اللهُ يَخْلُقُ الإِحْرَاقَ فِيْهَا.
وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ أَيْ: رَجَعْتُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ أَوْ مِنَ الْغَفْلَةِ إِلَى الذِّكْرِ.
والقاعدة عند العلماء في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم معصومون عن الكفر والكبائر والصغائر التي فيها خسة ودناءة نفس أما الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة نفس فتجوز عليهم ولكن يوفقون للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم، وليعلم أن النبي كان يدعو بمثل هذا الدعاء وغيره مما ذكرنا في الدروس السابقة حتى يُعلّم أمّته أن يدعوا بها.
وَبِكَ بِإِعَانَتِكَ خَاصَمْتُ حَارَبْتُ أَعْدَاءَكَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ أَيْ: بِغَلَبَتِكَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ومن أسماء الله الْعَزِيْزُ: هوَ القويُّ الذي لا يُغلَبُ لأنَّه تعالى غَالِبٌ على أمرِهِ، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سورة إبراهيم/ الآية 4]، فهوَ العزيزُ الذي لا غالبَ ولا قاهرَ لهُ سبحانَه، فاللهُ تعالى غيرُ مغلوبٍ فلذلكَ قالَ أهلُ السنةِ: اللهُ تعالى لا يجبُ عليهِ شىءٌ لأنَّه لا غالبَ لهُ وليس كما تقول المعتزلة، فَمَنْ جَعَلَ اللهَ يجبُ عليهِ شىءٌ فهذا ليسَ مسلمًا، أمَّا قولُه تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الروم/ الآية 47] أيْ وعدًا منَّا،
فهوَ سبحانَه الذي لا حاملَ لهُ على فعلِ شىءٍ ولا مُلجىءَ لهُ قالَ تعالى حكايةً عن عيسى عليهِ السلامُ: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سورة المائدة/ الآية 118] قالَ القرطبيُّ: “قالَ تعالى: ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ولم يقلْ: فإنَّك أنتَ الغفورُ الرحيمُ. ولوْ قالَ: فإنَّك أنتَ الغفورُ الرحيمُ لأوهَمَ الدعاءَ بالمغفرةِ لِمَنْ مَاتَ على شِرْكِهِ وذلكَ مستحيلٌ؛ فالتقديرُ: إن تُبْقِهِم على كفرِهم حتى يموتوا وتعذِّبْهم فإنَّهُم عبادُك، وإنْ تَهدِهِم إلى توحيدِك وطاعتِك فتغفرَ لهم فإنَّك أنتَ العزيزُ الذي لا يمتنعُ عليكَ ما تريدُه، الحكيمُ فيمَا تفعلُه تضلُّ مَنْ تشاءُ وتهدي مَنْ تشاءُ”. اهـ
وقالَ اللهُ تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة المنافقون/ الآية 8] قالَ أبو حيَّانَ: ولما سمعَ عبدُ اللهِ ولدُ عبدِ اللهِ بنِ أبيٍّ هذهِ الآيةَ جاءَ إلى أبيهِ فقالَ: أنتَ واللهِ يا أَبَتِ الذليلُ، ورسولُ اللهِ ﷺ العزيزُ، فلمَّا دَنَا مِنَ المدينةِ جَرَّدَ السيفَ عليهِ ومَنَعَهُ الدخولَ حتى يأذنَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ، وكانَ فيما قالَ لهُ: وراءَكَ لا تدخلْها حتى تقولَ: رسولُ اللهِ ﷺ الأعزُّ وأنَا الأذلُّ، فلم يزلْ حبيسًا في يدِهِ حتى أذنَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ بتخليتِهِ. وفي هذا الحديثِ أنَّهُ قالَ لأبيهِ: لئنْ لم تشهدْ للهِ ولرسولِه بالعزةِ لأضربنَّ عنقَكَ، قالَ: أفاعلٌ أنتَ؟ قالَ: نَعَمْ، فقالَ: أشهدُ أنَّ العزةَ للهِ ولرسولِه وللمؤمنينَ.
واللهُ يعزُّ مَنْ يشاءُ ويُذِلُّ مَنْ يشاءُ فاللهُ تعالى أعزَّ أناسًا بالإيمانِ وأذلَّ آخرينَ بالكفرِ، فبالطاعةِ تصيرُ عزيزًا وبالمعصيةِ تصيرُ ذليلًا،
يومَ القيامةِ ينادى في الناسِ أينَ الذينَ تتجافَى جنوبُهم عنِ المضاجعِ، فيكونونَ عزيزينَ في ذلكَ اليومِ،
وأما حالُ الذينَ يظنُّونَ أنفسَهم أعزاءَ في الدنيا بكفرِهم فيكونونَ أذلةً يُسحَبونَ على وجوهِهِم إلى نارِ جهنمَ، فالمؤمنونَ عزيزونَ بطاعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، كانَ بعضُ الصحابةِ في الجاهليةِ على ذلٍّ وهوانٍ مِنَ الناسِ، وبعدَ الإسلامِ أكرمَهم اللهُ بهذا الدينِ وبأنْ ذلَّل لهم رقابَ الكافرينَ حتى دانتْ لهم أكبرُ ممالكِ الأرضِ، ولم يكنْ كلُّ هذا بسببِ كثرةِ الأموالِ أو العدةِ والعَتادِ بلْ بصدقِ توكلِهم على اللهِ عزَّ وجلَّ، وبتمكنِ هذا الدينِ في قلوبِهم فصاروا أعزةً كِرامًا،
فقدْ روى الحاكمُ عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: خرجَ عمرُ بنُ الخطابِ إلى الشامِ ومعنا أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ، فَأَتَوا على مخاضةٍ وعمرُ على ناقةٍ لهُ، فنزلَ عنها وخلعَ خُفَّيْهِ فَوضَعَهُما على عاتِقِه وأخذَ بزمامِ ناقَتِهِ، فخاضَ بها المخاضةَ، فقالَ أبو عبيدةَ: يا أميرَ المؤمنينَ أَأَنتَ تفعلُ هذا تخلعُ خفيَّكَ وتضعُهما على عاتِقِك وتأخذُ بزمامِ ناقتِك وتخوضُ بها المخاضةَ، ما يسرُّني أنَّ أهلَ البلدِ استَشْرَفُوك – اسْتَشْرَفُوكَ أَي خرجوا إِلـى لقائك -، فقالَ عمرُ: أَوَّهْ – هي كلمة توجع وتحزن – لو يقلْ ذا غيرُك أبا عبيدةَ جعلتُه نكالًا لأمةِ محمدٍ، إنَّا كنَّا أذلَّ قومٍ فأعزَّنا اللهُ بالإسلامِ، فمهْمَا نطلبُ العزَّ بغيرِ مَا أعزَّنَا اللهُ بهِ أذلنَا الله.اهـ
وردَ عن عليِ بنِ أبي طالب أنَّهُ قالَ: مَنْ خَتَمَ مَجلسَهُ بقولِهِ تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: 180-182] فقدْ نالَ المكيالَ الأوفَى.
مِنْ خواصِّ اسمِ اللهِ “العزيزِ”: أنَّ مَنْ ذَكَرَهُ أربعينَ يومًا كلَّ يومٍ أربعينَ مرةً أغناهُ اللهُ وأعزَّه ولم يُحْوِجْهُ لأحدٍ.
لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لا معبود بحقّ إلا أنت ولا خالق غيرك أَنْ تُضِلَّنِى أَيْ: أَعُوذُ مِنْ أَنْ تُضِلَّنِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَوَفَّقْتَنِي لِلِانْقِيَادِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فِي حُكْمِكَ وَقَضَائِكَ وَالْمُخَاصِمَةِ مَعَ أَعْدَائِكَ وَالِالْتِجَاءِ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَى عِزَّتِكَ وَنُصْرَتِكَ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [سورة آل عمران/ الآية 8]
أي تهلكني بعدم التوفيق والرشاد، وفي الصحاح ضَلَّ الشيء ضاع وأما قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [سورة الضحى/ الآية 7]، أي لم تكن أوحيت عليه تفاصيل الشريعة ثم نزلت عليه بعد ذلك وليس المعنى الضلال عن الحق ولا الضلال في العقيدة.
وليس معنى الحديث في قوله: ((أن تضلني)) أن الله يسمى مضلًّا أو ضالًّا، بل الله يخلق الهداية فيمن شاء ويخلق الضلالة فيمن شاء فأنا أستعيذ بالله أن يجعل فيَّ الضلالة. هذا معنى الحديث.
أَنْتَ الْحَىُّ الَّذِى لا يَمُوتُ هذا فيه إثبات صفة الحياة لله عز وجل وهي صفة من صفات الله الواجبة الثابتة له إجماعا وهو كونه حيا سبحانه، وَاللهُ تعالَى حَيٌّ بحياةٍ أزليّة لا بداية لها أبديّة لا نهاية لها، ليس كحياتنا بوجهٍ من الوجوه، فحياتنا بسبب روحٍ في جسدٍ من مُخٍّ وعظمٍ وعصبٍ ولحمٍ وغير ذلك، وأما حياة الله فليست مشابهة لحياة غيره، فهي حياة لا بروحٍ ولا بعظمٍ ولا بعصبٍ ولا بلحمٍ ولا بغيرها من لوازم الحدوث. ومعنَى “لوازم الحدوث” أي ما لا يستغني عنها الحادث في وجوده، كتحيُّز الجِسم وكونه إمّا ساكِن وإمّا متحرِّك، وغير ذلك. والدليل على أنّ حياة الله تعالَى ليست كحياتِنا قوله تعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة الشورى/ الآية 11]،
وأمّا قوله تعالَى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [سورة الحجر/ الآية 29]، وقوله: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ [سورة الأنبياء/ الآية 91]، وأمثال ذلك فليس معناه أنّ لله رُوحًا يحيَى بها، حاشا لله، بل الرُّوح هنا في الآيات الكريمة مضافة إلى الضمير العائد إلى الله عَزّ وجلّ وهي إضافة على سبيل التشريف والتكريم لِرُوح ءادَم وعيسى عليهما السلام عند الله، كما يقال عن المسجد “بيت الله” وعن ناقة نبيّ الله صالِحٍ عليه السلام “ناقةُ الله”،
والرُّوح جِسم لطيف يَحْيَا به ذُو الرُّوح وهو الإنسان والجِنّ والملائكة والبهائم، وهي قسمان: أرواح مُشَرَّفة، وأرواح خبيثة. فأمّا أرواح الأنبياء فَمِن القِسم الأول، وأمّا أرواح الكافرين فمن القِسم الثاني، وكذب الدين من يعتقد أن الله تعالى رُوح أو أنّ له روحًا، وكذلك كذب الدين من يُسَمِّيه “الرُّوح”. وأمّا تسمية جبريل عليه السلام “الرُّوح القُدس” في النُّصوص الشرعية نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [سورة النحل/ الآية 102]، والقُدس وهو الطُّهر، ومعناه الرُّوح المقَدَّس أي الْمُطَهَّر مِن المآثِم.
الإضافة إلى اسم الله أو ضمير عائد إليه
إضافة حقيقة إضافة مجاز
للتشريف() للمِلْك
نحو: ﴿وَبِكَلَامِي﴾ [سورة الأعراف/ الآية 144] أي كلام الله الذاتيّ الذي ليس حرفًا ولا صوتًا ولا يشبه كلام أحدٍ من العالَمِين بوجهٍ من الوجوه نحو: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾ [سورة البقرة/ الآية 125] أي البيت المشرَّف عند الله وهو البيت الحرم حيث الكعبة نحو: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾ [سورة العنكبوت/ الآية 56] أي الأرض التي خلقها الله وهو مالِكُها على الحقيقة
وأمّا الدليل من النصوص الشرعية على حياة الله الأزلية الأبديّة وأنّها ليست كحياتنا فكثيرة جِدًّا، منها:
وقوله تعالى: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [سورة غافر/ الآية 65]، وهذه الآية الأخيرة قد نُصّ فيها على حياة الله بلفظ ﴿هُوَ الْحَيُّ﴾ فالمبتدأ ضمير معرفة والخبر معرفة وهذا يفيد الحصر وأنْ لا حَيّ بحياة كحياته إلا هو عزّ وجلّ، فذلك وَجَب أن يحمل ذلك على الحَيِّ الذي يستحيل أن يموت وأنّ حياته لا بداية لها، ولا حيّ بحياة ذاتيّة أزليّة أبديّة إلا هو،
وأمّا الحياة الأبديّة التي تكون للمؤمنين في الجنّة وللكافرين في النّار فتلك حياة غير ذاتيّة أي ليسوا هم مَن خصّوا أنفسهم بها وإنّما تلك تكون بتخصيص من الله لهم وهي أبديّة بمعنَى أنّها لا تنقضي لكن لا شكّ أنّ لها بداية.
ومن الحديث: ما رواه ابن ماجه والترمذي في السنن وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا)) ثم ذكر منها: ((الْحَيُّ)). وكذلك ما رواه أبو داود، واللفظ له، والترمذي في السنن وغيرهما من حديث بلال بن يسار بن زيدٍ مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت أبي يُحَدِّثُنِيه عن جدّي أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ)).
والإجماع: نقله الشَهرستاني في “الملل والنحل” فقال: “ومما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قولُهم: البارئ تعالى عالم بعلمٍ، قادر بقدرةٍ، حَيٌّ بحياةٍ” اهـ، وكذا نَقَلَهُ الباقِلّاني في “الإنصاف” والآمدي في “أبكار الأفكار”.
وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ خُصَّا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا الْمُكَلَّفَانِ الْمَقْصُودَانِ بِالتَّبْلِيغِ فَكَأَنَّهُمَا الْأَصْلُ.
وآخر هذا الحديث فيه تذكير لنا جميعا بنهايتنا التي لا بدّ منها وهي خروجنا من هذه الدنيا، فإننا لا بد سنفارق هذه الدنيا ونخرج منها، نسأل الله حسن الختام،
فانظر إليها بعينِ الحقيقةِ فإنها دارٌ كثيرٌ بوائقُها وذمَّها خالقها، وهيَ دارُ نفادٍ لا دارُ إخلادٍ ودارُ عبورٍ لا دارُ حبورٍ ودارُ فناءٍ لا بقاءٍ ودارُ انصرامٍ لا دارُ دوام، جديدُها يبلَى ومُلْكُها يفنى وعزيزُها يُذَلُّ وكثيرُهَا يَقِلُّ وُدُّهَا يموتُ وخيرُها يفوت.
إقبالُهَا خديعةٌ وإدبارُها فجيعةٌ لا تدومُ أحوالُهَا ولا يَسْلَمُ نُزَالُهَا، حالُهَا انتقالٌ وسكونُها زوالٌ، غَرَّارَةٌ خَدُوعٌ مُعْطِيَةٌ مَنُوعٌ نزوعٌ، ويكفي في هوانِها على الله أن الله تعالى لا يُعصَى إلا فيها ولا يُنالُ ما عندَه إلا بتركها.
كيف أَمِنْتَ هذه الحالةَ؟!، وأنت صائرٌ إليها لا محالةَ، أم كيفَ ضيَّعت حياتَك وهيَ مطيَّتك إلى مماتك، أم كيف تهنأ بالشهوات، وهيَ مطيةُ الآفات.
عبادَ الله إنَّ من نظَرَ إلى الدُّنْيَا بعين البصيرة أيقنَ أن نعيمَها ابتلاءٌ، وحياتَها عناءٌ، وعيشَها نكدٌ وصفوَها كدرٌ، وأهلُها مِنْهَا على وجلٍ إما بنعمةٍ زائلةٍ، أَوْ بليةٍ نازلةٍ أَوْ مَنيَّة قاضية.
مسكينٌ منِ اطمأنَّ ورضيَ بدارٍ حلالُهَا حساب، وحرامُها عقابٌ، إن أخذَه مِن حلالٍ حوسِب عَلَيْهِ، وإن أخذَه من حرامٍ عُذِّبَ به، مَنْ أحبَّها أَذَلَّتْه، ومن التَفَتَ إليها ونَظَرَها أعْمَتْه.
كَيْفَ يطمعُ عاقِلٌ في الإقامةِ بدارِ الرحيل، كيفَ يَضحَك من هو مَحْفُوفٌ بمُوجباتِ البُكاءِ والعَويلِ، أسْمَعَنا النَّاصِحُ فَتَصَامَمْنَا، وَأيْقَظَتْنَا الغِيَرُ فَتَنَاومْنَا، وَرَضِينَا بَالْحَياةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخرِة، واشْتَرَيْنَا مَا يَفْنَى بِمَا يَبْقَى فَتِلْكَ إِذًا صفقَةٌ خَاسِرَة.
أَيْنَ الآذَانُ الْواعِية، أيْنَ الأعْيُنُ البَاكِية، قَوْلٌ بلا فِعَالٍ وأمْرٌ بلا امتثال، مَلَكُ الموت في كُل نَفَسٍ يَدْنُو إلى أنْفُسِنَا وأجْسَادُ أَحِبَّتِنَا تحتَ أطباقِ الثرى هَامدةٌ.
تأمَّلْ في قولِ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي وعَى حقيقةَ الدنيا، تأمَّلْه بعينِ البصيرةِ وأمْعِنِ النظرِ فيه واجعلْ له من سمعِك مسمعًا وفي قلبكَ موقِعًا عسى الله أن ينفعَك بما فيهِ من غُررِ الفوائدِ، ودررِ الفرائدِ،
قَالَ عَلِيّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ لِعَمَّارٍ: عَلَامَ تَتَأَوَّهُ؟ إن كَانَ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ خَسِرَتْ صَفْقَتُكَ، وإنْ كانَ علَى الآخِرَةِ فَقَدْ رَبِحَتْ تِجَارَتُكَ، يَا عَمَّارُ إنَّيْ وَجَدْتُ لَذّاتِ الدُّنْيَا في الطَّعَامِ وَأَفْضَلُهُ العَسَلُ وَهُوَ مِنْ حَشَرَةِ، وفي المَلْبُوْسَاتِ وَأَفْضلُهَا الحَرِيْرُ وَهُوَ مِنْ دُوْدِ القَزِّ، وفي المَشْمُوْمَاتِ وَأَفْضَلُهَا المِسْكُ وَهُوَ مِنْ فَأرَةٍ، هَذِهِ العِظَةُ تَكْشِفُ لَنَا عَنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ حَيْثُ جَعَلَ لَذَّاتِهَا في أحْقَرِ الأَشياء، والله أعلم.
فلا تَغُرنّكُم الحَياةُ الدنيا فإنّها دار بالبلاء مَحفُوفةٌ، وبالفناء معروفة، وبِالغَدر مَوْصُوفَةٌ، كُلُ ما فيها زَوال وهي بينَ أهلِها دُوَلٌ وسِجَال، لا تَدُومُ أهوالُها، ولن يَسْلَمَ مِن شرِها نُزَّالهُا، بينما أهلُها منها في رَخَاءٍ وسُرور، إِذا هم مِنها في بلاء وغُرُور. العيشُ فيها مَذْمُوم، والرخاءُ فيها لا يَدُوم، وإنّما أهلهُا فيها أغراضٌ مُسْتَهْدفَة تَرْمِيهم بسهامِها، وتقصِمُهم بِحِمامِها، حتفُه فيها مَقْدُور وحظُّه فيها مَوْفُور.
وقد روي عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ ذهب مرة إلى المقبرة وقَالَ:
أَتَيْتُ الْقُبُورَ فَنَادَيْتُـــــــــــهَا أَيْنَ الْمُعَظَّــــــمُ وَالْمُحْتَقَــــــرْ
وَأَيْنَ الْمُـــدِلُّ بِسُلْطَانِـــــــهِ وَأَيْنَ المزكَّى إِذَا مَـــــا افْتَخَرْ
قَالَ: فَنُودِيتُ مِنْ بَيْنِهَا وَلَمْ أَرَ أَحَدًا:
تَفَانَوْا جَمِيعًا فَمَا مُخْبِــــــرٌ وَمَاتُوا جَمِيعًا وَمَـــــاتَ الْخَبَرْ
تَرُوحُ وتغدو بناتُ الثَّــرى فَتَمْحُوا مَحَاسِنَ تِلْكَ الصُّــــوَرْ
فَيَا سَائِلِي عَنْ أُنَاسٍ مَضَوْا أَمَــــــا لَكَ فِيمَــــا تَرَى مُعْتَبَرْ
والله تعالى أعلم وأحكم
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة