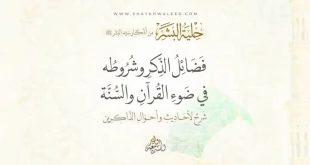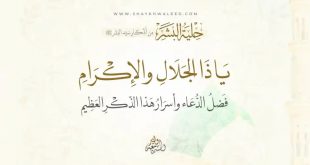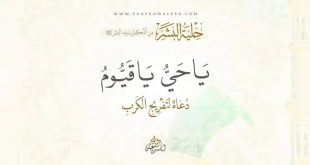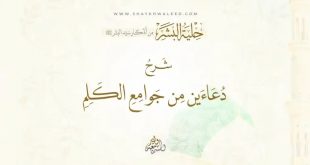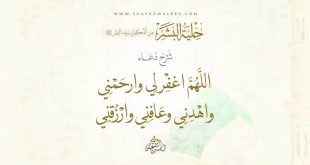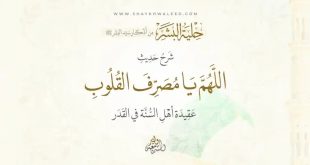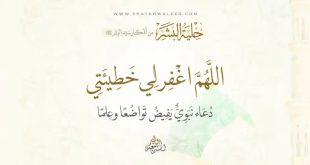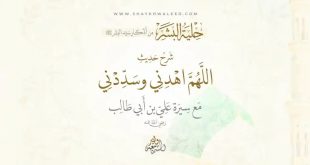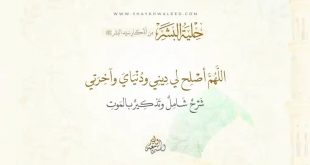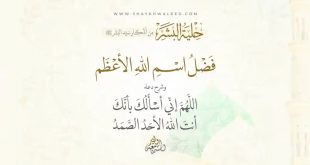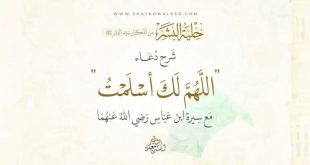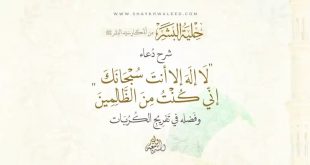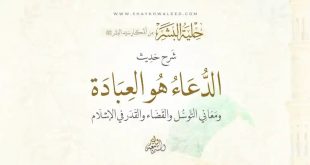المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله الذي أنزلَ على عبده الكتاب ولم يجعل لهُ عوجا، قيّما لِيُنذِرَ بأسا شديدا من لدُنه ويُبشرَ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنَّ لهم أجرًا حسنا، ماكثين فيه أبدا، و يُنذرَ الذين قالوا اتخذَ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كَبُرَت كلمةً تخرجُ من أفواههم إن يقولون إلا كَذِبا،
وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد أشرف الخلائق عُجمًا وعربًا، وأزكى البرية خَلْقا وخُلُقا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق ماله حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي من هيبته ولّى الشيطان هربا، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فُلّ سيف شجاعته قط ولا نبا. أما بعد:
الحديث
وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: ((قُولِى: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَءَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَءَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ شَّرِّ ما عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِى خَيْرًا)).
الشرح والتعليق على هذا الحديث
وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَائِشَةُ بِنْتُ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أبي قُحَافَةَ بْن عَامِرِ بْن عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بن مرة بن كعب بن لؤي. وأمها أم رومان بنت عمير بن عامر.
وقالت عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ عَشْرٍ مِنَ النُّبُوَّةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ لِثَلاثِ سِنِينَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ. وَهَاجَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقدم الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ لاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ. وَأَعْرَسَ بِي فِي شوال عَلَى رأس ثمانية أشهر مِن المهاجر. وَكُنْتُ يَوْمَ دَخَلَ بِي ابْنَةَ تِسْعِ سِنِينَ.
وروى مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((تَزَوَّجَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي))؟
وروي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النِّسَاءَ قَدِ اكْتَنِينَ فَكَنِّنِي. فكَنَاهَا أمَّ عبدِ الله. وفي رواية قَالَ: اكْتَنِي بِابْنِ أُخْتِكِ عَبْدِ اللَّهِ.
وروي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُضِّلَتْ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرٍ. قِيلَ: ما هن يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ:
لَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا قَطُّ غَيْرِي.
وَلَمْ يَنْكِحِ امْرَأَةً أَبَوَاهَا مُهَاجِرَانِ غَيْرِي.
وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَرَاءَتِي مِنَ السَّمَاءِ – أي بوحي من السماء -.
وَجَاءَهُ جِبْرِيلُ بِصُورَتِي – أي يحمل صورتي لا متشكلا بصورتي – مِنَ السَّمَاءِ فِي حريرة، وقال: تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُكَ.
وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِأَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي.
وَكَانَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِأَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي.
وَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَهُوَ مَعِي وَلَمْ يَكُنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي.
وَقَبَضَ اللَّهُ نَفْسَهُ وَهُوَ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي.
وَمَاتَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهَا.
وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.
وقال شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي الصَّادِقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ الْمُبَرَّأَةُ كَذَا وَكَذَا.
وَقَالَ غَيْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللَّهِ.
وروي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: رَأَيْتُهَا تَصَدَّقُ بِسَبْعِينَ أَلْفًا وَإِنَّهَا لَتَرْقَعُ جَانِبَ دِرْعِهَا.
وروي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ قَالَتْ: بَعَثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى عَائِشَةَ بِمَالٍ فِي غِرَارَتَيْنِ يَكُونُ مِائَةَ أَلْفٍ فَدَعَتْ بِطَبَقٍ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَائِمَةٌ، فَجَعَلَتْ تَقْسِمُ فِي النَّاسِ. قال فلمّا أمست قالت: يا جارية هاتي فِطْرِي. فَقَالَتْ أُمُّ ذَرَّةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا اسْتَطَعْتِ فِيمَا أَنْفَقْتِ أَنْ تَشْتَرِيَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَتْ: لا تُعَنِّفِينِي. لَوْ كُنْتِ أَذْكَرْتِنِي لَفَعَلْتُ.
وروي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَشْرَةَ آلافٍ وَزَادَ عَائِشَةَ أَلْفَيْنِ وَقَالَ: إِنَّهَا حبيبة رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَاقِفًا فِي حُجْرَتِي هَذِهِ عَلَى فَرَسٍ وَرَسُولُ اللَّهِ يُنَاجِيهِ. فَلَمَّا دَخَلَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَذَا الَّذِي رَأَيْتُكَ تُنَاجِيهِ؟ قَالَ: وَهَلْ رَأَيْتِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَبِمَنْ شَبَّهْتِهِ؟ قُلْتُ: بِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتِ خَيْرًا كَثِيرًا. ذَاكَ جِبْرِيلُ. قَالَتْ فَمَا لَبِثْتُ إِلا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ: يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامَ. قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ. جَزَاهُ اللَّهُ مِنْ دَخِيلٍ خَيْرًا.
وروي عَنِ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَصُومُ الدَّهْرَ.
وروى الترمذي في سننه عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: ((يَا عَائِشَةُ إِنْ أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِي فليكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الأَغْنِيَاءِ، وَلا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ)).
وقيل: مَاتَتْ عَائِشَةُ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْوِتْرِ فَأَمَرَتْ أَن تُدْفَنَ مِنْ لَيْلَتِهَا فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَحَضَرُوا فَلَمْ نَرَ لَيْلَةً أَكْثَرَ نَاسًا مِنْهَا نَزَلَ أهل الْعَوَالِي فَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ.
وروي عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: كُنْتُ خَامِسَ خَمْسَةٍ فِي قَبْرِ عَائِشَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بكر وعبد الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
روي لها ألفا حديث ومائتان وعشرة، اتفق البخاري ومسلم علـى مائة وأربعة وسبعين، وانفرد البخاري بأربعة وستـين ومسلـم بثمانـية وستـين.
أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: ((قُولِي النبي صلى الله عليه وسلم شفوق بأمته ورفيق بالمؤمنين ورؤوف ورحيم بهم ولا سيما بأهل بيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك لننتبه إلى كل ما أخذنا من الأدعية والأذكار في هذا الكتاب، كلها بلا استثناء تحوي مسائل التوحيد والعقيدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكّد التوحيد في قلوب المؤمنين وهذا أمر ظاهر بأدعيته عليه الصلاة والسلام، فكلها تحوي مسائل التنزيه لله عز وجل وتحوي تثبيت أمر القضاء والقدر والتوكّل على الله تعالى.
وهذا الذي علّمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها هو من أجمع ما ورد في الدعاء، فقد جاء في رواية عند ابن حجر في المطَالبُ العَاليَةُ بِزَوَائِدِ المسَانيد الثّمَانِيَةِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُكَلِّمَهُ فِي حَاجَةٍ وَعَائِشَةُ تُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالْجَوَامِعِ وَالْكَوَامِلِ)). وعلمها هذا الدعاء. والدعاء الجامع هو ما قلّ لفظه وكثر معناه أو التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة أو التي تجمع الثناء على الله وآداب المسألة وغير ذلك:
اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ أي أدعوك أن ترزقني هذا المذكورَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ أي بسائر أنواعه وجميع وجوهه، وتجعل لي نصيبا من الخيرات بكافة أبواب الخير عَاجِلِهِ وَءَاجِلِهِ الآجل على وزن فاعل خلاف العاجل، في الصحاح الآجل، والآجلة ضد العاجل والعاجلة مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أي مما أرشدتني إلى معرفته ومما لم ترشدني إلى معرفته مما تعلمه أنت يا رب العالمين، فأنت سبحانك أحطت بكل شيء علما لا يعزب عن علمك شيء ولا تخفى عليك خافية ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء،
وعلم الله صفة من صفاته الأزلية الأبدية التي ليس لها بداية وليس لها نهاية، لا يتغير علم الله ولا تتغير أي صفة لله تعالى، أمّا معنى قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [سورة محمد/ الآية 31]، مَعْنَاهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِالْقَتْلِ وَجِهَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ حَتَّى نُمَيِّزَ أَىْ نُظْهِرَ لِلْخَلْقِ مَنْ يُجَاهِدُ وَيَصْبِرُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَالِمًا قَبْلُ أَىْ فِى الأَزَلِ قَبْلَ وُجُودِ الْمَخْلُوقَاتِ كَمَا نَقَلَ الْبُخَارِىُّ ذَلِكَ فِى كِتَابِ التَّفْسِيرِ مِنْ صَحِيحِهِ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بنِ الْمُثَنَّى مِنْ فَطَاحِلِ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِه تَعَالَى فِى سُورَةِ الأَنْفَالِ: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [سورة الأنفال/ الآية 37] أَىْ لِيُظْهِرَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مَنْ هُوَ الْخَبِيثُ وَمَنْ هُوَ الطَّيِّبُ،
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَاتِهِ وَبِصِفَاتِهِ وَمَا يُحْدِثُهُ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ عَالِمٌ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لا يَكُونُ أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ بِعِلْمٍ وَاحِدٍ أَزَلِىٍّ أَبَدِىٍّ لا يَتَغَيَّرُ وَلا يَتَطَوَّرُ وَلا يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ.
وَمَا أَوْهَمَ تَجَدُّدَ الْعِلْمِ لِلَّهِ تَعَالَى مِنَ الآيَاتِ الْقُرْءَانِيَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِى سُورَةِ الأَنْفَالِ: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [سورة الأنفال/ الآية 66] فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ ذَلِكَ؛ أَىْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ تَجَدُّدَ الْعِلْمِ أَىْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ خَفَّفَ عَنْكُمُ الآنَ مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْكُمْ مِنْ مُقَاوَمَةِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَضْعَافٍ كَثِيرةٍ مِنَ الْكُفَّارِ بِإِيجَابِ مُقَاوَمَةِ وَاحِدٍ لِاثْنَيْنِ مِنَ الْكُفَّارِ لِأَنَّهُ الآنَ عَلِمَ بِالضَّعْفِ الَّذِى فِيكُمْ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ التَّخْفِيفَ حَصَلَ الآنَ وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ الأَزَلِىِّ مَا فِيكُمْ مِنَ الضَّعْفِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى نَقُولُ قَوْلُهُ: ﴿وَعَلِمَ﴾ لَيْسَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ: ﴿الآنَ﴾ بَلِ الْمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى خَفَّفَ عَنْكُمُ الآنَ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ بِعِلْمِهِ السَّابِقِ فِى الأَزَلِ أَنَّهُ يَكُونُ أَىْ يُوجَدُ فِيكُمْ ضَعْفٌ.
وَأَعُوذُ بِكَ قال ابن الأثير: يُقَالُ: عُذْتُ بِهِ أَعُوذُ عَوْذًا وعِيَاذًا ومَعَاذًا؛ أَيْ لَجأت إِلَيْهِ.
مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَءَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ هذا من جوامع الكلم والدعاء وأحب الدعاء إلى الله الجوامع، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهما بلغ الواحد منا في العلم والفصاحة لن يبلغ أن يسأل الله كما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ولن يستطيع أن يستعيذ بالله كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم.
فهو أفصح الناس صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بربه عزّ وجلّ، وأعلم الناس بما يصلح أحوال الناس، وأعلم الناس بالشرور والفساد، ولذلك كانت هذه الكلمات من أجمع ما ندعو به ربنا عزّ وجلّ.
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ شَّرِّ ما عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن جملة مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَمَرَ أَنْ يُسْتَعَاذَ مِنْهُ ما رواه الطبراني في كتاب الدعاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حُلُولِ الْبَلَاءِ، وَمِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ)).
وما رواه أحمد في مسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ)).
وما رواه مسلم في صحيحه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ)).
وروى الطبراني في المعجم الكبير عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ)).
وما رواه الطبراني في كتاب الدعاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ، وَمِنْ زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رِبًا – وفي رواية: وبالًا –، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنَهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ تَرْعَانِي إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا)).
هذا الدعاء المبارك فيه استعاذة من هولاء، فيهم هذه الصفات الذميمة التي لا ينفك عنها العبد في عيشه في هذه الدار.
فأوّلها: ((جار السوء))
كان أبو الأسود الدؤلي ـ ظالم بن عمرو ـ صاحب علي من سادات التابعين وأعيانهم، واضع علم النحو بتوجيه من علي رضي الله عنه، من أكمل الرجال رأيًا، وأسدهم عقلًا، ويعد من الشعراء، والمحدثين، وصاحب ملح ونوادر، من ذلك كان له جيران بالبصرة، كانوا يخالفونه في الاعتقاد، ويؤذونه في الجوار، ويرمونه في الليل بالحجارة، ويقولون له: إنما يرجمك الله تعالى؛ فيقول لهم: كذبتم، لو رجمني الله لأصابني، وأنتم ترجمونني ولا تصيبونني؛ ثم باع الدار، فقيل له: بعتَ دارك؟! فقال: بل بعت جاري؛ فأرسلها مثلًا.
ولله در القائل:
يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعرفوا جارًا هناك ينغـــــصُ
فقلت لهم كفوا المــــــــــلام فإنــــها بجيرانها تغلو الديار وترخـــــص
وباع أبو الجهم العدوي داره بمائة ألف درهم، ثم قال للمشترين: كم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ فقالوا: وهل يشترى جوار قط؟ قال: ردوا عليَّ داري، وخذوا دراهمكم، والله لا أدع جوار رجل إن فقدتُ سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألتُه أعطاني، وإن لم أسأله ابتدأني، وإن نابتني جائحة فرّج عني.
فبلغ ذلك سعيدًا فبعث إليه بمائة ألف درهم.
وقوله: ((ومن زوج تُشِّيبني قبل المشيب)) وهي المرأة السوء، وهي التي تراها فتسوؤك لقبح ذاتها، أو أفعالها، وتحمل لسانها عليك بالبذاءة، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك.
فينشأ بسببها الشيب قبل وقته، بسبب ما يحصل من الهمّ، والغمّ، وكدر العيش.
قوله: ((وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رِبًا- وفي رواية: وبالًا -)): أي أستعيذ بك أن ترزقني ولدًا يكون عليَّ مالِكًا، لعقوقه وعدم برّه، وتسلّطه عليَّ كأنه هو المالك السيد، وأنا العبد المملوك عنده.
قوله: ((ومن مال يكون عليَّ عذابًا)) ومن مال يكون سببًا لعذابي وخسارتي، لحرصي على جمعه من غير حِلِّه، وهذا المال الحرام الذي تفقد بركته وخيره في معاش العبد، ويورد شرّ الموارد في الآخرة، وتضمّنت هذه الاستعاذة والتي قبلها وبعدها أضداد هذه الشرور في سؤال اللَّه تعالى الرزق من الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والمال الحلال في الكسب والإنفاق، وكذلك مصاحبة الصالحين الذين يعينون العبد في دينه ودنياه وآخرته.
قوله: ((ومن خليل ماكر)) أي أعوذ بك من صديق يظهر المحبة، والخلّة والودّ، وهو في باطن الأمر محتال مخادع.
قوله: ((عينه تراني)) أي ينظر إليَّ نظر الخليل لخليله خداعًا، ومداهنة، ومكرًا.
قوله: ((وقلبه يرعاني)) أي قلبه يراعي إيذائي، وهو لي بالمرصاد، يتربص بي الشرّ والسوء.
قوله: ((إن رأى حسنة دفنها)) أي إذا علم مني بفعل حسنةً فعلتها.
((دفنها)) سترها، وغطّاها، وكتمها، ولم ينشرها.
قوله: ((وإذا رأى سيئة أذاعها)) أي إذا علم مني بفعل سيئة زللت بها، نشرها، وأظهرها خبرًا بين الناس، فهذا والعياذ باللَّه ليس بخليل ولا صديق، إنما هو عدوّ غشوم، ظلوم، وحاله هذه: حال المنافقين التي بيّنها اللَّه تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا﴾ [سورة آل عمران/ الآية 120].
وما رواه الطبراني في كتابه الدعاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ)).
وما رواه أحمد في مسنده عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ)).
وفي رواية الطبراني في المعجم الصغير عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ، وَالْعَيْلَةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفُسُوقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ)).
وما رواه الطبراني في كتاب الدعاء عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ الْخَطَايَا بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اللَّهُمَّ نَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ)).
وما رواه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)).
وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ أي دخولها، وقدْ روى مسلمٌ مِنْ حديثِ أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ عن أَهْل الجَنَّةِ إِذَا دَخَلوا الجَنَّةَ: ((يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا))، وَءاخرُ مَنْ يدخلُ الجنَّةَ مِنَ المؤمنينَ لهُ مثلُ الدنيا وعشرةِ أمثالِها. وقدْ وردَ ذلكَ في حديثٍ صحيحٍ رواهُ البخاريُّ وغيرُهُ.
والواحدُ مِنْ أهلِ الجنَّةِ أقلُّ ما يكونُ عندَهُ مِنَ الولدانِ المخلدينَ عشرةُ ءالافٍ، بإحدَى يديْ كلٍّ منهم صحيفةٌ مِنْ ذهبٍ وبالأخرى صحيفةٌ مِنْ فضةٍ قالَ تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ [سورة الزخرف/ الآية 71]، والأكوابُ جمعُ كوبٍ وهوَ إناءٌ مستديرٌ لا عروةَ لهُ أيْ لا أذنَ لهُ.
وقالَ تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ﴾ [سورة الطور/ الآية 24]، أيْ يطوفُ للخدمةِ غلمانٌ كأنَّهم مِنَ الحُسْنِ والبياضِ لؤلؤٌ مكنونٌ أيْ لم تَمَسَّهُ الأيديْ.
وجاءَ في وصفِهَا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَصْفِهَا: ((هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُوْرٌ يَتَلَأْلَأُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ، وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ فِي مُقَامٍ أَبَدِيٍّ فِي حُبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ)) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.
في بدايةِ هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ ﷺ لأصحابِهِ: ((ألا هَلْ مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ، فَإِنَّ الجَنَّةَ لَا خَطرَ لَهَا))، أيْ لا مثلَ لها، وقولُه ﷺ: ((هِيَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ)) أيْ أقسمُ بربِّ الكعبةِ بأنَّها نورٌ يتلألأُ أيْ فلا تحتاجُ إلى شمسٍ ولا قمرٍ، لا ظلامَ فيها هناكَ كمَا في الدنيا، لكنْ مقدارُ الليلِ والنهارِ يُعرفُ بعلامةٍ جعلَهَا اللهُ فيها.
وَوَصَفَهَا ﷺ بأنَّها: ((رَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ))، أيْ ذاتُ خضرةٍ كثيرةٍ يانعةٍ، وليسَ هناكَ مواسمُ للثِّمارِ، بلْ في أيِّ وقتٍ مَا تشتهيهِ تجدُهُ فقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ [سورة الواقعة/ الآية 33].
وقدْ جاءَ عنِ النبيِّ ﷺ فيما رواه البخاري في صحيحه أنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَلَا يَقْطَعُهَا.
وفي الحديثِ أيضًا وصفُ الجنةِ بأنَّها: ((قَصْرٌ مَشِيْدٌ)) أيْ فيها قصورٌ عاليةٌ مرتفعةٌ في الهواءِ، فقُصُوْرُهَا مِنْ ذَهَبٍ وَمِنْ فِضَّةٍ وَمِنْ لُؤْلُؤٍ، وَبِنَاؤُهَا لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، مِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، كما روى أحمد في مسنده.
وقولُهُ ﷺ: ((نَهْرٌ مُطَّرِدٌ)) أيْ أنهارٌ جاريةٌ لا تكلِّفُ تعبًا بالتناولِ منها، لأنَّها ليستْ في وِهَادٍ عميقةٍ بلْ هيَ جاريةٌ على وجهِهَا علَى وجهِ أرضِ الجنةِ، فنَهَرٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَلَمْ يُحْلَبْ، وَنَهَرٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، وَنَهَرٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ، وَنَهَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُطُونِ النَّحْلِ، يَصِلُ إِلَى بَيْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَرْعٌ مِنْ هَذِهِ الأَنْهَارِ،
قالَ تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [سورة محمد/ الآية 15]
وقولُهُ ﷺ: ((وَفَاكِهَةٌ نَضِيْجَةٌ)) أيْ أنَّ فيها مِنَ الفواكهِ كلَّ مَا تشتهيهِ النفسُ، وكلَّ ما فيها مِنَ الفواكهِ نضيجٌ، وقدْ وردَ أنَّ المؤمنَ يَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ فَيَشْتَهِيهِ، فَيَخِرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَشْوِيًّا.
وَفِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الجَنَّةِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَمُضَّطَجِعِينَ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءُوا، حَجْمُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ، كُلَّمَا نُزِعَتْ مِنْ شَجَرِهَا ثَمَرَةٌ أُعِيْدُ مَكَانَهَا أُخْرَى فَيَأْكُلُوْنَ وَيَعْرَقُونَ وَيَرْشَحُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ.
وأمَّا قولُه ﷺ: ((وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيْلَةٌ)) فتفسيرُهُ ما وردَ في الحديثِ الذي رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ: ((لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الحُوْرِ العِيْنِ)) وهذا الحديثُ صحيحٌ متفقٌ عليهِ،
والحورُ العينُ نساءُ أهلِ الجنةِ مِنْ غيرِ الإنسِ خُلِقْنَ خلقًا مِنْ غيرِ توالدٍ إكرامًا للمؤمنينَ، والحورُ جمعُ حوْراءَ والعِينُ جمعُ عَيناءَ، والحورُ مِنَ الحورِ وهوَ شدَّةُ بياضِ العينِ وشدَّةُ سوادِهَا، وأما العِينُ فمعناهُ واسعاتُ العيونِ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى في وَصْفِهِنَّ: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [سورة الرحمن/ الآية 58] وَهُنَّ خَيراتٌ حِسانٌ أزواجُ قومٍ كرامٍ.
والواحدةُ منهنَّ مِنْ شدةِ صفاءِ عظمِهَا يُرى مخُّ ساقِهَا مِنْ خلالِ الجلدِ وذلكَ مِنْ شدةِ جمالِها.
فائدةٌ:
في الجنة المؤمن غداة كل يوم – الغدو: قبل الظهر أول النهار؛ لذلك العرب يقولون الغداء عن الطعام الذي في أول النهار – يجامع مائة عذراء ولا مني في الجنة، الجنة ليس فيها المستقذرات ولا النجاسات؛ يعني ليس فيها دم حيض وليس فيها مني وليس فيها البزاق الذي هو مستقذر اذا اجتمع في اليد، إنما في أفواههم رطوبة، ليست كهذا البزاق الذي إذا اجتمع في اليد تعافه الأنفس لا يوجد هذا ولا مخاط، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبْصُقُونَ)) رواه عبد الرزاق في مصنفه، يعني هذا البصاق الذي شرحته الآن، ولا يوجد مني ولا يوجد دم.
ولا يوجد جوع إنما يأكلون للاستمتاع، ويشربون للاستمتاع ليس عن جوع وليس عن عطش، أهل الجنة لا يعطشون ولا يجوعون ولا ينامون لإن الله تعالى رفع عنهم التعب الذي هو في الفكر وفي الجسم لذلك لا يحتاجون للنوم. الآن في الدنيا يتعب جسمك ويتعب فكرك فتنام أما في الجنة لا يتعب جسمك ولا يتعب فكرك، ما في مشاكل هناك ما في لغو ما في كذب، ما في غيرة، ولا حسد، أمّا هنا في الدنيا يوجد غيرة، وحسد، وكذب ولغو.
وقولُهُ ﷺ في الحديثِ المذكورِ: ((فِيْ مَقَامٍ أَبَدِيٍّ)) أيْ في حياةٍ دائمةٍ لا نهايةَ لَها.
وقوله ﷺ: ((فِيْ حُبْرَةٍ))، أيْ سرورٍ دائمٍ، معناهُ أنَّهم في بحبوحَةِ عيشٍ أيْ أنَّ عيشَهُم واسعٌ لا يصيبُهُم فيها ضيقٌ وكذلكَ لا ينامونَ لأنَّهم لا يشعرونَ بتعبٍ جسمانيٍّ، ملأَ اللهُ نفوسَهُم سرورًا فلا يجدُ النومُ مجالًا إليهم.
وأمَّا قولُهُ ﷺ: ((نَضْرَةٍ)) فمعناهُ أنَّ وجوهَ أهلِها ناضرةٌ أيْ جميلةٌ لأنَّهم ليسَ عليهم فيها كآبةٌ.
وفي نهايةِ هذا الحديثِ قالَ الصحابةُ لرسولِ اللهِ ﷺ: “نَحْنُ الْمُشَمِّرُوْنَ لها يَا رَسُوْلَ اللهِ”، فَقَالَ: ((قُوْلُوْا إِنْ شَاْءَ اللهُ))، لِيُعَلِّمَهُمُ التفويضَ إلى اللهِ في أمورِهِمْ كلِّها، وَأنَّ الإنسانَ لا ينبغي أنْ يَرْكَنَ إلى نفسِهِ، بلِ اعتمادُهُ على رَبِّهِ، فَمَنْ أرادَ ذلكَ النعيمَ المقيمَ فَلْيَتَّقِ اللهَ بتأديتِهِ الواجباتِ واجتنابِ المحرماتِ.
فهنيئًا لِمَنْ عملَ لآخرتِهِ فإنَّ نعيمَ الدنيا بالنسبةِ لنعيمِ الآخرةِ كَلاَ شىءٍ، فقدْ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ((وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّاْ مِثْلُ مَاْ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ – وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ – فِي اليَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ)) رواهُ مسلمٌ، ومعناهُ هذا البللُ الذي يعلقُ بالإصبعِ ماذا يكونُ بالنّسبةِ لِعِظَمِ البحرِ؟ كَلَا شىءٍ.
وقدْ جاءَ في الحديثِ: ((مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) رواهُ البخاريُّ. والسوطُ هوَ الآلةُ التي تُسْتَعْمَلُ للضربِ وَتكونُ غالبًا مِنَ الجلدِ، أيْ أنَّ المساحةَ التي يأخذُهَا السوطُ إذا وُضِعَ على الأرضِ مِنَ الجنةِ خيرٌ مِنَ الدنيا ومَا فيها.
وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ الذي يقرب إلى الجنة وهو سبب لدخولها هو تقوى الله عز وجل والتقوى لا تنال بغير علم الدين، فالجاهل مهما أتعب نفسه في صور العبادات فإنه لن يصل إلى التقوى فهي أي التقوى حرام على الجاهل لا ينالها، فإن الجاهل لا يميز فقد يخلط ويظن الحلال حراما أو الحرام حلالا وقد يظن أنّه أدّى العبادة على وجهها وهو أنقص ركنا منها أو شرطا منها وهو بهذا غير معذور، فلو كان الجهل عذرا في أكثر أمور الدين لكان الجاهل أفضلَ من العالم، فليس كل جهل يُعَدُّ صاحبه معذورا، وإلا فلو عذر كل جاهل، لكان الجهل خيرًا وأنفع لصاحبه من العلم!
ولهذا قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: لَوْ عُذِرَ الْجَاهِلُ لِأَجْلِ جَهْلِهِ لَكَانَ الْجَهْلُ خَيْرًا مِنْ الْعِلْمِ إذْ كَانَ يَحُطُّ عَنْ الْعَبْدِ أَعْبَاءَ التَّكْلِيفِ وَيُرِيحُ قَلْبَهُ مِنْ ضُرُوبِ التَّعْنِيفِ، فَلَا حُجَّةَ لِلْعَبْدِ فِي جَهْلِهِ بِالْحُكْمِ بَعْدَ التَّبْلِيغِ وَالتَّمْكِينِ، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.اهـ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ أي من دخولها وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ قال الحليمي: هذا من جوامع الكلم التي استحب الشارع الدعاء بها لأنه إذا دعا بهذا فقد سأل الله من كل خير وتعوذ به من كل شر ولو اقتصر الداعي على طلب حسنة بعينها أو دفع سيئة بعينها كان قد قصر في النظر لنفسه.
وأشد ما يوقع في النار هو الكفر بالله والعياذ بالله تعالى فهو سبب لدخول النار والخلود فيها، والكُفْرُ نَقِيضُ الإيمانِ كَمَا أنَّ الظَلامَ نَقِيضُ النُّورِ، وَهُوَ ثَلاثَةُ أبْوَابٍ: التَّشْبِيهُ وَالتَّكْذِيبُ وَالتَّعْطِيلُ. التَّشْبِيهُ: أي تَشْبِيهُ اللهِ بِخَلْقِهِ، كالذي يَصِفُ اللهَ بأنّهُ جالسٌ أو أنَّ له شكلًا وهيئةً أو يصِفه بأنّ له مكانًا أو جهَةً.
التَّكْذِيبُ: أي تَكْذِيبُ مَا وَرَدَ في القرآن الكَرِيمِ أو ما جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهٍ ثابتٍ كَإنْكَارِ بَعْثِ الأجْسَادِ وَالأرْوَاحِ معًا وَإنكارِ وُجُوبِ الصَّلاةِ والصّيامِ والزَّكَاةِ.
التَّعْطِيلُ: وَهُوَ نَفْيُ وُجُودِ اللهِ تَعَالَى وَهُو أشَدُّ الكُفْرِ.
والكَافِرُ نَوْعَانِ: إمّا كَافِرٌ أصْلِيٌّ أوْ مُرْتَدٌّ عَنِ الإسْلامِ.
فَالَكَافِرُ الأصْلِيُّ: هُوَ مَنْ نَشَأ مِنْ أبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ على الكفر وَبَلَغَ على الكُفْرِ.
أمَّا المُرتَدُّ: فَهُوَ الشّخْصُ الذي كَان مُسْلِمًا وَوَقَعَ في أحدِ أنْوَاعِ الرّدَّةِ.
قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [سورة التوبة/ الآية 65-66]
وَالرّدّةُ هيَ الخُرُوجُ عَنِ الإسْلام، فيَجِبُ على كلّ مُسْلِمٍ أنْ يَحْفَظَ إسْلامَهُ وَيَصُونَهُ عَنْ هذِهِ الرّدّةِ التي تُفْسِدُهُ وَتُبْطِلُهُ وتَقْطَعُهُ والعِيَاذُ باللهِ تَعالى.
وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِى خَيْرًا وهذا يعطي معنى التوكل على الله والرضا عن تقدير الله للخير وللشر، يجبُ علينا الرضا بقضاءِ اللهِ وقدرِه وأن لا نعترض على الله تعالى لا بالقلب ولا باللسان ولا بالفعل لأن الله تبارك وتعالى يملِكُنا وما نَمْلِك، كُلُّ شىء مِلكٌ لله تبارك وتعالى وهو حكيم يفعلُ في مُلكِهِ ما يشاء، الله شاء في الأزل أن يكون قسم من الناس طائعين وأن يكونَ قسم من الناس غير طائعين فكان كذلك، اللهُ شاء في الأزل أن يكون قسمٌ من الناس مُنعمين وأن يكون قسم غير مُنعمين فكان كذلك، اللهُ يفعلُ ما يشاء ولا يُعترضُ عليه بشىءٍ سُبحانه: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [سورة الأنبياء/ الآية 23] الله تبارك وتعالى لهُ ما أعطى ولهُ ما أخذ، حتى يدي التي هي جزءٌ مني لستُ أنا الذي أملِكُها الله مالِكُها، أنا أنتفع بهذه اليد لكني لا أملِكُها، حتى المال الذي أملِكُهُ المالكُ الحقيقيُ لهذا المال هو الله تعالى، نحنُ وما نمْلِك مِلكٌ لله واللهُ يفعلُ في مُلكِهِ ما يشاء فعلينا أن نرضى بقضاءِ الله تبارك وتعالى معناهُ أن لا نعترِضَ على الله تبارك وتعالى فيما قضى لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح لأنَّ الذي يعترِضُ على الله تبارك وتعالى يكفر.
ما معنى الاعتراض على الله؟ الاعتراضُ على الله معناهُ نِسبةُ الظُلم إلى الله، معناهُ نِسبةُ عدمِ الحِكمةِ إلى الله وهذا كفر.
إبليس ما هو أول كفر كفرهُ؟ اعترض على الله قال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [سورة الأعراف/ الآية 12] يعني يا رب كيف تأمُرني أن أسجُد له أنا خيرٌ منهُ كيف تأمُرني أن أسجُد له، فاعترض على الله فكان هذا أول كُفرٍ كفرهُ إبليس.
فعلينا أن نرضى بقضاءِ الله تبارك وتعالى ونُسلم تسليمًا لأن الله تعالى مالِكُ كُلِّ شىء يفعلُ في مُلكِهِ ما يشاء عرفنا الحكمة أو لم نعرف علينا أن نُسلِم لله تبارك وتعالى.
فإذًا: يجبُ على المُكلَّفِ أن يَرضَى عن الله أي أن لا يعتَرِضَ على الله لا اعتقادًا ولا لفظًا لا باطنًا ولا ظاهِرًا في قضَائِه وقدَرِه فيَرضَى عن الله تبارك وتَعالى في تقدِيرهِ الخيرَ والشرَّ والحُلوَ والمُرَّ والرِضا والحُزْنَ والرّاحةَ والأَلَمِ معَ التّمييزِ في المَقدُور والمَقضِيّ فإنّ المقدورَ والمقضِيَّ إما أن يكونَ مما يحبه الله وإمّا أن يكونَ مما يكرهُه الله فالمقضِيُّ الذي هو محبوبٌ لله على العبدِ أن يحبه والمقضِيُّ الذي هو مكروهٌ لله تعالى كالمحرّماتِ فعلى العبدِ أن يكرهَه مِنْ غيرِ أن يكرَه تقديرَ الله وقضاءَه لذلكَ المقدورِ، فالمَعاصِي مِنْ جُملة مقدُوراتِ الله تعالى ومقضِيّاتهِ فيجبُ على العبدِ كراهِيَتُها مِنْ حيثُ إنّ الله تعالى يكرَهُها ونهَى عبادَه عنها.
يعني: تقديرُ الله الذي هو صِفةُ اللهِ تعالى هذا نقولُ فيه: تقديرُ اللهِ حسن، لا يُعترَضُ عليه. أمّا ما يحصُلُ بتقدير الله؛ المخلوقُ الذي يُوجدُ بتقديِر الله الذي منهُ خير ومنهُ شر: هذا نرضى بالخيرِ منهُ ولا نرضى بالشرِ منه.
جاء في الحديث حديثِ جبريل: ((وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) رواه مسلم في صحيحه، ما معنى وبالقدر خيرهِ وشرِهِ؟ خيرهِ وشرهِ ليس عن صفة الله، لا، لأن صفة الله لا يُقال منها خير ومنها شر، فإذًا القدر الذي منهُ خير ومنه شر ليس تقديرَ الله الذي هو صِفَتُهُ، إنما القدر الذي منهُ خير ومنهُ شر هو المقدور المخلوق الذي حصل بتقدير الله، الطاعة التي تحصُلُ بتقدير الله هذه خير، المعصية التي تحصُلُ بتقدير الله هذه شر، اللهُ هو الذي قَدَّرَ حصولَ الخير من قسم من العباد وهو الذي قدّر حصولَ الشر من قسم من العباد، الخير بمشيئتِهِ ومحبتِهِ ورضاهُ وأمرِه، الشر بمشيئتِهِ لكن ليس بمحبتِهِ ولا برضاه ولا بأمره. لماذا قلنا بمشيئتِهِ؟ لأنهُ لو كان يحصُلُ بغيرِ مشيئةِ الله لكن اللهُ مغلوبًا عاجزًا، تعالى اللهُ عن ذلك، لا يحصُلُ في مِلْكِ الله إلا ما أراد سُبحانه ما شاء اللهُ كان وما لم يشأ لم يكُن كما أخبرنا الله في القرءان: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [سورة البقرة/ الآية 253]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [سورة السجدة/ الآية 13] إذًا الخيرُ والشر كِلاهُما بتقديرِ الله كِلاهُما بتخليقِ الله كِلاهُما بمشيئةِ الله لكن الخير بمحبةِ الله وأمرِهِ ورضاه، أما الشر فليس بمحبةِ الله ولا بأمرِهِ ولا برضاه.
اللهُ خلق الخير والشر، الطاعة والمعصية، الكفر والإيمان، حتى إذا تأمل المؤمنُ في ذلك يقوى إيمانُهُ بكمالِ قُدرةِ الله وتمامِ حِكمةِ اللهِ عز وجل وتمامِ علمِ الله، لماذا؟ أنت لو رأيت قطعة خشب مُتشابهة، كُل أجزائها مُتشابهة، تتأمل في قطعة الخشب هذه، تقول قطعةُ الخشبِ هذه دليلٌ على وجودِ اللهِ ووحدانيتِهِ وكمالِ علمِهِ وقُدرتِه، لكن لو تأملت في الشجرة التي فيها أجزاء مُختلفة التي كانت بزرة صغيرة ما فيها خشب ولا ورق ولا جذور ولا شىء من ذلك ثم هذه البزرة الصغيرة نما منها جذورٌ وجذع وأوراق وكَبُرت ونمت وصارت شجرة فيها أغصان مُختلفة عليها ثمار مختلفة مع أن هذه الشجرة في ترابٍ واحد تشربُ من ماءٍ واحد وهواء واحد في مزاجٍ واحد مع ذلك نفس البرد يأتي على أجزائها ونفس الحر يأتي على أجزائها مع ذلك أجزاؤها مُختلفة منهُ ما هو أثخن، ومنهُ ما هو أقلُ ثخانة، ومنهُ ما هو أكثف، ومنهُ ما هو أقلُ كثافة، منهُ ما الثمرُ عليه أكثر، ومنهُ ما الثمرُ عليه أقل، حتى الثمار مُختلفة حتى الثمرة الواحدة تختلِفُ أجزاؤها، عندما تتفكر بذلك تزداد إيمانًا ويقينًا بكمالِ قُدرةِ الله عز وجل.
عادةً يكونُ هذا عندك أقوى من تأمُّلِكَ في قطعةِ خشب مُتشابهة، وكذلك إذا تأملت في الناس فوجدت أن الناس كُلهُم بشر كُلُهُم مُركبون من وجه ويدين وصدر وظهر ورجلين مع ذلك منهُم الطويل ومنهُم القصير ومنهُم النحيف ومنهُم السمين، منهُم اللطيف ومنهُم غيرُ اللطيف، منهُم الذكي ومنهُم الغبي، منهُم المؤمن ومنهُم الكافر، منهُم يُحسِنُ المعاملة ومنهُم من يُسيءُ المعاملة، منهُم من يقبلُ النصيحة ومنهُم من يرُدُ النصيحة، عندما تتأملُ في كُلِّ ذلك تزدادُ في قلبِك، والذي خلق ذلك كُلهُ ويُدبر كُلَّ هؤلاءِ البشر الملايين – دون أن نتكلم عن سائر المخلوقات – لمَّا يتفكر المؤمن في هذا وأن الذي يُدبِّرُ هذا كُلهُ هو الله بقُدرتِهِ يزداد إيمانًا وإيقانًا بكمالِ علمِ الله وتمامِ قُدرةِ الله عز وجل.
هذا هو الحكمة من خلقِ الناس مُختلفين على طبائع مُختلفة وعلى أحوالٍ مُختلفة المؤمن يستفيدُ من ذلك يتفكّر في ذلك فيزدادُ إيمانًا ويرتفِعُ درجاتٍ عند الله تبارك وتعالى.
ومن لم يرضَ بقضاءِ اللهِ وقدرِهِ فلا يلومنَّ إلا نفسه. الإنسان لا يرتفِع إلا بالتسليم لله والاستسلامِ لهُ سبحانه أمّا الذي يعترِضُ على الله فلا يضُرُّ إلا نفسه.
والله تعالى أعلم وأحكم
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة