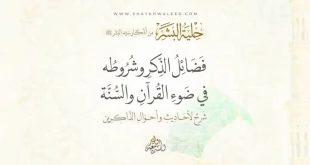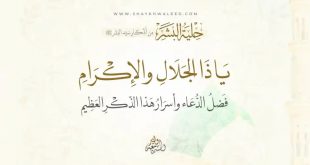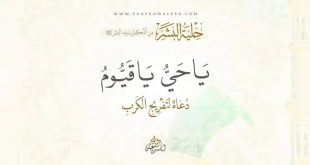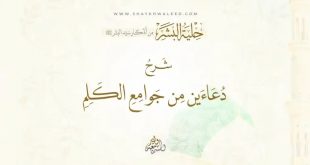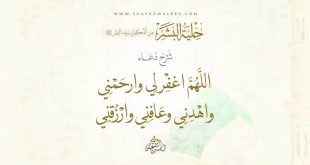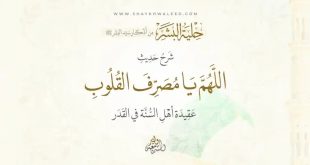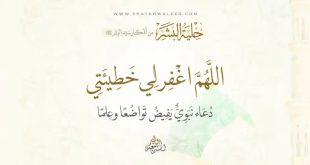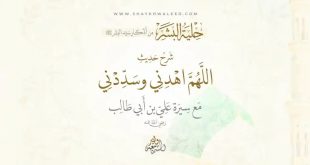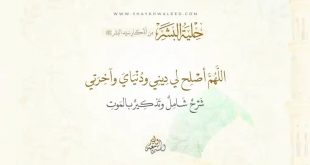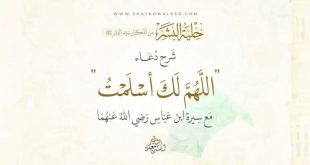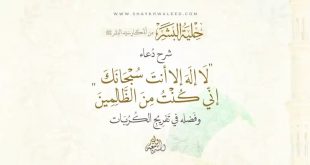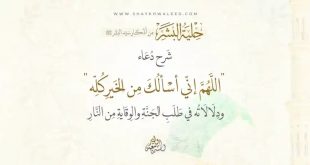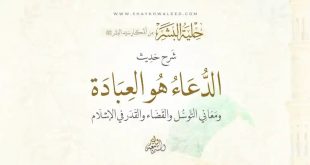المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي ابْتَعَثَ بِلُطْفِهِ السَّحَابَ، فَرَوَّى الأَوْدِيَةَ وَالْهِضَابَ، وَأَنْبَتَ الْحَدَائِقَ وَأَخْرَجَ الأَعْنَابَ، يَبْتَلِي ويمتحن وَإِذَا دُعِيَ أَجَابَ، قَضَى عَلَى ءادَمَ بِالذَّنْبِ ثُمَّ قَضَى أَنْ تَابَ، وَرَفَعَ إِدْرِيسَ وَأَرْسَلَ الطُّوفَانَ وَكَانَتِ السَّفِينَةُ مِنَ الْعُجَابِ، وَنَجَّى الْخَلِيلَ مِنْ نَارٍ شَدِيدَةِ الالْتِهَابِ، وَكَانَتْ سَلامَةُ يُوسُفَ عِبْرَةً لأُولِي الأَلْبَابِ، وأنزلَ الْبَلاءَ عَلَى أَيُّوبَ فَنَادَى مُسْتَغِيثًا بِالْمَوْلَى فَجَاءَ الْجَوَابُ، ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ [سورة ص/ الآية 42] أَحْمَدُهُ تعالى حَمْدَ مَنْ أَخْلَصَ وَأَنَابَ، وَأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ أَفْضَلِ نَبِيٍّ نَزَلَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ كِتَابٍ، وَعَلَى صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ مُقَدَّمِ الصِّحَابِ، وَعَلَى الْفَارُوقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلَى عُثْمَانَ شَهِيدِ الدَّارِ وَقَتِيلِ الْمِحْرَابِ، وَعَلَى عَلِيٍّ الْمَهِيبِ وَمَا سَلَّ سَيْفًا بَعْدُ مِنْ قِرَابٍ، وَعَلَى عَمِّهِ الْعَبَّاسِ الْمُقَدَّمِ نَسَبُهُ عَلَى الأَنْسَابِ. أما بعد:
الحديث
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنِّى أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ: ((لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ تَعَالَى بِالِاسْمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِىَ أَجَابَ)) وَفِى رِوَايَةٍ ((لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ)).
الشرح والتعليق على هذا الحديث
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو بُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَسْلَمِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، قِيْلَ: إِنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ الهِجْرَةِ، إِذْ مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُهَاجِراً وَشَهِدَ: غَزْوَةَ خَيْبَرَ، وَالفَتْحَ، وَكَانَ مَعَهُ اللِّوَاءُ. وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ. وَكَانَ يَحْمِلُ لِوَاءَ الأَمِيْرِ أُسَامَةَ حِيْنَ غَزَا أَرْضَ البَلْقَاءِ، إِثْرَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. لَهُ جُمْلَةُ أَحَادِيْثَ، نَزَلَ مَرْوَ، وَنَشَرَ العِلْمَ بِهَا. حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنَاهُ؛ سُلَيْمَانُ وَعَبْدُ اللهِ، وَأَبُو نَضْرَةَ العَبْدِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَطَائِفَةٌ.
وَسَكَنَ البَصْرَةَ مُدَّةً. ثُمَّ غَزَا خُرَاسَانَ زَمَنَ عُثْمَانَ، فَحَكَى عَنْهُ مَنْ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: وَرَاءَ نَهْرِ جَيْحُوْنَ لَا عَيْشَ إِلَاّ طِرَادَ الخَيْلِ بِالخَيْلِ.
وقال البخاري في صحيحه: بَابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ. [وهذا فيه دليل على جواز وضع عروق الشجر على قبر المؤمن وعلى جواز قراءة القرآن على الميت المسلم].
وَكَانَ بُرَيْدَةُ مِنْ أُمَرَاءِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي نَوْبَةِ سَرْغٍ – سرغ: أوّل الحجاز وآخر الشّام، من منازل حاج الشام -، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: مَاتَ بُرَيْدَةُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ، رُوِيَ لِبُرَيْدَةَ نَحْوٌ مِنْ مائَةٍ وَخَمْسِيْنَ حَدِيْثًا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ هذا توسّل لله تعالى بأسمائه الحسنى، وهو أعظم ما يتقرّب به العبد لربّه عزّ وجّل، أن نتقرّب إلى الله بالتوحيد بالإيمان بأسماء الله وصفاته بكوننا مسلمين،
روي عن عمرَ بنِ ذرٍ أنه ماتَ واحدٌ من جيرانِه وكانَ مسرفًا على نفسِه – أي كان كثيرَ الذنوبِ والمعاصي – فتجافى كثيرٌ من الناسِ عن جِنازته؛ أي لم يحضروها لكونِه كان عاصيًا، فحضَرَها هو وصلى عليها، فلمّا دُلِّيَ في قبرِه وقفَ على قبرِه وقال: يرحمُك الله يا أبا فلان فلقدْ صحِبْتَ عمرَك بالتوحيد وعفَّرْتَ وجهَكَ بالسجود وإن قالوا مذنبٌ وذو خطايا فمَن منا غيرُ مذنب وغيرُ ذي خطايا.
وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْعَزِيزِ: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الأَشْيَاءِ إِلَيْكَ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ، وَلَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ، فَاغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا”.
لا يجوزُ تسميةُ غيرِ اللهِ بهذا الاسم؛ أي الله، وهذا الاسمُ أعظمُ الأسماءِ التسعةِ والتِّسعينَ، فهوَ الاسمُ الأعظمُ عندَ أعلامِ الأُمَّةِ لأنَّه لا شَىءَ مِن الأسماءِ يتكرَّرُ في القرآنِ تكرُّرَهُ، فقدْ وردَ لفظُ الجلالةِ “اللهُ” في القرءانِ الكريمِ ألفانِ وستُّمائةٍ وسبعةٌ وتسعونَ مرةً، واستفتَحَ اللهُ بهِ ثلاثًا وثلاثينَ آيةً في القرآنِ الكريمِ، ولفظُ الجلالةِ اللهُ عَلمٌ للذاتِ المقدَّسِ ومعناهُ مَنْ لهُ الإلهيةُ وهيَ القدرةُ على الاختراعِ أي إبرازِ المعدومِ إلى الوجودِ، ومعنى قولِنا عَلَمٌ أيِ اسمٌ موضوعٌ للدِّلالَةِ على شىءٍ مُعيَّنٍ، فعندمَا نقولُ “سماءٌ” فهذا اسمٌ موضوعٌ للدلالةِ على كُلِّ ما يَعْلُوكَ. ومعنى “موضوعٌ” أنَّهُ اعْتُرِفَ عليه في اللغةِ هكذا، وليسَ أنَّ مجموعةً مِنَ الناسِ اجتمعوا ووضعُوهُ، بل إنَّ أصولَ اللغاتِ توقيفيَّةٌ، أعني أنَّ اللهَ أوحى بها إلى الأنبياءِ وَهُمْ علَّمُوها للنَّاسِ.
فنحنُ نعبدُ اللهَ نعبدُ الذاتَ المقدّسَ المستَحِقَّ للعبادةِ وحدَهُ لا غيرَه، والعبادةُ لا تكونُ إلا للهِ المتصفِ بالعلمِ والحياةِ والقدرةِ والسمعِ والبصرِ وصفاتِ الكمالِ اللائقةِ بهِ سبحانَه، فهوَ المعبودُ بحَقٍّ، والذاتُ بمعنى الحقيقَةِ، فإذا قيلَ ذاتُ اللهِ فالمرادُ حقيقةُ اللهِ، وحقيقتُه أنَّه موجودٌ متصفٌ بصفاتٍ لا يَتَّصِفُ بها غيرُه، فذاتُ اللهِ لا يُشبِهُ الذوات، ليسَ بجسمٍ ولا كيفَ ولا صورةَ لهُ، وليس بذي هيئةٍ وشكلٍ سبحانَه، وقد جاءَ إطلاقُ لفظِ الذاتِ على اللهِ تعالى في قولِ خُبَيبِ بنِ عَدِيٍّ عندما قُدِّمَ للقتلِ قالَ:
وَلَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًـا عَلَـىْ أَيِّ شِقٍّ كَانَ للهِ مَصْرَعِيْ
وَذَلِكَ فِيْ ذَاْتِ الْإلَهِ وَإِنْ يَشَــأْ يُبَاْرِكْ عَلَىْ أَوْصَاْلِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ
ولفظُ الجلالةِ اللهُ علمٌ غيرُ مشتقٍ على قولِ أغلبِ الفقهاءِ كمَا قالَ الخليلُ ابنُ أحمدَ الفَراهيدِيُّ: اسمُ الذاتِ المقدسِ “اللهُ” ليسَ مشتقًّا بلْ مُرتَجَلٌ.اهـ فنقولُ مثلًا العليمُ مُشتَقٌّ مِنْ عَلِمَ، كذلكَ السميعُ مشتقٌّ مِنْ سَمِع، أما لفظُ الجلالةِ “اللهُ” لم يُشْتَقَّ مِنْ لفظٍ آخرَ وما أُطلِقَ على غيرِ اللهِ بالمرَّةِ وهذا الذي اختارَهُ الأكابِرُ مِنَ اللُّغَوِيّينَ، وأسماءُ اللهِ الحسنى تدلُّ على صفاتِ اللهِ إلا لفظَ الجلالةِ اللهَ يدلُّ على الذاتِ، وحُكيَ عن سيبويهِ ما معناهُ أنَّه ليسَ مُشْتقًا مِنْ لفظٍ آخرَ. يقولُ سيبويهِ في كتابِه الذي يُسمَّى “الكتابَ”: “اللهُ أعرفُ المعارِفِ “اهـ لأنَّ كلَّ شىءٍ دليلٌ على وجودِه، فلا شىءَ معروف يشهدُ بوجودِه كلُّ شىءٍ إلا اللهُ، وقد رُؤِيَ سيبويهِ بعد موتِه فقيلَ له ما فعَلَ اللهُ بك؟ قالَ: غَفَرَ لي بقولي: “اللهُ أعرُف المعارِفِ”.
مِنْ خَوَاصِّ لفظِ الجلالةِ “اللهُ”: زيادةُ اليقينِ بتيسيرِ المقاصدِ المحمودةِ، ومَنْ دَاوَمَهُ كلَّ يومٍ ألفَ مرةٍ بصيغةِ “يَا اللهُ” رَزَقَهُ اللهُ قوةَ اليقينِ، ومَنْ تَلَاهُ يَوْمَ الجمعةِ قبلَ الصلاةِ على طهارةٍ ونظافةٍ خاليًا سرًّا مائتي مرة يَسَّرَ اللهُ لهُ مطلوبَهُ، وإنْ تَلَاهُ مريضٌ أَعْجَزَ الأَطِبَّاءَ عِلَاجُهُ بَرِأَ مَا لم يكنْ حَضَرَ أَجَلُهُ.
لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وهذا أصل الإيمان وهو توحيد الله عز وجل، وبه بُعث الأنبياء لتعليمه للناس وإرشادهم إلى التوحيد، كلّ الأنبياء مسلمون، دين جميع الأنبياء هو الإسلام وإنما الاختلاف بينهم كان في الشرائع فكل الأنبياء دعا إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده، فالصواب الذي لا حق إلا هو ولا صواب غيره أن لا دين سماوي نزل به سيّدنا جبريل على أنبياء الله كلّهم من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوى دين الإسلام وشهادة التوحيد وهذا الذي يثبته القرآن الكريم، وهي عقيدة كلّ أنبياء الله هي عقيدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [سورة آل عمران/ الآية 19] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [سورة آل عمران/ الآية 85].
وممّا يدل من القرآن على أنّ الأنبياء عليهم السلام كانوا كلُّهم على الإسلام قوله تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [سورة البقرة/ الآية 132] وقوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [سورة البقرة/ الآية 136] وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة آل عمران/ الآية 67] وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [سورة آل عمران/ الآية 52]، وحديث صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ))، الذين هم من نفس الأم والأب اسمهم أشقاء، ومعنى الإخوة لعلّات إذا كانوا من نفس الأب ولكن أمّهاتهم مختلفة فيقال لهم إخوة لعلات، فالنبيّ ﷺ شبه هذا بهذا بمعنى أن الأنبياء كلهم دينهم واحد وهو الإسلام ولكن شرائعهم مختلفة، مثلا كان في شرع ءادم يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الثاني، وأما في شرع من بعده من شيث إلى محمد فحرام. وكان بشرع أحد الأنبياء إذا وقعت نجاسة على الثوب فكان حكمه أن يقص مكان النجاسة أما في شرع محمد نزل التخفيف أي أن يطهر بإزالة النجاسة وصب الماء عليه. وكان يجوز في شرع أحد الأنبياء أن يجمع بين الأختين أما في شرع محمد فلا يجوز. وكان يجوز في شرع ءادم وشرع يعقوب السجود للإنسان المسلم سجود تحية كفعل إخوة يوسف ليوسف وفعل الملائكة لآدم وأما في شرع محمد فحرام.
وفي حديث موطأ مالك رضي الله عنه عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ))، فأتباع سيّدنا عيسى المسلمون قالوا: لا إله إلا الله عيسى رسول الله، وأتباع سيّدنا موسى المسلمون قالوا: لا إله إلا الله موسى رسول الله، وأتباع سيّدنا محمّد ﷺ قالوا: لا إله إلا الله محمّد رسول الله، ويقال لهم أيضا مسلمون محمديون أي أتباع محمّد ﷺ، وقول الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [سورة الكافرون/ الآية 1-2] وفي آخر السورة: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الآية 6]، معناه لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق وهو الإسلام دين التوحيد وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير، خالق كل شىء هو الله، محمّد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كل أنبياء الله تعالى ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الأَحَدُ هوَ الواحدُ المنزَّهُ عنْ صفاتِ المخلوقاتِ، فاللهُ لا شريكَ لهُ في الأزليةِ، قالَ تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص/ الآية 1]، وقالَ رسولُ اللهِ ﷺ في الحديث الذي رواه البخاري: ((كَانَ اللهُ وَلِمْ يَكُنْ شَىءٌ غَيْرُهُ))، قالَ بعضُ العلماءِ: هوَ بمعنى الواحدِ أيِ الذي لا شريكَ لهُ في الألوهيةِ، وقالَ بعضُهم: الأحدُ هوَ الذي لا يقبلُ الانقسامَ، أي ليسَ جسمًا لأَنَّ الجسمَ يقبلُ الانقسامَ عقلًا، واللهُ ليسَ جسمًا. قالَ تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص/ الآية 1]، وقال تعالى في ذم الكفار: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ [سورة الزخرف/ الآية 15]،
قالَ المناويُّ عنِ اللهِ تعالى: “واحدٌ في ذاتِه لا يقبلُ الانقسامَ والتجزئَةَ، واحدٌ في صفاتِه فلا شبيهَ لهُ، واحدٌ في أفعالِه فلا شريكَ لهُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة الشورى/ الآية 11]،
وقالَ السنديُّ: واحدٌ في ذاتِه لا يقبلُ الانقسامَ والتَّجَزأَ وواحدٌ في صفاتِه لا مثلَ لهُ ولا شبيهَ وواحدٌ في أفعالِه فلا معينَ لهُ.اهـ
قالَ ابنُ الأثيرِ في النهايةِ: فاللهُ واحدٌ في ذاتِه، لا يقبلُ الانقسامَ والتَّجزِئةَ، واحدٌ في صفاتِه فلا شِبْهَ لهُ ولا مثلَ، وَاحِدٌ في أفعالهِ فلا شريكَ لهُ ولا مُعينَ.اهـ
ومما هوَ مقررٌ عندَ المسلمينَ الذي لا خلافَ فيه أَنَّ اللهَ ليسَ جسمًا ولا يوصفُ بالجوارحِ والأعضاءِ فنفيُ الجسميةِ عنِ اللهِ أجمعَتْ عليهِ الأمةُ. “لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، أحدٌ أحدٌ، لم يلدْ ولم يولدْ، ولم يكنْ لهُ كفوًا أحدٌ”، هذا الذِّكْرُ الواردُ عنِ النبيِّ ﷺ فيهِ ثوابٌ عظيمٌ، فقدْ وردَ فيهِ أنَّ مَنْ قالَهُ إحدَى عشرةَ مرةً كُتِبَ لهُ ألفَا ألفِ حسنةٍ [كما روى ابن حجر في المطالب العالية]، وهذا لِمَا حَوَى هذا الذِّكْرُ مِنْ كلماتِ التوحيدِ والتنزيهِ للهِ عزَّ وجلَّ.
قالَ الخطيبُ البغداديُّ في تاريخِ بغدادَ عنْ قبرِ معروفٍ الكرخيِّ: ويقالُ إِنَّه مَنْ قرأَ عندَه مائةَ مرةٍ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص/ الآية 1]، وسألَ اللهَ تعالى ما يريدُ قضى اللهُ لهُ حاجتَه.اهـ وقدِ اشتهرَ أَنَّ مَنْ قرأَ سورةَ الإخلاصِ إحدَى عشرةَ مرةً ثم أهدَى ثوابَها لأهِل مقبرةٍ غُفِرَ لهُ ذنوبٌ بعددِهم.اهـ
الصَّمَدُ هوَ الذي يُصمَدُ إليهِ في الأمورِ كلِّها ويُقصَدُ في الحوائجِ والنوازلِ قالَ تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [سورة الإخلاص/ الآية 2]، فهوَ سبحانَه الذي يقصدُه القاصدُ ويطلبُ منهُ الطالبُ ويتوجهُ إليهِ الداعي بالدعاءِ، وهوَ لا يحتاجُ إلى شىءٍ مِنْ خلقِه، وقدْ وردَ هذا الاسمُ في سورةِ الإخلاصِ وهيَ مِنْ قصارِ السورِ وحَوَتْ معانيَ عظيمةً ووردَ في السنةِ أَنَّ لها فضائلَ كثيرةً لِمَا حَوَتْ مِنْ معاني توحيدِ اللهِ تعالى.
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير: ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْءَانِ وَقُلْ يَاْ أَيُّهَا الكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ القُرْءَانِ))، وقدْ وردَ في صحيح مسلم عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضيَ اللهُ عنهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ))؟ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: ((﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، تعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)) قالَ النوويُّ: “وقالَ القاضي: قالَ المازريُّ: قيلَ معناهُ إِنَّ القرءانَ على ثلاثةِ أنحاءٍ: قصصٌ وأحكامٌ وصفاتٌ للهِ تعالى، و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، متضمنةٌ الصفاتِ، فهيَ ثلثٌ وجزءٌ منْ ثلاثةِ أجزاء”.اهـ
وقالَ بعض شراح الترمذي: ((وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلْثَ القُرْءَانِ)) لأَنَّ علومَ القرءانِ ثلاثةٌ علمُ التوحيدِ وعلمُ الشرائعِ وعلمُ تهذيبِ الأخلاقِ وهيَ مشتملةٌ على الأولِ.اهـ
وقالَ السيوطيُّ: ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلْثَ القُرْءَانِ)) قيلَ معناهُ إِنَّ القرءانَ على ثلاثةِ أنحاءٍ قصصٌ وأحكامٌ وصفاتُ اللهِ تعالى وَ [قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ]، متضمنةٌ للصفاتِ فهيَ ثلثٌ وجزءٌ مِنْ ثلاثةِ أجزاءٍ.اهـ
عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، كُلَّ يَوْمٍ خَمْسِيْنَ مَرَّةً نُوْدِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ قَبْرِهِ: قُمْ يَا مَادِحَ الله فادْخُلِ الجَنَّةَ))، رواه الطبراني في معجمه الصغير.
وَعنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قالَ: نَزَلَ جَبْرَائِيْلُ عليهِ السلامُ فقالَ: يا مُحَمَّدُ ماتَ معاويةُ ابنُ معاويةَ المُزَنِيُّ أَفَتُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ عليهِ؟ قالَ: ((نَعَمْ)). قالَ: فَضَرَبَ جَبْرَائِيْلُ عليهِ السلامُ بِجَنَاحِهِ فلمْ تَبْقَ شجرةٌ ولا أَكَمَةٌ إلا تَضَعْضَعَت، ورُفِعَ له سَرِيْرُهُ حتَّى نَظَرَ إِليهِ وصَلَّى عليهِ، وخَلْفَهُ صفَّانِ مِنَ الملائِكَةِ كُلُّ صفٍّ سبعونَ أَلْفَ مَلَكٍ، فقالَ النبيُّ ﷺ لِجِبْرَئِيْلَ عليهِ السلامُ: ((يا جِبْرَائِيْلُ بمَ نالَ هَذِهِ المَنْزِلَةَ))، فقالِ: بِحُبِّهِ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، وقراءَتِهِ إِيَّاَهَا جائِيًا وذَاهِبًا وقائِمًا وقاعِدًا. رواه البيهقي في السنن الكبرى.اهـ
وَقَد نَحَى بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ إِلَى تَفْسِيْرِ اسْمِ اللهِ الصَّمَدِ بِأَنَّهُ بِمَعْنَى البَاقِي، فَقَالَ قَتَادَةُ: “الصَّمَدُ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾،اهـ
وقالَ الحسنُ البصريُّ رحمهُ اللهُ في معنى الآيةِ ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾: “الذي لم يَزَلْ وَلَا يَزَالُ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الزَّوَالُ كَانَ وَلَا مَكَان وَلَا أَيْنَ وَلَا أَوَان وَلَا عَرْشَ وَلَا كُرْسِيّ وَلَا جِنِيّ وَلَا إِنْسِيّ وَهُوَ الآنَ كَمَا كَانَ” رواه الرازي في تفسيره.
ولقدْ حثَّنا النبيُّ ﷺ أنْ نلتجِأَ إلى اللهِ تعالى في كلِّ أمورِنا فهوَ الصمدُ السيدُ المقصودُ الذى تفتقرُ إليهِ جميعُ المخلوقاتِ فقدْ روى الترمذيُّ عَن أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لِيَسْألْ أحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْألَ شِسْعَ نَعْلِهِ إذَا انْقَطَعَ)).
مِنْ خَوَاصِّ اسمِ اللهِ الصَّمَدِ: مَنْ قَرَأَهُ عِنْدَ السَّحَرِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ مَرْةً كُلَّ لَيْلَةٍ ظَهَرَ عَلَيْهِ آثَارُ الصِّدْقِ.
الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ هذا نفي لعقيدة الحلول والاتحاد، الله تعالى وصف نفسه في القرآن: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [سورة الشورى/ الآية 11]، الله لا مثيلَ له، الله لا شبيه له، لذلك نقل القاضي الفقيه المالكي الذي توفي في أوائل القرن الخامس الهجري، أبو محمد عبد الوهاب المالكي البغدادي في كتابه شرح عقيدة مالك، الإجماع على كفر من قال بما يؤدي إلى الحدوث في حق الله أو إلى الحلول في الأماكن، أو إلى التنقل، أو التطور أو التغير أو بما يؤول إلى التجسيم فذلك كفرٌ عند كافة أهل الإسلام. اهـ
فَلِيُعْلَمْ أن الغلوّ في الدين ممنوع، والغلوّ مجاوزة الحدّ، ومن الغلوّ ما هو كفر وخروج عن الملة المحمدية فإن الانحراف عن الإسلام بدعوى التصوف غير مقبول، وقد رفضه أشياخ هذه الطائفة الكريمة، فقد حذروا مرارًا وتكرارًا من المنحرفين القائلين بوحدة الوجود والقائلين بالحلول والمغالين في المشايخ إلى حد مخالفة الشرع الحنيف. وقد ابتليت طوائف من الناس بعقائدَ فاسدةٍ مضلةٍ ليست من الإسلام في شىء، ودخلت باسم الدين ليهون على أصحابها المارقين التلبيس على الأمة في عقائدها، ومن أخطر هذه الفئات القبيحة طائفة استفحل شرها تَدَّعي أنها صوفية وتسمي نفسها بطائفة التصوف الإسلامي وما أبعدها عن التصوف، وما أبعدَها عن الإسلام وهم أهل الحلول والوحدة المطلقة.
وذلك لأن عقيدة السادة الصوفية الحقيقيين الصادقين غير المدعين المارقين هي التمسك بعقيدة المسلمين والأمر بالواجبات واجتناب المحرمات والتزام نهج الصالحين وعدم التعلق بالدنيا والإقبال بهمة على الآخرة واتباع مسلك الزاهدين. وإنه يحزُّ في أنفسنا ما نرى وما نسمع من أدعياء التصوف الذين شوهوا سمعة الطرق الصوفية، وادعائهم الولايةَ والمقاماتِ والأحوالَ ودرجةَ القطبيةِ والإرشادَ، وافترائُهم على المشايخ الأجلاء، بكلام جُلُّه افتراء، كافترائهم على الشيخ محي الدين بن عربي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي يزيد البسطامي وغيرِهم من أئمة الدين وأعلامِ المسلمين وسادةِ الصوفية الصادقين، والكثيرُ من هؤلاء الأدعياء ارتدوا عن الدين لزندقتهم وانغماسهم في مستنقع القول بالحلول والزندقة ووحدة الوجود المطلقة التي حاربها السادة الصوفية وأعلنوا براءتهم ممن يقول بها وفي هذا يقول السيد الشريف أحمد الرفاعي الكبير: “كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة”. فلا يغرنك كل مُدَّعٍ للتصوف والطريقة وهو يقول بالحلول والوحدة المطلقة فهو مكذِّبٌ للدين على الحقيقة لما في فعله من ضرر على نفسه وعلى الخليقة. واعلم أن كثيرًا من الناس يذمون طرق الصوفية جهلًا وتعنتًا فلا أولئك نجَوا ولا هؤلاء نجَوا إنما يُذَمُّ من حادَ عن الشريعة واتخذ الباطل وهواه سبيلا. وقال الشيخ أحمد الرفاعي: “لفظتان ثلمتان في الدين: القول بالوحدة، والشطح المجاوز لحدّ التحدث بالنعمة”.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ معناه: اللهُ سبحانَه “مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ فِيْ حَقِّهِ” أي ما لا يليقُ بهِ تعالى كالجهلِ والعجزِ والمكانِ والحيزِ واللونِ والحدِّ والتحيزِ في المكانِ والجهةِ. قالَ أبو جعفرٍ الطحاويُّ أحمدُ بنُ سلامةَ المتوفى في أولِ القرنِ الرابعِ الهجريِّ في عقيدتِه التي ذكرَ أنَّها بيانُ عقيدةِ أهلِ السنةِ والجماعةِ على مذهبِ فقهاءِ الملةِ: “لَاْ تَحْوِيْهِ الجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ” معناهُ لا يجوزُ على اللهِ أنْ يكونَ محدودًا. والمحدودُ عندَ العلماءِ ما لهُ حجمٌ كبيرًا كانَ أو صغيرًا، كثيفًا كالإنسانِ والشجرِ أو لطيفًا كالنورِ والظلامِ، فإذًا هوَ منزّهٌ عنْ أنْ يكونَ جالسًا لأنَّ المتصفَ بالجلوسِ لا بدَّ أنْ يكونَ محدودًا، والمحدودُ يحتاجُ إلى مَنْ حدَّهُ بذلكَ الحدِّ ولا يجوزُ أنْ يحدَّ نفسَه بحدٍّ يكونُ عليهِ لأنَّ معنى ذلكَ أنَّهُ خلقَ نفسَه وذلكَ محالٌ لأَنَّ الشىءَ لا يخلقُ نفسَه قالَ اللهُ تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة الشورى/ الآية 11]، فهيَ أصرحُ ءايةٍ في القرءانِ في تنزيهِ اللهِ تعالى التنزيهَ الكليّ، وتفسيرُها أنَّ اللهَ لا يشبهُه شىءٌ بأيِّ وجهٍ مِنَ الوجوه، والكافُ في قولِه: ﴿كَمِثْلِهِ﴾ لتأكيدِ النفيِ، ففي الآيةِ نفيُ ما لا يليقُ باللهِ عنِ اللهِ. وأمَّا قولُه تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ففيهِ إثباتُ ما يليقُ باللهِ، فالسمعُ صفةٌ لائقةٌ باللهِ والبصرُ كذلكَ، وإنَّما قَدَّمَ اللهُ تعالى في هذهِ الآيةِ التَّنزيهَ حتى لا يُتَوَهَّمَ أنَّ سمعَه وبصرَه كسمعِ وبصرِ غيرِه، فاللهُ تعالى موصوفٌ بأنَّه ليسَ كمثلِه شىءٌ مِنَ اللطائفِ كالنورِ والروحِ والهواءِ، ومِنَ الكثائفِ كالشجرِ والإنسانِ. والجسمُ اللطيفُ ما لا يُضبطُ باليدِ، والجسمُ الكثيفُ ما يُضبطُ باليدِ أي ما يُجَسُّ باليدِ، وهو تعالى لا يشبِهُ العلوياتِ ولا السفلياتِ. فإذا وردَ حديثٌ ظاهرهُ فيهِ نسبةُ النقائصِ إلى اللهِ فاعلمْ أنَّ لهُ معنىً يليقُ باللهِ لا يعارضُ ما قرَّرَهُ الشرعُ الحنيفُ مِنْ تنزيهِ اللهِ عَنِ النقائصِ.
فَقَالَ: ((لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ تَعَالَى بِالِاسْمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِىَ أَجَابَ)) وَفِى رِوَايَةٍ: ((لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ)) لفظُ الجلالةِ “اللهُ” هوَ الاسمُ الأعظمُ للهِ تعالى وهوَ أفضلُ الأسماءِ وأعظَمُها، وهذا اللفظ هو أَجْمَلُ كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ؛ لَفْظُ الجَلَالَةِ “اللهُ”، وَاسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ الْمُفْرَدُ كَذَلِكَ هُوَ لَفْظُ الجَلَالَةِ “الله” أَيْ هَذَا بالنِّسْبَةِ لِلْأَسْمَاءِ الْمُفْرَدَةِ، وَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ العُلَمَاءِ: إِنَّ اسْمَ اللهِ الأَعْظَمَ “يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ” فمَعْنَاهُ فِي الدُّعَاءِ ولَيْسَ الاسْمَ الْمُفْرَدَ. وَأَمَّا الإِجْمَاعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، فقَدْ نَقَلَهُ الحَافِظُ العَسْقَلَانِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الأَرْبَعِيْنَ النَّوَوِيَّةِ فَقَالَ: “أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لَفْظَ الجَلَالَةِ اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ، فَهُوَ عَلَمٌ عَلَى الذَّاتِ الأَقْدَسِ الْمُسْتَحِقِّ لِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ” اهـ.
وَقَالَ نُوْرُ الدِّيْنِ السِّنْدِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ: “قَالَ الْقُطْبُ الرَّبَّانِيُّ وَالْغَوْثُ الصَّمَدَانِيُّ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيُّ: الِاسْمُ الْأَعْظَمُ هُوَ اللَّهُ” اهـ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ كَالزَّرْكَشِيِّ فِي تَشْنِيْفِ الْمَسَامِعِ وَالشَّمْسِ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيِّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَالعَلَّامَةِ سُلَيْمَانَ الجَمَلِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَمِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ ابنُ جُزَيٍّ الغِرْنَاطِيُّ الكَلْبِيُّ الْمُفَسِّرُ فِي كِتَابِهِ القَوَانِيْنِ الفِقْهِيَّةِ وَالقَاضِي عِيَاضٌ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِمٍ، وَمِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ الْمَرْدَاوِيُّ فِي التَّحْبِيْرِ شَرْحِ التَّحْرِيْرِ وَابْنُ النَّجَّارِ فِي مُخْتَصَرِ التَّحْرِيْرِ، وَنُقِلَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الفَقِيْهُ مُحَمَّد أَمِين بنُ عَابِدِينَ الدِّمَشْقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ رَدِّ الْمُحْتَارِ عِنْدَ كَلَامِهِ عَلَى لَفْظِ الجَلَالَةِ مَا نَصُّهُ: “وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ عَرَبِيٌّ عَلَمٌ مُرْتَجَلٌ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ أَصْلٍ مِنْهُ، وَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالشَّافِعِيُّ وَالْخَلِيلُ. وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ وَبِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ” اهـ.
فَهَذَا مُخْتَصَرُ الكَلَامِ عَلَى الاسْمِ الأَعْظَمِ الْمُفْرَدِ،
وَأَمَّا بالنِّسْبَةِ لِلِاسْمِ الَّذِي لَهُ تَابِعٌ في بعض الروايات: ((اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِأنَّ لَكَ الحَمْدَ لا إلهَ إلا أَنْتَ الْمَنَّانَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ يَا ذَا الجَلَالِ والإكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ)) هذَا ثَبَتَ حَدِيثًا عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ هذَا فِي صَلَاتِهِ: ((لَقَدْ دَعَوْتَ اللهَ باسْمِهِ الذِي إذَا دُعِيّ بِهِ أَجَابَ وإذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى)) رواه أبو داود في سننه، وَهذَا الحَدِيثُ أَقْوَى مِن كُلِّ مَا وَرَدَ فِي اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ. وَالسِّرُ فِي الْمِفْتَاحِ، مِفْتَاحِ اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ وغَيْرِهِ.
قَبْلَ ثَمَانِينَ سَنَةً، الْمُسْلِمُونَ كَانَ طَعَامُهُم حَلَالًا، فِي تِلْكَ الأَيَّامِ كَانَ إذَا إِنْسَانٌ مرض فاجْتَمَعَ عِنْدَهُ عَدَدٌ وَقَرَأُوا سُورَةَ يس يَتَعَافَى مِن أَيِّ مَرَضٍ حَتَّى لَو كَانَ مَجْنُونًا رُبِطَ بالحَدِيدِ، أمَّا اليَومَ فَفِي الغَالِبِ لا يَحْصُلُ لأَنَّ الحَرَامَ انْتَشَرَ، أَكْلُ الرِّبَا صَارَ كَثِيرًا فَذَلِكَ السِّرُّ لا يَحْصُلُ كَثِيرًا إلَّا قَلِيلاً.
قَالَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّيْنِ السَّفِيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى البُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ: “وَنُقِلَ عَنِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ رُؤِيَ فِي الْمَنَامِ فَقِيْلَ لَهُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِقَوْلِي: إِنَّ اللهَ عَلَمٌ عَلَى ذَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ”، ثُمَّ قَالَ: “وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا: أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا خَاطَبَ مُوْسَى قَالَ: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ [سورة طه/ الآية 14] فَلَوْ كَانَ لَهُ اسْمٌ أَعْظَمَ مِنْهَ لَقَالَهُ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَم يُسَمَّ بِهِ غَيْرُهُ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [سورة مريم/ الآية 65] أَيْ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا تَسَمَّى بِهِ غَيْرُ اللهِ” اهـ ومَن أَطْلَقَ لفظَ الجلالةِ “اللهَ” على غيرِ اللهِ تعالى فقد كفرَ والعياذُ باللهِ تعالى، فلفظُ الجلالةِ “اللهُ” هوَ أكبرُ الأسماءِ وأعظمُها وأجمَعُها، وقدْ قالَ أبو بكرِ بنُ العربيِّ رحمهُ اللهُ: “اللهُ هوَ الاسمُ الأعظمُ الذي يَرجِعُ إليهِ كلُّ اسمٍ (مِنْ أسماءِ اللهِ) ويُضافُ إلى تفسيرِه كُلُّ معنى، وحقيقتُه المنفردُ في ذاتِه وصفاتِه وأفعالِه عن نظيرٍ فهذَا حقيقةُ الإلهيةِ ومَن كانَ كذلكَ فهوَ اللهُ”اهـ
وقالَ الغزاليُّ رحمهُ اللهُ: هوَ – يعني لفظَ الجلالةِ الله- أعظمُ الأسماءِ التسعةِ والتسعين، لأنَّه دالٌّ على الذاتِ الجامعةِ للصفاتِ الإلهيةِ كُلِّها حتى لا يَشُذَّ منها شىءٌ، ولأنَّه أخصُّ الأسماءِ إذ لا يُطلِقُهُ أحدٌ على غيرِهِ تعالى لا حقيقةً ولا مجازًا.اهـ وكانَ مِن دعاءِ النبيِّ ﷺ كما رواهُ السيوطيُّ أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يقولُ: ((أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ [قال البيضاوي: وجه الله مجاز عن ذاته عز وجل تقول العرب أكرم الله وجهك بمعنى أكرمك والكريم الشريف النافع الذي لا ينفد عطاؤه] وباسْمِكَ الكَرِيمِ مِنَ الكُفْرِ والفَقْرِ)).اهـ وحبْرُ الأمَّةِ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: اسمُ اللهِ الأعظمُ “اللهُ”، ألا ترى أنَّه في جميعِ القُرآنِ يُبدأُ بهِ قبلَ كلِّ شىءٍ.اهـ ونُقِلَ كذلكَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ وروى الحافظُ ابنُ أبي شيبةَ والحافظُ ابنُ أبي الدنيا عنِ الشعبيِّ أنَّه قالَ: اسمُ اللهِ الأعظمُ يا اللهُ.اهـ وروى هشامُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ قالَ: سمعتُ أبا حنيفةَ يقولُ: اسمُ اللهِ الأعظمُ هوَ اللهُ.اهـ وبه قالَ الإمامُ الطَّحاويُّ.
هذا الحديث العظيم النفع يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم التوحيد وينشره بين الناس، ففي دعائه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بالتوحيد، فهو أهم ما نعلمه للناس ونخرج به إليهم، وهو الأساس الذي إذا صح من العبد يقبل بقية عمله إن شاء الله إن كان موافقا لما أمر به الشرع، وهذا يبين تماما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا أمته دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الكفر بالله والعياذ بالله، معاذ بن جبل حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن وبلاد الشام، وكان عالما شابا صالحا تقيا شجاعا، فقد روى البخاري عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلّم لمَّا بَعثَ مُعاذًا رضيَ اللهُ عنهُ على اليمنِ قال: ((إنكَ تَقْدَمُ على قومٍ أهلِ كتابٍ، فلْيكُنْ أولَ ما تدَعوهم إليهِ عِبادةُ اللهِ، فإذا عَرفوا اللهَ فأخبرهم: أنَّ اللهَ قد فرضَ عليهم خمس صلواتٍ في يومِهم وليلتَهم، فإذا فَعلوا، فأخبرهم: أنَّ اللهَ فرضَ عليهم زكاةً مِن أموالِهم وتُرَدُّ على فُقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخُذْ منهم، وتَوَقَّ كرائمَ أموالِ الناسِ)).
هذا الحديث يدل على أمور كثيرة، وهي: أن الشخص مهما كان يعبد غير الله فهو ليس موحدا، فهم يدَّعون أنهم أهل توحيد وأنهم يعبدون الله ولكن النبي نفى عنهم ذلك. وقوله: أول ما تدعوهم إليه عبادة الله أي إلى توحيد الله فإذا هم عبدوا الله وتركوا الكفر ودخلوا الإيمان صاروا عابدين لله بالنطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما. والنبي لم يقل له هؤلاء يعبدون الله لا، لم يقل له هؤلاء أهل كتاب فعلمهم الصلاة لا، بل قال: فإن هم أجابوا لذلك أي إن أسلموا فعلمهم الصلاة. فالأصل الأول هو عبادة الله وحده، فالأمور على حسب أولوياتها في الشرع ليس على ما يظنه الجاهل، بعض المجسمة يظن نفسه من عباد الله المخلصين وهم في الحقيقة لم يعبدوا الله بل عبدوا جسما توهموه.
ومن هذا الحديث نعلم أن الأولويات على حسب ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على ما يظنه هؤلاء الجاهلون، بعض الناس يقول لك أهم شيء أن أعرف تلاوة القرآن أو أن أحفظ القرآن أو أن أشتغل بقيام الليل أو بالذكر اللساني ونحو ذلك، وهذا الحديث يبين الأولويات ويرد على كل هؤلاء، ممن لم يعرفوا الأولويات في دين الله فالذي يقرر الأولويات هو النبي صلى الله عليه وسلم لا الهوى والتشهي وماذا يريد فلان وماذا يريد فلان. فمعرفة الله والرسول هي الأساس، ومن الأساس بل أعظم ما يجب التحذير منه هو الكفر بالله، بعض الناس يقول نحذر من الاختلاط بزعمهم، وبعضهم يقول نحذر من الغش في البيع والشراء، نقول لهم هذه كلها منكرات يجب التحذير منها لكن الأولى في التحذير منه هو الكفر بالله والعياذ بالله تعالى وهذا هو نهج محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول عندما بعث في مكة كم كان هناك من عادات خبيثة فاسدة التي انتشرت بين الناس مثل وأد البنات والزنا والربا وغيرها، أول ما بدأهم الرسول عليه السلام التوحيد لم يقل لهم تعلموا الاستنجاء أو فرائض الغسل أو الحجاب، بل بدأهم بالعقيدة وبعد ذلك صارت الأحكام تنزل تباعا وغالب الأحكام نزل في المدينة وفي مكة التركيز على توحيد الله، والنبي كان يمر بهم وهم مجتمعون بالموسم فيقول لهم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا الذي ركز عليه النبي، لأنهم لو بقوا على الكفر وعملوا صور هذه العبادات ظاهرا لا تنفعه عند الله ولا تصح منه ولا تقبل منه. النبي عليه السلام كم أوذي لأجل هذه الدعوة الشريفة. ثم صار الإسلام يدخل إلى بيوت أهل مكة يسلم هذا العبد يسلم هذا الرجل وهذه المرأة ثم انتشر الإسلام وتوسع. ثم أمر آخر أذكره: بلال رضي الله عنه أوذي كل هذا الأذى لأي شيء؟ هل لمجرّد أنّه يصدق في الحديث أو لأنه كان أمينا لا، لأجل التوحيد لأجل الإسلام، لأنه صار يعتقد أن الله أحد. لأجل هذا ضربوه وعذّبوه لأنّه كان يقول أحد أحد لأنّه صار يعتقد أنّ الله ليس له شريك والذي ليس له شريك يكون أزليا لا يكون حادثا والأزلي لا يكون جسما ولا متحيزا في مكان فالأماكن حاثة مخلوقة والأزلي لا يتخصص بالمخلوقات. وتلك الأصنام التي عبدها الكفار ولو كانوا علقوها على الكعبة هي ليست آلهةً تُعبد لأن الألوهية لا تصلح لمن كان جسما والعياذ بالله تعالى. هذا هو الأساس وهذه هي الأولويات وهذا هو الأهم في دين الله.
والله تعالى أعلم وأحكم
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة