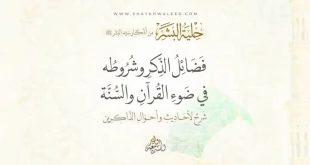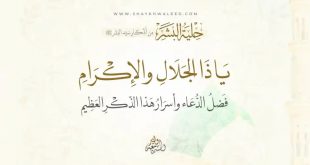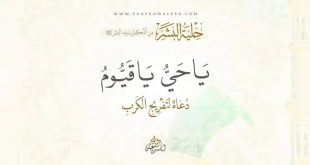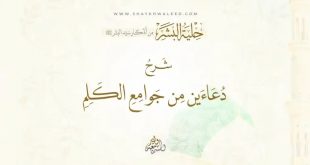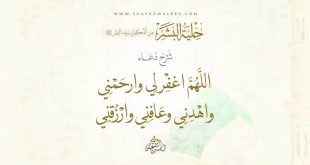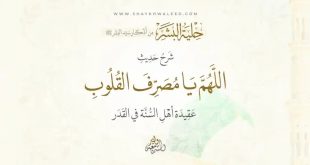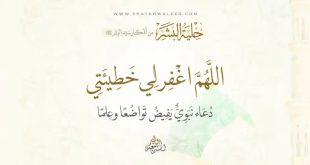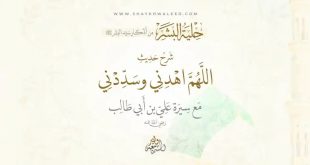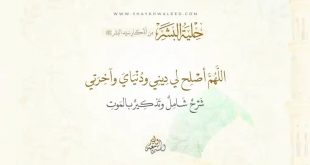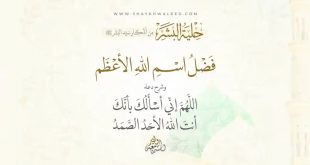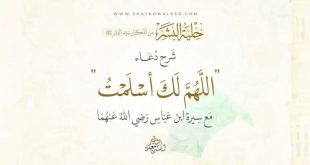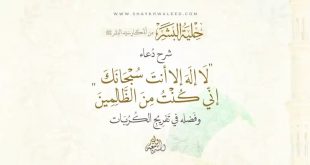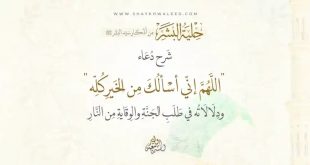المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْمَلَ لَنَا الدِّينَ، وَأَتَمَّ عَلَيْنَا النِّعْمَةَ، وَجَعَلَ أُمَّتَنَا خَيْرَ أُمَّةٍ، وَبَعَثَ فِينَا رَسُولًا مِنَّا يَتْلُو عَلَيْنَا آيَاتِهِ، وَيُزَكِّينَا وَيُعَلِّمُنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ الْجَمَّةِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً تَكُونُ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهَا خَيْرَ عِصْمَةٍ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً، وَفَرَضَ عَلَيْهِ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا، فَأَوْضَحَ لَنَا كُلَّ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ، وَخَصَّهُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، فَرُبَّمَا جَمَعَ أَشْتَاتَ الْحِكَمِ وَالْعُلُومِ فِي كَلِمَةٍ، أَوْ شَطْرِ كَلِمَةٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، صَلَاةً تَكُونُ لَنَا نُورًا مِنْ كُلِّ ظُلْمَةٍ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ:
باب فى فضل قول لا إله إلا الله
رَوَى الطَّبَرَانِىُّ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ مَاتَ وَفِى قَلْبِهِ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوقِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)).
وَمَعْنَى لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: لا أحدَ يَقْدِرُ عَلَى الْخَلْقِ أَىِ الإِبْرَازِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ.
قال بعض أهل العلم: (لا إله إلا الله) أفضل ما يُمتَدَحُ بِهِ الرَّب وأفضل ما يُمَجَّدُ به الربُّ. اهـ
وممّا يدلّ على عظيم فضل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ما روى النسائي في السنن الكبرى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((قَالَ نُوحٌ لاِبْنِهِ: إنِّي مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ وَقَاصِرُهَا لِكَيْ لاَ تَنْسَاهَا)) ومن جملة ما أوصاه به قال: ((أُوصِيكَ بِلاَ إلهَ إلَّا اللَّهُ، فَإنَّ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ لَوْ كَانَتا فِي كِفَّةٍ وَزَنَتْهُمَا، وَأُوصِيكَ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإنَّهُمَا صَلاَةُ الْخَلْقِ، وَبِهِمَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [سورة الإسراء/ الآية 44])).
وقال البهوتي وغيره: “(أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلا اللَّهُ) أَيْ: أُخْبِرُ بِأَنِّي قَاطِعٌ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَمِنْ خَوَاصِّ الْهَيْلَلَةِ: أَنَّ حُرُوفَهَا كُلَّهَا جَوْفِيَّةٌ، لَيْسَ فِيهَا حَرْفٌ شَفَوِيٌّ؛ – اللام، والألف، الهاء – لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْإِخْلَاصُ فَيَأْتِي بِهَا مِنْ خَالِصِ جَوْفِهِ وَهُوَ الْقَلْبُ لَا مِنْ الشَّفَتَيْنِ فقط – معناه ليست كلمة تخرج من الشفاه بل من جوفك-،
وَكُلُّ حُرُوفِهَا مُهْمَلَةٌ – غير منقوطة، تجريدها عن النقط ينبغي أن يتجرّد قائلها من الذي لا يرضي ربه عز وجل – دَالَّةٌ عَلَى التَّجَرُّدِ مِنْ ذكرِ كُلِّ شيء سِوَى اللَّهِ تَعَالَى”. اهـ
وأخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قالَ في كل يومٍ مائةَ مرةٍ: لا إلهَ إلا الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ لم يسبِقهُ أحدٌ كان قبلَهُ ولا يُدركهُ أحدٌ كان بعدهُ إلا من عمِلَ عملًا أفضل من عملِهِ)) وأخرجه أحمد والطبراني في الدعاء بلفظ: ((مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةٍ)).
وأخرج الطبراني في مسند الشاميين عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَلَمْ يُرْفَعْ لِأَحَدٍ يَوْمَئِذٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ)).
روى البخاري ومسلم عن أَنسٍ رضي اللَّهُ عنه أَنَّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَمُعَاذٌ ردِيفُهُ عَلى الرَّحْلِ قَالَ: ((يا مُعاذُ)) قال: لَبيَّيْكَ يا رسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قالَ: ((يا مُعَاذُ))، قالَ: لَبَّيكَ يا رَسُول اللَّهِ وَسَعْديْكَ، قالَ: ((يَا مُعاذُ)) قال: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْديكَ ثلاثًا، قالَ: ((ما مِن عَبدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِله إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمدا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ على النَّارِ)) قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُخْبِرُ بِها النَّاسَ فيستبشروا؟ قال: ((إِذًا يَتَّكلُوا)) فَأَخْبرَ بها مُعَـاذٌ عِنْد مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.اهـ أَيْ: خَوْفًا مِنَ الإِثمِ في كَتْمِ هذا العِلْمِ.
وممّا يدلّ على فضل وبركة كلمة التوحيد ما روى الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العَاص سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ الله سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحافِظُونَ؟ فيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ يَا ربِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَع هَذِهِ السِّجِلاَّتُ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ.
قالَ: فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كِفَّةٍ وَالِبطَاقَةُ في كِفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَت البِطَاقَةُ، ولا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ الله شَيْءٌ)).
والمعنى: لا يُقاوِمه شيء مِن المعاصي؛ بل يترجَّح ذِكْر الله تعالى على جميع المعاصي. ودلَّ الحديث على أنّ السِّجِلّ الذي كتبت فيه الأعمال يُوزَن، وما ورد في هذا الحديث ليس فيه صيغة عموم، وإنما هي حادثة عين، لشخص واحد يُكرمه الله برحمته، فلا ينبغي أن يتكل الإنسان على إسلامه ويتمادى في فعل المعاصي، وإن وردت نصوص أخرى بالتكفير بالتوحيد على سبيل العموم، لكن قد وردت نصوص أخرى أيضًا بأن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار حتى يُطهَّروا من معاصيهم ثم يخرجون منها إلى الجنة.
وفي مجمع الزوائد للهيثمي عن أبي المنذرِ الجهنيِّ قال، قلت: يا رسول الله علمني أفضل الكلام، قال: ((قل لا إلهَ إلا الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ يحيي ويميتُ بيدهِ الخيرُ وهوَ على كلِّ شىءٍ قديرٌ، مائةَ مرةٍ في كلِّ يومٍ فإنكَ يومئذٍ أفضلُ الناسِ عملًا إلا من قالَ مثل ما قلتَ)).
وعن أَبي سعيد الخُدْرِيِّ وأَبي هريرة رضيَ اللَّه عنهما أَنهُما شَهِدَا على رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنه قال: ((مَنْ قال: لا إِلهَ إِلا اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ صدَّقَهُ رَبُّهُ فقال: لا إِله إِلا أَنَا وأَنا أَكْبرُ – أي أكبر من كل كبير قدرا – وَإِذَا قال: لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وحْدهُ لا شَرِيكَ لَهُ قال: يقول اللهُ: لا إِله إِلا أَنَا وحْدِي لا شَرِيك لي وإذا قال: لا إِلهَ إِلا اللَّهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ قال: لا إِلهَ إِلا أَنَا ليَ المُلْك وَلىَ الحَمْدُ. وإِذا قال: لا إله إِلا اللَّهُ وَلا حَوْلَ ولا قَوَّةِ إِلاَّ بِاللَّهِ، قال: لا إِله إِلا أَنَا وَلا حَوْلَ ولا قوَّةَ إِلاَّ بي)) وَكانَ يقولُ: ((مَنْ قالهَا في مَرَضِهِ ثُمَّ ماتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وروى الترمذي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((خَيْرُ الدّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أنا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إلهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَديرٌ)).
وأذكر هنا تنبيها آخر وهو: أنه لا يجوز أن تقول عند نطقك بالشهادة: أشهد أنَّ لا إله إلا الله، بتشديد أن الأولى، ولكن ينبغي قولها بالتخفيف فتقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله.
فإن خُفِّفَتْ (أنَّ) مفتوحةً بقي إعمالهُا – وهي ليست “أنْ” الناصبة للأفعال، وأن الناصبة للأفعال مثل: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا﴾ [سورة البقرة/ الآية 184] أما هذه تكون مخففة من “أنّ” فيكون معناها التوكيد فتنصبُ اسمًا وترفعُ خبرًا-، ولكن يجبُ أن يكون اسمُها ضميرَ الشأن – أي الضميرَ الذي معناه الشأن، أو الحال أو الأمر، كـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص/ الآية 1] فالضمير “هو” ضمير الشأن فلم يحتج إلى شيء ليعودَ عليه ليفسِّرَهُ لأن معناه الشأن فيكون معنى الآية: قل الشأنُ هو اللهُ أحد، وكذلك قولنا “هو زيدٌ عالم” ومعناه: الشأنُ زيدٌ عالم، ويكونُ محذوفًا؛ ويجبُ أن يكونَ خبرُها جملةً نحوُ: (عَلِمَ أنْ سيكونُ) (“أنْ” هي المخففة واسمُها محذوف وهو ضمير الشأن وتقديره “هـ” فتكون الكلمة “أنَّهُ”، أو كـقول “أيقنتُ أنْ سيدخل المؤمنُ الجنةَ” فـ “أنْ” هي المخففة واسمها ضمير الشأن المحذوف وتقدير الكلام “أنَّهُ” والشأن هنا هو “سيدخل المؤمنُ الجنة”، وكذلك مثاله قولنا: “أشهدُ أنْ لا إله إلا الله” فيكون التقدير “أشهد أنَّهُ لا إله إلا الله”).اهـ
وأذكر فائدة أخرى في معنى كلمة (إله):
(إِلَهٌ) معناهُ المعبُود بحق، وهذا اللفظُ موضُوعٌ للمَعبُود بحَقٍّ فقط ثم استعَاره المشركون لما يَعبُدونَه مِن دُونِ الله من حجرٍ ونحاسٍ وغيره.
وليسَ لفظُ الإله مَوضُوعًا في الأصل لكلّ مَعبُودٍ، وإلَّا لم يصح معنى (لا إله إلا الله) لأنّه لو كان الإله وُضِعَ لمعنى المعبود بدون تخصيص، بل على الإطلاق لم يصح قول (لا إله إلا الله)، لكن لَمَّا كان الإله معناه المعبود بحق وهو الله، صحَّت هذه الكلمة: (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق إلا الله؛ أي أنَّ كل ما يعبد من دون الله معبود بباطل ليس معبودًا بحق.
قال تعالى: ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: 110] على أنه لا إله غيره، وبيان ذلك مجيء «إنّما» فيأول الآية وهي تفيد الحصر، ففهم من ذلك أن الله هو الإله وأن غيره ليس بإله، فلا يصح لغة ولا يجوز شرعًا أن يطلق لفظ الإله على غير الله عز وجل، ولا يصح أن يراد بالإله مطلق المعبود لأن المعبودات بالباطل كثيرةٌ.
وقد قال اللغوي أبو هلال العسكري في «الفروق»: “الْإِلَه هُوَ الَّذِي يحِق لَهُ الْعِبَادَة، فَلَا إِلَه إِلَّا الله،
وَلَيْسَ كل معبود يحِق لَهُ الْعِبَادَة، أَلا ترى أَن الْأَصْنَام معبود والمسيح وَلَا يحِق لَهُ وَلها الْعِبَادَة”.
وكذا عدَّ الإمام أبو منصور البغدادي الإله من أسماء الله الخاصة.
وأما القول في اشتقاق لفظ «إله» فحاصلُ ذلك ما قاله الفيومي في «المصباح» مختصرًا: “أَلِهَ يَأْلَهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ إلَاهَةً بِمَعْنَى عَبَدَ عِبَادَةً وَتَأَلَّهَ تَعَبَّدَ وَالْإِلَهُ الْمَعْبُودُ وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ اسْتَعَارَهُ الْمُشْرِكُونَ لِمَا عَبَدُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى”.
فالجامد هو الاسم الأصلي الذي لم يُؤخَذ من غيره، مثل القلم والدفتر والطاولة،
والمشتق هو الاسم الذي يُؤخَذ من اسم آخر ليدلّ على معنى معيّن.
الاسم نوعان: جامد ومشتق كل اسم لا يرجع إلى كلمة تسبقه في الوجود فهو جامد.
فالشمس والقمر والحجر والشجر، كلها أسماء جامدة. لأن ألفاظها لا ترجع إلى كلمات عربية أخرى سبقتها في الوجود.
أما الاسم المشتق، فهو الذي يؤخذ من كلمة سبقته في وجودها؛ فالمشمس والمقمر والمتحجر والمشجر، كلها أسماء مشتقة، لأنها ترجع إلى كلمات سبقتها في الوجود المذكورة.
فكما يكون الصخر جامدا ثم يخرج منه الماء، كذلك شأن الجامد من الكلمات، هو جامد ومنه تؤخذ المشتقات.
وروي عن الضّحاك أنّه قال: إنّما سمّي الله إلها؛ لأنّ الخلق يتضرعون إليه في حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم؛ فيكون المعنى: هو من يفزع إليه في النوائب لأنه المجير لجميع الخلائق من كل المضار.
وأمَّا قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [سورة الجاثية/ الآية 23] معناه عند ذلك المشرك إله، اللهُ ما أثبت له الألوهية.
والآية نزلت في شأن أناسٍ من العرب في الجاهلية، إذا رأوا حجرًا جميل المنظر حسن المنظر يأخذونه فيعبدونه، ثم إذا صادفوا ءاخر أحلى منه يرمون هذا ويأخذون الآخر فيعبدونه، فهذه الآية ذم لهم.
القرءان ما أثبت أنه يوجد إله غير الله. وأما ما جاء في نحو قول موسى عليه الصلاة والسلام للسامري بعد أن بيّن له أنّ العجل الذي يعبده هو معبود باطل: ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [سورة طه/ الآية 97] فمعناه: وانظر يا سامريُّ إلى ما اتخذته إلهًا وهو لا يستحق أن يكون كذلك، فلم يأت بلفظ «إله» في هذا الموضع مجردًا عن الإضافة فعلم من ذلك أنه لا يجوز قول: “الفينيقيون يعبدون الإله عشتروت” كما في بعض كتب التاريخ.
والخلاصة: أنه يجوز أن تُطلَق كلمةُ إله على غير الله إنْ كانت على معنى الإضافة أو هناكَ قرينةُ، وإلا فلا.
وإنّ أعظَمَ العلُوم وأنفعَها هو معرفة كلمة الشهادة وفهم معناها، فكما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ذكرناه أنّ من مات عليها؛ أي مات معتقدا معناها ثابتا عليها دخل الجنة، ومدارها يعودُ إلى معرفةِ اللهِ ورسُولِه، ما يُعرَف بهِ اللهُ ورسولُه وما يُعرف به سائرُ أصولِ العقيدةِ وهذا هو الأساس لذَلك سمَّى أبو حنيفةَ رضي الله عنه عِلمَ التّوحيد الفِقه الأكبر،
لهُ في عِلم التّوحيد خمس رسائل إحْداها الفِقه الأكبر ثم كتابُ العَالم والمتعَلّم ثم كتابُ الوصيّة ثم كتاب الفِقه الأبسَط ثم رسالة أخرى تُسَمّى رسالة إلى عثمان البَتّي، هذه الرسائلُ الخَمس هيَ مِن تآليف أبي حنيفةَ، وتَسميَتُه لكتابِه هذا الذي هو في العقيدة أي في معرفةِ الله ورسوله وما يَتبَعُ ذلكَ مِن أصُول العقيدة، الفِقه الأكبر دليلٌ ظاهرٌ على أنّ عِلمَ العقيدة أشرَف مِن عِلم الأحكام المسمّى بالفِقه.
ثم مِن أهمّ مسَائل عِلم العقيدة والتي يدور عليها معنى كلمة التوحيد مسألةُ خَلق أفعالِ العباد لأنّ الناسَ فيها على طَرفَين ووسَط فالطّرَفان هالِكان والنّاجِي هو الوسَط،
وبيانُ ذلك أنّ أهلَ الحقّ وهُم الصّحابةُ ومَن تبِعَهُم بإحسانٍ لم يَحِيدوا عمّا كانوا يعتقدُونَه إلى غيره، أي أنّ الله تبارك وتعالى هو خالقُ كلّ شىء، هو خالقُ أعمالِ العباد حَركاتِهم وسكَناتِهم كما أنّه خالقُ أجسادِهم، لا فَرق عندَ أهلِ الحقّ بينَ أجسَادِنا وبينَ أعمالِنا مِن حيثُ إنّ كُلا خَلقٌ للهِ تعالى، أجسادُنا خَلقٌ لله وكذلكَ أعمَالُنا أي حَركاتُنا وسكَناتُنا خَلقٌ لله تعالى، نحنُ لا نَخلُق شيئًا مِن ذلك،
إنما أجسَادُنا ليسَت مُكتسَبة لنا لا تَدخُل تحتَ كَسبِ العِباد، لكن أعمالنا أي حركاتُنا وسكناتُنا داخلةٌ تحتَ أكسَابِنا أي لنا فيها كَسْبٌ، أمّا مِن حيثُ الخَلقُ أي الإحداثُ مِنَ العدَم إلى الوجود فهيَ لِلّهِ تبارك وتعالى ليسَ لنَا مِن ذلكَ شىء، لَسنا مؤثّرين بإيجادها اشتراكًا مع الله ولا مستقِلّينَ بإيجادِها وتكوينِها، حركاتُنا وسكَناتُنا لسنا خالقِينَ لها استِقلالا ولَسنا خالقِينَ لها مُشَاركةً معَ الله، بل اللهُ تعالى هو المنفردُ بإيجادِ حَركاتِنا وسكَناتِنا، هذا معتقَدُ أصحَابِ رسولِ الله لم يكن بينَهُم اختِلافٌ في ذلك ثم تبِعَهُم على ذلكَ جُمهُور المنتَسِبين إلى الإسلام ولم يَشِذّ عن ذلكَ أي عن هذا المعتقدِ الذي هو اعتقادُ الصّحابةِ إلا طائفتانِ تَنتَسِبان إلى الإسلام أي تَدّعيان ادّعاءً وهم في الحقيقةِ ليسُوا مِن أهلِ الإسلام لا حَظَّ لهم في الإسلام، وإحْدَى هاتَين الفِرقتَين يُقالُ لها القدَريّة ويقالُ لها المعتزلة، والأخرى يقال لها الجَهميّة ويقال لها الجَبريّة. هاتان الفرقتان المعتزلة والجبرية هما الطرفان المخالفان لأهل الحق والذين هم الوسط، فلْيَحذر العاقل من الميل إلى إحدى هاتين الفِرقتين اللتين هما طرفان، ثمّ أهل الحقّ الذين هم الوسط لهم أدلّة قرآنية ولهم براهين عقليّة فمن أدلّتهم القرآنية قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سورة الزمر/ الآية 62] لأن كلمة شىء تشمل الأجرام والأجسام والحركات والسكنات والإدراكات والعلوم فإدراكات البشر وغيرهم من الخلق وعلومهم مخلوقة لله ليست مخلوقة للعباد وإن كان ظاهرا يُنسب إلى العبد يقال فلان حصّل علوما والمعنى عند أهل الحق في ذلك أنه اكتسب مَيل هذه العلوم فنالها بخلق الله لا بخلق العبد نفسِهِ.
كذلكَ الأسبابُ العاديّة عندَ أهلِ الحقّ لا تَخلُق شيئًا والأسبابُ العاديّةُ هيَ هذه الأمور التي جعَلَ اللهُ تبارك وتعالى فيها السَّببيّة بشَىءٍ منَ الأشياء، الماءُ جعلَه اللهُ سبَبا للرّيّ والخُبز جعَلَه اللهُ سببًا للشّبَع والنارُ جعَلها اللهُ تَعالى سبَبًا للإحراق والدّواءُ جعَله اللهُ سبَبا للشّفاء ولم يجعلِ الله تعالى هذه الأسبابَ خالِقةً للمُسَبَّبَاتِ التي تَحدُث بَعدَ مُباشَرتها، الرّيّ الذي يَحصُل بعدَ شُربِ الماء ليسَ الماءُ يَخلقُه كذلكَ الشّبَع الذي يَحصُل إثْرَ تَناوُل الخُبز ليسَ الخُبز يَخلقُه والشّفاء الذي يَحصُل إثْر تناول الدّواء ليس الدّواءُ يَخلقُه، فهذا الذي يكونُ مُوافقًا للقرآنِ لأنّ اللهَ تبارك وتعالى لما قال: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سورة الزمر/ الآية 62] أفهَمَنا أنّ كلَّ هذهِ الأسباب لا تَخلُق شيئًا بل اللهُ هوَ الذي يَخلُق هذه المسبَّبات عندَ تنَاولها،
ونصَبَ اللهُ تبَارك وتعالى لعِبادِه دَليلا يَدُلّ على أنّ هذه الأسبابَ لا تَخلُق مُسبّبَاتها.
يُوجَدُ حيَوانٌ يُقالُ لهُ السّمندل – قال في القاموس: السَّمَنْدَل طائِرٌ بالهندِ لا يَحْتَرِقُ بالنارِ – هذا الحيوانُ يتَلذَّذُ بالنّار ولا تُحرِقُه ولا تؤثر فيه وهو مثل غيره من الحيوانات مركّب من لحم ودم، حتى إنّ الفراء والمناديل المتّخَذة من جلده إذا اتّسخت تُطرح في النار، وحتى إنه يُغمس في الزيت ويُشعل نارا ثم لما ينتهي الزيت تنطفئ النار وتبقى هذه المناديل وقد ذهب عنها الوسخ ولم تحترق،
هذا جعَلهُ اللهُ تعَالى دليلا لنا على أنّ النارَ لا تَخلُق الإحراقَ، بل اللهُ تعالى هو الذي يخلُق الإحراقَ إثْرَ مُلامسَة النار، أي أنّ النارَ لا تَخلُق الإحراقَ بطَبِيعَتِها وأنها لا تؤثّر بطَبْعها في الإحراقِ أي بدونِ إرادةِ اللهِ وخَلْق الله تعالى لهذا الإحراق، فاللهُ تعالى هوَ الذي يَخلُق الإحراقَ ليسَت النارُ تَخلُق الإحراق،
وكذلكَ قِصّةُ إبراهيمَ عليه السلام دليلٌ على أنّ النّارَ لا تَخلُق الإحراق، لو كانتِ النّارُ تَخلُق الإحراقَ وأنها بطَبِيعَتِها تؤثّر في ذلكَ لا بمشيئةِ الله وإرادتِه لاحْتَرق إبراهيمُ وما خرَج سالما، فهذا دليلٌ نصبَه الله تعالى ليَزدادَ المؤمنُ إيْقانًا بأنّ اللهَ تعالى هو خالقُ كُلّ شىء، هو خالقُ الاحتراق إثْرَ مُماسَّة النّار ليسَت النّارُ تَخلُق الاحتراق،
كذلكَ السّمّ الذي هو مِن شَأنِه أنّه يَقتُل مُتناولَه في الحالِ ليس هو خالق الموتِ إثْر تَناوُله بل الله تعالى هو يخلُقه، فإن لم يشأ الله تعالى في الأزل أن يموتَ شَخص بتنَاوله للسّمّ القاتِل لا يَقتلُه هذا السّمّ لأنّ الله لم يشأ، والسّمّ لا يؤثّر بطَبْعه الموتَ لمتناولِه، هذا خالدُ بنُ الوليد رضي الله عنه كانَ بالحِيْرة وهناك كانَ كفّارٌ مِن كفّار العَجَم فهيّؤوا لهُ سُمّا قاتلا لسَاعَتِه فقالَ لهم هاتُوا فسمّى اللهَ تعالى وتناوله فلم يؤثّر فيه شيئا بل سالَ العرَقُ على وجْهه، على جَبْهَتِه، فلَمّا شاهَدوا ذلك أي أنّهُ لم يمُت مِن هذا السّمّ هابُوه فانقَادوا له، هذه دلائلُ عِيانيّة نصَبَها الله تعالى لعبادِه حتى يَزدادَ المؤمنونَ إيقانًا بأنّهُ لا خالقَ إلا الله، أي أنّ الأسبابَ العاديّةَ الماءَ والخبزَ والنار والدّواء وغير ذلكَ منَ الأسباب العاديّة لا تخلُق مُسبَّباتها وأنهُ لا ضارَّ ولا نافعَ على الحقيقةِ إلا الله، أي أنّ شيئًا منَ الأشياء منَ الأسباب العاديّةِ لا يَظهَرُ منها مسبّباتها إلا أن يكونَ اللهُ شاءَ في الأزل أن يحصُلَ المسبَّب إثرَ هذا السّبَب، لأن السّبَب لا يخلق ذلك المسبَّبَ إنما الله هو خالقُ ذلك المسبَّب.
روي أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِأَبِي مُسْلِمٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، مَا زِلْتُ أَجْعَلُ السُّمَّ فِي طَعَامِكَ كَذَا وَكَذَا فَمَا أَرَاهُ ضَرَّكَ، قَالَ: وَلِمَ جَعَلْتِ ذَلِكَ؟ لِأَنِّي جَارِيَةٌ شَابَّةٌ إِلَى جَانِبِكَ فَلَا أَنْتَ تُدْنِينِي مِنْ فِرَاشِكَ، وَلَا أَنْتَ تَبِيعُنِي، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَقُولُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ آكُلَ: بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ، رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ.
وهناكَ آياتٌ دلّت على أنّ الأعمالَ القلبيةَ أيضًا مخلوقةٌ للهِ تعالى قال الله تعالى: (وَنُقَلِّبُ أَفۡـِٔدَتَهُمۡ وَأَبۡصَٰرَهُمۡ) [سورة الأنعام/ الآية 110] دلّت هذه الآيةُ على أنّ تقليبِ العبادِ أبصارَهم وتحرّكاتِ قلُوبِهم وتَقلّباتها مِن حالٍ إلى حال كُلّ ذلكَ بخلقِ الله تبارك وتعالى،
وكانَ مِن دعاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: ((اللّهُمّ مُصَرّفَ القلُوب صَرّفْ قلُوبَنا على طَاعتِك)) رواه مسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم. الرسولُ قال هذا بعدَ أن قال: ((إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ)) معنى إصبَعَين مِن أصابع الرّحمن بمعنى التّقريب أي أنّ الله تعالى هو يتَصرَّف فيها مِن غيرِ أن يَلحقَه تعَب ومَشقّة، كيفَ يشَاءُ يُقلّبها مِن غيرِ أن يَلحقَه تعَب بل بمَحْض إرادَتِه الأزليّة وقدرته الأزلية يُحدِثها منَ العدَم إلى الوجود،
إذًا معنى بينَ إصبَعَين مِن أصابع الرحمن أنها في قَبضتِه؛ أنّ قلُوبَ العبادِ في قَبضتِه لا تَخرُج عن قَبضَتِه، لا تخرج عن مشيئتِه، هو يتصَرّف فيها كيفَ يشَاءُ أي على حسَبِ مشيئتِه في الأزل، ليسَ متَجدّدًا على الله تعالى عِلمُ ذلك، هو عَلِمَ في الأزل وشاءَ تقَلُّباتِ القلُوب، القَلبُ يتقَلَّبُ أكثر مِن تقَلُّب البَصر، أسرَعُ تقَلُّبًا مِن تقَلُّب البصَر، هوَ خالقُ ذلكَ كُلّه، هذا معتَقَدُ أهلِ الحقّ الصّحابةِ ومَن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين ثبّتَنا اللهُ على ذلك وحفظَنا منَ الميل إلى خلافِ ذلك، لأنّ الإنسانَ في هذه الحياةِ عُرضَة للتّقلُّبات والتّغَيرات فرُبَّ إنسانٍ كانَ على حَالةٍ حسَنة يجتَمِعُ بإنسانٍ مِن هؤلاء مِن أهلِ الزّيغ والضّلال مِن معتزلة فيَسمَع مِن أحدِهم هذا الكلامَ الذي هو عَكسُ ما عليه الصّحابة والتابعون، يَسمَع منهم أنّ العَبدَ هو يَخلُق حَركاتِه وسكَناتِه فيَعتقِدُ هذا الاعتقادَ فيَضلّ.
فالإنسانُ في هذه الحياة الدّنيا عُرضَةٌ للتّقلُّبات والتّغَيُّرات مِن حالٍ إلى حال فمِنَ الناس مَن وفَّقَهُم الله تعالى فيتقَلَّبُون مِن حالٍ حسَنٍ إلى أحسَن، مِن حسَنٍ إلى أحسَن حتى يتَوفّاهمُ الله وهم على أحسَنِ حال، ومِن الناسِ مَن يَنْقَلِبُون مِن حسَنٍ إلى سيّء ثم إلى أسوأ ثم إلى أسوأ حتى يموتوا وهم على أسوَأ أحوالهم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: “وكلّهم يتقلّبون في مشيئته بين فضله وعدله” يعني أن العباد ما يعملونه فهو بمشيئة الله تبارك.
يروى أنّ أحد العلماء واسمه الفضيل بن عياض كان له تلميذ وكان هذا التلميذ يحتضر على فراش الموت فوقف الفضيل عنده وصار يلقنه الشهادتين عند الاحتضار يقول له: “قل لا إله إلا الله” فلا يستطيع هذا التلميذ أن ينطق بها. “قل لا إله إلا الله” فلا ينطق حتى قال هذا التلميذ: “إني بريء منها” ومات على الكفر والعياذ بالله.
الفضيل بن عياض خاف وارتعب وصار يبكي من خشية الله، ثم رأى هذا التلميذ في المنام وإذا به يجر إلى جهنم فقال له الفضيل: “ويلك ماذا فعلت؟” قال له: “يا أستاذي أنا كنت أستغيب إخواني وكنت أحسدهم فوصلت إلى هذه المرحلة ومت على الكفر”.
ومما يروى: كان أحد المشايخ قوي الحجة سريع البديهة، لكن لم يكن صادق النية فأرسل لمناظرة (كفار) في بلاد الروم فكسرهم بالحجة والبرهان، فخشوا منه أن يسلم الناس على يده، فطلبوا من ملكهم أن يزيّن له ابنته ويغريه بها فتضعف نفسه فيطلب الزواج منها فلا يُعطى طلبه حتى يخرج عن دينه، وحصل ذلك فافتتن بها وخرج عن دينه، لكن سرعان ما ابتلاه الله بمرض سئم منه أولئك الكفرة الفجرة ورَمَت به تلك المرأة خارج قصرها واشتد المرض ومرت الأيام وما زال يقاسي ما يقاسي حتى مرَّ رجُل من بغداد بقربه فقال له: “وكأني رأيتك قبل ذلك أأنت العالم الفلاني الذي كان يدرس في بغداد؟” فقال: “أنا هو” فقال له: “ما حصل لك” فقص عليه قصته ثم بعد ذلك قال له ذلك الرجل: “ما يمنعك أن تعود للإسلام؟!” فسكت، فقال: “أما زلت تحفظ شيئا من كتاب الله؟” فقال: “ءاية واحدة” فقال له: “ما هي” فأجاب المرتد ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [سورة الحجر/ الآية 2] ثم مات.
وَلْيُعْلَمْ أنّ بعض من كَتَبَ الوحي قد ارتد عن دين الله ومنهم من عاد للإسلام ومنهم من مات على الكفر.
فالعباد مهما فعلوا من فعل خيرًا كان أو شرًا فبمشيئة الله، وفي ذلك بيان أنه ليس واجبًا على الله أن يفعل لعباده ما فيه صلاحهم أو ما هو أصلح لهم ومن يدعي ذلك فقد خرج من الإسلام وهذا قول المعتزلة.
لو كان يجب على الله فعل الأصلح كما يقول المعتزلة لخلق الناس في الجنة، أيش الأصلح للعباد؟! أن يخلقوا في الجنة، لا أن يبتلَوا في الدنيا فيكفر من يكفر ويعصى من يعصى فيعاقب!!
المعتزلة ليس بينهم اختلاف في أنهم يقولون: يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعبد، هكذا يقولون، ما علم الله أنه الأصلح للعبد يجب عليه فعله يجب عليه أن يعطى العبد ما هو الأصلح له هكذا يقولون. ثم كلامهم يقتضى نسبة العجز فيه وصف الله بالعجز هذا مقتضاه لأنه إذا فعل ما هو الأصلح للعباد إذًا على زعمهم ما عاد يستطيع أن يفعل لهم ما هو فوق ذلك إذا أوجبوا عليه فعل الأصلح إذًا على زعمهم هذا هو الأصلح إذًا لا يستطيع أن يفعل لهم شيئًا فوق ذلك ففيه نسبة العجز إليه كيف لا يُكَفَّرون.
الله خلق في الدنيا الموت والمرض والتعب والألم وفراقَ الأحبة إلى غير ذلك من المحن الله جعل في القبر أهوالًا الله جعل في الآخرة أهوالًا عند الموقف والصراط والعرض للحساب والميزان هذا غير أنواع عذاب النار التي لا حصر لها، فكيف يقال الله يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح للعباد؟!!! هم المعتزلة وصلت حماقتهم وعنادهم إلى درجة أنهم كابروا البديهة كابروا وردوا ما يعرف بالبديهة، قالوا: تعذيب الكفار بالنار أصلح لهم أيش يقولون أليس قالوا يجب على الله فعل الأصلح إذًا أيش يقولون؟! قالوا: تخليدهم في العذاب أصلح لهم لهذا قالوا المبتدع لا بد أن يتناقض لأنه لا يتبع الدليل. كيف يكون أصلح للعبد أن يجعله الله مكلفًا وقد علم أنه يموت على الكفر كيف يكون أصلح للعبد أن يعذب إذا مات على الكفر أو على عدم التوبة. إنما هذا كما قلنا البدعة إذا تمكنت من قلب الشخص تعميه، الهوى يُعمِى ويُصِم.
ثم هؤلاءِ أهلُ الاعتزال بعدَ أن ظهَروا بينَ المسلمينَ بعَددٍ قليل كانَ بدؤهم قَليلٌ جِدّا، هم فهِموا بعضَ الآياتِ القرءانيةَ على غيرِ وجهها فهلَكوا، ثم دعا هؤلاء غيرَهم إلى هذا الاعتقاد الذي هو ضَلالٌ وهَلاك فتبِعَهُم مَن أغواهمُ الله تَبارك وتعالى، أمّا الذينَ حفظَهُم الله فهم محفوظُون،
هؤلاء المعتزلةُ تكَلَّم فيهم رجالٌ مِن أعلام السّلَف كعمرَ بنِ عبدِ العزيز رضي الله عنه هو كانَ رأيُه في هؤلاء المعتزلة أن يُدعَوا إلى التّوبة أي التّخَلّي عن هذا الاعتقاد وإلا تُضرَب أعناقُهم، كان رجلٌ في عهده يُسمّى غَيلان الدّمشقيّ معتزلي كانَ يَدعُو إلى الاعتزالِ فاستَدعاه لما أُخبر بشأنه أنّه يَدعُو إلى هذه العقيدة الفاسدة فاستَتابَه فأَظهَرَ التّوبةَ فترَكه منَ القَتل لأنّهُ أظْهَر الرّجوعَ ثم بعدَ وفاةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيز رجَع إلى ما كان عليه، كانَ رأسًا مِن رؤوس الاعتزالِ فقتَلَه بعضُ الوُلاة الأمويّين بعدَ ذلكَ، بعدَ عمرَ بنِ عبد العزيز، ولهُ أي لعمرَ بنِ عبد العزيز رسالةٌ في الردّ على المعتزلة وكذلكَ لأناسٍ ءاخَرِين مِن أعلام السّلَف مِن جملتِهم أبو حنيفة فإنّهُ كانَ شَديدَ الاعتناءِ بالرّد عليهم حتى إنهُ سافرَ مِن بغدادَ إلى البصرة وبينَهُما مسافةٌ واسِعة لدَحْض أباطِيلِهم ونَقْضِ شُبَهِهم وتمويهاتهِم أكثرَ مِن عشرينَ مرّة، هكذا كانَ السّلَف الصالح رضي الله عنهم، في ذلك العصر الذي لم يكن فيه من أسبابِ التّنقلات العاديّة إلا ركوب الدّواب، تَكلَّف هذه المشاقّ لوجْه الله تعالى ونُصرَةِ دِينِه محافظةً على سُنّة رسولِ الله جزاهُ اللهُ عن المسلمينَ خَيرا، ليسَ لدَحْض هؤلاء المعتزلة فقط بل كانت البَصرةُ فيها أصنافٌ مِن الضّالّين، المعتزلةُ كانُوا فيها وأهلُ الإرجاء كانوا فيها وبعضُ الملاحِدة المشكّكِين في الإسلام للنّاس كانوا فيها، كانت رحَلاتُه هذه بقَصد دَحْض هؤلاء الفِرَق كلّها، الله تبارك وتعالى ءاتاه قوّةً في الجَدل وقوّةً في البَيان.
إذًا فمعنى لا إله إلا الله: أَنَّ أَحَدًا لا يَقْدِرُ عَلَى الْخَلْقِ أَىِ الإِبْرَازِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ، كَمَا فَسَّرَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الشَّرِيفَةَ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَبُو الْحَسَنِ الأَشْعَرِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.
في القَرن الثّالث الهجري كَثُرَ مثل هؤلاء الفِرق الشّاذة ثم قَيّضَ الله تبارك وتعالى في أواخِر ذلك العصر إمامَين أحدُهما عربي والآخَر عجَميّ، العربي هو أبو الحسن الأشعري هو مِن ذريّة أبي موسى الأشعري صاحبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي كانَ الرّسولُ مُعجَبًا بحُسن صوتِه بالقرءان، قال في حقّه: ((يَا أَبَا مُوسَى، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)) رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يعني بالمزمار الصّوتَ الحسَن لا يعني هذا المزمار الذي يُنفَخ فيه.
أبو الحسن الأشعريّ هو مِن ذريّة أبي موسى الأشعري صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر يقال له أبو منصور الماتريدي، أبو الحسن الأشعري كانَ ببغداد وأبو منصور الماتريدي كان ببلادِ فارس.هذانِ الإمامانِ قرّرَا عقائدَ أهلِ السّنة وأوضحاهَا إيضاحًا تامّا مع الردّ على المخالفِين مِن معتزلةٍ ومشبّهةٍ وغيرِهم فصارَ كلُّ أهلِ السّنة بعدَ هذين الإمامين يُنسَبون إلى أحدِ هذين الإمامَين فيقالُ لبَعض أهلِ السّنة أشعريّ ولبَعضٍ ماتريديّ، هذا أشعريّ وهذا ماتريدي، وكِلا الفَريقين مِن أهل السّنة ليسَ بينَهُما اختلافٌ في أصولِ العقائد، بينَهما اختِلاف في بعضِ فروع العقائد وهذا لا يُعابانِ به، لأنّ الاختلافَ في فرُوع العقائد حصَل في الصّحابة،
وذلكَ أنّ بعضَ الصّحابة نفَوا رؤيةَ النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى ليلةَ المعراج قالوا ما رأى، وبعضٌ منَ الصّحابة قال: الرّسول رأى ربَّه ليلةَ المعراج، فمِنَ المثبِتين رؤيةَ النّبي لربّه ليلةَ المعراج عبدُ الله بنُ عبّاس رضي الله عنهما وأنسُ بنُ مالك وأبو ذرّ الغِفاريّ لكن أبا ذرّ قالَ رءاه بفؤاده ولم يرَه بعَينه، أمّا الذين نفَوا رؤيةَ النّبي لربّه تلكَ اللّيلة عبدُ الله بنُ مسعودٍ وعائشةَ رضي الله عنهما هذان قالا لم يرَ ربّه، فنَحنُ مَن قالَ رأى ربّه لا نقولُ خَالف عقيدةَ أهلِ السّنة ومَن قال لم ير ربّه كذلكَ لا نقول إنهم ليسُوا مِن أهل السّنة، بل نقول كلا الفَريقين مِن أهل السّنة لأنّ هذا اختلاف في فروع العقيدة، ليسَ في أصولِ العقيدة.
أصولُ العقيدة اعتقادُ أنّ الله موجودٌ لا يُشبه غيرَه بالمرّة بوجه منَ الوجوه وأنّه غيرُ متحيّز في جهةٍ ومكانٍ وأنّ لهُ صفاتٍ أزليةً أبدية كما أن ذاته أزليّ أبدي، ولهُ عِلمٌ أزلي أبدي، ولهُ قُدرةٌ وإرادة أزليّتان أبديّتان وسمْع وبصَر أزليّان أبديان وكلامٌ أزلي أبدي ليسَ حرفًا ولا صوتًا وهو باقٍ لا يلحَقُه الفناء كما لم يسبقْه العدَم وأنّ له حياةً ليست كحياةِ غيره أزليّة أبدية، كذلكَ مِن أصول العقيدة أنّ الله واحدٌ وأنّه لا يُشبِه شيئا، وأنّه مُستغنٍ عن كلّ شىء، ولهُ القِدَم أي ليس لوجودِه ابتداء، هؤلاء الصفات الثلاثَ عشْرة هيَ أصول العقيدة، هذانِ الإمامان وأتْباعُهما لا خِلاف بينَهُم في هذه الثلاثَ عشْرة. أما رؤيةُ النبي لربّه ليلةَ المعراج هذه ليست مِن أصولِ العقيدة مَن أثبتَها ليسَ عليه حرج ومَن نفاها ليسَ عليه حَرج.
أما رؤيةُ الله في الآخرة هذه أهلُ السّنة اتّفَقوا عليها، وخالفَت المعتزلةُ قالت: كيف يُرى؟ الشّىءُ الذي يُرى لا بدّ أن يكونَ جسمًا كبيرًا أو صغيرًا أو قريبًا أو بعيدًا، الله لا يجوزُ عليه هذا، كيف يُقال يُرى؟ لا يُرى!! هؤلاء المعتزلة بإنكارهِم لرؤية الله رؤية المؤمنينَ ربهم في الآخِرة ضَلّوا.
أهلُ السّنة يَرُدّون على المعتزلة يقولون يُرَى مِن غير أن يكونَ في مكانٍ مِن غيرِ أن يكونَ في جِهة فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خَلْف يُرى لا مانعَ مِن أن يُرى بلا مكانٍ بلا جهة مِن غير مسَافة قريبة ومِن غير مسافةٍ بعيدة، يُرى لا كما يُرى الخلق هذا حُجّة أهلِ السّنة.
وإنَّ من يعقدُ قلبَهُ على أنَّ الله هو خالقُ كلِّ شىءٍ وأنه لا ضارَّ ولا نافعَ على الحقيقةِ إلا هوَ ويُكْثِرُ مِنْ شُهودِ ذلكَ بقلبِهِ حتى يصيرَ مُسْتَشْعِرًا لذلكَ بقلبِهِ دائمًا تَهُونُ عليه مصائبُ الدنيا وتهونُ عليه الشدائدُ ويذهبُ عنه الخوفُ من العبادِ ويصيرُ من أهلِ اليقينِ. اللهُمَّ اجْعَلْنا من أهلِ اليقينِ وثبتنا على الطريقِ القويمِ.
والله تعالى أعلم وأحكم
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة