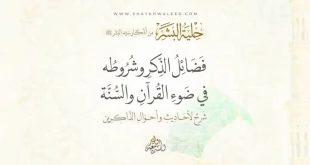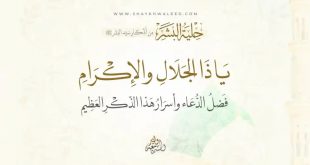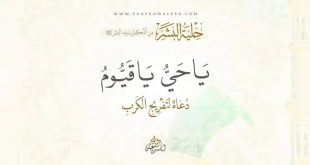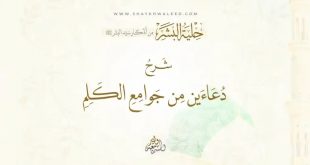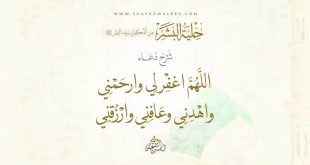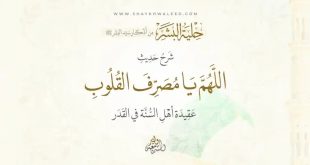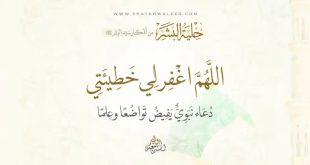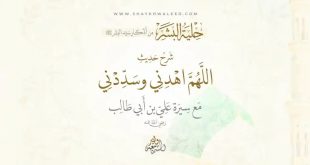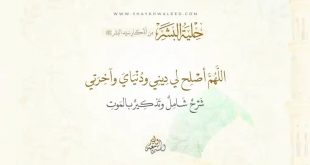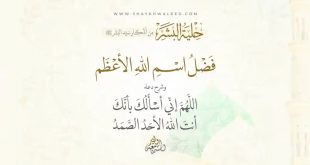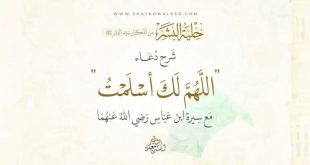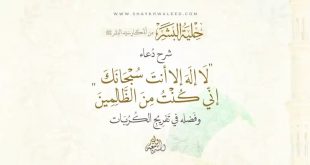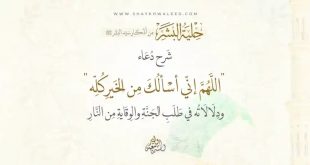المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لم يزل عظيما عليّا، يخذل عدوّا وينصر وليّا، أنشأ الآدمي خلقا سويّا، ثم قسمهم قسمين رشيدا وغويّا، رفع السماء سقفا مبنيا، وسطح المهاد بساطا مدحيا، ورزق الخلائق بحريا وبريا، كم أعطى ضعيفا ما لم يعط قويا، وإنه إذا قضى كان أمره مقضيا،
والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد خير رسول وأشرف نبيا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان بعد الأنبياء أفضل تقيا، وعلى عمر الذي كان مقدما في الجد جريا، وعلى عثمان الذي استحت منه الملائكة وكان حييا، وعلى علي الذي دخل في الإسلام وكان صبيّا، وعلى عمّه العباس المستسقى بشيبته فانتقعت الأرض ريا، أما بعد:
وصلنا في كتاب حلية البشر إلى:
باب ما جاء فى فضل ذكر الله عز وجل والدعاء
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [سُورَةَ غَافِر/60]. وَمَعْنَى هَذِهِ الآيَةِ أَطِيعُونِى أُثِبْكُمْ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ الآيَةَ)).
الشرح والتعليق على هذا الحديث
الإكثار من ذكر الله علامة خير لمن كان مؤمنّا وعرف كيف يذكر الله وذكره ذكرًا صحيحًا، وكان مخلص النية وقُبل عمله، فقد مَدَحَ الله تعالى البيوتَ التي يُذكَرُ فيها سبحانه صباحا ومساء ومَدح الذاكرين له فيها ووعدهم الأجرَ العظيمَ فقال: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [سورة النور/ الآية 36 – 38]، وقال سبحانه: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [سورة الأعراف/ الآية 205]، وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [سورة الكهف/ الآية 24]، وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [سورة آل عمران/ الآية 41].
وَذَمَّ الذين قست قلوبهم عن ذكر الله فقال: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سورة الزمر/ الآية 22]،
وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [سورة الزمر/ الآية 45]، ومدح قلوب الذاكرين وبيّن أن الذكرَ راحةٌ لقلوبِهم فقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [سورة الرعد/ الآية 28].
وَالدُّعَاءِ قال الفيروزأبادي: الدّعاء: الرّغبة إِلى الله تعالى. ويستعمل أَيضًا استعمال التَّسمية نحو: دعوت ابني زيدًا، أَى سمّيته.
قال الله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ﴾ [سورة النور/ الآية 63] حثَّا على تعظيمه صلى الله عليه وسلم. وذلك مخاطبة لمن يقول: يا محمد.
والدّعاءُ يَرِدُ فى القرآن على وجوه:
الأَوّل: بمعنى القول: ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ﴾ [سورة الأنبياء/ الآية 15] أَى قولهم.
الثانى: بمعنى العبادة ﴿قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا﴾ [سورة الأنعام/ الآية 71] أَى أَنعبدُ. و﴿يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ [سورة الحج/ الآية 13] أَى يعبد.
الثالث: بمعنى النِّدَاء ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ﴾ [سورة النمل/ الآية 80] أَى النِّداءَ، ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ [سورة القمر/ الآية 10] أَى نادى، ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [سورة مريم/ الآية 4] أَى بندائك.
الرّابع: بمعنى الاستعانة والاستغاثة ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ [سورة البقرة/ الآية 23] أَى استعينوا بهم، ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ [سورة يونس/ الآية 38] أَى استعينوا بهم.
الخامس: بمعنى الاستعلام والاستفهام ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا﴾ [سورة البقرة/ الآية 68] أَى استفهم.
السّادس: بمعنى العذاب والعقوبة ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ [سورة المعارج/ الآية 17] أَى تُعذّب.
السّابع: بمعنى العَرْض ﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ﴾ [سورة غافر/ الآية 41] أَى أَعرضها عليكم، ﴿وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ [سورة غافر/ الآية 41] أَى تعرضون علىَّ النارَ.
الثامن: دعوة نوحٍ قومه ﴿إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ [سورة نوح/ الآية 5].
التَّاسع: دعوة خاتم الأَنبياءِ لكافَّة الْخَلْقِ ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [سورة النحل/ الآية 125].
العاشر: دعوة الخليل للطيور ﴿ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا﴾ [سورة البقرة/ الآية 260]. .
الحادى عشر: دعاءُ إِسرافيل بنفخ الصّور يوم النشور لساكني القبور ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ﴾ [سورة القمر/ الآية 6].
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [سُورَةَ غَافِر/60].
حثّنا الشّرع الحنيف أن نكثر من دعاء الله عز وجل ولا نقتصر في دعائه عند الشدائد فقط، فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ))،
وفي الترمذي أيضًا: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ العَافِيَةَ))، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ((إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ))،
وعَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ))، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: ((اللَّهُ أَكْثَرُ)) – معناه الله يعطيكم يجيبكم ما سألتموه -. أخرجه الترمذي. ولكن لا يجوز اعتقاد أن قدر الله يتغير لدعوة داع أو لصدقة متصدق، لا، أخرج البزار والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) فيعتلجان: يتصارعان.
اللَّهُ تَعَالَى إِذَا قَدَّرَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ عِبَادِهِ يُصِيبُهُ كَذَا لا بُدَّ أَنْ يُصِيبَهُ ذَلِكَ الشَّىْءُ وَلَوْ تَصَدَّقَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ صَدَقَةً أَوْ دَعَا أَوْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَوْ عَمِلَ إِحْسَانًا لِأَقَارِبِهِ لِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِهِ لَوْ عَمِلَ لَهُمْ إِحْسَانًا لا بُدَّ أَنْ يَتَنَفَّذَ مَا قَدَّرَ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَ هَذَا الإِنْسَانَ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِدَ الإِنْسَانُ أَنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَوْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَوْ دَعَا دُعَاءً يَنْجُو مِمَّا قَدَّرَ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّهُمْ إِنْ دَعَوِا اللَّهَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ يَذْهَبُ عَنْهُمْ شَىْءٌ قَدَّرَ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ، وَهَذَا بِخِلافِ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ قَدَرًا مُعَلَّقًا بِأَنَّ فُلانًا إِنْ فَعَلَ كَذَا يُصِيبُ كَذَا مِنْ مَطَالِبِهِ أَوْ يُدْفَعُ عَنْهُ شَىْءٌ مِنَ الْبَلاءِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا لا يَنَالُ مَا طَلَبَهُ فَهَذَا جَائِزٌ لِأَنَّ الْمَلائِكَةَ يَكْتُبُونَ فِي صُحُفِهِمْ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيقِ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَلَقَّوْنَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى فَهَذَا لا يُنَافِي الإِيـمَانَ بِالْقَدَرِ.
وَأَمَّا الَّذِي يَدْعُو فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِنِيَّةِ أَنْ يَسْلَمَ مِمَّا قَدَّرَ اللَّهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ يُصِيبُهُ لا مَحَالَةَ هَذَا كَافِرٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ اللَّهَ مُتَغَيِّرَ الْمَشِيئَةِ وَالْعِلْمِ، وَتَغَيُّرُ الْعِلْمِ وَالْمَشِيئَةِ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [سورة الرحمن/ الآية 29] فَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ يُغَيِّرُ مَشِيئَتَهُ بِاخْتِلافِ الأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ بَلْ مَعْنَاهُ يَخْلُقُ خَلْقًا جَدِيدًا، كُلَّ يَوْمٍ يُغَيِّرُ فِي خَلْقِهِ وَلا يَتَغَيَّرُ فِي عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: ((لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ)) فَالْمُرَادُ بِهِ الْقَضَاءُ الْمُعَلَّقُ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْهُ مَا هُوَ مُعَلَّقٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مُبْرَمٌ لا يَتَغَيَّرُ وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُ هَذَا، فَالْمُعَلَّقُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ فِي صُحُفِ الْمَلائِكَةِ الَّتِي نَقَلُوهَا مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، مَثَلًا يَكُونُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فُلانٌ إِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَوْ بَرَّ وَالِدَيْهِ أَوْ دَعَا بِكَذَا يَعِيشُ إِلَى الْمِائَةِ أَوْ يُعْطَى كَذَا مِنَ الرِّزْقِ وَالصِّحَّةِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَعِيشُ إِلَى السِّتِّينَ وَلا يُعْطَى كَذَا مِنَ الرِّزْقِ وَالصِّحَّةِ، هَذَا مَعْنَى الْقَضَاءِ الْمُعَلَّقِ أَوِ الْقَدَرِ الْمُعَلَّقِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ تَقْدِيرَ اللَّهِ الأَزَلِيَّ الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ مُعَلَّقٌ عَلَى فِعْلِ هَذَا الشَّخْصِ أَوْ دُعَائِهِ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ كُلَّ شَىْءٍ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىْءٌ، هُوَ يَعْلَمُ بِعِلْمِهِ الأَزَلِيِّ أَيَّ الأَمْرَيْنِ سَيَخْتَارُ هَذَا الشَّخْصُ وَمَا الَّذِي سَيُصِيبُهُ، وَاللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ كُتِبَ فِيهِ ذَلِكَ أَيْضًا.
وَعَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ((لا يَنْفَعُ الحَذَرُ مِنْ القَدَرِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْحُو بِالدُّعَاءِ مَا شَاءَ مِنَ الْقَدَرِ))، فَقَوْلُهُ: ((لا يَنْفَعُ الحَذَرُ مِنْ القَدَرِ)) مَعْنَاهُ فِيمَا كَتَبَ مِنَ الْقَضَاءِ الْمَحْتُومِ، وَقَوْلُهُ: ((وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمْحُو بِالدُّعَاءِ مَا شَاءَ مِنَ الْقَدَرِ)) مَعْنَاهُ الْمَقْدُورُ.
وَمِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَشِيئَتَهُ لِدُعَاءِ دَاعٍ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ في تفسيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَرْبَعًا فَأَعْطَانِي ثَلاثًا وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً … )) الْحَدِيثَ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: ((سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً))، وَفِي رِوَايَةٍ عند مسلم: ((وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ))، فَلَوْ كَانَ اللَّهُ يُغَيِّرُ مَشِيئَتَهُ بِدَعْوَةٍ لَغَيَّرَهَا لِحَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا تَتَغَيَّرُ صِفَاتُهُ.
عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَّرَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [سورة الرعد/ الآية 39] بِالْقَضَاءِ الْمُعَلَّقِ، أَمَّا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ فَسَّرَهُ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ أَيْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَمْحُو مَا يَشَاءُ مِنَ الْقُرْءَانِ أَيْ يَرْفَعُ حُكْمَهُ وَيَنْسَخُهُ بِحُكْمٍ لاحِقٍ، وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْقُرْءَانِ فَلا يَنْسَخُهُ، وَمَا يُبَدَّلُ وَمَا يُثْبَتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ، وَهَذَا فِي حَياةِ الرَّسُولِ أَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلا نَسْخَ، يَقُولُ الْبَيْهَقِيُّ: “هَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ”. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [سورة الرعد/ الآية 39] أَيْ جُمْلَةُ الْكِتَابِ مَعْنَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَمْحُوِّ وَالْمُثْبَتِ،
أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُرْءَانَ مُفَرَّقًا عَلَى الرَّسُولِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الآيَاتِ مَا يُرْفَعُ بَعْدَ نُزُولِهِ فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْءَانًا، وَمِنْهُ مَا يَبْقَى تِلاوَةً لَكِنَّ حُكْمَهُ يُرْفَعُ هَذَا يُقَالُ لَهُ الْمَنْسُوخُ. هَذَا مَعْنَى الآيَةِ، أَيْ يَمْحُو بَعْضَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْءَانِ عَنْ حُكْمِ الْقُرْءَانِ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الأَكْثَرُ لِأَنَّ الْمَنْسُوخَ قَلِيلٌ جِدًّا. وَمِمَّا نُزِّلَ قُرْءَانًا ثُمَّ رُفِعَتْ تِلاوَتُهُ مَا رَوَاهُ أَنَسٌ قَالَ: »إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ قُرْءَانًا يَا رَبَّنَا أَبْلِغْ قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا« ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ. وَالنَّسْخُ لا يَخْلُو مِنْ حِكْمَةٍ، بَلْ هُوَ مِمَّا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ، لِأَنَّ الآيَةَ تَنْزِلُ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا بُرْهَةً ثُمَّ يُرْفَعُ حُكْمُهَا وَتَأْتِي أُخْرَى بَدَلَهَا كَانَتِ الْحِكْمَةُ قَبْلَ رَفْعِ الْعَمَلِ بِهَا الْعَمَلَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ مَصْلَحَةُ الْعِبَادِ فِي رَفْعِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، لِأَنَّ الأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ الإِلَهِيَّةَ مِنْهَا مَا هِيَ مُؤَبَّدَةٌ وَمِنْهَا مَا هِيَ مُؤَقَّتَةٌ، فَالظُّلْمُ مَثَلًا حُرِّمَ فِي كُلِّ الشَّرَائِعِ، وَكَذَلِكَ أَشْيَاءُ أُخْرَى كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ.
الحديث
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [سورة غافر/ الآية 60] الآيَةَ)).
الشرح
الْعِبَادَةُ فِى هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَاهَا الْحَسَنَاتُ؛ أي الطاعة والقربة إلى الله. الرسولُ صَلى اللهُ عليه وسَلَّم يَقول: ((الدُعاء هو العبادة))، والعِبادَة هنا مَعناها الحَسَنات، وفي رواية الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((الدُعاءُ مُخُّ العِبادَة)) أي شيءٌ عَظيمٌ من الحَسَنات، وليسَ معناهُ أنَّ الشَخصَ إذا قالَ: “يا مُحمَّد أو يا علي أو يا رِفاعي أو يا جيلاني” أنهُ صارَ عابِدًا له وصَارَ مُشْرِكًا بالله، لا. فقد وردَ أنَّ عبد الله بنَ عُمَر رَضيَ اللهُ عنهُما خَدِرَت رِجلُهُ، أَصابَها خَدَر، هذا علَّة شِبهُ الفالِج تَتَعَطَلُ الرِجلُ عن الحَرَكَة، شَللٌ جُزئي ليسَ التنميل الذي يقولُ عنه بَعَضُ الناس: نَمَلَّت رِجلي أو نامَت رِجلي، لا، تَعَطَلّت رِجلُهُ عن الحَرَكَة، فقال لهُ بعضُ الناس: اذكُر أحبَّ الناس إليك، فقالَ: “يا مُحَمَّد” فكأنّما نَشِطَ من عِقال، أي تَعافى فورًا وقامَ يَمشي، روى ذلك البُخاريُ في الأدب المُفرَد. وهذا ليس شِركًا وليسَ مَعصيةً من عبد الله بن عُمَر صاحب رسول الله صَلى اللهُ عليهِ وسَلَّم، بل هو أمرٌ جائِز. وعبد الله بن عُمَر هو من قالَ فيهِ الرَسول صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ عَبدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِح)) رواه البخاري في صحيحه، هذا الرَجُلُ الصَالِح هو الذي فعلَ ذلك.
فالدُعاءُ شَيءٌ عَظيم يُتَقَرَّبُ بهِ إلى الله إذا كانَ بنيةٍ حَسَنَة خالِصَة، وكانَ دُعاءً مُوافِقًا للشَريعَةِ. فَنَحنُ نَلجأ إلى الله بالدُعاء، نَدعو اللهَ تبارَك وتعالى، وتوجدُ أوقات الدُعاء فيها أقرَبُ إلى الإجابَة كما ورَدَ عن رَسولِ الله صلى اللهُ عليه وسلم فيما رواه النسائي في السنن الكبرى للنسائي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: ((جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ)) في الثُلُثِ الأخيرِ من الليلِ قَبلَ وَقتِ صَلاةِ الصُبح، بهذا الوقت يُستَجابُ الدُعاء.
الشَخص يَدعُو اللهَ تعالى مُخلِصًا وينوي التَقَرُّبَ إلى الله بِدُعاءٍ حَسَن ولَفظٍ صَحيح فإنّه يُستَجابُ دُعاؤه بإذنِ اللهِ تبارَكَ وتَعالى. وقَول اللهِ تَعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [سورة غافر/ الآية 60] مَعناهُ أطيعوني أُثِبكُم، وليسَ مَعناهُ أنَّ العَبدَ إذا دعا الله وكان الله لم يَشأ في الأزَل أن يَتَحَقَّقَ مطلوبهُ أنَّ اللهَ يُغير مَشيئتَهُ لأجلِ دعوة العَبد، لا. مَشيئةُ اللهِ لا تتغير، وعلمُ الله لا يتَغير، وتَقديرُ الله لا يتغيّر. أَقوى علامات الحُدوث التَغيُّر. المُتغيِّرُ حادِث، الحاِدث مخلوق، المخلوق لا يكونُ إلهًا. اللهُ لا تتغيرُ مشيئتُهُ ولا تَقديرُهُ ولا عِلْمُهُ سُبحانه وتَعالى.
بل وَردَ في الحديثِ الصَحيح الذي رواه مسلم: ((سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي: أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا)) وفي رواية أخرى عند مسلم: ((وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ)). قَضاءُ اللهِ لا يُرَد.
فإذًا يُرجى استِجابَةُ الدُعاءُ في جوفِ الليل في الثلث الأخير من الليل قبل الصُبح، ودُبُرَ الصَلوات. وفي مواطن وردت في الشَرعِ مَعلومَة عندَ أهل العِلم كالدُعاء عندَ رؤية الكَعبَة عند بئرِ زمزم، في الطواف، عند الصفا عند المروة، عند الحجر الأسود في أثناء السَعي بين الصَفا والمَروة. كذلِكَ في عَرَفات، كذلك في المَشعر الحرام. وقد ذكرَ العُلَماء الكبار والحُفَّاظ أنَّ قُبورَ الصالِحين من مواضع استجابةِ الدُعاء فكيفَ بِقَبرِ النبيِّ صَلى اللهُ عليه وسلم. كم من أناسٍ زاروا رسول اللهِ مُتَقَربين إلى الله واعتقادُهُم سليم.
خالِقُ الضَّرر وخالِقُ النَّفع هو الله، والنبيّ لا يخلُقُ شيئًا لكنّه مُبارَك، وأشرَفُ الخَلقِ وأَفضَلُ الخَلقِ وسيدُ العالمين والدُعاءُ عند قبرِهِ يُستَجاب بإذنِ الله ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [سورة النساء/ الآية 64].
شرح لمسألة التوسّل والتبرّك وأنّها ليست عبادة لغير الله كما يقول بعض الجهلة
قال الفيروزأبادي: وَسَلَ إِليه: تَقَرَّبَ.
وقال البغوي: الْوَسِيلَةُ كُلُّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى.اهـ
وقال الطبراني: الوسيلةُ: القُرْبَةُ؛ وهي فَعِيلَةٌ من: توَسَّل إلى فلانٍ بكَذا؛ أي تقرَّبَ إليه، وجمعُها وسَائِلُ.
يظهر لنا ممّا سبق أنّ التوسّل إلى الله هو التقرّب إلى الله عزّ وجلّ بما يُتَقَرَّب به إليه، وهذا التقرّب إلى الله عزّ وجلّ هو من باب الأخذ بالأسباب الواردُ في الشّرع والذي لا يخالف الدّين ولا يقدح في التوحيد، وقد يكون التقرّب إلى الله بالأعمال الصالحة أخذًا بالأسباب كحديث البخاري عن الثلاثة الذين تقرّبوا إلى الله بصالح عملهم ففرج الله عنهم، وقد يكون التقرب إلى الله بذات النبي ﷺ كما في حديث الأعمى الذي رواه الطبراني، والأخذ بالأسباب كثير بين الناس في حياتهم وليس قادحا في التوحيد، مع اعتقاد أن الله خالق الأسباب والمسبَّبات، فالمريض يذهب للطبيب ليُشفى واعتقاده أن الله هو الشافي المعافي، وأن الطبيب والدواء سببان، والله يحب من عباده الأخذ بالأسباب في عمل الخيرات للتوصل إليها، فهذا لا ينافي مبدأ التوكل على الله سبحانه وتعالى، فبهذا عُلم أن التوسل بذوات الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ليس عبادة لهم، وإنّما هو أخذ بالأسباب، فالله هو النافع والضار على الحقيقة، فالتوسل بالمعنى الذي ذكرت عملٌ من الدين، وقد علّمه النبي ﷺ للأعمى، فهو ليس بدعة قبيحة تخالف دين الله.
وقد جعل الله الدنيا على الأسباب والمسبَّبَاتِ بمشيئتِه، ومنكرو التوسل يقولون لماذا تجعلون واسطة بقولكم اللهم إني أسألك بعبدك فلان؟ الله لا يحتاج إلى واسطة. يقال لهم: الواسطة قد تأتي بمعنى المعين والمساعد وهو محالٌ بالنسبة إلى الله تعالى، أما الواسطة بمعنى السبب، فالشرع والعقل لا ينفيانه، فالله تعالى هو خالق الأسباب ومسبَّباتها، جعل الأدوية أسبابا للشفاء، وهو خالق الأدوية وخالق الشفاء، لذلك تجد في كتاب الله قول الله تعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [سورة الشعراء/ الآية 80]، وهذه الآية أفادت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبيّن أن الله تعالى هو خالق الشفاء على الحقيقة وهذا اعتقاد المسلمين، ولذلك أمثلة في كتاب الله كثيرة، قال الله تعالى في حق ملك الموت: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [سورة السجدة/ الآية 11] فهنا أخبر أن الذي يباشر قبض الأرواح هو ملك الموت لا على معنى الخلق، بل على معنى السبب، ولذلك تجد في ءاية أخرى قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [سورة الزمر/ الآية 42] لأن الله جعل للملائكة تدبيرا خاصا بإذنه سبحانه کما قال: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ [سورة النازعات/ الآية 5] فهي أسباب لا تخلق شيئًا إنما تدبر نزول المطر والنبات وغير ذلك بإذن الله، وكذلك فإن الله يقول: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ [سورة الأنفال/ الآية 17] مع أن الصحابة هم من باشروا قتل المشركين في المعارك، ولكن الله أفهمنا أنه هو خالق الموت، إلى غيرها من الآيات التي تفيد هذا المعنى، وفي القرءان مواضع كثيرة تؤكد هذا المعنى، وذلك كلُّه نجد معناه صريحًا وواضحًا وساطعًا في بعض قصص القرءان، وعليه فلا يجوز اعتقاد أن هذه الأسباب تخلق بذاتها المسبّبات، فمن اعتقد فيها التأثير والنفع والضرر خلقًا وإيجادًا، كالذي يكون من الله تعالى فهو مشرك مرتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى.
وكذلك فإنّ الشرع الحنيف جعل أسبابًا تقوي الرزق مع اعتقاد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأنه تعالى قال: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [سورة الذاريات/ الآية 22] ولكن هذا لا يعارض أن يسعى الشخص في طلب الرزق أخذا بالأسباب وأخذا بقوله تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ [سورة الملك/ الآية 15]، وكذلك أثبت الشرع وجود الأسباب في الدعاء فهناك أسباب تقوي إجابة الدعاء مع أن الذي يجيب الدعاء هو الله سواء أخذت بهذه الأسباب أم لا، ألا ترون أن الدعاء أقوى في الإجابة إذا دعوت الله تعالى في الحج في عرفة وقد أرشدنا رسول الله ﷺ لهذا فقال: ((خَيْرُ الدّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ)) رواه الترمذي، مع أن الذي يجيب الدعاء هو الله سواء دعوت الله في عرفة يوم عرفة أم دعوت الله في بلادك في أقصى المشرق أو المغرب، فالله لا يستعين بيوم عرفة لإجابة دعائك بل جعله سببا أقوى في إجابة الدعاء وهذا لا يعارض التوحيد ولا يقدح في الدين، وكذلك لا ينكر أحدنا أن الدعاء في آخر الليل في وقت السحر ليس كالدعاء في النهار مثلا لما ثبت من الترغيب في الدعاء في آخر الليل والذي يجيب الدعاء هو الله عز وجل وهو لا يحتاج إلى وقت معين لإجابة دعائنا، وكذلك الدعاء في السجود فهو مرغَّبٌ فيه لحديث أحمد في المسند: ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ))، وكل هذه أسباب لإجابة الدعاء وتقوي إجابة الدعاء، مع أن الذي يجيب الدعاء هو الله عز وجل سواء كانت هذه الأسباب أم لا، ومن هذه الأسباب دعاء الله بجاه النبي ﷺ.
والأسباب إما ضروريةٌ كالأكلِ والشرب وإما غير ضرورية كالتوسل، وكلٌ من جملة الأسباب، والمؤمن الذي يتوسّل بالأنبياء والأولياء لا يعتقد أن الله يستعين بهم في إيصال النفع للمتوسِّل، بل يراهم أسبابًا جعلها الله لحصول النفع بإذنه. ثم إنّ مقصود المتوسِّل قد يحصل وقد لا يحصل، كما أن الذي يتداوى بالأدوية قد يحصل له الشفاء بها وقد لا يحصل. فقول هؤلاء المنكرين لمَ تجعلون وسائط بينكم وبين الله، ولِمَ لا تطلبون حاجاتكم من الله من غير واسطة كلامٌ لا معنى له، لأنّ الشرع رخّص للمؤمن بين أن يطلب من الله حاجته بدون توسّل، وبين أن يطلب حاجته مع التوسل فالذي يقول اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو نحو ذلك، فقد سأل الله، كما أن الذي يقول اللهم إني أسألك كذا وكذا قد سأل الله، فكلا الأمرين سؤال من العبد رَبَّهَ وكلاهما داخلٌ تحت حديث الترمذي: ((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ)) فالأمر ليس کما يزعم من يرمي الناس بالضلالة لمجرد التوسل بالأنبياء والصالحين.
أما من يقول عمن يتوسل بالنبي ﷺ إنه عَبَدَ النّبيّ والعياذ بالله فنقول له: ما معنى العبادة في لغة العرب؟! العرب السليقيون على أي شىء كانوا يطلقون لفظ العبادة؟ العرب السليقيون انقرضوا منذ مئات السنين، فالفاصل بيننا هم علماء اللغة، فنقول: العبادةُ كما عرَّفَها علماءُ اللغةِ كالسُّبْكيِّ: أقصى غايةِ الخشوعِ والخضوعِ.
وقالَ النوويُّ عندَ شرحِ قولِه ﷺ: ((الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئا)) “أمَّا العبادةُ فهي الطاعةُ معَ خضوعٍ، فيَحتمِلُ أنْ يكونَ المرادُ بالعبادةِ هنا معرفةَ اللهِ تعالى والإقرارَ بوحدانيَّتِه”.
وأما خلاصة ما جاء في معنى التوسلِ فهوَ: طلبُ حصولِ منفعَةٍ أوِ اندفاعِ مضرَّةٍ من اللهِ بذكرِ اسمِ نبيٍّ أو وليٍّ إكرامًا للمتوسَّلِ بهِ.اهـ فمجرَّدُ التوسُّلِ والاستغاثةِ بغيرِ اللهِ ليس شركًا وكذلك ليس مجرَّدُ التذللِ لمخلوقٍ عبادةً لغيرِ اللهِ، وإلا لكَفَرَ كلُّ من يتذلَّلُ للملوكِ والعظماءِ، وقد ثبتَ فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى أنّ معاذَ بنَ جبلٍ رضي الله عنه عندما قَدِمَ من الشَّامِ سَجَدَ لرسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ الرسولُ ﷺ: ((مَا هَذَا؟)) فقال: يا رسولَ اللهِ إنِّي رأيتُ أهلَ الشامِ يسجدونَ لبَطَارِقَتِهم وأساقِفَتِهم وأنتَ أولَى بذلكَ فقالَ: ((لا تَفْعَلْ، لَوْ كُنْتُ ءَامُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)) ولم يقلْ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ كَفَرْتَ، ولا قالَ لهُ أَشْرَكْتَ معَ أنَّ سجودَه للنبيِّ ﷺ مظهرٌ كبيرٌ مِن مظاهِرِ التذللِ، فهؤلاءِ الذين يُكفِّرونَ الشخصَ لأنَّه قصدَ قبرَ الرسولِ أو غيرِه مِن الأولياءِ للتبركِ قدْ جَهِلُوا معنى العبادَةِ وخالفُوا ما عليه المسلمونَ، لأنَّ المسلمينَ سلفًا وخلفًا لم يزالوا يزورونَ قبرَ النبيِّ ﷺ، وليس معنى الزيارةِ للتبركِ أنَّ الرسولَ يخلُقُ لهم البركَةَ، بلِ المعنى أنَّهم يَرْجُونَ أنْ يخْلُقَ اللهُ لهمُ البركةَ بزيارتِهم لقبرِه الشريفِ ﷺ.
ومن أصرح الأدلة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته حديث الأعمى، فقد أخرجَ الطبرانيُّ في معجميهِ الكبيرِ والصغيرِعن عثمانَ بنِ حنيفٍ رضي الله عنه أنَّ رجلًا كان يختلفُ إلى عثمانَ بنِ عفانَ رضي الله عنه في حاجةٍ له، فكان عثمانُ لا يلتفِتُ إليه ولا ينظرُ في حاجتِه، فلقِيَ عثمانَ بنَ حنيفٍ رضي الله عنه فشكى إليهِ ذلكَ فقالَ: ائتِ الميضأةَ فتوضأْ ثم صلِّ ركعتينِ ثُمَّ قُلْ: ((اللهُمَّ إنِّي أسْأَلُكَ وأتَوَجَّهُ إليكَ بنبينَا محمدٍ نبيِّ الرَّحْمَةِ، يا محمدُ إنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إلى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لِتُقْضَى لي حَاجَتِي)) وتذكرُ حاجتَك، ورُحْ حتى أروحَ معك، فانطلَقَ الرجلُ فصنَعَ ما قال عثمانُ له، ثم أتى عثمانَ بنَ عفَّان رضي الله عنه، فجاءَ البوَّابُ فأخذَه بيدِه فأدخلَه على عثمانَ بنِ عفّان فأجلسَه على الطِّنْفِسَةِ فقال: ما حاجتُك؟ فذكرَ له حاجتَه فقضاها له، ثم قالَ له: ما ذكرتُ حاجتَك حتى كانت هذه الساعة، وقالَ له: ما كانَ لكَ حاجةٌ فأْتِنَا، ثم إنَّ الرجُلَ خرجَ مِن عندِه فلقيَ عثمانَ بنَ حُنيفٍ رضي الله عنه فقالَ لهُ: جزاكَ اللهُ خيرًا ما كانَ ينظرُ في حاجتي ولا يلتفِتُ حتى كلَّمتَه فِيَّ، فقالَ عثمانُ بنُ حنيفٍ: واللهِ ما كلّمتُه ولكنْ شهدتُ رسولَ اللهِ ﷺ وقد أتاهُ ضريرٌ فشكَا إليهِ ذهابَ بصرِه، فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: ((أَوَ تَصْبِرْ))؟ فقالَ: يا رسولَ اللهِ إنَّه ليسَ لي قائدٌ وقدْ شقَّ عليَّ، فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: ((ائتِ الِميضَأَةَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ادْعُ بِهَذِهِ الدَعَوَاتِ)) قالَ عثمانُ بنُ حنيفٍ رضي الله عنه: فواللهِ ما تفرَّقْنا ولا طالَ بنا الحديثُ حتى دخلَ علينا الرجلُ كأنَّه لم يكن بهِ ضُرٌّ قطُّ.اهـ قالَ الطبرانيُّ: والحديثُ صحيحٌ.اهـ
ومن الدليلِ على جوازِ التوسلِ بالأنبياءِ والصالحينَ حديثُ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه الذي حسَّنهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ وغيرُه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ((اللهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هذا فَإِنِي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا، وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً خَرَجْتُ اتقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَكَّلَ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَأَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِه – قال المناوي:أَي برحمته ولطفه – حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهِ)) رواه الطبراني في الدعاء وابن ماجه وأحمد في مسنده. وروى البخاريُّ في الأدب المفرد عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ قالَ: ((خَدِرَتْ رِجْلُ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما فقَالَ لهُ رجلٌ: اذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ، فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ، فَذَهَبَ خَدَرُ رِجْلِهِ)). ومما يدلُّ على جوازِ التوسلِ أيضًا ما صحَّ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عنْ أبي عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ رضي الله عنهما قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ نفر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فانْحَدَرَتْ صَخْرةٌ مِنَ الْجبلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنَ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ تَعَالَى بِصَالِحِ أَعْمَالكُمْ، قالَ رجلٌ مِنهُمْ: اللهُمَّ كَانَ لِي أَبَوانِ شَيْخَانِ كَبِيرانِ، وكُنْتُ لَا أَغبِقُ قبْلهَما أَهْلًا وَلَا مالًا فَنَأَى بي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلبْتُ لَهُمَا غبُوقَهمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِميْنِ، فَكَرِهْت أَنْ أُوقِظَهمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَة، فانْفَرَجَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ)) الحديثَ، فإذا كانَ التوسلُ بالعملِ الصالحِ جائزًا كما في الحديثِ السابقِ الذِكرِ فكيفَ لا يصحُّ بالذواتِ الفاضلةِ كذواتِ الأنبياءِ.
فائدة أخرى: اللهُ تعالى يجيبُ دعوةَ المضطرِ إذا دعاهُ، وهناكَ أسبابٌ تقويْ إجابةَ الدعاءِ كالدعاءِ بجاهِ رسولِ اللهِ ﷺ أوْ بغيرِه منَ الأنبياءِ والأولياءِ والصالحين، وكذلكَ الدعاءُ عندَ قبورِ الأنبياء والأولياءِ والصالحينَ. فالخليفةُ المنصورُ لما حجَّ وزارَ قبرَ النبيِّ ﷺ سألَ مالكًا قائلًا: “يا أبا عبدِ اللهِ أستقبلُ القبلةَ وأدعو أمْ أستقبلُ رسولَ اللهِ ﷺ؟ قالَ: ولِمَ تَصرفُ وجهَك عنهُ وهوَ وسيلتُك ووسيلةُ أبيكَ ءادمَ عليهِ السلامُ إلى اللهِ تعالى؟ بلِ استقبِلْه واستشْفِعْ بهِ فَيُشَفِّعْهُ اللهُ”، وقدْ قالَ الحافظُ الجزريُّ: “مِنْ مواضعِ إجابةِ الدعاءِ قبورُ الصالحينَ”اهـ وهذا الحافظُ الخطيبُ البغداديُّ يقولُ: “كانَ سيدُنَا محمَّدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ رضي الله عنه يقولُ: إِنِّي لأَتَبَرَّكُ بِأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَجِيءُ إلى قَبْرِهِ فِي كُلِّ يومٍ، فإذَا عَرَضَتْ لِي حاجةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَجِئْتُ إِلى قَبْرِهِ وَسَأَلْتُ اللهَ تعالى الحاجةَ عندَه، فمَا تبعُدُ عَنِّي حتى تُقْضَى”اهـ. والشافعيُّ هوَ الذي فُسِّرَ بهِ حديثُ رسولِ اللهِ ﷺ الذي رواه ابن أبي عاصم والنووي: ((عَالِمُ قُرَيْشٍ يَمْلأُ طِبَاقَ الأَرْضِ عِلْمًا)) كانَ يأتي قبرَ الإمامِ أبي حنيفةَ ويدعو عندَه فكيفَ بالدعاءِ عندَ قبرِ النبيِّ ﷺ. وقالَ الحافظُ ابنُ الجوزيِّ الحنبليُّ في ترجمةِ إبراهيمَ الحربيِّ: “وتوفيَ في بغدادَ سنةَ خمسٍ وثمانينَ ومائتينِ وقبرُه ظاهرٌ يتبركُ الناسُ بهِ رضي الله عنه”اهـ.
وقالَ الحافظُ ابنُ الملقنِ عندَ ذِكْرِ السيدةِ نفيسةَ رضيَ اللهُ عنها ما نصُّه: قبرُها معروفٌ بإجابةِ الدعاءِاهـ
قالَ الذهبيُّ عندَ ذِكْرِ السيدةِ نفيسةَ: كانتْ مِنَ الصالحاتِ العوابدِ، والدعاءُ مستجابٌ عندَ قبرِها بلْ وعندَ قبورِ الأنبياءِ والصالحينَ وفي المساجدِ وعرفةَ ومزدلفةَ وفي السفرِ المباحِ”اهـ
وقالَ الذهبيُّ أيضًا: لأَنَّ البقاعَ المباركةَ يستجابُ عندَها الدعاءُ، كمَا أَنَّ الدعاءَ في السحرِ مرجوٌّ، ودبرِ المكتوباتِ، وفي المساجدِ”.
وقالَ الذهبيُّ أيضًا: “وعنْ إبراهيمَ الحربيِّ قالَ: قبرُ معروفٍ الترياقُ المجرب”. انتهى كلامُ الذهبيِّ،
وقالَ الحافظُ الضياءُ المقدسيُّ الحنبليُّ أنَّه سمعَ الحافظَ عبدَ الغنيِّ المقدسيَّ الحنبليَّ يقولُ: “إنَّه خرجَ في عَضُدِه شىءٌ يُشبهُ الدُمَّلَ فأَعْيَتْه مداواتُه، ثم مسحَ به قبرَ أحمدَ بنِ حنبلٍ رضي الله عنه فبرئَ ولم يَعُدْ إليهِ”.
وَمِنْ جُمْلَةِ لَطَائِفِ الدُّعَاءِ مَا جَاءَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فيما رواه مسلم: ((دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ)).
وعنْ أبي هريرة أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ فيما رواه البخاري: ((إذا أَمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تأْمينُهُ تأْمينَ الملائكةِ غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
وَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِ مَا فِيهِ ذِكْرُ آدَابٍ لِلدُّعَاءِ وَمَا فِيهِ إِشَارَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلدَّاعِي كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَتَّى يُجَابَ دُعَاؤُهُ، ومنهُ ما جاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [سورة المؤمنون/ الآية 51] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [سورة البقرة/ الآية 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَذلك)) فَاُنْظُرْ إِلَى إِشَارَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَكَرَ أُمُورًا تُقَوِّي إِجَابَةَ الدُّعَاءِ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ رِزْقُكَ طَيِّبًا وَتَأْكُلَ الحَلَالَ وَتَبْتَعِدَ عَنِ الحَرَامِ، وَكَذَلِكَ أَشَارَ إِلَى دَعْوَةِ المسَافِرِ فَإِنَّهُ يُرْجَى فِيهَا إِجَابَةُ الدُّعَاءِ، وَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِيْ عَلَى حَالِ الانْكِسَارِ وَالتَّذَلُّلِ وَأَنْ يَمُدَّ يَدَيْهِ لِلسَّمَاءِ الَّتِي هِيَ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ وَمَهْبطُ الرَّحَمَاتِ وَالبَرَكَاتِ وَلَيْسَ لِأَنَّ اللهَ يَسْكُنُهَا فَالله مَوْجُودٌ بِلَا مَكَانٍ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ، وَمِمَّا يَقْوَى إِجَابَةَ الدُّعَاءِ وَهُوَ مستفادٌ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ أَنْ يُكْثِرَ فِي الدُّعَاءِ مِنْ قَوْلِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، فتَكْرَارُ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ.
فَائِدَةٌ: روى السيوطي في جامع الأحاديث عن أبي الدرداء قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ((مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعًا وعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْسًا وعِشْرِينَ مَرَّةً ـ أحدَ العددينِ ـ كَانَ مِنَ الذينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ، ويُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الأَرْضِ)).
والله تعالى أعلم وأحكم
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة