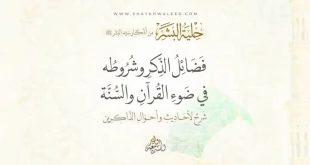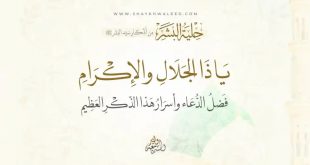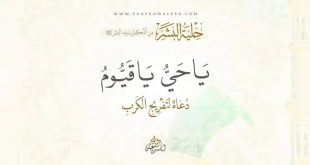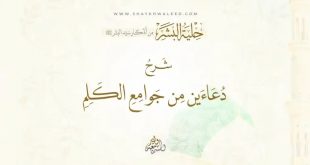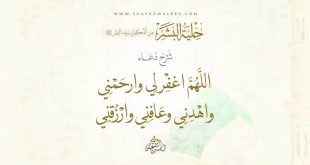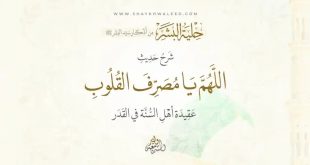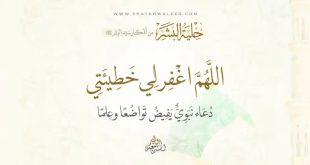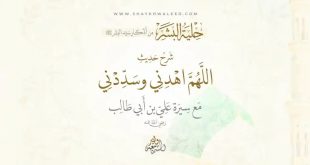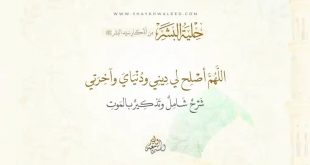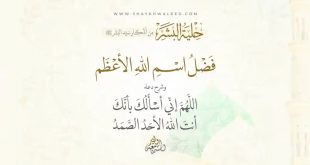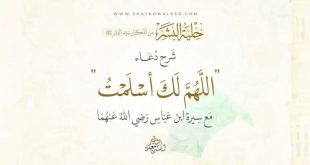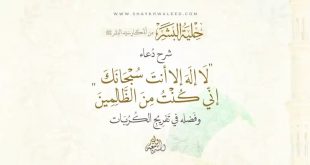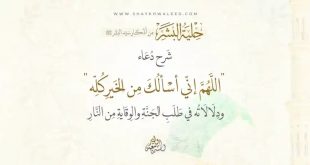المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّيِّبَاتِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطيبين الطاهرين، أما بعد:
الحديث
وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِىُّ وَابْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.
الشرح
وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِىُّ وَابْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ قال القاضي عياض: هذا يدل على رفعهما فوق الصدر وحذو الأذنين؛ لأنّ رفعهما مع الصدر لا يكشف بياض الإبط.
قال ابن هبيرة: هذا الحديث يدلّ على أن رفع اليدين في الدعاء مُستحب ورفع اليدين مناسب لذلّ الطالب ولإظهار فاقته وحاجته.
وقد روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ)).
وقد استحبّ جماعة من العلماء رفع اليدين عند الدعاء.
وكيفية الرفع: يشير ببطونهما إلى السماء. وهو رفع الرغبة والطلب.
قال النووي: “قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ)) هَذَا الْحَدِيثُ يُوهِمُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يرفع إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ قد ثبت رفع يديه فِي الدُّعَاءِ فِي مَوَاطِنَ غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ، وَقَدْ جَمَعْتُ مِنْهَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ حَدِيثًا مِنَ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أحدهما وذكرتها فِي أَوَاخِرِ بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.
وَيُتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعِ الرَّفْعَ الْبَلِيغَ بِحَيْثُ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ أَرَهُ رَفَعَ وَقَدْ رَآهُ غَيْرُهُ رَفَعَ فَيُقَدَّمُ الْمُثْبِتُونَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ وَهُمْ جَمَاعَاتٌ عَلَى وَاحِدٍ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ”.
قال ابن حجر في الفتح: “يُسْتَفَادُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّ ذَلِكَ بِالِاسْتِسْقَاءِ”. وقال أيضًا في التلخيص الحبير: “وروى البيهقي عن أنس أنه رفع يديه في القنوت، وعن عائشة أنه رفع يديه في دعائه لأهل البقيع رواه مسلم، وعنده عن عمر: أنه رفع يده صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم بدر، وللبخاري عن ابن عمر أنه رفعها في دعائه عند الجمرة الوسطى، وروى البخاري في جزء رفع اليدين رفع يديه في مواطن من حديث عائشة وأبي هريرة وجابر، وعلي”.
قال القرطبي في شرحه لمسلم: “وقول أنس: إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني: أنه لم يكن يبالغ في الرفع، إلا في الاستسقاء”.
تنبيه مهم: ليس معنى رفع اليدين في الدعاء أنّ الله منحصر في جهة فوق أو في السماء بذاته والعياذ بالله فاعتقاد هذا لا يجوز وهو ليس اعتقادَ المسلمين.
اللَّهُ تَعَالَى غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ أَىْ مُسْتَغْنٍ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ أَزَلًا وَأَبَدًا فَلا يَحْتَاجُ إِلَى مَكَانٍ يَتَحَيَّزُ فِيهِ أَوْ شَىْءٍ يَحُلُّ بِهِ أَوْ إِلَى جِهَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَشَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ لَيْسَ حَجْمًا كَثِيفًا وَلا حَجْمًا لَطِيفًا، وَالتَّحَيُّزُ مِنْ صِفَاتِ الْجِسْمِ الْكَثِيفِ وَاللَّطِيفِ، فَالْجِسْمُ الْكَثِيفُ مُتَحَيِّزٌ فِى جِهَةٍ وَمَكَانٍ وَالْجِسْمُ اللَّطِيفُ مُتَحَيِّزٌ فِى جِهَةٍ وَمَكَانٍ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِى سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [سورة الأنبياء/ الآية 33] فَأَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلٍّ مِنَ الأَرْبَعَةِ – اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمَا لَطِيفَانِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَهُمَا كَثِيفَانِ – التَّحَيُّزَ فِى فَلَكِهِ وَهُوَ الْمَدَارُ، الَّذِى يَجْرِى فِيهِ، وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى مَوْجُودًا قَبْلَ خَلْقِ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَالْحَيِّزِ وَالْجِهَةِ بِلا مَكَانٍ وَلا زَمَانٍ وَلا حَيِّزٍ وَلا جِهَةٍ وَبَعْدَ أَنْ خَلَقَهَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ تَغَيُّرٌ سُبْحَانَهُ وَهُوَ غَنِىٌّ عَنْهَا.
وَلِذَلِكَ أَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى نَفْىِ الْحَدِّ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِكَلِمَاتٍ صَرِيحَةٍ بِحَيْثُ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُشَبِّهَةُ إِنْكَارَهَا:
قال مصباح التوحيد ومصباح التفريد الصحابي الجليل والخليفة الراشد سيدنا علي رضي الله عنه (40 هـ) ما نصه “كان الله ولا مكان، وهو الان على ما – عليه – كان اهـ. أي بلا مكان. كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي ص / 333.
وقال أيضًا: “إن الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته لا مكانا لذاته”. كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي ص / 333.
وقال أيضًا: “من زعم أنّ إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود”. [المحدود: ما له حجم صغيرًا كان أو كبيرًا]. كتاب حلية الأولياء: ترجمة علي بن أبي طالب (73/1)، للمؤلف أبي نعيم الأصبهاني حافظ الدنيا وشيخ المحدّثين في زمانه وصاحب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وكان أصحاب الحديث يقولون: “بقي الحافظ أبو نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير، لا يوجد شرقًا، ولا غربًا، أعلى إسنادًا منه، ولا أحفظ منه”. هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ولد سنة ٣٣٦ هـ. لو رجم النجم جميع الورى لم يصل الرجم إلى النجم.
وقال التابعي الجليل الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم (94 هـ) ما نصه: “أنت الله الذي لا يحويك مكان” كتاب إتحاف السادة المتقين (4/ 380).
وقال أيضًا: “أنت الله الذي لا تحدّ فتكون محدودًا”. كتاب إتحاف السادة المتقين (4/ 380).
وقال الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين رضوان الله عليهم (148 هـ) ما نصه: “مَن زَعَمَ أنّ اللهَ في شىء، أو من شىء، أو على شىء فقد أشرك. إذ لو كان على شىء لكان محمولا، ولو كان في شىء لكان محصورا، ولو كان من شىء لكان محدثا – أي مخلوقا -“. ذكره القشيري في رسالته المعروفة بالرسالة القشيرية (ص/ 6).
قال الإمام المجتهد أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه (150هـ) أحد مشاهير علماء السلف إمام المذهب الحنفي ما نصه: “والله تعالى يُرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كميّة، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة”. ذكره في الفقه الأكبر، انظر شرح الفقه الأكبر لملّا علي القاري (ص/ 136- 137).
وقال أيضًا في كتابه الوصية: “ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حقّ”. (ص/ 4)، ونقله ملّا علي القاري في شرح الفقه الأكبر (ص/138).
وقال أيضًا: “قلت: أرأيت لو قيل أين الله تعالى؟ فقال – أي أبو حنيفة: يقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شىء، وهو خالق كل شىء”. كتاب الفقه الأبسط ضمن مجموعة رسانل أبي حنيفة بتحقيق الكوثري (ص/ 25).
وقال أيضًا: “ونقرّ بأنّ الله سبحانه وتعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجًا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان محتاجًا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا”. كتاب الوصية، ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة بتحقيق الكوثري (ص/ 2)، وملًا علي القاري في شرح الفقه الأكبر (ص/ 75) عند شرح قول الإمام: ولكن يده صفته بلا كيف.
وهذا ردّ صريح على المشبهة المجسمة أدعياء السلفية الذين يزعمون أنّ السلف لم يصرحوا بنفي الجهة عن الله تعالى.
وهذا ردّ صريح على المشبهة المجسمة أدعياء السلفية الذين يزعمون أنّ السلف لم يصرحوا بنفي الجهة عن الله تعالى.
فإنّ أبا حنيفة رأس من رؤوس السلف الذين تلقوا العلم عن التابعين، والتابعون تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، فاحفظ هذا أخي المسلم فإنه مهم في رد افتراءات المشبهة على علماء السلف.
ونلفت النظر إلى أنّ أتباع أبي حنيفة أي الذين هم على مذهبه سواء في لبنان وسوريا وتركيا وأندنوسيا والهند وغيرها من البلدان على هذا المعتقد أي ينزهون الله تعالى عن التحيز في جهة فوق العرش ويقولون الله موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان، إلا من لحق منهم بأهل التجسيم الذين فتنوا بالمجسمة وغرّتهم الحياة الدنيا.
وأمّا تكفير الإمام أبي حنيفة لمن يقول: “لا أعرف ربي فى السماء أو في الأرض”، وكذا من قال: “إنه على العرش، ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض” فلأنّ قائل هاتين العبارتين جعل الله تعالى مختص بحيز وجهة ومكان، وكلّ ما هو مختص بالجهة والحيّز فإنّه محتاج محدث بالضرورة. وليس مراده كما زعم المشبهة إثبات أن السماء والعرش مكان لله تعالى، بدليل كلامه السابق الصريح في نفي الجهة والمكان عن الله.
وقال الشيخ الإمام العز بن عبد السلام الشافعي في كتابه “حل الرموز” في بيان مراد أبي حنيفة ما نصه: “لأنّ هذا القول يوهم أنّ للحق مكانًا، ومن توهم أنّ للحق مكانا فهو مشبّه” اهـ، وأيّد ملّا علي القاري كلام ابن عبد السلام بقوله: “ولا شكّ أنّ ابن عبد السلام من أجلّ العلماء وأوثقهم، فيجب الاعتماد على نقله” اهـ. نقله ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر بعد أن انتهى من شرح رسالة الفقه الأكبر (ص/ 198).
وقال الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه إمام المذهب الشافعي (204 هـ) ما نصه: ” إنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه التغيير في ذاته ولا التبديل في صفاته” اهـ. كتاب إتحاف السادة المتقين (2/ 24).
وأمّا الإمام المجتهد الجليل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (241 هـ) رضي الله عنه إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة، فقد ذكر الشيخ ابن حجر الهيتمي أنّه كان من المنزهين لله تعالى عن الجهة والجسمية، ثم قال ابن حجر ما نصّه: “وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشىء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه” اهـ. الفتاوي الحديثية(ص / 144).
وقال الصوفي الزاهد ذو النون المصري (245 هـ) ما نصه:
ربي تعالى فلا شىء يحيط بـــــه وهو المحيط بنا في كـل مرتصد
لا الأين والحيث والتكييف يدركه ولا يـحـد بـمـقــــــــدار ولا أمـد
وكـيـــــف يـدركـه حـد ولـم تـره عين وليس له في المثل من أحـد
أم كـيف يبلغه وهـــــــم بلا شبه وقد تعالى عن الأشبـــــاه والولد
وَمِنْ جُمْلَةِ مَا رُوِىَ عَنِ السَّلَفِ فِى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ، وَمَا رَوَاهُ الزَّبِيدِىُّ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِىِّ بنِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: “سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لا يَحْوِيكَ مَكَانٌ لا تُحَسُّ وَلا تُمَسُّ وَلا تُجَسُّ” اﻫ.
وَيَكْفِى فِى تَنْزِيهِ اللَّهِ عَنِ الْمَكَانِ وَالْحَيِّزِ وَالْجِهَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِى سُورَةِ الشُّورَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [سورة الشورى/ الآية 11] لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَكَانٌ لَكَانَ لَهُ أَمْثَالٌ وَأَبْعَادٌ طُولٌ وَعَرْضٌ وَعُمْقٌ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ مُحْدَثًا مُحْتَاجًا لِمَنْ حَدَّهُ بِهَذَا الطُّولِ وَبِهَذَا الْعَرْضِ وَبِهَذَا الْعُمْقِ. هَذَا الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْءَانِ.
أَمَّا مِنَ الْحَدِيثِ فَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى صَحِيحِهِ وَابْنُ الْجَارُودِ فِى الْمُنْتَقَى وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ بِالإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيْرُهُ)). اهـ
وَالْمَكَانُ هُوَ غَيْرُ اللَّهِ قَطْعًا فَهَذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ هُوَ أَصْلُ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ نَصَرَهُمُ اللَّهُ: كَانَ اللَّهُ وَلا مَكَان، وَمَعْنَاهُ – أَىِ الْحَدِيثِ – أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ مَوْجُودًا فِى الأَزَلِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ لا مَاءٌ وَلا هَوَاءٌ وَلا أَرْضٌ وَلا سَمَاءٌ وَلا كُرْسِىٌّ وَلا عَرْشٌ وَلا إِنْسٌ وَلا جِنٌّ وَلا مَلائِكَةٌ وَلا زَمَانٌ وَلا مَكَانٌ وَلا جِهَاتٌ. فَهُوَ تَعَالَى مَوْجُودٌ قَبْلَ الْمَكَانِ بِلا مَكَانٍ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ الْمَكَانَ فَلَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِىُّ فِى كِتَابِهِ الأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: “اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِى نَفْىِ الْمَكَانِ عَنْهُ تَعَالَى بِقَوْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ)) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَوْقَهُ شَىْءٌ وَلا دُونَهُ – أَىْ تَحْتَهُ – شَىْءٌ لَمْ يَكُنْ فِى مَكَانٍ” اﻫ. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ الرَّدُّ أَيْضًا عَلَى الْقَائِلِينَ بِالْجِهَةِ فِى حَقِّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ فِى الأَزَلِ بِلا جِهَاتٍ وَبَعْدَ أَنْ خَلَقَ الْجِهَاتِ السِّتَّ هُوَ مَوْجُودٌ عَلَى مَا كَانَ بِلا تَغَيُّرٍ لِأَنَّ التَّغَيُّرَ دَلِيلُ الْحُدُوثِ.
وَلَوْ كَانَ الِاتِّصَافُ بِالْجِهَةِ كَمَالًا فِى حَقِّ اللَّهِ لَكَانَ وُجُودُهُ بِلا جِهَةٍ نَقْصًا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.
وَأَمَّا مَعْنَى ((الظَّاهِرِ)) الَّذِى جَاءَ فِى الْحَدِيثِ فَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلائِلُ الْعَقْلِيَّةُ فَإِنَّهُ مَا مِنْ شَىْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَعِلْمِهِ
وَأَمَّا ((الْبَاطِنُ)) مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَمَعْنَاهُ الَّذِى يَعْلَمُ حَقَائِقَ الأُمُورِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ بَعْضٌ: الْبَاطِنُ هُوَ الَّذِى لا تُدْرِكُهُ الأَوْهَامُ وَالتَّصَوُّرَاتُ.
والْقَوْلُ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ بِلا مَكَانٍ وَجِهَةٍ لا يَكُونُ نَفْيًا لِوُجُودِهِ تَعَالَى كَمَا زَعَمَتِ الْمُشَبِّهَةُ والدُّعَاةُ إِلَى التَّجْسِيمِ فِى هَذَا الْعَصْرِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: قَبْلَ خَلْقِ الْعَالَمِ هَلْ يُقَالُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ دَاخِلَهُ أَوْ خَارِجَهُ أَوْ فِى جِهَةٍ مِنْهُ فَيَلْزَمُ أَنْ يَقُولُوا لا، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَمَا صَحَّ عَقْلًا وُجُودُهُ تَعَالَى قَبْلَ خَلْقِ الْعَالَمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلا خَارِجَهُ وَلا فِى جِهَةٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَفْيًا لِوُجُودِهِ تَعَالَى فَكَذَلِكَ بَعْدَ خَلْقِ الْعَالَمِ هُوَ مَوْجُودٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَهُ أَوْ خَارِجَهُ أَوْ فِى جِهَةٍ مِنْهُ وَلا يَكُونُ هَذَا نَفْيًا لِوُجُودِهِ تَعَالَى.
وَحُكْمُ مَنْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِى كُلِّ مَكَانٍ أَوْ فِى جَمِيعِ الأَمَاكِنِ التَّكْفِيرُ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِى نِسْبَةِ التَّمَكُّنِ فِى الأَمَاكِنِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. هَذَا إِذَا كَانَ يَفْهَمُ مَعْنَى مَا يَقُولُ أَىْ يَفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَعْنَاهَا فِى اللُّغَةِ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ بِذَاتِهِ مُنْبَثٌّ أَىْ مُنْتَشِرٌ أَوْ حَالٌّ فِى الأَمَاكِنِ أَمَّا إِذَا كَانَ لا يَفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِىَّ لِضَعْفِ مَعْرِفَتِهِ بِاللُّغَةِ بَلْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَا أَنَّهُ تَعَالَى مُسَيْطِرٌ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَعَالِمٌ بِكُلِّ شَىْءٍ فَلا يَكْفُرُ وَهَذَا قَصْدُ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَلْهَجُ بِهَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ؛ أَىْ يُكْثِرُ اسْتِعْمَالَهُمَا فَإِنَّهُمْ يَظُنُّونَ لِجَهْلِهِمْ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ تَحْتَمِلُ هَذَا الْمَعْنَى فِى اللُّغَةِ فَيَقْصِدُونَهُ عِنْدَ النُّطْقِ، وَيَجِبُ النَّهْىُ عَنْهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا صَادِرَتَيْنِ عَنِ السَّلَفِ.
وَاعْتِقَادُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنْبَثٌّ فِى كُلِّ مَكَانٍ هُوَ عَقِيدَةُ الْجَهْمِيَّةِ فَإِنَّ جَهْمَ بنَ صَفْوَانٍ قَالَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ هَذَا الْهَوَاءُ مَعَ كُلِّ شَىْءٍ وَفِى كُلِّ شَىْءٍ وَلا يَخْلُو مِنْهُ شَىْءٌ اﻫ. فَكَفَّرَهُ الْمُسْلِمُونَ وَقُتِلَ عَلَى ذَلِكَ بِحُكْمِ الرِّدَّةِ.
وَنَرْفَعُ الأَيْدِىَ فِى الدُّعَاءِ لِلسَّمَاءِ لِأَنَّهَا مَهْبِطُ الرَّحَمَاتِ وَالْبَرَكَاتِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَثِيرٌ، وَلَيْسَ لِأَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ فِى السَّمَاءِ، وَمَعْنَى مَدِّ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ إِلَيْهَا اسْتِنْزَالُ الرَّحْمَةِ مِنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُخَيِّبُ الْقَاصِدِينَ بِحَقٍّ فَالسَّمَاءُ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ كَمَا أَنَّنَا نَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ فِى الصَّلاةِ فَهِىَ قِبْلَةُ الصَّلاةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِذَلِكَ وَلَيْسَ لِأَنَّ لَهَا مِيزَةٌ وَخُصُوصِيَّةٌ بِسُكْنَى اللَّهِ فِيهَا.
وَيَكْفُرُ مَنْ يَعْتَقِدُ التَّحَيُّزَ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ شَىْءٌ كَالْهَوَاءِ أَوْ كَالنُّورِ يَمْلَأُ مَكَانًا أَوْ غُرْفَةً أَوْ مَسْجِدًا كَمَا تَقَدَّمَ.
وَيُرَدُّ عَلَى الْمُعْتَقِدِينَ أَنَّ اللَّهَ مُتَحَيِّزٌ فِى جِهَةِ الْعُلْوِ مِنْ قُدَمَاءِ الْمُشَبِّهَةِ وَمُحْدَثِيهِمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لِذَلِكَ تُرْفَعُ الأَيْدِى عِنْدَ الدُّعَاءِ: بِمَا ثَبَتَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَسْقَى أَىْ طَلَبَ الْمَطَرَ وَجَعَلَ بَطْنَ كَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ وَظَاهِرَهُمَا إِلَى السَّمَاءِ كَمَا فِى صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمُصَلِّىَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِى الصَّلاةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَلَوْ كَانَ اللَّهُ مُتَحَيِّزًا فِى جِهَةِ الْعُلْوِ كَمَا تَظُنُّ الْمُشَبِّهَةُ مَا نَهَانَا عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِنَا فِى الصَّلاةِ إِلَى السَّمَاءِ وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ إِصْبَعَهُ الْمُسَبِّحَةَ عِنْدَ قَوْلِ إِلَّا اللَّهُ فِى التَّحِيَّاتِ وَيَحْنِيهَا قَلِيلًا فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا تَقُولُ الْمُشَبِّهَةُ مَا كَانَ يَحْنِيهَا بَلْ كَانَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَكُلُّ هَذَا ثَابِتٌ حَدِيثًا عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ فَمَاذَا تَفْعَلُ الْمُشَبِّهَةُ.
وَأَمَّا مَا فِى صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ائْتِنِى بِهَا فَأَتَاهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِى السَّمَاءِ. قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. اﻫ
فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ صَالِحٍ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ فِى الْعَقِيدَةِ؛ لِأَنَّهُ لا بُدَّ لِلِاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ فِى أُمُورِ الِاعْتِقَادِ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَ رُتْبَةَ الْمَشْهُورِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا لِأَنَّ الْعَقَائِدَ تُبْنَى عَلَى الْقَطْعِيَّاتِ لا عَلَى الظَّنِّيَّاتِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الْمَشْهُورِ.
وَعِنْدَ الْبَقِيَّةِ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الحديث صَحِيحًا ثَابِتًا بِلا خِلافٍ، وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ؛ الأَوَّلُ: لِلِاضْطِرَابِ عَلَى فَرْضِ تَسَاوِى رِوَايَاتِهِ فِى الْقُوَّةِ؛ لِأَنَّهُ رُوِىَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِلَفْظِ: ((مَنْ رَبُّكِ؟)) فَقَالَتِ: اللَّهُ. وَبِلَفْظِ: ((أَيْنَ اللَّهُ؟)) فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، وَبِلَفْظِ: ((أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَتَشْهَدِينَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ)) قَالَتْ: نَعَمْ، وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ كَلامُ الْبَيْهَقِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
وَالأَمْرُ الثَّانِى: أَنَّ رِوَايَةَ ((أَيْنَ اللَّهُ؟)) مُخَالِفَةٌ لِلأُصُولِ لِأَنَّ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الشَّخْصَ لا يُحْكَمُ لَهُ بِقَوْلِ “اللَّهُ فِى السَّمَاءِ” بِالإِسْلامِ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا الأَصْلُ الْمَعْرُوفُ فِى شَرِيعَةِ اللَّهِ مَا جَاءَ فِى الْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ الَّذِى نَصَّ عَلَى تَوَاتُرِهِ الْحَافِظُ السُّيُوطِىُّ وَغَيْرُهُ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ)) رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وغيرهما، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ حَدِيثَ الآحَادِ إِذَا خَالَفَ الأُصُولَ الْقَطْعِيَّةَ يُرَدُّ وَلا يُقْبَلُ فَهُنَا كَذَلِكَ فَتَكُونُ رِوَايَةُ ((أَيْنَ اللَّهُ)) شَاذَّةً مُخَالِفَةً لِلأُصُولِ فَلا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا، وَأَمَّا لَفْظُ رِوَايَةِ مَالِكٍ الأُخْرَى ((أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) إِلَى ءَاخِرِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلأُصُولِ فَيَكُونُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ.
فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذَا حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ بَاطِلٌ لِمُعَارَضَتِهِ الْحَدِيثَ الْمُتَوَاتِرَ الْمَذْكُورَ، وَالْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ قَطْعِىُّ الثُّبُوتِ لِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَا خَالَفَ الْمُتَوَاتِرَ فَهُوَ بَاطِلٌ إِنْ لَمْ يَقْبَلِ التَّأْوِيلَ. اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ الْمُحَدِّثُونَ وَالأُصُولِيُّونَ.
فَحَدِيثُ الْجَارِيَةِ مَهْمَا قِيلَ فِى تَصْحِيحِهِ أَوْ تَضْعِيفِهِ هُوَ حَدِيثُ ءَاحَادٍ أَىْ هُوَ ظَنِىُّ الثُّبُوتِ لا قَطْعِيُّهُ وَمَا كَانَ ظَنِّىَّ الثُّبُوتِ لا يُؤْخَذُ بِهِ وَلا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إِذَا عَارَضَ الثَّابِتَ بِالْقَطْعِ وَالْيَقِينِ بِحَيْثُ لا يَكُونُ هُنَاكَ مَجَالٌ لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْخَطِيبُ فِى الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَّقِهِ وَالنَّوَوِىُّ فِى التَّقْرِيبِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِى الْوَرَقَاتِ وَغَيْرُهُمْ.
لَكِنْ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَوَّلُوهُ أَىْ أَوَّلُوا حَدِيثَ الْجَارِيَةِ وَحَمَلُوهُ عَلَى مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ بِحَيْثُ لَمْ يَعُدْ هُنَاكَ تَعَارُضٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ. وَأَخْذًا بِالِاعْتِبَارِ لِتَأْوِيلِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحَّحَهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ قَالُوا: مَعْنَى أَيْنَ اللَّهُ سُؤَالٌ عَنْ تَعْظِيمِهَا لِلَّهِ؛ أَىْ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا مَاذَا تَعْتَقِدِينَ فِى اللَّهِ مِنَ الْمَكَانَةِ فَإِنَّ لَفْظَةَ (أَيْنَ) يُسْتَفْهَمُ بِهَا عَنِ الْمَكَانَةِ كَمَا يُسْتَفْهَمُ بِهَا عَنِ الْمَكَانِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ:
أَيْنَ الثُرَيَّا وَأَيْنَ الثَّرَى وَأَيْنَ مُعَاوِى وَأَيْنَ عَلِى
وَمِنَ الْجَهْلِ الْبَيِّنِ قَوْلُ بَعْضِ الْمُجَسِّمَةِ فِى رَدِّ هَذَا الأَمْرِ إِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوا إِنَّ (أَيْنَ) يُسْأَلُ بِهَا عَنِ الْمَكَانِ، إِذْ فَاتَهُمْ أَنَّ الْمَكَانَ يَعْنِى الْحَيِّزَ وَالْمَوْضِعَ كَمَا يَأْتِى بِمَعْنَى الرُّتْبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ وَكُتُبُ اللُّغَةِ وَكَلامُ الْعَرَبِ مَشْحُونَانِ بِبَيَانِ ذَلِكَ.
وَقَوْلُهَا أَىْ قَوْلُ الْجَارِيَةِ: (فِى السَّمَاءِ) مَعْنَاهُ هُوَ: عَالِى الْقَدْرِ جِدًّا؛ أَىْ أَعْلَى مِنْ كُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ كَلامِ الْعَرَبِ.
قَالَ النَّابِغَةُ الْجَعْدِىُّ وَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ:
بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَسَنَاؤُنَا وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا
رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ.
خلاصةُ الأمرِ أنه إذا أوردَ مُشَبِّهٌ هذا الحديثَ فطُرُقٌ إمَّا القولُ بأنَّ الحديثَ إن حُمِلَ على ظاهرِهِ فهو مِن روايةِ ءَاحادٍ ولا يُعتَمَدُ عليها فِى العقائدِ وهو قولُ الحنفيةِ وبعضٍ غيرِهِم، وإمَّا القولُ بالتأويل وبأنَّ هذا الحديثَ له معنًى صحيحٌ لا بدَّ أنْ يُحْمَل عليه حتى لا تتعارضَ الرواياتُ وإلى هذا ذهب بعضُ أهلِ الحديثِ، وإما القولُ بأنَّ بعضَ رواياتِ هذا الحديثِ متعارِضَةٌ متساويَةُ القُوَّةِ لا يُمْكِنُ الجَمْعُ بينها فيكون الحديثُ مضطربًا لم يُعْتَنَ بحفظِهِ وضبطِهِ فلا يُعتمد عليه وبه قال بعضُ أهلِ العلمِ وإليه أشار البيهقِىُّ، وإما القولُ بأنه على ما حملَهُ عليه المشبِّهةُ مخالفٌ للأصولِ القطعيةِ والأحاديثِ المتواترةِ فلا يُعْتَمَدُ عليه وإليه ذهبَ بعض أهل العلم ولعلَّ فِى صنيعِ مالكٍ فِى الموطَّإ ما يُشيرُ إليه.
وَحَمَلَ المُشَبِّهَةُ فِى عَصْرِنَا رِوَايَةَ مُسْلِمٍ عَلَى ظَاهِرِهَا كَأَسْلافِهِمْ مِنْ مُجَسِّمَةِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ فَضَلُّوا وَوَقَعُوا فِى التَّنَاقُضِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا نَحْنُ لا نُأَوِّلُ بَلْ نَحْمِلُ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِى الِاسْتِوَاءِ وَالنُّزُولِ وَحَدِيثَ الْجَارِيَةِ عَلَى ظَوَاهِرِهَا ثُمَّ تَنَبَّهُوا أَنَّهُمْ إِذَا حَمَلُوا حَدِيثَ الْجَارِيَةِ عَلَى ظَاهِرِهِ كَانَ ذَلِكَ إِقْرَارًا مِنْهُمْ بِأَنَّ السَّمَاءَ ظَرْفٌ لِلَّهِ وَأَنَّهُ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ فِيهَا فَيَتَنَاقَضُ ذَلِكَ مَعَ مَا زَعَمُوهُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَوْجُودٌ فَوْقَ الْعَرْشِ بِذَاتِهِ.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَهُوَ: ((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ)) فَهُوَ حَدِيثٌ قَوِىٌّ أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِى الْمُسْنَدِ وَالْبُخَارِىُّ فِى التاريخ الكبير وَالتِّرْمِذِىُّ فِى السُّنَنِ وَقَالَ عَقِبَهُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ اﻫ
وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى قَوِيَّةِ الإِسْنَادِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِى الْمُسْتَدْرَكِ وَالإِمَامِ أَحْمَدَ فِى الْمُسْنَدِ وَالطَّبَرِىِّ فِى تَهْذِيبِ الآثَارِ وَغَيْرِهِمْ: ((يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ)) فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُفَسِّرُ الرِّوَايَةَ الأُولَى لِأَنَّ خَيْرَ مَا يُفَسَّرُ بِهِ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ بِالْوَارِدِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِىُّ فِى أَلْفِيَّتِهِ: “وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ”، فَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ: ((ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ)) بِإِرْشَادِهِمْ إِلَى الْخَيْرِ كَتَعْلِيمِهِمْ أُمُورَ الدِّينِ الضَّرُورِيَّةَ الَّتِى هِىَ سَبَبٌ لإِنْقَاذِهِمْ مِنَ النَّارِ وَبِإِطْعَامِ جَائِعِهِمْ وَكِسْوَةِ عَارِيهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ يَرْحَمْكُمُ الْمَلائِكَةُ الَّذِينَ فِى السَّمَاءِ بِاسْتِغْفَارِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْزَالِ الْمَطَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الرَّحَمَاتِ.
وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة، وكان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة،
وفي المعجم الصغير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى مَكَانِي وَتَسْمَعُ كَلَامِي لاً يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي، أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ، الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنَبِهِ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وَذَلَّ جَسَدُهُ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ، اللَّهُمَّ لاً تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَكُنْ بِي رَءُوفًا رَحِيمًا، يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ، وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ))،
وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنًا مطرقًا برأسه، ويمد يديه كحال السائل، وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار ومن ذلك أيضًا افتقار القلب في الدعاء، وانكساره لله عز وجل، واستشعاره شدّة الفاقة إِلَيْهِ والحاجة لديه، وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء.
وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ)).
ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه، قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: “كان يقال: أفضل الدعاء الإلحاح عَلَى الله والتضرع إِلَيْهِ”.
وكان بعضهم يقول في دعائه: بعزتك وذلي، وبغناك وفقري.
وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: ((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ)) أي المتواضعين.
وأخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا، يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي المِسْكِينَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي المَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ القِيَامَةِ)).
وقال أبو ذر رضي الله عنه: ((أَمَرَنِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ)) الحديث. خرجه الإمام أحمد وغيره.
وفي المستدرك للحاكم عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ)).
ومِنْ أدبِ الدعاءِ كذلك التوبةُ وردُّ المظالمِ والإقرارُ بالإساءةِ، وأكلُ الحلالِ
ووصف الله تعالى المؤمن بالطيب بقوله تعالى: (ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ) [سورة النحل/ الآية 32] وإن الملائكة تقولُ عند الموت: اخرُجي أيتها النفس الطَّيِّبة كانت في الجسد الطيّب، وإن الملائكة تسلِّمُ عليهم عندَ دُخول الجنة، ويقولون لهم: طبتم،
وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه أنَّ المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة: ((طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا)).
فالمؤمن طيّب قلبُه ولسانُه وجسدُه بما سكن في قلبه من الِإيمان، وظهر على لسانه من الذكر، وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هى ثمرة الإيمان، وداخلة في اسمه. فهذه الطيبات كلُّها يقبلها الله عزّ وجلّ.
وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى أنَّه لا يقبل العملُ ولا يزكو إلَّا بأكل الحلال، وأنَّ أكل الحرام يفسد العمل، ويمنع قبولَه،
فالعملُ صالح مقبول إذا كان الأكل حلالا، فإذا كان الأكلُ غير حلالٍ، فكيف يكون العمل مقبولًا!!!
خرَّج الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباسٍ، قال: تُليَتْ هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [سورة البقرة/ الآية 168]، فقام سعدُ بنُ أبي وقاص، فقال: يا رسول الله، ادعُ اللهَ أنَّ يجعلني مستجابَ الدعوة، فقال النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((يا سعدُ أطِبْ مَطْعَمَك تَكُنْ مُستجاب الدَّعوة)).
ومن آداب الدعاء مدُّ يديه إلى السَّماء، وهو من آداب الدُّعاء التي يُرجى بسببها إجابته، وفي حديث سلمانَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله تعالى حييُّ كريمٌ، يستحي إذا رفع الرجلُ إليه يديه أنَّ يردَّهما صِفرًا خائبتين)) خرجه الِإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما.
والله تعالى أعلم وأحكم
 دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة
دعاة خير نشر الخير والفضيله هدفنا على مذهب أهل السنة والجماعة